دراسات
أ.د. عبدالله حسين البار
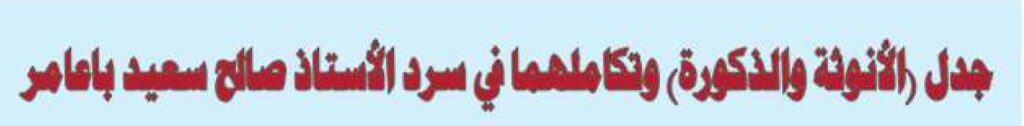

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 1 .. ص 72
رابط العدد 1 : اضغط هنا
ما الحياة إلا ذكرٌ وأنثى، أو أنثى وذكر.
سيقول قائل: في البدء كان الذكر.
ذلك ما نؤمن به ونعتقده. فقد سبق (آدم) (حوّاءَ) في الوجود. فهي بعضه.
قال تعالى:
“يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ، وخلق منها زوجها” النساء آية 1.
وبها اكتمل وجوده في إطارٍ شرعيٍّ.
قال تعالى:
“هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ، وجعل منها زوجها” الأعراف آية 189.
وقال تعالى:
“خلقكم من نفسٍ واحدةٍ، ثم جعل منها زوجها” الزمر آية 6.
(فحوّاءُ) لم تكن صديقةً، ولا خليلةً، ولا أنثى عابرةً في حياة (آدم) ولكنها وصفت في علاقتها به بصفتها الشرعيّة ولا غير، وهو ما جرى ذكره في القرآن الكريم.
بيد أنّ مواضعات الحياة، وملابساتها الثقافية منحت (الأنثى) صوراً متعددةً متقلّبةً في حياة (الذكر). وصار لكل صورةٍ موقفٌ استدعته رؤىً فكريّة، وأخرى اجتماعية، وهو ما استوجب عنه حديثاً في أدب الأدباء، وكتابات المفكرين.
ولقد مضى زمنٌ بدت فيه (الأنثى) مغلوبةً مقهورةً يتسلّط عليها (الذكر) كما شاء، وشاء له الهوى. وأمّا هي فمهيضة منكسرة الجناح لا صول لها ولا طول.
وإن من المصلحين الاجتماعيين من أبناء المجتمعات العربية في عصرها الحديث مَن نَسَبَ ذلك الجور الظالم والظلم الجائر إلى الإسلام، ناسياً أن القرآن الكريم: “ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف”.
سيقول قائلٌ مستدركاً: ولكن تتمّتها “وللرَّجال عليهنّ درجةٌ”.
وذلك حقٌّ. ولكن، أتنفي تلك التتمة ذلك التساوي بينهما في الحقوق (لهنّ) والواجبات (عليهنّ)؟ أحسبُ أن لا.
على أن الأخذ بمقولة التسّلط الذكوري والغلبة على الأنوثة نابعٌ من اتصال الذات بالآخر، وتفاعلها مع منتجات الفكر ومنطوقات الرأي في علاقة (الذكر بالأنثى) أو (الأنثى بالذكر) في أمم متعاصرة على الرغم من اختلاف الرؤى، وتباين العقائد، وفوارق التنشئة والتكوين التربويّ.
من هنا اتخذت العلاقة بين الأنوثة والذكورة صوراً شتى، تنامت حتى غدت قضيةً لها دعاةٌ ينافحون عنها وينادون بها. وكتّابٌ يؤلّفون عنها الكتب، وينشئون من أجلها الأعمال الإبداعية. وكلها يصدر من منظور (الأنثى) في بحثها عن وجودها إزاء ما رسمه (الذكر) في إنتاجه الأدبيّ من صورٍ لها. وكان (السرد) (كالشعر) مجالاً راقياً لجلاء مثل تلك الصور في علاقات الأنوثة بالذكورة في الحياة. ومن تلك الصور ما نجده في أعمال الأستاذ صالح سعيد باعامر قصّةً ورواية.
والأستاذ باعامر من أولئك الكتّاب الذين انشغلوا بهذه المسألة الفكرية في كثير من أعمالهم القصصية والروائية، يستوي في هذا الانشغال أن يكون بوعي فلسفيٍّ مستقصٍ متعمّقٍ، أو بحسٍ أدبيٍّ ناتج عن تجارب في الحياة مشفوع بقراءاتٍ في منتجات الثقافة والفكر. فعَلَقَ بأدبه منها صورٌ شتى متنوعة لا تخلو من محفّزات تستوجب تفكّراً وعرضاً للرأي.
وهو يستخدم ثيمة (الذكورة والأنوثة) في سردياته على نسقين، أحدهما نسقٌ اجتماعيّ، وآخر منهما نسقٌ رمزيّ. ولكلٍّ نماذجه من أدبه وشواهده. يستوي في ذلك أن يكون المُنتج السرديُّ قصصاً قصيرةً أو روايةً من رواياته.
وفي مقامنا هذا سنقف على قصّتين من مجموعته القصصية الأولى (حلم الأم يمنى)، وهما: (الهروب من الوحل) و(رقصٌ على ضوء القمر).
مثلما سنقف على ما اشتملت عليه روايته المطبوعة بأخرةٍ والموسومة بـ(إنه البحر)؛ لنقرأ في هذه الأعمال ما قاله نصّاً، ونستبين ما قاله كيفيّةً.
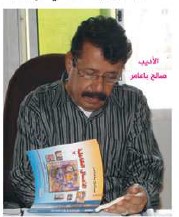
واللافت في سردية الأستاذ باعامر عند معالجته مثل هذه (الثيمة) أن يجدل علاقةً متناقضةً بين أنثى وذكر، ثم يصّاعد من ثناياها نوع من التكامل ينحلّ من بعد إلى تضادّ وانعتاق، أو إلى تماثل وانتماء. وتلك خصيصة في الوعي بمصائر الشخصيات تفرّد بها مُنتجُه السرديّ.
ولكي لا يتيه القول في مجرّدٍ نعمد إلى تعيينه بشواهد من سرده. في قصّة (الهروب من الوحل) يروي لنا (حسن) قصة خروجه من قريته بعد وفاة أبيه، وذهابه إلى واحةٍ في صحراء تفجّر فيها النفط فسال ثراءً فاحشاً غدا مطلبَ كلِّ ذي حاجةٍ إلى مالٍ يسدّ به عوزه، فحثته أمّه ليقصد تلك الديار أسوةً بأمثاله من أبناء القرية أتراباً كانوا أو غير أتراب. فينصاع لأمرها إرضاءً لها، فيسوقه قدره إلى قصر ذي جاهٍ عريضٍ، تنبئ عن ذلك الجاه أبّهة القصر ومحتوياته، ويكون عمله موكولاً إلى سيّدة القصر، وهي شابّة في مقتبل العمر، ولعلّها قريبةٌ من حسنٍ في السن، واسمها باسمة.
لم يكن لحسنٍ من عملٍ يؤديه سوى الإصغاء إلى ترّهاتها في الأيام الثلاثة الأولى. لكنّها في ليلة بعد تلك الأيام عدَت عليه في غرفته واغتصبت نقاءه الذي افتقدت شبيهه يوم رضيت بأن تُزَفّ قسراً إلى زوج لا يراها إلا كلوحةٍ من لوحات القصر الجميلة. فاستسلم حسنٌ صاغراً، لكنّه استيقظ على صوت أمه يحدّثه عن (الملائكة) وعن (العرش) فثار وجدانه على المهانة التي استساغها بادئ الفعل، فقرر الهرب من ذلك الوحل إلى فضاءٍ نسائمه نقيّة، وأزقّته جميلةٌ، ورياحه منعشة. ومن هنا انبثق عنوان القصّة (الهروب من الوحل).
والوحل كما في (المعجم الوسيط) هو الطين الرقيق ترتطم فيه الناس والدّواب، وجمعه أوحال ووحول.
بيد أن الإبداع انزاح به إلى معنى المستنقع والأوساخ التي تجرفها السيول من علٍ وتخلفها على سطح الأرض.
وهنا تتراءى مفارقةٌ في القول. (فالقصر) الذي أدهش حسناً – وهو الراوي، فقد رُويت القصة بضمير المتكلم – بسعته، وأضواء بهوه، وشدّة برودة مكيفه حتى ليكاد يتجمّد من البرودة، وجمال لوحاته وكثرتها حتى ليتساءل (هل يعبدون الفنّ إلى هذا الحدّ؟، أم أن زينة القصر تتطلب ذلك؟). والعبادة هنا تحيل إلى معنى التقدير العالي والإحساس السامي بروعة الفنّ وبهاء الإبداع فينزاح الدال عن معناه المعجميّ إلى دلالة متسعة، أقول هذا القصر الذي أدهش حسناً عند دخوله إلى (صالونه الفسيح) في مفتتح القصة غدا في ختامها غولاً يسعى هذا الفتى للهرب منه ومن أوحاله. وإنما يكون الهربُ والفرارُ من خوفٍ يقال: هرب منه دمُه، بمعنى اشتدّ خوفه. وهنا تتحوّل زينة القصر ونعيمه الظاهر إلى وَحلٍ، ويتحوّل الوحلُ إلى مثيرٍ تستجيب له الشخصية بالذعر، فتقرّر الفرار إنقاذاً لنفسها من السقوط الخلقيّ التردّي في الرذيلة والاستغلال الجنسيّ. وهو استغلالٌ يشي بقهرٍ اجتماعيّ طاغٍ يشمل ذكراً وأنثى ألجأتهما الحاجة والعوز إلى ما لا يرغبان فيه. لكن استجابتيهما لهذا المثير مختلفتان. ففي القصة تقف (باسمة) وجهاً مضاداً لـ(حسن). ومن هنا تنشأ الجدلية بين (الذكر والأنثى) على الرغم من التوافق في الرغبة والاشتهاء، وعلى الرغم من قسوة الظروف الاجتماعية التي قضت على (باسمة) بالرضوخ لزوجٍ لا يعيرها اهتماماً ولا يزيد على أن يراها (كإحدى اللوحات الجميلة المعلقة في القصر). وهي الظروف عينها التي قضت على حسنٍ أن يهجر أمه وقريته ويترك تعليمه، فبعد وفاة أبيه لم يَعُد من عائلٍ لأسرته غيره. وقريته مجدبةٌ لا تمنح المرء أملاً في غدٍ رغدٍ فقرّر الهجرة إلى بلادٍ لا قيمة للإنسان فيها. فما هو إلا سلعةٌ تعرض للبيع، أو قل الاستئجار لتحقيق رغبات أسياده ذكوراً كانوا أم إناثاً.
كلا البطلين أجبر على فعل ما لا يودّه ويرغب فيه، وهنا يكمن توافقهما. لكنّ (باسمة) رضخت لمصيرها واستسلمت لمظاهر الثراء مؤمّلة في إشباع رغباتها بما تحصّله من مالٍ كثير يستحيل إلى نعمةٍ ظاهرةٍ كانت فيها من الفاكهين.
وأكسبها هذا الحال سلطةً تتحكّم بها فيمن حولها من نساءٍ سيطرت عليهنّ كما سيطر عليها زوجها الغائب عنها في ما لا نعلم من مكان. ورامت أن تستعبد حسناً بمالها، وتهيّأت لها بوادر ذلك حين اكتشفت لهفته على معرفة مقدار (المرتب) الذي سيتقاضاه، بقولها: (سأسوّي لك كلّ أمورك إذا نجحت).
ولم يكن الامتحان عسيراً حتى يرسب فيه، فما هو إلا الجلوس في حضرتها يصغي إلى ترهات حياتها تهيئة للامتحان الثاني، والمتمثل في اغتصابه جنسيّاً لإشباع رغباتها المتأججة.
وهنا يندغم حسن مستسلماً في البدء تحت وهج الشبق النابع من أعماقه وأعماقها، فلا تتركه إلا بعد أن نالت منه ما أرادت، واستراحت لما فعلت مبتهجةً ظناً منها أنّه غدا صيداً سهلاً لصيادةٍ غير ماهرة.
لكنّ صراعاً يحتدم في أعماق حسن بين ضمير رُبّي على قيم ساميةٍ مثلى وبين رغباتٍ مكبوتة تتدافع من عالم معتم مهجور. فرأى الاستسلام لذلك الحال تردّياً وسقوطاً في وحلٍ، وإن أغرته رغباته الشهوانية بالمضيّ في ذلك الدرب، والاستقاء من تلك البئر.
لكنّ صوت أمّه المنبثق من أعماقه يردّد: (ملائكة السماء لا ينامون، يرهفون السمع لطلبات العباد. باب العرش مفتوح لدعوات الأمّهات)، يحثه على التمرد على ذلك الحال المزري، وعلى الهروب منه، فرأى الإشراق بعد العتمة، واستردّ النقاء بعد التلوّث. فقرّر الهرب، وكانت النجاة.
وهنا يفترق حسنٌ وباسمة. فهو ينماز عنها بأن رفض ما قبلت به، وأبى الاستسلام لما رضيت بقبوله.
وهو وإن اتخذ من تكوين الأنثى البيولوجية مدخلاً لاشتهاءٍ داخلي لم يتجاوز به حدّ الصمت فلم يجهر به وإن ردّدت السردية من دواله الواصفة ما يدل على ذلك الاشتهاء (جبينها البهي/ جسمها الممشوق/ روائحها العطرة/ فستانها الشفاف/ خصلات شعرها/ شفتاها الساخنتان/ صدرها الناهد).
والمفارقة هنا أن جسد باسمة الضاجّ كان سبباً في قهرها واضطهادها والسيطرة عليها رغبةً في امتلاكه بالمال الوفير والنعمة الزائدة الزائفة. وهو الجسد عينه الذي يستحيل إلى شَرَكٍ تصطاد به باسمة من تراه قابلاً للاستسلام له وراغباً في اشتهائه والظفر به لتحقق من خلاله ما ترومه من سيطرةٍ على الآخر وامتلاك وجوده، أما المال فيأتي لاحقاً. (ستكون تحت إمرتي). فإذا كان الزوج بماله قد امتلك جسد باسمة ونال منها مبتغاه وإن بعلاقةٍ شرعية، فباسمة بجسدها رامت امتلاك حسنٍ قبل امتلاكه بمالها. (إذا نجحت في الامتحان سأسوّي أمورك)، و(سأنال منك كلّ ما أريده).
وهنا مفارقةٌ ثالثةُ هي استعصام حسن بموقفه الأخلاقيّ الذي يقيم له المجتمع اعتباراً في كل نواميسه رغم التهاب الجسدين، فهو يذكّرها بأنها متزوجة: (إنك متزوجة) فتصفعه بقولها: (لو عرفت حقيقتي ما قلت ذلك). فيدافع حسن عنها من حيث هي: (لا أظنّ أنه سيجد أجمل من باسمة). فتثني على نقائه وسذاجة تفكيره وغرارة تجربته في الحياة. فيستحيل حديثه معها إلى حديث عنها، وغزلٍ بها: (إنك صغيرة ٌ ولطيفةٌ وأيضاً جميلة)، فيغدو ما تدعوه إليه أحبَّ إلى نفسه من السجن الذي ارتضاه (يوسف) خياراً له من ملاحقة امرأة العزيز له.
بيد أن هذا الصراع المحتدم بين الشخصيتين تحسمه (الأنثى) الكامنة في أعماق (الذكر/ حسن)، فتغلبت بقيمها المثلى على هذا السقوط المفجع. وتلك الأنثى هي أمّه التي انبعث صوتها من داخله فتردّد أصداءً ملء وجدانه: (بارك الله فيك ياولدي.. إنك ما زلت صغيراً.. الأحرى بك أن تواصل دراستك لكن ماذا نفعل؟ لقد جاءَ دورك بعد وفاة أبيك.. الله معك). ومثله: (ملائكة السماء يرهفون السمع لطلبات، باب العرش مفتوح لدعوات الأمهات) أليس هذا برهان ربه لينجو مما تدعوه باسمة إليه، ويغدو الفرار من قصرها فراراً من وحلٍ ومستنقع إلى فضاءٍ كلّه نور وإشراق؟ ألم يكن وقت فراره مع بزوغ ضوء الشمس؟ وهذه وظيفة تفسيرية رمزة للوصف يجيد باعامر أحكامها كما دلّل على ذلك كاتب مقدمة أعماله الكاملة في جزئها الأول، فلتنظر ثمّة. أما أنا فمعنيّ بالنظر في القصة الثانية من مجموعته الأولى وعنوانها (رقصٌ على ضوء القمر) لألتمس جدلية الذكورة والأنوثة وتكاملهما فيها. في هذه القصة (أنثى هي الزين) و(ثلاثة ذكور) هم سويلم وسالم وأب الزين. تنشأ بين تلك الشخوص علاقتان متضادتان متناقضتان هما علاقتا (اتصالٍ) و(انفصال).
لكن السردية تفتتح النصّ بوصف للأنثى على المستوى البيولوجيّ فتحدّد عمر الأنثى بأنه (في التاسعة عشرة من العمر). وتلقّط ملامح من حسنها لتوكيد المنحى (الواقعيّ) في القصة ليقينها من المستوى الرمزي المهيمن على أبعادها: (ذات وجه حالم، وعينين عسليتين جميلتين، ووجنتين ورديتين، وثغر باسم…).
وهي أوصاف لا وظيفة لها غير ما سلف ذكره. ومن هنا بدا التركيز على طبيعة العلاقات الرابطة بين الشخصيات ذا أهمية في العملية السردية.
تتقسم القصة إلى عدد من المواقف التي تجلو واحدة من تينك العلاقتين المتأرجحة وقائع القصة بينهما.
في الموقف الأول يتراءى (سويلم) مترصِّداً قدوم (الزين) مُذ خرجت من منزلها متجهة نحو الحقل لجني الذرة من سنابلها ووضعه في سلتها فيحييها بغزلٍ (يازين الزين) ليؤكد علاقة الاتصال بين (ذكر وأنثى) في إطار علاقة عشق. لكنه اتصال ملغوم بانفصالٍ ينبئ عنه اندهاشها من سماع صوته، وذعرها من مرآه. ولم يقف عند ذلك الحدّ فأمرته بالذهاب عنها (قبل أن يراك أحد)، وهو ما يفضي إلى انعدام التوازن في الموقف بين الطرفين. فهما عاشقان ومخلصان في عشقهما، لكنّ شيئاً يريبه منها، هي على علمٍ به، وهو لا يستطيع تبيّن سرّه.
قال السارد:
(نظرت إليه مضيقة عينيها.. همّت أن تفشي ما بداخلها لكنّها تراجعت).
لكن (سويلم) يأبى تصديق ما نطقت به (الزين) على الرغم من القلق الذي انتابه، مما مهّد لبدء الإحساس بالهزيمة، ويختلّ لديه التوازن. لكنه ظلّ مؤمّلاً مرآها في حلبة الرقص راجياً من ذلك الاستناد على شيء يعيد له توازنه بعد اختلاله، غير عالمٍ أن الرقص هو السبب في الضغط عليها لقطع الاتصال به – ولذلك جاء صمتها ترديداً خفيّاً لما تهجس به مشاعرها: (أعذرك لأنك لا تعرف ما يدور). مما يصعد باختلال التوازن إلى حدّ الانهيار.
في الموقف الثاني تلجأ السردية إلى استخدام تقنية (الاسترجاع). فتستعيد (الزين) في طريق عودتها إلى منزلها وقائع آخر ليلة رقصت فيها في حلبة (سويلم) ورفاقه، ودخولها على أبيها في وقتٍ متأخر من الليل.
وهنا تنشأ علاقة بين (الأنثى/الابنة) و(الذكر/الأب) الذي هو قاهر بسلطته الأبوية الممنوحة له بالحقّ الإلهي والشرع الديني والعرف الاجتماعي، فيهيمن (الثقافي) بكل صورة على الموقف، وتنتج علاقة انفصالٍ بينهما مشوبةٌ باتصالٍ هشٍّ. فهو على الرغم من السماح لها بالرقص في الحلبات، وعدم اعتراضه على خروجها في الليل المعتم المظلم يمثّل لها حالة من الذعر حين عودتها إلى المنزل في الليل البهيم وهو مستيقظ. ومن هنا هتفت خائفةً حين سمعت صوت (نارجيلته) وشمّت روائح (تمباكه) قائلةً: (يا إلهي! إن أبي ما زال ساهراً! ماذا حدث؟)، وهي تتوجس شرّاً قبل أن تُحيط بالخبر علماً.
بدأ الشيخ الحديث معها بالتذمّر: (أيقظني رقصكم)، والاحتجاج على رقصها في حلبة سويلم ورفاقه: (سمعتُ أنك تفضلين الرقص في حلبة سويلم)، ليكشف من بعد عن عدم ارتياحه لتلك الحلبة مستنكراً تفضيلها إيّاها، لكنه حصر علّة تفضيلها برغبتها في البقاء بجانبه، والضمير يعود على (سويلم) الذي سعت (الزين) إلى زحزحة ذكر علاقتها به إلى حين آخر، لكنه أجابها: (لقد عرفت كلّ شيء).
هنا تكشف السردية عن فجوةٍ في تسلسل وقائع الحدث، لكن الحوار بينهما يرأبها فندرك من خلاله أن ضغطاً ما وقع على كاهل الشيخ المتساهل مع ابنته ألزمه بتغيير وجهة نظرها من الرقص في الحلبتين بين قبول ورفض. فعمدت – أعني السردية – إلى جلاء الموقف (الرامز) في إطارٍ من التكوين الاجتماعي الذي يجعل (الأنثى) منصاعةً دائماً لسطوة الأبِ، والأبُ خانعٌ لسطوة الأعراف الاجتماعية والانتماءات الطبقية: (إنهم لا يليقون بك، فأنت من طينة، وهم من أخرى)، هكذا قال الأب لابنته، وحين احتجّت عليه بأن ذلك كان في زمن مضى قال لها: (سيبقون كما هم. اتركي الأوهام.. إنك ما زلت صغيرةً. والرقص ألهاك عن فهم أشياء عديدة).
كانت العلاقة تتسم بالاتصال بين الأب وابنته ما غَفَلَ الأب عن سطوة تلك الانتماءات، فأباح لها ممارسة الرقص دون رقيب فانتصرت (الزين) لحريتها في اختيار الحلبة، وعشق من هنت إليه نفسها، بل ودافعت عن ذلك الاختيار أمام أبيها بشجاعة تصل حدّ الوقاحة حين ردّت على سؤال أبيها عن عدم رقصها في الحلبة الثانية بقولها: (إنهم لا يعجبونني).

وهنا لا يبدو الرقص موضوعَ انتقاد في ذاته تحت أيّ منظور أخلاقيّ، ولكنّ المُنتَقَد هو الاختيار. فهو المشكلة. اختيار الحلبة واصطفاء الراقص، ومن ثنايا ذلك ينشق الانتماء من قمقمه، انتماء الأب إلى الحلبة الثانية، ورفضه للحلبة الأولى وراقصيها. وانتماء الابنة إلى الحلقة الأولى، ورفضها للحلبة الثانية وراقصيها. فتتجسّد من ثنايا ذلك علاقة انفصال بين الشخصيتين.
بيد أن القهر الاجتماعي، وهيمنة علاقات المجتمع على المستوى الديني والعرفي من حيث الانصياع لأوامر الأب وتقديرها يغمر (الابنة) فيجبرها على الخضوع رغم ما جبلت عليه من تمرّد، فتخنع بعد شموخ، وتختار الاستسلام بعد كبرياء. فتهجر (سويلم) لترقص في حلة (سالم) ابن شيخ القرية. قال الأب: (أدرك أنك تحبينه. لكن سالم سينسيك كلّ شيءٍ). فكان إجهاشها بالبكاء إعلاناً عن الاستسلام والرضى بما ارتضاه الأب.
في الموقف الثالث وهو الأخير تقرّر (الزين) الاستسلام لرغبات أبيها بعد أن رجاها أن لا تخذله: (لا أصدّق أن تربيتي ستذهب هباءً). فذهبت إلى الحلبة الثانية هاجرة حلبة (سويلم ورفاقه) على الرغم من اشتداد الرقص فيها، وتعالي أصوات المغنين بها، وضجيج أكفّ المصفقين من الحاضرين إليها وأقدامهم الضاربة على سطح الأرض ذكوراً وإناثاً. فيفتقدها (سويلم) ويشتدّ به القلق لغيابها وتأخرها عن القدوم إليهم فداخله شكّ دفعه للذهاب صوب الحلبة الثانية فانذهل من وجود (الزين) ترقص ثمّة، فاقتحم الحلبة وأخرج الزين منها، لكنّ أزلام ابن شيخ القرية دفعوه عنها ليظهر (سالم من بين الراقصين متزيّناً بأفخر الملابس.. ومتباهياً ببندقيته ووقف أمام سويلم بتحدٍّ قائلاً بصوتٍ آمر: ابتعد عنها). فيتعالى ضجيج اللجاج بينه وبين سويلم حول الزين وصلة كلٍّ منهما بها، فادّعى سالم ما لم يدّعه سويلم من أنها (خطيبته). وهذا إطارٌ شرعيّ يخرس الألسنة. لكنّ (الزين) تأبى الاعتراف بتلك الصفة فتمرّدت عليها كونها تمّت دون علمها ولا موافقتها فـ(افترقت الزين الجميع وأمسكت بيده – أي سويلم – ودَخَلَ الاثنان يرقصان في الحلبة الأولى).
هنا تتراءى حلبة الرقص رمزاً لصراع بين يمين ويسار، خيانةٍ ووطنية، ذكورةٍ تتكامل بأنوثةٍ، وذكورة تتقاصر عنها الأنوثة. وتغدو المرأة رمزاً للثورة التي يعرفها الفقراء والمحتقرون اجتماعيّاً – انظر في دلالة التصغير في (سويلم) و(عليان) – ولا يدرك معناها شيوخ القرى ولا أبناؤهم ولا أنصارهم الراضخون لهم.
ويبدو تمرد الأنثى على سطوة الأعراف الاجتماعية والتشريع الديني والانتماء الطبقي سبباً في انتصار المعدمين المحتقرين ليأخذوا بنصيبهم الوفير من الحياة. ويتجاوز بذلك دور الأنثى هنا حدّ التفاعل الاجتماعي ليتخذ بُعداً رمزياً لا يخفى.
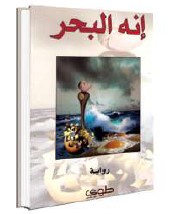
أما (الرقص) من حيث هو، فقد جرت به السردية في أعمالٍ أخرى، فرأينا (زوربا) يرقص في رواية كازنتزاكي، ورأينا (الزين) رواية الطيب صالح يرقص في كلّ عرس، لكنهما لم يوغلا في رمز. لكن حنا مينا هو الذي أوغل في الرمز حين جعل من الرقص مهاداً لإيقاظ المجتمع النائم ليثور على وضعه المتردّي، ويكون تعلمّه وسيلة البطل في الانسلاخ من طبقته والانتماء إلى طبقة المعدمين في روايته (الشمس في يوم غائم). ومن أحشاء كل ذك جاء رقص باعامر على ضوء القمر مضمّخاً بعبير بيئته المحلية من هنا كان امتيازه سرده في قصته القصيرة هذه.
ثم نأتي بعد هذا الطواف إلى روايته (إنه البحر)، وفي العنوان ما يستوجب استدعاء عوالم أنأى ما تكون (الأنثى) عنها. فقد خلقت عوالم البحر (لذكورٍ) ذوي سماتٍ خاصة وتكوين موصوف بدوال وضعت لوصف أحوال أمثالهم. لكنك حين تمخر في عباب تلك الرواية (إنه البحر) تتكشف أن للأنثى حضوراً فيها، وله انتشاره في جنباتها كحضور الذكر فيها، وأن جدليّة تنشأ بين الذكورة والأنوثة فيها على مستوياتٍ شتى، منها ما يتوافق ويتراسل، ومنها ما يتخالف ويتضادّ.
والعلّة التي نراها سبباً في حضور (الأنوثة) في عالم تختص بها (الذكورة) في هذه الرواية تعود إلى أن مساحة الوقائع التي في البحر أضيق من مساحة الوقائع التي تدور في (البنادر والمراسي). فالأحداث في فصل (ما بعد الإبحار) تجري على شاطئ البحر، حتى الجزء الذي تدور وقائعه في عمق البحر إنما تستذكره (حسناء) وهي على الشاطئ مستحضرةً صوت (السحيم) وهو يروي لها ما حدث معهم. ومن هنا صحّ استخدام ضمير الغائب في سرد تلك الوقائع. ولشيءٍ من هذا عنيت (السردية) بأخبار حسناء ونزولها المتوالي إلى الشاطئ، وحضور (الزين) معها، لم ذهابهما إلى الموبرة وسعيهما إلى مشاهدة حفلة (ما قاله التجلوب)، والضجر من (عبث الانتظار). ولم ينفرد فصل من تلك الفصول بتصوير صراع التجارة مع أمواج البحر، ولا وصف حركتهم في أعاليه ما خلا ما جاء في الفصل الموسوم بـ(فوق غبب رؤوس عمان)، ووصف سير السفن متجهةً إلى شرق أفريقيا عن طريق. وحتى في هذه الإلمامة لم يُخلِ السردُ بياض الصفحات من سواد وصفه ما جرى في تلك البنادر والمراسي التي وصلوها.
هذا الاستغراق في وصف ما جرى في البر الساحليّ دون بحره قد عاد بجدوى على متن الرواية، إذ تمّ استحضار الأنوثة على صور شتى دون قصر الحكاية السردية كاملة على الذكورة كما نجد في أغلب فصور رواية (الشراع والعاصفة) أو سواهما من أمثالها من رواياتٍ كان البحر فيها موضوعاً لسردٍ طويل.
في الرواية تندغم أنوثةٌ وذكورةٌ إذاً. وتنوّعت العلاقات في ما بينهما. ففي حين كانت العلاقة بين (السحيم وحسناء) و(سويلم والزين) تجري في إطارها الشرعيّ بوصفهما زوجين متحابين تتراءى علاقة (السعد بالنوبة) وعلاقتها بشيرون شاذّةً على المستوى الجنسيّ، وعلى مستوى المزج بين الواقعيّ والخرافيّ، مما يفقدها فاعليتها الإنسانية، ويدخلها في شيء من الرمز. وقريبةٌ من هذه العلاقة الشاذة بين (السعد وصاحبيها) علاقةُ (سالم المرزوع بقمر) التي قامت على الاتصال بغرض الممارسة الجنسيّة لهواً وعبثاً والتذاذاً لا نماءَ له.
هذا في إطار البيئة المحلية وشبيه به ما رأيناه في خارجها، في زنجبار مثلاً التي وصلتها (الفرج) آخر الرواية. فهناك ذكورة وأنوثة لها علاقات أخرى، فالأنوثة مطلبٌ حميمٌ للذكورة من (المتوّهين) وأشباههم، فإذا رضيت الأنثى بذكر اتخذت السبيل السليم لإتمام علاقتها الشرعية بمن تحبّ، فإن تأبّى أبوها عليها اتكأت على إرادتها وهربت مع حبيبها إلى حيث يتمّان ما بدآ. وفي هذا التمرّد خرقٌ لما رُبّي عليه أبناء البلدة على المستوى الديني وعلى مستوى العرف الاجتماعي. ومن هنا كان الحديث عن مثل تلك العلاقة – وإن جرت في إطارها الشرعي – مبعث اندهاش من (السحيم). وإن من أمثال تلك العلاقات ما لم يسلم من مآسٍ كالذي حدث لأحمد الغرابي حين عشق جوهر أمجد، وكادت تنتهي بموته لولا قدرٌ أنجاه من هلاكٍ محتوم.
بقيت علاقةٌ شاذة غير سويّة بين ذكورةٍ واعيةٍ بما تصنع وذكورة مختلّة تنصاع للقيام بدور (الأنثى) على المستوى الجنسي. ولقد بدأ الحديث عنها خفيفاً في أول الرواية لكنّه أوغل في الحس الغليظ بها حين روى السرد حكاية العلاقة بين (الصبي سليمان) و(الزنجباري هلال) التي انتهت بزفافهما بعد عقد قرانهما على يد قاضي الغرام. وتلك ذكورة شائهةٌ ناقصة استحقت مصيراً محتوماً هو (الموت) أو (الفضيحة) ازدراءً لسوء ما صنعت. ومن هنا جرت العلاقة السويّة بين الأنوثة والذكورة في إطارها الشرعيّ ما خلا ما جاء من حديث عن (الزين والنوبة وشيرون)، وعن (سالم المرزوع) وعلاقته بـ(قمر).
واللافت في رسم هذه الشخصيات وتشكيل المواقف أنها خضعت لمؤلّف الكلام بتعبير أوسبنسكي، فصارت تسير إلى حيث رسم لها، وعلى النحو الذي ارتضاه فجاءت صورها ملتصقة بهواه عن وعي منه مقصودٍ أو عن غير وعيٍ مقصود. ولذلك ظهرت (قمر) فجأة، وعاشت في الحدث الروائي قليلاً ثم ذهبت إلى عالم مجهول لا علم للقارئ به لعدم اعتناء السردية بها. ومن قبلها كانت وظيفة شخصية (السعد) محدودة برصد ما قاله التجلوب ثم تلاشى أثرها، وكأنها بنت الليالي الثلاث المذكورة في ذلك الفصل. و(سالم المرزوع) عشيق (قمر) ظهر في أول فصل (في الجزيرة الخضراء) واختفى في آخره، فلم يقدّر مؤلف الكلام له أن يعيش طويلاً على الرغم من حيوية شخصيته وفاعليته على تفعيل دراما العملية السردية. أما (سويلم) فعلى الرغم من أهمية حضوره في الرواية إلا أنه لم يحظ إلا بالقليل مقارنة بالسحيم. ولا مراء في أن السحيم هو (الذكر) الأمثل في الرواية مثلما (حسناء) هي (الأنثى) الأولى فيها، لكنّ بينهما فرقاً ليس على مستوى التكوين البيولوجي فحسب بل على مستوى الفاعلية وحيوية الصفات. فهو قويٌّ يدير دفة السفينة بصبر واستبصارٍ حازم لا يدع للتراخي ذريعةً تفقده السيطرة على المواقف المختلفة كموقفه من أحد (العبرية) حين هاجم الذكرين العاشقين وعيّرهما بفعلتهما، ناسياً ما أحدق بهم من خطرٍ لسوء ما فعلا، فسحبه إليه معنّفا، ومنعه من تجاوز حدّه حتى لا يكون سبباً في تهييج الركاب ضدهما. وهو لم يهمل إنزال العقاب بذينك العاشقين لئلّا يتمادى في ارتكاب الفحشاء سواهما. ناهيك بحبّه للصمت واقتداره على ضبط نفسه عن الثرثرة فلا يفضي إلا بما رام الإفضاء به من الكلام. ومن هنا بدا متماسكاً قادراً على الفداء بروحه إنقاذاً للآخرين.
هذه الشخصية الذكورية الممتازة بتلك الخلال تتطلبها وقائع الرواية لاقتدارها على مواجهة أهوال البحر ومخاطره تقابلها شخصية الأنثى المتمثلة في حسناء التي لها نصيب من اسمها، فهي تدرك محاسن جسدها وتحافظ عليها، وتحاول عرضها كعادة الأنثى كما عند فرويد، لكنها عاشقة حتى الوجد بزوجها السحيم لا ترى في غيره بغيةٌ، كثيرة الاشتياق إليه، بل ليس لها من فاعلية في الرواية سوى الحنين إلى ذكورته وتوقها إلى الالتصاق به والبقاء بين ذراعيه لتروّي ظمأ عروقها من خمر فحولته التي عتقتها مغامراته في البحار، ولذلك فهي تتلذذ بروائح البحر لأنها تذكرها به.
وحسناء لا تغيب عن وجدانها هذه الأنوثة ولا تحاول تجاوزها إلى دور أشدّ فاعلية، فانحصر وعيها عليها وعلى انجذاب الآخرين لجمالها كالعابرين في الطريق والقاعدين على المقهى بل حتى تعابين البحر لم تسلم من فتنة حسناء فأصرّت على ملاحقتها كما قالت أم الزين ساخرة منها. ولا يضير الشخصية أن تكون تلك طبيعتها التي آثر السرد أن يحصرها فيها، ولكنها تغدو مسطحة غير قابلةٍ للتطور والتفاعل مع تقلبات الأحوال. فهي غير قابلة للتمرد ولا التذمر إلا من طول أمد غياب السحيم عنها ، أو من عدم حرصه على إغلاق باب غرفتهما بعد عودته من رحلته الأخيرة متأثراً بما ملأ نفسه من حزنٍ وأسى لفقد سالم المروزع. وحتى هذا التذمر السلبي صرفته عن خاطرها حين أنبأها السحيم بما لا تعلم.
هل كان ينبغي أن تكون (حسناء) صورة مضارعةً للسحيم قوّةً واقتداراً حتى تتكامل معه؟
أحسب أن لا.
بل لعلّ التكامل بينهما لا ينبع من جدلية متناقضة رامزة بين ذكر وأنثى وإنما بين عالمين، عالم كلّه قوة ومخاطر وأهوال، وعالم كلّه رقةٌ ونعومة وهناء مقيم. ولذلك فإن ما يفتقده السحيم في إطار عالمه المفزع المخيف يجده في أحضان حسناء ودفء فراشها.
وما تفتقده حسناء من سندٍ قويّ يعصمها، ويحقق لها حاجة الإشباع إلى الأمن في صور شتى لا تلقاه إلا حين يحضنها السحيم. ولذلك فحين ذهب إلى زنجبار، وأنبئت بمرور سفينته على جزيرة سقطرى اشتعل القلق في نفسها عليه، لا من خطر محدق به في البحر، ولكن من حسناء أخرى تجذبه إليها بسحرٍ ربّاني أو شيطاني. في حين بدا السحيم غافلاً عن صور الأنوثة المترامية أمام عينيه وهو يحادث ابن عمه حديثاً لا يتجاوز ما تضمنه من تعليقٍ حدّ الشفاه. ففكرة منشغل بحسناء وفكرها لا يشغله سواه. وهذا تناغم بين الشخصيتين به تتكامل أنوثة وذكورة في إطارها الفطري. ومن هنا غلب الثقافي المتداول حول علاقة الزوجين بعضهما ببعض عند تلك الحدود فلم تتجاوزها حسناء كما تجاوزتها السعد مثلاً على شذوذ مسلكها، فظلّت منسجمة مع استسلامها دائرةً في فلكه غير قادرة على تجاوزه.
هذه العلاقة بين (السحيم وحسناء) نُسخت في علاقات شخصيات الرواية ذكوراً وإناثاً. فسويلم والزين لا يبعدان عنها وإن افترقا في الحضور المحدود لشخصية سويلم عن المدى المتسع الذي حظيت به شخصية السحيم. وبين سالم المرزوع وقمر وبين السعد والنوبة والسعد وشيرون من صور متنوعة تنتج علاقة واحدة تكون فيها الأنثى جسداً فوّاراً يشبع رغباته ذكر قويّ البنية ذو أثر عميق في وجدان الأنثى. ويتراسل معه ما شذّ عن سواء العلاقة بين ذكر وذكر، فهو قريبٌ من قريب.
وتأويل هذا الصنيع في رواية (إنه البحر) متيسر. فقد اضطرب الرسم الروائي بين (حكاية بحار) و(المرفأ البعيد). ففي رغبة السرد في الحديث عن مخاطر الإبحار في غبب المحيطات وأعالي البحار ما يشغله عن المرفأ البعيد، وما يمثله من مراسٍ وبنادر، لكنّ ذلك لم يتم له، فانصرف عنه إلى جلاء أحوال البنادر والمراسي، فشغل عن الاستغراق في حكاية البحار وصراعه مع أمواجه، فجاءت الرواية خليطاً من هذا وذاك، فاختلط فيها كل متناقض ومتضادّ على هذا النحو الذي صنع شعريتها الخاصة.
وخلاصة القول في هذا المقام أن الأستاذ صالح باعامر قد بدأ قصصه القصيرة منتصراً للأنثى فخلقها مضارعة للذكر متحدية لقهره متأبية على محاولات تدجينها لثقافة مجتمع واعتقاد أمّة. لكنه في روايته هذه جعلها خانعة مستسلمة لا تزيد على كونها جسداً ينتظر، لا فاعلية له إلا انتظار قدوم الذكر انتظاراً لا يخلو من عبث. ومن هنا رسم أمامها عالماً لا تستطيع عليه صبراً ولا تقوى على احتمال أهواله فتتركه لذكورة مكتفية بالبقاء على الشواطئ والبنادر والمراسي.
المكلا في 27/نسيان/2016م.