جزيرة الكهف
كتابات
د. سعيد الجريري
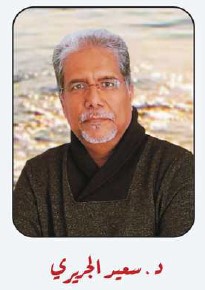
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 2 .. ص 101
رابط العدد 2 : اضغط هنا
سأرجيء الإشارة إلى دلالة العنوان، لغاية تعبيرية تكتيكية، مستبعداً أي تناص واعٍ بينه وبين جزيرة الكنز لروبرت لويس ستيفسون مثلاً، أو تماس مباشر مع كهف أفلاطون الأسطوري – ولا مشاحة في التناص والتماس – نافياً في الوقت نفسه أن يكون للعنوان أي دلالة جغرافية على خرائط العالم المتداولة – كما في بوراكاي بالفلبين – لكنه دال على (جزيرة) افتراضية تتراسل استعاريا مع (كهف) افتراضي، لإنتاج دلالة واقعية مؤرقة.
(1)
أثرت في مقال “مدينة بلاصحف” في العدد الأول من مجلة حضرموت الثقافية، هاجسا مؤرقا تتناسل أدواؤه، منتجة حالة خواء ثقافي وإعلامي لا يملؤها أي ضجيج خارج قوانين المواجهة الحقيقية للتحديات والإشكالات الماثلة. ولعلي مثير ههنا هاجساً مجاوراً من جملة هواجس تقتضي أن تمنهج آليات النظر إليها، ثم اجتراح كيفيات الانطلاق من لحظة الوعي بها إلى آفاق تتجاوزها، لا بالقفز عليها، وإنما بالاعتراف بها أولاً كمعضلة، ومن ثم تفعيل قوانين التحول إلى لحظة أخرى مغايرة، تصبح معها جزءاً من تاريخ تتأمله الأجيال التالية، ولا تقف عنده، بل تتجاوزه بوعي موازٍ، مكافئ، مستشرف ما بعده على منصة استراتيجية.
أشار أحد المثقفين العرب إلى ما جنته اللحظة المعاصرة في زمن تفكك الدولة الاستبدادية العربية المعاصرة، على مؤسسات العلم والمعرفة، حتى غدت االجامعات ” كليات مدرسية”، لا تنتج وعياً ومعرفة، بقدرما تحشد أجيالاً تغادر القاعات بعد سنوات معلومة، تحمل شهادات من ورق، يكثر في صالات الاحتفاء بها ضجيج وصخب احتفالي تعويضي عن فراغ تجتهد الكليات المدرسية في التعمية عليه، وهي تخرّج للمجتمع، في الغالب، أعداداً لم تحسن إعدادها، تقف حائرة إزاء تحديات لحظتها وأسئلة الواقع، ثم يمسها من فساد الأنظمة ما يحيلها إلى ما يشبه الإحباط، إذ تنتظر دورها الذي يكاد ألا يأتي للفوز بوظيفة تؤمّن معاشاً كريماً لعائلةٍ علقت كثيراً من أحلامها على فتاها الخريج.
(2)
ولعل سياقاً كهذا يستدعي تأملاً في جواهر الأشياء لا أعراضها، ونحن على عتبات مفصلية في البحث عن الذات ليس بالمعنى الفردي، وإنما الاجتماعي حيث تطفو على السطح أدوات وآليات منقطعة الصلة بالعصر، لتفعل فعلها في تشكيل المسار باتجاه المستقبل، على نحو مفارق، يحمل في داخله مفاعيل الانكفاء، والاطمئنان إلى الحلم بالماضي، باعتباره الصورة المثلى للمستقبل الذي يُخشى من مجهوليته ومعاصرته في آن معاً. وتلك حالة من حالات إفراز ما بعد تفكك دولة نظام الاستبداد التي يبدو أنها تؤسس لاستبداد بديل ومتخلف، لا يرى هو نفسه استبداديته المضمرة، مثلما لا يراها الذاهبون معه في مسارات طائفية لا بالمعنى الديني وحده وإنما بالمعنى التراتبي الاجتماعي أيضا، الذي يتلاشى معه ويتقزم إزاءه مفهوم المواطنة الذي يتكامل وجودياً مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
ولأن سياقاً كهذا لا يتسع للتفصيل فيه، حيز المقال، فإن ما ينبغي توكيده هنا هو أن مغادرة “النمطية” بأبعادها المختلفة تعد مقدمة موضوعية لأي تحول يُراد لحضرموت – كنموذج مطاوع – أن تنتقل فيه انتقالة نموذجية. فالملاحظ أن من مهيمنات الوعي والسلوك أنهما نمطيان استعاديان ليس على المستوى الوعي الديني وإنما على مستويات أخرى اجتماعية وسياسية وثقافية، وتبدو خطورة تلك النمطية الاستعادية أنها تشظي الذات والمجتمع وتشوههما من الداخل، وتسطح وعيهما معاً بحقائق الواقع الموضوعية، الأمر الذي يفسر حالة الشيزوفرينيا التي تعيقهما عن الانطلاق الحر المجرد من كوابح طارئة اكتسبت صفة الثابت.
(3)
جزيرة الكهف، تماهي دلالتين لإنتاج دلالة ثالثة، فالأولى هي إحاطة الماء باليابسة من كل جانب، فهي في عزلة عن اليابسة الضاجة بمفاعيل الحياة، ما لم تطلق سفنها في كل اتجاه، وتفتح موانئها البحرية والجوية للقادمين. والثانية انغلاق المكان عما حوله، ما يؤدي إلى توقف حركة الزمن داخله فيما يمور العالم حوله بحركة دائبة صاروخية السرعة. أما الدلالة الثالثة فناتجة عن تماهي العزلة بالانغلاق حيث تهيمن (فكرة الاستعادة) على كل ما / ومن في الكهف والجزيرة. وفكرة الاستعادة هذه عدمية، فهي تعمي عن رؤية أي نموذج سواها، فهي تمتلك حقائق التاريخ والفكر والدين والسياسة والاجتماع، ومهما يكن لها من صلة بمظاهر تقنية حديثة أو معاصرة، فهي صلة مبنية على ثنائية الفصل بين فلسفة المناهج وأشكالها، وهي ثنائية لا يغدو معها المنهج منهجاً وقد جُرّد من أساسه الفلسفي، ولا يغدو معها الشكل شيئاً أكثر من كونه هيكلا فارغاً. ومن هنا يبدو من الطبيعي ألا يكون للشهادات والدرجات العلمية معنى أو جدوى، ما دام تفكير “الخاصّي” هو تفكير “العامّي”، و رؤيته للعالم هي رؤيته، إن لم يقصرا دونهما أحياناً.