مدار
د. طه حسين الحضرمي
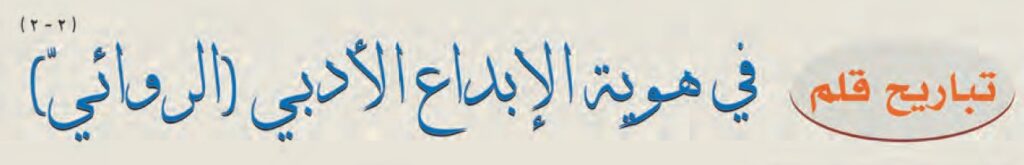

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 2 .. ص 106
رابط العدد 2 : اضغط هنا
(4)
الإبداع الأدبي في عمومه رؤية ورؤيا.تتقاسم إنتاج دلالته ما تراه عينُ الأدب البصرية من واقع ومعرفة ثقافية وما يحيط بالأديب من فكر وخيال وتشكيل لغوي.
بالغ بعض الدارسين في حديثهم عن واقعية النص الأدبي حينما حصروا هذه الواقعية بمعايشة الواقع فقط.بهذا المفهوم هضم بعضهم إبداع نجيب محفوظ؛ إذْ دندنوا طويلا حول إصرار نجيب محفوظ الدؤوب على مجالسه اليومية في (قهوات) القاهرة القديمة وعلى مسامراته الليلية على النيل وشوارع القاهرة البهيّة؛ مستندين إلى أهمية الرؤية المباشرة والمعايشة الحيّة للواقع، متجاهلين سيرورة العملية الإبداعية المكتنزة سردا أو شعرا في أعماق الأديب المبدع.
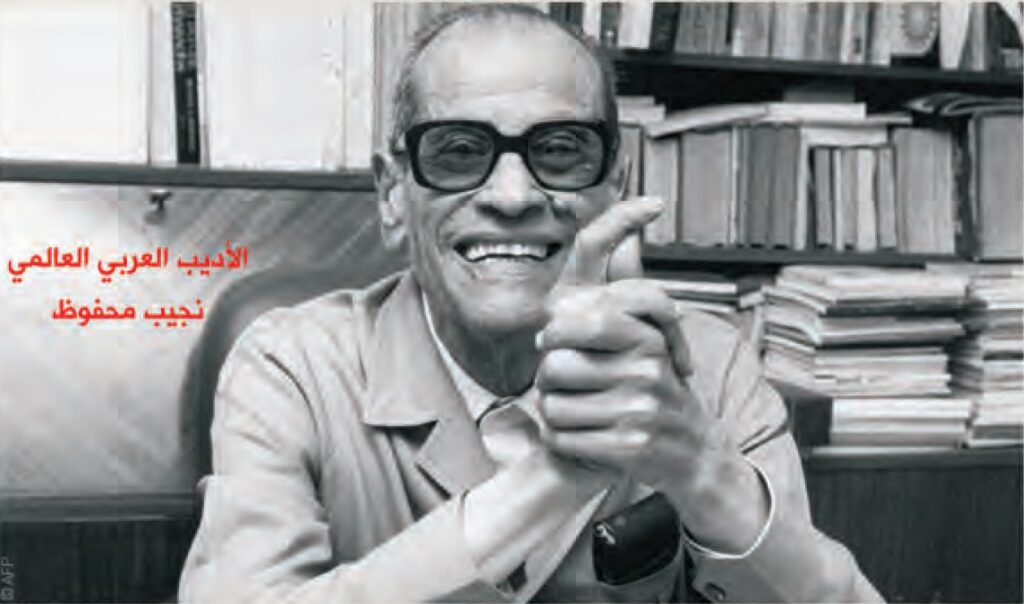
إنّ (نقطة ضوء) صغيرة كفيلة بإشعال وقود الإبداع الكامنة في هذه الأعماق التي تفيض واقعا وخيالا وفكرا.فكثيرا من حوادث روايات نجيب محفوظ تستضيء بمثل هذه النقاط الضوئية الصغيرة المتلألئة في سماواته اللامتناهية فيلتقط منها ما يشاء ويشكّلها كيفما شاء.
انبثقت رواية (اللص والكلام) من خلال شخصية سفاح الإسكندرية (محمود أمين سليمان) الذي شغل الرأي العام بأخباره سنة 1960م.وجد نجيب محفوظ في هذه الشخصية المقلقة فرصة سانحة تتجسد من خلاله الانفعالات والأفكار التي كانت تشغل فكره آنذاك فعندما شرع في كتابة رواية (اللص والكلاب) لم يكتب قصة محمود سليمان وإنما كتب (قصة فلسفية إنسانية وجودية) فجّرت أشياء كانت مخزونة في أعماقه وفي هذه الأثناء لم يعد لمحمود سليمان وجود لتتجلّى في إطاره شخصية (سعيد مهران) الروائية فتشتعل من خلاله عملية إبداعية (ميكانيزمية) معقدة تتخذ من هذه الحكاية (المتن) خطابا سرديا تتداخل في أحشائه قضايا الفكر والفلسفة وطرائق التشكيل الروائي. من خلال هذه العملية الإبداعية يتحدّد الفرق بين (الواقع الحقيقي والواقع الفني). وفي أثناء ذلك تتجلّى محدودية قدرة الإنسان على التذكر بينما قدرته على الخلق تظل غير محدودة على حدّ تعبير نجيب محفوظ.
أشار هنري جيمس في إحدى محاضراته عن الفن الروائي إلى أهمية هذه النقاط الضوئية في العملية الإبداعية متحدثا عن تجربة إبداعية متميزة؛ إذْ يقول (اذكر ما قالته لي روائية إنجليزية – سيدة عبقرية، من أنها أصابت كثيرا من المديح بسبب صورة الشاب البروتستانتي وطريقة حياته التي تمكنت من تقديمها في إحدى قصصها.سألها السائلون:أين تعلمت كل هذه الأشياء عن ذلك المخلوق الغامض؟ وهنئوها على الفرص العجيبة التي أتاحت لها ذلك.أما هذه الفرص فتتلخص في مرورها مرة، في باريس، وهي ترتقي سلما، باب مفتوح، يجلس خلفه في منزل قس، بعض الشباب البروتستانتي، حول المائدة بعد أن فرغوا من تناول وجبة غذائية، وقد صنعت هذه النظرة الخاطفة صورة، لم تدم سوى لحظة، ولكن تلك اللحظة كانت تجربة، لقد حصلت الروائية على انطباعها الشخصي المباشر، وحولته إلى نمط، لقد كانت تعرف ماهية الشباب، وماهية البروتستانتية، وكانت تتمتع أيضا بميزة أخرى فقد رأت ما يعنيه كون المرء فرنسيا، وهكذا حولت هذه الأفكار إلى صورة ملموسة وأنتجت حقيقة، ولقد كانت تستمع فوق كل شيء-على أية حال- بالقدرة التي إذا أعطيتها القليل أخذت الكثير، والتي هي بالنسبة للفنان أعظم بكثير كمصدر للقوة من أمر عرضي كمكان للسكن أو المركز الاجتماعي مثلا.فالقدرة على تخمين غير المرئي من المرئي، ومتابعة مضمون الأشياء، والحكم على العمل كله عن طريق الشكل، حالة الإحساس بالحياة بوجه عام بدرجة كاملة بحيث يكون المرء في طريقه إلى معرفة أي ركن معيّن منها- هذه المجموعة من المواهب تكاد تقول: إنها تكون التجربة)
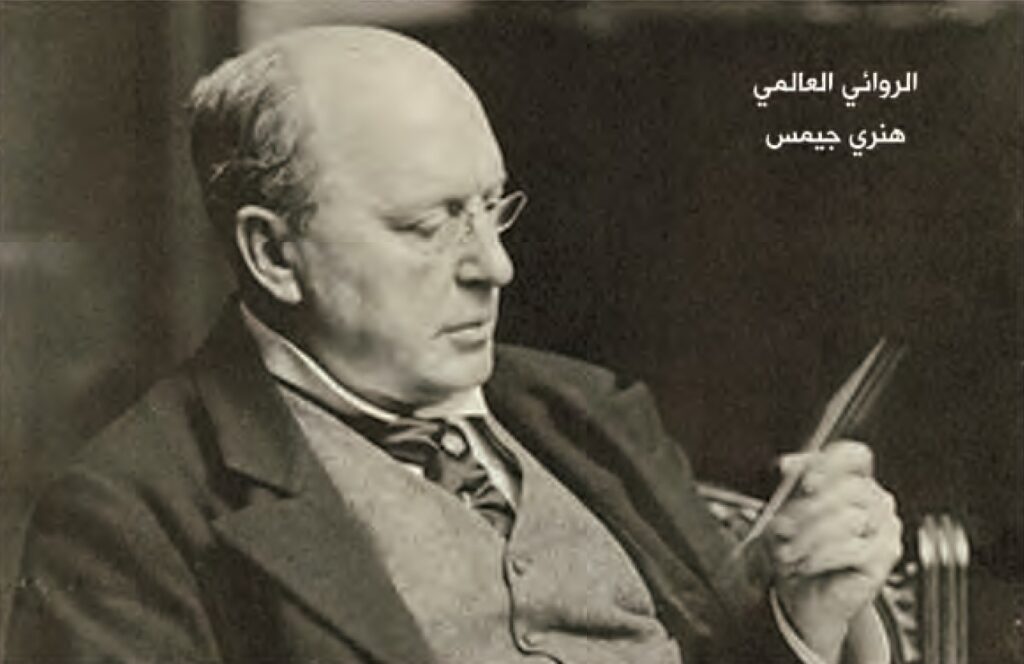
(5)
إذنْ! ما المحفزات التي نحرّك مكنونات هذه النقاط الضوئية الخافتة فتجعلها مشتعلة بالإبداع؟ لعل أيسر الأسئلة هو أصعبها إجابة؟ كما إنه ليس بالضرورة أن تكون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة مقنعة أو كافية إلى حد ما.على أية حال نستطيع أن نقول: إن النظرة المتأنية في طبيعة هذه المكنونات تفتح آفاقا واسعة لمحفزات لانهائية تبدأ من نقطة (الواقع) وتنتهي بنقطة (الخيال) بكل ما تحمله هاتان النقطتان وما بينهما من إحساس بالأشياء والأفكار.
أما الواقع فهو الأنموذج الأمثل للمحاكاة منذ عهد أرسطو حتى عصرنا هذا بكل ما تحمله (المحاكاة)-بوصفها مفهوما ضبابيا- من مشكلات تنظيرية، فكلٌّ ناظرٌ إليها من منظوره الخاص.فالواقع بكل حيثياته أرض خصبة للخلق والإبداع ابتداءً من ميثولوجيا هوميروس اليونانية في (الإلياذة والأوديسة) مرورا بألف ليلة وليلة العربية ومغامرات (دون كيخوته) الأسبانية؛ وصولا إلى سحرية واقعية ماركيز اللاتينية في (مائة عام من العزلة) وغيرها من الأعمال التي تبدو نافرةً في ظاهرها عن الواقع وهي في جوهرها جزء من تكوينه وتجلياته الخيالية.
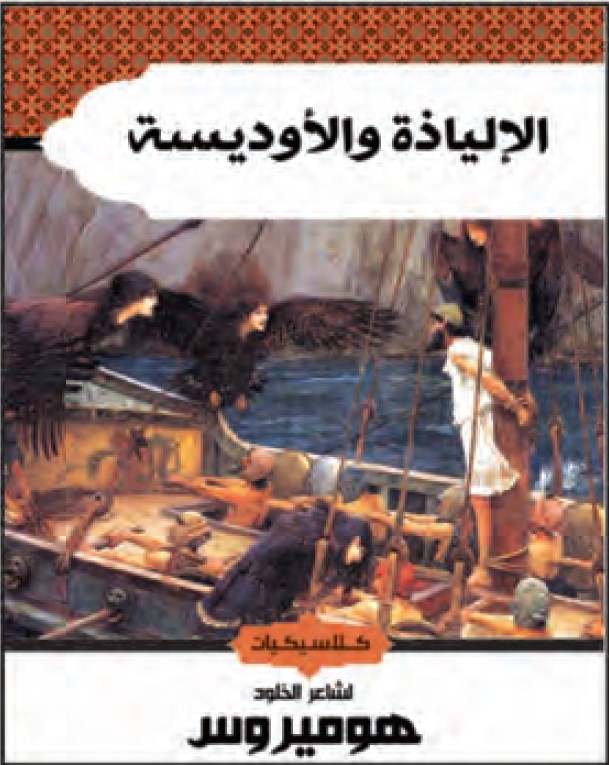
أما الخيال بكل نظرياته الفلسفية والنفسية والنقدية فهو محور التجربة الإبداعية؛ فلا إبداع بدون خيال.فالخيال الأدبي يصنع عوالم ممكنة افتراضية, فهو يمتح من الواقع بقدر ما يسعفه التخيّل اتكاءً على جملة اينشتاين الشهيرة (الخيال أهمُّ من المعرفة)؛ لأننا سندرك حتما أن المعرفة جزء لا يتجزأ من هذا الخيال الذي أسهم بشكل من الأشكال في صنع هذه المعرفة.
فالواقع في إطار الخيال أشبه بمرآتين متقابلتين يعكسان -من خلال صورة واحدة- صورا لا نهائية لا حصر لها تتمثل في صور أشتات في ذهن الرائي متشكّلة بوساطة (ميكانيكا الخيال)-على حد تعبير حبيب سروري- الكامنة في ركن قصي من ممكنات الإبداع المتنوعة لدى الأديب.
يحتاج هذا الخيال إلى تخصيب دائب من الأديب الناشئ.فقد أوصى ليوناردو دافنشي الفنانين الناشئين (باستثارة الذهن لشتى ضروب الابتكار).وقد أشرت في مستهل حديثي إلى أهمية النقاط الضوئية في صنعة الأديب والروائي بشكل خاص, فهناك صلة وثيقة بين هذه النقاط الضوئية المنبثقة من الذكرى وبين الخيال؟ أليست الذكرى أيضا خيال؟ أو ليست إعادة خلق؟ بلى! إذن فلابد من تدريب المخيّلة بقذفها في (بحار الذكرى مستدعية إلى عَتَمات الذهن، الأفراد والأماكن) بحسب تعبير الكسندر إليوت.
على الرغم من كل ذلك تظل الهوية الإبداعية عصيةً على القولبة والتقعيد؛ متفلتةً من القوانين العلمية الصارمة؛ سابحةً في بحار الإبداع والخلق اللامتناهية.ويظل التساؤل عن الهوية الإبداعية وماهياتها المتنوعة قائما باحثا عن إجابات مقنعة وكافية. وأنى لمثلي بذلك؟!