محطات محضارية .. الحب – العذال – السفر
دراسات
د. ماهر بن دهري
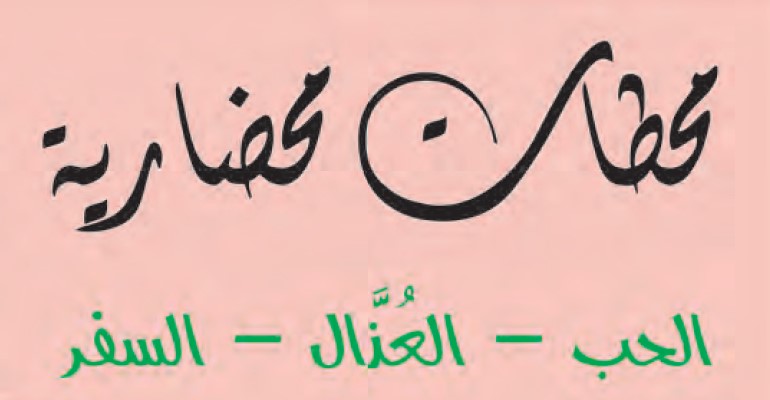


المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 63
رابط العدد 3 : اضغط هنا
كأنها إضاءة:
قد يتساءل البعض ماذا سيضيف هذا المقال من جديد عن المحضار؟ خاصة أننا نكتب في عصر كثر الكاتبون فيه عن هذا العَلَم، وقد يقول آخرون: ما فائدة إضافة حبةِ رملٍ جديدةٍ إلى هذا الشاطئ الرملي الهائل المترامي الأطراف؟ وماذا سيصنع مقال عن الشاعر حسين المحضار؟
وأجدني في هذه الأسطر لست معنياً بالإجابة عن هذا السؤال إذ إن الحديث عن شاعر كحسين المحضار حديثٌ يثيرُ كثيراً من بواعث الكتابة؛ فالمحضار قد شغف بحبه كثير من أبناء حضرموت الذين يتغنون بأشعاره في حلهم وترحالهم، وكثيراً ما يستشهدون بتعبيراته في البوح عن كثير من مكنونات أنفسهم التي يتحرجون منها أو التي يجدون المحضار قد عبّر عنها بشكل دقيق، فهو ينطق عن خواطر الناس، ويجسدها أحوالاً، ويصورها مواقف تتنوّع بتنوّع أحوال الحياة ومواقفها، ويبني من خلالها جسور التواصل بينه وبين جمهوره، ويصبح التفاعل مسألة معقولة، ويغدو الانفعال أمراً مُدرَكاً، وما من شكٍّ أن خواطر الناس ملأى بالحب والود والحنين والوجد والمعاناة والشوق وغيرها من الأمور, والمحضار إنسانٌ يحدث له ما يحدث لغيره من بني البشر، فهنا تتشابه كثيرٌ من تجاربه بتجاربهم، ويعاني ما يعانونه ويكابدونه، فيفرح كما يفرحون إنْ وجدت أسباب الفرح وعوامله، ويحزن كما يحزنون حين يتطلب الوضع حزناً أو يفرضه، والذي يختلف فيه الشاعر عن غيره من البشر هو درجة الحساسية لديه وقدرته على التعبير التي يتفوّق بها عمن سواه.
وهَذا ما يميّز الشاعر عن غيره، وعندئذٍ يصبح الشعر رسالة يتلقاها القرّاء ويسعى كلٌّ على حسب ثقافته وتجاربه في الحياة ليفكَّ شفرتها، ورؤاه وخبرته بالشعر من حيث هو نمطٌ من القول متميزٌ لغة وموسيقا وتشكيلا. فالنص الأدبي مزدوج الشفرة، فيه بنيتان: بنية سطحية ظاهرة، وهي ما يقوله النص في القراءة الأولى، أو هو القول المباشر والمفهوم من ظاهر النص، وبنية عميقة، وهي القسم المطمور في قعر النص، أو ما يشير إليه النص ويوحي به، وهذا يحتاج إلى قراءات وحفريات للوصول إلى عمق النص، وإذا كان النص ثريّاً بمخفيّاته والمسكوتات عنها فإن الحفريات والقراءات تزيد من توهُّجه وتألقه، وتمنحه حياة بعد أخرى، وهذا يعني أن النصَّ الثريَّ مُركّبٌ تركيبا فنيا معقدا، وهو بناءٌ سيمفونيٌّ تتعدَّدُ فيه الأصواتُ والعلاقات والتقاطعات، ففيه صوت النص الظاهر، ويقابله صوت النص الباطن، وفيه صوت الزمن الراهن، ويقابله في القعر صوت الزمن الغابر، ومن هنا يتعدد القراء والنص واحد. وكلٌّ يقرأ في النص ما يمكنه أن يقرأه. فيقف واحدٌ عند سطحه الظاهر ويدور حوله لا يتجاوزه، بينما يغوص آخر إلى أعماقه المطمورة فيقع على لآلئ ودُررٍ ما كانت تطوف بخياله. ويفسره ثالثٌ على حسب ما أحاط به من ظروف سياسية واجتماعية، أو أخبار أشتاتٍ جمعها من هنا وهناك، بينما يحرص غيره على تأويله تأويلاً نابعاً من بنية القول نفسه أو قل إنه يحاول استنطاقه معتمداً على قدرته على قراءة الوجه الغائب للنص من خلال وجهه الظاهر غير مكترث بما أحاط بالنص أو اتصل به من قريب أو بعيد،. وهكذا تغدو قراءة الشعر عملاً إبداعياً، ومعاناة شاقة كلما ألزم القارئ نفسه بالجدية، وأخذها بالشدة، أما إذا تهاون واكتفى بالسريع الساذج فإنه من السهل عليه أن يخطف القول خطفاً، وينثره كيف شاء دون تدبّر وإمعان. ومن هنا يصيبُ الشعرَ الضررُ.
وكون حديثنا سيدور عن الشعر الذي تلوّن بألوانٍ من تفاعل المحضار مع حركة المجتمع المحيط به وانفعاله بأحداث من تاريخه. فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأسئلة تكشف إجاباتها عن الكثير مما في شعر المحضار وكيف نظر المحضار إلى هذه الأحداث والآلية التي ساس بها ذلك الشعر وقدّمه للناس؟ وكيف يمكننا التفتيش والتنقيب فيه ودراسته ؟ ثم في أيِّ إطار يمكننا أن نضع هذا اللون من الشعر، أنعده شعر مناسبات، قيل في ظرف سياسي اجتماعي بعينه، وقد تجاوز الزمن ذلك الظرف وأحداثه، ولمّا يعد لها مكان سوى في أخبار التاريخ؟، وعليه فلنا أن نطرح ذلك الشعر الذي قيل عنه. أم نعده رؤية الشاعر للحياة أو بعض رؤية، وهل هذا الشعر يمثل موقف المحضار من مجتمعه الذي لم يقف عند تلك المرحلة وتلك الأحداث بل تجاوزها لأحداث أخرى، وبقي المحضار يتفاعل مع حركة المجتمع المتلاحقة، وينفعل بأحداثه؟
وسندَعُ الحديث في تفصيل القول لأنه يطول وليس هذا محله، فالمحضار كغيره من البشر حفلت حياته بتجارب متعددة وأطوار متنوعة انعكس أثرها في شعره حديثاً عن تلك المراحل والتجارب، فهو كغيره مرَّ بفترة الشباب اللاهي الذي لا تشغله همومُ الحياة ولا يستغرقه التفكير في مشاكلها، فقد تفرّغ للجمال فانشغل قلبه به، فهامَ خلفه عاشقا لا يشغله عنه شاغل، وإن اعتراه أمرٌ أو نابَهُ خطبٌ فإنه لا يقيم اعتباراً له، ولا يوليه اهتماما كبيرا، فالعشقُ ديدنه والهوى هاجسه، يدور حيث دارَ، صادحاً بأشجانه، متغنياً بعذاباته، باثّاً تأوهاته وسعاداته، ولكنّ الدنيا لا تسير على نهجٍ واحد أو خطٍّ ثابت، فإنه يعقب هذه الفترة أوقاتٌ أخرى تفرضُ على المرء إعادةَ ترتيبِ أولوياته وشكلَ ونهجَ حياته، فـ ( زمانه الجاير عليه جار) وسبّب ( له فراق الأهل والجيرة) فـ ( عزم على السفر) و( ودّعَ أحبابه وداعاً حار) و( بدّل بداره دار معمورة) وعاش في غربته ( طيرا شاديا يعيش فوق الشجر) و( بين أغصانها رايح وغادي وإن هزه الشوق فر) ولم تطل المدّة حتى هزّه الشوق فتمنى العودة( متى باضوي إلى عشي) لأن قلبه( عا الأوطان يتحرك) وليس قلبه فحسب بل ( والعين من جور الجفا تبكي) فكان أن هتف قائلا( قابليني يا سعاد والبسي ثوب السعادة) ليعود المسافر و( يلقي عصا الترحال) ويجد البلاد قد تغيّرت أحوالها وتبدلت على غير ما تركها فـ( نغّصوا عليه شُربَه) و( حطوا له الشوك في دربه) وأرادوا أن ( يشاركوه في جهده) و( بغوه دائم يمد للعطاء يده) فعندئذ يتحوّل من المحضار المتفرغ للجمال والعشق إلى الشاعر المشارك في الهموم والآلام التي يمر بها مجتمعه وأمته.
المحطة الأولى: الحب في شعر المحضار:
سئل حماد الراوية عن الحبِّ ما هو؟ فقال: الحبُّ شجرةٌ أصلها الفكر، وعروقها الذّكر، وأغصانها السهر، وأوراقها الأسقام، وثمرتها المنية.
ويطلق على الشعر الذي يتناول الحب الغزل، وفيه يتناول عآطفة الحب الإنساني الخالدة بجميع أحاسيسها ومشاعرها وانفعالاتها وانعكاساتها على حياة الشاعر المحب أو العاشق منذ أن تستهويه المرأة فيقع فريسة لحبِّها وتملأ قلبه وجدا وشوقا لرؤيتها، وقد تعرِفُ منه هذا الحبَّ فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومىء إليه إيماءة فيزداد ولعاً بها وغراما، وقد تتدلل عليه وتمتنع، وقد تنأى عنه وتهجره فتضطرم بين جوانحه نارُ شوقٍ لا تُخمد؛ وعبثا يتذلل لها ويستعطف ويتضرع ومع ذلك لا يذوى الأمل في نفسه بلقائها أبدا فهو دائما مؤمِّلٌ في اللقاء بعد الهجران( أمل عندي وساهن وصلهم لو هي ثواني ) ويدعو الله أن ييسر سبله(ربّ اجمع بيننا البين لا تحرم بطول البعد خلاًّ من خليله) أو على الأقل في الرؤية بعد الحرمان(وفي لقياك كل القصد والمطلوب).
والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس هو: هل عَشِقَ المحضار ؟ فإن كان الجواب نعم، فمن معشوقه؟ وهل المحضار موحِّدٌ في العشق أم أنه متنقل الهوى لا يكتفي بواحد، فلا يروي ظمأه إلا أن يكون له أكثر من معشوق؟
وللإجابة عن هذا السؤال فقد ذهب من تحدّث في هذا الأمر- وهم كثر- مذاهب شتى، كان منهم المحبُّ للمحضار الذي حاول تنزيه المحضار عن الوقوع في الحبِّ لأنه – من وجهة نظره – يهزُّ الصورة التي رسمها للمحضار في مخيلته، وقد انطلق من مفهوم أو تصوّرٍ أنَّ الحبَّ شيءٌ معيبٌ في مجتمع كالذي عاش فيه المحضار. وفريق ثانٍ رأى المحضارَ عاشقاً لكنه كان موحّداً في العشق أي أن كلَّ ما حَوَته أعماله الشعرية إنما هو حديث عن محبوب واحد تعددت صوره وأشكاله بحسب المراحل ويستشهد لك بأقوال للمحضار من مثل ( أنا من أجل واحد تجنبت العرب ومشيت وحدي) أو (غريب تارك بلاده والأهل من أجل واحد) وغيرها، وأيُّ قارئٍ لهذه الأبياتِ وغيرِها ليسَ أمامه سوى الاعتراف بأنَّ المحضارَ يتغنى بمحبةِ واحدٍ، لكنَّ كلمة واحد هذه لا تدل على أنه في هذه القصيدة هو ذاته الواحد في القصيدة التي تليها أو التي قبلها. من هنا يمكن أن يكون الحبيب في هذه القصيدة هو فلان، وفي قصيدة أخرى وقد تغيّرت حالة الحب الأولى أو انقضت يكون الحبيب هنا آخر، من هنا يبرز الرأي القائل إن المحضار مشركٌ في الحب، والرأي الذي يميل إليه الكاتب؛ هو أن( المحضارَ موحّدٌ في الحب ومشركٌ أيضاً) فالمحضار يكون موحّداً في الحب حال انعقاده أي حين يكون حبل الودِّ متصلاً، وجذوة نار العشق متّقدة ؛ لكنه حين تخبو نارُ الحبِّ لانشغال المحبوب أو إعراضه أو استماعه للعذال أو لغيرها من الأسباب، يبحث عن عشق آخر وبهذا يكون مشركاً في الحب.
من هنا يمكن القول إن المحضار تغنى في كل القصائد بالمحبوب الذي تعلق به قلبه وهامَ به عقله وعشقه ورغب فيه؛ وليس بالضرورة أن ينجح كلُّ حب، فالتاريخ ينبئنا عن تجارب حب فاشلة كان السبب فيها أن أحد المحبين منشغلا بحب آخر، ألم يقل الأعشى:
عُلِّقتها عَرضاً وعَلَّقت رجلا غيري وعُلِّق أخرى غيرَها الرجلُ
وعُلَّقته فتاةٌ ما يُحاولها من أَهلِها مَيِّتٌ يَهذِي بِهَا وَهِلُ([1])
وبقراءة متأملة وجادةٍ لأعمال المحضار تجد ما يزيد عن نصف قصائده عن الحب أو خالطها الحديث عن الحب، وما فيه من طقوس أو شعائر، ومظاهر من لقاء وفراق، ووصال وهجران، وسعادة وشقاء، ورضى وسخط، وظفر وحرمان، وغير ذلك من الذبذبات النفسية التي تمتلئ بها نفوس العشاق في كل زمان.
أما عن الكيفية التي ينعقد بها الحب المحضاري فينبيك بها قوله:
شفته ووافق شفي وبدأنا لقانا بالسَّلام
سرّحت نحوه طرفي أنظر في جماله والقوام
أوقوله في قصيدة ( بريد المحبة) :
رمز عينه بريد المحبة بين قلبي وقلبه، باقي الناس ما بابفهمونه
عنب في غصونه
كل تأشير له ألف معنى في فؤاد المعنّى يفتهم من حواجبه وعيونه
لكن لا يكتفي المحضارُ بنظرةٌ وتأشيرة لها ألف معنى؟ وأنَّى له بقلبٍ يرى الجمال ويكتفي به، ومن أين تأتيه القناعة بالنظر دون أن يعقبه كلام؟، لهذا تجده يصرخ قائلاً:
نظرة وبس ما تكفِي لابد من تعارف وانسجام
كلمة وبس ما تشفي لابد يتبع الكلمة كلام
أما موقف المحضار من الحب فقد جلاه قوله:
عندي حذيره نا من الحب ما با قول خيره ما بقي فــي لسـاني يـــــــدور الطعـــــم والـــــــــرِّيق
هكذا يصرح دون خفاء، أنه لن يتنازل عنه ما بقي حيّاً، وتعبيره (ما بقي في لساني يدور الطعم والريق)، يعكس امتداد الحب وسريانه في كل مكوناته، وهي إشارة إلى بقاء الحب ما بقيت الحياة، ولعلنا لا نذهب بعيداً لو قلنا إن في ” الطعم والريق” دلالة على أنه ولو تغيّرت أحواله حتى بدا الريق مُراً وهو تلميح إلى تغيّر الحياة وتبدل الظروف سيبقى متمسكاً بالحب.
ولأن المحبة كما يرى المحضار ( بغت جبري دوب يُرضي المحبين) فإنك تسمعه ( يقبل ما يجي منه ونفسه راضية)، بل ويقنع بما يأتي من المحبوب وإن كان قليلاً(ومن حب حد ما شنا يراعيه ويصونه ووده يشوفه جم لو هو قليل)، فهو رهن إشارة المحبوب (كل ما دعاني أو قال: عجّل، تعل. له جيت عاني)، ويؤكد أن هذه التلبية تكون في الحال قوله(ملزوم للأمر تحت الطلب طيّار) ما يعكس الجهوزية وسرعة الإجابة. ورغم ما يظهره المحضار من تسامٍ في الحب وتنازلٍ إلا أن المحبوب لا يعامله بالمثل فـ( ينصحه يبلغ النصائح ) لكن خله( ما انتصح) والمحضار من أجله( جاي رايح ليله وصبحه والروح) ومع كل ما يفعله من أجله، لا يقابل المحضار من محبوبه بما يتوقعه، فيظهر عليه اليأس وعدم الرضا بهذا الواقع حين يقول:
لا تعذبني وإلاّ سرت وتركت المكلا لك إذا ما فيك معروف
ولكن هل يستطيع المحضار فعلاً تركه وترك البلاد التي يعيش فيها وهو الذي غيّرَ دارَه من أجل محبوبه وانتقل للعيش معه و( لولاه ما حلَّ في هذي الديار) لأن داره ( تقع في خير ديره بين المجاني والخضيره) ومع هذا فقد (تركها لأجله وهو مختار)؟
الجواب ينبيك عنه المحضار نفسه حين يعنْوِنُ لقصيدة بـ( القنع منك سكون بس يا ريته يكون) ليظهر استحالة تخليه عن هذا الحب، ولا يكتفي بهذا القول دون أن يبدي السبب الذي يجعل بعاده مستحيلاً فيصرح لمحبوبه أن (بعادك على قلبي يؤثر).
وفي قصيدة (مول شامه) تبدأ القصيدة بعبارة صادمة يدّعي فيها المحضار ما لا قِبلَ له به يقول: ( محيتك من سطور مذكرة قلبي محيتك من رسوماتي الجميلة)
محيتك من سطور مذكرة قلبي محيتك من رسوماتي الجميلة
لكن هذه المقدمة لا تصمد طويلا حتى يظهر المحضار العاشق، وبتأمل الأبيات فإنَّ النَّص المحضاري يظهر محواً لكن ليس من القلب، وإنما هو من سطور مذكرة القلب، وكأنه يشير إلى تغلغل المحبوب ما وراء السطور وتمكنه في شغافه؛ ولذا نراه أسيراً عاجزاً عن التحكم في أعضائه فاللسان تذكره:
ولا أدري فين عاد الحب لك مخبي مكاني أذكرك في كل ليلة
ويرسم لقطة جميلة لتعلقه به فاليد والوجه يتحركان لا إراديا لرؤيته:
مكاني كلما شفتك معدّي بدون اشعور أشر لك بيدي أو بابتسامه
يامول شامه وباقة ورد عا خدك علامه
فهل بعد هذا يصْدُق المحو؟ لعل المحضار هنا يبحث عن نصرٍ معنويٍّ لنفسه تجاه هذا المحبوب الذي أحكم الشباك حوله فأبداه أولاً غيرَ قادر على السيطرة على أعضائه، وها هو يبديه أسيراً تحت رحمته:
كأنك قسمتي في الحب من ربي ونا ما لي من المقسوم ميله
كأنك قد عرفت السر من حبي ولك قد بان يا خلي دليله
وترجمت الهوى وفهمت قصدي ولا تبغي تصرّح به وتبدي خوف الملامه
يامول شامه وباقة ورد عا خدك علامه
ويرسم المحضار مشهداً لهذا الحب المتعثر، وسعي المحبوب لإشعاله وإبقاء الروح فيه فيبقيه – إن صح التعبير – على مرحلة الجمر ليست ناراً تأجّجُ وليست رماداً تذروه الرياح:
تخالسني النظر من لحظك الحربي وتصرعني بذاك اللحظ غيلة
وتلقاني عمد وتمر عا دربي وتتمنى إلى وصلي وسيلة
ولكنك نكِف لا قدك سدِّيْ ظهرت العنف وظهرت التحدّي ورفعت هامة
يا مول شامه وباقة ورد عا خدك علامه
كلها أفعالٌ تكشف معرفة من جهة المحبوب بما تضمره نفس المحضار له، وخبرةً في إنعاش هذا الحب واستمراره، فلا هو البعاد التام ولا الوصال المرجو، ويبدو أن هذا المحبوب قد أحكم الوثاق، ولهذا يتلذذ بتعذيب محبوبه، إذ تظهر أفعال الأمر التي احتشدت في المقطع الرابع حالة من الاستعطاف:
تكلم وأظهر المستور بالعربي لسانك ليه بالكلمة ثقيلة
تكلم لا تقع في عشقتك عصبي ودع عنّك شياطين القبيلة
بغوا قلبك من القسوة يصدّي بغوا الأحقاد بين الناس تمدي عاما فعاما
ثم يختتم القصيدة بتمنيات:
متى با نلتقي بالجانب الغربي وإلا عا مقد أو في مسيلة
أنا وأنت وبس والكأس والمضبي وبعض أنغام منظومة جميلة
ونتشاكى بما عندك وعندي ونسرح في الخلاء زندك بزندي ونعود لامه
ويلاحظ على الأبيات رغبة عارمة في اللقاء، لكنها رغبة من طرف واحد، ولهذا ظهر ضمير المحبوب الغائب الذي كان يُقدّر في كل الأبيات السابقة إلا حين رغب الشاعر في اللقاء وكأنه استشعر فشل أو تعذر هذا اللقاء فاكتفى أن يكون حاضراً ولو على الأقل بالضمير الظاهر( أنت، كاف الخطاب)؛ وربما فيه إشارة من بعيد إلى محاولة تحريك ضميره. أما اختياره الأماكن المفتوحة للقاء ( المقد- المسيلة- الخلاء) فكأنه يتوقع دمعا غزيرا يسيل. أو ربما كان محاولة للتحرر من سجن العواذل والحساد الذي يرى نفسه قابعا فيه، فهو يبحث عن مكان يغيب فيه عن النظر.
وإذا كانت أفعال المحبوب كذلك –وهي كذلك- فقد يسأل سائل ولماذا لا يترك المحضار هذا الحب ويبحث عن محبوب آخر؟ والإجابة عن هذا السؤال تعيدنا للحديث الذي أشرنا إليه آنفاً عن توحيد المحضار أو إشراكه في الحب، ذلك أننا لمّحنا إلى إخلاص المحضار في الحب وصرّحنا بتمسكه بالحب وبذله من أجله الكثير وسعيه من أجل إنجاحه، وهذا ما يؤكده قوله(إن جيت نرميك قلبي ما احتمل والصبر عا مثلك مصالاة) لكنه حين يستشعر إعراضاً وعدم رغبة في الحب من جهة المحبوب يلوّح المحضارُ مهدداً بإنهاء العلاقة قائلاً(وإن غلق المعروف بالمرة ولعاد لك في حبنا فكرة با قفل أبوابك وبا شبع سكون) وهنا يُلحُّ سؤالٌ: أيستطيع ذلك؟ والحقيقة أنَّ دون قفل الأبواب أشجانٌ، تخبرك بها الأبيات الآتية حين استحال لقاؤه ومع ذلك ظلَّ يدعو له بالسعادة وطول البقاء:
ترفعت وينك يا غزال النقا غطاك السماء والحيد تحتك وقا
على العين أقرب منك الغول والعنقاء ولا يستهن ولك وطيب العناق
إلى أن يقول:
طلبت السعادة لك وطول البقاء وخاصمت لاجلك أحسن الأصدقاء
وأصبحت بسعادتك ومحبتك أشقى وأيامي تعدّي معك في شقاق
أحب الفراق إذا كان في الفرقة الهدوء والرواق
ولا ينبغي أن تغرَّنا وتخدعنا هذه الخاتمة المحضارية المغالطة التي اختتم بها هذه القصيدة من (حبه للفراق إن كان فيه الهدوء والرواق)، إذ للمحضار موقف من البعاد يكشفه لك قوله(البعد يقتل كم من جمل روّح قتيله)، بل حين (قال له صاحبه با نفترق) ماذا كان ردُّ المحضار(قلت له: كيف أنا با فارقك؟ كل شيء يقتبل غير الفراق)، ويصوّر البعد قائلاً:
البعد سيفه حاد وحديده قسي هندواني
كم قطّع الأكباد خلاها تصب دم قاني
بل يزيد الأمر توضيحاً حين يعترف قائلاً:
ما ني على البعد طايق والبعد كلفته كلفه
ويزيد تصريحاً حين يقول:
بودِّي فارق أحبابي ولكن ما تحملت الفراق
أما مفهومه للحب: فيمكن الحديث عن مظهرين بارزين يراهما المحضار في الحبَّ :
أولهما: الحب عطاءٌ لا أخذٌ، ومسامحة لا مشاحة، وقبولٌ لا نفور، ولهذا يقول في قصيدة ( عسل):
خذ من الهاشمي ما تريده واسمح بلقياك يا ذا الحسن
خذ من الفائدة والوجيدة لي في الوسن
ليه تبخل عليْ بالتلاقي ما قد سبق بيننا شي وحن
فالحب عند المحضار عطاءٌ ولهذا كرر (خذ )مرتين وفتح له باب الاختيار في أخذ ما يريد في مقابل السماح له باللقيا فقط. وفي قصيدة (وفاء) يؤكد على العطاء ويجعلها شلة أو لازمة تتكرر:
الحب أصله وفاء ومسامحه ما هو عطاء وخلاص
بل إنه يرى أن(ومن حبّ حدْ ما يبالي باخبار قيلٍ وقالي)وليس هذا فحسب بل (ويخسر ويسهر ليالي لمّان يرضيه)، من هنا فهو لا يقبل المتاجرة بالحب ويشن هجوما عنيفا على من يفهم الحب مصالح(حاسب الحب سلعة يشتري ويبيع) أو (حاسب أن الهوى أغراض ومشاريع)، وترتّبَ على هذا الفهم الخاطئ أنه (ما يهمه اللقاء عنده كما التوديع)، أما المحضار فله فهمٌ آخر تمثل في (مَنْ يحِبْ صاحِبَهْ لُهْ يَستَمِعْ ويطيع ما يقوله، ويلقيه الأمير المطاعي)، فإن لم يكن كذلك فعلاجه (يترك الحب أحسن له ومن دون داعي)
ثانيهما:الحب قوة تجميع لا تفريق، ولهذا يقول(آمنت أن الحب قوة خارقة تجمع قلوب الناس)، فمع أن الحبَّ من وجهة نظر المحضار(راحته والله تشبه عذابه) لأنه يا(كم شاف من راحة وكم شاف تعذيب)، فإن رضي المحبوب في وقت من الأوقات ( يسقيه عسل من جبح ما غبه النوب)، وإن لم يرضَ (وأوقات يجرحه بنابه)، فأهل العشق في تعاسة دائمة(لا بكاء داوود ينفعهم ولا حزن يعقوب)، ولكن مع هذا يبحث المحضار عن لحظات يظهر فيها شيئاً من السعادة فـ(يستلي ويضحك وهو رأسه من اللطم معصوب) .
وكل الحديث عن تمسك المحضار بالحب وصبره على المحبوب لا يعني أن المحضار لم يشتكِ من هذا الحب، فقد ضجَّت دواوين المحضار وأعماله الشعرية بالشكوى من المحبوب الذي تتغير معاملته بين فترة وأخرى ولا يعرف المحضار سبباً في كثير من الأحيان لهذا التغيّر، وهو – المحضار – حريص على هذا الحب. ويمكن أن نلمس بعض أشكال التغيُّر التي أحسها المحضار، فيمنح عنوان قصيدة لفظة( تغيّرت) لتقع عليها كاميرا الناقد وتسلط الضوء عليها جاعلةً منها بؤرة ينطلق منها تحليل النص، فالعنوان عتبة تضيء دهاليز النص كما يرى ذلك النقاد، يقول المحضارمخاطباً محبوبه: (تغيّرت سبحان المغير) مبيناً له أبرز ملامح التغير (وقلّ الحياء لي فيك والغيرة)، وكانت نتيجة هذا التغيير أن(أصبحت في حقي مقصّر)، وهذا الظن بناه المحبوب على وهم وظنٍّ(وظنيت يدّي منك اقصيره). فمطلع القصيدة يصدم القارئ فيه فعلان( تغيرت، قلّ الحياء والغيرة) وكأن المحضار يربط التغير الأول بالتغير الثاني ربط النتيجة بالسبب، ويلاحظ أنه استخدم الفعل الماضي أربع مرات بالتساوي مع المضارع، بيد أن دلالة الماضي هي التحقق، ذلك أن التغير متحقق وقلة الحياء والتقصير والظن، في حين أن الأفعال المضارعة تدل على صراع بين المأمول المرتجى وما يقابله (بين الوعد والهجر، والعهد والغدر).للدلالة على تحقق المكروه واستحالة المأمول.
ويستمر في عرض مشهد الشكوى(وإن قلت لك : لي حق تنكر) ومما يثير امتعاض المحضار أن محبوبه لا يعتبر ظلمه( نكيره)، أما حين يحدث اللقاء قدراً فالمحبوب( يعبر مشمتر) ويزيد في التجاهل بأن( يقفي ويعطيه الشميره)، فيصرخ المحضار( الليش بالقسوة يا هاجري)، ويؤكد له أنه(ماجات شي هفوة مني) ويتساءل المحضار عن هذا التغير وهو البار بمحبوبه(عقيت معروفي ونا اللي فيك بار) ويطالبه بالإفصاح عن السبب (وقطعت حبل الوصل قل لي ايش صار) ويعلنها أنه(ما حد صبر مثله) .
وظهرت شكوى المحضار في عدة صور: منها:
- الشكوى من تجاهل المحبوب وعدم الاهتمام: ومن الأبيات التي تمثلها قوله:
كاتب عليك مخالفه يومك تعاكسنا وتمشي دوب من خلفي
كل يوم تقلب عاصفه ما طاع ماء حبك لنا في الساقية يصفي
ب – الشكوى من جفاء المحبوب وتبدل معاملته: فكل يوم يمر تظهر من المحبوب أفعالٌ لا تنم عن محبّة، حتى أصبح اللقاء عابراً وكلماته خالية من معاني الود وعبارات الحب فيقول في قصيدة هوّن شوي:
| ما تستحق العاطفة | لا جيت با بادلك بعض العطف من عطفي | |
| كلمتك دائم جافه | يا كم وكم تجرح بها قلبي وكم تجفي |
حتى لقاك أصبح فرص ومصادفة.. وأحيان ما تنشاف
- التبرم من تصرفاته والوصول لمرحلة المفاصلة: وهي مرحلة يرى المحضار أنها ستكشف كل شيء وستظهر الأمور على حقيقتها وتضعها في نصابها، فلا داعي للّفِّ والدوران:
| إن كان ما نيّتك بالحب صارح | أنا أقبل الصدق والتصريح | |
| ولا تخلّي محبك جاي رايح | يهوي معك في مهاوي الريح |
- اليأس والمطالبة بالفراق: ومع أن العنوان يبدو للوهلة الأولى صادماً إذْ قد يُظن أن المحضار يمتلك من القوة ما يُمكِّنه من الفراق، إلا أن الواقع خلاف ذلك. أليس هو الذي يقول:
| كيف يقدر يفارق من عشق | قرّب البعد وارحم عاشقك |
وألم يقل في قصيدة اشفق بحالك:
| إن جيت نرميك | قلبي ما احتمل |
والصبر عا مثلك مصالاة
وأما صرّح في قصيدة (القنع منك سكون) بقوله:
| وإن غلق المعروف بالمرة | ولعاد لك في حبنا فكرة |
با قفل أبوابك وبا شبع سكون
بلى فعل ذلك كله وأكثر ولكن دون قفل الأبواب أشجانٌ وإن وصل مرحلة اليأس من اللقاء كما في قصيدة طلبت السعادة :
| ترفعت وينك يا غزال النقا | غطاك السماء والحيد تحتك وقا | |
| على العين أقرب منك الغول والعنقاء | ولا يستهن ولك وطيب العناق |
إلى أن يقول:
| طلبت السعادة لك وطول البقاء | وخاصمت لاجلك أحسن الأصدقاء | |
| وأصبحت بسعادتك ومحبتك أشقى | وأيامي تعدّي معك في شقاق |
أحب الفراق إذا كان في الفرقة الهدوء والرواق
إلا أنه لا ينبغي أن تغرَّنا وتخدعنا هذه الخاتمة المحضارية المغالطة التي اختتم بها هذه القصيدة من حبه للفراق إن كان فيه الهدوء والرواق، إذ للمحضار موقف من البعاد يكشف لنا الحديث الآتي:
- موقفه من البعاد: وقد برز هذا الموقف في قوله
| البعد يقتل | كم من جمل روّح قتيله | |
| ولا معي من خبرة البِل | نشبي بهن في سهل وجبال |
ويقول في قصيدة ريم اليمن:
| قال لي صاحبي: با نفترق | قلت له: كيف أنا با فارقك؟ |
كل شيء يقتبل غير الفراق
وإن كان الجفاء سماً فإن لهذا السمِّ علاجاً ناجعاً من وجهة نظر المحضار، فكل مرض له ترياقٌ، المهم فقط هو تشخيص المرض ثم الحصول على هذا الترياق الذي حدّده في قصيدة الحباس يقول:
| الجفا والتباعد سُم والوصل مرهم | ما أحسن الوصل لا قد جاد به الخل وأنعم |
به يطيب الصفا به يلطف الجو ويزين
ويُلحُّ المحضار على هذا الدواء في قصيدة ( اتفقنا )حيث يقول:
| يوم نار الجفا مُحرقة | بالتلاقي طفينا الحريق |
هكذا يظهر عجز قلب عن الهجر وعدم انشراحه به، والمعنى نفسه يصرّح في قصيدة( أنتِ يالدنيا كذا):
| ماني على البعد طايق | والبعد كلفته كلفه | |
| عِدّ الزمن بالدقايق | مترقب الوصل صدفه |
ويزيد تصريحاً حين يقول:
بودِّي فارق أحبابي ولكن ما تحملت الفراق
المحطة الثانية: العذال في شعر المحضار وموقفه منهم:
تكرر في الشعر الجاهلي حديث الشعراء عن (عاذلةٍ لائمة) لهم على ما يقومون به من أفعال وتصرفات، وحاولوا من خلال ذلك التعبير عن بعض القيم الأخلاقية والاجتماعية التي يفخر بها العربي بأسلوب غير مباشر من خلال اختلاق حوار بين الشاعر وعواذله.
يرتبط مفهوم العذالة باللوم والعتاب والملاحاة، وترِدُ صيغٌ كثيرة مشتقة من مادة (عذل)، وتطلق تسميات متعددة، مثل اللائم واللاحي والزاجر والأعادي وأهل الحسد. وتشير كل هذه الصيغ والتسميات إلى الطرف الآخر الذي يصارعه الشاعر لتجسيد رؤيته في الحياة أو موقفه من قضية معينة. كما قد يتعلق موضوع العذل بموقف الشاعر من بعض القضايا الاجتماعية العامة، مثل المغامرات الغرامية والحياة اللاهية، أو بعض القضايا الحياتية الخاصة وبعض المشكلات الأسرية، أو غيرها.
عند استعراض الديوان الأول للمحضار تقف أولى قصائده بعد التي تغنى فيها بمكة والحرم وطيبة، حاملة عنوان ” أهل السبب” لينكشف لنا جزءٌ من الأمور المتعلقة بالحب، خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أنه يسميهم ” أهل السبب” التي تفوح من ثناياها رائحة الرفض المحضاري لما يقولونه.
فماذا قال أهل السبب حتى تتصدر قصيدتهم ديوانه:
| قالوا إنه ما يرابع دهن منه دهن | يرفعك ويحطك ابشيش |
أهل السبب في حبيبي قالوا ايش
| قالوا إنه بايخليك وحدك في سهن | بين جول العيص وبويش |
أهل السبب في حبيبي قالوا ايش
| قالوا إنه بايبيعك على قل الثمن | صبر أو تقسيط أو كيش |
أهل السبب في حبيبي قالوا ايش
| قالوا إنه عاسرايرك ما هو مؤتمن | ما يعقه الملح والعيش |
إنها محاولات لتفريق الشمل، وإفشال الحب، ويحاولون إظهار أنفسهم بصورة الناصح المشفق، ولم يكتفوا بكل ما ذكروه وأرادوا أن يزيدوا في إيغار صدره عليه وتبغيضه إياه،( قالوا: سمع.) فماذا كان موقفه؟ (قلت: لا.) ولماذا لايسمع؟ لأنه: (فيه عنده حسن ظن).
وعند تتبع بعض نتاجات المحضار الشعرية يتضح لنا جلياً موقفه من هذا الصنف من البشر، ففي قصيدته التي حملت عنوان” رمضان” تحدث الشاعر عن معاناته ومكابدته وسهره الليالي ، ويظهر ما يقوله العذال: (نسوك الصحب والخلان، ولعاد واحد منهم يسميك) ويحاولون الطعن فيه(وودك السابق عليهم هان ولعادهم حسب العوايد فيك) لكنه يرفض هذا ويرد على لائمه فيهم (كفى بهتان) ويطلب منه(خليك عني مبتعد خليك) ويُنكر عليه أنه(تلوّن له الحديث ألوان).
وفي مقابل ردّه عليهم فإنه يلفت انتباه محبوبه، ويصرح بحقيقة ما سيقوله هؤلاء العذال (إيش با يقولون لك عني الأعادي كلام ماله أثر) ومصلحتهم من هذا الكلام(ما قصدهم شي سوى عثرة جوادي) ويؤكد أن تصرفاتهم ناجمة عن حسد وحقدٍ(جم يحبو الفتن ما لهم قط مهنة غير تفريق الاثنين) أفبعد هذا يجوز الاستماع لهم ؟ّ!
بل إنه يصور استماتة العذال في محاولاتهم من خلال إظهارهم تعاطفهم معه وتلوينهم للكلام، وكيف أنهم في الوقت الذي ينصحونه بتجنب المحبوب يقومون بمغازلته ومحاولة كسب ودّه،( أسـّوي إيه لو شفت ذا يغريه أو ذاك ذا يطرح له الشمس في كفه وذا نجم السماك ) هكذا تتولى المغريات ويستفيد المحضار من تقنية التناص لإيضاح عظمة هذه المغريات من خلال استحضاره لما قالته قريش في عرضها للنبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا منه تركهم وآلهتهم وسيعطونه كل ما يرغب به وما يجعله أغناهم وأجملهم زوجة وغيره.
ومع كل ما يراه المحضار ويسمعه يُظهر لنا تناقضاً آخر من خلال إظهارهم بمظهر الناصح المشفق عليه حين يقولون له:
| تريــــده ليه قالـــــوا لي العذال ذولاك | قالوا ليه تبقى معه دايم وهو ما هو معاك | |
| تريده ليه فـــك منك الغدار والفاك | با تلقي مثيله وهو ما با يلاقي حــــد كماك |
ويوضح فعلهم القبيح وإصرارهم من خلال اختياره هذا النهج، ويكشف المحضار الغاية التي يسعى إليها الوشاة الحاسدون فيقول: ( والمسابيب يبغوني قنع وانسيه ) لكنَّ( للمحضار) نفساً يقظة تكشف ألاعيب ( عذاله) وأساليبهم الماكرة فـ(كلما حاول من نهر المحبة أن يشرب) كانت النتيجة أن (كدّر الواشي شرابه)
ولنا هنا أن نتساءل عن الكيفية التي يتعامل المحضار بها مع الحساد، ويمكن توضيح هذه الآلية بما كشف عنه المحضار، فحين (ودّعَ أحبابه وداعاً حار) و (أعطاهم وأعطوه الأسرار) أما الحساد فـ(ما جاب لهم سيره)
ويذكّر محبوبه بنصائحه (من العاذل دهَن ) وأن يـ( دعْ ما يقوله عذوله إذا رامَ المطولة) لأنه (ما في السعيف الزين تولة ولا عيب منكور)
ومع كل هذه النصائح والوصايا للمحبوب إلا أنه تنكّب الطريق فهو (يقاطعه وهو له مواصل) فاستوقفه المحضار قائلاً(غرّوك عذالي أو حبي الذي غرّك؟) ويطالبه بإجابة واضحة(صرّح بها يا أغر) ويتمسك المحبوب بطريقته في التعامل معه بعدم الرّد على تساؤلاته ويتعجب من أنه (ينفعهم وهم يسعون في ضره) ويبين المحضار أنهم لا يفعلون ذلك إلا لحقدهم وحسدهم،( غرّوه لي هم عَلي حاسدينه) .
وبعد هذا يكاشف المحضار محبوبه أنه كما يسمع هو كلاماً من عذاله فإنهم ينقلون للمحضار كلاماً عن محبوبه، لكن الفرق واضح في التعامل مع ما ينقله الوشاة والعذال فـ(كم بلغه فيه من هرج لاذع) لكن المحضار(ملقي عطب في المسامع وكلمة الناس عنده غير مسموعة ) ويكرر هذا الفعل فـ (يطرح عطب وسط آذانه)ويبين السبب أنه(ولعاد با يخلي الحاسد ولا الشاني يلعب بذيله )ولك أن تقف عند قوله( ملقي عطب في المسامع) لتعرف موقف المحضار من كلامهم. فـ(مهما قالوا العذال ما يصغي للمقاله)
ويكشف عن صورة أخرى من قولهم:
| ليه تنكر من يحبك، والعواذل عينهم بك | يشهد الله عا محبك، فيك ما با يطيع |
ويقول:
| غروك عذّالي أو حبي الذي غرّك | صرّح بها يا أغر | |
| نا عارف الناس لي تفتح لهم صدرك | تقبل لكل ما صدر | |
| لكننا حيد كيف الحيد يتحرك | واقف كما يوم كان |
إلى أن يقول:
| إن جيت بنصحك درت أعطيتنا ظهرك | ما للنصيحة مكان |
( العذّال) إذاً هم الذين جعلوا المحبوب ينفر من ( المحضار) ، ويغلق دونه قلبه وأذنيه، ولا يكاد يطيق له مجلساً، لذلك تراهم يتربصون بكل عشق محضاري ويسعون وراء كل حبٍّ( للمحضار) يكدِّرون صفاءه، ويفسدون عليه لحظات أنسه وهنائه فيزرعون الشكوك والمحضار كثيرا( ما جنى منه الشوك)و(كم من محازي الكذب وشروا فلوك) ونقضوا عليه غزله وهو يحوك)، وما ذلك إلا لأنهم( بغوا القلب يسبح في شطونه). ويضيق صدر المحضار ذرعا بما يفعله الحساد فيدعو عليهم (عسى لعين الحاسد الواشي العمى) وتنطلق هذه الدعوة من مبدأ الجزاء من جنس العمل، فالدعاء عليهم بالعمى فهو(لي هو حرمنا منك يا عذبَ اللمى)، وتارة يدعو عليه بالرمد لكي يشُلَّ الحاسة التي بها يرى تلاقيهما، فلا يمكنه بعد رؤيتهما (يا من عليك المعتمد ارم عيونه بالرمد) ومن جهة أخرى لأنهم(لم يرحموا دمع سايل يغني المحب عن سؤاله).
لكن على رغم ما يبذله العذال والواشون والحاقدون من جهد في سبيل حرمانه من لقاء محبوبه، فإنهم يفشلون في بعض المرات فيحدث للمحضار ما تمناه، فـ(على رغم الذي قال: ما با تلتقون. التقينا) ومن هذا القاء(وسيل الودّ قد سال) وتنعم المحضار ومحبوبه (وشربا كرع وارتويا) ظاهراً كما غسلا باطنهما(وصفَّيا القلوب)، وسكبا الماء على نيران البعد فـ (طفّيا اللهوب) أما العاذل الحاقد(خله بنار الحقد قلبه يصطلي ).
المحطة الثالثة: المحضار الرجل المسافر:
عرف العربي الرحلة منذ القدم، والرحلة هي تغيير للمكان الذي نشأ فيه الإنسان واستقر، وشهد ذكريات الطفولة ومراحل الصبا، وهذا المكان بالضروري يكون قد ترك أثراً في نفسية الشاعر، وفي حديثنا عن الرحلة ندرك تماما ً أن الرحلة والحركة، تنفيان المكان، ولا يعني النفي إلغاءً للمكان، ومحواً له وإنما النفي يكون في سلب المكان خصوصية الثبوت) من هذا المنطلق يمكن وصف الرحلة عند العربي القديم بأنه عنوان الانعتاق والتحرر، فالأماكن التي عاش فيها الإنسان يتعلق قلبه بها ويتشوق إليها ويحنُّ لها كل وقت، بل إنها تؤثر فيه حتى غدت كمكون أساسي من مكونات تركيبته الشخصية، يعيش في ظلالها ويألفها كل الإلف.
والرحلة بُعدٌ أي انتقال وتحوّل من مكان إلى آخر، وفي هذا الانتقال تغيير لكل ما يحيط بالإنسان، وتحرر من القيود التي يفرضها المكان؛ إذ يبدو الأفق الممتد مدّ البصر للراحل وكأنه داعية يدعوه لحث الخطى ليفارق الموقع الذي مكث فيه فترة من حياته، ويدرك المحضار أن الرحلة تحتاج زاداً يتزود به فيعلنها صريحة قائلا:
| ومرافقي في السفر | باشل حبَّك معي بلقيه زادي | |
| في مقيلي والسمر | وبا تلذذ بذكرك في بلادي |
ويوضح المحضار أن السفر ليس اختيارياً بأمره لكن هناك ظروف أرغمته عليه، ( باودّعك غصب ما هو باختيار) لأن(زمانه الجاير عليه جار) وكان نتيجة هذا الجور أن (سبب لي فراق الأهل والجيره)، وهذا الفراق للأهل والجيرة أفقده التوازن وأظهره عاجزاً عن التفكير، فـ(عقله الزاكي من التفكير ماع) وترسم لك كلمة( ماع) ما في السطحية وعدم الترابط بل يكاد يكون هشّاً لميوعة العقل.
ولم ينس المحضار استظهار صورة الوداع والاستعداد للرحلة، سعياً لنقل كل التفاصيل الخاصة بهذا الحدث فيظهر المحضار ساحاً لدموعه مصبراً نفسه وممنيها بالوصال فيقول:
| لي منه ذهاب القلب والحيرة | g | ودّعت أحبابي وداعا حار |
| والحساد ما جبنا لهم سيره | g | وأعطيتهم واعطوني الأسرار |
وبعد أن أعطاهم وأعطوه الأسرار قامت العيون بوظيفتها في توضيح هذا الفراق الحار فإذا(الدمع من عيونه سَبَل) فيكتوي المحضار بآثار هذا الوداع لأن الفراق (عذاب ع اللي ما يعرفونه) و(العين بالنوم ما غمضت) والسبب في ذلك أن (الدّمع فوق الوجن سحّاب) فإذا هو غير مستقر، يملأ المكان حركة ذهابا وإيابا، لا يعرف النوم لعينيه طريقا (يبات في شطن وتقلاّب من طاقة لبلكونة) وبدأت عملية استحضار الماضي ولحظات السعادة التي يستشعر عدم عودتها فيستحضرها من خلال(والتذكار في خاطري لم يزل)، ولأن هذا السفر عن غير رغبة وإرادة محضارية تجده يصرخ متمنياً لو له ( عندهم كَن وإلا محل) وهو لا يشترط مكاناً واسعاً فقرب المحبوب يغنيه عن المكان لهذا يريد من هذا المكان أن (يكفل الراس لو حتى ثنعشر فوت).
ويطالب عيونه بالتوقف عن سحِّ هذه الدموع اعلى وجناته(كفّي يا عين كفّي) ممنّياً نفسه بالأمل في لقياهم، فما زالَ يرقب ذلك اللقاء قوله:( ليش بالدمع هذا إنما الوصل مسهون) وهي لازمة كررها المحضار ست مرات في هذه القصيدة في تعبير على حرصه عليها ورغبة في عدم نسيانها. كما يلح على الاجتماع بقوله(وإن بعدت اليوم بكرة الاجتماع) ويحدد مكان اللقيا(في الوطن هذاك في خير البقاع)
ويصوّر المحضار ما ترتب على هذا السفر من حنين وشوق إلى الأحباب، وأثر هذا الحنين في التغير الذي طرأ عليه، وأنه فقَدَ طعم السعادة فـ(البعد قد أضحى لحاله ضار) بل لقد زادت المعاناة فيصبّر نفسه بأن هذا حكم القدر الذي لا يجدي معه سوى التسليم، يقول:
| وأيامه المُرّة | g | الويل لي من مقاساة الفراق الويل |
| ومسيت في همرة | g | أجرتْ دموعي على خدّي مثيل السيل |
ما تنفع الحسرة
| حكمت به القدرة | g | بُعدك مقدّر عَلَيْ ولعاد منّه ميل |
| ما بهمر المسرى | g | ريت المسافة تقع بيني وبينك ميل |
ولأن هذا البعد غصب عنه فـ (فراقهم ما هو بودّه منهم ما اشتفى قلبيه)، فلا يستطيع نسيانهم فهو ( رغم بعد الدار ما ينسى محبينه )ويعيش على تذكرهم(وبتذكّر مجالسهم ويبكي دمّ من عينه)، وينفي أن يتسلّى( ولا شي بايسليني)
ويذكرالمحضار أمورا هي التي تعينه على الصبر على هذا الفراق حيث يقول:
| عا يحسبون الليالي لي تعدّي علي زام زام | g | لو ما عرب في الشحر بعدي عيشهم ما صفى |
| يظهر عَليْ من قدا سمعون في الليل وقت المنام | g | لو ما علايم شوق تبدي نورها ما اختفى |
| نضحك ونهري ونا ما لي طربفي الكلام | g | من بعد ناسي وأهل ودّي ما وقع لي كفى |
ولم يجد أمامه سوى أن يرسل تحياته مع الريح علّها تهزُّ شيئاً في الأحباب وتحركهم فيبعثون له ما يفرحه:
| وذكّرهم ولو بالبعض من لحني وأبياتي | g | ألا يا نود ساير نحوهم بلّغْ تحياتي…. |
عسى بعدك خبر يأتي يسلِّي قلبي المشتاق
ولكن خيبته من عدم ردهم تزيد من حزنه تخوّفا من أن يكون الأحباب قد نسوه، فيتساءل(هل عادني عا البال؟، وإن لم يكن عا البال فأين مكانه أتراه(في طاقة الإهمال؟!)، ذلك أن من أحب شخصاً تواصل معه وبلّغه أخباره أما المحضار فـ(لا أخبار تبلغنه ولا إرسال)؛ لهذا لا يجد أمامه سوى أن يرفع يديه بالدعوات إلى السماء راجياً أن يجتمع الشمل وتحين لحظات اللقاء فيهتف:
| لا تحرم بطول البعد خلاًّ من خليله | g | ربّ اجمع بيننا البين |
| نعيش في راحات وسكون | g | واعطِ كُلاًّ يا إلهي مناله |
وقد يتمنى تقصير أيام البين كما قال(قصّر الرحمن أيام البعاد)والمحضار هنا استخدم اسم الرحمن لما يمتلئ به من انتظار رحمةٍ تغير بها حاله فتذهب(الليلات الشداد) وتزول.
ويختار المحضار عنوانا لقصيدته ( يا مسافر على البلاد) بث فيها آلامه ومعاناته وأشواقه ولواعجه، فيخاطبه قائلاً(يا مسافر على البلاد بروحي وقلبي) يرجوه أن يـ(سير ويتركنه هنا بآلام حبه) فهو غير قادر على السفر لكنه يحمله رسالة لأهله وأحبابه تحمل في ثناياها طلبا لهم بأن(يذكروه) لأنه (على ذكرهم دوب)، فـ(ذكرهم لا يزال في بعاده وقربه)، فهو (ما تخيّرت غيرهم) ومعه على ذلك خير شاهد(شاهدي ربي) وبهم قد استغنى عن غيرهم فـ(هم مراده ومطلبه وهم عز مطلوب).