دراسات
أحمد عمر مسجدي
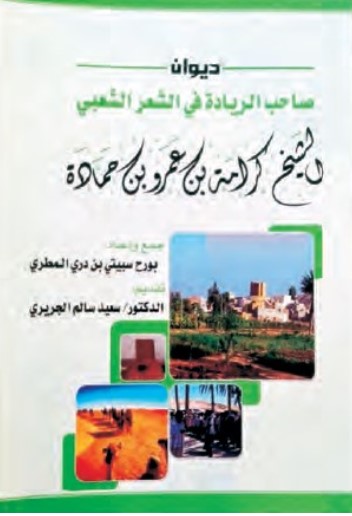

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 72
رابط العدد 3 : اضغط هنا
توطئة:
أثلج صدورنا الأستاذ الباحث / بورح سبيتي بن دري المطري لجمعه أشعار صاحب الريادة ابن حمادة في كتابه الموسوم بـ (ديوان صاحب الريادة في الشعر الشعبي الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة) ـ فرز وطباعة مطابع حضرموت الحديثة للأوفست بالشحر ـ ليصبح رافداً ثقافياً للمكتبة الحضرمية وللمهتمين بتراث المشقاص.
ومن خلال تصفحي للكتاب الذي يقع في ستة أبواب متنوعة الأغراض رأيت فيه الشيخ ابن حمادة ملك ملوك الشعر الشعبي المشقاصي الذين لم نعرف عنهم إلا القليل, والكتاب بحق يعد كنزاً شعرياً يحوي الكثير من التراث المشقاصي العريق من حيث المكان والزمان والغرض. حيث توجد رائحة التاريخ الحضرمي الأصيل في تلك البقعة التاريخية التي هي قلعة حضرموت الشرقية المتمسكة بعاداتها وتقاليدها ولهجتها المتداولة التي لم يطرأ عليها التطوير الملموس كالكثير من اللهجات المحلية إلا ما نذر, ونجدها ثرة وغزيرة في شعر ابن حمادة. والكتاب من تقديم ابن المشقاص البار الدكتور سعيد سالم الجريري.
يقول الدكتور الجريري في آخر تقديمه للكتاب: (أن المشقاص تحتوي على كنوز أثرية وتاريخية وتراثية وفولكلورية لم تحظ بالعناية نفسها التي حظيت بها مدن وادي حضرموت والمعراب والمنطقة الغربية وغيرها). ويقصد (العناية العلمية) التي حظيت بها حضرموت عامة دون المشقاص باستثناء إسهامات المهتمين في النشرات والمجلات المحلية والمدونات والمواقع الإلكترونية. وهذا صحيح, وهو جهد فردي لا غير. فهي ـ أي المشقاص ـ ظلت تعاني من التجاهل العلمي في البحث عن مكنوزها الخفي والثري بالآثار والتراث والتاريخ, ويعد هذا قصوراً من السلطات الرسمية المعنية بالثقافة والتراث.
فقد حوى فعلاً شعر الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة الثعيني على الكثير من هذه الكنوز ليقدمها الأستاذ بورح لقمة سائغة للباحثين عن هذه الكنوز المدفونة. ونحن بدورنا في هذا المقام سنمر عابري سبيل عليها دون التعمق فيها تعمق النقاد أو الباحثين المتخصصين لأننا لسنا منهم ولا نمتلك الكفاءة الكافية, ولكننا ـ فقط ـ سنستظل في رحلتنا القصيرة مع شعر ابن حمادة بظلال بعض الأمكنة الأثرية والفلوكلورية التي ترد في سياق الحديث, لأن المكان حيز اجتماعي جغرافي له أهميته في شعر ابن حمادة.
ابن حمادة شاعر شعبي:
ومن خلال ما كتبته سابقاً في العدد السادس من مجلة (آفاق حضرموت) الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب بحضرموت عن كتاب (بدع مشقاصي) للشاعر سعيد بن صالح بن عبد ربه العمقي, وما أحاول كتابته في مجلة (حضرموت الثقافية) عن شعر ابن حمادة فقد برز أمامي ذلك الصراع بين قديم الأدب الشعبي المشقاصي وجديده من حيث تعميمه واستخدام اللهجة البدوية الدارجة فيه, وأعني بها لغة الشاعر, لان الشعر كاد يكون في فترة من الفترات الوسيلة الوحيدة للتعبير عن تراكمات الشوق للتجاوز نحو التغيير, وكان للشعر تقاليده وهيكله ليبرز السؤال الشاغل لعقول الباحثين, ما الفرق بين الشعر الشعبي والشعر العامي؟.
والجواب يحتاج إلى بحث مستقل ليقودنا إلى ابن حمادة وغيره من الشعراء ليس في المشقاص فحسب وإنما في الساحة الشعرية عامة ما إذا كان الشاعر شاعراً عامياً أم شعبياً. وقد دلوت بدلوي في هذا المجال الشاغل في ما سبق لي من كتابات بحديث المقل.
على العموم, ليس كل شعر عامي شعبياً والعكس صحيح بصرف النظر عن كتابته باللهجة الدارجة, فهناك الكثير من شعراء الفصحى أصبحوا شعبيين من خلال شعرهم العامي ومنهم من أصبح بالفصيح شعبياً لذيوعه وشيوعه بين الجمهور.
وقد قال الدكتور عبد العزيز المقالح في كتابه قراءة في أدب اليمن المعاصر: (إن الشعبي هنا تعني الشائع الذي يتجه إلى جماهير الشعب وإذا لم يكن هذا التعليل اللغوي مقبولاً فمعنى ذلك أن أدبنا القديم والحديث أدب طبقي). وأضاف: (أرى أن المشكلة هنا من أساسها لغوية بحتة). وهذا صحيح. فالمتبصر في اللغة المستخدمة (المحكية) في الشعر عموماً لا يجدها أكثر من وعاء متسع يصب فيه الشاعر محتواه الشعري, ولكن حجم واختلاف هذا الوعاء يقدر كمية المحتوى ونوعيته.. ولكننا نرى أن صفة الشعبي التي تطلق جزافاً على كل شاعر قال شعره باللهجة الدارجة ليس في محله, وهو ليس حكماً مطلقاً على الشعر المكتوب باللهجة العامية فقط ـ أي لغة الشاعر ـ فالكثير من الشعر باللغة الفصحى الرفيعة قد تداولته جماهير الشعب باستثناء شعر التفعيلة المترفع عن الشعب للغلو في استخدام اللغة, مع أن هناك شعراً عامياً وباللغة المفهومة للشعب لم يكن شعبياً بالمفهوم الذي نقصده بالشعبي..
وشعراء المشقاص كغيرهم من الشعراء الذين خاضوا غمار الشعر فاتصف منهم من اتصف بالشعبية وهم قلائل مقارنة بمن قال الشعر منهم. والشيخ الشاعر كرامة بن عمرو بن حمادة واحد من القلائل الذين شاع شعرهم وذاع وتردد بين الجماهير المشقاصية فاتصف (ابن حمادة) بالشعبية لثراء شعره وتداوله.
فلنلج في ديوانه لنتعرف عليه عن كثب ولنبدأ بشعر الكرّام (الملحمي إن جاز لنا التعبير) والثري بالألفاظ العذبة والغريبة المتأصل الجذور بالمكان, بوصف الكرّام ركيزة من ركائز الثقافة الشعبية والمساهم الفعال في التداول المشترك للأفكار والعواطف كما يقول معد الديوان الأستاذ بورح المطري..

الكرّام في ديوان ابن حمادة:
لعل أهم ما يثري ديوان الشيخ المقدم كرامة بن حمادة الشعري ما جاء في قصائد (الكرّام) ـ بتشديدالراء وإمالة الفتحة إلى كسرة وإمالة الألف إلى ياء ـ من ملامح الطبيعة البدوية والخصوصية الشعرية والاجتماعية والمكانية أيضاً كما يقول مقدم الكتاب الدكتور سعيد الجريري, وهذا ما يحتاج إلى وقفة الباحث الفاحص في فنون الشعر الشعبي الحضرمي ليستجلي جماليات شعر الكرام وخصوصيته الفردية التي قلما تجدها في غيره من شعر شعبي.
ولعل الأستاذ الباحث بورح سبيتي المطري أول من لفت نظر القارئ الكريم إلى شعر الكرّام المنسي والذي كاد ينقرض من الساحة الحضرمية لعدم تداوله في الوقت الحاضر نظراً لتطور وسيلة النقل القديمة المعتمدة على الإبل, وبهذا يكون له السبق في تجميع مثل هذا الشعر وتدوينه وطباعته ونشره على الأقل من وجهة نظرنا القاصرة الاطلاع لما ينشر من أشعار تدوينية للشعر الشعبي.
والكرّام أو ما يعرف في بعض المناطق البدوية بالحداء, هو فن من فنون الشعر الشعبي التقليدي القديم, وقد حظي شعره بشعبية واسعة بين البداوة من رعاة وجمّالة وعشاق, وانتشر أكثر ما انتشر في المناطق البدوية, ولم يكن معروفاً في المدينة حتى ينال حظه من النقد والتحليل. ولكن ردده أبناء البادية فقط في مختلف الفئات العمرية ملحناً على شكل دان وبدون إيقاع أو تصفيق.. بيد أن الكرّام يجمع تأصل بادية المشقاص والمعراب فيه على حد سواء وغريزة تشبثهم إليه ومحافظتهم الدائمة عليه عبر الأزمان, رددوه في الرمال والصحراء وفي الشعاب والأودية وفي كل الأمكنة التي يمكثون فيها في أثناء تنقلهم وحلهم وترحالهم, وهو أحد الفنون الشعبية المتوارثة الذي توارثوه, فقالوا شعرهم فيه وألفوه وتداولوه أب عن جد,
ويقال للمدندن بالكرّام على ظهر الإبل في حالته في المعراب: (يغودر) من الغودرة المقتبسة من لفظة المغادرة بمعنى ترك المكان, وهي الفترة الزمنية التي تبعث على انبعاث الشجن والمشاعر التي تنتاب المغادر التارك لأهله وأحبابه عند السفر. وعادة ما تؤدى الغودرة ـ هكذا تلفظ في المعراب ـ فردياً بألفاظ لم تفهم من الوهلة الأولى, تبدأ بلفظة (الغودر) لتليها الأبيات الخاصة بها وهي قليلة, وسنحاول إذا ما فكرنا في تطوير هذا البحث لتصير دراسة الإتيان ببعضها. كما تزداد الغودرة من قبل المسافر على الإبل بعد قطعه جزءاً من المسافة لتكون أنيسه في ترحاله ورفيقه في تذليل عناء السفر, كما هي دليله في الحب الرومانسي العاطفي لغزو قلب المحب.
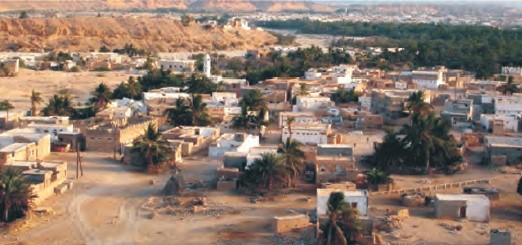
أما في المشقاص فيختلف فقط النمط الأدائي وربما اللحني للكرّام عنه في المعراب لكونه قصائد طويلة ملحمية المضمون, جزلة الألفاظ, متعمقة الجذور, متمكنة, سهلة اللحن. ومن هنا فليس بالضرورة أن يؤدى على ظهر الإبل وإن كان هذا هو الرابط الأصيل منذ القدم لتذليل عناء السفر؛ فقد يرتقي المؤدي له صخرة على سفح جبل أو يجلس تحت ظل شجرة وارفة عند الإختلاء بنفسه ليبث مشاعره الفياضة من الهوى عبر الهواء فليس ما يمنع ذلك, وإن كان هذا تطور أدائي شكلي بحت ولا يمت إلى مضمون التقليد والمحاكاة بصلة.
ومما يجذر ذكره أن شعر الكرّام على العموم في المعراب والمشقاص اعتمد خاصتي التقليد والمحاكاة المتأصلتين عند القدماء ولم يتأثر بالرومانسية الحديثة في الشعر الشعبي التي زاوجت بين القديم والحديث. ربما لأن شعر الكرّام لم يمر بمراحل تطورية كسائر الفنون الشعرية التي تأتي منسجمة مع متطلبات الواقع, أو نقول: أن الحاجة لمثل هذا التطور كادت تتلاشى من الواقع لعدم استخدام الوسيلة كحافز مؤثر لإنتاج هذا الشعر كما كانت عليه من قبل.
فإذا كانت الرومانسية الحديثة في الشعر الشعبي قد توهجت وصارت ثورة على التقليد والمحاكاة كما نراها عند البعض في تطور لغتهم المحكية مثلاً, فإن الواقعية بأشكالها ومضامينها أصبحت السمة الغالبة في قصائد المحدثين. بينما ظل الشاعر ابن حمادة كلاسيكياً على الأقل في شعر الكرّام بالرغم من اتساع ثقافته واختلاطه بثقافات وأدبيات الآخرين من خلال أسفاره خارج بلده المشقاص, وهكذا لم ينصع لما طرأ على الشعر من تطور ولم نره إلا متأصلاً بعاداته وتقاليده في قصائده, ومتمسكاً بأنواع الفنون القديمة في الشعر الحضرمي والمشقاصي بوجه الخصوص. لذا نراه يسير وفق منهج أجداده الشعري التقليدي ومن سبقوه في هذا المجال.
ولا يعني ذلك أن اهتمام المحدثين بمثل هذا النوع اطمار الأشكال الأساسية في الشعر الشعبي, فإن الأشكال الجديدة في الشعر ما أن تبدأ في التكوين حتى تنشط الأشكال التقليدية القديمة لتنقض على الشكل الجديد, وتكون ناتج عملية الصراع محاولة توفيقية بين الشكلين. وهذه المحاولة التوفيقية عبارة عن شكل تقليدي يحمل سمات التجديد ويجمع بين القديم والجديد. وبهذا يحافظ الشعر الشعبي على خصائصه الطبيعية التي تكفل أصالته. وهذا التوافق يظهر جلياً ومتجسداً في قصائد الشعراء الشباب, بيد أن الشاعر ابن حمادة في ديوانه الذي هيج خواطرنا ظل كما عرفناه من خلال قصائده؛ هو ذاك الشاعر الكلاسيكي الذي التزم بخصوصية مجتمعه المشقاصي وبلغته التقليدية المحكية وبنكهته البدوية الملتصقة بالمكان ولم يحل عنها ليصير مرآة عاكسه من واقعه الاجتماعي السالف إلى واقعه الثقافي الراهن..
لعل أهم ما ميز ديوان ابن حمادة الشعري تناوله لقصائد الكرّام التي أوشكت على الانقراض, ولم تلق من الشباب في الوقت الحاضر الاهتمام نفسه الذي لاقته من السلف, بسبب قلة استخدام الوسيلة كما أسلفنا ذكره.
ونذكّر: أن هناك علاقة وثيقة بين الكرّام وصاحب الإبل كعلاقة المزارع بالدندنة الزراعية في أثناء زراعة الأرض, وكعلاقة البحّار بمواويله البحرية, فيكثر ترديد الكرّام غناء من الراكب على الإبل لتقويض المسافة وقطعها, كما يردده الرعاة في أثناء رعي أغنامهم متى ما استظلوا بظل شجرة. ولأن الكرّام غناء فردياً ولا يصير رقصة أو لعبة في مساحة ما, لذا نرى العاشق المدندن به يثير لواعجه ويهيج شجونه ولو كان جالساً على صخرة صلدة ملساء مرتفعة عن الأرض أو تحت ظل شجرة ليخاطب منها المحبوب بصوته المرتفع متى ما أخذ قسطاً من الراحة.
نموذج من قصائد الكرام:
لو عرجنا متصفحين ديوان الشيخ الشاعر ابن حمادة تستنطقنا من أول وهلة هذه القصائد الغنية باللغة الفصحى التي تخالها لتداولها وكأنها لهجة بدوية مشقاصية دارجة يصعب على ابن المدينة معرفة كنهها, وهي غنية أيضاً بلهجة أهل المشقاص التي تختلف نوعاً ما عن لهجة أهل المعراب في بعض القياسات التي ذكرناها.
وهنا نحاول قدر الإمكان الأبحار في قصائد الكرّام لفك طلاسمها بمعرفة المقل لها بالرغم من انتمائي للمعراب, ثم نترك للمشقاصيين أو المتخصصين في اللغة عموماً استكمال ما بدأناه للكشف عن فحوى هذا الفن الأصيل.
ونبدأ أول ما نبدأ بعناوين القصائد الكرّامية نفسها التي وردت في ديوان ابن حمادة وعددها ست قصائد بين المتوسطة والطويلة, وكلها ملامح من الطبيعة البدوية ومؤثر من المؤثرات النصية لبيئة الشاعر, وهي مجموع قصائد الكرّام التي جمعها الباحث بورح سبيتي مشكوراً للشيخ الشاعر كرامة بن حمادة وتعتبر اللبنة الأولى في تجميع قصائد الكرّام.
نذكر هنا العناوين الستة كما جاءت في الديوان لنلاحظ عن كثب غرابتها عند القراءة قبل البدء بالحديث في نماذج من الكل:
(1) يا الراد ولاّف
(2) الفي عالصيق ماد
(3) الفي ع يهبط محتم
(4) حظين يا الرده حظين
(5) كهيب يا الظله كهيب
(6) الفي عالعدان أو الفيّه ضووا دنان
لست خبيراً باللهجة المشقاصية, ولكن بمجرد قراءتنا السطحية لهذه الألفاظ يلوح في الأفق تشابهها اللفظي والشكلي وواحدية مضمونها المعنوي, فالراد والردة والفي والفية والظلة كلها تلتقي تحت معنى واحد هو احتضان الظل بعضه بعضاً. كما أن تقارب الحروف في ولاّف والفي له دلالته المشقاصية التقليدية, أو التقابل الموسيقي والتوافق الجرسي والتكرار في حضين وكهيب له ميزة دلالية توقع في الأسماع وتسترعي الانتباه.
وقصائد الكرّام في ديوان ابن حمادة تختلف عن القصائد الشعرية في الفنون الأخرى من حيث الفواصل الشعرية التي تختتم البيت التوشيحي الكامل ويقفل بها. وهي عناوين القصائد الكرّامية, أو كما يعرف في الشعر الشعبي المغنى بالتخميسة أو الشلة, حيث أتت بعضها بعد بيت واحد وبعضها الآخر بعد تسعة عشر بيتاً وأتت ما دون ذلك.
وكل قصيدة من هذه القصائد هي حالة وصفية ذات خصوصية فيها الكرم والنبل والشجاعة, وفيها المعاناة والقسوة من صروف الزمن وفيها التذكار والحنين, وهي صورة تعبيرية يثبتها الشاعر عن نفسه لنفسه, وخبرة سابقة مر بها تبدأ من ظلال الجبال والأودية وتنتهي بزوال الشمس. أما ما يختص بانتشارها وتداولها إلى العشاق والمتذوقين لهذا النوع من الشعر ولهذا الفن الشعبي المتميز فبواسطة السماع ممن هم في الرحلة.
ويكثر في مثل هذا الشعر ذكر الأمكنة وهي جمة لكننا نكتفي بذكر جبلا (الجنسر والشويكل) وواديا (يوهب وهتف), و(الصيق) بمعنى الأغوار, و(الحبق) بمعنى الكهف, و(الرهاو) مكان سكون الماء وغيرها من الأمكنة التي لها مكانة مرموقة في نفس الشاعر ولها من بالغ الأثر في قلبه وشاهد حال له على غزواته انتصاراً أو انتكاساً. كما أن الشاعر ابن حمادة في قصائد الكرّام لم يغفل ذكر الأشخاص والإبل والأغنام والماعز والوعول والأشجار والأدوات وكل ما ألفه في باديته.
وكل قصيدة من قصائد الكرّام تعتبر لوحة فنية رسمها الشاعر بدقة وإتقان يجسد فيها عمق التجربة وصدق العاطفة وجزالة اللفظ وتأصله وتدفق الحركة بين الأمكنة.
وعلى غرار ما سبق نأخذ أولى قصائد الكرّام في ديوان ابن حمادة وأقلها أبياتاً كنموذج لنا ونتحدث عنها بمعرفتنا البسيطة لها ونركز في هذا المقام على لغتها المستخدمة وبعض ما يستوجب ذكره. والقصيدة كالتالي:
يا الراد ولاّف
والفيّ ع يعملوا ترادين ورداف
وخروا للأودي طرشين وخفاف
جزعوا عا شعاب وتقاديم وحقاف
ولا شي رجع لاف
خروا ع سننهم ما راحوا خلاف
ونا عيني عليهم شوف كما من شاف
أما الشمس تغصب غشت من ع حقاف
ونظري رجع كاف
وتولوني هموم أما الحال ينلاف
وتلاهيم ع قلبي عملوا فيه خاف
والكبد فيها خذاف
بقيت كما المرهوب والرأس عند سياف
صابي كما الساف
والناس من فكر فيني كل حد له مشاف
وذاك ما دروا بي قالوا ذي شاف
ونا بعد جاويد بقيت ع الحياة قاف
وحملوني حمول ثقل فيه وكلاف
ثقل ع قلبي أما دمّي نزاف
والثقل لا حمل وحط فوق الكتاف
ولا عدالة ثقيلة بتقعن خفاف
هذه هي أولى قصائد الكرّام وأقلها أبياتاً في ديوان ابن حمادة وهي مكونة من خمسة مقاطع مختلفة الأطوال, ولم تتخذ معياراً واحداً في السرد, ربما بمقتضى اللحن وهذا حكم قاصر لعدم سماعي لها غنائياً. وللوقوف عليها متأملاً وباختصار نجد الشاعر يتحدث عن الحالة الخاصة به في أثناء قول القصيدة وهي مجمل الأفكار العامة للقصيدة نفسها التي نلخصها في التالي:

ـ في المقطع الأول والثاني يتحدث الشاعر عن تكوين الظل في الشعاب والأودية والجبال والأحقاف.
ـ في المقطع الثالث والرابع يتحدث الشاعر عن تأثراته النفسية الخاصة به والتي هيجها تكوين الظل.
ـ في المقطع الخامس يتحدث عن مؤثراته الخارجية بمن حوله من الناس.
ولو حاولنا جاهدين الحديث عن فحوى القصيدة لوجدناها مناجاة النفس للنفس في غيبوبة شاعرية ألمت بالشاعر تلك اللحظة الجميلة ليفرز إحساسه بواقعه البيئي الجميل بكلمات سلسة عذبة مصوراً تلك المناظر الخلابة التي يحدثها الظل لتوديع الشمس في أثناء زوالها وقت الأصيل.
وهذه الظاهرة الغيبية الوقتية للشمس في كل يوم والتي لا يستطيع الشاعر قبضتها وتوقيفها كي تستمر على وضعها الحالي وفوق قدرات الإنسان طبعاً, كما يقول: (ولا شي رجع لاف) هي اللحظة الحاسمة التي أجبرت الشاعر بالغصب على المكوث على حاله في لحظة سكون من الحركة العملية والنشاط والحيوية المعتاد عليها في ساعات النهار مع إبله إلا من التفكير المصحوب بمخيلته تجاه ما تأثر به في بيئته البدوية, وهي التي أثارت ثائرته وهيجت شجونه وهو يدرك الشمس وقد شارفت على الزوال لتنهي بذلك عمل يوم جميل بين الإبل والأغنام والمرعى الخصيب لتسدل الستار عليه بدخول الظلام وتوقف بذلك رحلته مع ركابه.
وللنظر في هذه القصيدة الكرّامية للشيخ كرامة بن حمادة نجدها تحمل ما تحمله من ألفاظ فصحى وأخرى بدوية دارجة يستصعب فهمها من الوهلة الأولى ولكن بالتدقيق في فحواها يظهر أنها بسيطة خالية من التعقيد سهلة التداول مختزلة الأحرف مدغوم في بعضها لتنتج لفظة محلية غير غريبة على المشقاصيين.
ولو أخذنا المقطع الأول من القصيدة نجده يتحدث عن تكاثر الظل والتفافه حول بعض بالترادف ليصبح الظل الواحد رديف الآخر أو كما يقول ابن حمادة: (والفيه ع يعملوا ترادين ورداف) ثم يصف سقوط الظلال في أسفل الوادي لخفتها وطراشتها وهي تمر على كل الشعاب والكثبان وهو ـ أي الشاعر ـ لا يستطيع التكيف بهذه الظاهرة الكونية وليس في قدرته التمكين منها لأنها لم تكن في قبضته حتى يبقي الوضع على ما هو عليه.
وفي المقطع الثاني يبين لنا الشاعر حركة الظل في هذه الحركة المنتظمة من الظل على السجية المعهودة له دون مخالفة تذكر وهو يراقب بنظراته حركة غروب الشمس في ساعة زوالها وقد أبت إلا أن تغيب من وراء الأحقاف, وتغطي المكان بظل الوادي وتتركه في ظل يبدأ به ظلام الليل الدامس ويفتقد الرؤية بعدها ويصبح كفيفاً.
ثم ينتقل بالحديث عن نفسه في المقطع الثالث والرابع وما حدث له جراء دخول الليل لتتوالى الهموم والأحزان رغم صحة جسمه لكنه يبقى عديم الجدوى لتزايد التذكار وما خلفه في قلبه من عبء عليه منعه من التلذذ بالرحلة الممتعة, وليس هذا فحسب وإنما ما أثر على كبده التي تقطعت إرباً إرباً من جور ما به وجعلها كالحصاة بين سبابتيه ليرمي بها مما عملوا فيه من خساف. ثم يقدم لنا الشاعر وصفاً له أكثر مما أصاب قلبه وكبده ليبقى مرهوباً ومفزوعاً من هول الفجيعة التي ألمت به وكأنه سلم رأسه لسياف بعد إمالته وخفضه إلى الأرض وكأن داءه أهلكه كما يهلك الإبل من الداء ليصبح صابي كالساف.
ثم يتابع الشاعر في المقطع الأخير وصف ما ألم به مقارنة بالناس الذين يرون ما يرونه فيه كل حسب رؤيته الخاصة به وما تحمله من عناء وألم بتتبع أثره نتيجة تلك الرؤى, وتحمّل فوق طاقته من الحمل حتى ثقل على قلبه ونزف دمه لأنهم لم يعدلوا في الحكم عليه.
هذا باختصار شرح سطحي وبسيط لما تضمنته القصيدة من أفكار, ونعرج الآن على بعض المفردات المستخدمة في القصيدة والتي نخالها بأنها عامية ولكنها في الأصل فصحى ومن هذه المفردات (خروا) وهي من المستخدمات الكثيرة ليس في المشقاص فحسب وإنما في بادية المعراب أيضاً وتأتي (خر) على عدة معان وفي الصوت أيضاً, فقد جاءت في القرآن الكريم ((فلما خر تبينت الجن …)) بمعنى وقع وبمعنى مات, وكذلك لها معانٍ في الصوت لقولهم: خر الماء إذا جرى, وخر عند النوم, لكن ابن حمادة استخدمها بمعنى (سقط) فيقال: خر البناء إذا انهد وسقط, وقوله: (خروا للأودي طرشين وخفاف) بمعنى سقط الظل في الوادي بسرعة وخفة. أما لفظة (لاف) في قوله: ولا شي رجع لاف, أي لم يعد بقبضته. ولفظة (غشت) هي الأخرى بمعنى أظلمت. ولفظة (خذاف) التي أتى بها مع الكبد في قوله: (والكبد فيها خذاف) بمعنى الكبد متقطعة, ولها معنى آخر أي جعل الحصاة بين سبابتيه ورمى بها. وفي قوله: (صابي كما الساف) فالصابي بمعنى أمال رأسه وخفضه إلى الأرض, وصابي الشيء أماله وصابي السكين قلبها, وصابي السيف وضعه في غمده مقلوباً, وصابي الكلام لم يجره على وجهه الصحيح. أما لفظة الساف فتعني الداء يهلك الإبل. ولفظة قاف تعني بتتبع الأثر, كما جاء في معاجم اللغة, تاج العروس ولسان العرب ومختار الصحاح.
ولا يعني بأي حال من الأحوال أن هذه المفردات التي ذكرناها كعابري سبيل هي وحدها من الفصحى بل هناك الكثير من الكلمات الأخرى في القصيدة نفسها وإنما أتينا على ذكرها للتدليل فقط على استخدام ابن حمادة للفصحى الدارجة بينهم, كما أن هناك الكثير من المفردات المعتادة للمشقاصيين.
وإذا تحدثنا باختصار عن بعض الفنون الشعرية في هذه القصيدة الكرّامية كالإمالة والميل في القصيدة لرأينا الخصائص الصوتية البدوية ماثلة أمامنا كاستخدامه (نا) بمعنى (أنا) و(الودي) بمعنى (الوادي) و(شوف) بمعنى (أشوف). والبنية التركيبية في (فيني) بمعنى (فيّ أنا) و(ع قلبي) بمعنى (على قلبي) وهي من الاستخدامات البدوية الدارجة, كما أن لفظة (جزعوا) في القصيدة هي دخيلة عليها ومن خارج بيئته المشقاصية نظراً لاختلاطه العملي في الخارج. وهناك البعض الآخر من المفردات ذات الخصوصية الصوتية والبنية التركيبية لم نمر عليها بالذكر.
وإذا تأملنا في ثنائية السكون والحركة الداخلية للقصيدة لرأينا بوضوح أنها تنقسم إلى قسمين: العام وهو البادية حيث يقيم الشاعر به, والخاص وهو المدينة حيث عمل الشاعر فيه, ولكننا هنا لا ننظر في علاقة الإقامة والاستيطان أو العمل, لأن ارتباط الشاعر بعلاقة المكان بالبادية ثابت وارتباطه بعلاقة المكان بالعمل متغير وذلك لثبات المكان. إذاً فعلاقة الشاعر الارتباطية بالمكان هي علاقة اجتياز وبالذات في المكان العملي لأنها لم تستدعي من الذكريات في القصيدة سوى اللفظية منها. ولهذا كانت القصيدة إحياءً للحركة المكانية البدوية من خلال ما يؤثره الظل في المكان.
أما ما يختص بالمشاركة الزمانية للمكان نلاحظ الارتباط الوثيق بين الزمان والمكان تزداد متانة وقوة عن طريق خلق ضرب من التجانس الفني بينهما, فعلى صعيد الزمان نلاحظ أن الزمن المقدس في القصيدة بالنسبة للشاعر ابن حمادة هو وقت زوال الشمس حيث يضفي سمة القدسية أيضاً على المكان في الزمن الآني, ويتضح ذلك من عنوان القصيدة نفسها في لفظة (الراد) وما جرى بعده من حديث عن كونية الرؤية المكانية بعد تكوين الظل.
وبهذا الحد نكتفي بالحديث عن الكرّام في القصيدة الكرّامية لصاحب الريادة الشيخ كرامة بن حمادة, مع أننا لم نخض في كل فنون القصيدة ولم نأخذها من المنظور النقدي للعمل. وإنما أخذناها كنموذج للكرّام لا غير..