مدارات
عبدالله علي باسودان

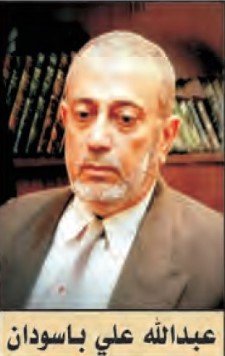
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 5 .. ص 72
رابط العدد 5: اضغط هنا
عندما ننظر إلى واقع إشكالية الشعر الحديث بعين الناقد المطلع على أكثر ما قيل فيه من آراء متصادمة نرى أنفسنا وكأننا – مع الأسف – ندور في حلقة مفرغة ، بل إننا أكثر من ذلك نرى من خلال هذه التصادمات ما هي ماهية الشعر ، فالشعر شكلاً ومضمونًا لدى شعرائنا المحافظين ليس إلا شعورًا ووزنًا مقفى ، وبالعكس لدى شعرائنا “المحدثين” فهو شعور مرتبط بموسيقى متحررة من التكرار المقفى العروضي؛ إذ إن المعركة الدائرة بين الفريقين ليست معركة مضمون كما يخال، وإنما هي معركة وزن مقفى . هكذا نرى الشعر من خلال هذه المعارك.
إننا لا نبالغ إذا قلنا صراحة إن بعض شعرائنا ونقاد الشعر لم يعوا حقيقة هذا الشعر، فنحن عندما نطالع كثيراً ممَّا كتبه النقاد والشعراء عن الشعر وماهية الشعر نراهم لا يخرجون عن نطاق الشكل لا المضمون ، فهم يتخبطون خبط عشواء كأنهم لا يريدون الفكاك منه.
إن انعدام روح البحث عن الجذور الأصيلة لمأساة واقعنا الحضاري في جميع المجالات ما هو إلا المأساة ذاتها التي تنخر – لا شعوريًا – أقبية عقول هؤلاء النقاد والشعراء المصابين بالتلوث والفقدان تجاه إشكالية الشعر الحديث ، فمن المستغرب أن نقرأ لكاتب ” كبير” من الفريق الأول كعباس العقاد يقول بأن الشعر ” ليس إلا موسيقى لغوية أولاً وقبل كل شيء ثم تأتي العاطفة والشعور أخيرًا ، وأن كل ما عداه ما هو إلا زيف وهراء ” ، وأن الشعر برأي نزار القباني وهو من زعماء الفريق الثاني ما هو إلا شعور متحرر من مترسبات قوالب التقليد، وأن كل ما عداه من أعمدة شعرية مقفَّاة عصماء ما هي إلا حقيقة منعدم فيها المعنى الكامل لروح الشعر الحديث .
وإذا نظرنا إلى أكثر القصائد لشعراء محدثين نراها دائمًا متلوثة بعقدة ” التحرر “، التي ترن في مسامع كل من هب ودب ؛ فقصائدهم من ذلك النوع المصاب بالتلوث والفقدان تلوث القصيدة بعقدة “التحرر” وفقدانها لروح الأصالة الشعرية الحقة ، فإذا تناولنا أعظم قصيدة لشاعر كبير من الشعراء المحدثين كنزار قباني مثلاً ، نجد أن التحرر لديه ما هو إلا الشكل فقط.
فلا فرق بينه وبين عمر بن أبي ربيعة ، بل لا نغالي إذا قلنا إن روح الأصالة في شعر عمر بن أبي ربيعة أقرب إلى واقعنا الحضاري من نزار، فقصائده بعضها ليست شيئًا باستطاعتنا أن نعتبرها بحق مكتسبات شعرية حضارية وذات رؤيا شعرية.
ونقادنا االيوم كما هم نقادنا بالأمس تبهرهم تلك الكلمات الرنانة؛ لأن كل ما هو شعري لديهم ليس إلا الشكل والمضمون ، الشكل بكل ما لديه من موسيقى خارجية. أما الرؤيا التي هي الشعر ذاته فلم تنل حظًا وافرًا من التفاتهم إليها بالنسبة للمضمون. .
ولكن لو نظرنا بعين الباحث الجاد نجد أن نقادنا معذورون وغير معذورين في آن واحد، فهم معذورون لأن أكثر قصائد الشعر الحديث والشعر التقليدي معدومة من الرؤية المثقفة الحضارية الحقة التي تتغلغل في أعماق النفس الشاعرة ، ولا معذورون لأنهم قلما يلتفتون إلى هذه الناحية التي هي بمثابة الشعر ذاته ؛ ذلك لأن الرؤيا بكل ما لديها من قبح وجمال تحمل في ثناياها إرهاصات عبقرية فذة حاطمة لكل ما هو نهائي ، إنها مطلق يثقب جميع الأبعاد والآفاق المكانية والزمانية.
وجميع الفلذات العبقرية التي تصطدم بأعماق الفنان أو الشاعر في بعض لحظات تجليه ما هي إلا فلذات رؤيا صادمة لكل ما هو محدود؛ لأن كل ما هو محدود ما هو إلا حقيقة قديمة في وقت ما ، وكل ما هو لا نهائي ما هو إلا المطلق ذاته.
ولو نظرنا إلى الأعمال الشعرية لوليم بليك وشكسبير ورامبو نجد أن الرؤية في بعض قصائدهم لا تزال تعيش معنا، ولا نزال نعتبرها حقيقة، أما الأفكار معدومة الرؤية التي هي من عمل العقل والواقع فقد تلاشت، فالرؤيا هي كل شيء هي الروح ذات الأبعاد اللامتناهية.
نرى إدجار الن بو وهو من أفذاذ الشعراء العالميين يقسم القوى الطبيعية الإنسانية إلى عقل، وضمير، ونفس، وأن الأخيرة هي وحدها المسؤولة عن الشعر؛ ذلك لأن الشعر الحق هو الذي يصدر عن النفس ، لا عن العقل؛ لأن العقل من اختصاص النثر، والشعر من اختصاص النفس.
وإذا اعتبرنا الشعر والنثر هما جناحا الأدب، فإنه لا يجوز أن يتلاقى الجناحان في موضع واحد. وهذا ما يثبت لنا أن النفس من اختصاص الشعر والعقل من اختصاص النثر.
وإذا كان الشعر والنثر جميعًا من عمل العقل فمن المستحيل أن نميز الشعر من النثر إلا بالوزن العروضي فقط؛ إذ إن الفرق بينه وبين النثر هو الموسيقى، وعلى هذا الأساس نقول إن الشعر عند المقلدين ما هو إلا صناعة، والصناعة لا تأتي إلا عن طريق العقل. وصدق قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري (في كتابيهما “نقد الشعر”و “كتاب الصناعتين).
فمثلاً عندما يخاطبنا شوقي ببيته الشهير:
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
نجد أن كل عصب في البيت مزدحم بكل ما هو فكري، فلو قال ناثر : ليس نيل المطالب هو أن نتمنى وإنما هو أن تؤخذ الدنيا غلابا نجد أن لا فرق بين قول الناثر وبيت شوقي إلا الوزن والقافية فقط، فأين الشعر هنا في قول شوقي ، أو قول العقاد في البيت الآتي :
يا جوهر الحسن لا تضعني لديك بالموضع المهان
فبيته عبارة عن خطاب اعتيادي بمقدور أي ناثر عادي أن يقوله؛ لأن روح الأصالة الشعرية الحقة ذات الأبعاد النافذة إلى أعماق اللامادي معدومة كليًا من كل أعصاب هذا البيت، ولأن لا فرق بين قول أي ناثر عادي في مخاطبته لنا بمعنى هذا البيت إلا في الوزن العروضي فقط؛ لأن كلمات البيت ليست متدفقة بأية رؤية. وكذلك إذا قرأنا قول نزار قباني نجد المعقولية – التي من اختصاص النثر – تنخر أقبية شعره ، فعندما يقول :
حبيبتي لدي شيء كثير أقوله لدي شيء كثير من أين يا غاليتي أبتدئ وكل ما فيك أمير أمير
نجد العصب الموسيقي البسيط مرتبطًا – أيضًا – بأحابيل العقل الواعي الذي هو من عمل النثر، كما أننا نجد ذلك في بقية أبياته الأخرى التي يعتبرها متحررة، فالتحرر في الشعر ليس هو أن نطلق القوافي ونهدم الوزن، وإنما هو أن نتحرر من كل ما هو محدود من كل ما تكتنفه المادة بجميع إشكالاتها المحيطة بذاتنا.
إن التحرر بمعناه الشعري هو خلق لغة وعوالم جديدة غريبة عن عوالمنا العادية المكبلة بأغلال المادة؛ لأن كل عمل نثري جبار يعتبر ماديًا حالمًا يقذف به العقل إلى الخارج ، وأما كل عمل شعري فيعتبر روحيًا حتى في حالة توجدنه؛ لأن الرؤيا هي أشياء لا محسوسة أبدًا ، ولماذا قيل إذن هذا شعر وذاك نثر؟ لأن الفرق ما بين الاثنين شاسع ولن يلتقيا إلا بالتقاء المادة والروح . إن الأشياء التي هي من صنع العقل باستطاعتنا أن نقيمها بحجج ودلائل، وأما التي هي من صنع الروح فليس بمقدورنا ذلك .
والرؤيا هي خلاف الخيال الذي يهتم به شعراؤنا اليوم وقديمًا؛ لأنها في الواقع حصيلة تصادم ثقافي وتأزمات وجودية ميتافيزيقية تجعل من الشاعر أو الفنان يتلقف ما لا يوجد في عالمنا المحسوس من عوالم وأبعاد حاطمة لأفكارنا، والشاعر الحديث – كما قلنا في مقال سابق لنا – ليصبح ذا رؤية عميقة يجب أن يتشبع بثقافات عميقة؛ إذ إنه يجب أن يكون ذلك المثقف الحالم على حد تعبير سيجمون فرويد ، وذلك طبعًا ليدرك واقعه الحضاري الوجودي من جميع الأبعاد ، فالشاعر الكبير هو صاحب الرؤيا الكبيرة؛ لأن الإيقاعات المصيرية تتطلب حتمًا لكشفها ثقافات عميقة تنبثق من كل الرؤى المرهصة والمعرية لتحركاتنا الثقافية ، وكل الرؤى الحقة لا تنبثق إلا من خلال إخلاص الذات الشاعرة المثقفة الواعية لواقعها القومي والوجودي الذي تعيشه؛ لأن التأزمات الداخلية ما هي إلا ردود فعل لتأزمات خارجية عاشها الشاعر في كل لحظة من لحظات حياته المتلفعة بضباب الإيقاعات المصيرية الغامضة المعرية لذاته المعرشة في أقبية تصوره الذاتي اللا منكشف له إلا من خلال الرؤيا العميقة التي تنبع من خلال واقع الذات الوجودي. فالرؤيا هي بمثابة اكتشاف وخلق جديد للأشياء. ونحب أن نوضح للقارئ أن كلمة الوجودية الواردة في بحثنا ليست وجودية سارتر أو كامو وغيرهم بل هي اللحظة التي يعيشها الشاعر.
و أخيراً نحب أن نؤكد أن الشعر العربي القديم شعرٌ في غاية الروعة والجمال بالنسبة لزمانه ومكانه ، وهو تاريخنا الذي نعتز به، ونتخذه كمادة تاريخية لا غنى عنها، لكن لا أن نجتره ونقلده، وإلا فماذا يتبقى للشاعر المقلد للشعر القديم من إبداع. كذلك هناك قصائد ذات وزن وقافيه لبعض شعرائنا فيها من الإبداع الشيء الكثير لأنها متشبعة بالرؤيا؛ كقصائد بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة، وفدوى طوقان، وكثيرين غيرهم.
لقد قسّم كثيرمن علماء النفس ونقاد الأدب، وكذلك الشاعر الأمريكي إدجار الن بو وهو من أفذاذ َالشُّعَرَاء والنقاد العالميين الطبيعة البشرية إلى عقل وضمير ونفس وأن الأخيرة هي وحدها المسؤولة عن الشِّعْر، ذلك لأنه يصدر عن النفس وغايته كشف الجمال والرؤيا والإبداع داخل النفس البشرية، ونفوا الالتزام في الشِّعْر ورفضوا اشتماله على الحكم والأساليب النثرية والخطابية كما نراها في أشعار كثير من َالشُّعَرَاء، وجعلوا كل ذلك مختصا ً بالناثر؛ لأنه إذا كان الشاعر مفكراً أو حكيماً أو خطيباً مفوهًا فماذا يتبقى للناثر؟ إذ لا فرق بين الشاعر والناثر إلا في الوزن العروضي ، وهذا ُيعتبر صناعة جرسية، وهل ذلك ُيعتبر شعرا ً؟
وكما قلنا في دراساتنا عن الشِّعْر و النثر، الأدب له جناحان هما جناح الشِّعْر وجناح النثر ؛ إذ ليس بمقدور الجناحين أن يلتقيا مع بعضهم البعض في مكان واحد،. إلا أننا نعتبر شعراء التراث العربي القديم من عصر ما قبل الإسلام وما بعده من العصور الزاهرة، العصر الأموي والعباسي والأندلسي وغيرها من العصور الأخرى جميع هؤلاء الشعراء نعتبرهم شعراء بحق من الطراز الأول، ذلك لأنهم مبدعو عصرهم؛ لأن كل ما قالوه من الشِّعْر ما هو إلا انفتاح زماني ومكاني، وإنه بحق تفاعل زماني ومكاني مع اللحظة الحضارية الَّتِي عاشوها لأنه قادر على استيعاب تجربة العصر، عصر البساطة والوضوح والوثوقية المحيطة بعوالمهم. لذلك علينا أن نقرأه كمادة تاريخية ونعتزبه لأنه تاريخنا لا أن نقلده ونجترَّه. وكما أشار الكثير من نقاد الأدب نرى أن اللحظة الحضارية هي الَّتِي تحكم النظام الداخلي في رأس المبدع شاعراً كان أم فقيهاً قانونياً أم فقيهاً دينياً أم خطيباً. ترى لو شاءت الأقدار أن يكون الإمام مالك أندلسيًا وابن حزم هو إمام دار الهجرة ، هل كانت الرؤيا لتكون مختلفة عند كل منهما ؟ أكيد. لو عاش الأديب اليمني الكبير علي أحمد باكثير طيلة حياته الأدبية في حضرموت وليس في مصر هل سيكون له نفس الفكر والإبداع؟ كلا. لو حاول أحدهم محاكاة الشاعر المتنبي في عصرنا هذا ، في نفس الفكر والثقافة والأفق هل كان ليكون له شأن المتنبي ؟؟ لا أعتقد، لو جاء زعيم سياسي اليوم وكان خطيباً مفوهاً على طريقة جمال عبد الناصر مثلًا، هل كان سيكون له نفس التأثير في الجماهير ؟؟ لا أعتقد، حيث إن المتبصر يرى حَتَّى في المناخ تأثيراً، فتجد مثلًا البلاد الحارة الغناء فيها يميل للطول والهدوء الشديد ، بعكس البلاد الباردة.
لذلك نقول إن لكل زمان أفكاره ومبادئه ونظرياته. فالعالم عبارة عن اكتشافات ونظريات، وأفكار متصادمة ، وأقرب مثال – إذا رجعنا إلى الأمثلة – نجد أقرب دليل على ذلك، ذلك الإفلاس المادي الذي سببته النظرية النسبية لأبرت اينشتاين ، فقد كانت الفيزياء الكلاسيكية قبل وقت ليس ببعيد تعد واقعاً مُسَلَّماً به في ذلك الزمان، فوزن حجرة معينة – مثلاً – هو وزنها الحقيقي وإن انتقلت إلى أي مكان، ولكنْ بعد أن جاءت النظرية النسبية ألغت ذلك الذي كان سائداً في ذلك العصر، أي أفلست هذا الرصيد المادي الذي كان يملكه الإنسان كحقيقة مسلــّم بها؛ إذ لم يعد وزن هذه الحجرة هو وزنها الحقيقي، فقد يخف أو يثقل وزنها في طبقة من طبقات الفضاء العليا ، وكذلك الحال في المحسوسات والمدركات الَّتِي هي من صنع الإنسان واكتشافاته. ونحن هنا لا نقصد بالمحسوسات والمدركات بالحقائق والثوابت الإيمانية الَّتِي هي أساس وجود الإنسان في هذا الكون..
ونحن هنا لسنا ضد الوزن والقافية في الشِّعْر، أو التحرر من هيكل القصيدة التقليدية العمودية وبنائها، أو الاحتفاظ فقط بوحدة التفعيلة وقوة الإيقاع الداخلي، فالوزن والقافية في نظرنا نوعٌ من أساسيات الشعر أو بعبارة أخرى هو نوع من المحسنات الإبداعية ، وهناك من َالشُّعَرَاء المجددين من أبدع في شعر التفعيلة بطريقة تداعي الوزن والقافية حسب تداعي الأفكار، وهذا محمود في الشِّعْر .وممن أبدع في شعر التفعيلة أديبنا الكبير الراحل علي أحمد باكثير، وهو أول مجدد في شعر التفعبلة في الشعر الحديث قبل بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة، وصلاح عبدالصبور، وغيرهم من كبار َالشُّعَرَاء المجددين.
وهناك من شعراء ما قبل الإسلام من تخطى عصره في توظيف الرمز والرؤيا في بعض أشعاره كامرئ القيس في معلقته الشهيرة :
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي..
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ بصبح وما الإصباح منك بأمثل
فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل.
لقد أثارت هذه الأبيات ذات الرمز والرؤيا أصحاب البلاغة لما تشمله من عمق في الرؤيا عند الشاعر، فقد ذكر الباحثون في ” الموشح” أن الوليد بن عبد الملك تناقش مع أخيه مسلمة حول هذه الأبيات من شعر امرئ القيس والنابغة الذبياني في وصف الليل أيهما أجود؟ فأنشد الوليد قول النابغة، وأنشد مسلمة قول امرئ القيس، فضرب الوليد برجله، فقال الشعبي بانت القضية. يعني أن قول امرئ القيس هو الأجود. هذه الرؤيا العميقة لصورة الليل عند امرئ القيس جعل النقاد والبلاغيين والباحثين يتحيرون في كشف أسرارها وخباياها، فقد أيد أبو هلال العسكري في كتابه “الصناعتين” : الكتابة والشِّعْرَ ما رآه ابن طبا طبا في “عيار الشعر” حيث رأى أن البيت الأول يدخل في “تشبيه الشيء بالشيء لونًا مع إضافته أن فيه معنى “الهول “.أما “ابن رشيق” فقد ذكر في كتابه العمدة أن “البيت الأول يغني عن الثاني، والثاني يغني عن الأول ومعناهما واحد.” وعندما نتناول البيت التالي من معلقة امرىء القيس:
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازًا وناء بكلكل
يقول شارحو هذه الأبيات إن امرىء القيس قد أبدع في توظيف الرمز والرؤيا لوصف الليل توظيفاً ذا دلالات رائعة عميقة، حيث أضفى عليها أبعادا إنسانية فقد جعل لليل صلبًا، وأعجازًا وهي المآخير مفردها “عجز”، و”كلكل” الصدر وجمعه “كلاكل “.وأسبغ عليه أفعالًا آدمية فهو يتمطى ويردف وينوء . وطول الليل هنا يعبر عن حزن الشاعر وتجرعه للآلام والخطوب، فالمغموم الحزين دائمًا يطول ليله ويقاسي فيه الشدائد والسهر . فتتعالى نداءات “امرئ القيس” متوسلة من هذا الليل أن ينكشف ويصبح، ولو أنه يعاني الهموم ذاتها في الإصباح . لكان الصبح والليل سيان وهذا ما نستشفه من قوله..”. وما الإصباح منك بأمثل”. فلا “حلكة الليل ” رفعت همه ولا “فلق الصبح” بدد حزنه، وإنما تمازج الألوان ساهم في تعميق ” أزمة رؤيا الشاعر”. ليختم هذه الأبيات الوصفية بصورة ولا أروع؛ إذ يصور النجوم وكأنها ثابتة في أماكنها لا تزول كأنما شدت بحبال متينة إلى صخور شديدة الصلابة، وهذا برهان على استطالته لليله ومعاناته العظيمة فيه.
إن صورة الليل في هذه الأبيات كما فسرها كثيرٌ من شراح معلقة امرىء القيس هي صورة حقيقية من معاناة الشاعر النفسية وهي صورة أخرى من حياة الشاعر البائسة الَّتِي يسيطر عليها الألم والوحدة والقهر العميق وهو محق. في كل أحزانه الَّتِي تفرقت به تفرق السُبل وأقبلت عليه من كل حدب وصوب فأصبح أشقى من غبار في مهب الريح من طرد أبيه له ومن غربته ووحشته وفقد أمه إلى هجر حبيبته وبنت عمه سلمى أو كما كان يحب أن يسميها فاطمة الَّتِي تركته ولم تغفر خطأه غير المقصود بدار جلجل ومائه والقصة معروفة، إلى قتل أبيه وسعيه للثأر ثم أخيرًا إلى تفرق الكل من حوله وصار طريدًا بعد أن كان يطارد، وأضحى مطلوبًا وقد كان طالبًا كما شرحه كثير من شراح شعره .
هذه الأبيات حيرت كثيرًا من الباحثين والنقاد قديماً وحديثاً، كل فسره حسب رؤيته، وهنا تكمن العبقرية والإبداع في شعر امرىء القيس، لذلك نقول إن امرئ القيس تخطى زمانه كأنه سابق جميع العصور من بعده. ..وهذه الأبيات ليست من صنع الخيال ولا من صنع العقل كما يعتقد البعض وإنما هي رؤيا عميقة عاناها الشاعر في لحظة من لحظات معاناته وقلقه وتأزمه، وهي من أروع ما أبدع فيه امرىء القيس في معلقته، حيث إن الرؤيا في الشعر هى موجة إبداعية ينفتح فيها الشاعر على عوالم إنسانية ثرية في التعبير عن معاناته وانفعالاته وتأزماته.
________________
*هذا المقال قد نشر لي في صحيفة الطليعة الحضرمية قبل 50 عاماً. وأعادت المجلة نشره لأهميته وتاريخيته.