نقد
د. زهير برك الهويمل
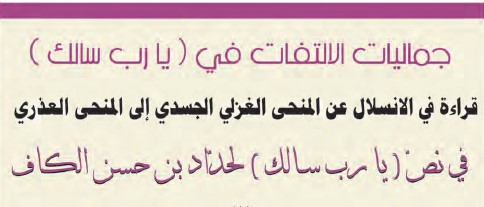

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 5 .. ص 103
رابط العدد 5: اضغط هنا
( 1 )
لم يكن حدّاد بن حسن الكاف مجرّد شاعر يمرّ شعره في الآن والمكان حسب ، بل كان حالة شعرية خاصّة شكّلت معالم مدرسة الدان الحضرمي بوصفها نهجًا غنائياً ذا أنماط متنوعة تنطوي تحت مسمّى الدّان الحضرمي ، رسمت هذه المدرسة الحدّادية أبعادًا وجدانية وروحانية تتواشج و تموسق أدائها على صعيد تعبير الجملة الموسيقية اللحنية ، وعلى نطاق التصوير اللغوي المشكّل لشعرية النّص الحدّادي برُمّته ، فتجاوزت دانيّات هذا الفتى المدلّل حياتيًّا ومعيشيا ـ في صورة غير بعيدة عن حياة إبداع غزليات امرئ القيس الكندي ، على الفارق في النهج الشعري ـ مرحلة الترف الغزلي الفردية إلى أن صارت نسيجًا لا ينفكّ عن نمط الذوق الجمعي الحضرمي الذي تلقّى أشعار حدّاد المغنّاة بعطشٍ وجداني أسهم الإيقاع اللحني الموروث كثيرًا في رسم ملامح تربة ذلك التلقي الخصبة ، التي مازالت تنبت فينا حدائق ذات بهجة جيلاً بعد جيل .
ما كان لهذا الصوت الشعري أن يبلّل وجداننا اخضرارًا من شجن مغناه لو لم يحو سماتٍ أسهمت إسهامًا جليًا في رسم مسارات صدحِه ، ولأننّا موعودون بالوقوف على نصّ معيّن من نصوصه سنقف على سمتين التصقتا بنهج وصفه للمحبوبة أو الموصوفة التي يتناولها سياق تصويره في نسيج من غزل فريد ، هاتان السمتان أو هذان النمطان ـ سمّهما ما شئت ـ يرسمان لوحة حيّة لهذه الموصوفة في النّص الذي بين أيدينا ، فتكتمل بهجة صورتها فيهما ، النمط الأول : التصوير الجمالي الجسدي ، والنمط الآخر : التصوير الوجداني الروحي ، ويتجسّد هذان التصويران في نصّنا ، في قوله : ” قلبي الليلة سمع عنقة ” وقوله ” تنوح بالصوت ” ، الأول يتجلّى في : ( عنقة ) وهي تصوير لبذخ الأنوثة بالغة الجمال في الوعي الجمعي الحضرمي لجسدية ذلك الطائر الجميل ، الموسوم بثراء الأنوثة ـ في مفارقة من حيث معنى العنقاء اللغوي ـ لجمال ذلك الطائر الذي يُجمع التأويل الحضرمي على تشبّع أنوثته ، والنمط الآخر ويبدو في : ” تنوح بالصوت ” فالصوت الطربي المموسق هو منبع الجمال الروحي لهذا الموصوف الجميل ، الأمر الذي يجعل رغبة التشهّي للواصف أن ينظر في وجهين من الغزل الموائمين لذينك النمطين ، و هما الغزل الحسّي ( الجسدي ) ، والغزل العفيف ( الوجداني ) ، وقد كانا حاضرين في نَصّنا ، حيث أخذا يتناوبان مسار اللغة الشعرية على مدار النص ، ممّا سمح لتبدّي حركة حدثية ذاتيّة نابعة من جهة الشاعر يضطرب فيها حضوره بين الظهور والخفاء ، والإفصاح والتلويح ، والجسد والروح ، والأنا و الشعر ، تساوقت هذه الحركة التقابلية ، الثنائية في حدث الصوت الشعري مع فنّ الالتفات الذي ظلّ حاضرًا يرسم ملامح جهات ذلك الصوت بين أسلوب ( التكلّم ) بضمير الـ ( أنا ) ، و أسلوب ( الغيبة ) بضمير الـ ( هو ) ، في نصنا المعنوَن في الديوان ( يا رب سالك تخلي ) ، لكن قبل الولوج إلى النّص وتتبع جماليات الالتفات ووظائفه بين ( الغيبة ) و ( التكلُّم ) فيه ، توجّب التعريف بإيجاز بالالتفات كفنّ بلاغي احتضنته البلاغة العربية في كتبها قديما وحديثًا ، بل وسمته بـ ( شجاعة العربية ).
يُعدّ الالتفات فنًا من الفنون البلاغية التي أغفلتها المناهج الدراسية في مستويات تعليمها الثانوي ، وأحيانا الجامعي ، على الرغم من القيم الدلالية والفنية المصاحبة لسياقات وروده ، كونه يتجاوز في مستوى إجرائه وتوظيفه كثيراً من دلالات الصور البيانية ، والمحسنات البديعية ، المزدحمة بها كتب البلاغة ، و إن كان الالتفات تتنازعه علوم البلاغة الثلاثة ( البيان و المعاني والبديع ) ، غير أنّ حضوره كان كثيفاً تحت قسم ( علم البديع ) في كتب البلاغة ، وإن تعدّدت مسمياته و ماهياته ، ما يهمنا هنا هو ، التفات الضمائر ( الغيبة ، والتكلم ، والخطاب ) ، والتنقل بينها شريطة أن تكون الذات التي تجمع كل تلك الجهات ـ وهي تمارس حركة تحويلها ـ ذاتًا واحدة ، وقتئذٍ تُسمّى هذه الحركة الجهوية لضمائر ذلك السياق التفاتاً .
ستتبع قراءتنا جماليات الالتفات بين (أسلوب التكلُّم ) و ( أسلوب الغَيبة ) ودلالاته في نصٍّ شهير من نصوص عميد الدّان الحضرمي الشاعر حداد بن حسن الكاف هو ( يا رب سالك تخلي سرنا مكتوم ) ، لقد رسم هذا النص الغنائي الحضرمي لنفسه مسارًا خاصًا في ذائقة التلقي ، لا على نطاق حضرموت حسب ، بل على نطاق الوطن العربي بشكلٍ عام ، لما حوى من رفاهية التوصيف الحدّادي على مدى مراحل التنامي الشعري في مقاطعِه ، فدراسة هذا النص و إغفال الحضور الالتفاتي فيه أمرٌ مُبخس لتجليات جمالياته ، لذا آثرنا أن نتتبع شيئاً من تلك التجليات في النص ، وفق رؤيا نقدية تنطلق من لغة النصّ نفسه لتتعمق فيه تركيباً ولغة :
بدأ النص بأسلوب الغائب : ( قال الفتى ) ، ليشكّل جسراً رابطًا مع المحيط الخارج المبلّغ بالنبأ منذ البداية :
قال الفتى قلبي الليلة سمع عنقة
تنوح بالصوت والأنغام
يا غارة الله حس في صوتها رقة
باللحن تشجي
نرى النص يعود ليربط هذا المحيط الخارج ، آخذاً به إلى داخل تسريد اللغة الشعرية ، وهي تتجلى في أنماط تصويراتها الداخلية القريبة ، فتوكأ السياق الشعري في ذلك القرب على أسلوب التكلم ( قلبي الليلة سمع ) ، متحوّلاً عن أسلوب الغيبة ( قال الفتى ) – على سبيل الحكاية ـ فيسمح هنا التصوير للقلب أن يمارس حاسة السماع عوضًا عن الأذن ليجسد مبلغ ذلك الصوت بأنه تجاوز الحواس الخارجية ، ليسكن الوجدان ومكمنه القلب ، لأنّه صوت ليس كأي صوت ، فقد انماز بالرقة و شجن اللحن ، الأمرالذي خوّله أن يتخذ من القلب مستقرًا سمعيًّا له ، متجاوزًا الأذنين حتى الغاية التأثرية والطربية ، وهو أسلوب يتواءم مع كون الصوت مظهرًا جماليًا ينتج عن الباطن ـ مقابلٌ لمظهر الجسد السطحي ـ فيستقبله في نقطة التلقي ، استقبال باطن ( القلب ) .

وهو يسرد تلك اللغة الشعرية ، يتبدّى الصوت المتكلم لديه : ( حِسْ ) في صوتها رقة باللحن تشجي ، بعد غاية الانبهار : ( يا غارة الله ) ، فالمقصود بالإحساس هنا الشعور ، في مرحلة تتجاوز حدّ السماع وجدانًا و انتشاءً ، فيضفي أسلوب التكلم إسهامًا في إبراز معزوفة ذلك الصوت الرقيق المنغوم الذي جعله جزءًا من سلطة الأثر المبثوث بالسجع من تلك ( العنقة ) ، وهي صورة استعارية تصريحية ، تتشكّل من بُعدين رئيسين ، أحدهما : وجداني (الصوت ) ، والآخر : شكلي جسدي ( جمال المظهر ” عنقة ” ) الجميلة شكلًا بهذا التوصيف ، ليكتمل الجمال بتموسق شدوها ، هنا ينسلّ الشاعر كجزء من حبكة درامية النص.
يختتم المقطع الأول بالالتفات إلى أسلوب الغيبة :
وبنغمها خلت العاشق -( غائب ) – ضوى مغروم ، لا شك إنّ هذا الغائب المغروم هو الشاعر المتكلم السابق ، لكنّ أسلوب الغيبة أكسبه تعميمًا وتوسيعاً لنطاق مكوّنه ليشمل كل عاشق يسمع ذلك النغم المتسلل النافذ إلى القلب الموصول بشدة جماله ورقة نغمه إلى حدّ الجنون .
( 2 )
ليعود في المقطع الثاني ملتفتاً إلى أسلوب ( التكلم ) : تميت / حيتي / رجلي / أنصت .
راسمًا صورة فردية قريبة من أثر ذلك التموسق الشجي ، الذي يصبح به ـ لا إراديًّا ـ وتدًا لا حراك له ، إنه أثر النغم الذي سلبه كيانه المادّي ، ليحيله كتلة من الوله المستجيبة لنشوة تردّد النغمات الموسيقية النابعة من فم ذلك الكروان ، نغمة تلو نغمة ، بتعبير النص الشعبي : زعقة قفا زعقة ، فلا ثمة حركة مطلقة إلا حركة مركز الحياة ، ومكمن الإلهام والالتذاذ بتلك الأنغام وجدانًا :
والقلب يدرج على بستانها و يحوم .
يدرج ، أي يتحرّك بمسارات دائرية تضطرب وجدًا وولهًا ، تتقصَّى موضع الجمال الحسي من تلك العنقة ، الذي تفصح به لغة النَص بأنه ( بستانها ) أي صدرها ، في منحًى عذري عفيف من لدنه : (القلب ) ، يقابله منحًى حسيّ من لدنها : (بستانها ) ويحوم ، جاء الفعلان ( يدرج / يحوم ) بصيغة المضارع مُعطيين حركة الدوران طاقة عظمى في الاستمرارية والتجدّد تنبئ عن حجم الأثر البالغ ، فالذي يدرج و يحوم هو القلب ، مكمّلاً مشوار التقصي والتتبع من عثقة إلى عثقة ، ليفاجئك السياق بأنّ ذلك القلب الذي تتوالى أفعاله بأسلوب الغائب ، ما هو إلا الشاعر نفسه ، كان متكاثفا في شقه الوجداني ( القلب ) ، لتدرك أنّ السياق قد التفت بك إلى أسلوب الغيبة بعد التكلم ، وهو يتجلى قائلاً : يتّبع الصوت من عثقة إلى عثقة … مسكين حدّاد ـ ( غائب ) ـ ما يلتام ، فيفتقُ هذا الالتفات إلى الغيبة من الشاعر نفسِه آخر مسكيناً ( ما يلتام ) ، هو أحوج ما يكون إلى الدفاع ودرء اللوم عنه ، وكأنّه يُبرزه متّهماً ـ من قِبل مجتمع التلقي ـ في قفص الاتهام ، وكأنّ أسلوب الغائب يجسّد سبابة الإشارة إلى ذلك المسكين ، خالقاً مسافة كافية لإبرازه في حالة المشفق عليه ، لتلحق التبرئة مباشرة في قوله ( ما يلتام ) .
و إن كانت النوايا المستقبلية تقرّ التهمة عليه ، لكنها لا تتعدّى كونها أمنياتٍ قلبية لم تضح أفعالاً يحاسب عليها القضاء ، تتراءى هذه النوايا القلبية في قوله :
ويودّي ـ ( غائب ) إلا وسط بستانها نذقة … بيّت وظلّي ( متكلم ).
إذا كان المكان يتمحور في قوله ( وسط بستانها ) فإنّ نوعية ذلك المكان وخصوبته أسهمت في مدّ الزمان بفعلين متحررين بحركة المضارع عن سكون آن اللحظة إلى تجدّدها ( بيّت وظلّي ) أي : أبيت و أظلي ، في امتدادٍ و استمرار، لا لذلك القلب المتكاثف بل لـ ( الأنا الشاعرة ) متكاملة بشقيها الوجداني المتجلي سابقاً، والحسي المادّي وتكوينه البشري ، في تجلٍّ و حضور حيٍّ عن وجدان اللحظة ـ القار في الشعرية ـ إلى مادّيتها الجسدية ، آنئذ يكون الالتفات إلى التكلم قد وصل إلى مرحلة البوح الصريح الذي كان يتغطّى على مدار النّص بأقنعة التكوين الوجداني البحت تارة : ( القلب ) ، أو سعة التكوين الشعري لمحيط الحدث الشعري : ( في الشمس واقف كما من قام ) ، حتى إذا وصل النص إلى غايته تنكشف تلك الأقنعة عن ذاتٍ توّاقة في واقع الأمنيات إلى غاية القرب الوصالي إفصاحًا بعد إلماح ، و بوحًا بعد إيحاء .
( 3 )
بالطف وباكون بين الغصن والورقة
ونظرة الزين ما تقتام
با مدّ بالاف نقدية لها وثقة
بالروح بافدي
يسهل علي في رضاه البذل و التسلوم
تتكاثف أنا الشعر بأسلوب ( التكلُّم ) حضورًا وبوحًا ، حتى بلغت حدّ الضمور للمكوّن الجسدي : ( بالطف ) ليستوعبه أدق و أرقّ مكانٍ في ذلك البستان ، لتحقيق تلك الارتماءة التي عبّر عنها مسبقا بقوله : ( نذقة ) ، فلا ثمة موانع مالية يمكن أن تعيقه من تحقيق تلك الغاية وإن ظلت هذه الأفعال المضارعة تشكّل لغة هذا المقطع : بالطف ( سألطف ) / باكون (سأكون ) / بامدّ ( سأمدّ ) / بافدي ( سأفدي ) / يسهل ، غير أنّها أفعال متصدّرة بالباء التسويفية الحضرمية ، التي توازي سين التسويف وسوف في العربية الفصحى ، فيترسم لك مشهدٌ مستقبليٌّ في أمنيات الشاعر لمّا يتحقق بعد ، وقد لا يتحقق ولكنّها غرائز تزرعها النظرة إلى الجمال الذي لا تقاومه الجوارح فيجرّ الذات الشعرية إلى حالة التشخيص ، عن مجرّد حالة التوجدن الداخلية إلى حالة التشهّي المادّية المحسوسة ، وبتعبير أدق من غزلٍ عذريٍّ إلى حسيٍّ جسدي ، لذا كانت تلك النظرة: ( ما تقتام ) ، أي لا تتقيّم بقيمة وثمن ـ لأنّها تجسّد كلّ الواقع الماثل المتحقق ـ وهو الأمر الذي جرّ كلّ ذلك السخاء المالي اللامحدود :
با مدّ بالاف نقدية لها وثقة بالروح با فدي
يسهل علي في رضاه البذل و التسلوم
هذه النظرة التي لا تتقيّم بقيمة مالية هي من فعّلت عنصر الانتقاء وحدث التكاثف على الذات في دقة متناهية ، وهي التي حرّكت سيل الأمنيات المستقبلية وجرّت كلَّ أفعالها في المقطع الذي تتصدّره الأنا الصريحة ، المنفردة عن الشريك ، لنفاسة الوصف ، فالفاعل في كلّ الأفعال المستقبلية السابقة : بالطف (سألطف ) / باكون ( سأكون ) / بامدّ ( سأمدّ ) / بافدي ( سأفدي ) ، هو ضمير مستتر مقدّرٌ بـ (أنا ) الأوحد ، فيتساوق إضمار الفاعل في تلك الأفعال المستقبلية وآلية التكاثف على الذات آنفة الذكر .
( 4 )
يتحوّل سياق النّص في المقطع الخامس من سبيل التوصيف إلى مباشرة آلية القرب، بالاستغناء عن الأسلوب الخبري واتخاذ الأسلوب الإنشائي ، يترك الشاعر فيه مساره الممدود منه إلى مجتمع التلقي، مجتهدًا في تحقيق أمنياته السابقة راسمًا مسارًا جدّيًّا جديدًا منه إلى الموصوف ، بلغة أكثر واقعية ، لغة يفهمها الموصوف من واقع بيئته حيث يضحي البستان (حيطًا) ، باللهجة الحضرمية الشعبية ، لكنّها وإن كانت لغة توسّلية للحصول على المبتغى ، فهي تترّفع في الطلب إلى التلميح ، و التكنّي عن التصريح ، لأنّها في مسرح المواجهة المباشرة :
يا صاحب الحيط للمحتاج مد صدقة
زكاة في ذي السنة والعام
والقصد من نخل بستانك نبى بسقة
من قرع هجري
يوم الهجر طعمه يشفي المحموم
ثمّة بُعدٌ يتجلّى مبثوثاً في لغة الإنشاء الطلبي المتمثل بأداة النداء للبعيد ، و في الالتفات عن المؤنث ( عنقة ) إلى المذكر (صاحب الحيط ) لأنّ في المذكر تحضر رسمية الحوار وجدّيته، على عكس حميمية القرب والألفة في أسلوب التأنيث ، وهو بدوره يقوّي استحالة تحقق الطلب ، الأمر الذي حذا به أن يعزفَ على الوتر الديني الفقهي -استجداءً -: ( صدقة + زكاة) ، هذا البعد الوصالي القارّ في خلد الشاعر ، يطمئن إلى الذهاب إليه الالتفاتُ عن المتكلم الحاضر بكثافة في المقطع السابق إلى الغائب : ( للمحتاج مد صدقة )، يتعاضد أسلوب ( الغيبة ) الدال على البُعد ، وامتداد المسافة الفاصلة بين الطالب والمطلوب ، وهو الأمر الذي يبرهنه امتداد الظرف الزماني للزكاة لسنتين : (زكاة في ذي السنة والعام ) ، دلالة على طول فترة استجداء الزكاة ، فلو كانت ستُخرج في هذه السنة ، من الأحرى بها أن تكون مدفوعة من العام، والتي يُقصد بها في عُرف الحضارم العام المنصرم .
هذا البُعد في مسافة تحقيق المطالب ظلت لغة النّص تبثه بين ثنايا مقاطعه ، وإن لم تصرّح به ، فهو يُقرأ في المقطع السادس :
من لا يزكّي وسط ماله تقع محقة
ولعاد يرجع مكمّل تام
هذه رسالة جليّة مفادها أنّ الشاعر فقد الأمل من الوصال ، لذا لجأ السياق ، إلى الغلظة في التحذير وأدخل الموصوف في جملة غير المزكّين ، فيجفّ ذلك البستان لأنّ صاحبه لم يؤدِّ خراجه ، فلم يعد ثمة بستان ، يستحق الذكر بل تجف خيراته وتذبل مبهجاتُ جماله وهو المعنيّ بقوله : ( وسط ماله ) كناية عن تبدّيه مكوّنًا مكمّلًا لقوام الجسد يقع في منتصف القوام ، فابتعد البستان والحيط عن اللغة في هذا السياق ومعه ابتعد أيضاً احتمال اللقاء و الوصول إلى الغاية ، هكذا ظلت لغة النص تتعاضد بتنوع سياقاتها ، لتؤدي الوظيفة الشعرية الجمالية ـ بشتى أدواتها ـ حقّ أدائها ، كما فعل الالتفات متحرّكًا و جِهاتِ الدلالة المنظومة بالسياق ذات البُعد وذات القرب ، و ذات التسريد وذات الإنشاء، فترسم حياة المشهد حيّة نضرة .
( 5 )
لم يكن أسلوب الغائب الوجهة الخاتمة لنصّنا بل يلتفت بعده سياق النص إلى (التكلّم ) حين يبتعد عن حواره مع محبوبته ويدخل في تسريدٍ عائد إلى محيط التلقي ، فيكون ( أنا ) مع بيئة التلقّي ، و( هو ) مع محبوبته البعيد عن نوالها ، ففي مقطعٍ يعقب المقطع السادس تراتبياً ـ و إن لم يكُن تاليًا له ـ يبدأ مراحل الانسلال عن المنحى الغزلي الجسدي وصولًا إلى المنحى العفيف والوجداني المنبثق عن عشق الروح في آلية ظاهرها لأول وهلة يوحي إليك بجسدّيتها ، لكنّها ما تلبث أن تتبدّى وجهة عذرية عفيفة ، ذلك الانسلال من حالة إلى حالة يأخذ في انتظام مراحله مسارين ، أحدهما رأسيّ من الأعلى إلى الأسفل ، و الآخر أفقيّ من اليمين إلى الشمال ، كالآتي :
في صُبع يمناه ودِّيته أقع حلقة
ولا أقع في يساره زام
راضي ولو كون تحت الطين له دحقة
في جبر خلّي
لو موت من قبل يأتي يومي المعلوم
كما هو معلوم ممّا سبق أنّ محور التلذّذ الغزلي الجسدي كان ( البستان ) أي الصدر في الوجهة الغزلية الجسدية ، لكنّ هذا المقطع الذي يلتفت فيه إلى أسلوب (التكلُّم) عن الغائب ، ( المحتاج ) ، يلتفت معه مسار الخطاب مقتربًا من محيط التلقي ، نرى وجهة الالتصاق بالموصوف تنزل عن محور الغزل الرئيس ( البستان ) ، باتّجاهٍ رأسيّ ، وكلّ ما نزلتْ ترتقي عذريّة ، فالمكان الجديد الذي يتمنّى فيه الشاعر ـ على سبيل التشبيه البليغ ـ أن يصبح حلقة في يمينه ، أو ساعة في شماله ، حتى يظلّ ملتصقًا بموصوفه ، لكنّ الذي يصرف هذا الالتصاق عن منحى الغزل الحسّي الجسدي ـ وإن تبدّى جسديّاً ـ هو مكان الالتصاق (الأصبع ) + ( اليد ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى استحالة الشاعر إلى مكوّنٍ ينأى به عن وصالٍ جسدي ( حلقة ) + ( زام ) أي ساعة وقت ، وهو الأمر الذي يأخذك إلى تسلسل مراحل الانسلال من حالة ( جسدية الغزل ) إلى وجهة ( الغزل العذري ) ، في نزول عن مكمن تحريك الغرائز الجسدية ( البستان ) إلى اليدين ، ثم بلوغ الانسلال غايته في اتجاهٍ إلى الأسفل ، في قوله : راضي ولو كون تحت الطين له دحقة ، هنا يبزغ مكون منفصل تمامًا عن الأول وعن الجسد بأكمله ، وصولًا إلى( تحت الطين ) فليس ثمة ما يربطه بجسد الموصوف ، غير أنّ هذا الاتجاه السفلي تسمو به العلاقة في اتجاه علوي ـ مغاير ـ عن مجرّد الماديّات الجسدية المحسوسة المتولّدة عن الغريزة الحيوانية المتواشجة بتكوين الإنسان ، إلى علاقة روحانية سامية ترتقي بموته في سبيل من يحب ، ويُضحي قبره طريقًا يمرّ عليه محبوبه ، أنّى لحالة كهذه أن تكون وجهة غزلية جسديّة في مُنتجِها الجديد ؟!
لذا لا تسلّم قراءتنا بصحة ما ورد في الديوان – وهو خلاف ما يقدّمه المؤدّون في نطقهم للكلمة -حين قال الديوان : للدّحقة ، والصواب : له دحقة ، لأنّ هذه الأخيرة تخصّص المسار له وحده دون سواه ، والأولى تعمّم المسار لكلّ داحق وهو معنّى فاسد دلالياً ، و تنأى قراءتنا كذلك عمّا ذهب إليه بعض النقاد من اقتراحهم ، ( فوق الطين ) بدلاً من ( تحت الطين ) وهم يفتّشون عن التلاحم الجسدي ، المخالف كما تقدّم لمسار دراستنا من جهة ، و من جهة أخرى أنّ القبر لا يكون مدفونُه فوق الطين بل تحتها ، والشاعر كان يتحدّث عن مآله بعد موته الذي تمنّى تسريع زمنه إن كان ذلك يُرضي محبوبه ، ومآل بعد الموت هو القبر، وهو الذي صرّح به في الشطر التالي : لو موت من قبل يأتي يومي المعلوم .
يمكن بيان مراحل الانسلال عن الحالة الغزلية الحسيّة إلى الحالة العذرية ، بالإيضاح الآتي :
المسار الرأسي ( متجّها إلى الاسفل ):
1 – ( عنقة )
2 – ( البستان + الحيط )
3 – ( في صُبع يمناه ودِّيته أقع حلقة )
4 – ( ولا أقع في يساره زام )
5 – (راضي ولو كون تحت الطين له دحقة ).
المسار الأفقي : ( في صُبع يمناه ودِّيته أقع حلقة ) ( ولا أقع في يساره زام )
هكذا تبدّت لغة النص في انتظام بنيتها تتعاضد دلالياً مع حركة الالتفات بجهاته ، قربًا و بعدًا ، وغيابًا وحضورًا ، لأنّ الحضور لجهةٍ يعني الغياب لضَّرتها ، والعكس صحيحٌ ، فالالتفات هو حركة تُحدث وظيفتها آلية في النص ولا تتوقف عند مجرّد سردها أو حكيها ، ليتجاوز كونه ظاهرة صوتية مسموعة أو مقروءة إلى كونه حدثًا يحوّل مسار السياق من جهة إلى جهة ، رؤيويًا ودلالياً .