أضواء
د. حسن صالح الغلام العمودي
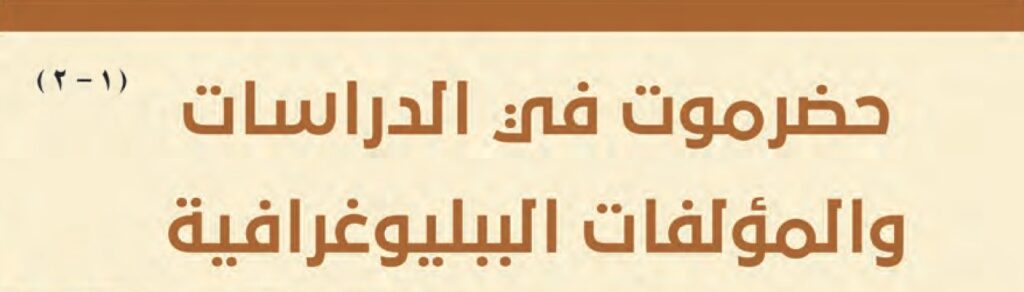
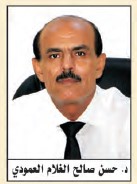
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 9
رابط العدد 6 : اضغط هنا
أما الحضارة الأوربية فقد عرفت ذلك العلم باسم ببلوغرافيا “Bibliographic”، وهو لفظ يتكون من كلمتين هما : Biblios “” بمعنى “كتاب” و “Grapho ” ومعناها يكتب ، وأصبح ذلك اللفظ يطلق في اللغات الأوربية على فن نسخ الكتب، وظل المعنى يرافق ذلك اللفظ حتى تحوّل مدلوله في النصف الثاني من القرن الثامن عشر من كِتابة الكتب إلى الكتابة عن الكتب [18]. وفي إطار هذا المعنى تبلورت مجموعة من أنواع الكتابة الببليوغرافية عد منها بعض الباحثين ثمان وأربعين نوعًا، ثم قسمها بحسب مدلولاتها على ثلاث مجموعات، وتلك المجموعات قسمها على ثلاثة قطاعات عريضة هي :
أولًا: الببليوغرافيا التاريخية .
ثانيًا: الببليوغرافيا البحتة .
ثالثًا : الببليوغرافيا التطبيقية .
ويذهب ذلك الباحث إلى أنّه يندرج تحت كل قطاع منها شعب وربما تفرعت الشعب على فروع [19]. وبالرغم من تنوع الكتابة الببليوغرافية فإنّه يمكننا أن نشير إلى نمطين منها؛ لكونهما أكثر استخدامًا بين الباحثين، زيادة على أن أغلب الدراسات التي أشارت إلى الإنتاج الفكري والعلمي المتعلق بحضرموت يندرج في إطارهما وهما:
1– الببليوغرافيا النسقية:
وهي التي تهتم بحصر الإنتاج الفكري في موضوع ما ، وتعد الأكثر شيوعًا بين المهتمّين بالتصنيف في هذا المجال .
2– الببليوغرافيا التحليلية:
وهي التي تعتني بالوصف المادي للكتاب من حيث ورقه وطباعته ونوع حروفه وغير ذلك.
وبالإجمال فإن للدراسات الببليوغرافية بكل أنواعها أهميتها عند المشتغلين بالبحث العلمي في كافة فروع المعرفة الإنسانية وتخصصاتها العلمية ؛ حيث تزوّدهم بأسماء “المصادر” و”المراجع” ذات الصلة بموضوع أبحاثهم بأقل وقت ممكن، فضلًا عن أنها تسهم بالكشف المبكر في إمكانية الاستمرار بالمضي قدماً لإنجاز الموضوع أو عدمه . بَلْهَ إنّ البعض منها يحدّد أماكن تواجد المصادر خاصة المخطوطات منها مما يسهل للباحث الوصول إليها بأسرع وقت ممكن. زيادة على أن المؤلفات و الدراسات الببليوغرافية تمثّل وسائل عمل ضرورية للباحث وتضفي على بحثه الصبغة الأكاديمية التي تفتقدها معظم الأبحاث التي تقدم إلى جامعاتنا العربية[20] ولاسيما الحضرمية منها .
لقد كانت ولازالت حضرموت محل اهتمام عدد من الباحثين عربًا وأجانب، فتوفرت عنها العديد من الدراسات باللغة العربية وباللغات الأجنبية, فإذا تعذر علينا حصر ما لفظته ألسنة المطابع مما دوّن عنها باللغة العربية ، فإنّ ما كتب عنها باللغات الأوربية حتى عام 1971م ينيف على خمسة آلاف نص بين كتاب ومقال[21], فكان ذلك دافعاً للمشتغلين بالدراسات الببليوغرافية أن يرصدوا ذلك الكم الهائل من الدراسات كُلٌّ في مجال اختصاصه، فضلًا عن ما أنتجته قريحة أبناء حضرموت أنفسهم من أعمال الفكر في شتى فروع المعرفة والعلوم الإنسانية[22].
إنّ تداخل موضوعات الدراسات الببليوغرافية عن حضرموت تجعل من الصعب تقديمها وفقا لموضوعاتها، غير أنه يمكن حصرها في نوعين هما:
أولاً: مؤلفات بيبليوغرافية خاصة: وهي التي عُنِي فيها أصحابها برصد عدد من جوانب الإنتاج الفكري والعلمي الخاص بحضرموت ، في موضوعات مختلفة، وقد جاء البعض منها على شكل كتب وأخرى في مقالات وبحوث.
ثانياً: مؤلفات بيبليوغرافية عامة: خصصها أصحابها لرصد النتاج الفكري لبلاد المسلمين عامة، فكان لحضرموت ثمّة حضور فيها .
إن تناولنا لكلا النوعين سيتمّ على وفق سنوات نشرها بهدف إبراز التراكم المعرفي عن حضرموت.
أولًا: المؤلفات الببليوغرافية الخاصة:

يعود اهتمام سيرجنت بالتراث والتاريخ الحضرميَيْنِ إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وقد أنجز جملة من الدراسات المهمة والرصينة التي تهمُّ الباحث في التراث والتاريخ والثقافة والفكر الحضرمي، هي ثمرة اطلاعه المباشر على المكتبات الحضرمية ومحتوياتها خلال إقامته في حضرموت 1947- 1948م . إضافة إلى ما سمعه ودوّنه من أخبار وآراء من أبناء المنطقة أنفسهم [23] . جاءت مساهمته في حصر بعض أعمال المؤرخين الحضارمة المحليين من غير سواهم وقد نشرها تحت مسمّى: ( مادة تاريخية حول جنوب الجزيرة العربية ” ملاحظات عن مخطوطات جديدة في حضرموت” )[24].
الموضوع جاء في قسمين: قدم للأوّل بأسباب وفرة المخطوطات في حضرموت، واختفاء المبكرة منها، كما أشار إلى أهم المراجع التي اعتمد عليها في تناوله موضوعه ، فضلًا عن قائمة بأسماء المكتبات التي زارها، ثم تناول في القسم الأوّل المخطوطات التاريخية، معرِّفًا بمؤلّفيها، ومحدّدًا لمواقعها وللمراجع ذات العلاقة بها، ومن ثمّ وصفها وعلّق عليها. هذا بالإضافة إلى ذكره بعض الأعمال المتعلقة بالأنساب والتراجم.
أما القسم الثاني من الدراسة الذي حمل العنوان نفسه [25] فقد استكمل فيه الحديث عن بعض المصادر معتمدًا المنهج نفسه الذي سلكه في القسم الأوّل، غير أنه لم يلتزم بطريقة معينة في دراسة مصادره، فتارة يقدّم المتأخّر وطورًا يؤخّر المتقدّم.
وهناك دراسة أخرى لسيرجنت تناولت المؤرِّخين وكتابة التاريخ في حضرموت[26] ، اعتمد فيها على ما أورده في دراسته آنفة الذكر بقسمَيْها، وعالج فيها كثيرًا من القضايا، مثل: الأسباب الكامنة وراء ندرة المادة التاريخية في النقوش الحضرموتية قبيل الإسلام، وكذا ضآلتها بعد ه، إضافة إلى تناوله نفرًا من المؤرِّخين والإخباريين الحضرميين تم تسجيله لعدد من الملاحظات على الأنساب والمادة التاريخية في الكتابات الحديثة. وقد ركّز سيرجنت في ذلك على الخلاف العلوي ـ الإرشادي، الذي عاشه المهاجرون الحضرميون في جنوب شرق آسيا وتحديدًا في أندونيسيا، وانعكاس أثر ذلك الخلاف على الكتابات التاريخية الحديثة عند الباحثين الحضرميين. كما درس بعض أعمالهم مقيّمًا إيّاها وموضحًا ما تحمله من أطروحات بشأن كثير من قضايا الفترة الوسيطة من التاريخ الحضرمي.
تكمن أهمية الدراسة فيما حملت من آراء للكاتب بصدد بعض المزاعم التي يروِّج لها جُلَّ المؤرخين العلويين المحدثين بشأن الفترة الوسيطة من التاريخ الحضرمي وتشكيكه في صحتها، وإنْ كان لا يعلن ذلك صراحة، بل يؤمئ إليه.
2- عبد الله محمد الحبشي :
له إسهامات جليلة وكثيرة في إحياء وحفظ و صيانة التراث والتاريخ والثقافة الحضرمية ، من خلال التأليف والتحقيق والنشر، فضلًا عمّا يقوم به من توضيح وتصحيح أينما تمكّن من ذلك. إضافة إلى اهتماماته العلمية والتاريخية والثقافية بالأقطار العربية الأخرى. وهو علم لا يمكن للمشتغلين والمهتمّين بالتاريخ الحضرمي خاصة والإسلامي عامة تجاوز إنتاجه العلمي، بل ويفرض نفسه على الباحثين بما دوّنه في هذا المجال، ويُعَدُّ في ضمن الروَّاد الأوائل الذين طرقوا هذا المجال. وممَّا خص به حضرموت كتابًا حمل عنوان : ( فهرست المخطوطات اليمنية في حضرموت،المحافظة الخامسة ) [27]:
جاء الكتاب في ( 112) صفحة من الحجم المتوسط، واشتملَ على تصدير للناشر وملاحظات للقراء، ثم مقدّمة المؤلف الذي بيّن فيها أسباب اهتمام المشتغلين بالآثار والنقوش القديمة وما رافق ذلك من صعوبات وخطورة , وإهمال الجانب الآخر من الآثار المتمثل في المخطوطات، وإسدال الستار عليها فترة من الزمن، واغتنام تلك الفرصة من قبل بعض الأوربيين باقتناء المخطوطات بطرق وأساليب شتى؛ لاستكمال ما تعانيه مكتبات بلدانهم من نقص, مُبيّنًا في هذا المنحى الأسباب والعوامل الخارجية والداخلية في فقدان وتشتيت كنوز التراث الحضرمي، فضلًا عن عوامل إتلاف الكتب المخطوطة.
ولئن كان عنوان الكتاب “المخطوطات اليمنية في حضرموت” يوحي بأنه يعتني برصد ما هو يمني من تلك المخطوطات ، فإنّ هذا لا يعني خلوّ الكتاب من المخطوطات الحضرمية الأصل والمنشأ ، بل إنّنا نجد أنّ أغلب ما ورد فيه يتعلق بالمخطوطات الحضرمية . وبعض المخطوطات من بلدان إسلامية أخرى نسخت في حضرموت ، وقد اشتمل الكتاب على ما وجده المؤلف من مخطوطات في أربعة عشر مكتبة شخصية للأهالي منتشرة في ربوع وادي حضرموت وفروعه، وقد اعتمد في إخراجها على أسماء المكتبات مدخلًا، وعلى الترتيب الأبجدي لأسماء المخطوطات أُسًّا لعرضها ، وأشار إلى عدد أوراقها ، وسنوات خطّها ، ثم أتى على ذكر مؤلّفيها وسنوات وفياتهم ، وقد جاءت موضوعات تلك المخطوطات في جملة من العلوم : كالفقه ، والتفسير ، والتاريخ ، والتراجم ، واللغة ، والأدب ، والفلك ، والطب ، والتصوّف وغيرها.
الجدير بالذكر أّنّ هذه المكتبات ومحتوياتها التي ذكرها الحبشي تكوّنت منها النواة الأولى لِمَا عُرِفَ فيما بعد بمكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم، وصدر لها فهرس أوّلي سنة 1985م، ثمّ أضيفت إليها بعض المخطوطات التي اشتراها المركز اليمني فرع حضرموت من المواطنين حتّى بلغ إجمالي ما يوجد بها من المخطوطات 5338 كتابًا مخطوطًا في شتى فنون العلم والمعرفة، وصدر بها فهرس سنة 1987م في ثلاثة أجزاء من إصدار المركز اليمني للأبحاث الثقافية فرع سيؤن, يوضح محتوياتها، وجاء مقسّمًا حسب المواضيع ومرتّبًا على الحروف الأبجدية، مشيرًا لاسم المخطوط ومؤلّفه وتاريخ نسخه، وهو الفهرس المتعامل به اليوم .
3- علي سالم بكيّر :

لـه : “بحث في مصادر التاريخ الحضرمي”[28] ، صدر البحث مُدبَّجًا بمقدّمة أشار فيها إلى ما يعانيه الباحث في التاريخ الحضرمي من مصاعب وعقبات ممثلة في ندرة المصادر والمراجع وصعوبة التعامل معها ، ملاحظًا في الوقت نفسه معاناة دراسات التاريخ الحضرمي من ثغرتين بحاجة إلى نظر وتحقيق وهما: الأولى: “آثارها”، والثانية: “تاريخها”. ثم تناول المؤرخين الحضارم، وقسمهم إلى ثلاثة أجيال مشيرًا إلى ممثّل كلّ “رعيل”، وتعرّض إلى سبب تأخّر تدوين التاريخ الحضرمي، وغموض فترة الحكم الأباضي فيه منذ سنة 130هـ/747م حتى مطلع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.
لقد عزا بكيّر سبب عدم التدوين إلى نظرة الأباضية للاشتغال بكتابة التاريخ؛ حيث عدُّوه من “الفضول”، كما فنّد الزعم القائل: إنّ فقدانَ مصادرِ التاريخِ الحضرميِّ يعود إلى نظرة الخلف لآثار السلف لما رأوا فيه ما ينكرونه عليهم .على أنّ ما يؤاخذ على هذه الدراسة تضمّنها إشارات عامة وعابرة عن المؤرخين والاكتفاء بذكر أسمائهم وعناوين مؤلفاتهم ، من غير الترجمة لهم أو الغوص في مصنفاتهم للكشف عن محتوياتها وأساليب تدوينها ومصادرها. وصاحب الدراسة كان أكثر قربًا من غيره إلى معاقل تلك المصادر، لتبوّئه إدارة مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم ، فضلًا عن أنّه سليل أسرة كانت لها مكانتها في الحياة العلمية والثقافية بالمدينة. غير أنه قد لامس في مقدمة بحثه مشاكل ومصاعب يعاني منها الباحث في مصادر التاريخ الحضرمي.
4- أحمد سعيد باحاج :

جاءت مساهمة هذا المؤلف وبحكم اختصاصه العلمي في مجال الجغرافيا ، فقد اهتمّ بالرّحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت منذ القدم حتى عهده ، وقد رصد كل ذلك في كتابه الموسوم بـ “الرّحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت “[29] .
الكتاب يتكون من 160 صفحة من الحجم المتوسط ، وقد صدّر كتابه بالإهداء وذكر المحتويات وفهرسين: الأول؛ للخرائط، والثاني للصور، إضافة إلى مقدمة المؤلف وخمسة فصول . والفصول اشتملت على عدد من المباحث تختلف باختلاف ما توفر عنها من مادة علمية ، ثم يتبع ذلك بالتوصيات التي خرجت بها الدراسة . وملحق للصور زيادة على فهرسين: الأول؛ بأسماء المواضع، والثاني؛ بالأعلام، ثم أتى على ذكر مراجع الصور والخرائط ، وأخيرًا أتى بقائمة لأسماء المصادر والمراجع.
تناول المؤلف في مقدمته أسباب تسمية المنطقة بــ”حضرموت”، وعدّد الآراء المتواترة عنها غير أنه لم يُبْدِ منها موقفًا، ثم أشار إلى أسباب ودوافع الرحلات الاستكشافية إلى المنطقة منذ عصر ما قبل الميلاد حتى بداية القرن العشرين، منوّهًا إلى طبيعة الأخطار والمصاعب التي تعرض لها الرحالة ، مثمّنًا جهودهم في إثراء معلوماتنا الجغرافية عن حضرموت: سواحلها، ووديانها، ومدنها، وقراها . ثم استعرض فصول كتابه التي جاءت على النحو الآتي:
الفصل الأول: الرحلات الجغرافية لجنوب الجزيرة العربية من باب المندب غربا إلى ظفار شرقا.
الفـــصل الثانـي: الرحـــلات الجغرافيــــة لــحضرمــــوت.
الفــصل الثالــث: حضرموت في الخرائط الجغرافية القديمة.
الفــصل الرابــع : مصادر الدراسات الجغرافية لحضرموت.
الفـــصل الخامس: نتائج الـرحلات الجغرافية لحضرمـــوت.
تُعَدُّ هذه الدراسة من أهم الدراسات الببليوغرافية عن حضرموت في إطار تخصصها المعرفي ، وقد حرص مؤلفها على إبراز التراكم العلمي الجغرافي عن المنطقة منذ عصر ما قبل الميلاد وحتى القرن العشرين وفق منهج علمي صارم سعى من خلاله التركيز على أهم الرحلات والدراسات, متناولًا إيّاها بحسب أقدميتها الزمنية، مشيرًا إلى أسماء أصحابها وموضحًا أهداف قيامها، والطرق التي سلكوها ، وما رافقها من مصاعب ومشاكل ، ثم يأتي على ذكر ما توصل إليه أصحاب تلك الرحالات من نتائج ، ملتزمًا في كل ذلك بالتوثيق العلمي لما يذكره من معلومات .
ولمَّا كان جُلُّ القائمين على تلك الرحلات والدراسات هُمْ رَحَّالةٌ وكُتَّابٌ أجانب فقد سعى المؤلف في كثير من الأحيان إلى ذكر أسمائهم باللغة العربية ثم الإنجليزية، إضافة إلى عناوين كتبهم ودراساتهم، منوِّهًا في الآن نفسه بالترجمات إلى اللغات الأخرى ، ولاسيّما وأنّ البعض منها قد كتبها أصحابها بلغاتهم الأصلية ، فعلى سبيل المثال يقول: “نشر فارثيما كتابه باللغة الإيطالية في روما في عامي1510م و1517م، كما نشر في البندقية في الأعوام 1863،1835،1518م . ونشرت أول ترجمة لكتابه باللغة الإنجليزية بين عامي 1576 ـ 1877”[30].
كما عُنِيَ المؤلِّف بذكر مصادره ومراجعه في نهاية كل فصل، وقد أظهرتْ لنا هذه المصادر والمراجع اطلاعَه المباشر عليها، وقلّما يأخذ من غيرها بطريقة غير مباشرة. ولمّا تعذّر عليه إيجاد الخرائط التوضيحية لبعض الرحلات خاصة الموغلة منها في القدم وتبيان خطوط سيرها ومواقع زياراتها فإنه اهتمّ بذلك في بقية الرحلات التي جابت المنطقة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر. وهي خرائط كان البعض منها من إعداد الرحالة أنفسهم ، بينما قام المؤلف برسم البعض الآخر مستفيدًا من المعلومات التي تضمّنتها الرحلات، وقد راعى فيها المؤلف الأسس العلمية لرسم الخرائط من مقياس رسم وتحديد اتجاه الشمال، علاوة على مفاتيح الخرائط التي تظهر أهم مواطن الاستقرار الحضري من مراكز و مدن وقرى، إضافة إلى خطوط سير الرحالة ذهابًا وإيابًا. وإذا كان المؤلف قد ركّز اهتمامه في الفصلين الأوّلين على الرحلات الجغرافية إلى المنطقة ، فإن الفصل الثالث قد خصّصه لحضرموت في الخرائط الجغرافية القديمة منذ ما قبل الميلاد وحتى القرن الثامن عشر الميلادي، ملتزمًا بالأسس نفسها التي اعتمدها في تناول الرحلات، غير أنه استثنى مساهمات الجغرافيين العرب من ذلك الترتيب وأخرجهم من إطارهم الزمني الذي ظهرت فيه أعمالهم وخصهم بالمبحث الأخير من غير ذكر السبب.
أما الفصل الرابع فقد أتى فيه المؤلف على ذكر مصادر الدراسات الجغرافية لحضرموت، وجاء تقسيمه لها بحسب فروع علم الجغرافيا ، فأشار إلى أهم مصادر الدراسات الجغرافية العامة موضحًا نوعَ المراجع المستخدمة فيها عربية كانت أم أجنبية . أما الرحلات والدراسات الإقليمية الخاصة بحضرموت وكذا الدراسات الجيولوجية والجيمورفولوجية فضلًا عن الدراسات المناخية والمائية والنباتية والحيوانية والدراسات السكانية والزراعية وأخيرًا الدراسات الاجتماعية والاقتصادية فقد جاءت في مجملها بأقلام أجنبية . وقد خصص الفصل الأخير من الكتاب لأهم النتائج التي ترتبت على الرحلات الجغرافية لحضرموت.
وإجمالًا فإنّ المؤلف قد بذل جهدًا يستحق الشكر والثناء عليه، وكان دقيقًا في كلّ ما قدمه من معلومات، مراعيًا للأسس العلمية والأكاديمية في دراسته، فضلًا عن منهجه المستخدم في الدراسة، الذي يساعد الباحث في الوصول إلى هدفه بأقل وقت ، كما أن إجادته اللغة الإنجليزية سهل له عملية التواصل مع الدراسات الأجنبية وزاد من مصادره وأسهم في نقل ما سطر فيها عن حضرموت إلى قُرَّاء اللغة العربية . وتكشف الدراسة عن سعة اطلاع المؤلف وإلمامه بمصادر ومراجع علم الجغرافيا وفروعه المختلفة، ويبدو أن ذلك كان دافعًا بالمؤلف لإعداد فهرس ببلوغرافيا لمراجع اليمن، غير أن المنيَّة عاجلته وأبت عليه تحقيق ذلك .
5– رودينوف ( ميخائيل ) : Rodeonov,M :
مستشرق روسي، وأحد الأفراد الذين عملوا في إطار البعثة السوفيتية اليمنية المشتركة خلال المدّة (1983-1993م) في حضرموت , وقد تبوّأ مسؤولية المجموعة الإثنوغرافية؛ حيث تعدّدت زياراته لحضرموت خاصة المنطقة الغربية منها ، التي تنطوي في إطارها على الروافد الجنوبية الغربية لوادي حضرموت الرئيس : وادي عمد , دوعن, العين والأنجاد فيما بينهما ، علاوة على سير الثلاثة الأودية ووادي الكسر الذي يشمل حوره. وقد أجرى هناك عددًا من الأبحاث الميدانية الإثنوغرافية , استفاد منها في إعداد أطروحته للدكتوراه التي تقدّم بها لمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بمدينة سانت بطرسبورغ في عام 1991م تحت مسمّى ” إثنوغرافية حضرموت الغربية “.
لقد فرضت طبيعة الدراسة والمنهج المستخدم فيها أن يشير المؤلف إلى الجهود العلمية التي سبقته في هذا الجانب المعرفي من حضارة حضرموت، فخصّص أحد محاوره التمهيدية لذلك الغرض الذي وسمه بـ : (البحث الأثنوغرافي في حضرموت)[31] :
تضمن هذا المحور ذكر عدد من أسماء المساهمين في هذا الجانب ـ الدراسات الإثنوغرافية ـ وإن كانت إشارات البعض منهم – خاصة الأوائل – قد أتت بشكل عرضي من غير أن يكون القصد منها التوثيق الإثنوغرافي للمنطقة , لكن سياق رحلاتهم ووصفها جرّهم للحديث عن عادات وتقاليد وأعراف المنطقة فضلًا عن المهن والحرف التقليدية، وكان أغلبهم من الرحالة والمستكشفين الأجانب, وقد استعرض دورَ كُلٍّ منهم على حدة منذ تدشين أولى رحلات الكشف العلمي لحضرموت في العام 1843م من طرف ادولوف بارون فون فريدا (Adolphe Baron von Wrede) مرورًا بالعهد البطولي للإنجليزي وليم هارولد انجرامس William Harold Ingrams)) في ثلاثينات القرن العشرين، وصولًا إلى جهود استكشاف دوستال ( Dostal) في 1960م و1964م و1966م، وعبد الله البجرة في يوليو1962- يونيو 1963. كما عرّج على ما جاء في الكتابات المحلية الحضرمية من معلومات إثنوغرافية، فضلًا عن نتائج أعمال البحث الميداني للبعثة السوفيتية اليمنية المشتركة. وبالإجمال فإنّ لهذا المحور والدراسة أهمية خاصة في دراسة تاريخ أثنوغرافية حضرموت لا بكونها رائدة في مجال موضوعها ومضامينه وحسب بل وبالمنهجية والأسلوب العلمي المتبع في إنجازها.[32]
7– عبدالله سعيد باحاج :

له كتاب وسمه بــ “حضرموت في المؤلفات العربية والأجنبية بحث في تطور المعرفة الجغرافية والتاريخية خلال خمسة وثلاثين قرناً (1500ق.م-2004م)”[33]:
يتكون الكتاب من 274صفحة من الحجم الصغير ويشتمل على مقدمة وإهداء وخمسة فصول،فضلا عن الخاتمة وفهرس بأسماء المؤلفين وسنوات مؤلفاتهم المذكورة في الكتاب،إضافة إلى مراجع البحث.
كان هدف المؤلف من تصنيف الكتاب سدَّ ثغرةٍ تعاني منها المكتبة العربية في مثل هذا النوع من الدراسات، ولاسيما المتعلق منها بحضرموت ، إضافة إلى توجيه الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأن الحضرمي بمنابعه وأصوله الخاصة بالمعرفة الجغرافية والتاريخية. زيادة على ذلك تحقيق حلم كان يراوده منذ ولوجه في حقل الدراسات الجامعية العليا ، فضلًا عن استكماله لمشوار كان قد بدأه شقيقه [34] في إطار الجهد المبذول لرصد الإنتاج الفكري المعني بحضرموت. وبحسب عنوان الكتاب فإن المؤلف قد ركّز جهده في إطار المعرفة الجغرافية والتاريخية ، وكان على بيّنةٍ من أن عمله هذا ليس بالأمر الهيّن والسهل ، وباستحالة حصر كل ما كتب عن حضرموت باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، لذلك قدّم لنا ما تسنّى له الوقوف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكانت حصيلته من ذلك ستمائة عنوان، وقد حرص أن يقدّمها موثّـقة توثيقًا علميًّا، وقام بتوزيعها على خمسة فصول، وكل فصل يتكوّن من عدة مباحث، تختلف في عددها من فصل لآخر تبعًا وما يرصده لها من عناوين المؤلفات .
8- صالح علي باصرة :

له ” حضرموت ببليوغرافيا مختارة “ [35] :
هذه الدراسة في ضمن مجموعة دراسات للمؤلف في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر، استهـلّها بمدخل موجز، أشار فيه إلى تعريف علم الببليوغرافيا, وسَبْق العرب فيه على الأوربيين, ثم أشار إلى ما طرأ عليه من تطوُّر، ولاسيّما بعد ظهور أجهزة الحاسوب وشبكات المعلومات المحلية والدولية، وما نتج عنهما من تدفق المعلومات، ثم تناول أهم الفهارس الدولية ومجالاتها، مشيرًا إلى الجهد الرسمي والشخصي في اليمن لإصدار مثل هذا النوع من الفهارس. وقد نبّه المؤلف إلى أن عمله هذا عبارة عن جزء بسيط ممّا كتب عن حضرموت خاصة , واستثنى ما جاء عنها في الدراسات والبحوث العامة الأخرى ، وقد رصد لنا 221 عنوانًا موزَّعة على أربعة محاور، جاءت على النحو الآتي:
الأول: المخطوطات والكتب والترجمات.
الثاني: البحوث والدراسات المقدمة إلى الندوات العلمية أو المنشورة في المجلات.
الثالث: الكتب والدراسات باللغات الأجنبية.
الرابع: الرسائل الجامعية.
لا تقتصر أهمية هذه القائمة على تزويد الباحث بالمراجع والدراسات الخاصة بتاريخ حضرموت الحديث والمعاصر, وإنما بما تقدّمه أيضًا من عناوين لمراجع وبحوث في جوانب علمية وفكرية أخرى، مثل : الأدب , والمياه ، والزراعة ، فضلًا عن المعلومات الجغرافية ونتائج بعض أعمال البعثات الأثرية وغير ذلك. ويبدو أن المؤلّف قد تجمّعت لديه عدد من الجذاذات الخاصة بعناوين الكتب أثناء إعداده لبحوثه في التاريخ الحضرمي، فأخرجها لنا في هذه القائمة “المتواضعة”على حد وصفه [36].
9- حسن صالح الغلام العمودي:
“مصادر تاريخ حضرموت في العصر الإسلامي الوسيط من صدر الإسلام حتى القرن العاشر الهجري “:
وهذا البحث هو رسالة تقدّم بها الباحث إلى قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الآداب والفنون الإنسانية بتونس لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الوسيط [37] ، تتكون الرسالة من أربعمائة صفحة A4″”، وتتركب من الإهداء وتقدير واعتراف، إضافة إلى ملاحظات أوّليّة نبّه فيها الباحثُ القارئ إلى بعض التوصيات الفنيّة المتعلقة بالمختصرات المستخدمة في الرسالة. ثمّ يتبع ذلك بمقدمة عامة اشتملت على أهمية الموضوع ودواعي اختياره وإشكاليته ومنهج دراسته.
وقد عزا الباحث أسباب طول الفترة الزمنية لدراسته بشحّ المصادر التي تتناولها من ناحية، وقلّة الأحداث التي جرت خلالها من ناحية أخرى، فضلًا عن ندرة المادة المدوّنة وتكرّرها. ويذهب إلى أنّ ما جعله أكثر استعدادًا للمضيّ قدمًا في دراسته هو ما رآه من قصور في الدراسات التي سبقته واكتفاء أصحابها فيها بحصر أسماء المصادر والمراجع ووصفها أحيانا، زيادة على أنه قد لاحظ أنّ كثيرًا من الدّراسات المعاصرة تكشف عن عدم معرفة أصحابها بمصادر ومراجع التّاريخ الحضرمي، وأنّهم يستندون في أحكامهم وآرائهم على ما وصل إليهم من كتب معدودة سُطّرت بأقلام حضرمية، ولم يكلّفوا أنفسهم عناء قراءتها بعين الناقد البصير، بل اعتبروها حقائق وأمور مسلم بها، على الرغم من وجود مصادر ودراسات أخرى لو طالتْها أيديهم لأعادوا النظر فيما انتهوا إليه من نتائج وأحكام.
ويذهب الباحث إلى أنّ دراسته تفترض تساؤلات عدّة منها: إلى أيّ مدى حظيت حضرموت باهتمام المؤرخين المسلمين؟ أيُّ صورة تاريخية رُسمت لهذا الإقليم بين دفّات المصادر الإسلامية؟ ما هي المحطات التاريخية التي أبرزتها؟ وإذا تنوّعت تلك المصادر وتعدّدت في المكان والزّمان هل كمّل بعضها البعض؟ وسدّ الفجوات الوثائقية للهيكل التاريخي العام للمنطقة فتخوّل للباحثين إعادة صياغة التاريخ وكتابته بكل عناصره وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
تلك الإشكالات وغيرها يثيرها الباحث ويحاول قدر الإمكان النّظر فيها من خلال قراءة متأنّية وناقدة لأهمّ المصادر المخطوطة والمطبوعة والأثرية والمراجع والدراسات العربية والأجنبية وفق منهج علمي تاريخي. لقد فرضتْ طبيعة موضوع الدّراسة على المؤلف منهجًا حاول من خلاله التركيز على فكرة جوهرية، تتمثل في تحديد موضع حضرموت في الكتابات الإسلامية المبكّرة من خلال رصد وتوثيق نشاطات وفعاليات القبائل والفرق المذهبية في التّاريخ السياسي، مع مراقبة ما يجري من الأحداث في بلاد الإسلام عامّة وجزيرة العرب خاصة، وأثر ذلك على ما شهدته حضرموت من تقلُّبات. ولتحقيق هذا الغرض عمد الكاتب إلى تحديد إطار جغرافي لحضرموت، ثم التعريف بها. وقسم دراسته على ثلاثة أبواب رئيسة، خصّص كلَّ واحدٍ منها لفترة زمنية معينة. وتكوّن كل باب من فصلين:
أولهما: تناول الإطار التاريخي العام الذي يعالجه الباب، ويهدف إلى استبيان أرضيّة واقع الأحداث التي تؤرخ لها المصادر، وهنا لا يدّعي الدّارس الوقوف على كل جزئيات أحداث التاريخ الحضرمي، إنّما أبرز محطّاته التي انعكس صداها على عمليّة التدوين التاريخي.
ثانيهما: وخصه بالمصادر والمراجع والدراسات الحديثة، وجاء هذا الفصل في قسمين: أوّلهما؛عُنِي بدراسة المصادر المبكّرة، وقد جعل من كلّ المؤلفات الموحّدة موضوعًا صنفًا مستقلًّا، صدر له بمقدمة تناولتْ أهمَّ ملامحه، ثمّ ترجم لكلّ مؤرخ ترجمة ذاتية موجزة، سار فيها على النّحو التقليدي فعُنِي بذكر اللقب والاسم الذي اشتهر به المؤلف، وحدّد فترة حياته بالسنوات الهجرية وما يقابلها بالميلادية ما أمكنَه ذلك [38]. كما بيّنّ نشأته وانتماءه القبلي والمذهبي، ومن تلقّى عنهم العلم، ورحلاته والوظائف التي تقلّدها، وغير ذلك من التفصيلات الخاصة. ولقد حرص على تذييل تلك الترجمة بأهم المصادر والمراجع التي استقى منها معلوماته. ويعرض الكاتب هذه الترجمة عند أوّل كلّ عمل، وتجري الإحالة إليها إذا كان للمؤلّف أكثر من عمل، ثم يلحق ذلك بتناول أهمّ أعماله ذات الصّلة. وقد أفرد لكل عمل عنوانًا في إطار الصّنف الذي ينتمي إليه، مبتدئًا بوصف العمل ومنهجه، مع الإشارة إلى المصادر التي اعتمدها. ثم الغوص في مظانّه للكشف عمّا يقدّمه من مادة علمية تتعلق بالفترة الزمنية للباب، وتقييمها من خلال مقارنتها بما ورد في غيره من المصادر، محاولًا إبراز نقاط الالتقاء أوالاختلاف أوالتفرّد، ومن ثم نقدها، مع الإشارة إلى أهميتها ومكمن الاستفادة منها لإعادة صياغة كتابة التاريخ الحضرمي.
أما ثانيهما: فمخصّص لإبراز أهم المراجع والدراسات الحديثة، وقد جعلها في ثلاثة أصناف بالاستناد إلى محاور اهتمامها، مقدِّمًا لكل صنف منها بمقدِّمة تناولنا فيها أهمية ذلك الصّنف وأبرز ملامحه والمنهج الغالب في تأليفه، والنتائج التي انتهى إليها فضلًا عمّا كُتِبَ بحقه من دراسات نقدية إن وُجِدَت. ولقد اختلفت مباحث الفصول إلى حدٍّ ما في عددها وحجمها، تَبَعًا لوفرة أو ندرة المصادر. كما حَكَمَتْها بعضُ القواسم المشتركة مثل التمهيد والخاتمة، والملاحق من خرائط ووثائق، وإعداد بعض القوائم ذات العلاقة.
ونظرًا للعلاقة التي تربط بين تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده فإنّه لا يمكن معرفة كثير من الظواهر التاريخية اللاحقة وتفسيرها إلا من خلال سبر أغوار ما سبقها. لذلك وسم الباب الأول بـ “حضرموت من قبيل الإسلام حتى ظهوره” خُصّص الفصل الأول “للإطار التاريخي” ألقى الضوء على الأوضاع السياسية وما شهدته بلاد العرب الجنوبية من أحداث داخلية متمثلة في التنافس والصّراع الدّيني والسّياسي وما نجم عنه من تدخل قوى خارجية أجنبيّة؛ حيث قدم الأحباش من الغرب لمؤازرة معتنقي الديانة المسيحية، والفرس من الشرق لمعاضدة سيف بن ذي يزن، ومن ثمة دخول تلك القوى وأنصارهما في صراع بهدف السيطرة على المنطقة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومقدرتها الاقتصادية، وتداعيات ذلك الصراع على حضرموت. وقد أبرز المؤلف في هذا المنحى أهمّيّة تلك الأوضاع بوصفها أحد الأسباب الموضوعية، التي أدت إلى تقسيم بلاد العرب الجنوبية إلى كيانات قبليّة صغيرة ومن ثمّ تهيئتها لتقبّل الدعوة الإسلامية.
كما ركّز اهتمامه في هذا الفصل على دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مبيِّنًا قدر الإمكان أثر الخصائص الجغرافية والطبيعية في توجيه المنطقة نحو الزراعة والتجارة، ومدى انعكاس ذلك على البنية الإجتماعية، وما ترتّب على ذلك من آثار أدّت إلى تصدُّر حضرموت مكانة مرموقة وسط أمم العالم القديم وشعوبها. كما تطرّق هذا الفصل إلى المعتقدات الدينية التي عرفتها قبائل المنطقة سواءً كانت وثنية أم سماوية، وأثر ذلك في تهيئة الأرضيّة لتقبُّل الإسلام.
أما الفصل الثاني فقد تناول المصادر والمراجع التي يمكن الاعتماد عليها لدراسة فترة قبيل الإسلام. فتمّ أولاً تقسيم المصادر إلى خمسة أصناف:
كان الأوّل منها يتناول الآثار والنقوش من حيث أهميّتها وموقعها في المجاميع التي عُنِيَتْ بها. وقد أوضح المؤلِّف أهمَّ الجوانب التي طرقتها مبرزًا نماذج منها. ثم عرّج على الآثار موضحًا عددًا من المواقع التي تمّ استكشافها، وما حوته من مخلّفات ماديّة قديمة ألقت الضّوءَ على بعض الجوانب الحضارية والتاريخيّة لحضرموت العتيقة، ومدى تأثّرها بالحضارة السبئية، فضلًا عن بروز بعض الآثار اليونانية فيها.
أما الصّنف الثاني فقد خصص لدراسة الكتابات الدينية التي تمثلت في المصادر اليهودية والإسلامية. فعلى الرغم من قلّة ما تقدّمه هذه الأخيرة من معلومات عن هذه الفترة من تاريخ حضرموت فإنّه لا يمكن تجاوزها خاصة فيما يتعلّق منها بالنواحي العامّة التي تناولت علاقات العرب بغيرهم من شعوب وأمم العالم القديم. فضلًا عن تناول بعض المظاهر الروحية الاجتماعية والاقتصادية للمجموعات العربية قبيل الإسلام.
وقد عُنِي الصنف الثالث بدراسة المصادر الكلاسيكية اليونانية والرومانية التاريخية منها والجغرافية ليكشف عن المظاهر الأولى لاهتمامات أولئك المؤلفين بالمنطقة، ومدى تطوُّر معارفهم عنها والجوانب التي حظيت باهتمامهم، وتقييم عطائهم العلمي ومقارنته بما تم الكشف عنه من نقوش وآثار وبما ورد في المصادر الأخرى أينما تمكّن الباحث من ذلك.
أمّا الصّنفانِ الرّابع والخامس ـ المصادر الإسلامية ـ حاول المؤلِّف أن يسوق أهمّها بشقّيهما الإسلامي العام والإقليمي الخاص، وهي بالإجمال مصادر نادرة ومحدودة الفائدة. غيرَ أنّ المؤلِّف لم يتجاوزها نظرًا لِمَا اشتملت عليه من إشاراتٍ عامّة تتعلَّق بالحياة العربية قبيل الإسلام.
لقد جاء القسم الثاني من هذا الفصل ليتناول أهمّ المراجع والدراسات الحديثة؛ حيث تمّ التطرّق إلى بدايات الاهتمام الأوروبي بالكشف الأثري في حضرموت عبر مرحلتين، كانت الأولى ثمرة للجهود على مستوى الأفراد والحكومات الأوروبية، بينما كانت المرحلة الثانية نتاجًا لجهود متّصلة ومشتركة أوروبية ويمنية. أسفرت كلتا المرحلتين عن قيام عدد من الرحلات والبعثات إلى المنطقة، فتمّت الإشارة إليها ورصد أهمّ نتائجها كما أشار إلى أهمّ الدراسات المعاصرة.
أما الباب الثاني تعلقّ بدراسة “حضرموت من صدر الإسلام حتى العهد الأيوبي”، وهي الفترة التاريخية الممتدّة منذ بعث النّبي إلى سنة 569 هـ/ 1174م وقسم على فصلين: تناول الأول منها الإطار التاريخي العام للباب بشكل موجز، فرصد الأحداث التي شهدتْها حضرموت، وانعكاس صداها في المصادر؛ حيث تم تسليط الضّوء على حضرموت في العهد النّبوي والكشف عن علاقة النبي صلّى الله عليه وسلّم بقبائل المنطقة وتوجيه الدعوة لها، وموقفها منه، وأثر إنجازاته في المدينة وبالتالي إرسال الوفود، والنتائج المترتّبة على ذلك.
كما عُنِي هذا الفصل بدراسة حضرموت في عهد الخلفاء الراشدين، ووقف عند أهمّ منعطفاته خاصّة “رِدَّة” القبائل العربية. فرصد أسبابها وأثرها في ارتداد قبائل حضرموت وموقف المدينة من ذلك والنّتائج المترتّبة عليها. ثمّ تطرّق إلى أهمّ الأحداث التي شهدتها حضرموت في العهد الأموي من تسرّب للمذهب الأباضي وتبنّي قبائل له، والعوامل التي ساعدت على انتشاره، وعلاقاتهم بأباضية عُمَان والبصرة، ونجاح إمامهم في الظّهور وتمكّنه من الاستيلاء على اليمن وبعض مدن الحجاز، ثمّ موقف الخلافة الأموية منه، فالقضاء على الكيان الجديد.
كما تناول هذا الفصل دخول حضرموت تحت النّفوذ العباسي، ثمّ تمرّد قبائل المنطقة على عاملهم، وانقلاب أباضية حضرموت عليه، وما رافق ذلك من حملات عسكرية انتقامية بهدف استئصال المذهب من المنطقة.
وكانت آخر محطّات هذا الفصل علاقة حضرموت بالدويلات المستقلة في اليمن، التي امتدَّ “نفوذها” إليها، مثل: الزيادية واليعفرية والصّليحية، وما ترتّب على ذلك من نتائج أسهمت في تفكيك المنطقة إلى كيانات محلّية قبليّة، اتخذت من المدن الهامّة عواصم لها، ودخولها في صراعات حادّة.
أمّا الفصل الثاني فقد تناول أهمّ ما تعلّق بدراسة الفترة الزمنية، التي يعالجها الباب من مصادر، فتمّ تقسيمها إلى مجموعتين: الإسلامية واليمنية، وجَرَتْ دراستها في ستّ وحدات هي: المؤلّفات التاريخيّة العامّة والخاصّة، وكتب السّيرة، والطّبقات، والتّراجم، والأنساب، والكتب والمعاجم الجغرافية بما فيها اليمنية. وقد تمّ ترتيبها بحسب موضوعاتها وعرضها فدراستها وفق سنوات وفيات مؤلفيها. كما تمَّت الإشارة إلى أبرز المراجع والدراسات الحديثة التي تناولت الفترة الزمنية التي يعالجها الباب.
أما الباب الثالث الموسوم بـ ” حضرموت من الحضور الأيوبي حتى قيام الدولة الكثيرية” فهو يغطّي الفترة الواقعة بين 569 هـ – 926 هـ/ 1174م- 1520م، كُرّس الفصل الأول منه “الإطار التاريخي” للغزو الزنجبيلي لحضرموت وموقف سكّانها منه، ثم خروج طغتكين إليها وفتحُها صلحًا، كما تمت الإشارة إلى استقطاع المسعود بن الكامل حضرموت لصالح أميره عمر بن مهدي، ووقوف القبائل ضدّه ثمّ القضاء عليه، كما أشار الفصل إلى اتصال الرسوليين بحضرموت ساحلها وواديها، وكذا محاولة أمير ظفار سالم بن إدريس الحبوضي توسيع مملكته ومحاولته الاستيلاء على حضرموت، ومن ثم اصطدامه بالرسوليين فيها، هذا بالإضافة إلى محاولة أمراء الشحر”آل إقبال” لاستعادة ولايتهم عليها، كما تطرّق الفصل إلى ظهور إمارة آل بادجانة في حيريج ومحاولاتهم الاستيلاء على عدن، ومن ثم خروج الطاهريين إلى مدينة الشّحر وضمّها إلى دولتهم، وإنابة الكثيري فيها، وبالتالي جهود هذا الأخير في بعث أسس الدولة الكثيرية الأولى واصطدامه بالقوى المحليّة، واستغلاله الظروف المتردِّية التي يمر بها الطاهريون، للاستحواذ على الشّحر.
أما الفصل الثاني المعني بدراسة المصادر والمراجع والدراسات الحديثة، فقد جرى في القسم الأوّل منه تقسيم تلك المصادر إلى ثلاث مجموعات هي: العربية الإسلامية واليمنية، وأخيرًا المحليّة. ولئن كنّا قد قدّمنا للمجموعتين الأوليَيْنِ في الباب الثاني، فقد تمّ مباشرة تناول بقية ما لم يذكر من المصادر التي تخصّ هذه الفترة. ولمّا كان المؤلف قد أجّل الحديث عن المصادر المحلية الحضرمية إلى هذا الباب فقد تمّت دراستها بشيء من التّفصيل؛ حيث جرى تقسيمها إلى مجموعتين: هي المصادر الأثرية أوّلًا، ثم المصادر الكتابية ثانيًا. فالأولى على الرغم من حداثتها فإنّ المؤلف لم يتجاوزْها؛ إذ أشار إلى خطوطها العامّة، مع بيان أهميّتها، وأصنافها وما تنفرد به من معطيات بشأن تاريخ حضرموت في العصر الإسلامي الوسيط. أمّا المصادر الكتابية فقد دعتِ الباحثَ الضرورة إلى الإشارة قبل تناوُلِها إلى بعض القضايا ذات الصّلة، مثل: الحركة العلمية والثقافية في حضرموت، وكذلك المذاهب الدينية والفكرية، والإنتاج العلمي والأدبي. كل ذلك بهدف الكشف عن أسباب تأخّر الكتابة التاريخية في هذه الرقعة من الأرض، وتبيين العوامل التي أثّرت فيها، إضافة إلى التّعرُّف على الواقع الاجتماعي والفكري الذي أفرز تلك الكتابات.
لقد تم تصنيف تلك المصادر إلى ثلاثة أصناف هي:
الأوّل :المصادر التاريخية الأساسية.
الثاني: كتب السير والتراجم والطبقات.
الثالث: فقد ضمّ مصادر متنوعة من حيث موضوعاتها وأهميتها. وذلك بالاستناد إلى محاور اهتمامها، وكذلك أهميتها بالنسبة لموضوع الدراسة؛ حيث جرت دراسة هذه الأصناف الثلاثة في إطارها العام مع الإشارة إلى ما اتسمت به من ملامح عامة، ثم تناول كلَّ صنفٍ على حدة، معرِّفًا به، مع التنويه بأهمّيته بالنّسبة للفترة وما تناول من موضوعات، وما غلب عليه من منهج في تأليفه، ثم درس كل مؤرِّخ ومساهمته في هذا الصنف بشكل مستقل، وبالمنهج نفسه ثم تناول الصنفين الأخيرين.
أما القسم الثاني من هذا الفصل فقد تمّ فيه تناول المراجع والدراسات الحديثة، فجرى تقسيمها على ثلاثة أصناف: الأوّل؛ هو تلك التي اتخذت من تاريخ حضرموت أو بعض من جوانبه محورًا أساسًا لها، في حين تناول الثاني تلك التي اهتمّت ببعض جوانب تاريخ حضرموت من خلال وقائع التاريخ اليمني الوسيط أو بعض من جوانبه. بينما اهتم الصنف الثالث بتاريخ حضرموت من خلال الدراسات الإسلامية العامّة. وهذه الأصناف الثلاثة تم تقويمها في إطارها العام من حيث المواضيع التي عالجتها والمنهج المستخدم في دراستها، وما انتهت إليه من نتائج، إضافة إلى ما جاء بصدد البعض منها من دراسات نقدية. ثم عمد إلى رصد أهمّ تلك الدّراسات حسب أصنافها. وقد حرص الباحث أن يمهِّد ويختم كلَّ باب من أبواب رسالته, وأن يعمل على تحرير خاتمة عامة للرسالة قدّم فيها أهم النتائج التي خرج بها من دراسته.
وقد دعَمَ الباحث رسالته ببعض الخرائط ووضعها في أماكنها المناسبة من الدراسة، كما شفعها بتسعة ملاحق ذات صلة بأبواب البحث، ويحيل القارئ إليها كلّما دعته الحاجة إلى ذلك. وقد جاءت في أسماء الوافدين على الرسول صلّى الله عليه وسلّم من أفراد قبائل حضرموت مثل كندة وبطونها وحضرموت وجُعفي وغيرها، كما تضمنت تلك الملاحق كتب الرسول صلّى الله عليه وسلّم لزعماء قبائل أرض حضرموت وأفرادها، وقد أتى على ذكر كل الروايات التي جاءت بها تلك الكتب، ولم تفته الإشارة إلى الرسائل التي كان قد بعث بها الخليفة الراشدي أبوبكر الصديق إلى زعماء كندة أثناء”ردَّتهم”.
لقد أنجز الباحث دراسته بالاستناد إلى مجموعة من المصادر والمراجع العربية والمعرَّبة، تشير قائمتها بتقسيمه لها إلى عدّة مجموعات هي: المصادر العربية وتتكون من الكتب المخطوطة والمطبوعة، ثمّ المراجع العربية والمعرَّبة زيادة على البحوث الجامعية غير المنشورة، وفي آخرها المراجع والدراسات الأجنبية غير المعرّبة. وتسهيلًا لوصول القارئ إلى مبتغاه من الدراسة فقد زوّدها بستة فهارس جاءت في الأعلام والفرق والجماعات والقبائل, فضلًا عن فهرس الأماكن والملاحق والخرائط , فضلًا عن فهرس المواضيع .
[17] – ابن النديم( محمد بن إسحاق): الفهرست ، تحقيق،إبراهيم رمضان،دار الفتوى، بيروت،ط1/1994م.
[18] – الحلوجي( عيد الستار): مدخل لدراسة المراجع ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة،ط/1991م،ص85.
[19] – خليفة (.عبد العزيز شعبان) :الببليوجرافيا أو عِلم الكتاب دراسة في أصُول النظرية الببليوجرافية وتطبيقاتها النظرية العامة، الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط2/1998م ،ص ص 127- 131.
[20] – بنين ( أحمد شوقي ):دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ،ط/1993م ،ص 173.
[21] – سيرجنت (آر.بي) : حول مصادر التاريخ الحضرمي ، ترجمة : د. سعيد عبد الخير النوبان ، مطبعة جامعة الكويت ، د. ت، مقدمة المترجم ، ص 7.
[22] – للمزيد ينظر العمودي ( حسن صالح الغلام ) : حضرموت في الرسائل العلمية ، ماجستير ودكتوراه ، دار حضرموت للدراسات والنشر، المكلا،ط1/2010م.
[23] – بهذا الصدد ينظر : العقيقي (نجيب) : المستشرقون ، مصر ،دار المعارف ، ط 4 ,1980م ،ج2 ،ص141-142 ؛ الأحمري (عبد الرحمن عبدالله ) : المستشرق البريطاني روبرت برترام سيرجنت ،حياته وآثاره ،مجلة الدرعية ،فصلية محكمة ،السعودية ، ع 6-7 ،1999م ،ص ص226-213.
[24] – Serjeant¸( R¸B): “Materials For South Arabian history ¸ Notes on new MSS from hadramaut XIII(1950)‚P1.pp282-306. . In BSOAS Vol
وقد ترجم المرحوم د. سعيد عبد الخير النوبان هذا المقال ومقالات أخرى للمؤلف ذات الصّلة بمصادر تاريخ حضرموت إلى اللغة العربية ونشرها بعنوان “حول مصادر التاريخ الحضرمي” مرجع سابق.
[25] – Serjeant¸( R¸B): “Materials For South Arabian history ¸ Notes on new MSS from hadramaut XIII(1950)‚P11.PP518- 601. . In BSOAS Vol
[26] – Serjent:”Historiography of hadramawt‚in Studies in Arabian and Civilisation. London‚1981‚pp‚242-245.
[27] – نشره المركز اليمني الأبحاث الثقافية،جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،طبع بمطابع مؤسسة 14أكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،عدن،1975م.
[28] – نشره المركز اليمني للأبحاث الثقافية،المكلا،1979م.
[29] — باحاج(أحمد سعيد): الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت،جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،مكتبة الجسر،جدة،ط1/1988م
[30] – المرجع نفسه ،ص10.
[31] – روديونوف ( ميخائيل ) : الدراسة الإثنوغرافية لحضرموت ،ترجمة : سرجيس فرانتسوزوف و د.عبد العزيز جعفر بن عقيل , مجلة آفاق الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين م/حضرموت,ع8 /1985م,ص ص31-43؛ وينظر أيضا كتاب المؤلف نفسه الموسوم بـ عادات وتقاليد حضرموت الغربية العام والمحلي في الثقافة السلالية” ترجمة: د.علي صالح الخلاقي ، إصدارات دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، ط1 / 2002 م , ص ص 15 – 29 .
[32] – المرجع نفسه ,ص8. (مقدمة المترجم )
[33] -باحاج(د.عبدالله سعيد): حضرموت في المؤلفات العربية والأجنبية بحث في تطور المعرفة الجغرافية والتاريخية خلال خمسة وثلاثين قرنا (1500- 2004م), سلسلة صنعاء عاصمة الثقافة العربية2004م،كتاب كل أسبوع-37،دار حضرموت للدراسات والنشر،ط1/2004م.
[34] – باحاج(احمد سعيد): المرجع السابق.
[35] – باصرة (د,صالح علي ) : في كتاب دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة , عمان , ط1 /2001م – 14 2هـ , ص ص 7 – 45 .
[36] – المرجع نفسه,ص17.
[37] – الغلام( د. حسن صالح):مرجع سابق.
[38] – نوه المؤلف بأنه عند موافقته السنوات الهجرية بالسنوات الميلادية أتضح له بأنها تأتي بين سنتين ميلاديتين في أغلب الحالات لذلك أثبت السنة الميلادية الثانية إشارة إلى موافقتها للسنة الهجرية المعنية دون كتابة السنة التي قبلها رغبة منه في الاختصار.