كتابات
عمر عبدالله حمدون
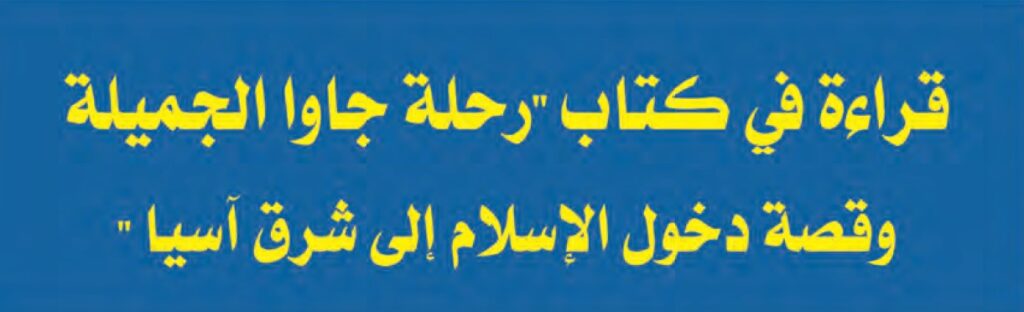

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 50
رابط العدد 6 : اضغط هنا
الكتاب الذي أنا بصدد عرض أهمِّ محتوياته للقارئ الكريم، يدخل ضمن مؤلفات أدب المذكرات أو الرحلات ، فهو عبارة عن تسجيل لذكريات رحلة قام بها المؤلف الأديب والمؤرخ والفقيه والسياسي والشاعر السيد صالح بن علي الحامد إلى بلاد جاوا … ويبيّن المؤلف في المقدمة الطويلة للكتاب أنه قد زار جزيرة جاوا ثلاث مرات: الأولى كانت عام 1346، والثانية عام 1350، والثالثة كانت عام 1354 هجرية.
ويستطرد السيد الحامد في حديث المقدمة ذاكرًا الأسباب التي دعته لتأليف هذا الكتاب قائلًا :
( وقد عنّ لي عند هذه الزيارة الأخيرة أن أكتب ما تيسّر لي كتابته عن هذه الجزيرة الجميلة وتاريخها وسكّانها وهجرة العرب إليها وتطوّرهم، ووصف ما يمكنني وصفه من محاسن هذه الجزيرة وعجائبها ومتنزّهاتها تعريفًا لقرّاء العربية بهذه البلاد، واطّلاعًا لمن عسى أن يجهل الكثير عن هذه الجزيرة، وأحوال أبناء الضاد بها، وليكون ما أكتبه سجلًّا لذكرياتي عنها …) ص9.
الكتاب صدر في طبعته الأولى عام 1423هجرية، الموافق عام 2002 م عن دار تريم للدراسات والنشر بحضرموت، وهو كتاب فيما احتواه من معلومات يكشف للقارئ جانبًا مهمًّا من حياة الكاتب الشخصية، ذلك الجانب هو الحياة الخاصة والهانئة التي عاشها السيد صالح بن علي الحامد، وهي حياة أثّرت إيجابيًا فيما أبدعه من أدب وشعر ونثر، وتأكيدًا لهذه التأثيرات كتب الأستاذ عبد القادر محمد الصبان في كتابه “الحركة الأدبية في حضرموت” عن العوامل التي أثّرت في شعر الحامد وأدبه وعدّد منها: ( 1- الحياة الخاصة الهادئة .. 2- هجرة الحامد إلى أندونيسيا واستمتاعه بالمناظر الخلابة وجمال الطبيعة وعيشته المترفة نسبيًا ) ص 158.
وفي ظني أنَّ الكتاب يُـعَـدُّ أيضًا نموذجًا فريدًا، يعطينا مجمل الجوانب الإبداعية والعلمية التي كتب فيها وأبدع المؤلف السيد صالح الحامد؛ إذ نجد فيه لغة الأديب الشاعر وأساليبه الأدبية في الكتابة، ونجد فيه كذلك معلومات المؤرخ، وخبرة الجغرافي، ومعرفة واطلاع المثقف بالسياسة وأحوالها، كما نجد فيه تراجم شخصية لعدد من العلماء والفقهاء والتجار الحضارمة، من الذين برزوا وتميّزوا، وكانت لهم بصماتٌ في تلك البقاع الملاوية، ونقرأ فيه أيضًا مجموعة من القصائد ” المناسباتية “، التي صاغها المؤلف في أثناء تجواله في مدن تلك الجزر الخلابة.
يمكن تقسيم محتويات الكتاب على قسمين رئيسين: الأول؛ ضمّ مقدمة طويلة كتبها المؤلف نفسه، وغطت مساحة 44 صفحة من صفحات الكتاب البالغة 217صفحة، تضمّنت المقدمة الطويلة حديث المؤرخ والجغرافي والأديب عن هذه الجزر، ومنها جزيرة جاوا، وعلاقة الحضارمة بها، معرّفًا بمكانة هذه الجزر في العالم، وما آتاها الله من حسن الموقع وخصوبة التربة وجمال المنظر حتى أصبحت كما قال: ( من أهمّ بقاع الدنيا وأشهرها، وذلك راجع لجمالها ولخصوبتها ولكثرة ما تنتجه من المواد الضرورية ).
في المقدمة يتحدّث المؤلف أيضًا عن تاريخ دخول الإسلام إلى هذه الجزر، وقد جعل المؤلف عنوانًا فرعيًّا للكتاب وهو قصة دخول الإسلام إلى شرق آسيا، وهنا يوضح السيد الحامد رؤيته كمؤرخ، لما حدث من إخفاء المعلومات أو من تشويه متعمّد لتاريخ دخول الإسلام إلى هذه البقاع، وما سأتعرّض له في هذه القراءة للكتاب يتعلق في الغالب الأعمّ بما جاء في المقدمة الطويلة للكتاب.
أمّا القسم الثاني من الكتاب فهو عبارة عن تدوين شخصي ليوميات المؤلف بشكل تفصيلي دقيق، ابتداء بيوم انطلاق الرحلة في 19 أكتوبر 1935م، مرورًا بتسجيل أدقِّ تفاصيل الرحلة ذاكرًا اليوم والتاريخ وزمن التحرّك وساعة الوصول والأشخاص الذين التقى بهم, وانتهاءً بالحديث عن عودته إلى حيث انطلاقته في البداية.
وفي تدوينه لأيامه في جاوا في هذا الجزء من الكتاب نجد تعريفًا بشخصيات حضرمية أغلبها علوية, وما قام به هؤلاء من جهود دعوية وتعليمية وحتى تجارية أيضًا .. كما نجدُ تسجيلًا لانطباعات المؤلف من خلال مشاهداته وزياراته للمدن المختلفة, معرّفًا بها، وما تنتجه من مواد خام وغيرها من صادرات، كما يتضمن هذا القسم من الكتاب القصائد الشعرية التي قالها في المناسبات التي يُدعَى إليها، سواءً كانت أفراحًا أو كانتْ أتراحًا، هذه اليوميات التفصيلية غطّت الصفحات من صفحة 44 حتى صفحة 217 نهاية الكتاب، كما ضمّ الكتاب في صفحاته الثلاث الأخيرة عددًا من الصور التذكارية التي التُـقِـطَتْ في أثناء الرحلة.

وقد بَـدَرَ إلى الذهن سؤال في أثناء تنقّـلي بين صفحات الكتاب حين سحرتني لغة الكتابة الوصفية .. السؤال يقول: هل يستطيع الشاعر حين يكتب نثرًا أن ينفصل عن شاعريته وعن خيال الشاعر ؟!
ولم تمكث بي الحيرة طويلًا للإجابة عن هذا السؤال؛ إذ وجدتُ فيما صاغه الكاتب من أسلوب، وما انتقاه من كلمات حين كان يصف مشاهداته كلها، تكشف عن أن المؤلف الأستاذ الحامد هنا في كتابة هذا يكتب نثرًا بخيال شاعر وقلم أديب، وبالتالي من الاستحالة – في ظني – أن يتخلّى الشاعر عن ذاته الشاعرة وخياله المبدع حين يكتب النثر.
في هذا الكتاب نلمس لغة الشعر وخيال الشاعر منذ البدايات الأولى لصفحاته حين يذكر المؤلف تفاصيل سير رحلته الثالثة إلى جاوا, فيجعلك – أيها القارئ للكتاب – تبصر المشاهد التي يصفها على حقيقتها لكأنك مرافق له في رحلته، أو لكأنك تشاهد فيلمًا سينمائيًا أمامك، من خلال ما يرسمه قلمه بالكلمات من مناظر أو حركات أو مواقف .. نقرأ مثلًا ساعة وقوفه على الباخرة قبيل تحرُّكها، ثم كيف يصف منظر البحر حين بدأت السفينة بالتحرك: ( وقفتُ على سياجها ناظرًا إلى صفحة البحر فإذا هي بدت خلف الباخرة تتكسر وتبيضُّ من الرغوة حتى كأنها صفحة زبرجد أصابها تهشم من صدمة، وأدركت أن الباخرة تحركت … ) ص 10.
ثم نقرأ كيف يصف منظر مجموعة من الاصدقاء على الشاطئ وهم يودعونه وهو على ظهر السفينة: ( فنظرتُ فإذا الرصيف وعليه بعض المودِّعين يبتعد فكأنما يجري بهم هاربًا منا على كل عكس الواقع … ) ص10.
كما نقرأ في المقدمة أيضًا وصف المنظر الطبيعي والباخرة تبحر بهم عباب البحر: ( وكان المنظر رهيبًا رائعًا كانت الشمس قد مالت إلى الغروب لولا أنْ حالت دونها طبقات السحب ذات الألوان … إلخ ).
وخلاصة القول في هذا الجانب إنه لا يكاد يخلو أي سطر من سطور مقدمة الكتاب من ذلك الوصف المشبع بالصور البيانية الجميلة والمتحركة، لدرجة أنَّ القارئ – كما أشرت – كأنه مرافق لصاحب الرحلة منذ ساعة انطلاقها.
وإذا كُـنَّـا قد تعرفنا في الأسطر السابقة على جزئية بسيطة جدًّا ممَّا جاء في المقدمة من أسلوب أدبي وبلاغي، عَـكَـسَ جانبًا أدبيًّا لَـدَى مؤلِّف الكتاب كونه ليس مجرَّدَ كاتب, بل أديب أيضًا فإننا في الأسطر الآتية سنتعرف على جانب آخر من جوانب شخصية السيد صالح بن علي الحامد، وأعني بذلك أنه مؤرِّخ أيضًا، ولعَـلَّ أبرز ما كتبَه في مجال التاريخ هو كتابه المسمَّى ” تاريخ حضرموت “، الذي صدرت طبعته الأولى عام 1968م، والثانية منه صدرت في العام 2002م.

ما يهمُّنا في هذا الجانب من شخصية المؤلف هو حديثه في مقدمة الكتاب عن تاريخ دخول الإسلام إلى جزر الهند الشرقية – أندونيسيا وماليزيا وجاوه وما جاورها – فقد بدأ كلامه بالقول: ( يخفى على كثير من الباحثين كيف ومتى دخل الإسلام إلى جزر الهند الشرقية، ونحن نعترف بأن الغموض كان سائدًا على ذلك، غير أنّه لم يكن طبيعيًّا ولكن هناك أيدٍ خفية تثيرُ الغُبارَ حول هذا الأمر محاولة جهدها إخفاءه وتجهد أن تلقي أمام الأعين ستارًا كثيفًا دون الحقيقة في هذا الشأن، ذلك بإنشاء الدروس وانتحال الروايات التي تبعث على الارتياب في كل ما يُروَى عن دخول الإسلام إلى هذه الجزر، كل ذلك علّها توفق إلى ستر الحقيقة وأن تسدل على ما تقتضيه الوثائق المحفوظة والآثار المعروفة ذيل العفاء ولكن هيهات ) ص17.
وفي ما قاله السيد الحامد في الفقرة السابقة يذكِّرنا بحالة مشابهة لها من حيث قيام بعض الأيدي بإخفاء أو تشويه حقائق ذات صلة بحضرموت وتاريخها وتراثها الفكري والعقائدي بشكل خاص، من بعض حالات الإخفاء تلك، ما ذكره المؤرخ السيد علوي بن طاهر الحداد حين قال في كتابه جني الشماريخ: ( إنَّ الأخلاف وجدُوا في سيرة الأسلاف ما يُنكِرُونَه عليهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها ).
فالتشابه بين الحالتين يتمثل في قيام بعض الأيدي بإخفاء حقائق تاريخية لها علاقة بحضرموت وأهلها وتاريخها، وهو إخفاء أو تشويه يتم بتعمُّد وبقصد.
أما أوجه الاختلاف – في رأيي – بين حالتي الإخفاء فتكمن في أمرين: الأول؛ إنَّ ما ذكره السيد صالح الحامد في كتابه هذا يتعلق بعملية إخفاء لحقائق لها ارتباط بالحضارمة وتاريخهم خارج حدود بلدهم – حضرموت – أمَّا ما ذكره السيد علوي بن طاهر الحداد فهو أمر يتعلَّق بإخفاء حقائق ذات صلة بتاريخ حضرموت وتم الإخفاء في داخل حضرموت من قبل من ينتمي إليها ” الأخلاف”.
الأمر الثاني؛ من أوجه الاختلاف هو أنّ السيد الحداد جعل ” الأخلاف ” هم المتهمين بالإخفاء أو التشويه .. أما السيد صالح الحامد فلم يعيِّنْ مَنْ هُـمْ هؤلاء بالتحديد الذين قاموا بهذا العمل بقوله: ( أيدٍ خفية ) التي تحاول جهدها إخفاء دور الحضارمة وجهدهم في نشر الدعوة الإسلامية في تلك المناطق الملاوية ..!
وهنا يبرز سؤال بشكل طبيعي: لماذا تُـسْتَهدَفُ بعضُ الحقائق التاريخية ذات العلاقة بحضرموت وأبنائها بالتشويه والإخفاء وبطريقة مقصودة أو متعمدة ؟!
إن الاجتهاد في الإجابة عن هذا السؤال يتطلب بحثًا آخر ليس هنا مكانه، كما أنه بحث آخر، لا أدَّعي أنني بقدراتي المتواضعة في جانب المعلومة التاريخية، أقول لا أدعي بأنني مؤهل للخوض فيه قدر ما هو بحث له ناسه ورجاله من باحثين ومختصين في التاريخ وبالأخص تاريخ حضرموت ..!!
نعود إلى ما كتبه السيد صالح الحامد في كتابه هذا عن دخول الإسلام إلى هذه الجزر، فبعد أن ذكر ذلك الغموض وتلك الأيادي الخفية استطرد قائلًا: ( المعروف أن دخول الإسلام إلى جزر الهند الشرقية كان على أيدي العرب …) ص17.
ويدلل على ذلك مستندًا إلى ما كتبه الأمير شكيب أرسلان في تعليقاته على حاضر العالم الإسلامي نقلًا عن علماء هولندا – الدولة المستعمرة للمنطقة آنذاك – وغيرهم من مؤرخين أوربيين ووطنيين، وأيضًا ما ذكره الرحّالة الإيطالي ماركو بولو الذي أمضى في شاطئ سومطره الشمالي مدة من الزمن نقلًا عن السكان من أنهم قد اعتنقوا الإسلام بواسطة التجار العرب، ويتوسع السيد الحامد في تبيان كيفية اعتناق بعض أمراء وسلاطين تلك المقاطعات للإسلام عن طريق ( مبشرين إسلاميين انتهزوا الفرصة للدعوة إلى هذا الدين بالتي هي أحسن ) ص18.
ثم يتساءل المؤلف الحامد قائلًا: ( مَنْ هم أولئك العرب ؟ وإلى أيِّ أصلٍ وبلدٍ ينتسبون ؟ وفي أيِّ عصرٍ ابتدأ هذا الدين الأقدس يسري بنوره في تلك الأصقاع ؟ ).
وقبل أن يجيب عن أسئلته هذه أوضح: أولًا؛ إنّ المؤرخين ذكروا أن الإسلام قد دخل سومطره من عهد قديم أي منذ حوالي القرن السابع الهجري ثم علق على ما أورده العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي في تاريخه المسمّى ” نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ” من أنّ العلويين الفارين من الأمويين والحجاج قد استوطنوا بالجزيرة المعروفة بهم، وكان تعليق المؤلف الحامد أنه نفى أن يكون هؤلاء العلويون قد فرُّوا من بني أمية أو الحجاج، بعد ذلك يعود إلى الإجابة عن أسئلته المطروحة بالقول: ( إنّ أولئك العرب الطامحين الذين أدخلوا الإسلام إلى جاوا وما حولها هم السادة آل عظمت خان العلويون والحضرميو الأصل، خرج جدهم عبد الملك بن علوي عم الفقيه المقدم في أواخر القرن السادس الهجري من قَسَم عند ثورة الخوارج وهجومهم على تريم بحضرموت في تلك الآونة وقصد الهند هو وجماعة من السادة العلويين وانتشرت ذريته هناك، ثم يذكر أنّ من هؤلاء الأبناء مَنْ فرَّ منهم إلى جاوا ومنهم مَنْ نزلَ غيرَها بعد أنْ ثارَت الفتن ببلاد الهند ) ص20.
خلاصة القول إن هؤلاء العلويين القادمين من الهند هم الذين نشروا الإسلام في جزر الهند الشرقية – الملايو -.
ويدلل السيد الحامد على ذلك بقوله: ( إنّ هجرتهم قائمة على الدعوة التبشيرية بالإسلام، وهي هجرة لم يكن مبدؤها من أوطانهم وإنّما كانت من مهجرهم الأول وهو الهند ).
هكذا يورد المؤلف معلومة ربما لم تكن معروفة على نطاق واسع من أنّ مَنْ نشر الإسلام في البقاع الملاوية هم الحضارمة الذين قدموا من الهند، وليس الذين وفدوا إليها مباشرة من حضرموت.
وعلى الرغم من قيمة المعلومات التي يوردها المؤلف السيد صالح الحامد عن السادة آل عظمت خان ، وخروج جدهم عم الفقيه المقدم من حضرموت الى الهند … ومن ثم نشرهم للإسلام في جزر جنوب شرق آسيا … أقول على الرغم من ذلك فإن السيد الحامد لم يشر في هامش الكتاب إلى أيّ مرجع أو مصدر تاريخي “مطبوع او مخطوط” يستند إليه في إعطاء هذه المعلومة، واكتفى بالقول: ( فالمعروف أن أولئك العرب … هم السادة آل عظمت خان … إلخ ) ص20.
نعم … ما أورده المؤلف من معلومات في هذا الجانب قد تكون معروفة لديه كونه علويًّا – سيِّدًا – وأولئك هم سادة أيضًا، ومن هنا فهو الأعرف بهم وبتاريخهم، ولكن القارئ أو الباحث المهتم بالمعلومة التاريخية ومصادرها يهمُّه جدًّا المرجع التوثيقي، خاصة وأنّ الكتاب لم يتناول مذكرات رحلة قام بها المؤلف فحسب، بل وأيضًا تضمَّن بحثًا تاريخيًّا عن دخول الإسلام إلى الجزر الملاوية … بل إن العنوان الفرعي للكتاب ” قصة دخول الإسلام إلى شرق آسيا ” يؤكد هذا الجانب البحثي الذي تضمنه الكتاب.
من هنا يمكن القول بكل ثقة إنَّ هذا الكتاب يُـعَـدُّ مصدرًا من المصادر التي يعتمد عليها في معرفة دخول الدين الإسلامي وانتشاره في تلك الجزر، إضافة إلى ذلك يمكن القول أيضًا إنه يُعَـدُّ مرجعًا موثوقًا به لمعرفة أحوال وأوضاع العرب عمومًا ومنهم الحضارمة بشكل خاص في جزر الهند الشرقية في الفترة الزمنية التي تردَّد فيها المؤلف على تلك الجزر، وتأثيراتهم في واقع البلدان الملاوية وما وصلوا إليه من مكانة اجتماعية وتجارية وسياسية فيها.
أخيرًا أقول: ليس في النية إعطاء القارئ الكريم تلخيصًا شاملًا للكتاب، قدر ما أهدف إلى إعطاء لمحة تعريفية موجزة بالكتاب، وأهمّ محتوياته لافتًا الانتباه إلى أهميته كمرجع يرجع إليه الباحث والمختص والمهتم بتاريخ الحضارمة وهجرتهم إلى جنوب شرق آسيا وتأثيراتهم وأحوالهم في تلك البقاع الملاوية.
آمُلُ أنّني قد وُفِّـقْـتُ لِمَا هدفْتُ إليه من هذه القراءة للكتاب وعرضها للقارئ العزيز .. كما لا يسعني في الأخير إلَّا تقديم جزيل الشكر وكل التقدير لأخي العزيز الأستاذ غالب بن صالح الحامد ابن الفقيد مؤلف الكتاب، الذي خصَّني بنسخة منه فجزاه الله كل خير.