حضرموت في المؤلفات والدراسات الببليوغرافية العامة (2)
أضواء
د. حسن صالح الغلام العمودي
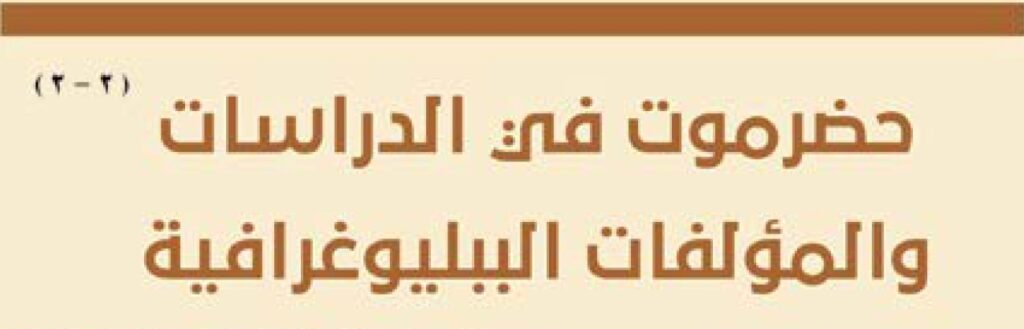
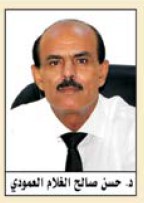
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 15
رابط العدد 7 : اضغط هنا
كنا قد تناولنا في العدد (السادس) من مجلة (حضرموت الثقافية) عدد من المؤلفات الببليوغرافية الخاصة بحضرموت، وفي هذا العدد نتناول جملة من المؤلفات الببليوغرافية العامّة التي حظيت بذكر متفاوت للإنتاج الفكري الحضرمي.
1- عبدالله محمد الحبشي:
له عدد من الأعمال الببليوغرافية الخاصة باليمن كتبها في فترات زمنية مختلفة منها:
– مراجع تاريخ اليمن[1].
– حكام اليمن المؤلفون المجتهدون[2].
– فهرست مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن[3].
– معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها[4].
– مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن[5].
مصنفات الحبشي السابقة الذكر كانت ولا زالت قبلة للباحثين في تاريخ اليمن الفكري والحضاري؛ ولذلك عوّل عليها كل أصحاب الدراسات العلمية والأدبية والتاريخية والإسلامية بكل أصنافها من علوم القرآن، والحديث، والسيرة، والتراجم، والطبقات وغيرها. كما اعتمد عليها جُل المشتغلين بالدراسات الببليوغرافية، بل لا توجد دراسة لم تستفد منها طالما وهي تنقب عن ما سطرته أقلام أهل العلم في مجالات المعرفة الإنسانية المتعددة. ومدونات الحبشي تلك إذا ما استثنينا كتابه (معجم الموضوعات…)، فـإن كتابه الأخير (مصادر الفكر…)، قد استوعب مجمل ما احتوته تلك الكتب من عناوين أساسية وأصيلة للإنتاج الفكري اليمني على كافة المستويات الشعبية والمثقفة، إضافة إلى أنه يهمنا في هذه الدراسة المعنية بتقصي المؤلفات الببليوغرافية العامة التي تناولت بعضًا من الإنتاج الفكري المتعلق بالحياة العلمية والفكرية والثقافية لحضرموت لذلك لا بدَّ من تناوله.
الكتاب موسوعة ببليوغرافية استوعب فيها المؤلف الإنتاج الفكري الخاص باليمن وحضرموت على مدى تاريخي طويل قرابة أربعة عشر قرنًا، وفيه رسم المؤلف خارطة جغرافية لذلك الإنتاج جاءت في (681 صفحة) من الحجم الوسط، وزّعها على عدد من المحاور؛ بحسب التقسيم الإسلامي المعتمد للفنون فجاءت على النحو الموالي:
1- علوم القرآن ومتعلقاته (ص ص11- 33).
2- علم الحديث (ص ص37- 79).
3- السيرة النبوية ومتعلقاتها (ص ص83- 89).
4- علم الكلام (ص ص93- 149).
5- الفقه وأصوله وعلم الفرائض (ص ص153- 268).
6- التصوف (ص ص271- 308).
7- الأدب (ص ص311- 363).
8- علوم اللغة والبيان والنحو (ص ص367- 396).
9- التاريخ (ص ص399- 472).
10- الـعلوم وتشمل: المعارف العامة، وعـلوم السياسة، ونظام الدواوين، وعــلم الفلك، وعلوم المساحة الحساب، والطب، والمنطق، وأدب البحث، والمناظرة، والزراعة، والكيمياء، والموسيقى، والملاحة، والفلسفة، (ص ص475- 503).
كما الحق تلك المحاور بقسم أسماه (مؤلفات حكام اليمن) وهو نفس الكتاب الذي سبق له نشره تحت عنوان (حكام اليمن المؤلفون المجتهدون)، وقدم له الأديب الأستاذ زيد بن علي الوزير.
وأخيرًا قائمة بمراجع الدراسة وفهرس للأعلام.
وقد سعى المؤلف إلى التمهيد والتعريف بالفنون الذي يتناولها، ثم رُتّبت مادته حسب الموضوعات، وجعل المؤلفين في ترتيب زمنيّ، وترجم لهم، وذكر أعمالهم مخطوطة أو مطبوعة أو مفقودة، وعرّف بمصادرهم. وقد ساق فيه من عرفتهم اليمن وحضرموت من الكتّاب للفترة التي يتناولها، واستحوذت على اهتمام المؤلف الإسهامات الفكرية للمؤلفين الحضارم في شتى فنون المعرفة الإنسانية وضروبها، فجاءت مبثوثة بين أقسام كتابه وفقًا والخط الذي رسمه المؤلف لنفسه. والكتاب على شموله وفائدته إلا أنّه لا يخلو من بعض الثغرات، فضلًا عن الأخطاء التوثيقية والمطبعية التي تنبه إليها غيرنا[6].
2- دليل الأطروحات الجامعية: ماجستير – دكتوراه في الجامعات الحكومية اليمنية للفترة من عام 1962- 2007م[7].
يعد هذا الدليل الأول من نوعه في اليمن، يهتم بحصر الإنتاج الفكري المتعلق باليمن الذي أجازته الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، فضلًا عن الجامعات العربية والأجنبية الأخرى.
وقد جاء في (903 صفحة) من الحجم الكبير، مقاس (21 × 28 سم)، اشتملت الصفحات الـ(22 الأولى) على تقديم ودراسة تحليلية وإحصائية للأطروحات الجامعية وفقًا والمنهج البيليومتري، مدعمة بجداول إحصائية حيث تمت الإشارة إلى الضبط الببليوغرافي للأطروحات، وكذا التحليل الزمني لها في الفترة المشار إليها سلفًا، ناهيك عن اللغات التي أنجزت بها تلك الأطروحات، علاوة على توزيعها بحسب إنتاجها في دول العالم، وأخيرًا الحقول العلمية والمعرفية التي غطتها تلك الأطروحات التي تمثلت في:
أولًا: العلوم الإنسانية والآداب واللغات وتشمل:
- اللغات (عربية + إنجليزية).
- – الآداب.
- – علم النفس.
- – الجغرافيا.
- – التاريخ.
- – دراسات إسلامية.
- – الفلسفة.
وقد أجيزت في هذه المجالات (1717) أطروحة، بنسبة (29,09%) من الإجمالي الكلي للأطروحات.
ثانيًا: العلوم الاجتماعية وتضم الموضوعات الآتية:
1- الإدارة العامة.
2- إدارة الأعمال.
3- التسويق.
4- البنوك.
5- التجارة.
6- المناهج التربوية والتربية المدرسية والإشراف التربوي.
7- علوم التربية.
8- العلوم الإسلامية.
9- الشريعة والقانون.
10- العلوم السياسية.
11- الإعلام.
وقد أجيزت في هذه المجالات (2312) أطروحة بنسبة (39,17%) من الإجمالي الكلي للأطروحات.
ثالثًا: مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا وتشمل المجالات الآتية:
1- إدارة نظم الحاسوب.
2- الزراعة.
3- الطب.
4- العلوم.
5- البرمجيات.
6- العمارة والفنون المعمارية.
7- الرياضيات.
8- الصناعة.
9- الفيزياء
10- الهندسة.
11- الجيولوجيا.
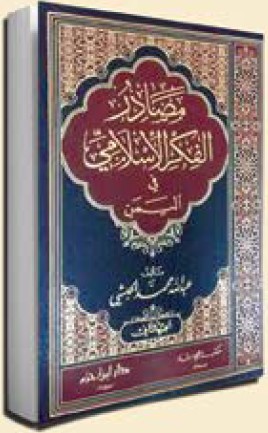
وقد أجيزت في هذه المجالات (1871) أطروحة بنسبة (31,74%) من الإجمالي الكلي للأطروحات.
كما حملت آخر صفحات مقدمة الدليل على تسع توصيات ومقترحات منها ما يتعلق بالمكتبة الوطنية اليمنية والمركز الوطني للمعلومات بشأن الأطروحات التي ما زالت في حوزة أصحابها سواء ما كان منها لدى أفراد أو مؤسسات علمية وأكاديمية مدنية أم مؤسسات عسكرية وأمنية، وضرورة التنسيق والتشاور مع تلك الجهات لتوثيقها وضبطها وإتاحتها للباحثين والدارسين. كما نوهت التوصيات بالجامعات التعاون مع المركز الوطني للوثائق للقيام باستنساخ الأطروحات الجامعية على شرائح مايكروفيش للحفاظ على حقوق الآخرين، بالإضافة إلى حفظها من الضياع والتمزق. كما أوصى الدليل كل جامعة يمنية بعمل ملخصات لما بحوزتها من رسائل جامعية، ومن ثمَّ إتاحتها على الإنترنت للاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين الجدد تفاديًا لعدم تكرار البحث في الدراسات.
لقد احتوى الدليل على ذكر (5902 عنوانًا)، جاءت مقسمة إلى قسمين: أول خاص برسائل الماجستير الذي بلغ عددها (4159 عنوانًا)، وجاءت بين الصفحات (25- 432)، وثاني خاص برسائل الدكتوراه التي بلغت عدد عناوينها (1743 عنوانًا)، وشغلت الصفحات من (435- 603)، وقد جاءت معلومات تلك الرسائل في تسعة قوالب على النحو الآتي:
الرقم المسلسل، عنوان الرسالة، الجامعة الحاصل منها، بلد التخرج، سنة الدراسة، لغة الدراسة، المجال، المكتبة المتوفر فيها، وأخيرًا اسم الباحث.
لقد ضم الدليل بين دفتيه (خمسون أطروحة عن حضرموت) منها (ثلاثين رسالة ماجستير)، و(عشرين رسالة دكتوراه)، موزعة على المجالات العلمية التي شملها الدليل. لا ريب أن جهودًا مضنية بذلت في إعداد ذلك الدليل، ولم يكن بمقدور المشتغلين فيه الإلمام بكل ما تم إجازته من قِبل الجامعات الأمر الذي أكدته توصيات الدليل نفسه. ويبدو أن القائمين عليه تواصلوا مع الجامعات اليمنية لمدهم بما توفر فيها من عناوين، غير أن من أوكلت إليه المهمة في جامعة حضرموت لم يعط ذلك الموضوع ما يستحقه من الاهتمام والوقت، بدليل أننا رصدنا أكثر مما ذكره الدليل في بعض مكتبات كليات الجامعة[8].
- د. السيد مصطفى سالم:
(المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول 1538- 1635م)[9]:
يعد الدكتور السيد مصطفى سالم من أوائل الروّاد الذين اختصوا بدراسة تاريخ اليمن الشمالي الحديث والمعاصر، وقد أعد رسائله الجامعية العليا الماجستير والدكتوراه في هذا الاختصاص[10]، مما سهل له عملية التواصل مع مصادر ومراجع تاريخ هذا البلد، وأصبح أحد المتوفرين عليه، هذه الدراسة جاءت في (97 صفحة) من الحجم المتوسط، اشتملت على تقديم بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبدالكريم (رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) الذي أشاد بمساهمة الدكتور السيد مصطفى سالم في دراسة تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وتخصصه فيه، وما أخرج من دراسات عنه، ثم نوّه بأهمية الكتاب الذي يقدمه، ودوره في لفت انتباه المؤلف إلى بعض القضايا التي تجب الإشارة إليها حتى تكتمل الرسالة التي يريد المؤلف إيصالها إلى القراء.
أما مقدمة المؤلف فقد حملت جملة من التساؤلات عن قضية إحياء التراث العربي ودور الدول والأفراد والجماعات فيها، والجهود التي بذلتها مصر في هذا المنحى. كما لوّح إلى أن هذه الدراسة (المتواضعة) تعد من أحد المراحل التعريفية والضرورية التي تسبق أو تصاحب خطوات إحياء التراث. وقد صدّر الكاتب بحثه بدراسة تمهيدية أشار فيها إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بأولئك المؤرخين -الذين يدرسهم- والتي في خضمها ظهرت كتاباتهم، كنتاج لحركة التأليف التاريخي التي شهدها هذا الجزء من بلاد العرب، وجعلها تتميز نسبيًا عن غيرها من كتابات البلدان العربية الأخرى، منوهًا بما اكتست به تلك الأعمال من صفات يمنية، وطابع إسلامي.
ثمّ استعرض موضوع بحثه المتضمن دراسة لـ(اثني عشر مؤرخًا يمنيًا) ظهروا في (القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين)، مقسمًا إياهم إلى مجموعتين (أصحاب كتب التراجم)، و(أصحاب كتب التاريخ العام)، مبينًا في المجموعة الأخيرة المؤرخين المنحازين للحكم العثماني أو للأئمة الزيديين. وقد عني في دراستهم بترجمتهم وأسلوب كتابتهم، وموضوعاتها، واهتماماتهم، ومواقفهم الفكرية والسياسية، وما تميز به كلٌ عن الآخر. كما الحق الدراسة بمؤلفاتهم التاريخية في فروع المعرفة المطروقة في عصرهم. هذا بالإضافة إلى قائمة المصادر المخطوطة والمطبوعة، فضلًا عن المراجع باللغة العربية والإنجليزية.
لقد تناولت الدراسة (ثلاثة من مؤرخي حضرموت) هما عبدالقادر بن شيخ العيدروس، ومحمد بن أبي بكر بن عبدالله الشلّي، وأبو الطيب عبدالله بن أحمد بامخرمة، وقد التزم بالمنهج الذي رسمه لنفسه في تناولهما، فجاءت ترجمته لهما ضافية، ناهيك عن دراسته لكتبهم، إضافة إلى ما تميزوا به من صفات في أسلوبهم باعتبارهم ممثلين لأصحاب كتب التراجم[11]. كما أشار إلى مؤلفاتهم عند ذكره لمؤلفات المؤرخين الذين درسهم[12].
- د. أيمن فؤاد سيد
(مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي)[13]:
تعد هذه الدراسة من أوائل البحوث التي عالجت المصادر اليمنية وغير اليمنية ذات العلاقة بتاريخ هذا البلد عبر عصوره الإسلامية المختلفة طوال أربعة عشر قرنًا. وقدم لها المؤلف بتعريف الكتابة التاريخية عند اليمنيين قبيل وبعد الإسلام، مستعرضًا بعض الملاحظات العامة حول المصادر، كما لم تفته الإشارة إلى التعريف بالتراث اليمني المنتشر في مكتبات العالم. أما المدوّنات نفسها فقد قسّمها حسب العصور والقرون، مقدمًا لكل منها بفصل يُبيّن إطارها التاريخي والثقافي، ويُتبع ذلك بالمؤلفين الذين عاشوا في ذلك العصر، مرتبًا إياهم حسب سنوات وفاتهم ومترجمًا لهم. كما أورد مؤلفاتهم وأوضح منها المخطوط والمطبوع. وهذه الدراسة لا غنى عنها لمن يبحث في تاريخ اليمن.
وما يميز هذه الدراسة أنّ مؤلفها سلك منهجًا علميًا دقيقًا في عرض مصادره ووصفها، إضافة إلى رفدها بملاحق تضمّنت قائمة بأسماء المصادر والمراجع والدراسات الحديثة، وقائمة بأسماء ملوك اليمن وسلاطينها منذ انفصال البلاد عن الحكم العباسي حتى آخر الأئمة الزّيديين (محمد البدر). وقد تضمّنت تلك القوائم مصادر التراجم إضافة إلى تحديد مدة حكمهم، علاوة على ما اشتملت عليه تلك الدراسة من فهارس بأسماء المؤلفين والكتب والمحققين والناشرين والأماكن والبلدان الأمر الذي يساعد الباحث في الوصول إلى مراده بأقل وقت ممكن.
5- د. شاكر مصطفى:
عمل موسوعي ضخم تناول فيه المؤلف تطور علم التاريخ في بلاد الإسلام، في مختلف أطواره وعصوره وعني بدراسة المؤرخين ومدارسهم ومصنفاتهم وتقنياتهم العلمية فيها، فضلًا عن مصادرهم وأخرج كل ذلك تحت عنوان (التاريخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام)، وجاء في (أربعة أجزاء)[14]. وقد حظيت المدرسة التاريخية اليمنية مع حضرموت بعناية المؤلف وقد جاء حديثه عنها بين ثنايا (الفصل الثالث) من (الجزء الأوّل) المتعلق بالمدرسة اليمنية الأولى قبل الإسلام وإرهاصات قيامها وأعلامها المؤسسين ونوعيّة المادة التاريخية التي قدمتها، حتى أواسط القرن السّابع[15] حينذاك دخلت المدرسة مرحلة جديدة من تاريخها ليتناوله المؤلف في (الفصل السابع عشر) من (الجزء الثاني)[16]، مقسمًا إياها إلى مرحلتين: أولى: وقد أعاد فيها بنوع من التّوسّع ما أورده في (الجزء الأول)، وثانية: أبرز فيها أسباب زوال المرحلة الأولى، وطبيعة ما تقدمه المصادر عن اليمن من مادّة تاريخية، وكذا أسباب اهتمامها بتاريخ اليمن، ثم الملامح العامّة. ويعرّج بعد ذلك على مؤرّخي هذه المدرسة موضحًا أبرز ممثلي المرحلتين[17]. وقد تابع مسيرة (المدرسة التاريخية اليمنية مع حضرموت) في الفصلين (التاسع والعشرين والثلاثين) من (الجزء الرابع)[18] اللذين أبرز فيهما سماتها العامّة مع ذكر المؤرخين (الكبار) و(الثانويين). وقد نوّه بأنه لا يعني بالثانويين المؤرخين الصغار أو الذين لا قيمة تاريخية لأعمالهم إنما هم من اقتصر في الغالب على تأليف كتاب واحد أو كتابين سواء كانت محلية أو مذهبية أو ينظم التاريخ شعرًا أو يشرح هذا الشعر. وهو وإن عمّم استنتاجه عن المدرسة الأخيرة -وكان محقًا في بعض منها- إلا أن منهجه الشمولي الذي سلكه قد أخفى عنه بعضًا من خصائص الكتابة التاريخية في حضرموت، خاصة وأنه لم يطلع على مظانّ تلك المصادر التي يتناولها؛ وهي خمسة عشر مصدرًا من أعمال باطحن، ومحمد عبدالرحمن باعبّاد، والشّواف، وعبدالرحمن الخطيب، وعبدالله بن معروف بن عمير، وعلي بن أبي بكر السقّاف، وشنبل، وباشيبان، وخرد. وقد اكتفى بما جاءت به مراجعه التي اعتمد عليها مثل: المشرع الروي للشلّي، أو تاريخ الشعراء الحضرميين للسقّاف، ومصادر تاريخ اليمن لأيمن فؤاد سيد، إضافة إلى بعض أعمال عبدالله محمد الحبشي مثل مراجع تاريخ اليمن، ومصادر الفكر.
6- عبدالله بن حسين العمري:
(مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني)[19]:
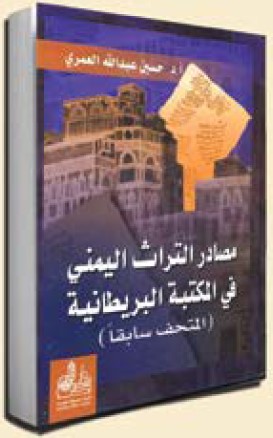
الكتاب عبارة عن حوصلة لمراجعات المؤلف وزياراته للمتحف البريطاني منذ التحاقه بجامعة كمبردج. وكان يرجى منه تسليط الضوء على ما يوجد بالمتحف البريطاني من كنوز التراث اليمني. وقد جاء الكتاب في (387 صفحة) من الحجم الوسط. اشتمل على مقدمة وقسمين. وقد عالج في المقدمة جملة من القضايا مثل التراث والتجديد، والخارطة الجغرافية لانتشار مليون مخطوطة عربية في رفوف مكتبات العالم مبينًا مواطن تواجدها وأعدادها. ثم يعطف على ذكر نشأة (المتحف البريطاني) الذي كان ثمرة من ثمار عصر التنوير في أوروبا وما رافق ذلك العصر من نتائج على مجمل نواحي الحياة. فبرز الاهتمام بالبحث العلمي وتدفق البعثات العلمية نحو أرجاء العالم القديم للتعرف على أحواله عامة وتراثه الفكري والحضاري خاصة، ومن ثم اقتناء ما يمكن الحصول عليه بعدة طرق ووسائل الأمر الذي ساهم في تجمع ثروات كبيرة من المخطوطات الإسلامية في أوروبا ومن بينها المخطوطات اليمنية والتي كان لها حضورها في تلك المكتبات العالمية، ولا سيما (المتحف البريطاني) التي شكلت مقتنياته من تلك المخطوطات موضوع كتابه هذا.
- د. سلطان ناجي:
(ببليوجرافيا مختارة وتفسيرية عن اليمن)[20]:
يعد هذا الكتاب من أوائل الأعمال الببليوغرافية اليمنية المبكرة، وقد حاول مؤلفه نشره مرتان، وكاد أن يوأد لولا تدخل الصدفة في انبعاثه من قبل الأشقاء في دولة الكويت، فخرج إلينا بصورته الحالية مشتملٍ على (184صفحة) من الحجم الكبير، وكل صفحة مقسومة على عمودين، والكتاب في إطاره العام يتكوّن من ثلاثة أقسام:
أول وخص به المطبوعات الأجنبية فاحتوى على (1979 عنوان)، فكان من أكبر الأقسام وأهمها، وقدم له بمقدمة تاريخية باللغة الإنكليزية أوجز فيها القول عن تاريخ اليمن عبر مراحل تاريخه المختلفة وجاءت في ستة أجزاء:
الأول منها في التاريخ القديم وحضارته حيث أشار إلى الدول والممالك التي قامت في هذا الجزء من بلاد العرب فأتى على ذكر دولة معين، مملكة سبأ، قتبان، أوسان، حمير، حضرموت. ثم أشار إلى ذكر الديانتين المسيحية واليهودية، ثم عطف على فترة الغزو الحبشي والفارسي.
أما الجزء الثاني من المقدمة فقد خص به تاريخ اليمن في عهد الإسلام من القرن السابع إلى القرن السادس عشر الميلادين، أشار فيه إلى الدويلات المستقلة التي شهد قيامها هذه الناحية من الجزيرة العربية مثل: الدولة الزيادية، اليعفرية، القرامطة، الزيدية، النجاحية، الصليحية، الزريعية، الحاتمية، الأيوبية، الرسولية، وأخيرًا الدولة الطاهرية.
ثم تناول في (الجزء الثالث) الصراع في البحر الأحمر من أجل التجارة. بينما تحدث في (الجزء الرابع) عن اليمن منذ التدخل التركي إلى الاستعمار البريطاني. وجاء (الجزء الخامس) عن الإرهاصات البريطانية الأولى لاحتلال عدن، أما (الجزء الأخير) فعني بالاستعمار البريطاني حتى الاستقلال، وفيه تتبع المؤلف السياسات الست التي انتهجتها بريطانيا، بدء من فرق تسد مرورًا بــ(الصيغة المطاطية)، فضلًا عن المشكلة الحدودية والسياسة الإمامية، ناهيك عن حكومة الاتحاد، وأخيرًا الكفاح المسلح والانسحاب البريطاني. ولما كانت تلك المفردات التي تناولها المؤلف في مقدمته بمثابة عهود مهمة من تاريخ جهة اليمن، فقد سعى إلى تحديد فتراتها الزمنية بالتاريخ الميلادي، باستثناء عهود الدول والممالك القديمة التي أهملها ربما لعدم أتفاق الباحثين على تحديد فترات حكمها بدقة.
أما القسم نفسه -المطبوعات الأجنبية- وبحسب مقدمة المؤلف فقد وزعه على اثنين وعشرين فصلًا اشتملت المواضيع الآتية: عام، رحلات، اكتشافات، آثار، نقوش، نميات ونقود، تاريخ (قديم – إسلامي – حديث)، جغرافيا، نبات، زراعة وري، اقتصاد، إثنولوجيا، لغة، أقليات، أحوال اجتماعية، عادات وتقاليد، تغير اجتماعي، صحة عامة وأمراض، تربية، وجزر، (سقطرى، ميون، كمران… إلخ)[21].
أما القسم الثاني من الكتاب فقد عني بالمصادر التاريخية المخطوطة فرصد (258 مخطوطة). بينما جاء القسم الثالث في المطبوعات العربية فذكر منها (560 عنوانًا). وقد سبق القسمين الأخيرين بالحديث عن علم الببليوغرافيا وأهميته، وبيّن أسباب اهتمام المؤلف به فضلًا عن الصعوبات التي واجهها عند تأليف كتابه ونشره.
لا ريب أن الكتاب قد أدى دوره ومهمته في التعريف بما تم تأليفه وتصنيفه من مؤلفات عن ناحية اليمن سوى ما كتب منها باللغة العربية -مخطوطًا كان أم مطبوعًا- أو باللغات الأجنبية التي كانت أكبر من القسمين الأول والثاني من حيث عدد العنوانات ويبدو أن تواجد المؤلف في بيئات تتحدث اللغة الإنجليزية فضلًا عن دراسته في بريطانيا قد ساهم في رفد موضوعه بهذا العدد من الدراسات، كما أن أهمية هذا المصنف تكمن في انبعاثه في وقت لم يتم فيه بعد نشر كثير من كنوز التراث أهل اليمن. ولذلك كان لمؤلفه الفضل على المشتغلين والمعنيين بدراسة تاريخ وحضارة هذه الناحية من جزيرة العرب بما قدمه من أسماء للمصادر والمراجع والدراسات الحديثة وأن كانت (مختارة). لا سيما وأن المؤلف لم يحشر موضوع كتابه في جانب معين من جوانب الإنتاج الفكري بل طرق جوانب متعددة منه. إضافة إلى أنه قد سلك منهجًا لم يسبقه غيره إليه حسب زعمه. فإذا كان جُل أصحاب الفهارس والأعمال الببليوغرافية السابقة عليه قد تناولوا فيها أسماء مؤلفيها، وعناوين كتبهم، ومكان نشرها، وعدد صفحاتها، فإنه زاد عليهم بإيراده بعض محتويات الكتب التي يقدّمها والاستشهاد بجزء مما جاء في مقدمتها[22]، ويبدو أن ذلك كان دافعًا له بأن جعل من عمله هذا ببليوغرافيا وتفسيريًا في آن واحد حسبما حمله عنوان كتابه. لقد نبه المؤلف إلى أنه لم يقم برصد كل المؤلفات والمدونات، إنما اختار بعض منها دون أن يُبيّن أسباب ذلك الاختيار. إن المنهج الانتقائي الذي سلكه المؤلف في اختيار عنوانات مصادره ومراجعه عكس نفسه على حجم المادة التي يقدمها عن حضرموت حيث لا يصادف الباحث فيه إلا القليل مما تم ذكره عنها في تلك الفترة مع أن ما دوّن عن حضرموت باللغات الأوربية حتى عام 1971م يزيد على خمسة آلاف نص بين كتاب ومقال[23].
[2]– نشر دار القرآن الكريم، بيروت، ط1/ 1399هـ/ 1979م، وقد حققه (Fherhard, E.N.W)، ونشر في behrrassowitz ألمانيا.
[3] – تحقيق جوليان يوهانسين، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط/ 1994م.
[4] – نشره المجمع الثقافي، أبوظبي، ط/ 1979م.
[5] – مركز الدراسات اليمنية، صنعاء. د.ت ، وقد تم نشره.
[6] – العمري (حسين بن عبدالله): مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، دار المختار للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط/ 1400هـ/ 1980م، ص ص14- 16.
[7] – صدر هذا الدليل عن رئاسة الوزراء، المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، الأمانة العامة، د. ن، 2008م.
[8] – د. حسن صالح الغلام العمودي، حضرموت في الدراسات الجامعية ماجستير ودكتوراه، دار حضرموت للدراسات والنشر، ط1/ 2011م.
[9] – سالم (د. السيد مصطفى):المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول 1538- 1635م، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1971م.
[10] – كانت رسالته للماجستير بعنوان (تكوين اليمن الحديث أو اليمن والإمام يحيى 1904- 1948م).
[11] – سالم (د. السيد مصطفى): المؤرخون، ص ص23- 37.
[12] – المرجع نفسه، ص ص88- 90.
[13] – المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، نصوص وترجمات، المجلد (7)، ط/ 1974م.
[14] – مصطفى (شاكر): التاريخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام، تم نشر هذه الأجزاء من طرف دار العلم للملايين، بيروت، ج1، ط1/ 1983م، ج2، ط2/ 1980م، ج3، ط1/ 1990م، ج4، ط1/ 1993م.
[15] – المرجع نفسه، ج1، ص ص135- 139.
[16] – مصطفى (شاكر): التاريخ العربي والمؤرخون، ج2، ط2/ 1980م، ص ص305- 361.
[17] – سبق للمؤلف وأن نشر كل ذلك في مقال له تحت مسمى (التاريخ والمؤرخون في اليمن الإسلامية حتى القرن السابع الهجري) في مجلة كلية الآداب والتربية، جامعة الكويت، ع 13، يونيو حزيران، 1978م، ص ص91- 115.
[18] – مصطفى (شاكر): التاريخ العربي المؤرخون، ج4، ص ص229- 293.
[19]– مصطفى (شاكر): التاريخ العربي المؤرخون، ج4، ص ص229- 293.
[20] – ناجي (سلطان): جامعة الكويت، مراقبة المكتبات، السلسلة الببليوجرافية رقم 6، أغسطس 1973م.
[21]– ناجي (سلطان): ببليوجرافيا، ص13.
[22] – ناجي (سلطان): ببليوجرافيا، ص13.
[23] – سيرجنت: حول مصادر التاريخ الحضرمي، ص13. (مقدمة المترجم).