دراسات
محمد عوض محروس
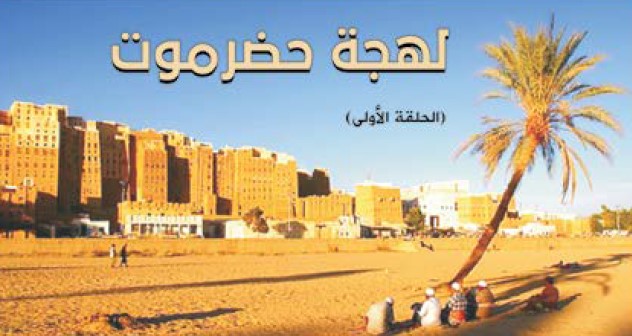

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 57
رابط العدد 7 : اضغط هنا
إلى جانب اللغة العربية الفصحى كلغة وطنية لكل العرب في مختلف أقطارهم يتحدث الناس في مختلف مناطق العالم العربي بلهجاتهم العربية الخاصة، سواء منها تلك اللهجات المتبقية في بعض المناطق العربية من اللغات العربية القديمة كـ(الآرامية) في بعض مناطق سوريا، أو المهرية والشحرية (الجبَّالية) والسقطرية في محافظة ظفار العُمانية وفي المهرة وسقطرى، أو تلك اللهجات الأخرى التي مزج فيها الناس بشكل تلقائي بين اللغة العربية الفصحى الحديثة ولغات عربية قديمة (سامية) كاللغة الحضرمية، ولذلك فإن تلك اللهجات تعد لهجات أصيلة لارتباطها بالمكان والإنسان العربي وموروثه الاجتماعي والثقافي المحلي وبالموروث العربي العام.
ولهجة حضرموت هي إذن تلك اللهجة التي تكونت من لغة حضرموت القديمة واللغة العربية الفصحى، وهي جزء من هوية متحدثيها؛ لأنها اللغة التي يتحدث بها الناس فيما بينهم يوميًا، وهي لغة تراثهم وإبداعاتهم من شعر وغناء وأمثال وحكم وأقوال، وهي لغة المصطلحات الخاصة بأصحاب المهن المختلفة، أي أنها الحامل الرئيس للمشهد الاجتماعي والثقافي القديم والحاضر لديهم، وهي من اللغة العربية كفرع من الأصل، والخاص من العام، أي أنها نتاج مشترك للغة الفصحى ولغة حضرموت القديمة، إحدى اللغات التي سادت كتابة ونطقًا عند عرب الجنوب في العصور القديمة، وتلك اللغات هي: اللغة الحضرمية، واللغة القتبانية، واللغة المعينية، واللغة السبئية([1])، وهي من ضمن لغات العرب ولهجاتهم القديمة التي تكونت منها اللغة العربية الفصحى ونزل بها القرآن الكريم([2]). لذلك فإن لهجة حضرموت هي جزءٌ من كل، وارتباطها بالفصحى يعني ارتباط الخاص بالعام، وهي وسيلتهم اليومية -أي الحضارم- في التخاطب والتفاهم والإبداع، وهي جزء من هويتهم، وبارتباط لهجتهم المحلية باللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم، وبمعتقدهم الديني الإسلام فهي تعد جزءًا من هويتهم العربية الإسلامية.
إن اللهجة بوصفها وسيلة للحديث والتخاطب والإبداع، وظاهرة اجتماعية ثقافية ليست عرضة للزوال، فعلى الرغم من توسع امتداد اللغة الفصحى وانتشارها في كل أنحاء حضرموت ابتداءً من القرن الرابع الميلادي، وكثرة وتنوع المؤسسات التعليمية التي تدرسها كلغة رسمية وحيدة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ومن حيث توسع انتشارها عبر المؤسسات الرسمية المختلفة، أو عبر وسائل الإعلام التي تعمل بشكل مزدوج بين الفصحى والعامية، إلا أنها أي الفصحى تظل محصورة في قطاع التعليم وفي مجال الإعلام والثقافة والعمل الرسمي، ذلك لأن اللهجة المحلية تُغذى يوميًا وساعة بساعة ولحظة بلحظة من الأسرة، والمجتمع المحلي، ومن محيط العمل، ومن الشارع، ومن مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية المحلية، التي تغذي اللهجة المحلية وتحافظ على حضورها أكثر مما تفعله المؤسسات الرسمية مع الفصحى.
وألفاظ اللهجة المحلية في غالبها هي ألفاظ عربية جنوبية وعربية فصحى، وهذا لا يعني أن ألفاظًا أجنبية لم تتسرب إليها، وفيها -أي اللهجة المحلية- اختلاف في نطق كثير من ألفاظها عن نطقها في الفصحى، ولكن هذا الاختلاف في إطار اللغة نفسها، وليس في أصل الألفاظ العربية، ويتضح ذلك الاختلاف في كيفية نطق تلك الألفاظ، وفي نحوها وفي صرفها وفي جمعها، واللهجة كما يقول د. عبدالله صالح بابعير: «هي اتجاه منحرف داخل اللغة، وليست مُنْبَتَّةً عنها، واللهجات العامية الحديثة فروع للفصحى في أصلها، فهذه اللهجات (في الكثير منها ألفاظ تعود في تاريخها إلى الجاهلية، ولكنها تختلف عن الفصحى في أنها خرجت عن القياس الذي وضعه النُحَاة»([3]).
والمواطن البسيط لا يلتزم في حديثه بقواعد اللغة من نحو وصرف كما وضعه علماء اللغة العربية الأوائل، ربما لأن في لهجته عناصر أقدم مما وضع هؤلاء الروّاد من قواعد، ولأنهم لم يتعرفوا على لهجته عندما وضعوا قواعدهم تلك، وهم لم يأتوا إلى حضرموت لأنهم لم يعدوا لهجة أهلها عربية أصيلة، ولأن المواطن العادي في هذه البلاد لم يطلع على قواعد اللغة التي أعدها أولئك الروّاد إلا في مقاعد الدراسة، وهو في الغالب سرعان ما ينساها بمجرد تخرجه من المدرسة أو الجامعة بسبب تغلب اللهجة العامية السائدة على ألسن الناس على اللغة الفصحى.
إن توسع تعليم اللغة الفصحى بقواعدها لا يتطلب القضاء على اللهجة المحلية، وهو لن يؤدي إلى طمسها أو نزعها من ألسن الناس ومن موروثهم ومن ذاكرتهم؛ لأن اللهجة المحلية تعبر عن وحدة متأصلة في كلام الناس، وفي تعاملهم فيما بينهم بسلاسة ودون أي تكلف في بيئتها وإطارها الجغرافي المحدود، كما تحافظ اللهجة المحلية على موروث الناس الاجتماعي والثقافي وتقوي روابطهم بذلك الموروث، وتشدهم إلى مواقع طفولتهم، ومراتع شبابهم، ومثاوي أجدادهم، وماضي أهلهم، وتواصل الحياة على أرضهم. وإذا كان هناك من تطور في توسع تعليم الفصحى فإن ذلك يعني مزيدًا من الارتباط باللغة الأم، وهو ما سوف يعمل على المدى البعيد على تقارب اللهجة المحلية مع اللغة الفصحى، وذلك لن يعمل على زوال اللهجة المحلية، ولكن على تجذرها وتحسن استعمالها من قِبل أغلب الناطقين بها.
إن لهجتنا المحلية في حضرموت ليست وسيلتنا نحن جيل اليوم في الحديث والتخاطب، ولكنها كانت وسيلة كل أسلافنا من أبناء هذه الأرض في التخاطب والحديث والإبداع، احتوت على كل تراثهم الاجتماعي والثقافي من عادات وتقاليد وشعر وغناء وحكم وأقوال وأمثال وحكايات، ولذلك فإن لهجتنا العامية كانت وما زالت من أهم مظاهر حياتنا وحياة أسلافنا الذين عاشوا على هذه الأرض، وهي تعبر عن هويتنا كحضارم وعرب ومسلمين، والحفاظ عليها يعني الوفاء لماضي أهلها، وإصرارًا على وجودنا وتمسكنا بهويتنا وحق أبنائنا وأحفادنا في العيش على أرض الأجداد.
إن العلاقة بين الفصحى والعامية هي كما يقول د. عبدالله صالح بابعير إن «اللهجة العامية مستوى من الأداء اللغوي، مرتبط بأصوله التراثية الفصيحة، فهي فروع من العربية الفصحى، والعلاقة بينهما هي العلاقة بين الخاص والعام»([4])، وعليه فإنه لا خوف من العامية على الفصحى، ولا من الفصحى على العامية؛ لأن الخاص ينطلق من العام وهو جزء منه، والعام هو أصل الخاص وهو أساس لكل ما يختص به، ولأن كلًا منهما يأخذ موقعه ومكانه الطبيعي في حياة الناس اليومية ونشاطهم المهني والاجتماعي وفي حياتهم العامة. ففي مقاعد الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، وفي النشاطات والمخاطبات الرسمية، وفي أجهزة الإعلام المختلفة تكون الأولوية للفصحى، بينما تحتل العامية موقعها الطبيعي في محيط الأسرة والمجتمع، وفي مواقع العمل الشعبية، وفي تجمعات الناس في الأسواق، وفي النشاطات والمناسبات الاجتماعية ذات الطابع المحلي.
إن دراسة اللهجة المحلية في حضرموت يعني دراسة علاقتها بالأصل الجنوبي العربي الذي جاءت منه، وهو لغة حضرموت القديمة، واللهجات القديمة التي سادت وما زالت قيد الاستعمال إلى اليوم في مواقعها القديمة، وأصبحت تشكل اليوم لغات قائمة بذاتها، وهي اللغات المهرية، والسقطرية، والشحرية التي يطلق عليها الناطقون بها اليوم في سلطنة عمان (الجبَّالية)، وتعني أيضًا دراسة مواقع التقائها مع الفصحى وانحرافها عنها، وقد يؤدي ذلك إلى البحث في شئون أخرى تتعلق بالثقافة المحلية والموروث الشفهي، وقد أكد د. عبدالله صالح بابعير على أهمية «الدعوة إلى الاهتمام بدراسة اللهجات المحلية الحديثة، بوصف هذه اللهجات نشاطًا اجتماعيًا وثقافيًا للناطقين بهذه اللهجات من جهة، ولما تفيده هذه الدراسة في تبيان ملامح الاتفاق والافتراق عن أصولها الفصيحة وملامح التأثير والتأثر من جهة أخرى»([5]).
وعليه فإن البحث في اللهجة المحلية في حضرموت يستهدف تبيان علاقتها بالفصحى وبأصولها العربية الجنوبية القديمة، وتبيان نسبة دلالة بعض الألفاظ القرآنية إلى هذه اللهجة، ومدى تجذر اللهجة المحلية في إبداعات الناس وموروثهم المحلي من شعر وأمثال وأقوال وحكم بوصفها جزءًا من الموروث العربي العام، وبحث المشترك والمختلف في لهجة الناس في وادي حضرموت عن لهجة أهل الساحل، ولهجتي أهل المشقاص والمعراب، ومدى ارتباط اللهجة بموضوع الهوية، ومدى التأثير المتبادل للشتات الحضرمي في لغات البلدان التي استقر بها المهاجرون الحضارم، وفي لهجة حضرموت نفسها.
لهجة حضرموت واللغة العربية الفصحى، كجزء من كل:
يعد توزع السكان في المساحات الواسعة، وتنوع البيئة، وبعد المسافات بين المناطق الآهلة بالسكان، وصعوبة التواصل بين الناس في الماضي، بالإضافة إلى تعلق الناس بموروثهم الاجتماعي والثقافي الخاص بهم من ضمن الأسباب التي ساعدت على تكون اللهجات في اللغة الواحدة، وعلى بقائها. واللهجة هي أسلوب أو طريقة التعبير بنطق معين للغة الأم من قبل جماعة من الناس تعيش في منطقة وبيئة جغرافية محددة.
ولهجة حضرموت عربية الأصل؛ لأن كثيرًا من ألفاظها وتعابيرها عربية جنوبية تعود للغة الحضرمية القديمة، إحدى اللغات العربية الجنوبية التي سادت كتابة ونطقًا في جنوب الجزيرة العربية، وهي إحدى اللغات العربية القديمة التي أطلق عليها علماء اللغات النمساويون في العام 1781م تجاوزًا (اللغات السامية)([6])، وتكمن خصوصيتها في أصالتها وعلاقتها بكل من اللغة الحضرمية القديمة واللغة العربية الفصحى، وعليه فإن لهجة حضرموت مزيج من نسيج لغوي تتضح خصوصيته من خلال معرفة مفرداته وتعابيره، ودلالات تلك المفردات والتعابير وما يقابلها من معانٍ في الفصحى، حيث يقول الأديب والمؤرخ محمد عبدالقادر بامطرف: «يُخطئ من يظن أن الكلمات الفصحى ما هي إلا الكلمات القاموسية. إن معاجم اللغة بما فيها (الأمهات) لم تستوعب كافة مفردات اللهجات العربية، كما إن بعض الأميين وأنصاف الأميين يأتون في أشعارهم الحمينية بكلمات قاموسية دون أن يعلموا أن هناك معاجم تضم في ثناياها تلك الكلمات، ولكي ندلل على كلامنا هذا سوف نأخذ ثلاثة مقاطع من شعر حميني قاله الشاعر عوض عبدالله السبتي (يُقال أيضًا سبيتي)، المتوفى سنة 1383هـ/ 1963م من أهالي مدينة الديس الشرقية في محافظة حضرموت. وهو شخص من العوام عاش طيلة حياته على برزخ التوسط بين الحضر والبادية. قال رحمه الله:
نا شقيق الليل تشهد لي الزواهر
غيب الزاهرة
والقمر والفجر يشهد لي نسيمه
والبِيَح والصبح لابان
* * *
الهوى يا بو علي له أخذ خاطر
والعصي صابرة
بالوتاء ذي يكسر اعظوم الصميمة
وإن صرفته للقسي لان
* * *
لا يهمه هم من به صوب غائر
حجته ظاهرة
كل من به ضيم يشكي لي بضيمه
نا معي للعشق ديوان
* * *
ويتابع بامطرف قائلًا: «فعلى كل من يرغب من الشعراء المعاميد، وخاصة من أبناء محافظة حضرموت أن يرجع إلى (يتيمة الدهر) للثعالبي وإلى (تاج العروس) للزبيدي ليرى إلى أي مدى استطاع الشاعر السبتي أن يرتب درجات ظلمة الليل بدءًا من الغروب إلى تألق النجوم إلى ظهور نجمة آخر الليل، ثم البِيَح (بكسر الباء وفتح الياء)، الذي هو مطلع الفجر، ثم الفجر ونسيمه. وقد استعمل الشاعر السبتي استعمالًا لغويًا صحيحًا جملة (أخذ خاطر) وقصد بها المعالجة النفسانية، ففي جمله وتراكيبه يطمئن السبتي، في حصافة طبيب القلوب الواثق من نفسه، المصابين بلواعج العشق والغرام والهيام بأن طريقته ولكل شيخ طريقة استعمال (الوتاء) أي المداراة الحكيمة للتغلب على الحالات المستعصية في دنيا صرعى الغواني والجمال، ثم لهؤلاء المصابين إن كان قد تركت طعنات العيون النُجل فيهم بقية أن يبحثوا عن كلمتي (العصي والقسي) وهما على وزن واحد في صحاح الجوهري و(لسان العرب) لابن منظور، علهم يعثرون على معناهما، وكان السبتي قد استعارهما للصد والهجران. ولن أكون حانثًا إذا أقسمت أن الشاعر السبتي لم يسمع في حياته بواحد من معاجم اللغة ولا من كتب الأدب العربي، ولكنه كان بفعل السليقة والنفس الذكية المتفتحة على معاني الحياة مزودًا بثروة من لهجتنا العربية الدارجة»([7]).
وفي تقديمه لديوان الشاعر الشعبي المشقاصي الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة([8]) كتب الدكتور سعيد سالم الجريري يقول: «بن حمادة([9]) شاعر طالع من أعماق هذه الأرض، معجونًا بلغتها، ومعجمها، وتراثها، وفلكلورها، وتنساب على لسانه معان وصور لصيقة بالمكان الذي يتشكل على صورة (بن حمادة)، أو (بن حمادة) يتشكل على صورته، لا فرق، في حالة من التماهي الوجودي والجمالي، ويتجلى ذلك كله في أنماط التعبير وأشكاله الإيقاعية التي يجيد (بن حمادة) اللعب على أوتارها، إذ يستل من الكلام كلامًا خاصًا به، دالًا عليه من دون غيره كأنه البصمة.. معظم أشعار (بن حمادة) ولا سيما الكرّام البدوي، لكن لغته عربية جنوبية جذورًا واشتقاقات ودلالات، وتمثيلها في أشعاره صورة من صور الهوية المتناسلة عبر العصور، عصية على أدوات المحو والطمس، ولأن الشواهد تجلُّ عن الحصر فلنكتف بمثال: إذ يقول (بن حمادة) في إحدى قصائد الكرّام:
كهيب يالظلمة كهيب
ولقد تبدو لفظة (كهَيب) -بفتح الهاء- غريبة غير متداولة في المعجم اليومي، لكن لسان العرب يضعها في سياقها العربي الفصيح دلالة على أن عرب حضرموت، ولا سيما بدوهم، أقحاح في لغتهم، وإن اتسمت بسمات صوتية وصرفية تغاير متداول اللغة الرسمية صوتًا وصرفًا. جاء في (لسان العرب) لابن منظور: «الكُهبة: غُبرة مشربة سوادًا في ألوان الإبل، زاد الأزهري: خاصة بعير أكهب: بيّن الكهب، وناقة كهباء. الجوهري: الكهبة لون مثل القهبة، قال أبو عمرو: الكهبة لون ليس بخالص الحُمرة، وهو في الحُمرة خاصة. وقال يعقوب: الكهبة لون إلى الغبرة ما هو، فلم يخص شيئًا دون شيء. قال الأزهري: لم أسمع الكهبة في ألوان الإبل لغير الليث، قال: ولعله يستعمل في ألوان الثياب. الأزهري: قال ابن الأعرابي: وقيل الكهب لون الجاموس، والكهبة الدهمة، والفعل في كل ذلك كهب وكهب كهبًا وكهبة، فهو أكهب، وقد قيل: كاهب، وروي بيت ذي الرُّمَة:
جنوح على باقٍ سحيقٍ كأنه إهاب ابن آوى كاهبُ اللونِ أطحلُهْ
وتكشف قراءة (كهيب) (بن حمادة) في سياق قصيدته تلك، عن دلالات وشيجة بالمعنى الفصيح لدى عرب الجزيرة»([10]).
وعن اللغة المستخدمة في قصائد الكرّام عند (بن حمادة) يقول الأستاذ أحمد عمر مسجدي: «لو عرجنا متصفحين ديوان الشيخ الشاعر ابن حمادة تستنطقنا من أول وهلة هذه القصائد الغنية باللغة الفصحى التي تخالها لتداولها وكأنها لهجة بدوية مشقاصية دارجة يصعب على ابن المدينة معرفة كنهها، وهي غنية أيضًا بلهجة أهل المشقاص التي تختلف نوعًا ما عن لهجة أهل المعراب… ونبدأ أول ما نبدأ بعناوين القصائد الكرّامية التي وردت في ديوان ابن حمادة:
ويقول الأستاذ مسجدي: «لست خبيرًا باللهجة المشقاصية، ولكن بمجرد قراءتنا السطحية لهذه الألفاظ يلوح في الأفق تشابهها اللفظي والشكلي وواحدية مضمونها المعنوي، فالراد والردة والفي والفية والظلة كلها تلتقي تحت معنى واحد هو احتضان الظل بعضه بعضًا، كما إن تقارب الحروف في ولّاف والفي له دلالته المشقاصية التقليدية، أو التقابل الموسيقي والتوافق الجرسي والتكرار في حضين وكهيب له ميزة دلالية توقع في الأسماع وتسترعي الانتباه… وكل قصيدة من قصائد الكرّام تُعد لوحة فنية رسمها الشاعر بدقة وإتقان يجسد فيها عمق التجربة وصدق العاطفة وجزالة اللفظ وتأصله وتدفق الحركة بين الأمكنة.. نأخذ أولى قصائد الكرّام في ديوان ابن حمادة وأقلها أبياتًا كنموذج لنا… ونركز على لغتها المستخدمة.. والقصيدة كالتالي:
يا الراد ولاّف
والفي ع يعملوا ترادين ورداف
وخروا للأودي طرشين وخفاف
جزعوا ع شِعاب وتقاديم وحقاف
ولا شي رجع لاف
خروا ع سننهم ما راحوا خلاف
ونا عيني عليهم شوف كما من شاف
أما الشمس تغصب غشت من ع حقاف
ونظري رجع كاف
وتولوني هموم أما الحال ينلاف
وتلاهيم ع قلبي عملوا فيه خاف
والكبد فيها خذاف
بقيت كما المرهوب والرأس عند سياف
صابي كما الساف
والناس من فكر فيني كل حد له مشاف
وذاك ما دروا بي قالوا ذي شاف
ونا بعد جاويد بقيت ع الحياة قاف
وحملوني حمول ثقل فيه وكلاف
ثقل ع قلبي أما دمّي نزاف
والثقل لا حمل وحط فوق الكتاف
ولا عدالة ثقيلة بتقعن خفاف».
ويتابع الأستاذ مسجدي بقوله: «بعض المفردات المستخدمة في القصيدة التي نخالها بأنها عامية ولكنها في الأصل فصحى، ومن هذه المفردات (خروا) وهي من المستخدمات الكثيرة ليس في المشقاص فحسب، وإنما في بادية المعراب أيضًا، وتأتي (خر) على عدة معانٍ في الصوت أيضًا، فقد جاءت في القرآن الكريم ((فلما خر تبينت الجن..)) بمعنى وقع وبمعنى مات، وكذلك لها معان في الصوت كقولهم: خر الماء إذا جرى، وخر عند النوم، ولكن ابن حمادة استخدمها بمعنى (سقط) فيقال: خر البناء إذا انهد وسقط، وقوله: (خروا للأودي طرشين وخفاف) بمعنى سقط الظل في الوادي بسرعة وخفة. أما لفظ (لاف) في قوله: (ولا شي رجع لاف)، أي لم يعد بقبضته، ولفظ (غشت) هي الأخرى بمعنى أظلمت. ولفظة (خذاف) التي أتى بها مع الكبد في قوله: (والكبد فيها خذاف) بمعنى الكبد متقطعة، ولها معنى آخر أي جعل الحصاة بين سبابتيه ورمى بها. وفي قوله: (صابي كما الساف) فالصابي بمعنى أمال رأسه وخفضه إلى الأرض، وصابي الشيء أماله، وصابي السكين قلبها، وصابي السيف وضعه في غمده مقلوبًا، وصابي الكلام لم يجره على وجهه الصحيح. أما لفظة (الساف) فتعني الداء يهلك الإبل. ولفظة (قاف) تعني تتبع الأثر، كما جاء في معاجم اللغة (تاج العروس) و(لسان العرب) و(مختار الصحاح)»([11]).
لقد تحدث الأستاذ مسجدي عن لغة الشعر عند ابن حمادة وعلاقتها بالفصحى الدارجة عند أهل المشقاص كما يقول، وقد أحسن صنعًا وأصاب عندما ربط مفردات قصائد الشاعر الشيخ ابن حمادة بالعربية الفصحى، ولكنه تجاهل معاني ودلالات تلك المفردات في لهجة حضرموت، وكانت الفائدة والوضوح سيكون أفضل لو قارن معاني تلك المفردات ودلالاتها في الفصحى وفي لهجة حضرموت معًا، فلفظة (خر) التي فسرها بمعنى سقط بناء على ما ورد في معاجم اللغة والقرآن الكريم لها عدة معانٍ في لهجتنا المحلية بالإضافة إلى معانيها في الفصحى، فالأصل: خر، يخر، خرة، وخر فلان إلى مكان ما تعني أنه اندفع سريعًا أو ذهب وعاد مسرعًا، والخرة هي الذهاب والعودة السريعة، والخرة عند معالمة وعمال البناء هي الأخشاب التي تُثبت في جدار المبنى من الخارج أو تتدلى من أعلى المبنى ليعمل البناؤون من عليها على ترميم المبنى من الخارج، وخر الماء من السقف تعني أن الماء اخترق سقف المبنى لينزل إلى داخله، وعندما يأتي أحدهم بحديث غير لائق عند أبناء القبائل البدوية في المشقاص مباشرة ينطق أحدهم بلفظة (خر) مع شيء من الصرامة في تقاطيع الوجه وحركة اليدين، و(خر) هنا هي لفظ زجر ونهي عن تكرار ما يعيب من الحديث، وهي هنا في قول بن حمادة:
وخروا للأودي طرشين وخفاف
فيه تشبيه للفيا أي الظلال بالطِرشِين جمع طَرِش، والطراشة هي رشاقة وحيوية الشباب، وقوله هذا يعني أن الفيا اندفعت بسرعة وخفة ولم تسقط، وتفسير لفظة (غشت) بمعنى أظلمت قد يكون في غير موقعه؛ لأن الشمس ليست مصدرًا للظلام، ولكنها وفقًا لقول ابن حمادة (غشت من ع حقاف) يعني أنها تغطت أي غابت أو غربت من فوق كودٍ رملي، كما إن لفظة (صابي) ليست كما ورد في معاجم اللغة بمعنى (أمال رأسه وخفضه إلى الأرض) كما ذكر الأستاذ مسجدي، ولكن الصابي في لهجة حضرموت من صبا، يُصبِي، صابي، مصباي، ولفظة (صبا) هنا تعني أنه سرح بخياله مهمومًا بأمر ما، وعندما يقال: فلان فيه صبية تعني أنه يعاني من الشرود من كثرة ما يحمل من هموم، والصابي هو الشخص المهموم السارح والشارد بأفكاره بعيدًا عن الناس، وكذلك هو المصباي الذي لا يُعتمد عليه بسبب حالة الصبية التي يعاني منها، وصابي يمكن أن تكون من صبَّى يُصبِّي تصبِّية، وهي هنا صفة لحالة الصياد الذي ينتظر وصول الأسماك إلى وسائل اصطياده وهو في حالة سكون عائمًا دون حراك فوق مياه البحر. أما لفظة (قاف) التي فسرها الأستاذ مسجدي (بأنها تعني تتبع الأثر) أي من القيافة، فهو في تفسيره هذا قد أخرجها من سياقها الشعري في قصيدة ابن حمادة، واستغنى عن معاجم اللغة، وهو لو فتح واحدًا منها لوجد أن معنى هذه اللفظة ليس كما ذكر، لأن لفظة (قاف) من قف، وقف الثوب يبس بعد غسله، وقف الشعر تعني أنه قام من شدة الفزع، وقفت الأرض يبس زرعها، وهي في قول ابن حمادة لا تختلف عن ذلك لأن (القاف) في لهجة حضرموت هو ما يبس وخرج عن أصله، كلحاء الشجر اليابس الذي يبرز خارجًا عن ساق الشجرة، وتلك هي لفظة (قاف) في القاموس الحضرمي بنطقها المشقاصي بإمالة الألف نحو الياء.
ومن خصوصيات اللهجة الحضرمية التي أعطت لشعر ابن حمادة نكهته الحضرمية المشقاصية دخول حرف العين متقدمًا الفعل أو الاسم، فحرف العين عندما يتقدم الفعل المضارع فإنه يفيد باستمرار الفعل كقول ابن حمادة: (والفي ع يعملوا ترادين ورداف) أي استمرار توارد وترادف الظل، وهذه من خصوصيات لهجة أهل المشقاص، أما إذا تقدم حرف العين الاسم فهو اختصار للفظة (على) وهو من لهجة حضرموت عامة كقول ابن حمادة:
جزعوا ع شعاب
خروا ع سننهم
غشت من ع حقاف
وتلاهيم ع قلبي
أما في قول ابن حمادة:
وتلاهيم ع قلبي عملوا فيه خاف
فالتلاهيم من الإلهام، وهو إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص الله به أصفياءه، وهو ما يُلقى في القلب من معان وأفكار كما جاء في (المعجم الوسيط)([12])، والتلاهيم هنا هي استعادة وتذكر شريط الأحداث التي حصلت له، ولفظة (خاف) في لهجة حضرموت تعني: ربما أو يمكن، وهي لفظة تعني التأويل.
مما تقدم يتضح أن اللهجة العامية المتداولة اليوم في حضرموت هي لهجة عربية الأصل في ألفاظها، قديمة في تكوينها، وهي من الفصحى كجزء من كل، ولأن جذورها تمتد عميقًا في تربة البلاد العربية الجنوبية، فهي تستمد قدمها من قدم حضرموت لغة وأرضًا وإنسانًا.
المراجع:
[1] – ينظر: الأستاذ الفريد بيستون، لغات النقوش اليمنية القديمة نحوها وتصريفها مختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص68.
[2] – د. هادي عطية مطر الهلالي، دلالة الألفاظ اليمانية في بعض المعجمات العربية، ص14- 18.
[3] – انحراف اللهجات العامية الحديثة عن العربية الفصحى، ص12.
[4] – المصدر السابق، ص149.
[5] – المصدر السابق، ص149.
[6] – د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج1، ص222.
[7] – التراث وصناعة الشعر، ص13.
[8] – جمع وإعداد بورح سبيتي بن دري المطري، ديوان صاحب الريادة في الشعر الشعبي الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة.
[9] – كرامة بن عمرو بن حمد بن مبرور بن مطر الثعيني، من مواليد 1354هـ بريدة عبدالودود (الريدة الشرقية حاليًا) تلقى تعليمه على يدي إمام (مسجد ضبق هزاول) بعسد الجبل الشيخ سعيد بن عبدالرحمن باحميد، قضى معظم أيام صباه وشبابه بأرض البادية، سافر إلى الكويت عام 1965م، وعمل في دكان.
[10] – ديوان صاحب الريادة في الشعر الشعبي الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة، ص8- 10.
[11] – مجلة (حضرموت الثقافية)، العدد (الثالث)، رجب 1438هـ/ مارس 2017م، ص75- 76.
[12] – ينظر: المعجم الوسيط، مادة (لَهِمَ).