كتابات
د. طه حسين الحضرمي
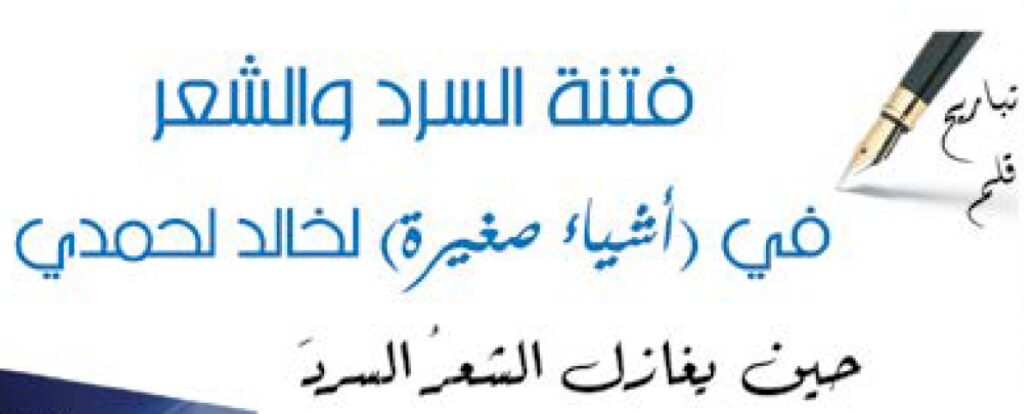

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 84
رابط العدد 7 : اضغط هنا
السرد والشعر جنسان أدبيان أداتهما اللغة، فبينهما قواسم مشتركة تمتح في الغالب من بحر التخييل، ولكنهما في إطار المنهج الإجناسي يتوهج كل منهما بفرادة نوعية تعتمد العنصر المهيمن -بحسب النظرة التقليدية لنظرية الأدب- تقوم على أساس نظري يتكئ على جملة من التمايز بينهما يبرز إشعاع بعضها عند قوم ويخفت عند آخرين، يتأرجح بين الخيال المجنح والموسيقا المطربة والعقل والعاطفة على ما بينها من توافق وانسجام.بيد أن النقد الحديث بدأ يبحر في محيطات اللانوعية، فشرع في الحديث عن شعرية النص وأدبيته بعيدا عن التصنيفات الإجناسية التي انشغل بها النقد ردحا من الزمان؛ حتى وصل عند بعض النقاد الأفذاذ إلى مرحلة اجتراح مصطلح لافت ذي طاقة تجريدية هو (جامع النص).
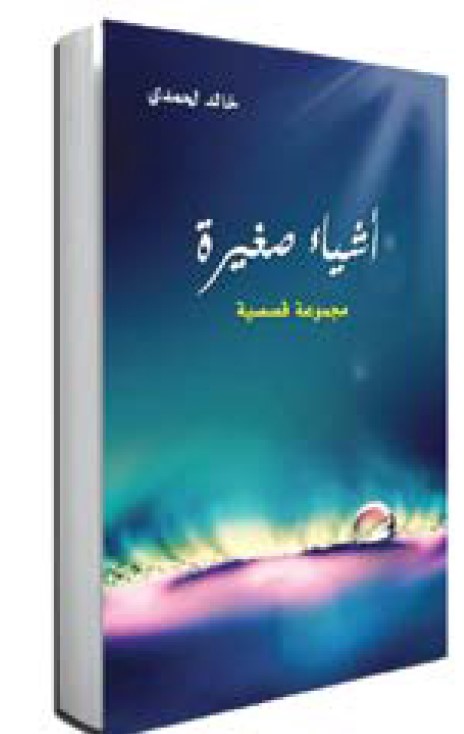
وبعد هذا هل نستطيع إلغاء الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر ؟
ثم هل نجرأ على منح كل منهما خصوصية إبداعية قاطعة مانعة ؟
وبعد كل هذا هل نستطيع أن نقول جازمين: إن الشعر شعر، وإن النثر نثر؟ لا يمكن أن يلتقيا مثلما يستحيل أن يلتقيَ الخطان المتوازيان ما دامت السموات والأرض.
ففي ميدان الأدب لا مكان للمستحيل، وإلا لأضحى الأدب علما من العلوم الطبيعية، وافتقد أبرز ما يميزه عن سائر الفنون والعلوم: الخيال والعاطفة.
لهذا كله أصبح أمام الأديب مجال واسع للتعبير عن خلجات نفسه وسوانح فكره وجوانح خياله من خلال طرائق التشكيل اللغوي التي يرتئيها مناسبة.
وعلى الرغم من ذلك تظل قضية الجنس الأدبي مادة نظرية تعتمد التصنيف الذي يتخذ الأسلوب التعليمي منهجا تنظيريا؛ ليقول كلمته الفيصل: هذا النص ينتمي إلى جنس النثر وذلك النص ينتمي إلى جنس الشعر.مع التأكيد على استحالة امتناع التماهي بينهما.
هذه مقدمة أحببت أن ألج بها إلى تجليات أشياء خالد لحمدي الصغيرة.
خالد قاص يكتب القصة القصيرة بشغف، ويهيم بصياغتها هياما لا حدّ له.فهاهو في باكورة إنتاجه (أشياء صغيرة) يتلمس خطاه في متونها القصصية تشكيلا وتجريبا؛ فيغمس قلمه في جمرة الإبداع ليشتعل سردا ويضيء شعرا.
وإذا كان أجدادنا الأقدمون يحتفلون بولادة الشاعر حين كان الشعر ديوانهم الأوحد، فحريّ بنا في زمن السرد أن نحتفي بولادة السارد.
وإذا كان للشعر فتنته في زمان الوصل والانصهار في بوتقة العشق، فآن للسرد أن تكون له فتنته الخاصة المنبثقة من بوتقة الذات الشاعرة والمتشظية في آفاق البوح السردي والمتماهية في فضاءات الكلمة التي تُدرَك بوصفها كلمة حسب حين تتجلّى الشعرية في متونها، والمتساوقة مع الكلمة بوصفها صنوا لشيء مسمّى على أساس المرجعية التاريخية.
لفت نظري في هذه المجموعة أمران:
الأمر الأول: عتبة العنوان (أشياء صغيرة).
الأمر الثاني: النوعية المراوغة بين السردية والشعرية.
أما الأمر الأول فيثير مسألتين جوهريتين في إطار العنوان:
المسألة الأولى: تطابق عنوان هذه المجموعة مع مجموعة سابقة للقاصة الفلسطينية سميرة عزام(1926-1967م) فقد نشرت دار العلم للملايين ببيروت مجموعة (أشياء صغيرة) لسميرة عزام في عام 1954م. وأنا على يقين أن مبدعنا لم يطلع عليها وإلا لأضرب صفحا عن هذا العنوان، ولا ضير في تطابق العنوانات؛ فلكل عنوان شعريته وتجربته.وصاحبنا ليس بدعا في هذا الأمر فقد تطابقت عنوانات في كتب أسلافنا، وما(معاني القرآن) إلا أنموذج مثاليّ لهذا التطابق، ولكن القريب إلى أذهاننا في العصر الحديث ولاسيما في مجال الفن القصصي رواية (المصابيح الزرق) لحنامينة(1954م) ومحمود تيمور(1960م).
المسألة الثانية:
توهج دال عتبة العنوان الأول (أشياء) في متون المجموعة جمعا وإفرادا، فقد تكرر في عموم المجموعة ثلاثا وخمسين مرة إجمالا: اثنتي عشرة مرة بصيغة الجمع، وإحدى وأربعين مرة بصيغة المفرد تفصيلا. فجاءت منكرة في اثنين وأربعين موضعا ومعرفة (بأل) في ثمانية مواضع، ومعرفة بالإضافة في ثلاثة مواضع.
وهذا التكرار يشير إلى هاجس دلالي يهجس في أعماق المبدع له صلة بالدال (الشيء).
ودال (الشيء) بعيدا عن تفريعات الفلاسفة وتهويمات الصوفية يحيل بمعناه المعجمي على كل موجود حسًّا كالأجسام، أو معنىً كالأقوال.
وقد ورد هذا الدال في محكم التنزيل شاملا كلَّ الكائنات والأحداث والأمور فكلمة شيء من أعم الكلمات وأبعدها عن التعريف بل تكاد تكون نكرة بإطلاق.ونشبهها بشيء من التجوز بالماء، فكما يتخذ الماء شكل الإناء الذي يوضع فيه نراها تتخذ جنس ما تطلق عليه؛ لهذا تطلق في التنزيل على كل ما سوى الله مهما تباعدت الأجناس، كقوله تعالى﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ﴾ الإسراء44.
بيد أن هذه الكلمة بكل تجلياتها في متون(أشياء صغيرة) تتوهج بإشعاع إبداعي خاص له نكهته وله بريقه الشعري، وتلقي بظلالها الإيحائية في عموم المجموعة.

وإذا تأملنا الإحصاء السابق لهذه اللفظة بحسب ورودها في المتن الإبداعي سنرى غلبة التنكير على هذه اللفظة، وللتنكير جماليته الخاصة وله فوائده الإبداعية، فهو يستخدم في مواضع لا يمكن للتعريف أن يقوم بها لا من الوجهة اللغوية ولا من الوجهة البلاغية والدلالية.
أما الأمر الثاني فله صلة بتماهي السرد مع الشعر، على ما يحمله الأول من سبق التصنيف الإجناسي بوصفه موصوفا وبوصف الشعر صفة له وذلك بالإخبار عن هذا المتن بعدّه سردا يحمل نفسا شعريا.
وهذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن ماهية تداخل الأجناس الأدبية في أدبنا الحديث الذي يعدّه بعض الدارسين من جملة التقنيات الخطابية الحديثة.وقد غامر بعض المبدعين في توليد نصوص ملتبسة الهوية مثلما صنع إدوار الخراط في نصوص كثيرة تداخل فيها السردي والشعري وأبرزها نصه السردي المتميز(ترابها زعفران) الذي وسمه بجملة(نصوص إسكندرانية) موغلا في إبهام هوية هذه النصوص المتناسلة سردا والمتجلية في إهاب شعري.
خاض خالد لحمدي في معظم نصوصه السردية هذه، مغامرةَ التماهي بين السردي والشعري مع محاولة إمساكه –بقوة- بتلابيب نصوصه السردية.ولكنه كان في الغالب الأعم يرخي راحتيه لشآبيب الشعر المتدفقة إليه من ذاته الوالهة والحيرى بين الأنا والآخر.
وقد حاول خالد في بعض نصوص هذه المجموعة اختراق السور الوهمي الفاصل بين الشعر والسرد باعتماده الشعرَ بنيةً منظِّمةً لبعض نصوصه السرديّة؛ وكأنه بهذا يسعى إلى خلق حوار بين ما هو سردي وبين ما هو شعري دون أن يخلّ ذلك بماهية نصوصه السردية وخصوصيتها البنائية.
من المعلوم أن الغيرية مهيمنة على السرد اتكاء على سطوتها القائمة منذ القدم على ضمير الشخص الثالث(هو) والمنسجم مع الفعل الماضي (كان)؛ ولكي يتغلب المبدع خالد على هذه السطوة الغيرية حاول أن يستقطب كل ما أمكنه من (أنوية ضمائرية) تتجابه فيها (الأنا المذكر) مع (الأنا الأنثى) لتتشكل وجدانيا في تلافيف هذه المجموعة المتمثلة في قصص مثل(تفاصيل، الأكفان، لن أكون، جينز أزرق، نهايات مباغتة، لم أكن إلا امرأة، تسابيح لمملكة النور)؛ لتنزوي الذات الغائبة (هو) المتمثلة في الآخر(الذكر / الأنثى) والذات المخاطبة (أنت) المتمثلة تحديدا في الآخر (المخاطب الذكر) في زوايا سردية يخفت فيها صوت الشعر المنبثق من (الأنا) فيعلو صوت السرد الغيري.
وفي غمرة انشغال المبدع بهذا التماهي بين السردي والشعري لم يغفل عن تحسس السمات المشتركة بينهما، فهو يحاول مجتهدا الموازنة بينهما، مع الاحتفاظ للسرد بكل مقوماته البنيوية المتكئة على دعامتين أساسيتين هما: مادة الحكي المعتمدة على أحداث معينة ولو في أضيق الحدود، وطريقة بناء هذه الأحداث مما له صلة ببنية زمن السرد والشخصية وسواهما؛ لتظل مهمة الشعر هاهنا مكتفية بمغازلة السرد حسب، دون أن تحدث هذه المغازلة اللطيفة شرخا في مرآة السرد عامةً.
وفي الأخير أستطيع القول:إن هذه المجموعة -بكل ما تحمله من أعباء تشكيلية ومعيشية تقتحم التجريب بنيةً، وتخترق المألوف دلالةً- تشكّل إضافةً جادة في مجال السرد اليمني عامةً وفي مجال السرد الحضرمي خاصةً.