نقد
أ.د. عبدالله حسين البار
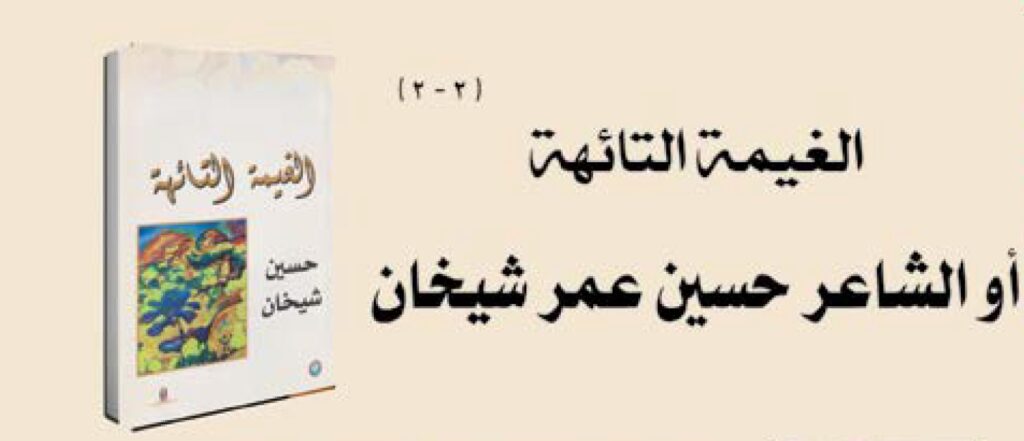
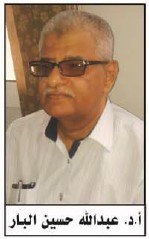
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 86
رابط العدد 7 : اضغط هنا
صورة الذات كما جلاها النص:
مفهوم الشعر عند شعراء الوجدان هو تعبير عن الذات الشاعرة. ولذلك تحدّثوا نقادًا ومبدعين عن (التجربة) وعن (الصدق الفني) وعن (مطابقة الشعر للحياة والحياة للشعر) وما إلى ذلك. وحكموا أحكاما على الشعر والشعراء معا, وصنفوهما تصنيفات شتى. فنفوا شوقي من جمهوريتهم الشعرية لأنك لا تعرف حياته من شعره كما تعرف حياة ابن الرومي – مثلا – من شعره, أضف إلى ذلك إشارتهم إلى أن ما يذكره الشاعر في قصائده هو وقائع يقينية حدثت وعكسها الشاعر في قصيدته. وهذه مسألة تستوجب نظرا. فنزار قباني مثلا تبدوا الذات المتكلمة في قصيدته (الرسم بالكلمات) منكسرة تعلن عجزها رغم ماضيها المغامر القوي, وفي قصيدته (إلى أجيرة) تبدو الذات المتكلمة متجبرة لحد الاحساس بالسادية المرضية في معاملة المرأة, وهو في قصائد يجري الذات المتكلمة بضمير المؤنث فيتحدث بلسان المرأة مراهقة وتلميذة وناضحة وامرأة حاقدة أو متسامحة أو ما شاء من الصور.
فهل نزار هو هذا كله, أو أن للشعر مفهوما آخر غير هذا الذي قال به دعاة (الوجدان) منذ العقاد والمازني وشكري حتى شعراء الحداثة ونقادها, فما حديث هؤلاء عن (المعادل الموضوعي) و (القناع) إلا صورة معادلة لصورة الشعر عند شعراء الوجدان ونقادهم وإن كان من وراء حجاب, ألم ينسبوا كل ما في القصيدة إلى الشاعر عينه لا إلى شيء سواه؟ لكن اللسانيات الحديثة حين هيمنت بآلياتها الإجرائية على مناهج النقد اسهمت في تقديم مفهوم للشعر غير ما سلف. فنظرت إليه من باب اللغة, فإذا هو تشكيل للعالم من خلال اللغة. وهنا يتراءى كل ما يستخدمه الشاعر في نصه من تقنيات لغوية لها وظائفها فيه, ولها غايات من الكلام. وعليه فإن دراسة (الذات) في الشعر وفق هذا المنظور تبدو مخالفة عن دراستها وفق منظور (الرومنسيين) لها. فإذا كان هؤلاء ينظرون إلى الشاعر على أنه حالة عصابية يتأملها محلل يفقه في علم النفس ما يفقهه علماؤه أو ما يقرب منه فإن النقاد اللسانيين يفيدون من معطيات علم النفس ليدرسوا شخصية (الذات المتكلمة) في القصيدة, ولقد تكون الشاعر عينه, ولقد تكون ذاتا أخرى زرعها الشاعر في القصيدة وترك لها حرية الحركة داخل النص. وهنا يكون الاعتناء بلغة القصيدة لدراسة ظواهرها, وما الشاعر إلا منتج محدود الحضور عند العملية التحليلية تنتهي وظيفته باكتمال انتاج القصيدة لتأخذ هذه طريقها من بعد إلى أفئدة المتلقين فينفعلون بلغتها ويتفاعلون معها على نحو يحقق لها مدى منفسحا من الشعرية وما جاورها من وظائف الكلام.
والناظر في شعر حسين شيخان يلفته طغيان استخدام ضمير المتكلم الذي ينبئ عن طغيان حضور (الذات المتكلمة) في كل قصائده. وقل قلة لافتة غياب هذه الذات في بعض القصائد.
وعلى الرغم من أن حسينًا كان شاعر ذوات لا شاعر معنى, فإن (الذات المتكلمة) تحضر في كل نص ومع كل ذات أخرى. فـ(أسماء) ذات لها صفاتها المائزة عن سواها من الذوات, وللمتكلم حضور بضميره وإن قل ذكره عددا. و(كلب) ذات في دائرة الاستعارة, له ما يميزه من سواه, وللمتكلم تفاعل معه وإن يكن في إطار الهجاء, و(مشرف الاسكان) و(نزيل السجون) و(هو) و(إلى صديق) و(المستقية) و(الحطابة) و(المساواة) و(العارية) و(بطلة الشباك) و(جالاتيا) كلها ذوات تتحدث إليها الذات المتكلمة أو تحدثت عنها, وسواها ذوات أخرى تفاوت حضورها وتنوع تفاعل هذه الذات المتكلمة معها. فهي حاضرة مع كل ذات غائبة أو مخاطبة. فالقصيدة عند حسين جدل بين ذات مخاطبة وذات متكلمة. أو بين ذات متكلمة وذات غائبة. وقل أن تستقل القصيدة بضمير غائب دون حضور للذات المتكلمة كما هو نسيج القصيدة في قصيدة (هو), إذ لم يكن للذات المتكلمة حضور, واكتفى الشاعر بجلاء صورة الآخر باستخدام ضمير الغائب ليلج به إلى دائرة الملحمية التي هي من متمّمات السردية التي تسهم في بناء النص.
وإننا حين نجيل النظر المتأمل في طبيعة الذات المتكلمة في النص من خلال ضميرها اللغوي مفردا وجمعا, متصلا ومنفصلا, ظاهرا ومستترا, ومن خلال صفاتها التي اتسمت بها في ثنايا القصيدة, ومن خلال عوالمها التخييلية, تتراءى لنا هذه متعددة الصور, متنوعة الدلالات. فهي في مظان من القصائد تبدو جامحة تتدفق مشاعرها كالسيل الجارف إن في غزل وإن في هجاء:
ياطريد الرباط .. يا بصقة الغيل .. سيأتي على الوقود اللهيب
يا وراء الوراء .. يا قيأة الخلف .. ستدري متى وكيف تتوب[1]
هنا ذات جمحت في خصومتها إلى حد الفجور, ولم يكفها كل ما قالته في أبيات القصيدة التي سبقت هذين البيتين. وما كان يدرء عنها هذا الجموح ارعواء عن الايغال في الشتم, ولا سيطرة على اندفاق الانفعال بحكمة وروية.
وهذا جموح لا يختص به هاجس شعري دون آخر, بل هو سمة في الذات حين يستفزها غضب أو يحركها هوى لا يحد انفعاله:
أمشي وراءك لا أكل :: وشموخ نفسي مستذل
رحالة هيمان بعدك لا يحد هواي عقل
رشد الكهولة قد قبرت, وها أنا ذا اليوم طفل
أتسلق الجبل الذي تتسلقين, ولا أمل
ولكم تعثر بي الطريق وزل بي قدم ورجل
وتشققت قدماي أدماها من الأشواك غل
ولكم وشت بي الريح ضاق الدرب بي وانسد دغل
فهل الجماد يغار؟ حولي ههنا غدر وختل
هذي ضريبة رحلة للحب بالآلام تحلو[2]
هنا تمتزج الذات بالجماد في روح استحيائية, فتمنح الأشياء الجامدة روحا بشرية فتصدق كالرجل البدائي أن لها ما للحيوان عامة وللإنسان خاصة أرواحا تسكن الصخر أو الشجرة أو تتردد في أصداء الكهف, فإذا بالريح تبدو واشية تثير غيرة سواها منها, وإذا الاشواك تدمي قدميها لغل دفين يحرقها, وإذا الدرب ضائق بها صدرا, وكل جماد يغار منها يدير حوله مؤامرة كلها غدر وختل. ومن هنا تزيد هياجا وتزيد جموحا فلا ترعوي عما انتوت فعله.
وتلك الذات الجامحة لا تقبل حين تغضب بأقل من منزلة (زيوس) رب الرعد والصواعق والسحب والامطار:
فإذا عصيت ولم تصل فمعي :: في قبضتي الشابوك والصمل
وإذا هزأت بها فملء يدي :: شهب, وبين أصابعي زحل
ولي النيازك كن على حذر :: وعلى رمادي يحرق البطل
وإذا غضبت تطايرت أمم :: وانهد كون .. وانطوى أجل[3]
هذه الصورة التي يرسمها الشعر للذات المتكلمة جامحةً متدفقةً في غضبها السيال تقابلها صورة أخرى تبدو فيها تلك الذات حائرة بين الهدى والضلال, بين العفاف والفجور, بين (المهادنة) و(الرفض). وهي حيرة نفسية تعترف بها الذات ولا تجد منها مهربا:
تعالي إلى معبدي في الضفاف :: ليحيا بأنفاسك المعبد
فقد تهت بين الهدى والضلال :: ولم أدر كيف يكون الغد[4]
ولقد تقلبت الذات في غبار الخطايا انصياعا لصرخات غرائزه وعوائها في داخله, وما استطاع الاعتصام منها بصلاة أو جبل من الصبر والاحتمال, فغرق في أعماقها, وحين آب إليه صفاؤه لم يكن بد من الاعتراف:
كأنه بعدما أرضى غرائزه
وما أطاع الهوى والنفس ما عتقا
وما هوى الحسن ما استوحى مفاتنه
وما تحدى لوزن شارد خلقا
ومالها بخصور كلما رقصت
تواثبت نحوه لحنا بها شهقا
وما ترنح مغشيا على شفة
يستقطر الوحي مخمورا به شبقا
لكم عصى النفس كم أرضى غرائزه
وكم أضاع لإشباع الرويّ تقا[5]
لكنها على الرغم من تهتكها لا تزال تقبض على بقايا من خلق رفيع تسمو به على تلك المباذل والراذئل:
فلا تقولي شاعر ماجن
لا يستحي لم يخش لم يعرق
بقية من خلق لم تزل
تضيء في نفسي وطهر بقي[6]
وإنما استمرأت الذات – وهي شاعرة – هذا الانغمار في ماء الخطايا رغبة في التحرر من قيود الأخلاق – دينية كانت تلك القيود أو اجتماعية – فالفنان في نظرها يفعل ما يشاء ليقول ما يشاء, وليس من واجب لازم يدرؤه عن ارتكاب ما يخرج به على أعراف المجتمع وقيمه:
لا شيء للفنان غير الهوى :: والحب فوق العقل والمنطق[7]
إن لهذه الذات قيمها الخاصة التي – وإن لم تعلن عنها صراحة, أو تمارسها في واقعها المعيش – تفترض من الآخرين أن يعلموها ويدركوها ولو بالظن دون اليقين:
جهلت سلوكي لو عرفتي ترفعي
لأنكرت رأيا خاطئا ما له أصل[8]
ومن هنا كان لابد من الجهر بطبيعة ما ترى تلك الذات والإعلان عنه ليعرف الآخرون سموها
لقد عشت بالذهن المجرد في الذي
كتبت, ويكفيني الخيال أو الظل
وحسبي من الحسن ابتسامة زهرة
أمادت بدرب أم تباهى بها حقل
وترنيم عود, أو رنين أساور
وعجز عوى عند الزفين له حجل
ونكهة عطر أو تمايل برقع
وثوب لصيق خلفه شرد العقل
وضحكة ثغر فيه أجراس جنة
ترن فينهار الوقار ويختل[9]
وقد تبلغ الحيرة في نفس هذه الذات أن تنقض في قصيدة ما سعت إلى توكيده ففي (الحطابة), وقد أعلن فيها ما أعلن من جهر بالاشتهاء, وحرص على طلب الوصال الشديد لأنه (لا يطيق الضعف حين يحين وصل), يأتي في أخر القصيدة خطاب متسامٍ على الشهوة الرعناء, والتهتك المبتذل:
لا تخطئي بي الظن :: في الأعماق أخلاق ونبل
روحي إذا ما انهار بي جسد لتسمو بي وتعلو
وأعيش بالذهن المجرد ما أنا يا أخت بغل
إني برغم تهتك الفنان لي بالطهر وصل[10]
ومن قال إن هذه الذات تحمل روح بغل لتكون إياه؟ إنها مفطورة على جبلة إلهية ألهمتها فجورها وتقواها, فتأذت من أشواك الفجور حين ارتضته, ونعمت بورود التقوى حين اعصمت بها وآثرتها على الهوى. ولذلك سعت (الذات) إلى الابتهال إلى الله متضرعة:
يا إلهي : نصف قرن مر بي
في ضلال .. رب هل تقبلني
في ضياع أنا أهواه .. وكم
بين شطيه رست بي سفني
نصف قرن في مجون عابث
حامل كل خطايا الزمن
في انطلاق نزق مستهتر
غارق في نزوات البدن[11]
فهل هذا اعتراف يفضي إلى توبة نصوح؟! وأنى ذلك, وما زالت بواعث الضياع في داخله لم تكف عن النبض والحركة؟
قلبي الأرعن إن مر بي
خيط حسن نحوه يسبقني
وإذا حاولت أن أكبحه
عاد في موضعه يلسعني
هو ينقاد لجفن عابر
وعلى الأهداب كم علقني
وأرى حتفي إذا ما مر بي
صدر أنثى فوقه يصلبني[12]
فمضت في حيرتها.. وعزاؤها أنها بشر:
ولا أدعي أني ملاك فما أنا
سوى بشر فوق الغرائز قد يعلو
وأن الفنان فيها له من الحق ما لا يكون لسواه:
أبيح لنفسي ما يباح, وإن يكن
من الغبن للفنان تحريم ما يحلو[13]
على أن هذه الذات من الرقة يبكيها ما يبكي الآخرين, وهي من صفاء يعمها, ومن وضوح في الرؤية, لا تطيق نفاقا, أو تتعامل مع الآخرين من وراء قناع. فإن أحبت أحبت بصدق, وإن بغضت بغضت بعمق وشموخ:
أنالست أملك غير وجه واحد
غير له وجه خفي آخر
قلبي بتاريخي وجغرافيتي
في أعيني – يجثو أمامك – ظاهر
وبكل قاراتي التي لم تكتشف
أرشيف نفسي في فمي يتناثر
وجهي يعبر عن خفي مشاعري
مالي قناع للمشاعر ساتر[14]
والذات المتكلمة في نصوص الديوان لا تخفي نرجسية مطوية في أعماقها تجعلها تمنّ على المرأة بأنها من خلقها, وتدل الآخرين على محاسنها كلها:
أأنت, ألا تدرين أني بأحرفي
خلقتك من لا شيء هل كنت من قبل
تخطتك من قبلي العيون وحينما
بعثتك في شعري أحس بك الكل
ولو شئت يوما أن أميتك كان لي
فمن كان غيري في المخاض له الفضل
حملتك في نفسي ولم يحمك امرؤ
سوى النفس, عز المورثون, فهم قلُّ
وتلك نزعة مكتسبة من قراءة شعر نزار, لكنها غدت مع الأيام خصيصة نفس تتغنى بها الذات جذلانة.
الهجائيات:
اشتمل الديوان على قصائد في الهجاء عددها خمس هي (نزيل السجون, وهو, وإلى صديق, وتألهت, وكلب). ومقطوعة واحدة قوامها بيتان, وعنوانها (محامي) – كذا رسمت في الديوان, وصواب رسمها (محامٍ) لأنها اسم منقوص يحذف ياؤه عند الرفع وعند الخفض-.
وهذا عددٌ ضئيلٌ لشاعرٍ عرف عنه تقديره لموروث شعر الهجاء, وولوعه به, ناهيك بنفوره من كل صور القبح التي تحيط به على كل المستويات. فهو موكّل بالبحث عن صور الجمال مشغوف بالتعبير عنها, فإن لم يجدها هجا ما وجده من نقائضها وذم أصحابها.
لكن هذه القصائد الخمس لا تنبئ عن منظور شامل لمفهوم الهجاء في خلد الشاعر لأنها صدى انفعال شخصي باعثه الغضب لكبريائه التي مسها أحد بجرح, أو عناها صديق بإخلاف وعد فظن الشاعر في ذلك استهانة به, أو لمجرد خلاف في رأي انتصر فيه آخر بحجة فأبت الذات الشاعرة القبول بحجّةٍ فصوّر لها انفعالُها الغاضبُ الموقفَ على غير وجهه الصحيح. فأفرز كل ذلك قصائد نفث فيها الشاعر حِمَمَ نفسه الغاضبة, وجلد بها ظهور خصومه حتى أوجعها فاستراح. فهي إذا لا تصدر عن رؤية شاملة للحياة فتحيط بماجريات الوجود سياسيّةً كانت أم اجتماعيّةً كالتي نجدها عند أبي العلاء ولزومياته من الأولين, والتي نجدها عند شعراء كالسياب وبلند والبياتي ونزار والبردوني في المتأخرين. إنه يصوغ موقفه الشخصي من ذات بعينها يستهجن منها صفة أو يذم لها موقفا في قصيدة هجاء شخصية, فيتقاصر هجاؤه ذلك عن أن يغدو صورة تمثل (جمعا) يتكثف وجوده في شخص واحد (كبخلاء) الجاحظ مثلا أو (بخيل) موليير, حيث تتجمع الأشباه بنظائرها في ذات واحدة تصبح رمزًا, أو معادلًا موضوعيًّا لأمثالها. وذلك سبب انحصار الهجاء في القصائد الخمس على بعدٍ شخصيٍّ لم يتجاوز الذات المعنية ويتعالى عليها. وهو وإن لم يعين ذلك المهجو باسم علم ولا بكنية ولا بلقب فإنه يسمه بعددٍ من الصفات منها الهلاميّ الذي لا يعين شيئا من مثل (نزيل السجون/ خبيث/ شيخ الخنا/ رخيص الضمير/ كومة القش/ غبي/ ضيق الأفق/…). فهذه الصفات عامة لا تعين مهجوًّا, ولا تعطي دلالة واضحة عن وجود كائن حي تجلو تلك الصفات هويته وتحدد شخصه. على أنه يستخدم من الصفات في مظان أخرى ما يحدد هُويّةً وشخصًا من مثل قوله: (طريد الرباط/ بصقة الغيل). ناهيك باجترائه على ذكر مفرداتٍ هي من البذاءة بحيث يعف اللسان عن لفظها من مثل قوله: (قيأة الخلف/ نفايتي/ قمامة…) وهذه أنقاها لفظا وأنآها عن الفحش. على الرغم من أن استخدام مثل هذه المفردات ليس واجبا شعريا. ولعل العفة في استخدام اللغة في هذا المقام أولى بالشعر, وفاعليته أعمق. قال أبو نواس هاجيًا أحدهم:
بما أهجوك لا أدري :: لساني فيك لا يجري
إذا فكرت في عرضك أشفقت على شعري
ومن مثله قول ابن الرومي, وهو من هو في شعر الهجاء:
لئن جاوزت في مديحك ما قصرت في منعي
لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع
ومن قبلهما هجا جرير بني نمير وأقذع, فقال:
فغضّ الطرف, إنك من نمير :: فلا كعبًا بلغت ولا كلابا
فقيل فيه إنه أهجى بيت.
على أن لمسلم بن الوليد احتقارًا شديدًا في هجاء أحدهم حيث قال:
أمويس قل لي أين أنت من الورى
لا أنت معلوم ولا مجهول
أما الهجاء فدق عرضك دونه
والمدح منك كما علمت جليل
فاذهب فأنت طليق عرضك, إنه
عرض عزرت به وأنت ذليل
وهجائيات حسين شيخان هي المعادل المقابل لغزلياته من حيث:
وفي هجائيات شيخان مفرداتٌ من العامة تتردد في ثنايا الأبيات استملاحا كمثل قوله: (الليف/ قعادة/ العطير/ زير/ غرب/ الخمير). وقد يلجأ إلى أعلام ضربت بها الأمثال في العربية مثل (عرقوب/ وفند), أو أمثال رددتها العامة كقولهم: (الله يخلّي لآل عامر طَفْلَة).
وهو يعمد إلى المبالغة في تصوير حالة المهجو كصنيع رسامي (الكاريكاتير) حين يهزلون بشخصية ما. فهو يقول في أحدهم:
لا اندفاع الجمهور خلفك كالإعصار ضاقت بالشامتين الدروب[15]
ولو خرج أهالي (المكلا) بأجمعهم خلف ذلك المهجو ما صاروا اعصارا, ولا ضاقت بهم الدروب شماتةً, ناهيك بكونهم أرقى سلوكًا وأكرم خلقًا من أن يفعلوا ذلك بمهزوم قهرته الأيام وإن طغا وتجبر.
وخلاصة القول في هذا الهاجس إنه لا يزيد على كونه تنفسيًّا عن خصومة شخصية, أو انتصارًا لرغبة أعاق تحقيقها شخص بعينه أو ما أشبه هذا وذاك, ولكنه لم يصعد في الشعرية ليبين عن رؤية للحياة وموقف منها على مختلف الرؤى, فكرية أو سياسية أو اجتماعية, فظل هجاءً شخصيًّا ولا غير. وأين مثل هذه القصائد مما نجد في شعر أبي العلاء من هجاء يتسم بالشمول؟
لقد أفسد الإيغال في النازع الشخصي على شيخان هجائياته, وأفرغها من قدرته على التفاعل مع القراء حين يتأملون أبعادا أخرى فيها تتجاوز ذلك المنحى الشخصي. وإذا كان من المقدور عليه تشبيه صنيعه هذا بما صنعه كاتب عظيم كالجاحظ حين كتب (البخلاء), وبين الأثرين فرق. وما زال كتاب (البخلاء) موضع نظر من ذوي العقول الراجحة, وليس الحال كذلك مع (رسالة التربيع والتدوير) له. وقل في أهاجي شيخان شيئًا شبيهًا بهذا.
ولعلنا نجد هنا فسحةً لنتدبّر الحكم الذي قيّده أخونا وصديقنا الدكتور الصيغ من أن (في الديوان نَفَسَ الشعراء الكبار الذين يحمل شعرهم همًّا, وليس الشعر عنده ترفًا كما نجد عند الكثيرين)[16].
والحق أنّي لم أجد هذا الهمّ بالمعنى الذي يشير إليه قول الدكتور الصيغ في ديوان (الغيمة التائهة) قطّ. وكلّ ما هنالك أشعار هي صدى انفعالات ذاتية لا تدل على انشغال بمجتمع ومشكلاته ولا بحياة وقضاياها. وخذ على ذلك مثلا شرودا قصيدة احتواها الديوان عنوانها (إلى الحزب). وهو عنوانٌ لافتٌ من شاعرٍ لم تكن علاقته بالحزب (سمنًا على عسل) كما يقال, ممّا يثير الرغبة في قراءة القصيدة لمعرفة ماذا يقول النص؟ وكيف آن له أن يتكلّم بعد صمتٍ؟ وبم؟ ولكنّ قارئها يصاب بخيبةٍ, ويكابد انكسارًا حين يعلم أن الشاعر يشكو إلى الحزب حظره انتشار بيع القات في حضرموت وحدها دون بقية محافظات الجمهورية في ذلك العهد.
وما للمكلا قد ذوى في ربوعها
شذا القات حتى عاف أجواءها الشعر
وسيؤون لا الأجواء تلهب دانها
ولا الوحي في همس السواقي ولا السحر
وما ذنب أرضي حضرموت وما الذي
جنته المكلا أو شبام أو الشحر
أَأُوتِيت ما لم يؤت أهلي بأسرهم
أذنب بلادي أنّ شيمتها الصبر[17]
فأين الهم الكبير الذي شغل فؤاد الشاعر فكبر به لمنافحته عنه؟ أيكون في حظر نشوةٍ عابرةٍ همٌّ يؤرق شاعرًا ويدفع به لمواجهة مهالك وأخطار؟
وقل مثل ذلك في هجاء محامٍ تقاعس في أداء عمله, والأمر لا يحتاج إلا استبدال سواه به, وهو يسيرٌ لا يحار في فعله ذو بصرٍ محدودٍ.
ولكن النازع الشخصيّ حين يحرك الشاعر للقول يخرجه من دائرة عموم القول إلى خصوصه. ولقد يجوز له ذلك ما دام يرضي رغبة في نفسه. لكنه يتجاوز عنها حين يعود إليها بآخرة من الزمان فيستبعدها من شعره إذ يعده للنشر فما للناس وخصوماته الشخصية؟ وليس أولئك المهجوون بالشخصيات العامة ليكون للقول فيهم معناه وقيمته كما صنع أبو العلاء بهجائه رجالا كانوا يتّجرون بالدين ويدلسون فيه.
رويدك قد غررت وأنت حر
بصاحب حيلة يعظ النساء
يحرم فيكم الصهباء صبحا
ويشربها على عمد مساء
تحساها فمن مزج وصرف
يعل كأنما ورد الحساء
يقول لكم: غدوت بلا كساء
وفي لذاتها رهن الكساء
إذا فعل الفتى ما عنه ينهى
فمن جهتين لا جهة أساء
وصنيع شيخان في قصائده التي عرض فيها مشكلته الخاصة مع إدارة الإسكان شبيهة بهجائياته. وإن وصف الدكتور الصيغ تلك القصائد بأنها تعبير (عن همومه وهموم الكثيرين مع إدارة الإسكان في العهد السابق وعلى الرغم من أن الموضوع يبدو بعيدا عن الشعر إلا أن الشاعر صاغ فيه قصائد من أجمل الشعر وأحسنه, لأنه كان ينظر إلى الموضوع في إطاره الإنساني العام, ولم يكن يتعامل معه بوصفه مشكلة خاصة به)[18].
أما أن الشاعر (لم يكن يتعامل معه بوصفه مشكلة خاصة به) فليس بقول دقيق, والنص ينقضه. ألم يقل:
تركتنا في المكلا مالنا سند
عز النصير, وعز اليوم أحباب
فلا المحافظ يدري ما غشى بصري
وانتابني, وهو بي ما زال ينتاب
أنا القعيد بداري وهو يجهلني
تعطّلي خلفه داء وأسباب
معوّقٌ أنا لا أقوى على عمل
براثن الداء في عينيَّ والناب[19].
فعجزه عن حل مشكلته (الخاصة) هو الذي ولج به إلى هذا المضيق ولم يجد منه مهربا. فتوالت شكواه من حال بيته بعد أن تهدد بالانهيار:
قل للمحافظ بيتي مسه ضرر
وانهد سقف وجدران وأخشابُ
جفت خلاياه, واختلت به غدد
تمزقت منه أوصال وأعصابُ
يكاد ينقض فوق القاطنين به
في كل صدعٍ يُرى للموت سردابُ[20]
وسال الشعر بقصائد في هذا الموضوع دون أن تبلغ حد الهم العام فبقيت مشكلة خاصة تحدث عنها الشعر من حيث هي كذلك دون سواها. وهو موضوع الفقرة التالية من هذه القراءة للديوان.
مشكلة خاصة:
في العقد التاسع من القرن العشرين واجه الشاعر مشكلة خاصة تمثلت في تهدد منزله بالانهيار, فقد أهملت صيانته سنين عددًا وقل الاعتناء بترميمه بعد أن شمله – كما شمل سواه – قانون تأميم المساكن الذي أصدرته حكومة الجبهة القومية بعد استقلال البلاد في المنتصف الثاني من العقد السابع من القرن العشرين, ثم ورثت حكومة (الحزب الاشتراكي) تلك التبعة ولم تضع لها حلولا ناجعة ما بقيت حاكمة متسلطة. ولقد سعى الشاعر إلى إدارة الإسكان يبحث عن حل لمشكلته, وهيهات. فما كان منه إلا أن استل سيفا من قصائده, وأعلى صوته ملء الفضاء جاهرا بمشكلته, فخاطب أصحابًا ومسئولين ذوي شأن, وطلب وساطة كل ذي قدرة ونفوذ لإعانته على إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة. وكم رجا وتوسل وعاتب ولام وهجا وذم إلى حد السباب. ولم يُجْدِهِ الشعر إلا بعد لأيٍ وقلقٍ وإنهاكٍ.
ترك شيخان من قصائده في هذا الهاجس ستًّا, ومقطوعة مؤلفة من بيتين بعث بها إلى أخينا المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ عبدالله حسين الهدار, وكان يومئذ مدير إدارة الثقافة, ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب, ومن المقربين إلى عدد من ذوي النفوذ والسلطة, يرتجي منه حلا لمشكلته:
عضو اتحادك في المكلا ما زال يرجو منك حلا
وسـواه مهـدت الطريـــق لـه فكـان الصعــب ســهــــــلا[21]
أما القصائد الست فلها حال آخر, اثنتان منها (بائية ورائية) خاطب فيهما من رجا وساطتهما, وهو في الأولى صديقه (صلوح) ليكون همزة وصل مع المحافظ ليعتني بمشكلته ويجنبه شرا محدقا به:
لم يبق لي بعدك يا صلوح أصحاب
متى نراك؟ فنحن اليوم أغراب
تركتنا في المكلا مالنا سند
عز النصير, وعز اليوم أحباب
فلا المحافظ يدري ما غشى بصري
وانتابني, وهو بي ما زال ينتاب
أنا القعيد بداري وهو يجهلني
تعطلي خلفه داء وأسباب
معوق أنا لا أقوى على عمل
براثن الداء في عيني والناب[22]
ثم يعرج بعد شكواه من سوء حاله إلى جوهر مشكلته:
قل للمحافظ بيتي مسه ضرر
وانهدّ سقفٌ وجدرانٌ وأخشابُ
جفت خلاياه, واختلت به غددٌ
تمزقت منه أوصال وأعصابُ[23]
فهو مهدد بالسقوط, وفصل الربيع تنهمر فيه الأمطار فينذره بخطر, وصخور تتدافع عند جريان السيل تهز فرائصه وترعدها, ولا منجى إلا بتدخل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بترميم أو ما يشبه الترميم.
لو غيمة – وهي حلم الأهل في بلدي-
تحدرت, جاء طي الحلم إنذار
قل للمحافظ ما زلنا برقبته
حتما سيؤسيه لو مادت بنا الدار[24]
وهذه (الرائية) خاطب بها صاحبه (الهدار) ليشكو له من سوء ما صنع به مشرفو إدارة الإسكان, وانشغالهم عنه بتوافه الأشياء والأحداث.
فكيف ننجو و(باعلوي) منشغل
(كالبافطيم), ودور الناس تنهار
هذا بأمجاد تيم الغيل منشغل
وذاك أمجاده المسواك والطار
غطت ضخامته عينيه في كتل
من اللحوم جثت فيهن أبقار
ما عاد يبصر حتى ما يمر به
ولو كان حقا يرى ما انهد إعمار
وهناك قصيدتان وجههما الشاعر للمشرفين على إدارة الإسكان مباشرة, مهادنا ولائما في واحدة, هي (الدالية), وشاكيا متذمرا, وهاجيا في الثانية وهي (الرائية). وفيها أظهر سخطا من سوء معاملة أولئك المسئولين لفنان عبقري مبدع مثله:
أبطال حمير في السطوح مع الأشاوس من نزار
والباب ذو الأقفال تكسره الخلاخل والسوار
ولا ضير في ذلك لو كان (المشرف الثوري) واعيا بما يجب القيام به في مثل هذه الحالة, ولكنه:
يلهو كهارون الرشيد مع الحرائر والجوار[25]
وكأنه السلطان تشرب نخب غفلته الديار
يلهيه عنا نفس ما قد كان يلهي شهريار
فلم يطق صبرا, ولم يحتمل حنقه على هذه اللامبالاة, فانفجر هاجيا:
موهت إشراق الحياة سلبت أضواء النهار
أرواحنا صارت بسطحك سلعة للاتجار
في كف سمسار نسوق بين بياع وشار
من خلف ظهرك يا خليفة ألف مروان حمار
من خلف ظهرك.. لا تثر يا تنح ظهرك كالجدار
يا أجبن الجبناء حتى في اتخاذك للقرار
ولقد ابتأس حاله على ابداعه فرثى حاله وصور بؤسه وتعاسته في بلد لا يقيم للإبداع والمبدعين شأنًا عظيمًا كريمًا:
ما أتعس الشعر يا هدّار في بلدي
ما دام يقلق هذا الشعر صرصار
وهذه نغمة حرص على ترديدها في هذه القصائد الأربع:
مضى الجميع. وأقوام أتت ومضت
وشاعر القوم عند الباب بواب
أمضي من الوقت ما يكفي لملحمة
ما صاغها قبل إغريق وأعراب[26]
وقال في أخرى:
وترنحت فوق الجدار قصائد
واختل بحر كامل ومديد
ومعلقات هن كل نفائسي
شقت شرايين لها ووريد[27]
وبقيت قصيدتان, داليّة وقافيّة, كلتاهما في موضوع واحد هو مناجاة الغيوم المنذرة بالمطر لتبارح سماءه فينجو بيته من سيلها المنتظر.. وإذا كان تجمع الغيوم في فضاء بلد ما إيذانا بخير عميم فهو في نظر الشاعر المرعوب من انهيار البيت الآيل للسقوط إنذار خطير بشر عظيم.
يا حلم أهلي وصحرائي وأوديتي
اذكى انحدارك في أجوائنا القلقا
صحح مسارك ما في الدور من عطش
أعد إلى الزرع في ودياننا الرمقا
اعد إلى القمح في الوادي نضارته
وامنح سنابلنا الإنعاش والألقا
اعد إلى الطبل والمزمار فرحته
وامسح بجفن الرواعي السهد والأرقا[28]
ولذلك تراه ينفر من الغيم, ويرجو زواله؛ لأن في زواله عن سماء داره بقاءً للدار وساكنيها. وخيرٌ من هطول مائها على المكلا أن تذهب إلى البعيد البعيد حتى تنجو داره وديارٌ مثلها مهددة بالسقوط والانهيار.
أتخمتنا بالوصل فارتحلي
عنا إلى الأغوار والنجد
يكفي, لهوت بدورنا وبنا
فتوقفي. حاشاك أن تئدي
يا غيم ما بالدور من عطش
صحح مسارك في ذرى بلدي[29]
لقد ضج الشعر بمشكلة الدار المهددة بالسقوط, وأبلغ عن حالها بما هي مشكلة خاصة بالشاعر الذي ارتبط وجوده كله ببقاء الدار وسلامتها من الانهيار. وفي القصائد اشارات تنبئ عن ذلك: (بيتي مسه ضرر/ يكاد ينقض فوق القاطنين به/ جئنا نطالب بالصيانة للديار لا لنستجدي/ حسب داري أنا إعلان مقدم الصرصار لترتمي قبل ركب القادم الدار/ نبلع أقراص منع سقوط الدور, وملء جوفي من الأقراص مليار…). وتلك نظائر دلالية تدل على انحصار عرض الشاعر للمشكلة في إطارها الذاتي المحض. وحسبك إلى ما أنبأ عنه النص أن الشاعر حين ضمن حل المشكلة لم ينبس بكلمة في هذا الموضوع, واكتفى بما قاله فيه يوم كانت المشكلة قائمةً حيةً عنده. أَتُعدُّ قصائده تلك مما يندرج في باب (الهم) العام الذي ينشغل به كبار الشعراء كما قالت مقدمة الديوان ذلك جهرا؟!
إخوانيات وقطع متجاورات:
بقيت في الديوان بعض نصوصٍ لم يكتمل بناؤها لتصير قصيدةً. منها ما هو مشروع قصيدة لكن الشاعر لم يستغرق في نظمها فتاهت بين أوراقه, ولم يرجع إليها ليتمها, أو كأن احساسه بهواجسها لم تلحّ على وجدانه فبقيت على ما هي عليه, على الرغم مما في بعضها من خفق وجداني غير خافية شعريته:
يا ليل إنك صاحبي في محنتي
بيني وبينك عشرة وإخاء
وحكايتي في الحب أنت كتابها
والقارئون نجومك الغراء
أمشي على جمر الحرائق صامتا
للقا الحبيب لو الحبيب يشاء
يا ليل ذوبني السهاد كشمعة
تبكي وترقص فوقها الأضواء
وهناك أبيات قل أن تنبئ عن شعر حقيقي كالذي قرأناه في هاجسي (المرأة) و(الذات المتكلمة), ولذلك فهي لا تضيف إلى تجربته عظيما ولا حقيرا لأن الحصاة المعزولة لا تدل على عظمة الجدار ولا روعة بنائه.
وهناك قصائد وجدانية بعث بها لبعض أحبته يستزيرهم, أو يتفقد أحوالهم, أو يسأل عن غيبة تبحث عن اطمئنان:
حتى عديم النفس طمأنته
بأنك الأمس وصلت العراق
ولم تطمئن من غدت نفسه
هاربة منه وراء الرفاق
يا من سلبت النفس من أضلعي
لم يبق مني غير دمعي المراق
وحين ودعتك أحيا أنا
وقبلتي حين أصلي العراق[30]
وهذه (الإخوانيات) مما عرفه الشعر العربي في عصور متقادمة, والعبرة فيها بقدرة اللغة على تجاوز (الآنية) ولحظات المناسبة لينفسح مداها على الأعمق من المعاني والرؤى المنهمرة في الزمان. وهل قول أبي تمام مخاطبا صديقه علي بن الجهم:
إن يكد مطرف الإخاء فإننا
نغدو ونسري في إخاء واحد
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا
عذب تحدر من غمام واحد
أو يفترق نسب يؤلف بيننا
أدب أقمناه مقام الوالد[31]
إلا من هذا السمت العالي من الشعرية؟ ومن أمثاله أشعار لابن الرومي ومن لف لفّه. وكلها أدخل في نسيج الشعر العربي وسياقه الابداعي. أما اخوانيات شيخان فأبعد عن ذلك منزلة, وهي لا تزيد على مثل قوله:
يحلو بقربك مقيل ويطيب ويلذ لي ما دمت أنت قريب[32]
أو مثل قوله:
لا تلمني إذا تأخر ردي إنني مثلما علمت كسول
وأنا في تلهفي واشتياقي لكتاباتكم إليَّ عجول[33]
فهل في مثل هذا القول وأشباهه شجن الشعر وخفق الاحساس بالمعاني السامية المقام؟ أدع الإجابة عن ذلك للقارئ المطلع على الديوان.
وهنا أراني أضع سؤالا: هل ينبغي نشر كل ما خلّفه (الشاعر) على أنه تراثه الابداعي؟
أو أن ما يستحق أن ينشر هو ما أبدعته قريحة “عبقرية” واحساس عميق بالمعاني والرؤى؟
وعلى هذا فإن كثيرًا من (نصوص) الديوان كان ينبغي نخلها وغربلتها قبل الإقدام على ضمها للديوان ونشرها ضمن قصائده البارعات.
ولكن هيهات ذلك اليوم فقد سبق السيف العَذَل.
في بهاء القصيدة:
لا مراء في أن حسينا شاعر متمكن من صياغة الشعر, وله خصائصه الاسلوبية التي تميزه من سواه, وسأسعى في الفقرات التالية الوقوف على ما تيسر لي منها, وأبدأ بأولها:
تصنيف الشعراء في مثلثات ومربعات ودوائر عادة جرى عليها النقد قبل اللسانيات, وعد ذلك منهجًا مادام النقد يقوم على فعلي أمر محددين هما: صنِّفْ واحكمْ. وهذه معيارية تتحكم في إنتاج النص أو هي تفترض ذلك. فالشاعر إنما يتعامل مع اللغة والحياة تشكيلا وتكوينا ولا يعطي النظرية أدنى اهتمام, ولا يعيرها بعض اعتناء. لكن النقد هو الذي يسعى إلى ذلك, ويرى سعيه ذلك غاية مقصودة, ومطلبا أسنى. من هنا سعت مقولات النقد ما بعد اللسانيات إلى نقدٍ وصفيٍّ محضٍ, ويدع الحكم على النص مرهونا بمعطيات اللغة ومنطوق الكلام في النص.
والناظر في ديوان (الغيمة التائهة) يلفته غلبة الوظيفة التعبيرية على لغة الكلام في النص, وهي متأتية فيه من حلال حضور الذات المتكلمة في النص بضميرها وصفاتها في مقابل الحضور المحدود للآخر ذكرا أو أنثى, مخاطبا أو غائبا. وسأجلو لك ذلك من خلال الوقوف على ثلاث قصائد من قصائد الديوان, وأدع ما تبقى لدراسة أخرى تتوفر على دراسة (أنا الشاعر في ديوان الغيمة التائهة), تقوم على إحصاءٍ حسابيٍّ دقيق, ووصف نفسيّ يحلل طبيعة تلك (الأنا) وخصائصها, وهو ما لا يتسع له هذا المقام. وقد اخترت القصائد (المستقية “تحت الأمطار”/ شباك/ الحطابة) مثلا للتحليل وموضوعا له. ففي (المستقية) يوحي العنوان باحتمال وجود بعد سردي في بناء القصيدة يهيمن فيه ضمير الغياب بمختلف صوره, ولكن الاحصاء العددي لحركة الضمائر في القصيدة أنبأ عن شيء آخر. فقد جاء ضمير المخاطبة مرة واحدة في المتن (عراك غيم) ثم اختفت, ليتجلى عدد من الافعال هي (لقطاتٌ) في بنية الصورة الحرة, وكأن الشاعر حمل آلة تصوير متحركة, فتابع توالي الافعال وتلون صورها وتحولاتها المرئية على جسد (المستقية) لينسرب من ذلك إلى تتبع ذبذبات النفس وتفاعلها الشهواني مع تلك الصورة الماثلة أمام عينيه (سابقت خطوي الدروبُ/ ترنّحت مثلي الديار/ أعلنت أطماعي الحمراء عصيانها/ اجتاح اللهيب أشلائي/ دنوت للغيم الرضيع/ في فمي شبق/ تلهث داخلي الصحراء/ وقفت أستسقي السماء…). وتلك حركة مزدوجة منها الداخلي ومنها الخارجي, وفي كلتيهما يتوالى حضور الذات المتكلمة, ويهيمن حضوره بمختلف صور ضميرها فاعلا ومفعولا به, ظاهرا ومستترا, متصلا غير منفصل لتوكيد الرغبة في الوصول إلى تلك المرأة والالتصاق بها. يماثله في ذلك ما نجده في قصيدته (الحطابة) وللعنوان الوظيفة ذاتها وقد رأيناها في عنوان قصيدة (المستقية). لكن حضور ضمير المخاطبة هنا يفوق عدد حضوره في القصيدة السالفة, بلغ عدده الحسابيّ سبعة عشر ضميرَ مخاطبةٍ, ناهيك بصوتها الحواريّ الذي ينقله النص في اسلوب غير مباشر, لكنه حضور يتقاصر أمام طغيان حضور ضمير المتكلم الذي بلغ عدده الحسابي مئة وعشرين ضميرًا, وكأن الذات أمام صورتها النكرة في عيني المرأة الحطابة حرصت على جلاء صورتها بما يساعدها على تقريب بعيد وتيسير نيل عسير مرجوّ. أضف إلى شيوع الصوائت الطويلة في القصيدة مما يهيؤها للغناء على الرغم من وجود السردية في بناء بعض المظان. فتخفت لذلك الوظيفة المرجعية والوظيفة الانتباهية المتجهة إلى المخاطب غالبا لتهيمن على لغة النص وظيفة انفعالية تعبيرية تركز على ذات المتكلم تحديدا وتنحصر في صفاته ومشاعره.
ثم نقف على قصيدة (شباك). وهو عنوان حياديّ – ان جاز وصف كهذا – كونه يقبل احتمالات متعددة ومتناقضة. وهنا لا تخلو المخاطبة من حضورٍ لافتٍ يحدثه لها (المتكلم) في الأصل, فهو (الناهي) عن فعل ما لا يجب (لا توصدي/ لا تغلقي/ لا تسدلي/ لا تقولي/ لا تفرقي…), وهو (المستفهم) عن الحال الغامض, (ألم تحسي أنني أقتفي؟!), فغدا حضورها مرتبطًا بحضور ذلك المتكلم, وما يوجه من كلام. وعلى الرغم من ذلك فقد جاء حضور المتكلم طاغيا من جهتين, أولاهما استخدام ضمير المتكلم في صوره النحوية كلها, وثانيتهما في متعلقات الذات التكوينية, فالقلب الذي يخفق قلبه هو, والعين التي تبصر عينه هو, والشاعر المتهم بقلة الحياء وعدم الخشية من الفضيحة, والمدعي الطهر والنقاء إنما ذاك هو, وفي هذا دلائل غلبة حضور الذات في النص, وانشغال المتن بها مما يحصر وظيفة لغتها في التعبير عنها, وهو جوهر مبدأ المذهب الرومنسي دون سواه من مذاهب الإبداع الأدبي. سيقول قائل: ولكن شيخان وصف باتجاهه نحو مذهب (الفن للفن)؟ وأقول: إن ذلك ليس بمانعٍ نصَّه ولا لغته من أن يتسما بملامح مذهب شعري آخر هو ذو صلة وثقى بمذهب (الفن للفن), وأعني به المذهب الرومنسي, نجد ذلك عند كثير من أعلام الأدب في الغرب, ونجد أشباهه عند آخرين من شعراء أعلام في أدبنا العربي الحديث, وحسبك بعلي محمود طه, ونزار قباني مثلين شرودين في ذلك. ولعل حضور شعر نزار في شعر حسين أطغى. فهو يتناص معه تناصا ظاهرا كقوله:
يانهدها على فمي :: يعصر كرم الموسم
الذي يستدعي مطلع قصيدة نزار:
يا شعرها على يدي :: شلال ضوء أسود
مثلما يستدعي قول حسين:
يا مشرف الإسكان جئتك طالبا :: إصلاح ما قد أفسد التجميد
قول نزار, وبين المطلعين بون شاسع:
يا تونس الخضراء جئتك عاشقا :: وعلى جبيني وردةٌ وكتابُ
ومن الباب عينه قول حسين:
يدك التي التفت تطوقني :: وتلف جسمي المتعب المرهق
الذي يترسم خطى نزار في قوله:
يدك التي حطت على كتفي :: كحمامة نزلت لكي تشرب
والبيتان على تقاربهما متباعدان. فهما يتحدثان عن موضوع واحد وهو اليد التي مست المتكلم في شيء من الرقة والحنان. لكن تعبير حسين عنها موصول ببيئة وذات يغايران بيئة نزار وذاته. (يد امرأة) حسين التفت كأنها أفعى على رقبته فقربت به من حال الاختناق, وطوقت عنقه كأنها عنق كلب مطوق بسلسلة تقيده, (ولفت جسده المتعب المرهق) وكأنها كفن يدفن الجسد به بعد استكمال تكفينه. أما (يد امرأة) نزار فحمامة حطت على كتفه لتلفته من استغراقه في التفكير بعيدا عنها, وقد نزلت تلك الحمامة لتشرب منه, وهذا أقصى حالات الاطمئنان وانتفاء الذعر.
لكن لا لوم على حسين, فالشاعر إنما يصور كما قال ابن الرومي (ماعون بيته), وما يعرفه منه, وما يراه فيه. وما زالت المرأة المكلاوية في حاجةٍ لسنواتٍ طوالٍ لتضارع المرأة الدمشقية غنجا ودلال.
ب – في مرائي النص:
عمد شعراء الوجدان في الشعرية العربية الحديث إلى التشكيل الاستعاري حين يقصدون إلى الرسم بالبيان العربي, فغدت الاستعارة مقصدًا يتجهون نحوه لجلاء فكرة الاتحاد بين ذواتهم وبين صور الحياة والطبيعة والمرأة اتحادًا تمتزج فيه العناصر فتغدو كأنها ذات واحدة. ولهذا يكثر في أشعارهم تعبير من مثل (الشمس الذابلة/ والوردة الباسمة/ والقمر العاشق/ وما إلى ذلك). على أن هذا لا ينفي وجود بنى الصور التشبيهية في أشعارهم, فهم من أوائل شعراء الحداثة الذين تجاوزوا التطابق الشعبي بين المشبهات والمشبهات به منذ عاب العقاد على شوقي ذلك في كتاب (الديوان جـ1). وهل يمكن لمتذوق شعر هؤلاء الشعراء أن يغفل عن مثل قول أبي القاسم الشابي:
عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد
كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد[34]
حيث تتوالى التشبيهات متجاوزة ذلك التطابق لتخلص إلى عالم فسيح من الدلالات المتدفقة المتنوعة.
أو هل يستطيع متذوق للشعر مستغرق في ظواهره البلاغية أن يصرف نظره عن روعة التشكيل البياني في هذين البيتين:
وإذا ما استخفني عبث الناس تبسمت وفي أسى وجمود
بسمة مرة كأني أستل من الشوك ذابلات الورود[35]
وهي من العمق والسعة بحيث لا تحيط بتحليلها صفحة من كتاب.
هم إذًا يجيدون بناء الصورة في إطار تشكيلها التشبيهي أو الاستعاري, لكنهم غلبوا الثاني على الأول, وتجاوزوا في الأول المألوفَ في الموروث الشعري فمنحوا لغة شعرهم خصوصيةً وتميزًا.
وما كان حسينٌ إلا واحدًا من هؤلاء. عمد إلى التصوير البياني كما عمد إلى استخدام الصورة الحرة في هيئاتها الثلاث (لوحةً ولقطةً ومشهدًا), فرسم بالكلمات صورًا شتى ومرائيَ متنوعة ضمنت لشعره بهاء تخييليا يدل على اعتناءٍ بلقاء المتلقي في حال من الاندهاش.
ولقد استخدم الصورة التشبيهية متجاوزًا ذلك التطابق الذي كان يقصده إليه شعراء الاجتراء عامة, فإذا الصورة عنده توغل في العمق الدلالي والإيماء الشعري إلى المعنى.
لا حاجزا أعرف أو فاصلا :: أنا هنا كالمارد المطلق
كالشر, كاللعنة, لا تتقى :: شراهتي, كالقدر المطبق[36]
والمشبهات بها هنا مجردات لا يحيط بها الحس ولكنها تسبح في تائهات المعاني فيتلقطها الابداع ليتفاعل معها المتلقي.
وقريب من ذلك حديثه عن مدى بلاده الفسيح وقد انطوى في وجدانه وتسرب عبر خلاياه (كرخيم الحدا/ كأنفاس وديانه/ كهمس سواقيه/ كالدان/ كأجراس نحلة). وتلك محسوسات منها المسموع ومنها المشموم, ولكن تصعيدها عن مطابقة الأشباه بنظائرها أوغل بها في عالم الإيحاء الذي رأينا صورة منه في استخدام المجردات في باب التشبيه.
وتجري الاستعارة في شعره كما جرت في أشعار أمثاله من شعراء الوجدان. وأبرز ما يلحظه قارئ شعره في تشكيل الاستعارة عنده انه يجري اقتران دوالها بين دوال كائن حي (حيوان/ طائر/ نبات) (بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد), مما يلج بالصورة الاستعارية إلى الاستحيائية animation. وقد يكون اقتران الدوال فيها بين دوال (تشير إلى خاصية بشرية والاخرى جماد أو حي او مجرد), مما يدخل الاستعارة في دائرة التشخيصية personification. وذلك من مثل قوله:
وعوت شراهات الجماد, وسابقت خطوي الدروبُ, كأنها أحياء[37]
دع عنك (كأنها أحياء) فهو تشبيه فضلة. وانظر إلى عواء الشراهة وإلى إضافة الجماد إليها لتر الشاعر وقد منح (الجماد) حياة فيها وحشية كالتي هي ممنوحة للذئاب, ولك أن تتصور أي شبق ذلك الذي شمل الأحياء والأشياء عند رؤية تلك المرأة المستقية. أما (سابقت خطوي الدروبُ) فتشخيص يبين لك مدى الحرص على السرعة للوصول إليها والظفر بها.
وتمرد الكبت الحبيس, وأعلنت عصيانها أطماعي الحمراء[38]
التمرد صفة في الانسان تلبسها الكبت فتشخص المعنوي المجرد في هيئة ماثلة أمام الباصرة. ومثلها عصيان الأطماع حيث اقترن المجرد بصفة بشرية.
وهو كثيرا ما يوغل في خياله فيتصور الجوامد كائنات حية تسكن أرواحها الخفية في أعماق ذلك الجماد كالريح والأشواك والأدغال, حتى لينسب للجماد غيرة وغدرا وختلا, وكأنه ذلك البدائي الذي لم يستطع تعليل حركة الأشياء من حوله, أو ذلك الطفل الذي اندمج مع لعبه فسكب عليها من روحه نفسا تحيا به وهي الجماد.
وتشققت قدماي أدماها من الأشواك غل
ولكم وشت بي الريح ضاق الدرب بي وانسدّ دغل
فهل الجماد يغار؟ حولي ههنا غدر وختل[39]
وعلى بهاء مرائيه التخييلية فقد تراه يقع في تكرار صورة بعينها ولا يسعى إلى تجاوزها إلى سواها مما يماثلها. انظر معي:
– واستحال الوجود أرجوحةً سكرى وتاه الوجدان في سبحاته
– وتهاوى القوام أرجوحةً سكرى تموج النهود في طياته[40]
– أرجوحةٌ سكرى لها لحني وعودي واحتد طبل[41]
وقد ياتي بالأرجوحة مجردةً من النعت, وقد يجيء بها جمعًا, وقد جرت مفردة كما رأيت.
ومن طرائقه في التصوير لجوؤه إلى الصورة الحرة في هيئة اللقطة. وهو يعمد فيها إلى اقتران الفعل بالاسم متخطيا اقتران الاسم بالاسم, ليفيد من ذلك معنى الحركة وتنوع الحال وعدم الثبات على هيئةٍ واحدةٍ, وهو ما يفيد اقتران الاسم بالاسم, وكأن الشاعر يحمل آلة تصوير سينمائية فيجسد بها المرائي في لقطات متوالية. أولا ترى ذلك متجسدا في قوله:
عرّاكِ غيمٌ شفَّ منه رداءُ شهقت له سحبٌ فساحَ فضاءُ
وتلملم الغيم المبعثر وارتمى خلف الرداء يصول حيث يشاءُ
عبر المضيق وفيه لامس ما اشتهت أرضٌ وما اجترأت عليه سماءُ[42]
… أولا تراها لقطات تتوالى في حركتها وتجددها حتى تكتمل الصورة, وتستقيم بنيتها؟ وفي الديوان من أمثالها كثيرٌ كثير.
في خاتمة الأقاويل
كان الشاعر حسين عمر شيخان واحدًا من ثلةٍ من الشعراء اتجهوا بالشعر العربي فيها وجهةَ التجدد والابداع, فتجاوز مع أترابه حالا من (الاستاتيكية) التي اتسم بها مجتمع حضرموت الثقافي والأدبي إلى حال من (الديناميكية) كانت تمثل في شعره أملا مرجوًّا ولكنه انكسر فخابت ظنونٌ, ونكص افتراضٌ رأى فيه منشودًا, فاكتفى بالموجود, وإن فيه لما يغني المحتاج حين يبحث عن قصرٍ مشيدٍ بين ركامِ طلولٍ وآبارٍ معطلةٍ. ولعلَّ حسينًا – وهو الشاعر المتفنن المبدع – قد ظلم شاعريته حين لم يعتنِ بما أنتج إلا في أقلّ القليل, فصار هو الموجود الذي دلّ بيقينٍ على شاعرٍ متفننٍ مبدعٍ اسمه حسين عمر شيخان, غيمة تائهة في فضاء الابداع في حضرموت.
[1] الغيمة التائهة: صـ30
[2] نفسه: صـ102-103
[3] نفسه: صـ 109-110
[4] نفسه: صـ147
[5] نفسه: صـ76-77
[6] نفسه: صـ83
[7] نفسه: صـ85
[8] نفسه: صـ94
[9] نفسه: صـ97
[10] نفسه: صـ107
[11] نفسه: صـ122
[12] نفسه: صـ123
[13] نفسه: صـ98
[14] من النصوص التي سقطت من الديوان. وعنوان القصيدة (الوجه الآخر)
[15] نفسه: صـ27
[16] نفسه: صـ8
[17] نفسه: ص8
[18] نفسه: صـ8-9
[19] نفسه: صـ 20
[20] نفسه: صـ22
[21] نفسه: صـ 111
[22] نفسه: صـ20
[23] نفسه:صـ22
[24] من القصائد التي سقطت من الديوان.
[25] من القصائد التي سقطت من الديوان
[26] الديوان:صـ25
[27] نفسه: صـ47
[28] نفسه: صـ79
[29] نفسه: صـ 43-44
[30] نفسه: صـ90
[31] أخبار أبي تمام: للصولي, تحقيق محمد عبده عزام وصاحبيه, صـ 62
[32] ديوان الغيمة التائه: صـ35. ولاحظ الخطأ النحوي في الشطر الثاني
[33] نفسه: صـ110
[34] نداء الحياة: أبو القاسم الشابي, كتاب الدوحة, عام2011م صـ91
[35] نفسه: صـ95
[36]الغيمة التائهة: صـ82-83
[37] نفسه: صـ16
[38] نفسه: صـ16
[39] نفسه: صـ103
[40] نفسه: صـ36
[41] نفسه: صـ105
[42] نفسه: صـ15