نقد
سالم فرج مفلح
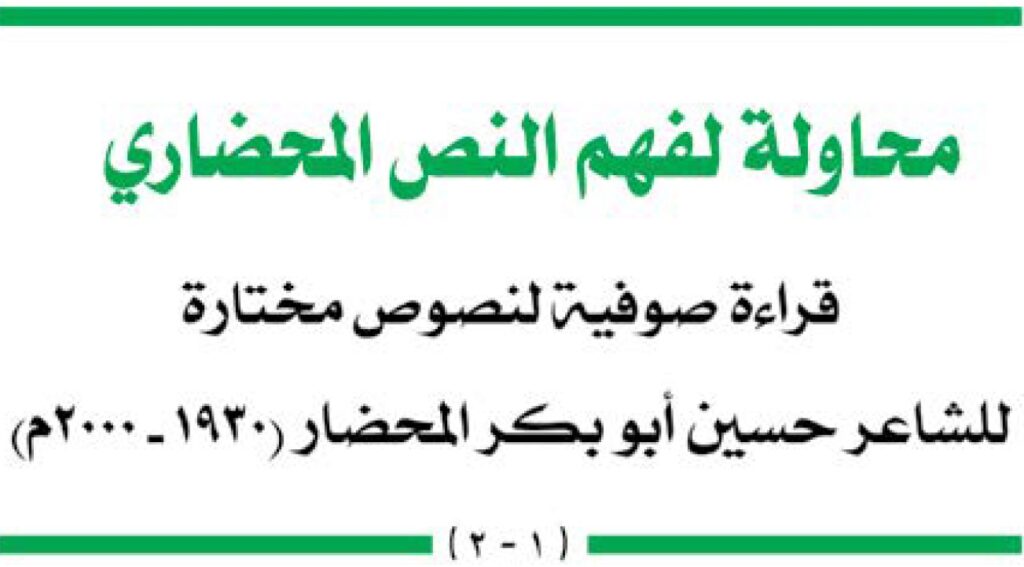

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 95
رابط العدد 7 : اضغط هنا
تأملت نفسي مليًا مرات كثيرة، وعلى مدى سنوات، وساءلتها في أمر الكتابة في الموضوع عنوان هذه الورقة، وطالت الحيرة، وظل التردد قائمًا في النفس والوجود، وكيف لا يكون حالي كذلك؟! وشاعرنا المحضار قد شغل الناس حاضرًا وغائبًا، أما حاضرًا فبروائعه الشعرية الغنائية وشخصيته القوية في نطقها وصمتها معًا، وأما غائبًا، فإننا وبعد أن غادرنا المحضار إلى العالم الآخر، ونحن نكتب عنه وعن شعره في كل مناسبة وفي لا مناسبة، ونحتفل بذكراه في كل عام مرة، وتقدم الدراسات وتنعقد الندوات….، إلا أن المتأمل لكل ما قيل عن المحضار وشعره وإلى اليوم، لا ينقص مثقال ذرة من جهلنا بحقيقة المحضار وأدبه وفنه، وظل المحضار غائبًا كما كان حاضرًا، ذلك العملاق الذي بالقدر الذي يشعرنا بقزميتنا أمامه، فهو أيضًا يذيقنا مرارة الهزيمة أمامه حاضرًا وغائبًا. ولعل خير مثال على عجزنا أمام النص المحضاري، هو أن يظل ما كتبه المؤرخ الأديب الراحل محمد عبدالقادر بامطرف في تقديمه لديوان المحضار (دموع العشاق) في طبعته الأولى سنة 1987م وإلى اليوم، هو الدراسة الوحيدة الجادة التي حاولت سبر غور المحضار وشعره وفنه، ولم نستطع بمعارفنا وخبراتنا المتأخرة المتقدمة تجاوزها بحال من الأحوال، والغريب الأغرب أن أيًا ممن كتبوا عن النص المحضاري استفاد علميًا مما كتبه مبكرًا الراحل بامطرف، من أجل فهم أفضل ومعرفة أقرب له. يقول الأستاذ بامطرف في نظرته للنص المحضاري: «إن الناس تذهب في تفسير أشعاره في استنباط الأغراض منها كل مذهب، ونؤولها تبعًا لانفعالاتنا وما كانت عليه حالتنا النفسية، ونأخذ منها شواهد الحال، وننفس بها عن موجدة نجدها عن أمور تعتمل في صدورنا، فننفعل بها على قدر قراءتنا وفهمنا، ثم نتجادل حولها، فنقتل ما قاله المحضار تفسيرًا وتأويلًا». ما قاله الراحل بامطرف هو عين الحقيقة أمس واليوم، في حضرة المحضار أو في غيابه، خاصة وأنه يتحدث بلغة الجمع، ذلك أن الأستاذ بامطرف فيما قاله إنما ينقل صورة مباشرة لحضور النص المحضاري فينا جميعًا، وهو في وصفه المكثف لذلك النص بوصفه (حمّال أوجه)، وقابلًا لتجدد القراءات ومناسبة الأحوال، قد أعطى شهادة مبكرة على أن ذلك النص إنما هو من النوع (الجيد) الذي يتمتع بكل تلك الصفات؛ نظرًا لـ(غموضه والتباسه)، وهو الأمر الذي يعني (فلسفية) ذلك النص؛ فهل يقول أستاذنا بامطرف بأن شاعرنا المحضار يصدر في شعره عن فلسفة ما؟ وأن النص المحضاري إنما هو نص فلسفي؟

يقول الأستاذ بامطرف: «المحضار رجل مسالم، وإن جنوحه للمسالمة يرجع إلى طبيعة روحه الفلسفية، فهو يرى أن مراد النفوس أحقر من أن نتعادى فيه أو نتفانى؛ ولذلك اختط لنفسه مجرى في الحياة أسماه (مجرى سفينة نوح)، وهو شديد الإحساس بأحوال زمانه، يشير إليها بكثير من الرفق وبُعد النظر، وفوق ذلك فهو ذواقة في صياغة أشعاره، ديدنه النظر إلى كل قضية من أكثر من زاوية». وإذا أردنا أن نلخص خصائص الفلسفة المحضارية كما رصدها مبكرًا الأستاذ بامطرف، والتي أعطت النص المحضاري نوعيته (الجيدة)، فإننا نجدها على النحو الآتي:
1- الزهد في الدنيا ومتاعها.
2- الدعوة إلى السلام والمحبة بين الناس.
3- وإذا كانت فلسفته تقوم على أساس أن مسلكه في الحياة هو مسلك سفينة نوح عليه السلام، فإن هذا يعني أنها تقوم على مبدأ طلب العناية الربانية، وهو مضمون الفلسفة والنشاط الصوفي.
كل تلك الخصائص التي رصدها الأستاذ بامطرف تعني أمرًا واحدًا، هو الفلسفة الصوفية، وإن كان لم يسمها باسمها. أما كيف انعكست تلك الفلسفة في أشعاره، فإن بامطرف يرى أن تلك الفلسفة هي التي جعلت شعر المحضار من النوع (الذوقي)؛ لأنه صادر عن نفس ذواقة ورؤية بعيدة للأشياء. غير أن الشعر الذوقي أو (الإشاري) هو فقط الشعر الصوفي، فهل النص المحضاري هو فعلًا نص صوفي ذوقي إشاري؟
قبل الإجابة على هذا السؤال المحوري في هذه المحاولة، لا بدَّ من الحديث عن الشعر الصوفي كما يفهمه أهله (الصوفية) الذين يقولون عن أدبهم (نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة) و(الإشارة لنا والعبارة لغيرنا)، ويقول فيه شاعرهم:
إذا أهل العبارة ساءلونا
أجبناهم بإعلام الإشارة
نشير بها فنجعلها غموضا
تقصر عنه ترجمة العبارة
فنشهدها وتشهدنا سرورا
له في كل جارحة أثارة
ترى الأقوال في الأحوال أسرى
كأسر العارفين ذوي الخسارة
ويقول ابن الفارض الصوفي الكبير في نفس المعنى:
وعني بالتلويح يفهم ذائق
غني عن التصريح للمتعنت
بها لم يبح من لم يبح دمه وفي
الإشارة معنى والعبارة حدت
ويقول أيضًا:
رموز كنوز عن معاني إشارة
بمكنون ما تخفي السرائر حفت
ويقول الصوفي الكبير عمر عبدالله بامخرمة موضحًا دور الرمزية في أشعاره من أجل فهمها:
خذ على مذهبي عند المجي والذهاب
واستمع زمزمة رطني ورمز الخطاب
ويقول في نفس المعنى الشاعر الصوفي الكبير (جلال الدين الرومي):
أهل الصورة غرقى في بحار كلامي
وأهل المعنى رجال أسراري
ويقول الشاعر الصوفي أحمد بن علوان:
نظر المحب إلى المحب سلام
والصمت بين العارفين كلام
جمعوا العبارة بالإشارة بينهم
وتوافقت منهم بها الأفهام
يَتَراجَعون بلحظهم لا لفظهم
فلذا بما في نفس ذا إلهام
هذا هناك وذا هناك إذا ترى
ولسر ذاكَ بسر ذا إلمام
وتقابلت وتعاشقت وتعانقت
أسرارهم وتفرقت أجسام
فيقول ذا عن ذا وذا عن ذا بما
يلقى إليه وتكتب الأقلام
سقط الخلاف وحرفه عن لفظهم
فلهم بحرف الائتلاف غرام
ألفوا نعم لبيك وائتلفوا بها
إذ لا وليس على الكرام حرام
أعرافهم جنوية أخلاقهم
نبوية ربَّانِيُوْنَ كِرام
شهواتهم ونفوسهم وحظوظهم
خلف وفعل الصالحات أمام
بسطت بهن لهم أكف بالعطا
قامت بواجبها لهم أقدام
فالسر علم والعقول أدلة
والرب قصد والرسول إمام
الشعر الصوفي هو الشكل الذى عبر به الصوفية عن أحوالهم ومواجيدهم وسكبوا فيه تجاربهم الذوقية من خلال توظيفهم الإشارة والرمز للدلالة على المعاني المقصودة، بعيدًا عن المعاني الواردة الظاهرة على سطح أقوالهم. والصوفية في إيثارهم الإشارة على العبارة، إنما فعلوا ذلك أيضًا لأن الإشارة تمتاز باللطافة والرقة والدقة التي تجعلها أكثر اتساعًا للحقائق العلية والروحية، بينما العبارة في كثافتها المادية تضيق على مثل ذلك، فضلًا عن أن التلويح سبيل إلى كتمان الأسرار الإلهية وصيانتها وضنًا بها على غير أهلها من المتصوفة، وعلى العموم فإن أولى خصائص الشعر الصوفي وأبرزها، هو ما يتعمده شعراء الصوفية ومنهم المحضار في سلوك سبيل الرمز والكناية وضرب الأمثال؛ مثل: (الحب مثل البحر تلعب به الرياح – شوفنا كما الطير لي هو دوب شادي.. – وهو كثير في شعر المحضار)، ليحمل الشعر بين طياته ما لا حصر له من الدلالات الخاصة، وهذا ما يصرح به شعراء الصوفية أنفسهم ومنهم المحضار كما سوف نرى، ويستخلص الشعر الصوفي إبداعه الأدبي من خلال اعتماده على (المماثلة في الشبه) -كقول المحضار: على ضوء ذا الكوكب الساري- اعتمادًا مباشرًا، وهو الأمر الذي يعطي الأدب الصوفي قيمة أدبية عالية، ولهذا نجد أن هذه المماثلة تسيطر على أدبهم، كما يعمد الشاعر الصوفي إلى استثمار تعدد الدلالة للكلمة، مثل قول المحضار:
وهم ع العسل واللبن من سمح ضروني
وبعده سقوني من القاطع وضروني
(ضروني الأولى: تعني عودوني. ضروني الثانية: تعني أضروني).
أو مثل قوله:
رعى الله زمن فيه أكرموني وودوني
وبالحب جابوني معاهم وودوني
(ودوني الأولى: تعني أكرموني. ودوني الثانية: تعني أعادوني).
أو مثل قوله:
ما بين عيني وبين النوم بادي
(بادي: على معنيين، الأول: تعني ظاهر، والثاني: تعني حضرميًا: حرب).
ويقيم على أساس تلك المماثلة والتعدد أنواعًا من المماثلات والموازنات والمطابقات، ولقد توصل الصوفية إلى هذا النوع من الشعر بعد أن عانى الصوفية الأوائل مثل الحلاج محنًا شديدة وصعبة لما صدر عنهم من (شطحات) كانت مثار حفيظة الفقهاء خاصة الذين أتقنوا إثارة الشكوك حول إيمان الصوفية وتوحيدهم الخالق تعالى، انطلاقًا من محاكمة شطحاتهم محاكمة فقهية صرفة، وهكذا كان ذلك الشكل الأدبي الذوقي الإشاري الرمزي هو الأسلوب الذى اختاره الصوفية لترجمة معانيهم وأحوالهم ومواجيدهم، بعيدًا عن لغة الناس والمعاني المتداولة التي لا تستجيب للمعاناة الصوفية إلا في شكل تلك الشطحات التي عانى منها الصوفية الكثير والكثير.
ومنذ القرن السادس الهجري أخذ الشعر الصوفي صفته الفلسفية، بعد أن أخذ الفكر الصوفي مضمونه الفلسفي الكلامي (الأسلوب الرمزي الإشاري الذوقي) الذي يهيمن على الشعر الصوفي، يعني أن العبارة فيه غير مقصودة في ذاتها، وإنما هي إشارة ورمز ذوقي لمعان وجدانية صوفية جاءت عن طريق الكشف والإلهام الإلهي لحالة من المعاناة الروحية لذلك الصوفي، وهذا يعني أن ظاهر النص الصوفي غير مقصود، وأن المعنى المقصود يمكن الوصول إليه من خلال الغوص في البنية العميقة للنص، بعد معرفة التصوف على حقيقته وكما يفهمه أهله، ومعرفة إشارات القوم ورموزهم واصطلاحاتهم وأحوالهم. وإذا كان الأستاذ بامطرف قد أعطانا -مبكرًا- مفتاحًا لفهم فلسفة المحضار، ومن ثم النص المحضاري من خلال تصوره عن المحضار وشعره، ومن خلال ما رصده من خصائص الفلسفة المحضارية من حيث هي فلسفة صوفية، فهل ترك لنا المحضار مفتاحًا يكون مصداقًا لفهم الأستاذ بامطرف ومتوافقًا والنص الصوفي الرمزي الإشاري الذوقي؟
الحقيقة أن المحضار كان سباقًا في إعطائنا أكثر من مفتاح لفهم فلسفته في الحياة ونوعية أشعاره الفلسفية، فإذا كان بامطرف قد كتب ما كتب عن المحضار وشعره في سنة 1978م، فإن المحضار كان قد خاطبنا في إحدى مراثيه سنة 1975م بقوله:
من طهّر النفس من وسواسها الخناس
وحب مثلي وآمن مثل إيماني
تصير عنده المآتم مثلما الأعراس
وتعيش فيه المحبة رمز ومعاني
في البيتين أعلاه يشرح لنا المحضار فلسفته في الحياة، فيقول إنها تقوم على تطهير النفس من أدرانها والسعي إلى اكتساب المحبة والإيمان الخالص بالله تعالى والتسليم له تعالى في كل أمر وشأن بحيث تستوي لديه الأفراح والأتراح والمآتم والأعراس، ولسنا في حاجة إلى القول أن تلك المساعي والصفات التي يسعى إليها المحضار في الحياة، إنما هي مساعي أهل التصوف والفلسفة الصوفية والنفسية الصوفية، فلا يكون التصوف إلا في النفس، ذلك أن التصوف إنما هو علم بما ينبغي أن يعرفه الإنسان من أمر نفسه وطبيعتها وآفاتها وخواطرها، وما تصفو به النفس وتسمو وترقى به من ألوان الرياضة والمجاهدة، ووسائل التصفية والترقية، ثم العمل بما علمه من هذا كله والتحقيق له في حياته الخاصة والعامة، في ما بينه وبين نفسه، أو بينه وبين الآخر، أو بينه وبين ربه، وذلك على وجه تتحقق فيه المثل الأخلاقية العليا التي ينتفي معها الشر ويتحقق فيها الخير. ثم إن المحضار يخبرنا في البيت الثاني بأنه قد أصبح في مقام تتساوى فيه لديه المآتم والأعراس، وهذا هو مقام التسليم بقضاء الله وقدره، وهو مقام عزيز لدى المتصوفة، وهو يعني سكون القلب تحت جريان الحكم الرباني بلا اعتراض أو جزع وخوف، وهو بلغة المحضار في إحدى قصائده (مسلم ما يهمه برقها أو رعدها القاصف)، أو قوله: (ما دام ربي معي مانا معول.. يحط مهما يحط الوقت ويشل.. كله سواء إن عدل عندي وأن جار)، وقوله في أخرى: (سلمت لله أمري.. ما با يسلط علي غيره ناهي وآمر).
وفي الشطر الثاني من هذا البيت يخبرنا المحضار بأن المحبة (ويقصد بها التصوف) تتبين وتنعكس في أشعاره رموزًا ومعاني ذوقية ذاتية معيشة على مستوى الداخل والباطن، تم سكبها في إشارات ورموز، وذلك هو أسلوب الخطاب الصوفي كما سبق بيانه.
كما خاطبنا في مرثية أخرى سنة 1977م متحدثًا عن أسلوبه الصوفي في أشعاره بقوله:
(1)
حسبي الإشارة في العبارة
أنا على التعداد مقدر
(بمعنى: ما أقدر).
يكفيك تسأل عن خباره
من كانوا به أخبر
ما تختفي الأنوار والأقمار
ليلة خمستعشر
اللول هو والماس ظاهر
ما تخالطه الصهاديد
(الصهاديد: الزجاج المكسر).
(2)
ليه حبوا الناس شعره
ليه قالوا إنه أشعر
عن من سبق قبله
لأنه ما تبجح أو تقعر
جاب الكلام السهل
حط وسط الكلام السهل سكر
وبعد ما رق وانطعم
وزعه في كل البراريد
(البراريد: جمع براد وهو الوعاء الذي يوزع به الشاي في الفناجين).
في المقطع الأول من النص أعلاه يخبرنا المحضار في صراحة تامة، بأن شعره إنما هو شعر إشاري رمزي ذوقي، ويخبرنا بأن العبارة فيه غير مقصودة في ذاتها، وإنما هي إشارة إلى معنى آخر، وأنه لا يستطيع أن يقول أكثر من تلك الإشارة لما يقصده، ويقول المحضار في إحدى قصائده: (يكفي من الرمز والتلميح)، ويقول في أخرى: (الرمز والتأشير يكفي.. سره على الناس مخفي.. بالعمد من ذات شفي)، أو قوله: (رعى الله أيام زينة معه في سعاد الزبينة.. لها سر بيني وبينه.. على الناس با اخفيه)، وقوله: (رمش عينه بريد المحبة… بين قلبي وقلبه… باقي الناس ما با يفهمونه)، وغير ذلك كثير. ثم يخبرنا المحضار بأنه يعلم أن مقاصده من المعاني عصية على إدراك العامة من الناس، وإنما يفهمها أهل الاختصاص في هذا الفن من المتصوفة، لهذا فهو يرشدنا للاستعانة بهم لإدراك تلك المعاني المشار إليها في أشعاره، إذ إنهم بها أخبر خبرة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ببضاعتهم.
بل نجد المحضار أكثر وضوحًا في هذه المسألة حين قال:
من شرب له كأس منه
حل ربطه ورموزه وأسراره
وفي المقطع الثاني يرى المحضار أن سبب إعجاب الناس بشعره يعود إلى بساطة ألفاظه العادية الشعبية البعيدة عن التبجح والتقعر، ثم مزج وخلط تلك الألفاظ لإلباسها معاني ذوقية رفيعة تتجاوب مع كل الأذواق والحالات.
وإذا كان شعر المحضار يعتمد على توظيف (الرمز)، حسب قول المحضار نفسه، فإن الرمز يحتاج بالضرورة إلى (التأويل)، والتأويل الرمزي للنص ينتج عنه بالضرورة نص مغاير للنص الأصلي، ولهذا لا غرابة أن تكون محصلة تأويلنا للنص المحضاري نصًا آخر مغايرًا للنص موضوع المعالجة النقدية في صورته الأصلية.
وإذا كان التأويل إنما هو شبكة معقدة من التخمينات والحسابات الدقيقة، فإنه يجب ممارسته من أجل تجنب سوء فهم النصوص، فليس من التأويل في شيء تأويل قول المحضار مثلًا: (أعبدك بعد الإله) بأنه كفر بواح، إذ إن ذلك ليس تأويلًا، وإنما هو قراءة سطحية وساذجة أبعد ما تكون عن التأويل.
النص المحضاري ليس منتجًا جاهزًا للفهم، وإنما هو إشارة إلى معان تقع وراءه، ولهذا فإن مهمتنا تكمن في معرفة حقيقة هذه الإشارة وتأويلها من خلال الغوص بعيدًا في بنيته العميقة والحياة داخله وفي صلب المعنى الذى نقوم بمساءلته، لملء فجواته وبياضاته وثغراته وتحقيق تماسكه الدلالي (الوحدة الموضوعية للنص).
ولما كان جنس النص ونوعه يتحكم في طريقة تماسكه الدلالي، فإن التماسك الدلالي للنص الصوفي يتم في ضوء معطيات نقدية ولسانية خاصة.
وإذا كانت اللغة المتداولة لا تستجيب للمعاناة الصوفية، فإن الخطاب الصوفي يمثل تجاوزًا لها، وتفجيرًا لإمكانياتها المكنونة، انظر كيف أنزل المحضار القمر من سمائه وعليائه وطرحه أرضًا ومحايثًا له بقوله:
على ضوء ذا الكوكب الساري
انظر كيف أحال الشعر نثرًا بين يدي حبيبه بقوله:
الشعر با انثره لك مثل حب الهيل
بك طاب لي نثره
ولا اقدر أنساك ولو فوقي مدر وصليل
تحلى بك الذكرى
ما تنتسي العشرة
أيام ذقنا بها طيب الخمرة
كأس المدامة
انظر كيف جعل القلب كائنًا عضويًا قابلًا للسلامة والفساد والتعفن، وكيف فرق بين العشق والحب بقوله:
قلب لي ما تعفن.. يعشق الحب والفن
قضايا الشعر الصوفي ونماذج محضارية:
1- التقشف والزهد في الدنيا وهجرها: (المحبة بلية والهوى مشكلة منك بغى قلب ميدان).
2- العشق الإلهي: وهو الغالب على أدب القوم. (عاد الهوى عاد الحبيب الأولي عاد)، (الحياة)، (جمالك رمز).
3- المقامات: وهي فيما تحقق للعبد من مكاسب عبر الرياضة والمجاهدة. وهي متناثرة في أغلب قصائده الصوفية مثل قصيدة: (حبلك قوي) وهي في مقام الرجاء، ومجاهداته ورياضته الروحية.
4- المناجاة: وهي سرد لتجربة العارف الصوفية. متناثرة في أغلب قصائدة الصوفية، إضافة إلى قصيدة: (الله قدير)، قصيدة: (واسع الجود، يا حافظ الخلق…).
5- المديح النبوي: (روضة العشاق في نظم مولد عظيم الأخلاق من أنفاس متقن الأشعار)، وهي قصيدة مطولة.
6- التوسل والاستغاثة: بالنبي أو الأنبياء وعباد الله الصالحين.
7- مدح شيوخ الصوفية وأعلامها.
نماذج من الشعر الصوفي للمحضار:
إذا كنا قد رأينا فيما سبق بعضًا من آراء أهل التصوف في نهجهم الصوفي، فما هي نظرة الشاعر المحضار في نهجه الصوفي؟ لعل القصيدة الآتية تعطي إجابة على ذلك السؤال:
الصبر أولى
الهوى حاكم مسلط عانفس غصب وقلوب
لاحكم ما في حكامه شي انقلابه
كم وكم خرّج صحابه من رواشين وغلوب
بعد ريح النصر حسوا بالغلابه
راحته والله تشبه عذابه
فيه ياكم شفت من راحه وكم شفت تعذيب
باصبر والصبر أولى ما وقع لي حظ ونصيب
* * *
وقت يسقيني عسل من جبح ما غبه النوب
لارضي وأوقات يجرحني بنابه
تمضي الأيـام نا واياه ركضـه بقيـروب
لا في المبعد ونصحوني القرابه
الهوى خافي حنش في جرابه
اختبرته من زمن صغري وجربت تجريب
باصبر والصبر أولى ما وقع لي حظ ونصيب
* * *
لارعى الله الهوى ذي ما ركب فوق تركوب
دوب وأهل العشق خدامه ركابه
لابكاء داود ينفعهم ولا حزن يعقوب
عندما تنزل بهم نقمة عذابه
كم وكم من شاب ضيع شبابه
في الهوى لما تبيّض دومة الراس وتشيب
باصبر والصبر أولى ما وقع لي حظ ونصيب
* * *
استلي واضحك ونا راسي من اللطم معصوب
الهوى والناس والدنيا عصابه
لاشكيت الحال قالوا لي مقدر ومكتوب
لي كتب مبعد رضي يمحي الكتابه
عاد شي دعوه من الله مجابه
لي بها في الحب بانقضـي جميـع المواجيـب
باصبر والصبر أولى ما وقع لي حظ ونصيب