تعليق نقدي على ( بلاد بلاسماء ) رواية وجدي الأهدل، الفصل (١)
نقد
أ.د. أحمد سعيد عبيدون
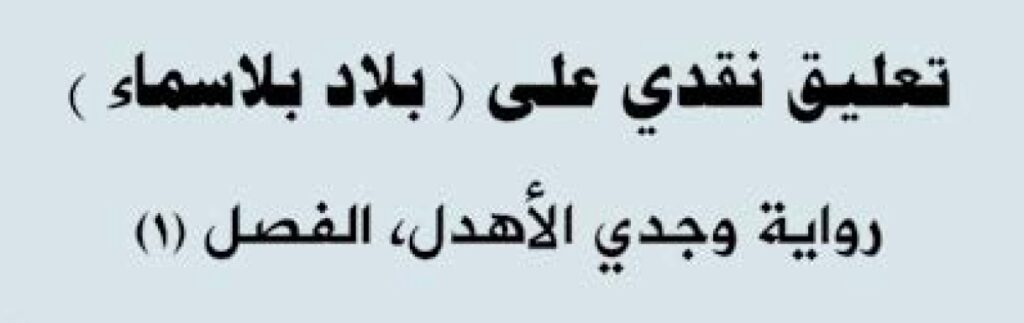

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 100
رابط العدد 7 : اضغط هنا
لعل المتأمل للرواية يلحظ أنّ ثمّة خطين بنائيين متضادين ينتظمانها؛ أحدهما؛ ينتمي إلى الوعي، ويتّجه من المعرفة إلى العرفان، يتجلى بوضوح في العنونة في عتبات الرواية، في إشارات: (السماء، والخطأ، والشرح، والمعرفة، والخبرة، والتحرر، والملك، والاستسلام، والمتعة، والسلطة، والعمى، والوهم، والسحر، والارتباك، والقربان، والشكّ، والتنسّك).
أمّا الآخر فيعود إلى العلاقة بين هذه العتبات والمجتمع في نماذج شخصيات الرواية في علاقتها بـ (سماء) كما تروي كلّ شخصية من شخصيات الرواية.
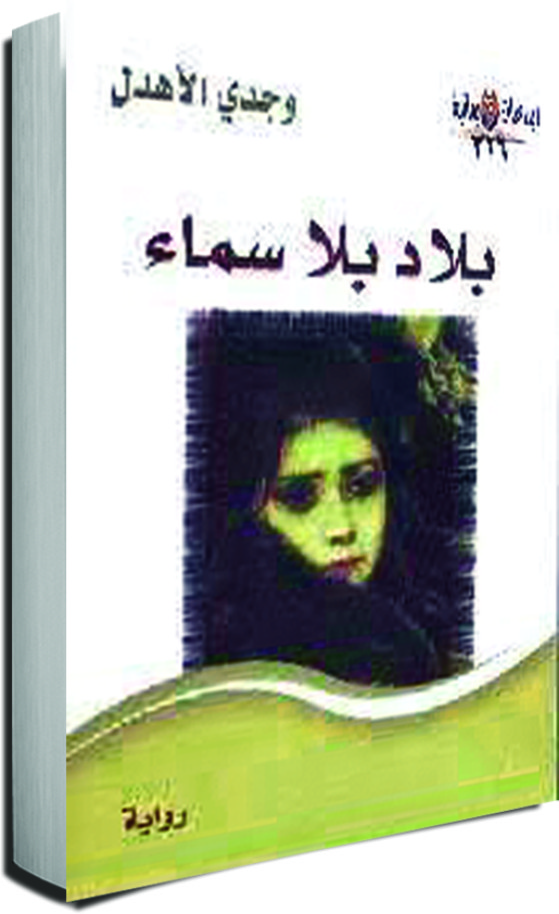
(١)
هذان الخطّان يمكن أنْ نراهما بوضوح من عنوان الرواية الذي يقدم لنا البلاد/ الأرض منقطعة عما يقابلها: السماء، وقد عبّر عن الأرض بلفظ البلاد التي هي جمع بلد، وفي جذرها وأغصانها إشارات سلبية
من الثبات، والدوام، والبلادة، وذهاب الحياء والعقل، والتردّد والحيرة. وهي صفات تبرز الإنسان في لحظة استفال، ودنوّ، والتصاق بالأرض، التصاقًا يُظْهِر الصفات الحيوانية في الأفراد أكثر من الإنسانية. ( انظرلسان العرب مادة: بلد ). هذه الصفات يؤكدها الوصف الثاني: (بلاسماء)، فهو يقطع عنها صفات العلوّ، والسموّ، والأخلاق، والفضائل،والقيم، ممّا يبرز العنوان في تداعياته الدلالية علاقات متضادة تؤكد الخطَّيْنِ السابقين في بناء لغة الرواية: العقل/ والبلادة، التغير/ والثبات، العلو/ والاستفال، الفضائل/ والرذائل، اليقين/ والحيرة…
(٢)
هذان الخطان يمثِّلان علامة، الدالِّ والمدلول فيها لا يقومان على منطق الاختلاف الذي يؤدي إلى التوحُّد والبناء، وإنّما على (الاختلاف) الذي يؤدّي إلى التناقض والتبعثر والتقويض، في مساحة من السرد تُعلِي من الشرِّ في مواجهة الخير، والبراءة في مواجهة الخُبْث، والفساد في مواجهة الصلاح، والخرافة في مواجهة النور، والسواد في مواجهة البياض … في مجتمع يختبر ويجرّب مزيدًا من المواجهة بين الوعي والواقع في طريق تحرّره ووضع قدمه على الطريق نحو النور، ويمكن أن نرى هذا الوعي في تأمل له في الفصل الأوّل المعنون بـ ( الملكة ) مثالًا:
(٣)
في فصل (الملكة) يبرز اسم (سماء) متجاوزًا معناه الكنائي الأنثوي القريب، إلى معناه البعيد، المنتمي إلى خطِّ الوعي والعُلوّ، وهو يتناسب في صفاته هاتِه مع الملوكية، التي هي في معناها سُموٌّ وارتفاعٌ وعُلوٌّ؛ فهي طالبة علم في كليّة العلوم، وهي ترفض الرفث والدناءة، فقد ردّت على سفاهة الحاج صاحب البقالة بالتلويح بظاهر الشبشب في وجهه رغم استشعارها لحرج كبر سنِّه، وهي ترفض إزعاج ابن الجيران علي، وترصّده لها، وتتضايق من ملازمته لها كظلِّها، ومن مضايقة المارَّة وتحرّشهم بها، وإساءتهم إليها، كلّها صفات ترفعها إلى أعلى باتجاه حريّتها وأخلاقها وسُموِّها، الطفولة، البراءة، التفكير في الانتحار للدخول إلى الجنة، والموت كطفلة بريئة ليس عليها حساب، الحاجة إلى مَنْ يشعرها أنّها من البشر، لها عقل وروح، لا يختزل وجودها في اللحم والمتعة والجنس وحدها، وإنما في كونها إنسانًا لها عقل وتفكير وروح تحتاج للتقدير والاحترام.
هذه الصفات كلّها تجعلها ترتفع عن أرض الناس العاديِّين واهتماماتهم الشعبية والحيوانية باللحم والمتعة، إلى سماء الاحترام، والتقدير، والفهم، والحرية، والعقل، والروح، والإنسانية. وهذا ما يعطي اسمها (سماء) مدلوله الكنائي الأبعد، ويجعلها ملكة يتطلّع إليها الناس بعيون الاحترام، وقلوب المحبة والامتنان، والعيش معها ومعهم بسلام.
هذا هو الشقُّ الأوّل من العلامة المنتمي إلى السماء، والمحتوي للصفات الملوكية، أما الشقّ الثاني المضادُّ له، فهو ما نراه في وجود ملكة بهذه الصفات السماوية، لا تعيش في قصرٍ عالٍ، ولا تحتجب عن الناس، ولا تستطيع أنْ تحكمهم وتُمْلِي قِـيَـمَها عليهم، هي سَمَاءُ نقيَّة، جميلة، نزلتْ لكيْ تسكنَ الطابق الثاني، وتذهب للجامعة، وتمارس حياتها كفتاةٍ بسيطةٍ في غابةٍ من القيم الأرضية السفلى في مجتمع لمْ يَـرَ ملكة تمشي في الأرض على قدمَيْنِ، ممَّا يجعلُها أقرب إلى أنْ تَؤُوْلَ إلى مملوكةٍ في نظرِهم، أكثر ممّا تريد أنْ تكونَ مالكة.
(٤)
إذا كان التعاملُ الطبيعيُّ مع الملكة هو التطلّع إليها بعيون الصيانة والتقدير، والاحتجاب، والخدمة، والسمع والطاعة، فإنّ الأمر مع (سماء) ينعكس تمامًا، وهنا يبدأ الفعل التفكيكيّ للقِيَم في احتكاك (سماء) بالمجتمع، وهو الأمر الذي يحتويه مصطلح يمكن أنْ يعبّر عنْ هذا الفعل الإبداعي في الرواية، ويعطي للسَّرْدِ وظيفة تحليل وتفكيك وإبراز وبعثرة لثنائيات متضادَّة تركبتْ بشكلٍ زائفٍ فاسدٍ يحتاج إلى التعرية والتهديم، هذا المصطلح هو ( التّحديق) وبدائله اللغوية في لغة السرد، وهو يُرِينَا الفعل الذي يقوم به المجتمع ضدَّ قِيَمِ الوَعْيِ مع بقائنا داخل اللغة، فإذا كان النظر إلى الملكة (التّطلّع) هو وعيٌ يقوم على الاحترام في اتجاه من (أدنى إلى أعلى)،فإنّ (التّحديق) وعيٌ يقوم على الانتهاك بالنظر غير المحترم في اتجاه من (أعلى إلى أسفل)، كما نرى في هذا الرصد اللغوي الغزير:
يراني / يترصّدني / العينالسحرية / يراني / يلحقبي / أحسب نظراته النارية مسلطة عليّ / نظرات الناس الفضولية / الجميع يحدّق فيها / التحديق المكثّف القادم من جميع الاتجاهات / التحديق من ذكور مكبوتين / يقتحم جلدي / يحدق فيهن الرجال بشهوانية / التحديق المتواصل من عشرات المارّة / يصوّبون نظراتهم الشبقة إلي / تحديق الرجال فيّ / التحرّش البصري / وهو يبصبص عليّ متلمّظًا بشفتيه / تلصّص شقيقي الأكبر على دفتر يوميّاتي/ أمّي تحدّق في وجهي بتركيز بحثًاعن أثرٍ للحبّ / الأنظار المسلطة عليّ طوال الوقت / أنا تحت المراقبة ليلًا ونهارًا / أشعر أنّي محاصرة / المجتمع يحاصرني من كافة الجهات / كلّ ما حولي يشعرني أنّني لسْتُ بشرًا لي عقلٌ وروح / أداة للمتعة …
ويتطور التحديق بالعين إلى التحديق باليد، بمعنى أنه ينتقل إلى الفعل، من النظر إلى اللمس، الإيذاء، سائق الباص: ينشب مخالبه في لحمي حتى الرسغ، وثمّة جناس قصصي في التحديق؛ ذلك الذي يتعلّق بحكاية التحديق في عيني القط، وحكاية التحديق في عيني النمر.
يبدو التحديق لعبة الأسود والأبيض في وعي السرد بالمعنى الحسّي والمعنوي، أشبه بالحوَر الجمالي في الرؤية، فالحوَر شدّة بياض بياض العين وشدة سواد سوادها، والأحور العقل، والحوار رجوع الكلام، ويبلغ هذا الحور قمته في استعارات قصصية شديدة التنافر والحركة كما نجد مثلًا في ارتداء (سماء) البالطو الأسود وفي حملها الحقيبة البيضاء، فيما أسمته بـ (هيستيريا الحقيبة البيضاء): “أرتدي البالطو الأسود فوق ملابسي، وأضع النقاب على وجهي”، ” لا أنْصح أية بنت من بنات بلادي بحمل حقيبة بيضاء .. لأن لونها يلفت انتباه الرجال بصورة غريبة .. وبعضهم يصاب بهيستيريا من نوع خاص – هيستيريا الحقيبة البيضاء- في فقد شعوره والقدرة على التحكّـم بنفسه” هذه الجماليات مقترنة باللذة القرائية التي تتمتع بالتضاد المعرّي والهادم بهذه الطريقة في التدافع بين الأسود والأبيض.