كتابات
د.عبدالقادر علي باعيسى
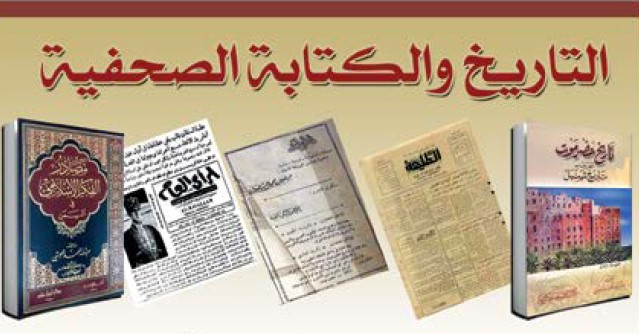
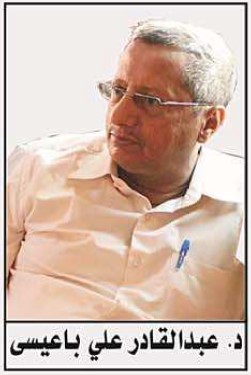
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 8 .. ص 20
رابط العدد 8 : اضغط هنا
عندما نكتب عن الحركة الصحفية في حضرموت في ستينيات القرن الماضي فلا بد أولًا من الكشف عن المعالم السياسية التي رافقت تلك الحركة الصحفية، وحصر أبرز اتجاهاتها السياسية سلطة ومعارضة، ومن ثم حصر أبرز اتجاهات الكتابة الصحفية سلطة ومعارضة، وما قد ينشأ داخل هذا من تناقضات وتنوعات مختلفة، ذلك لأن حركة السلطة لن تمضي على وتيرة واحدة متسقة من البداية إلى النهاية، وكذلك حركة المعارضة، إذ تخضع العلاقة بين السلطة والمعارضة لحال من المقاومة والرفض، والتجاوب، والتماشي أحيانًا، وكل هذه الحركات في مجموعها تشكل خلفية واسعة للكتابة التاريخية، فليس التاريخ سلطة فحسب، ولا معارضة فحسب، وإنما مجال واسع خاضت فيه هذه الاتجاهات وتعاركت، فلا تحتكر الكتابة التاريخية في زاوية واحدة هي زاوية المعارضة التي خاضت فيها صحف ستينيات القرن الماضي في حضرموت (الطليعة، والرائد، والرأي العام)، وإنما وفق منظور جدلي تنبثق عنه رؤى ربما لا يتم الالتفات إليها عند النظر من زاوية واحدة.
ربما كنت ألمح هنا إلى الرغبة في قراءة بحوث جدلية تقدم لنا فاعلية الفهم والإدراك بصورة أكثر نتائجية وعمقًا حيث تقدم الأبحاث بناء على أولوية النتائج المتوصل إليها لا على أولوية الأسماء التي تكتب، فالكتابة التاريخية هي مادة ثقافية للتفاعل والجدل ليس بين السلطة والمعارضة في ذلك الوقت، بل بينهما وبين عقل المحلل والدارس التاريخي، الذي يتعرض لكل الأحداث ويعيد قراءتها وتحليلها، بوصف قراءة التاريخ لا تخلو من نشاط ذهني يبديه القارئ التاريخي نحو ما يقرأ، ولا أقول المؤرخ الذي يعيد تسجيل الأحداث دون أن يعمل جهده في التحليل والاستنتاج بحيث يتحول التاريخ إلى أيقونات ثابتة، ويتحول معه قراء الحاضر إلى أيقونات ثابتة تعيد إنتاج ما أنتج، فالكتابة التاريخية من أخطر المجالات التي تمارس فيها الكتابة لما لها من أهمية في تطور الموقف الإنساني اللاحق بكل مجالاته الإنسانية السياسية والاجتماعية والحقوقية.. إلخ.
وعليه فمن المهم أن تندرج الكتابة التاريخية في نظم متجددة حتى لا تعيد نفسها بحيث تظل تمتلك إمكانية الوصول إلى نتائج أكثر تنوعًا بغية تنمية البحوث وأبعادها الاستنتاجية بعيدًا عن طريقة التكرار والإعادة، وحتى يكون للكتابة التاريخية عمق تأثيري في المجتمع وحبذا لو تخالفت الرؤى حول مرحلة معينة فلا يتم النظر إلى أي شيء منها على أنه نموذجي أو مثالي أو مفروغ منه ما دام آتيًا في إطار حركة الزمن وتطوره، وما ننظر إليه على أنه ثابت في التاريخ ليس أكثر من حركة، ذلك لأنه سبق بظروف ونظم سياسية واجتماعية وإدارية، ولحق بظروف ونظم أتت بعده، إنه ذو صبغة تحولية ما دام مرتبطًا بالزمن، وعلى ذلك لا يمكن وصف التاريخ بالثبات المطلق إلا على المستوى الذهني والدراسي فقط.
وأهم ما يمكن التركيز عليه:
– الاهتمام بالمكتوب والتعليق عليه.
– الاهتمام بالثابت والمتحرك في حركة التاريخ.
– الاهتمام بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري الذي وجدت فيه تلك الكتابات التاريخية ودراسته، وعدم التسليم بما جاء في تلك الكتابات تسليمًا عامًا ومطلقًا دون دراسة.
– التقابل المستمر بين الحاضر والماضي، فربما أثرت مرحلة لاحقة في التاريخ على مرحلة سابقة وأعادت النظر إليها بصورة مختلفة.
وعودة إلى ما بدأنا به إلى أي حد يمكن أن نعد المادة الصحفية مادة تاريخية تخضع للعمليات التحليلية نفسها التي يخضع لها أي كتاب تاريخي صرف، وهل يمكن مقارنة الكتابة الصحفية بالكتابة التاريخية؟ فالكتابة الصحفية أنشئت نمطًا مستقلًا من الكتابة، لا لتكون تاريخًا، فإلى أي حد نضع على الكتابة الصحفية مقاييس الكتابة التاريخية، وما هي الفوارق بين الطريقتين في الكتابة والتحليل؟ وما هي الأخطاء التي نرتكبها في سبيل المطابقة بينهما؟ من حيث المبدأ كل شيء قيل في الماضي يمكن أن يكون تاريخًا، واللغة هي نفسها في تطورها حالة تاريخية بمعنى أننا عندما نقرأ التاريخ الذي كتب في القرن العاشر أو الثاني عشر مثلًا فإننا نقرأ الأحداث التاريخية، في الوقت الذي نقرأ تاريخية اللغة، وتاريخية اللغة قد تنقل لنا الأحداث بصورة مختلفة عما نفهمه نحن منها انطلاقًا من لغتنا المعاصرة لا سيما إذا كتبت باللهجة العامية، بل إن طريقة فهم أي مؤرخ للغة الحادثة التاريخية قد تختلف عن الآخر إلا إذا كانا يتآثران، أو ينقل أحدهما آليًا عن الآخر في نوع من التآثر الميكانيكي دون إعمال للذهن، فالمؤرخ وإن ظن أنه يكتب التاريخ بأمانة فإنما يكتب لغته الخاصة به، وينتقي من تجارب وأحداث متعددة ما يريد، وباللغة التي يريد، وفي هذا الانتقاء تظهر انطباعاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. إننا أمام جهتين مشكلتين هما حقيقة الواقعة التاريخية ونقل الحقيقة باللغة.
وحبذا لو تم النظر إلى التاريخ بأكثر من زاوية من التحليل النفسي والاجتماعي والاقتصادي بحيث نفهمه بصورة أوضح مما نحن بحاجة إلى تنشيطه في قراءاتنا القادمة بوصف التاريخ ملك الجميع الذين يمكن أن يقرؤوه بمناهجهم الخاصة، وفي هذا التداول بين المناهج تتضح كثير من الحقائق التي كانت مغيبة، ويظل التاريخ في حالة من الفعالية والنشاط دون توقف، وربما سمعنا عن علم النفس التاريخي، وعلم الاجتماع التاريخي، وكثير من الأحداث الاجتماعية والسياسية التي حدثت في الماضي ربما كانت أسبابها نفسية خالصة بوصف السلطان أو الملك كان هو المتنفذ الأوحد في شؤون سلطته إلى درجة أن يخضع المجتمع كله لتصرفاته التي تغدو بدورها تصرفات يتبناها المجتمع مما يترسخ بعد ذلك في الوعي والسلوك الاجتماعي، أو أن أحداثًا معينة فرضها المجتمع بقوة سلطته في الأعراف والتقاليد.
وعلى أية حال فالتاريخ عملية مستمرة من الهدم والبناء والتراجع والتقدم، وربما كانت كتاباتنا تدعو لا إراديًا إلى حالة من التراجع عن حالة كانت متقدمة عقليًا في التاريخ بسبب النقل الآلي للمكتوب وعدم تشغيل مناهج مختلفة في قراءة التاريخ.