قراءة نقدية في كتاب (أربعون حديثاً في الأدب النبوي)
مدارات
د. أحمد هادي باحارثة
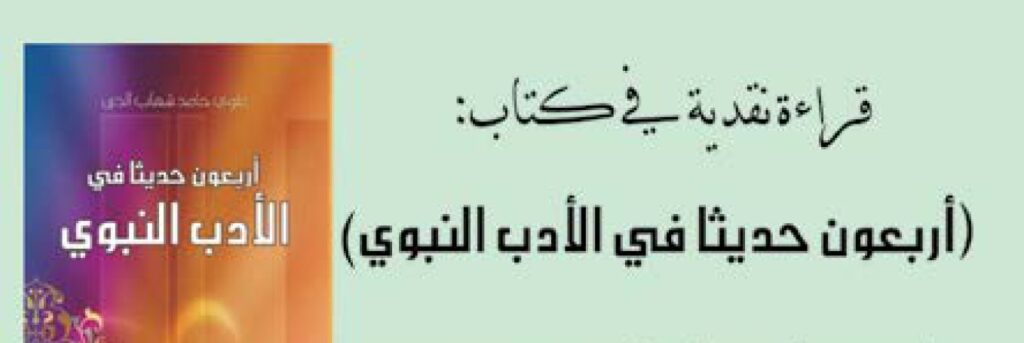
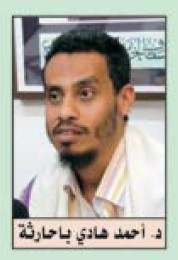
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 8 .. ص 77
رابط العدد 8 : اضغط هنا
هي أربعون حديثًا تناولت عددًا من الآداب النبوية، وجامعها هو الدكتور علوي بن حامد بن شهاب الدين، الذي نزع في مؤلفاته إلى التجديد والتأصيل والإبداع في مختلف تناولاته الدينية، وقد اختص بكتابه هذا موضوعًا عزيزًا نحن اليوم بأمس الحاجة إليه مما نعانيه من غربة في آدابنا الإسلامية، وكربة في قيمنا المجتمعية، إنها أربعون حديثًا في الأدب النبوي، هكذا أطلق ابن شهاب على عنوان كتابه.
وحيث إن المؤلف الصديق ابن شهاب قد أهدى إليَّ هذا الكتاب، وأرسله إليَّ من تريم عبر الباحث مراد باخريصة، وطلب بكل تواضع مني إبداء رأيي في ما ضمه بين دفتيه، فقد وضعت طلبه هذا في مقام الأمر الأخوي، مع أنني أعترف -والصدق منجاة- بأن بضاعتي في العلوم الدينية بضاعة مزجاة، فوضعت يدي على قلمي الرصاص؛ لأقيد ما يعنُّ بخاطري من ملاحظات وأنا أتلو ذلك الكتاب الشهابي، الذي خف وزنه حجمًا، وغلا ثمنه بما ضمه من جواهر أحاديثه وفوائده، وترونني الآن أرسلها في هذا المقال، موزعًا تلك الملاحظات ما بين المقدمة، والأحاديث، والفوائد، ومتفرقات تتعلق بالمراجع ولغة الكتاب.
المقدمة:
لم يذكر ابن شهاب في مقدمة كتابه هذا أنه ملتزم بصحة جميع الأحاديث التي يوردها، وما كان أحراه بذلك، وهو المتخصص في الحديث وعلومه، في وقت كثر فيه الكلام والجدل حول هذه المنطقة الحديثية، وقد أشار بأنه سيقتصر فقط على الأحاديث النبوية، لكنه خالف ذلك باعتماد أثر عن صحابي، هو ابن عباس رضي الله عنهما؛ ليستنبط منه أحد الآداب، كما التزم أيضًا بذكر سبب الحديث، وحدثت له في ذلك إشكالات بنظرنا نوردها لاحقًا.
وقد تفرّد ابن شهاب بمزية جمع تلك الأربعين حديثًا في الأدب، وربما كان من المستحسن برأيي أن يذكر من سبقه ممَّن خصُّوا الأدب بجمع أحاديثه في كتاب منفصل، أو في قسم خاص من بعض كتبهم، ولا سيما الإمام البخاري في كتابه (الأدب المفرد)، أو كتاب الأدب من جامعه الصحيح.
كما إنه كذلك لم يلزم نفسه في المقدمة بذكر مصادر فوائد أحاديثه، وفي رأيي أن الأولى هو إيراد مصادرها، ولا سيما في لطائفها، أو ما قد تتضمنه من أحكام كالحرمة والإباحة، خصوصًا ما فيه اختلاف بين العلماء، وتمنّيت أن يفعل ذلك كي نعلم الفوائد التي أتت من جانبه، واستنبطها هو بنفسه من تلك الأحاديث، وكان سيمثل ذلك إضافة قوية لعلمه، وحفظًا لحقوقه الأدبية، كما سيدل على مستوى ذهنيته، ولطف معارفه.
وقد ألزم نفسه بالترجمة لصحابي كل حديث يورده، مع أنه غير ملزم بذلك؛ لكونه عملًا تاريخيًا محضًا، ولا يفيد موضوع الكتاب إفادة مباشرة، ومع ذلك فقد تراوحت تلك التراجم طولًا وقصرًا، وتفصيلًا وإيجازًا، دون معيار علمي محدَّد سوى وفرة المعلومات أو شحتها عن بعض الصحابة، متنكبًا أحيانًا سبيل الاختيار والاختصار، ومن العجيب أنه يذكر اسم الصحابي مرَّتين؛ في المتن لدى إيراد الحديث، وفي الهامش عند التخريج، من غير حاجة ظاهرة.
الأحاديث:
يكتفي ابن شهاب -غالبًا- في تخريج أحاديثه بمصدر واحد، إلا ما اتفق عليه الشيخان، فيذكرهما معًا بطبيعة الحال، وهو لم يلتزم بذكر حكم ما هو خارج الصحيحين من حيث الصحة والضعف، فتراوح بين ذكرها وعدمه، فينص أحيانًا – وهو الأكثر – على حكمه تصحيحًا أو تحسينًا، ثم إنه تارة يبين صاحب الحكم وينسبه إليه، وغالبًا ما يكون ذلك في هامش الصفحة، عدا الحديث (السابع والثلاثين) فذكر تحسينه في المتن، وتارة يهمل ذكره، وهنا أيضًا خفي عمل المؤلف الحديثي لنعلم ما باشر بنفسه الحكم بتصحيحه.
وقد اشتملت الأربعون الشهابية على أحاديث فيها كلام من حيث صحتها وضعفها في مظانها؛ من كتب التخريج والعلل المعروفة لدى المشتغلين بعلوم الحديث كابن شهاب، وهي من تلك الأحاديث التي وردت خارج الصحيحين اللذين هما الوحيدان اللذان كادت الأمة تجمع على صحة ما جاء فيهما من أحاديث نبوية.
وفي الحديث الخامس والثلاثين سقط واضح؛ إذ سقطت من آخره لفظتان هما »والثلاثة ركب«، وعكسه في الحديث السادس والثلاثين؛ إذ زاد المؤلف بعده كلمة »بيمينه« لأحد رواة الحديث (ابن قدامة)، وكان بإمكانه أن يذكرها في الفوائد كما هي عادته في تفسير دلالات الأحاديث، وليس مقترنة بمتن الحديث، وقد صرح هو بذلك في الفائدة الثالثة بأن »لفظة بيمينه ليست من الحديث«، لكنه أغفل روايات أخرى ذكرها بعض المخرجين احتوت على تلك اللفظة، أو تحلُّ محلَّها لفظة بيده، فلم يُـشِـرْ إلى ذلك البتة، وسارع إلى إثبات سُـنِّــيَّـة إثبات التسبيح عقب الصلوات بكلا اليدين؛ يمينها ويسارها، فلا عول على سائر الروايات، ولا على تفسير ذلك الراوي الذي (حشكه) في المتن، ومع ذلك فالمسألة في نظري أقرب لجو العبادات وليس الآداب.
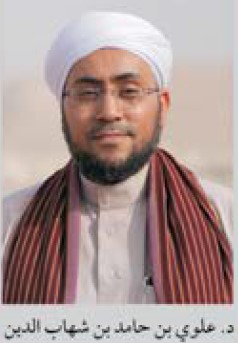
وقد جعل ابن شهاب من بين أحاديثه الأربعين أثرًا عن الصحابي حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أو ما يسمَّى بالحديث الموقوف، وذلك في الحديث الثلاثين، وهو ليس حديثًا نبويًا، وقد ورد مرفوعًا في بعض روايته، لكنْ تشكَّك المحدثون في ذلك الرفع؛ لذا ربما أعرض عنها ابن شهاب، لكنْ لا أدري لماذا أثبت ذلك الأثر مخالفًا ما التزمه من كون أربعينه كلها نبوية؟! إلا إذا كان يراه في حكم الرفع، لكن برأيي لا أراه كذلك؛ لأنه لم يتضمَّنْ خبرًا غيبيًا، أو حكمًا تعبُّديًا، بل هو نصيحة مجرَّدة، قد تأتي على لسان أي شخص ذي حكمة ورويـَّـة، فيبقى السؤال أو الإشكال قائمًا.
وثُــمَّـت آداب بعينها أطال ابن شهاب الوقوف عندها، بتعدُّد ما ورد فيها من أحاديث، كآداب الطعام التي خصَّها وحدها بربع أحاديث الكتاب، أي نحو عشرة أحاديث، وظَـفِـرَ العُـطَاسُ وتشميـتُـه بخمسةِ أحاديث، وهناك أحاديث هي أدخل برأيي في باب العبادات، وليس الآداب، كالحديث السادس والثلاثين المتعلق بسُـنِّــيَّـة التسبيح باليدين، وكان ممكن أن يشغل مكانه، أو مكان ذلك التعدد الذي قد يصل إلى التكرار، بأحاديث آداب أخرى لم يوردها، ومجتمعنا بحاجة ماسة بتذكيره بها.
وكان بإمكانه في هذه الحالة الاستعانة بصنيع الإمام البخاري في الأدب المفرد، أو في كتاب الأدب من صحيحه، فيأخذ منها آدابًا أخرى، كالآداب المتعلقة باللباس، والحوار، والتبسُّم، وطلاقة الوجه، وما شاكلها، مع بقاء الحق له في ذكر الأحاديث التي أوردها البخاري، أو يأتي بأحاديث أخرى متعلقة بها ودالة عليها.
أمّا ما للأحاديث من سبب فإن حديثها عجب! فقد رأينا ابن شهاب يذكر أحيانًا أسبابًا لأحاديث بروايات مختلفة مع عدم اتفاقها في الحدث والموقف، أو يسبب ما لا يحتاج لسبب ولا يتصل به، فالحديث الرابع والعشرون لا يتضمن حادثة أو موقفًا بحاجة إلى تسبيب، فهو يبين ذكر العُطَاس لا غير، ومع ذلك جعل له المؤلف سببًا مأخوذًامن حديث يخالفه في الصحابي، وفي اللفظ، ومن ثم فالموقفان متغايران، وفي الفوائد أغفل الذكر المغاير الذي ورد فيه، فضلًا عن الحديث المسبب في صحته مقال لدى أهل الشأن فقد ذكروا أن في سنده انقطاع، أو رجل مجهول.
الفوائد:
أورد ابن شهاب فوائد جمة ومهمة لجميع أحاديثه، وهي تمثل موطن اللباب من الأحاديث الواردة بكتابه، لكنه لم يكنْ يشير غالبًا لمصادرها، ولم يفصل ما هو من استنباطه، وما هو منقول، وقد يذكر قليلًا مصدرها، وأكثر مصدر تكرّر عنده هو كتاب (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني، وغالبًا ما ينقل الفائدة عنه بنصها، وقد ينسب بعض تلك الفوائد لقائلها، لكن من غير مصدر، وأكثر من نسب إليه فوائد هو الخطابي، ومع ذلك بخل عليه بتعريف وجيز، حتى باسمه.
ونرى في بعض الأحاديث تكثر الفوائد وتتفرع؛ بحيث قد تتناول أمورًا خارج نطاق نص الحديث المذكور، وتدخل في باب المعلومات الإضافية، أو التتمَّة المعرفية، وكان يفضِّل الإشارة لهذا في مقدمة الكتاب، ومن ذلك الحديث الخامس؛ إذ فيه فائدتان (الثانية والثالثة) تعدَّانِ من الآداب العامة للنوم، ذكرهما تتمَّةً من غير أن يشير لهما حديث الباب، ومثله الحديث العشرون فائدته الثالثة ليست في نصه، كذلك الحديث الثامن والعشرون في فوائده معلومات يعوزها الدليل، ولم ترد في نص الحديث كقوله: »إن الله يحب العطاس«، كما اختلفت علة كراهة التثاؤب لديه في الفائدتين الثالثة والرابعة بين دلالتها على الشهوات والامتلاء والاسترخاء، وبين تغيُّر صورة الشخص المتثائب فيصبح شكل وجهه مضحكًا، وإن كنت لا أدري كيف سيتجنّب الواحد منّا ذلك التغيُّر (المضحك) لوجهه عندما يغلبه التثاؤب.
وبالمقابل رأينا في بعضها شحة قد لا تتجاوز الحديثين، وقد تهمل فوائد ظاهرة في نص الحديث، أو يمكن أن تستنبط منه، كالحديث التاسع عشر؛ إذ من الممكن وبوضوح أن يستنبط منه سؤال ذوي الفضل، وإحالة العلم إلى أهله، والحديث الثلاثون يمكن أن تستنبط منه فائدة تدعو للتواضع، أيضًا الحديث الحادي والثلاثون لم يبيِّنْ فيه الفرق بين استعمال الفعلين ألج وأدخل كما يوهم لفظ الحديث، لكن توضح بعض الشروحات أنه لا فرق، ولا دلالة لتغايرهما، فيزول بذلك وهم التغاير بين اللفظين لذاته.
كذلك الحديث الثامن والعشرون ذُكِرَتْ فيه أمور لم تتطرق لها الفوائد، وهي الانحناء، والالتزام أو المعانقة، والتقبيل، وصرف جميع فوائده الستة إلى المصافحة فقط، ومما رآه في أحكامها استثناء الأمرد الحسن من عموم جواز المصافحة لخوف الفتنة، ولم يدلِّلْ على ذلك الاستثناء، وهو قول لبعض العلماء كالنووي، وفيه من الحرج والتكلُّف ما لا يخفى.
وبعض الفوائد ذات إيجاز مُخِلٍّ لنقصٍ أو حصر، فمثال النقص في الحديث التاسع مثلًا؛ فقد ذكر في فائدته الأولى »كراهة ذكر عيوب الطعام«، وفيها إجمال يحتاج القارئ اليوم لتفصيله كالتفريق بين العيب الخلقي، والعيب الطبخي، وقد نصَّ بعض الشارحين على التفريق بينهما، فقد يحتاج لذكر العيب الثاني لمضرَّة قد تلحق بالآكل كزيادة الملح أو السكر أو الدهون لمن يظن أنه يحمل أمراضًا قد تثيرها تلك العيوب، أو حِمْيَة قد تفسدها؛ فيتحرَّج القارئ لتلك الفائدة المجملة من ذكرها؛ خشية وقوعه في محذور شرعي، ومخالفة للأدب النبوي.
ومثال الحصر في الفائدة الثالثة للحديث العاشر حين حصر الأكل من وسط وأعلى الوعاء في الفاكهة وهو شامل لكلِّ ما هو طعام متنوع، ومن بينها مثلًا المكسّرات، والمتعدّد الطبخات، ونحو ذلك، وحصره لـلـعق في الأصابع الثلاثة في الحديث الحادي عشر بينما نصه أعمُّ، والآكلون بكل أصابعهم كُـثُـر، كما نسي إطلاق الأمر نفسه على مستخدمي الملاعق وجواز لعق ما علق بها من طعام لوجود العلَّة نفسها.
ومثلها الفائدة الرابعة من الحديث التاسع عشر فقد حصر شرور الأسواق في رذيلتي الغش واليمين الكاذبة وهي أكثر من ذلك، كضياع الأوقات وتأخير الصلوات والصخب والغفلة وحبّ الدنيا وغيرها، وكذلك في الفائدة الخامسة من الحديث الحادي والعشرين؛ إذ حصر النياحة في لفظتي (وا ويلاه وا حسرتاه)، ولو قال هي نحو قول النائحة كذا لكان أدقَّ وأشمل، أيضًا نراه في الحديث التاسع والثلاثين قد حصر حرمة إفشاء السرّ فيما يجري بين الرجل وزوجه في الفائدة الأولى، بينما أتى العنوان عامًا، وهو الأليق.
وبعض الفوائد قد تتكرر من حديث لآخر، كالفائدتين الأولى والخامسة من الحديث السادس عشر عن لعق الأصابع، وإعادة كلام النووي من غير نسبته إليه، وبعضها يذكر في غير موضعه، أو يناسبها حديث آخر من المذكورات، ومثال ذلك الحديث السابع والعشرون فهو يكاد يكون تكرارًا للحديث السابق له؛ لذا تداخلت فوائدهما، فالفائدتان الثانية والثالثة كان من الأحرى أن يذكرهما في الحديث السادس والعشرين، أما الفائدة الرابعة فهي تابعة لهذا الحديث مباشرة؛ لأنها مأخوذة من نصه وتخالف نص تاليه، فهو ينص قولًا على التشميت ثلاثًا، بينما تاليه، أي السابع والعشرون، ينص فعليًا على مرة واحدة فقط، ولم يقف المؤلف عند هذا الإشكال أو تلك المخالفة، أما الفائدة الخامسة فهي مناسبة للحديث الثالث والعشرين الذي يتناول أدب كيفية العُطَاس، أي أنها أتت في غير موضعها، وكل تلك الإشكالات جاءت بسبب تكرار أحاديث خمسة عن العُطَاس وحده.
وبعضها فوائد عامة ممكن تصدق على كل أحاديث الكتاب كالفائدة الثانية للحديث التاسع؛ إذ نصها »سعة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم«، وهي فائدة لعلها تصلح لكل أحاديث الكتاب، ومثلها الفائدة الثانية من الحديث الثامن عشر؛ إذ تصلح لكل أحاديث الطعام.
ومن الفوائد ما يحتاج إلى تدقيق في صياغتها؛ حتى لا يشكل فهمها على قارئها، أو يسيء فهمها فلا يحسن تطبيقها، ومن ذلك الفائدة الثانية للحديث السابع عن كيفية التعامل مع القذاة التي تسقط في الإناء، فوردت الفائدة هكذا »استحباب إراقة المشروب الذي وقعت فيه القذاة«، وكان ابن شهاب قد فسر القذاة بأنها كالعود أو الشعرة، فنصُّ الفائدة أن يسكب الشارب مشروبه بمجرد أن يرى عودًا أو شعرة في إنائه، أي سيتخلّص من كلِّ ما في الإناء، وفي ذلك تكلُّف وإسراف غير محمود، بل ليس من الأدب مطلقًا، بينما المقصود والمتعيَّن هو سكب بعض المشروب بحيث تنسلُّ معه القذاة، وهو ما نص عليه شارحو الحديث.
ومن ذلك الفائدة الأولى في الحديث الثلاثين المتضمن أثر ابن عباس، ونصُّها »لا بد للمسلم أن يذكر عيوبه حتى يتمكن من إصلاحها«، من غير أن يـبـيـِّنْ هنا محلَّ الذكر أَهُوَ ذهنيٌّ أم لفظي؟ إذ قد يفهم القارئ من نص الأثر والفائدة أن يعدِّد عيوبه، ويجهر بها، ويفضح نفسه، ويهتك ستره، وهذا خلاف للأدب والمروءة، والأمر ليس كذلك كما نصت شروح هذا الأثر.
ومن ذلك الفائدة الرابعة من الحديث السادس عشر، وهي التي فسَّر فيها نسلِتُ القصعة بمعنى نمسحها، ولم يبيِّنْ غرضَ المسحِ وأداتَـه، وهو موهمٌ للتنظيف، وليس لِــلَّــعقِ واللحس.
والفائدة الثالثة من الحديث الثاني والعشرين في غاية الإشكال، وهي تجيز التناجي لاثنين دون الثالث إذا لم يكن في الإثم والعدوان؛ ونسبه إلى مفهوم الحديث، وهو مفهوم غير مفهوم، ولم ينص عليه أحد على العموم؛ إذ كيف سيعلم الثالث أنهما لا يتناجيان، والنجوى هي كلام سرِّي، في إثم ولا عدوان، فلا يحزن، ثم إن المؤلف لم يفسِّـرْ سبب حصول ذلك الحزن ليفهم من الحديث هذا الجواز العجيب، فالعلَّة لا تنحصر في خوف العدوان أو التآمر، بل تمتد إلى علة ظن الاحتقار، واتهام الرأي، كما قال الشُّــرَّاح، وهذه العلة قائمة على كل حال، كذلك فات المؤلف إشارتان مهمتان وهما: تثبيت أن ذلك النهي يصدق في السفر للعابرين، وفي الحضر بالمجالس للحاضرين، والأخرى هي قياس التحدُّث بلغة لا يفهمها الثالث؛ لأنها قد أصبح مدلولها غير معلوم عنده كالنجوى، وهي مما نص عليه القوم.
ومن ناحية أخرى كثيرًا ما يؤدي إيراد بعض الفوائد لذكر أحاديث نبوية أخرى، أو عرض روايات متعدِّدة للحديث المذكور، وأحيانًا يورد آثارًا من أفعال بعض الصحابة وأقوالهم، وتشملها أيضًا جدليَّة الصِّحَّةِ والضَّعْفِ، التي تُـعَـدُّ بحقٍّ أكبرَ إشكالات الاستعانة بالحديث النبوي في الدلالات الدينية أخبارًا وأحكامًا، ولا يعلم تأويلها إلا الراسخون في العلم الحديثي، ولا يلقَّـاها إلا ذو حظ عظيم.
المراجع:
أورد المؤلف ابن شهاب في آخر كتابه قائمة بمراجع الكتاب ومصادره التي عاد إليها، سواء كانت حديثية، أو فقهية، أو لغوية، أو أدبية، أو غيرها، لكنّه لم يستوعبْ كل ما أورده منها في تلك القائمة، ومن بين ما أهمل ذكره أربعة كتب؛ هي: كتاب (جامع السيوطي)، وكتاب (ملحق مصنف عبدالرزاق)، وكتاب (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام) للنووي، وكتاب (أزواج الرسول) للمؤلف نفسه، أي ابن شهاب.
اللغة:
أخطأ في ضبط بعض الألفاظ، وقد يكون الضبط لغويًا أو صرفيًا أو إملائيًا، فالخطأ اللُّـغَوِيُّ كان في لفظة (ألية) وهي بفتح الهمزة كما نصُّوا عليه، فرسمها مكسورة في الحديث الثالث والثلاثين، والخطأ الصرفي كان في لفظة (ضِجعة) في الحديث الخامس، وهي بكسر الضاد؛ لأنها اسم هيئة، فجعلها بالفتح كأنها اسم مرة، والخطأ الإملائي المتكرِّر أنه رسم اسم (أبو داود) صاحب السنن بواوين، وهو بواو واحد.
ونرى ابن شهاب أحيانًا يذكر معاني بعض المفردات الواردة في أحاديثه، لكنه يهمل معاني أخرى غيرها مما هو مكرَّر بكتابه، مع وجود الحاجة إليه، كتفسير كلمات اللعق، والتشميت، التناجي، تفسيرًا لغويًا، وفي الحديث الأخير كان يزيد في صياغته لفائدتيه كلمتي «في هذا»، و«في الحديث» دون حاجة.