نقد
أ.د. عبدالله حسين البار


– مفتتح:
تفسير النصّ غير تأويله.
(التفسير) وقوفٌ عند ظاهر القول. شرحٌ للتراكيب وصولًا للمعنى المقصود.
(التأويل) إيغالٌ في باطن القول مستفيدًا من معطيات علومٍ، وإجراءات منهجٍ.
(التفسير) إعادةٌ للنصّ بلغةٍ تقلّ عن لغته براعةَ أداءٍ، وكيفيات تعبير.
(التأويل) إضافةٌ للنصّ تتمثّل في رؤيةٍ أعمق، ومنظورٍ أشمل.
فهل (نفسّر) النصّ، أو (نتأوّله)؟
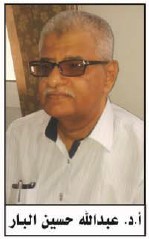
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 8 .. ص 99
رابط العدد 8 : اضغط هنا
للإجابة عن سؤالٍ كهذا السّؤال علينا أن نعيّن بدءًا هُويّة هذا (النصّ). وإنّه -في مقام حديثنا عن أعمال الأستاذ باعامر، وهو قاصٌّ وروائيٌّ في آن- متعلّقٌ بالنصّ السرديّ قصّةً قصيرةً وروايةً. ثمّ نشير من بعد إلى أنّ الأدب العربيّ الحديث قد عرف نقّادًا انشغلوا بدراسةِ أعمالِ أدباءِ عربٍ أبدعوا في مجال السرد قصّةً قصيرةً وروايةً، وقالوا فيهما أقوالًا شتّى تعتمد في غالبها على (تفسير) النصّ، وكان لأقلّها نصيبٌ من (تأويله). نجد مثل هذا في قراءات د/ شكري محمد عيّاد لأزمة الضمير في الرواية العربية، وفي قراءات د/ علي الراعي للرواية المصرية في مطلع شبابه، ثم للرواية العربية في آخر عمره، وفي قراءات د/ فاطمة موسى لروايات نجيب محفوظ والطيب صالح، ود/ رضوى عاشور لرواية الزيني بركات للغيطاني، وفي قراءات آخرين من أمثال هؤلاء وأولئك مما لا يكاد يحاط بها حصرًا. تقابل ذلك محاولاتٌ أخر تزاورت عن (التفسير) لارتضائها مناهج أمكنت الناقد من (التأويل) من مثل قراءة د/ يمنى العيد لرواية الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال)، وإن استغلقت إجراءاتها النقدية تحليلًا ووصفًا على كثيرٍ من القرّاء فلم تمتزج بنسيجه الثقافيّ، ومن مثل قراءة د/ طه حسين الحضرميّ لروايات علي أحمد باكثير التاريخيّة، وإن لم تحظ بالذيوع والتداول اللائقين بها من حيث هي دراسةٌ منهجيّةٌ عز نظيرها بين دراساتٍ عرضت لروايات باكثير التاريخيّة وغير التاريخيّة.
وفي هذا المقام غامر كاتب هذه السطور بإعادة قراءة أعمال الأستاذ صالح باعامر القصصيّة في الجزء الأوّل من أعماله الكاملة فوقف على قصتين من مجموعته الثانية الموسومة بـ(دهوم المشقاصيّ) وجد فيهما شبهًا في الموقف والرؤية، وإن اختلفتا في المعالجة والأداء. وحين همّ بالتفكير -نقديًّا- في القصّتين تحيّر عقله، أيسعى إلى تفسير النصّين أم يمضي نحو تأويلهما؟ فجال بفكره ذات اليمين وذات الشمال، وقلمه فاغرٌ فاه على الورقة حتّى ارتضى صيغةً لا هي من التفسير الخالص، ولا هي من التأويل المحض ولكنّها في منزلةٍ بين المنزلتين، فجاءت مقبولةً في دوائر النقد، ولم يجفل منها القارئ، وإن شكَّ كاتبها أنها تصلح أن تكون نموذجًا يُحتذى لو سعى ساعٍ للاستئناس بها. ولعلّ هذه خصيصةٌ من خصائص توظيف الثقافة في النقد، فتتسع دوائره، ويعزّ فيه الضبط المنهجيّ إلا في مظانّ ضيّقةٍ ومحدودةٍ.
– رؤية العالَم في النصّ:
سيقول قائلٌ: أنّى لك أن تصف هذه القراءة بعدم الضبط المنهجيّ وأنت تنطلق في قراءة النص السرديّ من معطيات منهجٍ منضبطٍ قال به ناقدٌ من طرازٍ رفيع وهو لوسيان جولدمن؟
وأقول: إنّ الوعي بصنيع جولدمن لم يَعْنِ هنا الالتزام بكلّ إجراءاته المنهجيّة، فكانت هناك مندوحة للمرء أن يأخذ من منهجه شيئًا ويترك منه أشياء. وإنّ النظر من هذا المنظور يتيح للمرء أن يقف على زاويةٍ للنظر إلى النصّ محددة دون أن يعنّي نفسه بالنظر إليه من زوايا متعددةٍ متنوعة. ولعلّ القراءة الثقافيّة تبيح له حريّة مثل ذلك التناول، وتعينه على مثل تلك المعالجة.
وإذا وافق قولُنا هذا وعيَ القارئ كما وافق شنٌّ طبقةً فإنّه حقٌّ علينا أن نعرض مفهوم رؤية العالم وما تعلّق به من مفهومات. وإنها -كما جلاها جولدمن نفسه، وعرّف بها من عرضوا لها من نقاد عرب وسواهم- بناءٌ متناسقٌ من الأشواق والأفكار والعواطف تختصّ بها فئةٌ ما في المجتمع لا ترقى أن تكون طبقةً بالمفهوم الماركسي للطبقة. وهي -أي تلك الفئة الاجتماعيّة- على تضادّ مع فئات اجتماعية أخرى لها أشواقها وأفكارها وعواطفها. وتسعى كلُّ فئةٍ من تلك الفئات إلى إدراك الواقع المحيط بها إدراكًا مرتبطًا بحركة التاريخ على جميع المستويات سياسيًّا، واجتماعيّا، واقتصاديًّا، وتربويًّا، ودينيًّا، وثقافيًا. ومن هنا ينشأ وعيٌ يمثل بنية فكريّة ترتبط بالمشكلات الآنية التي ينفعل بها المجتمع ويتفاعل معها من خلال صورتين من صور الوعي. فهو إما واقفٌ عند حدود الموجود عاجزٌ عن تجاوزه إلى ما ينبغي أن يكون وتسميه اللغة الواصفة بالوعي القائم ووجوده كائنٌ بالفعل. أو هو متجاوزٌ المشهود، يتنظّر المنشود ويسعى للالتحام بما ينبغي أن يكون وتسميه اللغة الواصفة بـ(الوعي الممكن) ووجوده كائنٌ بالقوة.
الوعي القائم صورةٌ من ارتباط الحاضر بالحدث التاريخيّ الذي تكوّن ويتكوّن في المجتمع. أما الوعي الممكن فصورةٌ من ارتباط الحاضر بالمستقبل الذي سيتشكّل من خلال سعي الفئات الاجتماعيّة التي اعتقدته في الحاضر ومضت معه إلى زمانٍ قادم.
مصطلح رؤية العالم كما تمّ عرضه في السطور السالفة -على الرغم من قصور الوصف في بلوغ مراقي الفهم لأبعاده النقدية- يصلح أن يكون وسيلةً للناقد في تأويل العمل المبدَع. ذلك أن قصارى ما يتغيّاه الفنان المبدِعُ هو جلاء مواقف الشخصيات، وتجسيد أبعادها النفسية والفكرية وبناء عوالم من التخييل تمتح من الواقع المحيط بها بعضَ شيءٍ ثم يدع للغة استكمال ما تبقّى من خَلْقٍ وإبداع.
أتراه من هنا جاز لنا البحث عن رؤية العالم في أدب الأستاذ صالح سعيد باعامر؟
لعلّه كان جائزًا.
وأدب الأستاذ باعامر ثريٌ ومتنوعٌ ومتعدّدٌ. فله مجموعات قصصية، وله روايات. فهو من السعة بحيث لا تقوى على احتوائه مقالةٌ في مجلة. فلا سبيل إذًا إلا تخيّر نماذج وانتقاء أمثلة تكون برهانًا على طبيعة البناء الفكري في بعض أعماله، فينفتح الباب لقراءات أخرى تستكنه مغاليق أعماله السردية، وتفضي إلى خصوبة في عرض الرؤى المكتشفة، وجلاء براعته في التشكيل.
ولقد سبق القول إلى أن كاتب هذه السطور وقف في الجزء الأول من أعماله الكاملة على مجموعته الثانية (دهوم المشقاصيّ)، وهنا يشير إلى أنه اختار منها قصتين هما: (العيك العيك)، و(صاحبة الشامة)، لتماثل بينهما في الموقف والرؤية، وإن اختلفتا في المعالجة والبناء.
حركة الأيام في تاريخ المجتمع:
وإنّ من متممات القول في حديث رؤية العالم الإشارة إلى حركة الأيام في تاريخ المجتمع لنرى ما للأحياء فيه ذكورًا وإناثًا من صلةٍ به وباتجاهاته الإيديولوجية وتأثرهم بها. فمنذ مطلع العقد الثامن من عقود القرن العشرين بدأ التنظيم السياسي للجبهة القومية (ج. ي. د. ش) يسنّ القوانين التي تنظم العلاقة بين الطوائف الاجتماعية على جميع المستويات، ويصدرها لتلتزم شرائح المجتمع بتنفيذها، وإن تكن في بعضها مخالفةً لمنظومة الشريعة الإسلامية كقانون الأسرة الذي سُنّت فيه موادّ تجرّم من يعمد إلى تعدد الزوجات، وتقيّد الطلاق بنزعه من يد الزوج ليصبح بيد الحاكم يفصل فيه بعد مداولةٍ بين الطرفين يصلان فيه إلى تراضٍ، وقد لا يصلان. وكان لهذا القانون وأشباهه أضرارُه على الأحياء في مجتمع الجمهورية أورثته رذائل لم تنس عواقبها حتى حين. ولم يكتفِ التنظيم بذلك بل أنتج مبادئ صاغها في شعاراتٍ ثوريّةٍ حماسيّةٍ من مثل (تحرير المرأة واجب)، و(حرق الشياذر واجب)… إلى آخر ما هنالك من ذلك، وإن يكن فيها خروج على أعراف المجتمع وتقاليده التي رسخت من سنين. ولقد كان من نتائج تلك المبادئ بحثُ المرأة عن سبلٍ للحصول على عملٍ تتهيّأ به للخلاص من تحكم الرجال في حاضرها ومستقبلها، ففي العمل فرصٌ ناجعةٌ للتحرّر من السيطرة والأسر والقهر الاجتماعي، فأنشئ في مدينة المكلا مثلًا ما عرف بالمجمع المهني الخاص بتدريب المرأة على صنوفٍ من الأعمال، وتتهيّأ من بعد للانخراط في مكاتب الإدارات المعنيّة مختلطةً مع زملائها في المكتب. فانفسح الدرب أمام الأحياء في المجتمع ذكورًا وإناثًا لتشكيل رؤىً مغايرة للرؤى التي نشأوا عليها من قبل. وصار العالم من حولهم يتشكّل على نحوٍ مختلفٍ عمّا كان عليه من قبل. ضعفت سيطرة الأب فلانت قبضته، وتقبل الزوجُ الحالَ الجديدَ تحت غطاءِ التمدّن ودعوى التحرّر والتطور، واستمرأ شبابٌ ذلك المنظور الجديد للحياة فتفاعلوا معه منفعلين به، وجرّ الوضع الجديد ذيولًا خلفه لم يستبن خطرَها الأحياءُ في المجتمع إلا بعد سنين. وبدا المجتمع يتشكل شرائح تتضاد رؤاها للعالم المحيط بها. ففي حين ارتضت شرائح منه (الرذيلة) فعاقروها حتى أدمنوها، اعتصمت شرائح منه (بالفضيلة) جبلًا يتحدّى صور السقوط والابتذال. وبدت مدينة كالمكلا مشطورةَ الأهواء والميول، تلقى فيها المتدينّين الذين يقيمون فيها شعائر الدين كاملةٍ من صلاةٍ وزكاةٍ وصومٍ وصفاء سريرةٍ وحسن خلق، كما تعثر فيها على اللاطة والزناة والسكارى الذين لا يقيمون للفضيلة ولا للخلق الحميد أدنى اعتبار. ومن هذه الأجواء خرجت (حسناء وحسن) في قصة (العيك.. العيك) وإن صار لهما مآلٌ آخرُ غير ما كانا عليه، ومنه جاءت (صاحبة الشامة وصديقها الموظف/ ملك الزمان). وهنا تسلّل الواقع المعيش إلى عوالم التخييل لدى المؤلف ليتجلى بلغته وحكايته وخطابه مستقلًّا عن ذلك الواقع وإن لم يبتر جذوره كاملة منه فيغدو مَرْكَبَةً تائهةً في فضاء لا توازنَ فيه. أو بنيةً فكريّةً مجرّدةً من قيود الزمان والمكان تنساح في مطلقٍ منهمرٍ لا يحيط به واقعٌ ولا تقيده حدودٌ. وهذه سمةٌ في الإبداع السامي حين يغدو نصًّا لغويًّا يمتح من واقعه صورًا وأشكالًا ويعيد صياغتها لتشكل رموزًا تشفّ عن رؤيةٍ وتكشف عن واقعٍ.
– في البنية الدلالية للسرد ورؤية العالم:
في القصة بطلان، عشيقة وعشيق. جمعت بينهما الأيام. كانت (حسناء) متشردةً تائهةً في مدينة المكلا، آواها (حسن) ومنحها ما لم يستطع أن يمنحها إياه الآخرون حبًّا فيها واشتهاءً لها. ولعلّ الرغبة في الظفر بها كانت الدافع الأقوى إلى تضحياته في سبيلها: (يقينًا لن يتحوّل حبّها إلى أيّ شخصٍ مهما كان إلا إذا لم تقدّر تضحيتي بكل شيءٍ). هكذا أنبأنا راوٍ يعلم أسرار الشخصية حاضرًا وماضيًا. ويمتلك القدرة على الجوس في خفايا النفس فينقل عنها ما استتر على المتلقين للسرد. ولقد استبطن صمت (حسن) حين استحضر في نفسه ما قدّمه (لحسناء) من عطاءٍ غيرِ مجذوذٍ: (التقطتها من الشارع. أخرجتها من أزقة المكلا المشبوهة. أبعدتها عن البيوت التي تتردّد عليها من أجل التكسب. ألبستها أفضل الملابس، زينتها بالأساور والخواتم والأقراط الذهبية. أزلت عن وجهها مظاهر الشحوب والبؤس…) إلى آخر ما هنالك من ذلك.
أفعالٌ ساميةٌ في ذاتها، لكنّها في الحقّ وسائل لغايةٍ، لا غاية تتقصّد صنع الجميل والمعروف لأنّه خيرٌ وأجملُ. إنّ ما قدّمه (حسن) سنانير اصطاد بها (حسناء) لتغدو عشيقته التي يتشهّاها، ولا يهمّه منها إلا ما يشبع حاجاته الحسية دون أدنى اعتبارٍ لإنسانيتها المنتهكة من زمنٍ بعيد. فهو حين يخرج بها مساءً إلى (خلف) لا يقصد إلى الترويح عنها ولكن ليفيض وجدانه بلحظات الاشتهاء داخله: (ألقى نظرة على الجسد الذي تكوّر بجانبه، وأخذ يتشمّم الرائحة العطرية التي امتزجت برائحة العرق الذي طالما أسكره). وعند انسرابها إلى أعماقها متفكّرة يسعى إلى جذبها إلى حاضره بفعلٍ لا يخلو من إيحاءٍ جنسيٍّ: (مدّ يده إليها وقرص فخذها). وحين كانا في السيارة (مرّر نظرةً على الجسد الذي ابتعد عنه روحيًّا…). وذاك ما أنبأ به راوٍ يعلم المخفيَّ من الصفات والصور الذهنية وكأنّه البطل نفسه.
هكذا تبدأ العلاقات بين عوامل (جريماس) تتشكّل في ثنايا السرد، ويتهيّأ النصّ لجلاء رؤيته للعالم المحيط به. فـ(حسناء) تتجلّى موضوعًا للسرد، أنثى يتشهّاها (حسن)، ولكنّها تتأبّى عليه في تلك اللحظة الزمنية منصرفةً عنه وعن رغباته وإن انصاعت لها في لحظاتٍ زمنيّةٍ سالفةٍ يوحي بها النص ولا يفصّل القول فيها تفصيلًا. علاقة الرغبة التي تتملّك نفس (حسن) وتملأ كل وجدانه تجد لها مُعينًا على إنجازها يتمثّل في (الخمر) و(العشاء) و(الأجواء المحيطة بهم في المكان المختار)، -هو هنا منطقة خلف حيث ينتشر العشّاق، يومذاك، على مسافاتٍ متقاربةٍ بما يأذن بسماع الوشوشات والهمسات كما يقول النص-. لكنها رغبةٌ تعجز الذات عن تحقيقها إذ يعوقها انصراف (حسناء) إلى أعماقها تتأمل حالها، ويستغرقها السؤال عن أهلها في (نوجد) ممّا نأى بها عن جوِّ الأنس المشتهى. وهنا تنشأ علاقة صراع بين ذاتٍ راغبةٍ وموضوعٍ مشتهى، وتتشكّل رسالةٌ تبعثها رغبةُ اشتهاءٍ إلى وعيٍ لم ينفصل بعد عن الوعي القائم في المجتمع بالفعل، وعي لم ير في اللذاذة الحرام ما يقام عليه الحد، لكنّه في تلك اللحظة الزمنية يستيقظ على رفضٍ لم تكتمل أسبابه وتنضج صورته ليتحدّى الموجود سعيًا إلى المنشود فظلّ كما يقول السرد غثيانًا في النفس تشعر به (الأنثى) ولا يدرك سرَّه (الذكرُ). (رائحة أشجار السيسبان تنفذ إلى منخريها.. فتسبّب لها شعورًا بالغثيان)، ولم يقف بها الحال عند ذلك بل سحبها الفراش الذي أعدّه (حسن) لجلوسهما إلى ذكريات طفولتها في (نوجد) (فتراءت لها “الشملة” السقطرية المنسوجة من شعر الأغنام التي يفترشها أبوها وأمها).
وهنا تتجلّى أمامنا علاقةٌ جدليّةٌ تقوم على أساس من الاتصال والانفصال. (فحسن) متصل بقيم المجتمع كما رسمتها أعوام العقد الثامن في (ج. ي. د. ش) وملتحم بها، لكنه منفصل عن قيم (الإله)[1] الذي بدا خفيًّا في وجودِ شريحةٍ عريضةٍ في المجتمع. تتماهى معه علاقة (حسناء) بقيم المجتمع، فهي مثله تمامًا خفي الإله في وجودها، ولذلك هربت من منزل الحاكم الذي آواها وتزوّجها في إطارِ منظومةٍ شرعيّةٍ لكنها كما قالت نصًّا: (عفت الحاكم بعد أن امتلكت نفسي. وانتظرت أحدًا من أولئك الشبّان أن يأتي ليطلب يدي لكن انتظاري طال). فهجرت (قصيعر) إلى (الريدة) ثم إلى سواهما من قرىً وحواضرَ تنتقل من رجلٍ إلى آخر حتى التقت بـ(حسن) (وأخذتَ ما تبقّى من نصفي السفلي). فصار (حسن) و(حسناء) كيانًا واحدًا متماهيًا مع قيمٍ لا علاقة لها بالدين ولا شرائعه ولا مثله. وقد أورثتهما تلك الحالة وضعًا نفسيًّا يلغى فيه (العقل) ويستبدّ به القلق، ينبئ عن ذلك الحوار الذي أداره (حسن) مع (حسناء) دون أن تردّ عليه سوى بقولها (لن تفهم)، والسبب في عدم الفهم أنه أضاع (نصفه العلوي). وهنا تغلّب الوعي القائم الموجود على الوعي الممكن المنشود وتراءت رؤية السرد للعالم المحيط بأحيائه رؤية انتماء والتحام. لكن حركة القص أنبأت أن (حسناء) كانت قد انسحبت من (الزمن الحاضر) وغاصت في أعماق (زمن ماض) استحضرت منه بعض صوره، يوم كانت طفلة (تلعب بين جذع نخلة هرمة)، وكان أبوها يغلي الحليب، وأمُّها وجدّتُها كل منهما تفعل ما شاءت. وهذا تحفيزٌ تأليفيٌّ قصد إليه (كاتب السرد) فوظفه على نحو رمزيٍّ، حيث أوحى إلى حال البراءة التي افتقدتها حسناء حين أخذت قسرًا من عالمها إلى عوالم أخرى لا صلة لها بها فافتقدت بكارة الحياة وطزاجتها، تذكّرْ أن الطائر قد هجم على القدر الفخاري الذي يغلي فيه الحليب -وهو رمزٌ للفطرة والنقاء فكسره ليهراق منه الحليب-. هذا الاسترجاع محفّزٌ تأليفيٌّ آخر يدّخره (السرد) لتهيئة (حسناء) للانفصال القادم في سطور القصة اللاحقة. على أنّ هذا استباقٌ نقديٌّ، لكننا واصلون إليه ولا مراء.
حين أتمت (حسناء) سرد حكاية طفولتها، وما وقعت فيه من تجارب، كانت قد أدركت أنّ (حسنًا) قد أضاع وعيه تمامًا، وأصبح وجدانه يرتعش فَرَقًا من عدم إدراكه سرَّ (الطائر والعجوز والحوت) فاتخذتها وسيلة للوصول إلى مبتغاها، وهو النجاة بنفسها واستعادة نصفها السفلي ليلتحم كيانها في كلٍّ واحدٍ متّحدٍ، مستغلّةً أجواء الظلام المحيطة بهما لإثارة انفعال الخوف والرعب في نفس (حسن). (نظرت حواليها مرارًا ثم توقفت عيناها طويلًا على شجرة السيسبان ثم حولت نظراتها إليه بينما هو ظل ينظر إليها وهي تتلفّت وتفتح منخريها أكثر فأكثر لتشمَّ روائح العالم)، وفجأة أخبرته أنها ترى ما لا يراه (المرأة العجوز. انظر إنها تقترب نحونا .. يا سلام .. وفوق الشاطئ ينتظر الحوت). وهنا تلاشت الرغبةُ كاملةً من نفس (حسن) في (حسناء)، وغدا اشتهاؤه إياها لهبًا يحرق شرايينه فيحيلها رمادًا، فخشي على قليل ما تبقّى له من لذائذَ حسيّةٍ تمثّلت في (لفافة الأكل) والقنينة والكأسين الزجاجيين، (وزحف نحو شجر السيسبان). وهذا محفزٌ تأليفيٌّ آخر، حيث أصبح السيسبان معادلًا موضوعيًّا لانقطاع العطاء والعجز عن الإثمار النافع المفيد، ورمزًا لتلاشي الحياة إن طغا على الأرض واستبد بالحياة. أما هي فقد (انتصبت وأدخلت أصابع يديها بين خصلات شعرها وأبرزت صدرها وغنت بصوت طروب: العيك .. العيك .. العيك).
وهذه علاقة انفصال بين (حسن) وما يمثله من وعيٍ قائمٍ موجودٍ، تقابلها علاقةُ اتصالٍ بين (حسناء) ترفض (حسنًا) وبين عوالمه الشهوانية المبتذلة، وترتفع بنصفها السفلي عن آبار الرذيلة المعتمة لتتعزز في ربى الفضيلة التي تترقب إشراق شمسها في محيطها المظلم، ولذلك كانت آخر جملة في السرد: (وطارت هي في الأجواء البعيدة وكأنها ستعانق الشمس).
كانت (الرذيلة) في وجود (حسناء) نتاجَ وعيٍ قائمٍ لا يقيم لشرائع الدين اعتبارًا، ويستبدل بها قوانينَ ما أنزل الله بها من سلطانٍ. فهل في رفض (حسناء) إيذان بشروق شمس تلك الشرائع والاستئناس بها في ممارسة الحياة؟ إن النظر إلى بنية العلاقة هنا في إطار (الاحتباك) يجعل الإجابة عن السؤال بالموجب واردةً وصحيحةً.
وهذا يعكس طبيعة الصلات بين (حسناء) و(حسن ومجتمعه) وشرائع الإله. فهو هنا يتجلى في نفسها فترفض ما حرّمه، وتتأبّى على رغبات مرذولةٍ محرمةٍ وتنفصل عن قيم مجتمعٍ اختفى فيه الإله وما ينبغي له أن يختفي لولا نظمٌ مفروضةٌ لا بقوة الفكر وتصادم الإيديولوجيا ولكن بفعل السلطة وجبروتها الفرعونيّ، ومن هنا كان الانزياح سهلًا والتوافق مع بديله ميسّرًا، فتغيّرت رؤية العالم في النص فغدا الرفض لا الانتماء شعارها الموسوم وبندها العالي المتعالي. وهذا نقيضٌ ما أفضت به قصة باعامر الثانية (صاحبة الشامة).
لم تقف الآثار الاجتماعية لقانون الأسرة وما تعلّق به من مبادئ وشعاراتٍ عند حدود الإناث المتشردات في الشوارع، المتنقلات بين بيوت ذكور تائهين في المجتمع لا غاية سامية لهم تصّاعد بهم إلى مستويات من الرؤية ذات سمتٍ رفيعٍ فانحصروا في دوائر شهواتهم التي كانوا يتلقطونها من شارعٍ عامٍ أو زقاقٍ ضيّقٍ، فتجاوزتهن إلى عمق المؤسسة الشرعية العظمى -أعني الزواج- لتتراءى أعدادًا من المتزوجات متخذات أخدان يتلهين بهم كما يتلهون بهنّ، مشكلاتٍ في المجتمع شريحةً تنتخب كلُّ واحدةٍ من أفرادها معشوقًا بعينه تخصّه بجناحٍ مفردٍ من عواطفها ومشاعرها وتشاركه لحظات أنسها به وأنسه بها غير مكرهة على فعل كائنة ما كانت صفته. ولقد تكون الأنثى متزوجة وبعلها يعيش معها في المنزل، وقد تكون متزوجة وبعلها يعيش مغتربًا في أحد المهاجر، وقد يكون حالها معه قريبًا من هذا وذاك. وأيًّا كان حال الزوج -مقيمًا في الوطن أو مغتربًا عنه- فإنّها تجد في عاشقها ومعشوقها في آن واحد ما يثري وجودها ويمنحها حالة من الاتزان النفسيّ فتراها تتلذذ بهيامها به، وتجد في استعادة ذكرياتها معه سعادةً وصفوًا. وإن لصفاء العلاقة بين الطرفين يدًا في قبول جانبٍ حسيٍّ تولده الرغبة والاشتهاء في قلبيهما، فلا تجد هي غضاضةً في مضاجعته والالتذاذ به، ولكم وجد هو هناءً في إطفاء لهيب حسه في خلجانها الدافئة.
ومن تلك الأجواء التي عرفها المجتمع ولم يقبل بها، فما زال للفضيلة حرّاسُها، انبثقت قصة باعامر الموسومة بـ(صاحبة الشامة). وتلك صفة صاحبة القصة، و(اسمها العَلَم) الدال على هويتها. وكأنما أراد السرد أن يبئّر (الشامة) -وهي نكتةٌ سوداءُ في خدّ الحسناء تزيدها فتنةً- لتظهر على مستوى العنوان، وعلى مستوى (العَلَميّة)، وعلى مستوى (التحفيز التأليفي) كما سنراها في خاتمة القصة.
تتكون القصة من ثلاثة مقاطع سردية يكتنفهما زمنان، حاضر تنطلق منه أحداثٌ، وماضٍ تُسترجع فيه أحداثٌ. أما زمن الحاضر فيشتمل على مقطعين هما المقطع الأول والمقطع الثالث. وفيهما تتغلّب تقنية (المشهد) في عملية (العرض). فيروى حدث الحكاية من خلال حوار هاتفي بين (العاشقين)، يعودان فيها إلى التواصل عبر الاتصال بعد انقطاع لا ندري أمده. وهو حوارٌ يشفّ عن طبيعة العلاقة بين (العاشقين) وسمتها الجنسيّة. قال لها: (رائحتك تخترق سلك الهاتف). قالت له: (وذكورتك تطاردني). وهي تقصد (فحولته) فما كل ذكر بفحل.
وفي هذين المقطعين تقوم (الكاميرا) -وهي آلةُ تصويرٍ مرئيٍّ- بدور السارد الذي يروي لنا الأحداث، فنسمع تحاورهما، ونرى حركة ما حول البطل وهو في مكتبه الوظيفيّ، ونبصر أثر وقع كلامها عليه على أعضاء جسده. (تأوه .. أخرج تنهيدة موغلة .. نظر إلى وجوه المتحلقين حوله وأدار ظهره لهم … دق قلبه دقات فوق ما يحتمل)…
ولقد دلّ الحوار على أنّ (العاشقة المعشوقة) لم تعد تطيق فراقًا فسعت إلى وصل ما انقطع بينهما ولكن في ضوء شروطها التي اعتادت إملاءها على (عاشقها المعشوق)، فهي أقوى منه شخصيّةً وأظهر إصرارًا على الرأي وأوغل في التحدي. ففي المقطع الأول يظهر لك إصرارها على استنطاق (الذكر المتصل به) ليكشف لها أنه عرفها واستحضر ذكراها واستدل على اسمها ولو من خلال الصفة. (هل أنستك السنين صوتي؟ من؟ يبدو أنك لم تتذكرني). فما كان منه غير الاعتراف لها بأنّه عرفها (وكيف لا أعرف من ارتسمت شامتها في كل دواخلي). وهنا ينقطع السرد في المقطع الأول لينتقل بتقنية الاسترجاع في المقطع الثاني، لكني أؤثر أن أستمرّ في استقراء حالة السرد في زمنه الحاضر ليتسق العرض والتحليل. في المقطع الثالث تستمر الكاميرا في رصد حركة الحدث وتجسيد الحوار بين البطلين. فنرى (المتحلقين) حول البطل منشغلين بأنفسهم عمّا يدور حولهم من مكاشفة (عشق) مما أتاح لهما أن يبوحا عَلَنًا بما لا ينبغي له أن يباح، أعني اشتهاء العاشقين بعضيهما، لكن اللافت أنّ البطلة وإن اشتهت (ذكورة صاحبها) إلا أن لها من الاقتدار على احتمال لهبها دون ارتخاءٍ، في حين أورثت الشهوة (للأنثى) فيها البطلَ حالةً من الامتهان جعلته يتضرّع لها مستجديًا وصالَها بعد انقطاع:
( – لنعد كما كنا
* وهل الذي ينكسر يعود كما كان؟
– بي توق إليكِ).
وهنا تدثر البطلة تمنّعَها عليه بتعلّاتٍ قد تكون صائبةً وقد لا تكون، ولكنها اعتصمت بها. وفجأة ضحكت (فقال بفرح طفولي: كم اشتقت لهذه الضحكات). وحين استنكرت منه شوقه لضحكاتها، أردف قائلًا: (وإلى الشامة التي تميزك عن سائر البشر). فتردّد الأنثى -وفي ردها يتجلى إصرارها وتحديها وقوة إرادتها في مجابهة ومواجهة رغبتها وإن تك مشتهاةً- (ولأنها تميزني أزلتها بعملية جراحية).
وذلك ما لم يحسب له الذكر حسابًا فغرق في الصمت، وانتهت القصة. لكنّ وقفتنا إزاءها لم تنتهِ، فما زال عرضنا لأحداثها في الزمن الماضي المسترجع لم يبدأ بعد، ولم يزل حديثنا عن جلاء رؤية العالم فيها متواريًا غير معلن.
يفتتح المقطع الثاني بمرأى (العاشق المعشوق) صاعدًا سلالمَ منزلها ويقرع جرس بابها لتفتح له متهللةً هاتفةً باسمةً: (ملك الزمان). ولسنا على يقين من أن ذلك هو اسمه العَلَم أم أن تلك صفةٌ أسبغتها عليه حبًّا وهيامًا. وتلك ملاحظة يدركها قارئ القصة، وأعني بها تقنية اللبس التي يقع فيها القارئ فتتكاثر فيها الأسئلة في نفسه دون العثور على جوابٍ، والعلة فيها هو بتر التفاصيل السردية التي تساعد على جلاء الغموض وتعيين طبيعة المواقف وهوية الشخصيات. ومن ذلك مثلًا ألهذه الأنثى زوجٌ مقيمٌ أو مغتربٌ -سيان- أم ليس لها (شيءٌ) من ذلك الارتباط الشرعي؟ وما مدى تاريخ هذه العلاقة بين العاشقين المعشوقين التي بلغت حدًّا من الثقة تجعل الأنثى تستضيف ذكرها في منزل الزوجية وتبيح له ما لا يباح إلا لزوجها وفق معطى الشريعة وأعراف المجتمع (انفتح الباب فرآها دون نقابٍ فبدا له جسمها المرمري ينفح بالحياة داخل الثوب الشفيف).
ولقد قضيا وقتًا تمتعا فيه بلذائذَ شتّى متحلقين حول (البخاري) ليشربا من شاهيه ما شاءا، ولينغمسا في سوى تلك اللذة الحسية من متع أخرى لا يعلمها إلا الله وهما.
لكنهما ما إن اكتفيا من ذلك كله فاجأته برغبتها في الفراق عنه وقطع أسباب العلاقة بينهما. هكذا دون علةٍ مذكورةٍ أو مشارٍ إليها بذكرٍ. وهذه صورة من صور البتر في جلاء الحدث. بيد أن السرد انصرف عن ذلك ليبئر الحالة النفسية للبطل باستخدام تحفيزٍ تأليفيٍّ يتمثل في البخاري الذي زاد اشتعاله من غليان الماء بداخله فنفث دخانًا كثيفًا كأنه الآهات المحمومة التي تراكمت أبخرةً في وجدانه المصدوم بما ذكرت له من رغبتها في فراقه. يتماهى معه تبئير السرد لمظاهر من جسدها ليكشف عن بضاضته وملاسةِ ملمسه مما يثير الحسرة في نفسه (هل سأفتقد هذا الجسد البض، هل سأحرم من هذه الروح الشفيفة، والرائحة العطرة التي ينفح بها شعرها…؟). على أن هذا لا يجديه نفعًا، فقد تحقق الفراق، واستمر سنين عددًا حتى جاء اتصالها ليحيي أملًا لم يبدأ حتى انتهى، وبه أنهى السرد حركته ليتولّى التحليل جلاء رؤية العالم فيه.
والحق أن تلك الرؤية نابعةٌ عن وعي (العاشقين المعشوقين) بصور الحياة كما هي ممارسةٌ في وجوديهما. وهما وجودان غير منفصلين عن حركة الحياة في المجتمع، فانبثق عنه (وعيٌ) أدرك سر الوجود في إطار الموجود دون مجاوزته إلى المنشود. وهو وعي صاغته قوانين سلطةٍ ومبادئ نظامٍ متحديةً منظومةَ شرعٍ وأعرافِ مجتمعٍ، كان ذلك سمة وعيهما في زمن القصة الماضي، وظل هو وعيهما في زمن القصة الحاضر، إنه وعيٌ قائمٌ بالفعل، يتحدد منظوره السرديّ بتعيين العلاقة بين الذكر والأنثى في علاقة اشتهاء خارج دائرة الشرع الذي يبيح للزوجين استحلال بعضهما لبعض بأمر الله، أما العاشقان فقد استحلّا محرّمًا بقوة القانون وجبروت سلطته.
وهنا يخفى (الإله) ولا يتجلى في الوعي القائم في المجتمع من جهة فيتمثله البطلان وعيًا قائمًا بالفعل من جهة أخرى، فيتم الالتحام بينهما منفصلين عن ذلك (الإله الخفي)، وتتجلى الرؤية في النص رؤية انتماء للموجود، وعجز عن الالتحام بالمنشود. وهي رؤيةُ سلطةٍ حكمت مجتمعًا كاملًا ردحًا من الزمن حتى آذن الله بزوالٍ، فانتفى حالٌ، وتجلى حالٌ.. وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنته تبديلًا ولا تحويلًا.
المكلا في 6/11/2017م
[1] أقصد (بالإله) هنا كل معالم الشريعة الإسلامية وما اتصل بها من قيمٍ وأخلاقٍ وما نتج عنها من أعرافٍ.