نقد
د. أحمد عبدالله السومحي
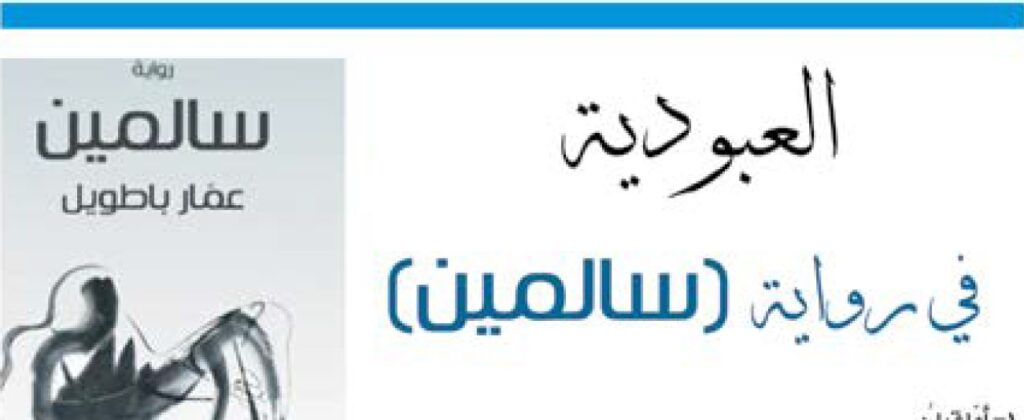
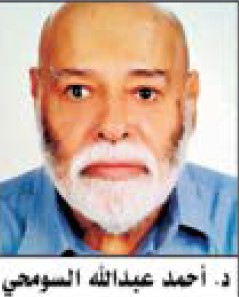
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 8 .. ص 108
رابط العدد 8 : اضغط هنا
1- أمّا قبلُ:
فإن رواية (سالمين) للكاتب الروائي الشاب عمار باطويل، هي باكورة إنتاجه الأدبي، والرواية تقع في (107 صفحات من القطع المتوسط)، وغلاف بسيط، من إصدارات دار فضاءات -الأردنية- عام 2014م.
ولعله من الطبيعي أن تكون البدايات في الأعمال الأدبية صعبة وغير مكتملة، وقد عانى كُتَّابٌ أصبحوا كبارًا ومشهورين من هذه الظاهرة الطبيعية، فقد كتبوا ومزقوا، ونشروا وندموا… إلخ.
وهناك عبارة للراغب الأصفهاني، يقول فيها ما معناه (أنه إذا أنجز عملًا كتابيًا، وأعاد النظر فيه لتمنى أن يعدل ويغير فيه).
وإذا جاز التعبير فإني أشبه ذلك بالطفل الذي يبدأ المشي بالاستناد إلى الحائط، ثم يمشي بخطوات مهتزة، ثم ينطلق، أو كما تتطور الثمرة من البرعم إلى التفتح إلى الاخضرار إلى النضج، المهم أن تكون عندك الموهبة.
والكاتب في تقديري يملك موهبة كتابية قوية في الفن الروائي، ستبرز في المستقبل القريب، فلا يستعجل الشهرة، فالجاحظ لم يبلغ مرحلة النضج إلا في سن الستين، وهناك شعراء نبغوا بعد الأربعين، والكاتب إلى الآن لم يبلغ هذا القدر من العمر، والأدب: موهبة، وثقافة، وتجربة، ثم ممارسة، والممارسة تحتاج إلى نَفَسٍ طويل، فكم من كاتب -مثلًا- كتب قصة قصيرة ممتازة بعد أن مزق عشرات المسوَّدات، والسبيل إلى ذلك هو الاطلاع بعمق على تجارب الآخرين، فالموهبة وحدها لا تكفي.
وليس في ذلك من عيب، فالتطور من سنن الكون، وطبيعة الحياة، والدليل على ذلك أن رواية الكاتب الثانية (عقرون 94) أنضج فنيًا مما نحن بصدد الحديث عنها، وربما تكون الثالثة أقوى.
وليس معنى ما أقوله أن الرواية سيئة، ولكني أريد أن أدفع بالكاتب إلى مزيد من الاطلاع والممارسة؛ لأني في السطور القادمة سأتحدث عنها بحسب رؤيتي وقراءتي لا برؤية الكاتب أو القارئ، ولكل رؤيته وقراءته.
2- العبودية:
وفكرة الرواية تتمحور حول العبودية، والعبودية أنواع وأصناف وأشكال، فالإنسان عبد لله منذ وجوده، ثم يصبح عبدًا لامرأة، وقد يصبح عبدًا لشهواته ونزواته، أو يصبح عبدًا للمال، أو للوظيفة.. وهكذا هلم جرًّا.
لكننا هنا أمام حالة فتى أسود في الرواية يسمى (سالمين)، اشتراه سيده الوجيه صالح من (حجر) أو من تاجر جلبه من حجر بثور، صفقة رخيصة إنسان بحيوان، ولا أدري لماذا اختار الكاتب حجرًا مع أن الراوي يقول: إن العبيد يباعون في سوق (بضه، والخريبة) بدوعن، وحجر بعيدة من (دوعن). هل لأن حجرًا بؤرة السواد، وبه أنواع من هذا الجنس (العبيد، والصبيان، والحجور، والبحسن) أو لسبب آخر؟!
وشراء سالمين من حجر، الذي لا يعلم شيئًا عن أبيه وأمه، ولا يعرف شيئًا عن جذوره يثير هذا الجهل بأصوله في ذهني تساؤلات هل هو شخصية حقيقية أو رمز للجهل والغيبوبة التي يعيشها المجتمع الحضرمي في ذلك العصر، ومن تناقضاته، ويذكِّرني هذا بقول الشاعر العكبري (برجف):
واحد عشق في عبد حبه ملك له ***من زام عاد الناس تعشق في العبيد
عشقه ع صيته ولا يعرف سمه *** والعبد حر من زام هارون الرشيد
يومن من الأيام شل عبده معه *** وتملكوا وادي وهي ترعد رعيد
حتى وصلهم سيل ماشي مثل له *** ونووا على عبوره يريد أو ما يريد
وقال له يلعبد سيدك عز به *** وحمله حتى وصله للغوط الشديد
سبر يراوس به وجاته حقته *** ورماه من كتفه ونط منه بعيد
هذه دلول العبد لا ما تعرفه *** بدعات يلقيها ويلقي شي جديد
قطعًا الشاعر لا يقصد العبودية الآدمية، وإنما قد يكون يقصد أمرًا قبليًا أو اجتماعيًا أو نظامًا سياسيًا.
على كل حال بعد أن نال سالمين ألوانًا من الإهانات والخدمة والتهديد بالبيع، هاجر مع سيده إلى السعودية بعد أن بذل جهدًا في إقناعه بالسفر معه؛ ليقوم على خدمته، على أن يقوم بالإشراف على النخل والأرض الزراعية الصبي (صالح)، وصالح هذا من فئة سالمين الاجتماعية، إلا أنه يرى أنه أفضل منه درجة، فهو لا يباع ولا يشترى.
انتقل سالمين مع سيده حمد أو أحمد إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، واستقرا فيها، وانتقل من العبودية إلى الحرية، ومن الجنسية الحضرمية إلى السعودية بعد أن اشترى له سيده الجنسية السعودية بمليون ريال سعودي بعد أن راجت تجارته في الذهب، والأراضي، وهنا يصعد إلى ذهني سؤال، كيف اشترى الجنسية للعبد سالمين؟ فالمفترض أنهم هاجروا إلى السعودية في زمن كان خوية آل سعود يدورون بالتابعيات على الدكاكين والبقالات أي في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان هناك من يرفضها، إذن نحن أمام عبودية جديدة.

وتتحدث الرواية عن تهديد الشيخ أحمد ومنِّه على سالمين لكونه اشترى له الجنسية، وجعله بني آدم مثل خلق الله، وبذلك انتقل سالمين إلى عبودية جديدة.
بعد أن استقر سالمين بطل الرواية وسيده أحمد في جدة، وأخذت ثروتهما في النمو، تزوج أحمد من (سوسن)، وقد عرفنا زواج السيد، لكن الكاتب لم يخبرنا عن زواج العبد، ودخلوا في عبودية النساء والإنجاب والمال، وانقلبت حياتهما، حيث أخذتهم عبودية الشهوات والنزوات، وتعددت الرحلات، وأغرم العبد الأسود باللحم الأبيض، ونسي أحمد مريم حبيبته التي كان يطاردها في الشعاب والغيران، كما نسي خديجة أخته التي أرسلها أبوه له من إندونيسيا.
ويبدو أن استعباد سوسن لأحمد كان طاغيًا وشرسًا، فقد سيطرت عليه ومسخت شخصيته، فلم يظهر كشخصية عامة من رجال الأعمال لها مكانتها في المجتمع.
وذلك ما أدى إلى عدم اهتمامه بموطنه الأصلي، وإقامة مشاريع فيه. والمرة الوحيدة التي ذكر فيها موطنه حضرموت هي في تأنيبه لسالمين بقوله: (هكذا يا سالمين نسيت البلاد بعدما وصلت جدة)، ولكن يظهر العبد أنه ما زال متمسكًا بوطنه كتمسكه بعبوديته التي لم يستطع الخلاص منها، فكيف لهذا الإنسان مجهول الأب والأم والأصل أن يتمسك بوطن ذاق مرارة العبودية فيه مع جهله لأصله، هل كان الكاتب يريد أن يفهمنا أمرًا ولكن في فمه ماء؟؟ ربما!
ومع أن سالمين استرد حريته وآدميته في السعودية إلا أنه ظلت العبودية تحاصره في أشكال مختلفة في زوجة سيده، وابنه حسن، وفي الشارع، وفي الأحلام، ففي الشارع يسبونه وينادونه يا العبد بسبب لونه، وفي أحلامه تعيد عليه الماضي في رؤية محمد سالم ذاهبًا به للبيع، وفي السوق ينادي عليه (عبد للبيع)… إلخ.
وتبرز من خلال العبودية إشكالية تنكر السيد لأصله الحضرمي، وتمسك العبد بها الذي يجهل أصله وفصله وأباه وأمه ومكان مولده، ويقفز أمام القارئ سؤال إلى أين يتجه بنا الكاتب؟ هل يقصد العبودية الآدمية حقًا أو أن العبودية غلاف لواقع الحضارم في المملكة العربية السعودية وخاصة المهجنين منهم كما يطلق عليهم؟!
والكاتب إن أراد بالعبودية، العبودية الفردية، فالرواية مجرد حكاية عادية.
«رجل يدعى صالح يملك ثورًا وأرضًا زراعية، فيبادل بالثور عبدًا، ثم تضيق عليه الحياة فيهاجر إلى إندونيسيا ويموت بسنغافورة، ويهاجر ابنه أحمد مع العبد سالمين إلى السعودية، وينالون الجنسية السعودية، ويثرون ثراء فاحشًا، ويتزوجون وينجبون، وينسون وطنهم الأصلي أو يكادون».
أما إذا أراد بها واقع الحضارم وعبودية المال، واتخذ العبد سالمين ستارًا لذلك، فالرواية تعد عملًا أدبيًا جيدًا، وأنا أميل إلى الرأي الثاني، ويرشح هذا الرأي أن سالمين يريد أن يتخلص من لون جلده وعبوديته مع أنه أصبح حرًّا فلم يستطع، ويعني ذلك مهما غيَّرتُمْ يا حضارم من أسمائكم وعيشكم ستظلون في نظر السكان الأصليين (أبوحضرم) أو (حضيرمي)، وسيظل (الباء) مركوزًا أمام أسمائكم، وأمر آخر جدير بالملاحظة في هذا الترشيح، وهو أن العبد سالمين من غير أب ولا أم ويبحث عن جذوره.
على أنه من الجائز أن يكون قصد نوعًا آخر من الاستعباد، كاستعباد الاشتراكية أو الرأسمالية.
3- الهجرة وتحولاتها:
والرواية تتعرض لهجرة الحضارم، وذهابهم في أصقاع الأرض بحثًا عن الرزق والعيش الكريم، فهذا صالح أبو أحمد بطل الرواية من قرية من دوعن يهاجر إلى أفريقيا، ثم إلى الهند فجاوة، ثم يقتل في سنغافورة في أثناء الحرب العالمية الثانية، وهذا ابنه أحمد يطلب من وكيلهم في إندونيسيا أن يتصرف في أملاكهم هناك بالبيع، وأن يحول المبلغ إلى السعودية، وفي السعودية تتحول حياة أحمد من حضرمي إلى سعودي، ومن ملاليم إلى ملايين، وهكذا العبد سالمين من العبودية إلى الحرية، ومن ملاليم إلى ملايين، ويطلب من أولاده أن يتزوجوا نساءً بيضًا لتتحول ألوانهم من السواد إلى البياض، وحياة الشظف تحولت إلى ترف، وابن خال أحمد تحول إلى مكاوي، ويحاول يغير جلده ولهجته، فقد تزوج من سعودية من أصل مغربي، وأولاده أصبحوا بيضًا، وهو يحاول يقلد أهل مكة في كلامهم، وهناك تحولات في السلوك والمشاعر والمثل والعادات.
4- أمّا بعدُ:
فإن كتابة الرواية الأدبية ليست سهلة، وهي من أصعب الأجناس الأدبية؛ إذ كيف يأتي الكاتب بأشخاص، ويوجد لكل شخصية حياتها بأحداثها من خير وشر، ويعبر عن شعورها وإحساسها، ثم يؤلف بين تلك الشخصيات، أو يفرق، ويجعلها تتصارع أو تتواءم.
وفي منتصف القرن الماضي تقريبًا هاجم النقاد المفكر الأديب عباس العقاد، وتحدَّوه أن يكتب رواية أدبية، وقبل التحدِّي، وكتب قصة هزيلة بعنوان (سارة)، وفشل في ذلك ولم يعاود التجربة؛ لأن قدراته الفكرية أعظم من الخيالية والتخيل، وليس ذلك عيبًا، فالمواهب متعددة ومختلفة، فنجيب محفوظ -رحم الله الجميع- كاتب رواية من الطراز الأول، لكنه لا يستطيع كتابة مقال جيد، وإنما كان له عمود صغير في (الأهرام) أو (الأخبار).
وبناء على ذلك فإن هذه الرواية التي نتحدث عنها هي باكورة كاتب شاب، وبداية مشواره الأدبي، ومن الطبيعي أن تكون للبدايات قصورها الفني، ومع هذه البداية فهناك إجادة، وهناك هفوات، وسأبدأ حديثي عن فنياتها من الغلاف:
فغلاف الرواية بسيط يعلوه العنوان (سالمين) وفي الوسط رسمة في غاية البساطة، وهي معبرة عن فكرة الرواية؛ حيث تجمع بين السواد والبياض، وكأن هناك إنسانًا ممسوخًا، ولعل الكاتب أراد أن ينبهنا، إلى أن هذا المسخ مخلوط من اللونين، فغلافه أسود لكن داخله إنسانية، والإنسانية بيضاء؛ لذلك فالقدم واليدان بيضاوان واضحتان، وكأن البياض يريد أن يتخلص من السواد، وهي فكرة جيدة وطبيعية، فالرِّجل البيضاء بارزة وكأنها تريد الهرب.
أما عنوان الرواية (سالمين) فلا يشدني ولا أظنه يشد القارئ، وربما أعاد النظر الكاتب فيه في الطبعة الثانية.
والرواية تبدأ بأسلوب الحكاية، وسردها حكواتي فأحمد رجل بدوي، يتنقل في القرى والأودية والشعاب، ويقابل أناسًا مختلفين، ويتحدث إليهم حديثًا عاديًا، ويجالسهم، ثم إنه جمّال على جمله (الدهس)، هكذا يبدأ السرد إلى الفصل الرابع فترتفع وتيرة السرد الفني قليلًا.
وبعد.. فإن ما قلته مجرد استنتاج وهو رأي شخصي يخصني ولا يخص الكاتب، والإنسان قد يصيب وقد يخطئ..