كتابات
د. محمد علوي بن يحيى
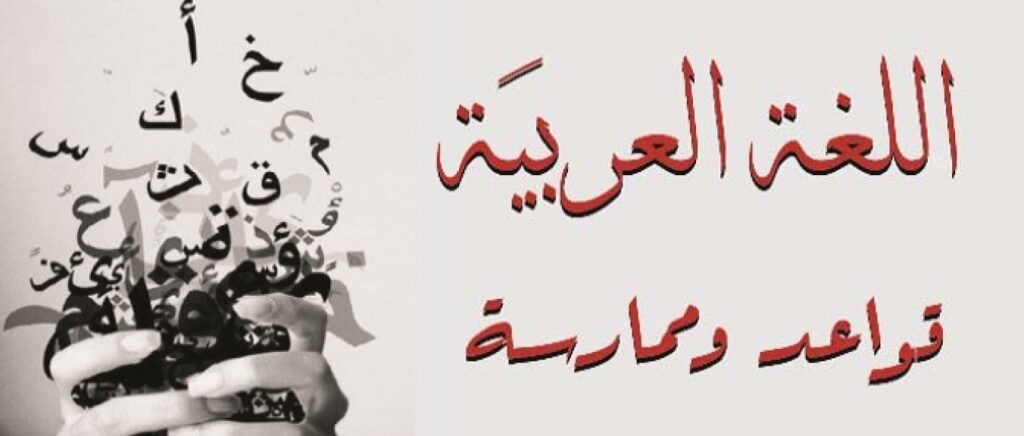
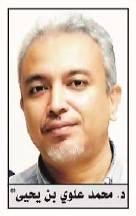
د. محمد علوي بن يحيى
أستاذ علم اللغة والنحو العربي المساعد قسم اللغة العربية وآدابها- كلية الآداب/ جامعة (عدن)
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 9 .. ص 48
رابط العدد 9 : اضغط هنا
كم كنتُ أتمنَّى ألَّا يُخَصَّ يومٌ من أيامِ السَّنة بالاحتفال بلغتنا الأم (لغة الضاد), وتُهمَلُ في سائرِ أيامِ السَّنة؛ ذلكَ لأنَّها لغةُ القرآنِ الكريم. هذا الكتابُ المقدَّس الذي ينبغي ألاَّ تُهجَرُ قراءتُه في مجمَلِ أيامِ السَّنة، ولا يتأتَّى أن تُقرأ كلماتُه إلَّا بلغةٍ عربيةٍ مُبِينةٍ فصيحة، فحرِيٌّ بأمَّة القرآنِ أن تتكلَّم في أيّامِ السنةِ كلِّها بلغةِ القرآن.
بيدَ أنَّ ثمَّةَ مشكلةً عويصةً تعترِضُ إنفاذَ هذا الهدف، هي:
كيف يمكنُ لعربِ القرنِ الخامسَ عشرَ الهجريِّ أن يظفَروا بفصاحةِ عربِ القرنِ الأول الهجري, وما قبلَه؟
ولعل الجوابَ المتبادرَ إلى أذهان الكثيرين ممَّن حظَوا بنصيبٍ من دراسةِ هذه اللغةِ, هو أن يلجَأ كلُّ مَن يرومُ دراسةَ هذهِ اللغةِ, إلى دراسةِ قواعدِها الممثَّلةِ في علمَي: النحو, والصرف.
غير أنَّ الجوابَ الذي يبدو لي واقعيًا, هو (مع الأسف) غيرُ ذلك!
إذ لو سألَ كلُّ واحدٍ نفسه: أيُّهما سبقَ الآخر: اللغةُ أم قواعدُها؟ لهداهُ فكرُه إلى أنَّ الأولَ سبقَ الآخر.
وقد فطنَ العلاَّمة (ابنُ خلدون) المتوفَّى سنةَ (808هـ), أي قبلَ ثمانيةِ قرونٍ تقريبًا, بفكرٍ ثاقبٍ, إلى أنَّ العربَ الأوائلَ لم يمتلكوا الفصاحة في كلامهم سليقةً, كما ظنَّ كثير منهم قديمًا وحديثًا, وإنما امتلكوها بعد سَماع, ومِراسٍ طويلَين؛ إذ يقول: “يظنُّ كثيرٌ من المغفَّلين ممَّن لم يعرفْ شأنَ الملَكاتِ أنَّ الصوابَ للعربِ في لغتهم: إعرابًا, وبلاغة أمرٌ طبيعي, ويقول: كانتِ العربُ تنطقُ بالطَّبع, وليس كذلك, وإنما هي ملَكة لسانيَّة في نظمِ الكلام, تمكَّنتْ, ورسخَتْ, فظهرتْ, في باديِ الرأيِ, أنَّها جِبِلَّةٌ, وطبع, وهذه الملكة… إنما تحصل بممارسة كلام العرب, وتكرُّره على السمع, والتفطُّن لخواصِّ تراكيبه. وليستْ تحصل بمعرفة القوانين العلميَّة في ذلك, التي استنبطها أهلُ صناعةِ اللِسان”. (مقدمة ابن خلدون:313).
ويضيف إلى ما سبق بقوله: “فإنَّ العلمَ بقوانينِ الإعرابِ إنَّما هو علمٌ بكيفيَّةِ العمل, وليس هو نفسَ العمل, ولذلك نجدُ كثيرًا من جهابذةِ النحاة, والمهَرةِ في صناعةِ العربيَّة, المحيطينَ علمًا بتلك القوانين, إذا سُئِل في كتابةِ سطرينِ إلى أخيه, أو ذي مودَّتِه, أو شكوى ظُلَّامِه, أو قصدٍ من قصودِه, أخطأ فيها عن الصواب, وأكثرَ من اللَّحن, ولم يُجِدْ تأليفَ الكلامِ لذلك, والعبارةِ عن مقصوده على أساليب اللسان العربي. وكذا نجدُ كثيرًا ممَّن يُحسِن هذه المَلَكة, ويُجيدُ الفنَّين من المنظوم والمنثور, وهو لا يُحسِن إعرابَ الفاعلِ, من المفعولِ, والمرفوعِ من المجرور, ولا شيئًا من قوانينِ صناعةِ العربيَّة. فمِن هذا تعلمُ أنَّ تلك الملكةَ هي غيرُ صناعةِ العربيَّةِ, وأنَّها مستغنيةٌ عنها بالجُملة”. (المقدِّمة: 321).
أي إنَّ قواعدَ النحوِ, والصرفِ ينبغي أن تكونَ خادمةً النصَّ اللغويَّ المثاليَّ, ومُحكِمةً ألفاظَه, وليس العكس.
وإن كان الأمرُ كذلك فهذا يُلزِمُنا أن نبحثَ عن اللغةِ المثاليَّةِ, ونستمعَ إلى أصحابِها؛ لكي نحاكيها, ونرتقِيَ بألسنتِنا لتجاريها. وهيهاتَ أن نجدَ تلك اللغةَ! ذلك أنَّ اللغةَ العربيةَ الفصحى (المثاليَّة) -في الحقيقة- انقرضَتْ بانقراضِ أصحابِها. وأصحابُها هم الذين عاشوا خلالَ الحِقبةِ الممتدَّةِ من عصرِ ما قبلَ الإسلام إلى نهاية القرن الثاني الهجري. هذا فيما يخصُّ أهلَ الحضَر. أمّا فيما يخصُّ أهلَ المدَرِ (أي البوادي) فتمتدُّ حِقبةُ فصاحتهم حتى القرنِ الرابعِ الهجري. (ينظر: الرواية والاستشهاد باللغة: 15, 34).
أي إنَّنا فقدنا هذه اللغةَ الراقيَّةَ منذُ حوالي أحدَ عشرَ قرنًا! وحلَّتْ محلَّها اللهجاتُ العاميَّةُ, و(العربيزيَّة)!
وهذه الحقيقةُ قد تُفضِي إلى العزوفِ عنها, والاستسلامِ للتحدُّثِ باللهجاتِ المحليَّة, وإحداثِ ألفاظٍ لا تمتُّ للغتِنا الفصيحةِ بأيِّ سببٍ, أو نسب. والأشدُّ نِكايةً من ذلك أن نركنَ إلى لغاتِ غيرِنا؛ كي نستجديَ منهم التحضُّرَ والرُّقي!
غير أنَّ ما يُبقِي ماءَ وجهِ لغتِنا عَذبًا, زُلالًا، هو أنَّ أسلافنا, من علماءِ اللغةِ, والأدبِ, لم ينسَونا, وإنَّما تركوا لنا إرثَهم اللغويَّ. ولكنَّه غيرُ مسموع, وإنما مكتوبٌ؛ لسبب بسيط, هو أنهم لمّا حُرِمُوا من وسائلِ الحفظِ الصوتيَّةِ والمرئيَّةِ التي أُتيحَت لنا, في هذا العصرِ المُفعَمِ بالوسائلِ! اضطُرُّوا إلى استعمالِ وسيلةٍ أدنَى منها. فلجأُوا إلى الكتابة.
ومع هذا أبقوا لنا ما يُحيِي في نفوسنا الأملَ في إعادة خلقِ هذه اللغة الشريفة, وبثِّ الروح فيها.
وهذا الأمرُ لن يتأتَّى, من وجهةِ نظري, إلَّا بخُطواتٍ عمليَّةٍ جريئة، يمكن حصرُها في الآتي:
أولًا– أن يوجَّهَ اهتمامُ الراغبِ في تعلُّمِ اللغةِ العربيةِ إلى الشروع في تعلُّمِها عن طريقِ سماعِها, من معلِّمٍ متقِنٍ لها, ثم محاكاتِه عن طريق الكلام, ثم اللجوءِ إلى قراءةِ نصوصٍ نموذجيَّةٍ, مما يزخرُ بها تراثُنا العربيّ, سواءً قرآنًا, أو حديثًا, أو شعرًا, أو نثرًا. ثم كتابتِها كتابة سليمة. (ينظر: النحو العربي ودوره في تدريس اللغة العربية وفهم نظامها: 19).
ثانيًا– أن تُذكَى ملَكَةُ الإبداعِ لدى متعلِّمِ هذه اللغة؛ عن طريقِ تنميةِ مَلَكةِ القياس لديه, أي أن يُنشِئَ كلامًا مُحدَثًا, لم يبلَغْ سمعَه, على ما اختزنَه في ذاكرتِه من كلامٍ مسموع, تحتَ إشرافِ معلِّمٍ, يضطلعُ بمهمة إصلاحِ ما قد يقع من المتعلِّم من أخطاءٍ معجميَّةٍ, أو نحويَّةٍ, أو صرفيَّةٍ, أو صوتيَّة.
ثالثًا– أن يُنمَّى مستوى الإبداعِ الكلامي لدى المتعلِّم؛ عن طريقِ توجيهِ المسؤولين, في مجالَي التربيةِ والتعليم, ووزارةِ التعليمِ العالي, إلى سنِّ قوانينَ تُلزِمُ تلاميذَ مدارسِ التعليم الأساسي, والثانوي, وطُلاَّبِ الجامعات, بنوعيها: الحكوميِّة, والأهليَّة – على ممارسةِ التكلُّمِ بلغةٍ عربيةٍ سهلة, داخلَ جدرانِ مقرَّاتِهم التعليميَّةِ (في أقلِّ تقديرٍ)؛ لكونِ مَلَكةِ الممارسةِ الواقعية للغة لا تنفكُّ عن تعلِّم قواعدِها. بل إنَّها تُقدَّم عليها. (ينظر: من قضايا اللغة التربوية: 29).
رابعًا– أن يُنمَّى مستوى الإبداعِ الكلامي, لدى المعلِّمِ؛ عن طريق إلزامِ القائمين على إدارة المرافقِ التعليمية, بنوعيها: التربويِّ, والجامعيِّ – جميعَ المعلِّمين بإلقاءِ دروسِهم لتلامذتِهم, وطُلاَّبِهم, بلغةٍ عربيَّةٍ فصيحةٍ سهلة, داخل جدرانِ مقرَّاتِهم التعليميَّة. وألَّا يُقصَرُ ذلك على مدرِّسِي مادةِ (اللغة العربية)؛ لِمَا في ذلك من إشعارِ مدرسِي المواد, والتخصُّصاتِ الأخرى أنَّهم مشترِكون في هذه المسؤوليَّةِ العظيمة. (ينظر: في قضايا اللغة التربوية: 29-30).
خامسًا– أن يُنمَّى مستوى المتعلِّم في قراءة النصوص العربيَّةِ وكتابتِها؛ من خلال تخصيصِ القائمين على العمليَّةِ التعليميَّة حِصَصًا, ومحاضراتٍ للقراءةِ الجهريَّـةِ, والكتــابةِ التعبيــريَّة, بنوعيهـــا: العلميِّ, والأدبِي. والاستعانــةِ, في ذلك, بنصوصٍ راقيةٍ من تراثنا العربي.
سادسًا– أن يُعنَى المختصُّون بوضع المناهجِ التعليميَّة, بضبط النصوصِ العربيَّةِ المكتوبةِ, ضبطًا صرفيًّا ونحويًّا, ووضعِ علاماتِ الترقيم في ثناياها, كلَّما دعَتِ الحاجةُ إليها؛ لكونِ تلك الحركاتِ والعلاماتِ إنَّما هي أصواتٌ ممثَّلةٌ في رموزٍ مكتوبة, ترشدُ المتعلِّمَ إلى الطريقة السليمةِ في قراءتِها, وتنغيمِها.
سابعًا– أن تسهمَ وسائلُ الإعلام المرئيةُ, والمسموعة, والمكتوبة, إسهامًا فاعلًا في خلق بيئة لغوية فصيحة؛ بحيث لا يسمع المستمع, ولا يشاهد المشاهد شيئًا من البرامج الإخبارية, أو العلمية, أو الترفيهية, إلَّا بلغة عربية فصيحة, تخلو تمامًا من الألفاظ العاميّة, المُنبتَّة عن أي أصل فصيح, أو الألفاظ الأعجميَّة الدخيلة على أصالة لغتنا الأم. وهذا لن يتأتَّى -من وجهة نظري- إلَّا إذا اضطلعتْ وزاراتُ الإعلام, في الدول العربيَّة عمومًا, وفي دولتنا خصوصًا, بمهماتها الإيجابيةِ الرئيسة, ومن أهمها سنُّ قوانين تُلزِم كلَّ من يتصدِّى للبروز في وسائل الإعلام كافة, أن يخضعَ لدورات مكثفة, في تنمية مهاراته القرائيةِ, والكتابية, والحواريَّة, في اللغة العربية, وحثِّه على ممارستِها, في كلِّ المحافلِ, والمناسباتِ, ولا سيَّما الرسميَّةُ منها. (ينظر: فصول في فقه العربية: 423).
من خلال عرضِ الإجراءات العلاجيَّةِ السابقة, التي تهدفُ إلى الرقيِّ بالمستوى اللغويِّ, لدى الشعوبِ العربيَّةِ, نجدُ أنَّ امتلاكَ ناصيةِ اللغةِ الفصيحةِ ينبغي أنْ يحصلَ بتضافرِ المَلَكاتِ اللغويَّةِ الأربع: السماعُ, والكلامُ, والقراءةُ, والكتابة. يُضافُ إليها تنميةُ ملكةِ الحِفظ لشيءٍ من المنظوم والمنثورِ, من كلام العرب الفُصَحاء, والبناءِ عليه, ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
أخيرًا أرجو أن أكونَ قد وُفِّقتُ لإجلاء ما ينبغي أن تكونَ عليه لغتُنا الشريفةُ, ووضعَها في الموضعِ الذي تليقُ به, بينَ اللغاتِ العالميَّةِ الحيَّة. وألَّا تكتفي الجهاتُ المعنيَّةُ بإقامةِ مثلِ هذه المؤتمراتِ, والندوات, بأرشفتِها, وحفظِها رهينةَ الأدراجِ, والأرفُفِ, وإنَّما تعملُ على تنفيذِها بكلِّ ما تملكُ من إمكاناتٍ, وطاقاتٍ, على مستوى المواقعِ التعليميَّةِ, والثقافيَّةِ, والإعلاميَّةِ, كافَّةً, إنْ أرادَت ذلك! وصدقَ الشاعرُ إذ يقول:
وما نيــــلُ المطالــــبِ بالتمَنِّـــــي ولكنْ تُؤخَـــذُ الدُّنيـــــا غِلابــــــا
قائمة الكتب والأبحاث المنشورة: