الصلات التجارية بين حضرموت والهند .. تاريخها – وأثرها في رفد الهجرة المتبادلة منذ العصور التاريخية القديمة حتى عصر السيادة الإسلامية .. (2 – 3)
دراسات
أ.د. محمد بن هاوي باوزير
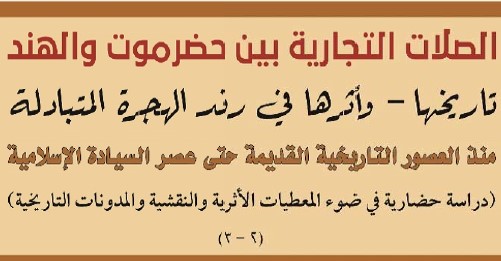
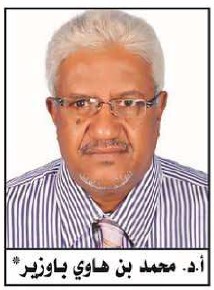
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 9 .. ص 54
رابط العدد 9 : اضغط هنا
في عصر السيادة الإسلامية حتى مطلع العصر الحديث
1- العرب والحضارمة.. ودورهم في انتشار الإسلام في الهند:
كانت الاتصالات بين العرب قبيل الإسلام (العصر الجاهلي) والهنود مستمرة كعادتها، وفي هذه الحقبة التي نتحدث عنها انتشرت في بلاد العرب طائفة من الهنود، عُرفت باسم (الزط)([1]). فقد اشتهر هؤلاء القوم بالحرب والبطولة، وكانوا يقطنون من قبل في جبال السند وبلوجستان.. وقد أكدت بعض الأحاديث النبوية عن وجود قوم الزط في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومزاولة بعضهم مهنة الطب، وقد دخل كثير منهم في جيش المسلمين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلموا وحَسُنَ إسلامهم، وبهذا اشتهروا في بلاد العرب، ونالوا منزلة كبيرة([2]).
إذن فالهنود المعروفون بـ(قوم الزط) كانوا أول طائفة هندية لها شرف السبق للتعرف على الإسلام، واعتناقه قبل دخول الفتح الإسلامي للهند، بل يبدو أنهم كانوا مشاركين مع طلائع المسلمين، الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية في قارة آسيا. وفي صدر الإسلام بدأت الفتوحات الإسلامية تتجه صوب الهند عبر البحر، ويبدو أن البداية كانت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.. وعلى الرغم من هذه العناية، التي وجهت إلى الهند فلم يأت دور فتحها الفعلي إلا في عصر الوليد بن عبدالملك، وبأمر حاكمه على العراق وهو الحجاج بن يوسف، الذي أسند هذه المهمة إلى محمد بن القاسم، أعظم فاتح وقائد في تاريخ الفتوحات الإسلامية، وقد بدأ ذلك في عام 93هـ ففتح بلدانًا كثيرة في ولاية السند، وأرسى فيها قواعد دولة إسلامية عربية، ظلت تنمو وتزدهر قرونًا طويلة.. وهكذا توالت الفتوحات الإسلامية حتى انتشر الإسلام في أجزاء واسعة من شبة القارة الهندية. وقد كان لعرب الجزيرة العربية وخاصة التجار والمهاجرين الحضارمة دور كبير في نشر الإسلام، وإرساء دعائمه في بلاد الهند([3]).
لقد وصل الإسلام إلى قارة آسيا وبلدانها المعروفة، مثل: الهند، والسند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا.. وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، وقد حدث ذلك عبر مجموعة من العوامل، أهمها: النشاط التجاري – للتجار العرب ومنهم الحضارمة، وغيرهم، وعن طريق الفتوحات الإسلامية، وكذا عن طريق الرحالة والدعاة، وعن طريق العلاقات الاجتماعية بالأهالي، وأيضًا المدارس والمعاهد الإسلامية، التي فتحها المسلمون العرب، ومنهم الحضارمة كان لها دور كبير في انتشار الإسلام في أنحاء آسيا.. وغيرها من العوامل.
أما عن تأثير العقلية الإسلامية والشريعة الإسلامية في أهل الهند بعد الفتح الإسلامي، فقد كان واضحًا وملموسًا في الاتجاه إلى التوحيد، ونزعات الاحترام للمرأة وحقوقها، والاعتراف بمبدأ المساواة بين طبقات البشر، إلى غير ذلك مما سبق إليه الإسلام، وامتازت به شريعته ومدنيته. وبهذا الصدد يقول الباحث الهندي (K. M Panikkar) سفير الهند في مصر سابقًا، وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية في عقلية الشعب الهندي ودياناته: “من الواضح المقرر أن تأثير الإسلام في الديانة الهندوكية كان عميقًا في هذا العهد (الإسلامي)، إن فكرة عبادة الله في الهنادك مدينة للإسلام، إن قادة الفكر والدين في هذا العصر -وإن سموا آلهتهم بأسماء شتى- قد دعوا إلى عبادة الله، وصرحوا بأن الإله واحد، وهو يستحق العبادة، ومنه تطلب النجاة والسعادة، وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات، التي ظهرت في الهند في العهد الإسلامي، كديانة (Bhagti)، ودعوة (كبير)”([4]).
ويقول رئيس وزراء الهند (سابقًا) جواهر لال نهرو في كتابه (Discovery of India): “إن دخول الغزاة الذين جاءوا من شمال غرب الهند قد انتشروا في المجتمع الهندوكي، إنه قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ، وحب الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش فيه الهند، إن نظرية الأخوة الإسلامية، والمساواة، التي كان المسلمون يؤمنون بها، ويعيشون فيها أثرت في أذهان الهندوس تأثيرًا عميقًا، وكان أكثر خضوعًا لهذا التأثير البؤساء، الذين حرم عليهم المجتمع الهندي المساواة، والتمتع بالحقوق الإنسانية”. ويقول كاتب عصري وهو (N. C. Mehta) في كتابه (الحضارة الهندية والإسلام) (Indian Civilization and Islam): “إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلًا من نور، قد انجلت به الظلمات، التي كانت تغشى الحياة الإنسانية، في عصر ماتت فيه المدنيات القديمة إلى الانحطاط والتدلي، وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية؛ لقد كانت فتوح الإسلام في عالم الأفكار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة، شأنه في الأقطار الأخرى، لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام في هذا القطر (الهندي) مرتبطًا بالحكومة، فبقيت حقيقة الإسلام في حجاب، وبقيت هباته وأياديه الجميلة مختفية عن الأنظار”. ولا يستطيع دين من الأديان، ومدنية من المدنيات تعيش في العالم المتمدن المعمور أن تدعي أنها لم تتأثر بالإسلام والمسلمين في قليل ولا كثير([5]).
2- الصلات القديمة بين حضرموت والهند.. أساسًا ورافدًا للهجرات المتبادلة في العصرين الوسيط والحديث:
عُرفت العربية الجنوبية، وخاصة مملكة حضرموت القديمة، وعبر تاريخها الطويل بأن أهلها من أنشط شعوب العالم في النشاط التجاري، وقد ساعدهم على هذا التفوق في هذا المجال، الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم لبلادهم، فكان له عظيم الأثر على المستوى العالمي، فهي تتوسط ثلاث قارات، كانت مهد الحضارة منذ القدم، وهي: آسيا، وأفريقيا، وأوربا، وهي بذلك همزة وصل بين حضارات الهند وجنوب شرق آسيا وشرقي أفريقيا، وحضارات البحر المتوسط، ووادي النيل، وبلاد الرافدين، ولهذا احتلت العربية الجنوبية موقعًا جغرافيًا ممتازًا على طريق الملاحة العالمية منذ أقدم العصور([6]).
وإذا كان البحر الأحمر لتقارب شاطئيه قد شكّل ممرًا سهلًا لعرب الجنوب الساكنين عليه إلى بلاد أفريقيا، فإن شواطئ بلاد العرب الجنوبية المطلة على خليج عدن وحوض المحيط الهندي، كانت هي أيضًا منطلقًا وطريقًا إلى بلدان السواحل الهندية وما يليها شرقًا([7])؛ حيث كان للبحر العربي المتصل بالمحيط الهندي أثر متميز عبر التاريخ؛ إذ أسهم بربط عرب الجنوب، وبخاصة الحضارمة بالهند وشرق آسيا. إذن لم تكن مياه المحيط الهندي منذ القدم مياهًا مجهولة، مثل الأطلسي (بحر الظلمات)، أو الهادي، بل كان طريقًا للبحارة منذ آلاف السنين، ولهذا لعب المحيط الهندي دورًا كبيرًا في عملية التواصل الحضاري، وكانت التجارة أبرز مظاهر النشاط في المحيط الهندي، بل يبدو أن هذا النشاط (التجاري) هو المظهر الوحيد، الذي نقل المظاهر الدينية، والثقافية، والحضارية، فضلًا عن الهجرات([8]).
ويبدو أن عرب الجنوب وخاصة الحضارمة (أهل مملكة حضرموت القديمة) كانوا أول من احتكر تجارة الشرق (الهند وسيلان)، وتجارة شرقي أفريقيا، وقد ارتبطت الموانئ الحضرمية القديمة، كمينائي قنا وسمهرم بعلاقة تجارية مع الموانئ الهندية، وأقدم إشارة للطريق البحري الذي يربط الموانئ الحضرمية بالموانئ الهندية وردت في المصادر الكلاسيكية، التي تعود إلى القرن الأول الميلادي، ويزكي ذلك القول (بليني) في كتابه (التاريخ الطبيعي)، عندما ذكر ميناء قنأ كأحد المحطات التجارية البحرية بين مصر والهند، كذلك أشار إلى أن عرب الجنوب قد استقروا في سيلان منذ القرن الأول الميلادي([9]).
ولعل أبرز تلك المصادر الكلاسيكية هو كتاب الطواف (دليل البحر الأرتيري)، فقد ذكر ميناء قنا وسمهرم، وسقطرى، وعلاقاتها التجارية مع الموانئ الهندية، كما أشار مؤلف الكتاب إلى أن عرب الجنوب كانوا موجودين بكثرة في ساحل مالابار الهندي، وفي سيلان، وهو الأمر الذي جعلهم أسياد الساحل، والمحتكرين الأساسيين للتجارة الشرقية([10])، ولعل الشواهد كثيرة عن الصلات والعلاقات بين حضرموت والهند. ومن الجدير ذكره أيضًا أن عرب الجنوب من حضارمة وعمانيين وغيرهم لم تقتصر تجارتهم البحرية على الهند فحسب، بل تعدت تجارتهم إلى القرن الأفريقي وساحل أفريقيا الشرقي، وجزر الملايو، وإندونيسيا وصولًا إلى السواحل الصينية، وكانت لهم جاليات فيها، وصلات قوية بأهل تلك البلاد([11]).
غير أن الاضمحلال قد أصاب عرب الجنوب والحضارمة عامةً منذ القرن الرابع الميلادي بسبب الاضطرابات الداخلية، والتدخل الخارجي -البيزنطي والحبشي-، ومناوشة عرب الجنوب في بلادهم لحقبة طويلة من الزمن بقصد السيطرة على مدخل البحر الأحمر في باب المندب، حتى انتهى الأمر بنجاح الأحباش في أن يحلوا محل عرب الجنوب والحضارمة عامة في نقل تجارة الهند لمدة من الزمن؛ بل انتقلت لاحقًا تلك السيطرة الى الفرس بعد نجاحهم في طرد الحبشة من بلاد العرب الجنوبية في نهاية القرن السادس الميلادي، وأقاموا حكمهم فيها حتى بزوغ فجر الإسلام([12]).
ولكن بعد مدة من ذلك الركود والاضمحلال، ومع ظهور الإسلام، واستجابة لتعاليم الإسلام في طلب العلم، واستقصاء أخبار وأحوال الأقطار والأمم، وتشجيعه للأسفار، ومعرفته أخبار البحار، نهض الحضارمة، ومعهم من جنوب الجزيرة العربية إخوانهم العمانيون وغيرهم من العرب، واستعادوا لذلك النشاط التجاري البحري حيويته، ومكانته السابقة، حتى وصل قمة الرقي والازدهار. ففي عصر السيادة الإسلامية (العصور الوسطى)، وبعد أن أسلم أهل اليمن وحضرموت نجد أن تجارتهم قد وصلت حينذاك إلى قمه ازدهارها، وكانوا يصدرون البضائع إلى الخليج العربي، ومصر، والسند، ومالابار، وسيلان، وجاوا، والصين وغيرها من البلدان النائية. وفي كل بلد نزلوا فيه قاموا بالدعوة إلى الإسلام، ونشروا تعاليمه بطريقة سليمة وودية، وبهذه الطريقة وصل صوت الإسلام إلى الهند وسيلان عقب انبثاق فجره من جزيرة العرب…([13]).
وقد لعبت الموانئ الحضرمية دورًا كبيرًا في ذلك النشاط التجاري البحري في عصري: السيادة الإسلامية (الوسيط)، والحديث، والموانئ هي: الشحر، والمكلا، والحامي. من المرجّح أن التخلي عن قنا قد جرى في بداية القرن السابع الميلادي، أو ربما قبل ذلك بقليل تقريبًا إثر انقلابات سياسية ودينية، كانت تؤثر آنئذ على مجموع حياة الجزيرة العربية، مؤدية إلى تغييرات في العلاقات والشبكات التجارية. ومع دخول الإسلام انهارت عدة منشآت قبل الإسلام، في حين ظهرت منشآت أخرى وازدهرت، واستبدلت تلك القديمة بمنشآت جديدة، كمينائي الشحر والحامي وبعدهما المكلا([14]). وهكذا تميز الشريط الساحلي الحضرمي بوجود عدد من الموانئ التجارية المهمة، ولا شك أن أقدمها ميناء قنا الميناء الرئيس لمملكة حضرموت القديمة، أما الموانئ الأخرى فمنها:
ميناء الشحر:
وهو ساحل حضرموت الممتد بينها وبين عُمان، وكانت الشحر تطلق على جميع سواحل حضرموت، وأرض المهرة، وعُمان([15]). وكان ميناء الشحر ميناء رئيسًا على خطوط التجارة العالمية، وهذا الميناء أصبح لاحقًا اسمًا للمدينة، بل أضفى على المدينة هذه الأهمية([16])، وهكذا كانت الشحر تتمتع بأهمية كبيرة؛ حيث كانت تقوم بدور التبادل التجاري بين الهند، والخليج العربي، ومصر، ومشرق أفريقيا، وكانت مثل ميناء (ترانزيت) إلى ومن أقطار خارجية عديدة، في مقدمتها الهند وشرق أفريقيا وجنوبها، وازدهرت فيها تجارة اللبان، حتى أن البعض كان يطلق عليها أرض اللبان، وحتى أن البعض كان يطلق عليها أرض اللبان، ينسب إليها (اللبان الشحري)، وبهذا الصدد يقال عن الشحر([17]):
| اذهب إلى الشحر ودع عمانا | إن لم تجد تمرًا تجد لبانا |
وإلى جانب تجارتهم في اللبان وسلع أخرى، ازدهرت أيضًا في ميناء الشحر تجارة الدقيق، بل كانت من أهم وارداتها([18])، وهكذا ظلت الشحر ولحقبة طويلة (قديمًا، ووسيطًا، وحديثًا) حاضرة حضرموت، ومركزها التجاري على العالم الخارجي، تستقبل العديد من السفن والمراكب القادمة من مناطق عديدة من أفريقيا، والهند، والشرق الأقصى، وعدن والخليج العربي([19]).ولاحقًا ضعفت أهمية ميناء الشحر في النشاط التجاري الحضرمي وحل محلاها ميناء المكلا، فأصبحت المكلا حاضرة السلطنة القعيطية وميناءها الرئيس، بل ملتقى لطرق التجارة البحرية القادمة من سواحل شرق أفريقيا وعدن من جهة، وسواحل الخليج العربي والهند وشرق آسيا من جهة أخرى([20]).
ميناء بروم:
تقع بروم غربي مدينة المكلا بنحو 25 كلم، وميناؤها موغل في القدم، فقد جاء ذكره في خريطة الرحالة اليوناني بطليموس، التي وضعها في أجواء سنة 140م كميناء تجاري تؤمه السفن عابرة المحيط الهندي. لذلك كانت بروم من الموانئ ذات الأهمية في ملاحة حضرموت منذ القدم؛ حيث جاء ذكرها في سجلات الملاحين العرب وخاصة الحضارمة والخليجيين بأنها ميناء أزيب (مكان حفظ السفن عند اشتداد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعروفة عند الملاحيين بـ(الزيّب)، أي مكان صون وحفظ السفن، ومكان السقيا والتزود بالماء).
وقد اشتهرت مدينة بروم بأنها محضن للسفن الشراعية، وهي المرسى الآمن لها حتى يوم الناس هذا؛ لحفظها من الزوابع البحرية والرياح التي تهب على البحر العربي في فصل الصيف أو الخريف كما يسميه الحضارم([21]).
ميناء الحامي:
تقع مدينة الحامي وميناؤها إلى الشرق من الشحر، اشتهرت بأنها مصنع للملاحين الماهرين أكثر منها ميناء تجاري، وقد لعب ملاحو الحامي دورًا كبيرًا في الملاحة البحرية منذ فجر التاريخ، فهم الذين يسَيرون الخط التجاري القديم بين الشحر، والهند، والخليج، وشرق أفريقيا وجنوبها، ولقد عُرف أهل الحامي بروح المغامرة البحرية، واشتهروا في حضرموت بأنهم ذوو الحرف الأربع، أي أن ابن الحامي ملاح بحري، وصائد سمك، وفلاح، وتاجر صغير، غير أنهم اشتهروا بالملاحة، وقد أنجبت الحامي مشاهير الملاحين أو الربابنة الحضارم ومنهم:
الربان سعيد بن سالم باطايع المتوفى سنة 1273هـ/ 1856م، والملاح عوض بن أحمد بن عروة المتوفى عام 1333هـ/ 1915م، والملاح محمد عوض عيديد المتوفى 1358هـ/ 1938م، والملاح محمد بن عبدالله بن سالم باعباد (1304هـ/ 1891م- 1401هـ/ 1981م)، والملاح عمر عبيد باصالح المتوفى (1361هـ/ 1942م)([22])،وحفيده الملاح أحمد عوض باصالح، المتوفى في عدن عن (حوالي 95 عامًا). وفي مدح ملاحي الحامي قال الشاعر الشعبي سالمين بن مسلم الشحري (ت 1194هـ)([23]):
| بن مسلّم قال بالناظور خايل ساعية | نتّخت من زنجبار | |
| وسطها شبّان ذي ما يحسبون التالية | يطعمون الحلو قار |
وخلاصة القول إن النشاط التجاري الملاحي بين حضرموت والهند، له تأثيرات كبيرة على الجانبين، فقد تمخّض عنه إقامة الجاليات الحضرمية في الهند والجاليات الهندية في حضرموت، لإدارة أنشطتهم التجارية، بل يبدو أن ذلك كان أساسًا ورافدًا لهجرات الطرفين. وعلى هذا الأساس حدث الاستيطان، ففي المدن – الموانئ الحضرمية استوطن الكثير من الهنود، وحدث الاختلاط والتزاوج بينهم، والتأثير والتأثر في جوانب عديدة من حياتهم.
الهوامش:
([1]) الزط: اشتركت طائفة من الزط في الغزوات الإسلامية. ولما فتح المسلمون خراسان كان هؤلاء في الجيش الإسلامي. وقد دخلوا السياسة لأول مرة في عهد الحجاج بن يوسف؛ لأن الحجاج أرسل محمد بن هارون إلى مكران ليقوم بمهمة إدارة شئون الهند والسند ويؤدب العابثين في تلك المنطقة ويعيد إلى البلاد الأمن والاستقرار. فحارب محمد بن هارون القراصنة واستولى على مكران. وكان محمد بن هارون هذا ينحدر من سلالة الزط. محمد الندوي: تاريخ الصلات، مرجع سابق، ص36؛ نقلًا عن: القاضي أطهر المباركبوري: رجال الهند والسند، ص90، 138، 189، 272.
([2]) محمد الندوي: تاريخ الصلات، ص36– 37.
([3]) محمد الندوي: تاريخ الصلات، ص37– 39؛ وانظر، جوزيف شاخت وبوزورث: تراث الإسلام، ج1، ترجمة: حسين مؤنس، ج1، ط3، عالم المعرفة، العدد (233)، الكويت، مايو 1998م، ص180– 181.
([4]) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ط8، دار الكتاب العربي، بيروت، 1984م، ص126– 127.
([5]) ولمعرفة المزيد عن تلك الآراء انظر، أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم، ص120– 128؛ ومحمد الأشقر: تجارة التوابل في مصر في العصر المملوكي، القاهرة، 1999م، ص375- 382.
([6]) أسمهان الجرو: موجز التاريخ السياسي – اليمن القديم، ط1، إربد، الأردن، 1996م، ص5؛ وأحمد بن بريك: اليمن والتنافس الدولي على البحر الأحمر، ط1، دار الثقافة، الشارقة، ودار جامعة عدن، عدن، 2001م، ص7.
([7]) عبدالرحمن الملاحي: الحضارم في ممباسه ودار السلام، ط1، دار حضرموت، المكلا، 2004م، ص6– 7.
([8]) شوقي عبدالقوي: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، مرجع سابق، ص7.
([9]) أسمهان الجرو: طرق التجارة البرية والبحرية في اليمن القديم، مجلة العلوم الإنسانية (م2)، (ع3)، جامعة عدن، 1999م، ص29. والعواضي والأدهم، بلاد اليمن في المصادر الكلاسيكية، مرجع سابق، ص43- 46.
([10]) أسمهان الجرو: طرق التجارة، مرجع سابق، ص29؛ وانظر:
Schoff, The Periplus of the Erythaen Sea, ch. 27-32.
([11]) وللإفادة الوافية انظر، أكوبيان وآخرون: التقنيات الأثرية في ميناء قنا القديم، ص42– 48؛ وأسمهان الجرو: الموانئ العمانية، ص172– 175.
([12]) أنور عبدالعليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب، مرجع سابق، ص18– 20.
([13]) حسن صالح شهاب: أضواء على تاريخ اليمن البحري، ط2، دار العودة، بيروت، 1981م، ص183، ولمعرفة المزيد عن سيل الهجرة الحضرمية إلى الهند منذ القرن 7هـ وقبله واستقرارهم في الهند ودورهم في الدعوة الإسلامية، وإمساكهم بزمام الزعامة العلمية والدينية، ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية، واشتراكهم في الجيش الهندي – حيدر أباد… انظر: محمد أحمد الشاطري: دراسة شاملة عن الهجرة الحضرمية، قدمت لمؤتمر المغتربين بعدن 1970م ص1– 5.
([14]) ألكسندر سيدوف: قنا ميناء كبير بين الهند والبحر المتوسط، مرجع سابق، ص196.
([15]) ثابت اليزيدي: الدولة الكثيرية الثانية في حضرموت، ط1، الشارقة، 2002م، ص43.
([16]) وللإفادة الوافية عن الشحر وتسميتها بالشحر وموقعها.. انظر، خميس باحمدان: الشحر عبر التاريخ، صنعاء، 2005م، ص15 وما بعدها.
([17]) محمد عبدالقادر بامطرف: الشهداء السبعة، ط2، دار الهمداني، عدن، 1983م، ص21– 23.
([18]) محمد عبد الكريم عكاشة: قيام السلطنة القعيطية والتغلغل الاستعماري في حضرموت (1839– 1918م)، ط1، دار ابن رشد، عمان، 1985م، ص14؛ ونقلًا عن: Wellested , J. R , Travels in Aralia , Vol. 12(1837) P. 434 – 501.
([19]) للإفادة الوافية حول الشحر ودورها في النشاط التجاري أنظر: ثابت اليزيدي: الدولة الكثيرية، ص43– 46؛ وبامطرف: الشهداء السبعة، ص21– 26؛ ويحيى محمد غالب: الهجرات اليمنية الحضرمية إلى إندونيسيا، ط1، تريم حضرموت، 2008م، ص44- 47.
([20]) عبدالله الجعيدي: الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت، ط1، الشارقة، 2001م، ص103؛ وعكاشه: قيام السلطنة القعيطية، ص14، 225؛ وثابت اليزيدي: الدولة الكثيرية، ص48- 49.
([21]) لمزيد من المعلومات عن هذا الميناء انظر، محمد علوي باهارون: ميناء بروم.. تاريخ ملاحي عريق لمرسى آمن، مجلة (شعاع الأمل)، العدد (117)، حضرموت – المكلا، يناير 2012م، ص24- 25.
([22]) الجعيدي: الأوضاع الاجتماعية…، ص105– 106؛ أحمد محمد باعباد: الرحلات البحرية لملاحي حضرموت، ط1، دار الحامي، حضرموت، 2010م، ص5– 8؛ وبامطرف: الشهداء السبعة، ص50– 52.
([23]) بامطرف: الشهداء السبعة، ص52. ولمعرفة المزيد انظر، محمد باهارون: الحامي.. ملاحوها أشهر من نار على علم، ص23– 25.