ثنائية الأنا والآخر في قصيدة (يلوموني) من ديوان (اسكني بس يا جراح) للشاعر عمر أبوبكر العيدروس
نقد
د. ماهر بن دهري
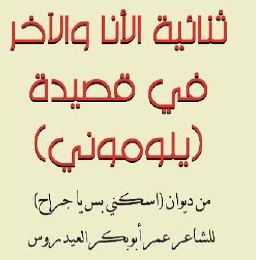

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 9 .. ص 99
رابط العدد 9 : اضغط هنا
قصيدة (يلوموني) هي القصيدة الرابعة من ديوان (اسكني بس يا جراح) إذ سبقتها القصائد (فهمك لمعنى الحب خاطي)، و(لا خصّك المولى بشي)، و(تَرْك الوفاء في الحب شي غير معقول).
نص القصيدة:
| تحدانا وفارقنا | وريته ضبّط الآخر حفظ أسرارَنا | |
| ولكن راح يتجـنَّى | يقُلْ([1]) للناس لا حبُّهْ ولا شي بيننا |
ولا قلبي هواه
يلوموني يلوموني وهم بالوصل أغروني وشبكوني معاه
***
| نَسيْ أيّامَ ما كُنّا | مِنِ اكؤوسِ المحبَّه نَحتسي خمْرَ الهنا | |
| وطيـر الشّوق ثالثنا | يُناجي خدّه الوَردي ويمرحْ فوقنا |
نسي ماضي قضاهْ
يلوموني يلوموني وهم بالوصل أغروني وشبكوني معاه
***
| سَلوا عنّا رُبَى الغنّا | وحيطان الطّويلهْ كم ثَراها ضَمّنا | |
| وكم بِتنا بها نهنا | وبالقُبلات ع الخدّين نرسم حبّنا |
وكم قلبي احتواه
يلوموني يلوموني وهم بالوصل أغروني وشبكوني معاه
***
| كأنّا ما تعارفنا | إذا مَرَّهْ جَزَعْ([2]) جنْـبي تجاهَلْ من أنا | |
| ونا لوْلاي ما تْغـنَّى | بحُبّه بُلبُل الوادي ولَصدحْ([3]) بالغنا |
ولا رفرفْ لِواه
يلوموني يلوموني وهم بالوصل أغروني وشبكوني معاه
***
| بِظـنّي إنّه استغنَى | وإلّا كيف يخرب عَتمَ جاري بيننا | |
| ويجني وسْط كُلْ مجنَى | وَنا مِنْ سَمْحَ عوَّدْتُه على مَجناي نا |
ولم أعشقْ سِواه
يلوموني يلوموني وهم بالوصل أغروني وشبكوني معاه
إن قراءةً متأملةً للنَّصِّ تكشفُ عن حالةٍ من الهجرِ والبُعدِ من الآخَرِ عن الأنا، في مُقابلِ نظرةٍ متلهّفةٍ لحالةٍ من الوصال، منطلقة من تصوّرِ الذّاتِ المتكلمةِ في النَّصِّ لمعنى الحبِّ، وكيفَ ينبغي أنْ يكونَ، وهو أمرٌ يُمكنُ تلمّسُه من خلالِ تأمّلِ المُنتَج الدّلاليِّ للأبيات.
فالبيتُ الأوّلُ يكشفُ عن علاقةِ هجرٍ وقطيعةٍ، تنشأ بين الذَّاتِ المتكلمةِ والآخرِ، الذي أشارتْ إليه الذّاتُ المتكلّمةُ بضمير الغياب، وهو ما يتناسَبُ مع حالةِ الانقطاع والهجر، وهذا الانقطاعُ أو الهجرُ نشأ بعدَ مرحلةِ حُبٍّ لم تكتملْ، أو هكذا تصوّرته الذاتُ المتكلمةُ، التي كانتْ حريصةً على الوصالِ وترغبُ في اللقاء بالمحبوب، لكنَّ ذلك لم يتحقق، بلْ إنَّ المحبوبَ تعامَلَ بشيءٍ من الجفاءِ والاستعلاءِ يَدُلُّك على ذلك قولُه: (تحدّانا وفارقنا)، ومع أن هذا قد حَصَلَ فإنَّ الذاتَ المتكلمةَ قد زادَ من جراحِها سوءُ تصرُّفاتِ ذلكَ المحبوبِ، فما (ضبّط الآخر)، ولا (حفظ الأسرار)، بل (راح يتجنى) منكرًا أيَّ علاقةٍ جمعتْ بينهما (يقول للنّاس لا حبُّه ولا شي بيننا)، و(لا قلبي هواه)، مما استثارَ غضبَ الذاتِ المتكلمةِ التي رَاحتْ تذكِّرُه بأيّامٍ، كانت كأسُ الوصالِ دائرةً بينهما (نسي أيام ما كنا مِنِ اكؤوس المحبة نحتسي خمر الهنا)، ولقد تبدّلتْ مُعاملةُ المحبوبِ للذّاتِ المُتكلِّمةِ تبدُّلًا جَعلهُ يَشعُرُ بالخيبةِ الكبيرة (كأنا ما تعارفنا)، واشتطّ المحبوبُ في قسوَتِهِ حتَّى أنّه (إذا مرّه جزع جنبي تجاهل من أنا)، وهنا تشعُرُ الذّاتُ المُتكلّمةُ بمرارةِ قسوةِ المُعاملةِ، فتعلِنُ حضورَها، ودورَها، وما أحدَثَهُ وجودُهُ من أثرٍ في التعريفِ بهذا المحبوبِ (ونا لولاي ما تغنّى بحبّه بلبل الوادي ولا صدح بالغنا)، ثم تصرّحُ الذّاتُ المُتكلمةُ بما وصلتْ إليه من قناعةٍ تبرِّرُ بها سلوكَ هذا المحبوب (بظنِّي إنّه استغنى وإلا كيف يخرب عتم جاري بيننا).
هُنا تتَرَاءَى الذاتُ الغائبةُ (الآخر) طاغية الحُضورِ من خلالِ الضمائرِ الظّاهرةِ والمقدّرةِ التي بلغتْ أربعةً وستين ضميرًا، منها ثلاثةٌ وأربعون ضميرًا ظاهرًا، وواحدٌ وعشرون ضميرًا مقدرًا، في حين بلغت ضمائر المتكلم ستة وأربعين ضميرًا، ثلاثة وأربعون ضميرًا ظاهرًا، وثلاثة ضمائر مقدرة، وهذا يعكس حرصًا إثبات الذات المتكلمة لحضورها، فتساوت في الحضور مع الغائب، لكنها حينما غيّبت الآخر وقدّرته في واحد وعشرين مرة لم تُغيّب نفسها إلا في ثلاثة مواضع، موضعين فيها مشتركة مع الآخر (نحتسي – نرسم)، ومرة واحدة يعود على الذات المتكلمة (ولم أعشق سواه).
ويتحوَّلُ (الأنا) إلى موضوعٍ للتَّدميرِ أو التَّعميرِ بحسبِ أفعالِ الآخَرِ عليه، بالإضافةِ إلى تدفُّقِ انفعال المُتكلّمِ والحالة الشُّعورية، وفي هذا الخطابِ تبدو علاقةٌ قائمةٌ بطريقةٍ غيرِ مُباشرَةٍ بين (مُتكلّم) و(غائب)، لا يُسمَحُ بظهور صوتِهِ، ولا تفنيدِ ما يقولُهُ المُتكلّم، وفي هذا ما يُظهِرُ صِراعًا حادًا بين الأنا (المتكلم)، والآخر (الغائب)، فقد كشفت الأبيات قوّةَ الصراعِ بين الآخر والمتكلم، وبدت العلاقةُ بينهما في صُوَرٍ مُختلِفةٍ، كانَ أبرزها أنَّ الآخَرَ فاعلٌ ومؤثِّرٌ في المُتكلم، وقد جَلَتْ مجموعةٌ من الأفعالِ طبيعة علاقة الآخر بالذات، فالآخر (متحدٍّ، مفارقٌ، يبوحُ بالأسرار [غير كتوم]، متجنٍّ، منكرٌ للحب، متجاهلٌ، ناسٍ ما كان بينهما، مستغنٍ عنها، مُخرّبٌ، غير مخلص للذات المتكلمة [ يجني وسط كل مجنى]).
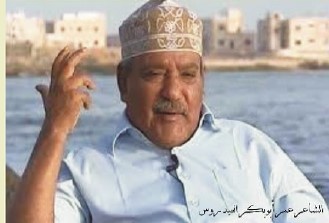
أما الأنا المُتكلّمة فقد ظهرتْ في موقع المفعولية يقعُ عليها الفعلُ، فهي تُتحدَّى، تُفارق، وتُلام، وتُغرى، وتُشبك، وتُضَمُّ (تحدانا، فارقنا، يلوموني، أغروني، شبكوني، ضمنا)، وحتى في اللحظة التي تسنّى لها أن تكون فاعلًا -حين اجتمعت بالمحبوب وطير الشوق ثالثهما- فإنها آثرت عدم القيام بشيء، بل تركت المجال لطير الشوق أن يناجي خدَّ المحبوب الوردي، واكتفت بأن تكون مادة للفرح (وطير الشوق ثالثنا يناجي خذه الوردي ويمرح بيننا). وعلى الرّغم من هذا كلّه فقد حاولتْ الأنا المتكلمةُ الظهورَ بصورةِ الفاعلِ في نمطين: أحدُهما مشتركة مع الآخر، حين رسمَتْ مع المحبوب حبَّهما (وكم بِتْنا بها نهنا وبالقبلات ع الخدين نرسم حبنا، كأنّا ما تعارفنا)، والموضِعُ الآخَرُ حين كانَ حبلُ الودِّ متّصِلًا، وكانت له في قلبِ المحبوبِ مكانةٌ يُستَمَعُ له فيها (ونا من سَمْحَ عوَّدته على مجناي نا، ولم أعشق سواه). هذا بالإضافةِ إلى أنَّ الذّاتَ المتكلمةَ حين استشعرتْ تجاهُلَ الآخر (المحبوب) لها حاولت الانتصار لنفسِها، وقد برز ذلك من خلال تكرار (أنا) أربع مرات، في إحداها ادَّعتْ أنها هي السبب في شُهْرة الآخر (ونا لولاي ما تغنى بحبه بلبل الوادي ولا صدح بالغنا).
أما الموضوعُ الشعريُّ الذي يعالجُه النصُّ فيتمحور حول معاملة المحبوب للذات المتكلمة، هذه المعاملة النّاجمة عن فهمٍ للحبِّ تراه الذات المتكلمة مغلوطًا؛ لذلك وجدناها عنونت للقصيدة الأولى في الديوان بـ(فهمك لمعنى الحب خاطي)، والتي تكشف عن جدالٍ دارَ بينها وبين المحبوب، تمسّك المحبوب بفهمه الخاص للحب، وعدم الاستماع للذات المتكلمة؛ لذلك تصرح الذات المتكلمة (ما طعت تفهمنا)، ويبدو أن هذه العلاقة ظلت متأرجحة متأزمة، يغلب عليها الصدود من جهة المحبوب، في حين تسعى الذات المتكلمة للقاء وتطلبه (عوّد لنا لحظات عشناها مع الأنغام وأغصان تتمايل)، وقد عانت الذاتُ المتكلمةُ من هذا الصُّدودِ ما جعلها تصرّح:
حبك أحرم عيوني لذة النوم من كثرة أشواقي بيّت تقهّد
فكان الرد من المحبوب صادمًا، وهو ما افتتحت به الذات الشاعرة هذا النص (تحدانا وفارقنا)، لكنه لا يقطع بذلك، بل يجعل الشك مكان اليقين (بظني إنه استغنى)، فما زالت الذات الشاعرة راغبة في الوصال طامعة في اللقاء.
فالنَّصُّ يظهر صراعًا بين طرفين هما: الذات المتكلمة التي تتبنى التعمير، وبين الآخر الذي يتمسك بالتّدمير، يرغب الأول بالاتصال والاجتماع بالآخر، بينما يتمنّع الثاني عن الاستجابة لهذه الرغبة، ومن هنا رصد النّصُّ الآلامَ التي تعانيها الذّاتُ المتكلمةُ من خلال الصراع الداخلي في أعماق الذات، وتذكرها لما فات، وحنينها على لحظات استشعرت فيها دفء المشاعر، ولذة المناجاة.
ولأن النص لا ينشأ في فراغ، إنه يتوالد في مجتمع نصوصي، أو هو تفاعل الكلام مع الكلام، و”لولا أن الكلام يُعاد لنفد”، ولمّا كانت الكتابة نتاجًا لعدد كبير من النُّصوص المختزنة في الذاكرة القرائية، وكل نص هو حتمًا نص متناص، ولا وجود لنص ليس متداخلًا مع نصوص أخرى، أو لا وجود لكلمة عذراء لا يسكنها صوت الآخر، أو بتعبير كرسيتيفا “كل نص هو امتصاص وتحويل لكثير من نصوص أخرى”؛ لذا فالنص الجديد تشكيل من نصوص سابقة أو معاصرة وردت في الذاكرة الشعرية تشكيلًا وظيفيًا، فيغدو النَّصُّ الرّاهنُ خلاصةً لعدد من النصوص التي امَّحتِ الحدودُ بينها، وكأنها مصهور من المعادن المختلفة المتنوعة يعاد تشكيلها وإنتاجها، ولا يبقى بين النص الجديد وأشلاء النصوص السابقة سوى نوعية المادة، وبعض البقع التي تومئ وتشير إلى النص الغائب، من هنا فإن قراءة النًّصِّ الذي بين أيدينا تستدعي إلى الذهن نزار قباني في ديوانه (الرسم بالكلمات) الذي صدر عام 1966م، وإن كان للتناص صورٌ ثلاثٌ، أولاها: التماهي بأن يقع النص الجديد في أسْرِ نصوصٍ سابقةٍ، وثانيتها: هي التّصارع بأن يقابل النّصُّ الجديد ضديًا النصوصَ القديمة، أما الثالثة: فهي التجاوز بالفرادة، فإن النّصَّ الذي بين أيدينا قد أخذَ صورتين هما الأولى والثالثة. وقبل الحديث عن صورتي التّناصّ لعله يكون من نافلة القول إن ميل الشاعر إلى التناص لا يقلل من قيمة إبداعه، فكل مبدعٍ أثناء إنتاجه للنصوص تتداعى إلى ذهنه من مكوناته الثقافية، ومن مخزونه المعرفي صورًا سبق له قراءتها أو سماعها، فيقوم بإعادة تشكيلها بطريقته الخاصة، التي تظهر فرادته وتميزه مع عدم انقطاعه عن سابقه. وقد اتخذ التناص في قصيدة (يلوموني) على صورتين سبقت الإشارة إليهما، وبقي علينا تحديدهما، فأما الصورة الأولى فكانت بالتجاوز بالفرادة حيث أسمى نزار ديوانه المشار إليه بـ(الرسم بالكلمات)، وهو عنوان القصيدة الأولى في الديوان، فيلتقط العيدروس إشارة الرسم ليقوم بعملية رسم من نوع فريد، هي “الرسم بالقُبلات”، وقد اختار أن يكون هذا الرسم على الخدين، حين يتحدث عن لحظات الدفء العاطفي والأنس فيقول:
| سَلوا عنّا رُبَى الغنّا | وحيطان الطّويلهْ كم ثَراها ضَمّنا | |
| وكم بِتنا بها نهنا | وبالقُبلات ع الخدّين نرسم حبّنا |
ففي حين يجعل نزار قباني الرسم بالكلمات طريقه للخلاص من الآلام؛ إذ تعبت خيله من غزو أجساد النساء، وزراعة راياته في النهود البيض والسود، ومرور عرباته في أجسام الجميلات وبنائه أهرامًا من الحلمات، وعجز الجنس أن يكونَ مُسكّنًا لآلامه، فلم يُنهِها، فظلّت كل الدروب مسدودةً أمامه ولم يجد خلاصًا إلا بالرسم بالكلمات، فإن العيدروس يجعل من لحظات رسمه القبلات على الخدود ساعات هناء وسعادة.
أما الصورة الثانية فهي التماهي، فتمثل في حديث العيدروس عن أنه هو السبب في شهرة المحبوب، وأنه لولاه لَمَا عرفه الناس وذاع صيته:
| ونا لوْلاي ما تْغـنَّى | بحُبّه بُلبُل الوادي ولا صدحْ بالغنا |
وهو هنا يستدعي قول نزارٍ:
| وكُنتِ مجهولةً حـتَّى أتيتُ أنا | أرمي على صَدْرِكِ الأفلاكَ والشُّهُبا |
وهو أمرٌ لعله قد سُبِقَ إليه الشاعران كثيرًا، حتى في كلام العامّة حين ينشأ خلاف بين المحبوبين يعقبه هجر أو انقطاع في العلاقة يحاول طرفٌ منهما نسبة الفضل إلى نفسه في معرفة ولفت انتباه الناس إلى الآخر.
وقد تناصَّ هذا النصُّ تناص تماهٍ مع الشاعر حسين المحضار، إذ يقول العيدروس:
| بِظـنّي إنّه استغنَى | وإلّا كيف يخرب عَتمْ جاري بيننا |
الميل إلى اقتناص الصورة من طبيعة الحياة بتشبيه العلاقة بين الشخصين حين تجري الأمور على طبيعتها بالعتم الجاري، تحدث عنها الشاعر المحضار حين يقول:
| يا جارنا إرعَ لنا حق الجوار | وخَلِّ عتمَ الودِّ فيما بيننا جاري |
وبيت المحضار يشير إلى الحالة التي تعانيها الذات الشاعرة في قصيدة يلوموني؛ إذ الحديث في القصيدتين كلتيهما منصبٌّ على الوصال.
سبق أن تحدثنا عن تكرار الضمائر في النص حيث بلغ عددُها مئة ضمير وعشرة ما بين ضمير ظاهر ومقدر، وتوزّعت على ضمائر التكلّم وضمائر الغيبة، حيث غابت ضمائرُ الخطاب فلم يَرِدْ في النصِّ إلا ضميرٌ واحدٌ للمخاطب (سَلُوا).
وعند تفصيل هذه الضمائر نلاحظ أن ضمير التكلم تردد ستًا وأربعين مرة، ثلاث وأربعون منها ظاهرًا، وثلاث ضمائر مقدرة، لكن ضمير المتكلم الظاهر الوارد في النص كان ذا دلالة مختلفة حيث أشار في بعض المواطن إلى مفرد هو الذات الشاعرة ثماني وعشرين مرة، وكلها كانت الذات المتكلمة غير فاعلة، وفي مواطن أخرى أشار إلى الذات المتكلمة والذات الأخرى (المحبوبة) خمس عشرة مرة في إشارة إلى الاتحاد بينهما، توزعت فيها الذات بين الفاعلية والمفعولية، أما ضمائر المتكلم المقدرة التي وردت ثلاث مرات فقد أشار إلى الذات المتكلمة مرة واحدة، وإلى الذات المتكلمة والمحبوب مرتين، وكانتا في إطار الحديث عن التمتع في وصف لحظات الأنس حين كان عتمُ الودِّ جاريًا بينهما (نحتسي خمر الهنا، بالقبلات ع الخدين نرسم حبّنا).
أما ضمائر الغائب فقد تكررت أربعًا وستين مرة، منها ثلاث وأربعون مرة ضميرًا ظاهرًا، وهو هنا يتساوى مع ضمائر التكلُّم الظاهر ليعكس لنا الصراع القائم بين الذّاتين، غير أنَّ الذَّات الغائبة سيطرت على الذات المتكلمة؛ حيث بلغ عدد الضمائر المقدرة واحدًا وعشرين ضميرًا وهذا يدلُّ على فاعليتها في النصِّ.
ولعله يجدر بنا أن نتحدث عن طبيعة العلاقة بين المتكلم والغائب، تلك العلاقة التي يكشف النّصُّ عنها أنها علاقة توتُّرٍ وسخطٍ، وضيقٍ وعدم رضى، بل إنّ الذّات المتكلمة تصرِّحُ بتبرُّمِها من فعل هذا الغائب بتدرُّج؛ حيث ابتدأت بالتمني على المحبوب لو أنه فارق بإحسان (وريته ضبّط الآخر حفظ أسرارنا)، وهو بهذه الطريقة يكشف عن جُرحٍ غائر؛ إذْ لم تتصوَّر الذّات المتكلمة منه إنكار الحب والتجني (ولكن راح يتجنى يقول للناس لا حبّه ولا شي بيننا)، ثم تحاول الذات المتكلمة التذكير بماضي العلاقة والأوقات الجميلة:
| نَسيْ أيّامَ ما كُنّا | مِنِ اكؤوس المحبه نحتسي خمر الهنا | |
| وطيـر الشّوق ثالثنا | يُناجي خدّه الوردي ويمرح فوقنا |
وتعمد الذات المتكلمة إلى طريقة أخرى هي إحضار الشهود، أو الاستعانة بمن يمكنهم إثبات العلاقة وإن كان هؤلاء الشهود لا يتكلمون، مستغلًا ما يُعرف بـ(التشخيص)، وهو قدرة الشاعر على تخيّل الحياة فيما لا حياة فيه، وعلى إكساب الجمادات أوْ قوَى الطبيعةِ أفعال الأشخاص أو صفاتهم، وهو إخراج المعاني في صورة الأشخاص أو أن ينسب للحسي -الجماد والطبيعة- ملامح بشرية، ويعتبر التشخيص من أبرز عناصر الصورة في الإنتاج الأدبي؛ إذ إنَّه يُكسِبها قوّة وحيويّة، والصّورة في مجملها تعد وسيلة الأديب في نقل فكرته وعاطفته معًا إلى قرائه أو سامعيه، يقول العيدروس:
| سَلوا عنّا رُبَى الغنّا | وحيطان الطّويلهْ كم ثَراها ضَمّنا |
هكذا تمنح الذاتُ المتكلمة بعضَ مظاهر الطبيعة (ربى الغنّا، وحيطان الطويلة، ثراها الأحاسيس فتبرزها -وهي الجامدة – في صورة كائنات حيّة تحسُّ وتتحرك وتنبض بالحياة، فتُسأل وتُخبِر، وهكذا تكون الذات المتكلمة قد أضفت صفات الكائن الحي خاصة على مظاهر العالم الخارجي، فتبثُّ الحياة فيها، وتجعلها تحس وتشعر. ثم تعلن الذات صرخة كبرى منافحة عن نفسها، محاولة التخلّص من محاولات الازدراء والإهانة التي يحاول الآخر إلصاقها بها، وهنا توجّه ضربة لذلك الآخر:
| كأنّا ما تعارفنا | إذا مَرَّهْ جَزَعْ جنْـبي تجاهَلْ من أنا | |
| ونا لوْلاي ما تْغـنَّى | بحُبّه بُلبُل الوادي ولا صدحْ بالغنا |
أما من ناحية الإيقاع فيمكن القول إن الذات الشاعرة نظمت قصيدتها على تفعيلة واحدة هي تفعيلة (مفاعيلن)، مع اختلاف في عدد التفعيلات؛ حيث عمدت على أن تكرر التفعيلة مرتين في الجزء الأوّل (مفاعيلُن مفاعيلن ل – – -/ ل – – -)، أما الجزء الثاني فتتكرر فيه التفعيلة أربع مرات، ثلاث منهن تامات، والرابعة ناقصة (مفاعيلن مفاعيلن مفاعِيلن مفا ل – – -/ ل – – -/ ل – – -/ ل -).
وقد جاء رويُّ القصيدة على (نا) الدالة على الجمع، ولعلَّ فيها إشارة إلى حرص الذات المتكلمة على حضورها مندمجة ومنصهرة مع الذات الأخرى الهاجرة، إلا في موضعين جاءت (نا) للدلالة على الذات المتكلمة إدلالًا منها بنفسها، ومحاولة منها إلى تضخيم دورها (تجاهل من أنا)، (نا من سمح عوّدته على مجناي نا).
أما فيما يتعلق (بالقفل)، وهو المقطع الذي يسبق الشلّة، فقد حرصت الذات المتكلمة على اختتامه بـ(آهـ) وكأنها تشير بذلك إلى زفرات الحرقة والألم التي تطلقها الذات، خاصّة إذا علمنا أنّ ضمير الغائب الهاء هنا يعود على ذلك المحبوب الذي حرمه وصلَه، وكأنّ فيه شيئًا من الإصرار على استحضاره، وإن كان هذا الحضورُ باعثًا للألم والحرقة. وهذا القفل قد جاء على (مفاعيلن مفاعْ)، وصورة (مفاعْ) صورة غير مألوفة في تحولات مفاعيلن، فهل في هذا إشارة إلى صورة غير مألوفة في هذا التعامل من المحبوب؟ هذا شيءٌ غير مستبعَد.
أما إذا انطلقنا للحديث عن الصورة الفنية في هذه القصيدة فإن أعيننا وآذاننا لا تخطئ وجودها؛ إذ لا نكاد نصل إلى البيت الثاني إلا ويصادفنا قوله:
| نَسيْ أيّامَ ما كُنّا | مِنِ اكؤوسِ المحبَّه نَحتسي خمْرَ الهنا | |
| وطيـر الشّوق ثالثنا | يُناجي خدّه الوَردي ويمرحْ فوقنا |
تبرز اللقاءات التي كانت تجري، وتناساها المحبوب، وأنكرها لحظاتِ أنسٍ؛ إذ تعددت أسباب السعادة لتعدد الأسباب الباعثة عليها، فقد شبّه اللقاءات التي كانت تتمُّ بمجالس الخمر وما فيها، وشبّه تعاطي الأحاديث بينهما، وتبادل القبلات، وما يتبعها من اللمساتِ باحتساء الخمر، وشبّه الشفاه بالكؤوس، والصورة هنا تشبيه مركب، يجلوه الشكل الآتي:
اللقاءأ ب مجالس الخمر
الأحاديث والقبل أَ بَ الاحتساء
ولا يقف حديث العيدروس عند التلذذ بالرؤية، والتذوق، والملامسة، والشمِّ حتى يضيف لها ما يجعل اللحظات مفعمة بالسعادة والانبساط فيكون للغناء حضور، فكان طائر الشوق يناجي خدّ المحبوب الوردي، وهذه المناجاة بما تحمله من معنى القرب بين المتناجيين هي مناجاة محصورة على خدّه، ولنا في وصف الخدِّ بالوردي دلالة مزدوجة، فهو إما أن يكون ناجمًا عن حياءٍ تزيّنٍ، وما يبعثه في عين الناظر مما يكمل المنظر بهاءً.
ومن الصور الفنية كذلك ما يبرز في قوله:
| سَلوا عنّا رُبَى الغنّا | وحيطان الطّويلهْ كم ثَراها ضَمّنا | |
| وكم بِتنا بها نهنا | وبالقُبلات ع الخدّين نرسم حبّنا |
حيث يميل الشاعر إلى التّشخيص فيمنح مظاهر الطبيعة صفات الإنسان؛ حيث برزت رُبى الغناء، وحيطان الطويلة، وكأنهما شاهدان على ما كان يحدث، وأنهما سينطقان بالشهادة على ذلك الحب، وقد لجأ العيدروس إلى استنطاق الصوامت، في إشارة إلى أن هذا الحبَّ لا يمكنُ إنكاره حتى استشعرته الصوامت الجوامد، فحرارته تدبُّ ولا يمكن إخفاؤها.
وتأتي الصورة الثانية متمثلة في اللقطة التي تتميز بالحركة والتجدد، واتساع حدود الصورة في إطارَي الزّمان والمكان، واللقطة التي نحن بصددها لقطة تجاوزت حد المناجاة والبث الوجداني الهامس إلى حدّ الملامسة الخالقة عن طريق الرسم بالقبلات، ذلك الرسم الذي يتطلب حركة كما تطلبه القبلة كذلك، ومما لا شك أن هناك صوتًا للرسم وللقبلة وإن كان خافتًا، لكننا هنا أمام لقطة تُثبّتُ واقعةً، أو قل نحن أمام منظرٍ تُرسَم فيه معالم الحب، وتوضع القبلات على الخدود، فلا يكاد يُخطئ إنسانٌ قراءة اللحظة.
وقد اختتم العيدروس قصيدته بصورة فنية مُعبّرةٍ عما استشعره من جفاء الآخر، وسعيه إلى إنهاء العلاقة التي كانت قائمة، ومع أنه رُبما قد وصل إلى مرحلةٍ تيقّن فيها فشلَ هذا الحبِّ، وعدم رغبة الطرف الآخر في استمرارها إلا أنه يجعل باب الأمل مُشرعًا من خلال استخدام الظن لا اليقين -(بظني)- مع أن الشواهد تؤكد تيقّنه، لكنْ لعلّ حرصه على التمسك بهذا الحب ورغبته في استمراره عمد إلى الظن؛ حيث يقول:
| بِظـنّي إنّه استغنَى | وإلّا كيف يخرب عَتمَ جاري بيننا | |
| ويجني وسْط كُلْ مجنـَى | وَنا مِنْ سَمْحَ عوَّدْتُه على مَجناي نا |
فقد شبّه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة حياةٍ، واختار الماء- لِما له من طبيعةٍ دينية؛ بوصفه مبدأ الخلق والتكوين منفردًا أو مع غيره- للتأكيد على أهمية بقاء هذه العلاقة، وشبّه تكدير هذه العلاقة بمن يقوم بتخريب مجرى هذا الماء، ثم يُشبّه تنقّل هذا المحبوب من محبّته إلى محبّةٍ أخرى بحشرةٍ (النحل مثلًا)، ويُشبّه نفسه والآخرين بأماكن الجني أو المحصولات، ويجعل تنقُّل المحبوب من حبّه إلى حبِّ إنسان آخر كتنقّل هذه الحشرات، وربما يرجع سبب عدم تصريحه بأن هذه الحشرة هي النحل؛ نظرًا لكونها لا تقع إلا على الطيبات، ولا تُخرج أو تفرز إلا الطّيبات، والعيدروس يأبى أن يمنح إنسانًا آخر هذه الصفة ويخصصها لنفسه.
وأخيرًا فهذه القراءة لا تدّعي لنفسها الإحاطة بكلِّ ما في القصيدة، ولكن حسبُها أنها حاولت أن تضيء شيئًا من تراث أهمِل ولم يتعرض للدراسة أو القراءة، ولعل آخرين يعيدون قراءة هذه القصيدة وأخواتها فيمنحون الديوان ما يستحق من العناية.
([1]) يقل: تعني: يقول وكتابتها بهذه الطريقة أضبط للوزن، وإن كتبت في الديوان يقول لكن لعله خطأ لم يُنتبه إليه.
([2]) كلمة (جزع) ليس لها حضور كثيف في اللهجة الحضرمية، وهي منقولة من لهجة عدن، وإنما يُعبِّر الحضارمة بدلًا عنها بلفظة (عبر) على أنه قد وردت بصيغة فاعل في قصيدة الشاعر سالم بانبوع حين قال:
يوم الخميس الصبح أنا جازع ولا قصدي بحد
إلا وذا روشان سَدّي باب له حين انقلد
([3]) لصدح: تعني ولا صدح، ولكن الحضارم في نطقهم لا يمدونها خاصة في درج الكلام.