تاريخ دخول المذهب الشافعي حضرموت
أضواء
حسين صالح بن عيسى عمر بن سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
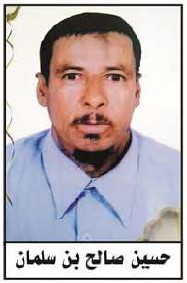
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 11 .. ص 24
رابط العدد 11 : اضغط هنا
نستطيع القول اليوم إن التعصب للمذاهب الذي كان سائدًا في الأسلاف في عالمنا الإسلامي، قد خفَّ وقلَّ اليوم كثيرًا بعد أن انتشر العمل بالكتاب وصحيح السنة على منهج السلف الصالح مذهب أهل التحقيق من أهل الحديث والفقه، وتوسع وتنامى التواصل الكبير بين مختلف أقطار العالم الإسلامي.
أما في الماضي من تاريخ المذاهب وانتشارها في بلاد المسلمين فكان للحكومات والسلاطين دور فاعل في ارتفاع حدة التعصب والتقليد في اتخاذ هذا المذهب أو تركه، وأمثلته كثيرة في مصر والشام وغيرها من البلدان.
وكانت حضرموت ومناطق واسعة من اليمن قد ظلّ فيها المذهب الشافعي متربعًا كرسي القضاء وما زال حتى اليوم، من غير تعصب في التقليد إلا عند طائفة قليلة من الجمهور، وبخاصة بعد انتشار واسع لمذهب أهل التحقيق، وهم التاركون التقليد الآخذون بنصوص الكتاب والسنة وما صح منها، وهو مذهب السلف في القرون الثلاثة المفضلة وكل الأئمة رضي الله عنهم.
وهذان مبحثان اختصرتهما من بحث لي مطول جعلته في تاريخ دخول المذهب الشافعي حضرموت، مفصلًا فيه الأقوال التي تناولت وجهات نظر مختلفة فيما قيل عن تاريخ دخول المذهب الشافعي حضرموت؛ حيث ظلت هذه المسألة قائمة حتى يومنا هذا فيما أعلمه، والله أعلم.
المبحث الأول: الأوضاع السياسية والمذهبية في حضرموت قبل دخول المذهب الشافعي حضرموت:
ظل أهل حضرموت على الإسلام، وعلى مذهب السلف في العقيدة والأصول والفروع حتى ظهور الإباضية في حضرموت.
فالأصل أن أهل حضرموت كغيرهم من أقطار الجزيرة العربية الأخرى أنهم تعلموا أحكام الدين وشرائعه، وأخذوا عقديتهم في الله تعالى وأسمائه وصفاته وفي كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كان لهم شرف الصحبة به صلى الله عليه وسلم، وهم سلف هذه الأمة مع التابعين لهم في القرون المفضلة الأولى التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قبل ظهور المذاهب الإسلامية والفرق الكلامية في بلاد المسلمين.
واتفق علماء الإسلام على أن السلف الصالح هم من في الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.. وقال الإمام عبدالكريم السمعاني في (الأنساب، 7/ 104): »السلفي: بفتح السين واللام، وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم«.
والمعنى الاصطلاحي للسلفية: قال الإمام السفاريني: »المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة، وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة، والكرامية، ونحو هؤلاء«. (لوامع الأنوار، 1/ 20).
فكانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، قبل ظهور المذاهب الأربعة في بلاد المسلمين، هذا هو الأصل العقدي في أهل حضرموت حضرًا وبدوًا.
وعندما ظهرت بدعة الخوارج سنة 128هـ، والشيعة سنة 318هـ تميَّز أهل السنة والجماعة في حضرموت عن الإباضية الذين جعلوا من حضرموت منطلقًا لثورتهم، ويشهد لذلك أن عبدالله بن يحيى الكندي زعيم الثورة أتى دار الإمارة في حضرموت واستولى عليها وأخرج منها إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي من غير قتال، وحبسه ثم أطلق سراحه بعد أن استولى على حضرموت، والشاهد أنَّ هذا الوالي للدولة الأموية دولة الخلافة الإسلامية لم يكن مع الإباضية ومذهبها الذي أخذ ينتشر في حضرموت وأقطار أخرى، وكان معارضًا لهم فهو على غير عقيدتهم التي يدعون الناس إليها، وليس هناك إلاّ طريق واحد سلكه هذا الإمام وهو طريق أهل السنة والجماعة المذهب الحق، ومعتقدهم أنهم يجتمعون على طاعة السلطان ولو كان جائرًا؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الإمام وأمر لزوم أمر الجماعة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومهما تكن لهم من مسوغات من فساد السلطان وجوره فما ترتب من نكبات على خروجهم وثورتهم كان أعظم من قتل ودمار وخراب.
وقال الأستاذ كرامة سليمان بامؤمن في (الفكر والمجتمع في حضرموت، صـ141): »وعندما دخل فكر إمامي شيعي حضرموت مع الوافد المهاجر أحمد بن عيسى سنة 318هـ لم يقبله قبولًا سريعًا الحضرميون، وظل منعزلًا منغلقًا مائتي سنة«.
وعليه فرضًا فإنه سيظلُّ جزء من أهل حضرموت متمسكين بمذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف كغيرهم في سائر بلاد المسلمين طيلة القرون الثلاثة الأولى المفضلة وما تلاها حين راجت وشاعت أفكار الخوارج والشيعة التي خرجت على أهل السنة منذ صدر الإسلام، ومن هذه الفرق الإباضية.
وهي فرقة من فرق الخوارج ويطلقون على أنفسهم (الشُراة) و(حملة العلم)، إلا أن كُتّاب الفرق الإسلامية يعدُّونهم من فرق الخوارج، وتنتسب إلى عبدالله بن إباض التميمي، وكانت لهم محاولتان للخروج في عصر الدولة الأموية سبقت ثورتهم التي انطلقت من مدينة شبام ودوعن بحضرموت سنة 129هـ بقيادة القاضي عبدالله بن يحيى الكندي، الذي أطلق عليه أنصاره (طالب الحق)، في عهد آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد الملقَّب (مروان الحمار).
وتوافد أفرادًا وجماعات من إباضية البصرة والحجاز ومناطق مختلفة من اليمن، ثم أعلنوا ثورتهم بزعامة عبدالله بن يحيى الكندي، وعزلوا عامل الخليفة الأموي إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي، المقيم في مدينة دمون بدوعن، واستمرت هذه الثورة قرابة السنة والنصف، بدأت عام 129هـ وانطلقت صوب صنعاء، ومن ثمَّ مكة والمدينة، وكان من أهدافهم الوصول إلى الشام، وكان أبرز قادة هذه الثورة إلى جانب عبدالله بن يحيى الكندي أبو حمزة المختار الأزدي نائبًا له الذي تولى المدينة المنورة، وإبراهيم بن الصَّباح الحميري في مكة المكرمة، وعبدالله بن سعيد الحضرمي تولى الحكم والقيادة في شبام بحضرموت. (انظر تفاصيل الأحداث عند ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من كتب السير والتاريخ والأعلام).
وما يهمنا ذكره في هذه المناسبة فشل الثورة الإباضية من الناحية العسكرية في إسقاط الخلافة الأموية، لكنهم ساهموا في إضعافها ونهايتها، والأهم من هذا أن فكرهم ظل مسيطرًا قرونًا طويلة بعد ذلك في مناطق مختلفة خاصة في حضرموت، بالرغم من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش الأموي بعد أن قتل قائد الثورة عبدالله بن يحيى الكندي في مكان يقال له (تبالة) خارج صنعاء في منطقة تهامة. ولقد ظل عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي والي اليمن لمروان بن محمد يطارد فلول الإباضية فيها حتى حضرموت، إلا إنه لم يستطع السيطرة التامة على الوضع في حضرموت، فاضطرَّ إلى مصالحة الإباضية وعاد إلى مكة، ولكنه قُتل في أثناء الطريق.
فما لبث أن أرسل الخليفة مروانُ بْنُ محمدٍ ابن شعيب البارقيَّ على رأس حملة تأديبية كبرى إلى مدينة شبام والهجرين وذي أصبح وتريم، فأوقع القتل في الرجال والنساء والأطفال، حتى قيل إنه بقر بطون النساء، وأتلف الأموال، وخرب الديار، وانتهب ما بأيدي الحضارمة حتى أخمدت ثورتهم عام 130هـ.
إن سوء الحكم وتعسف الولاة الذين يعينهم خلفاء بني أمية على اليمن وحضرموت من قبل الوالي في صنعاء؛ كان سببًا مباشرًا لهذه الثورة كما اتفق الكثير من المؤرخين على ذلك.
لم ينته أمر الإباضية بالقضاء على قادة الثورة وأنصارها بقسوة شديدة كما يذكر بعض المؤرخين، حتى قيل إنه قتل ألف فارس من الحضارم، وكان من الصعب محو هذا الفكر المتجذر كما يرى ذلك الأستاذ (كرامة سليمان بامؤمن)، ويرى أن السبب »أن هذا الفكر يحمل قيمًا إنسانية من عدل ومساواة، وعقائد توحيدية أساسها القرآن الكريم والسنة النبوية«، (الفكر والمجتمع في حضرموت، صـ141)، ويرى آخرون كالأستاذ عبدالرحمن جعفر بن عقيل: أن المذهب يدعو إلى الحفاظ على العلاقات السلمية المتبادلة مع المسلمين غير الإباضين والذين يعتبرهم أنصار المذهب من المؤمنين، (انظر: صـ127).
وهذه الأقوال وغيرها فيها من العاطفة والحنين إلى الماضي كما هو واضح ولكن الاتباع للسلف من هذه الأمة خير من الابتداع والخروج الذي كلّف حضرموت كثيرًا من المحن والقتل والدمار والفراغ السكاني والفتن الكثيرة.
ثم عاد الإباضيون يحكمون حضرموت بعد سقوط الدولة الأموية، وقبل أن يتمكن بنو العباس من إقامة حكمهم ببغداد كان الإباضيون يحكمون، ومذهبهم سائد في حضرموت.
ثم نهضت الحركة الإباضية مرة أخرى عام 141هـ في ولاية أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي إذ ولى معن بن زائدة الشيباني، الذي قام بحملة تأديبية مشهورة أوقع بالإباضية في حضرموت القتل والدمار ولم يتورع عن استخدام أي وسيلة تمكنه من الإيقاع بخصومه المعارضين. وإزاء هذا الإصدار من جانب الولاة في صنعاء الذين تعينهم الدولة العباسية والدويلات التي ظهرت مستقلة عنها في اليمن فيما بعد، فقد استمر الإباضية في ثوراتهم في حضرموت وعُمان، أوجدوا لأنفسهم بعض الدول في المدن الحضرمية كشبام والهجرين خلال القرن الرابع والخامس الهجريين، وواجهوا غزو الصليحي الرافضي علي بن محمد اليمني، وكان داعية للفاطميين ويقال لهم العبيديون بمصر، وهم شيعة إسماعيلية، كما تذكر كتب التاريخ أنهم استولوا على حضرموت سنة 455هـ فقاومهم الإباضيون في مدينة شبام وغيرها من مناطق حضرموت.
قال الشاطري في (أدوار التاريخ الحضرمي، صـ148) إن القرامطة الروافض هاجموا حضرموت ولم تسلم من هجماتهم عليها في أواخر القرن الثالث الهجري أو أوائل الرابع، وأضاف الشاطري ويظهر أنه لم يدم طويلًا.
وبدأ الضعف يعتري دعاة الإباضية منذ القرن السادس الهجري تقريبًا، قال بامؤمن: وبمرور الزمن تلاشى الفكر الإباضي في حضرموت واليمن وترسخ فكر أهل السنة والجماعة لا سيما للفكرين منهلًا واحدًا. وبانتشار الفقه الشافعي في تهامة اليمن امتد إلى حضرموت بجهد فقهاء يمنيين وحضرميين، وبانتشار العقيدة الأشعرية التي أتت مع الحكم الأيوبي في تهامة اليمن الذي وصل إلى حضرموت أيضًا.

المبحث الثاني: الأقوال في متى دخل المذهب الشافعي حضرموت ومن هم رواده الأوائل وكيف انتشر في حضرموت:
سأفترض للمسألة ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: دخول المذهب في القرن الرابع الهجري على يد المهاجر السيد أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي القادم من البصرة عن طريق الحجاز ومن ثم إلى حضرموت.
القول الثاني: دخول المذهب عن طريق الحضارم المهاجرين من بلد حضرموت إلى مصر، وتواصلهم الذي لم ينقطع مع أهلهم وذويهم منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين.
القول الثالث: دخول المذهب عن طريق علماء الشافعية بتهامة باليمن، ومن طريق الإمام الفقيه محمد بن علي القلعي الذي ارتحل من تهامة وسكن ظفار.
الأول: قول من قال بدخول المذهب في القرن الرابع الهجري على يد المهاجر السيد أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي القادم من البصرة عن طريق الحجاز ومن ثم إلى حضرموت:
تقول هذا بعض الروايات المنتشرة في بعض المراجع الحضرمية التي بين أيدينا، ولا تذكر سندًا ولا تذكر مصدرًا معاصرًا، بل هي على شكل آراء ووجهات نظر لا تتعدى الاستنتاجات الشخصية لبعض من الكتاب والمؤرخين المعاصرين، وغالبًا ما يكون عند ذكر مذهب المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي، يشير البعض منهم إلى فضل المهاجر على أهل حضرموت بدخول المذهب الشافعي ودحر مذهب الإباضية وانكساره. ومع هذا لا يوجد نص صريح يحدد وصول المذهب الشافعي إلى حضرموت، وإن كان من المؤكد كما يرى أصحاب هذا القول أنه قد بدأ انتشاره في أوائل القرن الرابع من الهجرة، أي بعد وصول الشريف: أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي الحسيني إليها عام 319 من الهجرة.
ففي (أدوار التاريخ الحضرمي، للشاطري، طبعة 1994م، صـ149) ذكر أن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد العريضي بن جعفر الصادق [إلى آخر النسب]، وإليه يرجع أصول السادة آل باعلوي وفروعهم. هاجر من موطنه العراق إلى أرض حضرموت ولذلك لُقب بـ(المهاجر)، وهو أول من أتى حضرموت من آل البيت النبوي، وله الأثر الكبير في انتشار المذهب الشافعي فيها. ثم ذكر أن المهاجر جادل الإباضية وأنهم كانوا يقبلون الجدل والأخذ والرد حول مذهبهم فيما له وعليه بالطرق السلمية كما وقع لهم مع الإمام المهاجر أحمد بن عيسى العلوي في أثناء القرن الرابع الهجري، فإنه استعمل معهم طريقة الإقناع والاقتناع ونشر بوساطتها في حضرموت المذهب السني -الشافعي- هو وبنوه وأتباعه حتى توارى المذهب الإباضي من حضرموت شيئًا فشيئًا إلى أن رحل عنها فعمها المذهب الشافعي في الأعمال والأحكام، والمذهب الأشعري في العقائد…. ويضيف الشاطري فيقول: »إن المهاجر وإن كان يعتنق مذهب الشافعي لا يقلد الشافعي تقليدًا أعمى، فهو أجل من ذلك، وكيف وأمامه الكتاب والسنة اللذان عليهما أساس مذهب الشافعي، وكذلك عقائده الإسلامية هي عقائد آبائه وأجداده كالباقر وزين العابدين… «، (1/ 156).
فالشاطري في الوقت الذي يقول بريادة المهاجر للمذهب الشافعي في حضرموت ونشره نراه يتراجع بطريقة أو بأخرى؛ لأن الأدلة الواضحة لا تعينه فيتوارى خلف قول التمسك بمذهب الآباء والأجداد الذين لا لبس في إماميتهم المذهبية والعقائدية الواضحة، كما يرد عليه صالح بن علي الحامد في كتابه (تاريخ حضرموت)، قال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في كتابه (هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، 3/ 698): (ذكر المؤرخ صالح بن علي الحامد العلوي الحضرمي في كتابه (تاريخ حضرموت) (1/ 323) أن أحمد بن عيسى المهاجر (الذي ينسب إليه العلويون الحضارمة) كان إمامي المذهب. مع أن الغالبية ممن ينتسب إليه قد تمذهبوا بمذهب الإمام الشافعي، وهو المذهب السائد في حضرموت إلا أنه بقي فيهم من يعتنق المذهب الإمامي إلى اليوم، ومن هؤلاء في عصرنا الشاعر أبو بكر بن عبدالرحمن بن شهاب المتوفى سنة 1341هـ، ومحمد بن عقيل بن يحيى المتوفى بالحديدة (1350هـ) صاحب كتاب (النصائح الكافية لمن يتولى معاوية).
ونقل محمد ضياء شهاب في كتابه (الإمام المهاجر أحمد بن عيسى، صـ77) قول القاضي عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف بإمامية مذهب المهاجر، فقال تحت عنوان بارز مذهبه الديني: يميل العلامة السيد عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف إلى القول بإمامية المهاجر في كتابه (نسيم حاجر في تأكيد قولي عن مذهب المهاجر) المطبوع بمطبعة النهضة اليمانية بعدن. جاء فيه قوله: »وأما القول بالنص على إمامة علي ثم على ابنيه ثم علي زين العابدين ثم الباقر ثم الصادق فكل أهل البيت قائلون بذلك… «، صـ1، وقال: »وجل ما ارتقى من القدح إليهم إنما كان بسبب المذهب، وما يزن به بعضهم من الطعن في أكابر الصحابة، مع أن الكثير من أهل العلم يعذرونهم، وإلا لما قدروا على توثيق شريف قط، مع أصفاقهم على ندرة السني فيهم بل عدمه…. «، صـ7.
وقال: »وتأمل في الحكاية “337” من الجوهر الشفاف، وما علق به عليها مؤلفه، فإنها صريحة في أن الشيخ السقاف ليس بحنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي«، صـ8.
ويرى ابن عبيدالله السقاف أيضًا في (نسيم حاجر في تأييد قولي عن مذهب المهاجر صـ8، طبع في مطبعة النهضة اليمانية بعدن، 1368هـ/ 1948م) أن المهاجر إمامي المذهب ولا علاقة له بالمذهب الشافعي وتؤكده الإجابة على سؤال بعث به إليه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بكير وأثبتها في كتابه (القضاء فى حضرموت في ثلث قرن 1351- 1385هـ/ 1932- 1966م). قلت: »فلا يمكن أن يحمل المذهب الشافعي؛ لأنه ليس بمذهبه، وإنما هو كآبائه إمامي لا يحمل إلا مذهبهم«. وأضاف بن عبيدالله السقاف:… «ولما تحول ابن السمعاني عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي امتلأت الدنيا دويًّا، وما كان المهاجر على سؤدده وشهامته ونجدته وعلو شأنه ليكون انتقاله عن مذهب آبائه شيئًا خفيًّا لا تملأ ضجته الآفاق، ولا يدوي صداه باليمن والعراق. ولو كان تحول عن مذهبه كما يزعم بعض من لا بصيرة له، لكان الأقرب إليه مذهب الاعتزال؛ لأنه خرج من بينهم، إذ كان شيخ الاعتزال واصل بن عطاء، وعنه أخذ الإمام زيد بن علي عليه السلام، وشيخ واصل عبدالله بن محمد بن علي بن أبى طالب.
فأنى يتحول المهاجر أحمد بن عيسى عن مذهب آبائه ويتخطى الاعتزال وهو الذي درج من وكره، ويتجاوز ذلك إلى الأشعري الذي ثبت أن الإمام عليًّا كان يلعن جده. وقد جمح بنا القول حتى خرج بنا عن مذهب الشافعي إلى الأشعري، والأمر قريب من بعضه، وإن كان الشافعي أقرب إلى العلويين بمسافات طويلة؛ لأنهم جميعًا يستقون من العيون الصافية. أما الإباضية فعهدهم بحضرموت إلى ما قبل الشافعي، وكان لهم بها دولة فى القرن الخامس، وفيهم كثيرون من العلماء حسبما يعرف من شعر إمامهم إبراهيم بن قيس، وهم كما يقول الهمداني فى بلاد دوعن«.
لأجل ذلك انتقد ابن عبيدالله من زعم أن (المهاجر) وأولاده كانوا أشعرية المعتقد شافعية المذهب، فقال: »زعم قوم كصاحب المشرع الروي، ومؤلف أدوار التاريخ الحضرمي اللذين زعما بأن المهاجر ليس شافعيًا فحسب بل هو الذي نشر المذهب الشافعي بحضرموت دون ذكر أدلة مقنعة لما قالا«.
ثم عاد الشاطري في كتابه (أدوار التاريخ الحضرمي، صـ160) فقال: »وبلغني أن بعض مؤرخي هذا العصر يقول إنه إمامي المذهب«، وهذا رجوع إلى الصواب، وذكر بامؤمن في أكثر من موضع أن المهاجر شيعي إمامي، (الفكر والمجتمع في حضرموت صـ190 وغيرها).
وممن ذكر سنية المهاجر الشيخ عبدالرحمن الخطيب في (الجوهر الشفاف)، وبامخرمة في (قلادة النحر)، وباوزير في (التحفة النورانية)، والشلي في (المشرع الروي)، والأستاذ باوزير في (صفحات من التاريخ الحضرمي).
وهكذا يتضح للباحث أن القول بأن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي هو أول من نشر المذهب الشافعي -عندما قدم سنة 319هـ- في حضرموت يعد من أضعف الأقوال ولا دليل عليه مطلقًا، فضلًا عن أن إباضية حضرموت وعُمان التي وجدت مراسلات وبعض من أدبيات شعرهم كمصادر موجودة اليوم لم تذكر العلويين مطلقًا في حضرموت في تلك الحقبة، ووجد أيضًا من يعارض هذا القول من أحفاده العلويين فضلًا عن غيرهم.
القول الثاني: دخول المذهب عن طريق الحضارم التابعين الذين هاجروا من بلد حضرموت إلى مصر وتواصلهم لم ينقطع مع أهلهم وذويهم منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين:
يرى بعض المحققين من مؤرخي حضرموت، ومنهم السيد علوي بن طاهر الحداد في كتابيه (جني الشماريخ)، و(إثمد البصائر)، أن وجود المذهب الشافعي في حضرموت كان قبل قدوم المهاجر سنة 319هـ، ويرجع ذلك إلى وجود صلات قوية بين سلالات المهاجرين أيام الفتوحات الإسلامية من أهل حضرموت من أهل السنة المتصلين بأئمتها وبين ذوي أنسابهم في حضرموت، مثل الإمام حرملة بن عبدالله صاحب الإمام الشافعي وأحد رواة مذهبه. (وقد روى عن حرملة الإمام مسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه).
ومثل الإمام أحمد بن يحيى التجيبي المتوفى سنة 251هـ، وهو ممن صحب الإمام الشافعي وتفقه عليه (وقد روى عنه النسائي في سننه) وغيرهما ممن سيكون لهم تأثير على المتصلين بهم من قراباتهم في حضرموت، وأخذهم عنهم المذهب الشافعي.
يؤكد هذا الاتجاه أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تولى القضاء في نجران عام 179 من الهجرة، وحمد الناس سيرته، وانتشر به العدل هناك، وظهر صيته في عموم اليمن حتى اعتقد بعض الموالين للدولة العباسية أنه سيكون خطرًا عليهم فوشوا به إلى الرشيد فاستدعاه إلى بغداد، ومعلوم قرب نجران من حضرموت مما يسهل معه بلوغ أخبار الإمام الشافعي إليها ويهيئ للتعريف بمذهبه عندما يفد إلى حضرموت بعض المتصلين بأهلهم من حملة مذهبه.
ومن القائلين بهذا القول أيضًا العلامة عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف؛ فقد بعث إليه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بكير من المكلا -كما تقدم ذكره- رسالة يستفسر فيها عن تاريخ دخول المذهب الشافعي حضرموت، ونوردها كما جاءت في كتاب (القضاء في حضرموت في ثلث قرن، صـ49- 52):
«الحمد لله، جناب المكرم المحترم الولد النبيه عبدالرحمن بكير بعد السلام.. وصلني كتابك المحرر 25 محرم من هذا العام، تسأل فيه عن وقت دخول المذهب الشافعي إلى حضرموت، فالذي تقرر عندي بعد نوع من الفحص أن آل حضرموت كانوا على جانب عظيم من العلم فى عصر التابعين فمن بعدهم، كما تشهد بذلك معاجم الرجال، فما من حرف فى تهذيب التهذيب وغيره إلا وفيه العدد الكثير من محدثي حضرموت، ومعاذ الله أن تحصل منهم تلك الثروة الضخمة فى الآفاق، ويملأون زوايا الشام والحجاز ومصر والعراق بدون نظيره أو أقل منه فى مساقط رؤوسهم. فقد ذكرت فى المعجم: أن يونس بن عبدالأعلى أحد أصحاب الشافعي، وأن حرملة بن عبيداللاه أحد رواة مذهبه كانا من تجيب، ومثله أبو نعيم التجيبي المتوفى سنة 204هـ، ومثوى تجيب من أعلى حضرموت، ثم نجع منهم الكثير إلى مصر، ولا بد بطبيعة الحال أن يكونوا على اتصال بأهاليهم فى أوطانهم ماديًّا وأدبيًّا كما هي العادة بين العشائر إلى اليوم، بين الباقين بحضرموت وبين أقاربهم المنتشرين فى شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، ومن أبعد البعيد أن يقطع رجال الحديث والعلم صلاتهم من أوطانهم وأهاليهم، وإنهم لأحق الناس مع ما خصهم الله به من فضيلة المعرفة بصلة الأرحام وحب الوطن. غير أنهم -فيما يغلب على الظن وتنصب عليه القرائن- لا يعولون إلا على الاجتهاد، حتى لقد كانت فتاوى السيد سالم بن بصري المقتول سنة 604هـ فتاوى اجتهاد لا فتاوى تقليد، ولا يحضرني نص صريح في تعيين الوقت الذي دخل فيه المذهب الشافعي إلى حضرموت، غير أن اليافعي يقول: إن القاسم بن محمد بن عبدالله القرشي المتوفى سنة 438هـ نشر مذهب الشافعي في نواحي الجند، وصنعاء، والمعافر، والسحول، وعدن، ولحج، وأبين. وفي كتاب (المسالك اليمنية) للسيد محمد إسماعيل الكبسي أن المأمون ولّى محمد بن هارون التغلبي قضاء التهائم فى سنة 203هـ، وهو جد بني عقامة. ونقل ابن السبكي فى طبقاته عن ابن سمرة أن فضائل بني عقامة مشهورة، وهم الذين نشر الله بهم مذهب الشافعي فى تهامة، وكان قدماؤهم يجهرون بالبسملة فى الجمعة والجماعات. اهـ. وتقديم المسند إليه مع الأخيار بالفعل مؤذن بحصر نشر مذهب الشافعي على بني عقامة. ونقل الشيخ المؤرخ سالم بن حميد عن الأمير عبدالله بن عمر الكثيري أن أهل ظفار كانوا على مذهب أبي حنيفة حتى جاء الشيخ أبو عبدالله محمد بن علي بن حسن القلعي، فدخلوا على يده مذهب الشافعي، وبخط الحافظ ابن حجر أن الفقه الشافعي انتشر عن القلعي بظفار وحضرموت، وأن الناس تسامعوا به في حضرموت وغيرها، فقصدوه وحملوا عنه، غير أن القلعي متأخر، والمتأكد أن المذهب الشافعي وصل إلى حضرموت من قبل ذلك، إما من الحجاز وإما من عدن كما سبق عن اليافعي، وإما من زبيد لما فهمت أن بني عقامة اعتنقوا بها المذهب الشافعي من قديم، والمواصلات بين حضرموت وزبيد وعدن كثيرة جدًّا«.
وقرر ابن عبيدالله السقاف (أن الحضارم من أبعد الناس عن التمذهب)، وقال: »ولا يلزم -على كثرة العلماء بها (يعني تريم)- أن يتمذهبوا بشيء من المذاهب المشهورة، فقد اشتهروا بالعلوم في عصر التابعين فمن بعدهم قبل ظهور المذاهب…«، وهذا يعني كثرة العلماء قبل المهاجر وذريته، ويلغي ما يُكتب ويُنشر ويقال حول المهاجر إنه الذي أنقذ الله به حضرموت من الجهل، وأنه الذي نشر العلم، كيف نشر العلم وهو وذريته لم يدخلوا شبام وتريم اللتين كانتا تعج بالعلماء. (انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت، بامؤمن).
القول الثالث: دخول المذهب من طريق فقهاء بني عقامة بتهامة باليمن ومن طريق تلاميذ الشيخ الإمام الفقيه محمد بن علي القلعي:
اليمن: يقول التاج السبكي (ت 771هـ): (ومنهم أهل اليمن والغالب عليهم الشافعية لا يوجد غير شافعي إلا أن يكون بعض زيدية، (أحمد تيمور باشا، نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة، صـ88).
وقال أكرم عصبان فقهاء بني عقامة: وهم الذين انتشر المذهب الشافعي بجهودهم صرح بذلك ابن سمرة فقال: (وفضائل بني عقامة مشهورة، وهم الذين نصر بهم مذهب الشافعي في تهامة، وقدماؤهم جهروا ببسم الله الرحمن الرحيم في الجمعة والجماعات ونسبهم في تغلب). ( طبقات فقهاء اليمن عن عصبان، صـ17).
وذكروا أن هذا البيت تحمل أبناؤه قيام المذهب خير قيام، فتولوا القضاء والفتيا والتدريس وأفادوه، حتى انتشرت تعاليمه وانتفع بهم الناس، وأهم هؤلاء الفقهاء كما ذكرهم عصبان (صـ17- 18)، نقلًا عن (طبقات فقهاء اليمن)، و(السلوك)، و(المفيد في أخبار زبيد):
– أبو محمد الحسن بن محمد بن أبي عقامة.
– أبو الفتوح عبدالله بن محمد الحفائلي ابن عم أبي الفتوح، وقد كان فقيهًا انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في زبيد.
– عبدالله بن محمد بن أبي عقامة القاضي سيف الإسلام.
فهؤلاء أربعة من العلماء: أما الأول فلم يدركه الإمام القلعي لتقدمه، فقد قتله جياش بن نجاح المتوفى سنة 498هـ، وأما الرابع فيبعد أخذ الإمام القلعي عنه، لظهوره متأخرًا في القضاء، ويبقى القول إنه أدرك أبا الفتوح والحفائلي. (أكرم عصبان، جهود الإمام القلعي العلمية، صـ18).
والشاهد أن دخول المذهب تهامة من اليمن كان متقدمًا على ظهور الإمام القلعي في مرباط؛ حيث تتلمذ على يده بعض من الطلاب الحضارمة الذين سيأتي ذكرهم.
ثم إن للإمام الشافعي صلة باليمن وطيدة وله إليها عدة رحلات (انظر تفصيل رحلاته إلى اليمن: محمد أبوبكر باذيب، فقهاء حضرموت وجهودهم في خدمة المذهب الشافعي، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بيروت الإسلامية، 2008م، مقدمة الرسالة).
ولكن انتشار المذهب الشافعي في اليمن كان في بداية القرن الخامس الهجري، أي بعد استقرار المذهب، وللأيوبيين دور كبير في نشر دعائم المذهب باليمن، ولفقهاء الشافعية باليمن جهود مشهورة في خدمة المذهب. (الموسوعة اليمنية، مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة العفيف الثقافية، بيروت، ط2، 2003م)، (3/ 1676)، و(د. حسين العمري، مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، دار الفكر، دمشق، ط1، 1405هـ).
انتشر في مخلاف الجند وصنعاء وعدن وتهامة وحضرموت، وصار مذهب الدول السُّنِّية التي حكمت اليمن، والتي استقرت فيما يعرف باليمن الأسفل، (أيمن فؤاد سيد، تاريخ المذاهب الدينية في اليمن، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 1408هـ، صـ63).
وقال سقاف علي الكاف بهذا الصدد: ويتبع له إقليم حضرموت (جنوب اليمن)، الذي انتشر فيه المذهب الشافعي أواسط القرن السابع الهجري، (انظر: سقاف علي الكاف، حضرموت عبر أربعة عشر قرنا، مكتبة أسامة، بيروت، ط1، 1410هـ، صـ58). قلت: ودخوله حضرموت أقدم من ذلك.
ومن هذه المقدمة التاريخية يتضح أن المذهب قدم من مصر إلى اليمن وبخاصة بلد تهامة؛ حيث كانت مدينة زبيد من أهم مراكز تعليم المذهب الشافعي، فمن روّاد نشر المذهب الشيخ زيد بن عبدالله بن جعفر اليفاعي -بالياء المثناة من تحت والفاء-اليمني، كان عالمًا بالفقه والفرائض والحساب. أخذ عن أهل اليمن ثم ارتحل إلى مكة وأخذ عن الطبري صاحب العدة، والبندنيجي صاحب المعتمد. ثم عاد إلى اليمن، فانتصب للتدريس، واجتمع عليه خلق كثير. ثم رجع إلى مكة وأقام فيها مدة ثم رجع إلى اليمن. أخذ عنه صاحب البيان، ونقل عنه في الإجازة وفي الهبة. توفي سنة 514هـ أو 515هـ. (انظر: طبقات الشافعي، ابن قاضي شهبة، 1/ 47). وتحمَّل الدور الريادي طلابه الحضارم في نشر المذهب وخدمته ذكرهم أهل العلم، مثل الجعدي صاحب تراجم فقهاء الشافعية، فقد ذكر من أهل حضرموت محمد بن إبراهيم باعيسى العلامة محيي السنة ومميت البدعة أبا عبدالله المعروف (بجحوش)، كان مبرزًا في علوم الشريعة، وعلمًا من أعلام الدعوة إلى الله، ومن عشيرته القاضي أحمد بن محمد باعيسى التريمي المتوفى سنة 626هـ. وأبا زنيخ وأبا أكدر قاضي تريم جمع بين القراءات السبع والفقه، (عصبان، جهود الإمام القلعي العلمية، صـ28، وانظر: باوزير، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، صـ11- 15).
وأضاف الأستاذ أكرم عصبان في بحثه بذكر جهود الإمام محمد بن علي القلعي وكذلك الأستاذ سعيد عوض باوزير فقال: وكما أفاد فقهاء وعلماء حضرموت ومحدثيها في تلك الحقبة التي ظهر فيها الإمام شيخ الشافعية وقاضيها في مرباط ظفار من أرض حضرموت والذي انتقل من زبيد باليمن بعد فتنة ابن مهدي عام 554هـ.”أبو عبدالله محمد بن علي بن أبي الحسن بن أبي على القلعي”، الذي ولد بمصر، وتوفي عام 575هـ وأصله من المغرب على أرجح الأقوال كما ذكر (أكرم مبارك عصبان) الذي ألَّف رسالة في جهود الإمام القلعي العلمية (انظر صـ11- 15)، فهذا الشيخ العالم الإمام الهمام قد أفاد منه أهل حضرموت عندما حل ضيفًا على السلطان محمد بن أحمد المنجوي المتوفى سنة 573هـ، وقد تولى الحكم في مرباط، ومن بعده ابنه الملقب الأكحل (انظر: المصدر السابق، صـ26- 32، وبامطرف، محمد عبدالقادر، مختصر تاريخ حضرموت العام، صـ77).
»وبما أنَّ تعاليم مدرسة الفقهاء القراء بحضرموت وما عليه الإمام القلعي، يخرجان من مشكاة واحدة فقد دفع كثير من الطلبة إلى مرباط واستعاضوا الرحلة إليها بدلًا من الرحلة إلى زبيد، وذلك لقرب المرجعية المتمثلة في القلعي فهاجر الفقيه علي بن أحمد بامروان، والفقيه إبراهيم باماجد وغيرهما من تريم إلى القلعي«، (عصبان، جهود الإمام القلعي العلمية، صـ41).
فكان من نتائج ذلك الاتصال بهذا العالم شيخ الشافعية أن انتشر به المذهب الشافعي في مرباط وحضرموت، بالرغم من أنَّ الريادة الأولى لدخول المذهب كانت من قبل على يد الطلبة الحضارم الذين درسوا في مدرسة الشيخ الفقيه زيد بن عبدالله اليفاعي في الجند، »غير أن انتشاره إفتاء وقضاء وتدريسًا وتأليفًا كان على يد الإمام القلعي بلا ريب، وهذه حقيقة صرح بها أهل الشأن، وأخبر بعض من أهل العلم من الشافعية المتقدمين منهم كالجندي والخزرجي وابن حجر«. (عصبان: المصدر السابق، صـ43).
وبعد أن عرضت هذه الأقوال الثلاثة وتحددت مدتها الزمانية والمكانية فالذي يظهر لي أن القول الثاني هو ما ترجح لدي بأن: (دخول المذهب عن طريق الحضارم التابعين الذين هاجروا من بلد حضرموت إلى مصر وتواصلهم لم ينقطع مع أهلهم وذويهم منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين)، ولغياب المصادر الحضرمية التي توضح هذا التواصل بين المهاجرين من التابعين وذويهم في حضرموت، وبخاصة وأن حضرموت شهدت في القرنين الأول والثاني الهجريين أحداثًا تاريخية غير عادية تناولتها مصادر التاريخ الإسلامي خارج حضرموت، وهي ثورات الإباضية على الدولة الأموية والعباسية؛ ولغياب المصادر الإباضية خلال تلك الحقبة التي كان المذهب الإباضي هو السائد في حضرموت عندما بدأ دخول المذهب الشافعي، بالرغم من أننا نلاحظ بجلاء ذلك الاهتمام الذي أبدته مصادر التاريخ الإسلامي بحضرموت وتاريخها في القرن الأول وبداية القرن الثاني من الهجرة، فقد أسهبت كثيرًا في سرد وتفصيل أخبار ثورة طالب الحق، لكن تلك المصادر تعتصم بالصمت عند الحديث عن حضرموت في الحقبة التي تلت فشل الثورة (السيابي، سالم بن حمود: الحقيقة والمجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجاز، وزارة التراث القومي، مسقط، عُمان، 1980م، صـ48). ولم تذكرها إلا عرضًا في شذرات من التاريخ وفي مواضع متفرقة، بل وصفتها بالبلاد التي لا يطلب فيها العلم ووصفت أهلها بالجهالة والغتم والبداوة الشديدة، (انظر: البشاري، محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، ط3، القاهرة، مصر، 1991م، صـ103)، مما حدا بأحد المؤرخين إلى القول إن سبب غياب مصادر التاريخ الحضرمي في الحقبة الإباضية كان بسبب انتشار الجهل والبداوة الشديدة في تلك البلاد وليس عدم التدوين، (الحداد، علوي بن طاهر: جني الشماريخ، طبعة عدن، اليمن، 1970م، صـ30).
وأسهب الكثير من الكتاب والباحثين المعاصرين في تناولهم حول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي في العصر الإسلامي الوسيط، ولم تكن المصادر الإباضية وحدها التي تعرضت للتغييب والإخفاء، إذ حصل ذلك قريبًا لمصدر تاريخي مهم وهو كتاب (الفرج بعد الشدة في فروع كندة) للشيخ النسَّابة عوض بن أحمد الجرو، (سارجنت، آر، بي: حول مصادر التاريخ الحضرمي، ترجمة: سعيد النوبان، إصدارات جامعة عدن، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، د. ت، صـ31).
وقال محمد سعيد باحنان وغيره من مؤرخي حضرموت: (ولقد ضاعت أو فقدت لسبب من الأسباب مصادر تاريخ هذه القرون الخاصة بحضرموت، ولولا التواريخ العامة الإسلامية لم نطلع على الكثير مما تقدم بل عليه كله إلا ما شذ…)، (باحنان، محمد سعيد، جواهر تاريخ الأحقاف، 2/ 52).
فاجتمع على حضرموت ظروف الصراعات القبلية والمذهبية التي لا شك أنها أذهبت عنا الكثير من الحقائق حول تاريخ حضرموت عمومًا ودخول المذهب الشافعي وريادته، فأسهمت بشكل أو بآخر في تعدد الأقوال ووجهات النظر.
ومن مدرسة تريم الفقهية الشافعية يحيى بن عبدالعظيم الحاتمي (480- 540هـ) ولد وتوفي بمدينة تريم وهو من فقهاء الشافعية، وأمَّا الحفاظ والمحدِّثون الذين عرفوا في تلك الحقبة منهم أبو محمد عبدالملك بن محمد التريمي الحضرمي أحد حفاظ الحديث وروى صحيح البخاري بسنده إلى البخاري، وكان هذا السند لا يتجاوز ثلاثة أساتذة سنة 542هـ، وكذلك المحدث النهدي العلامة عبيد بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن رحيم النهدي أحد رجال الحديث ورواته، ويروي صحيح الإمام مسلم وبينه وبين الإمام مسلم من الحجاج ثلاثة رواة فقط، وأخذ الحديث عن إمام الحرمين الحسين بن علي الطبري في المسجد الحرام عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المحدث الفقيه السلطان المجاهد عبدالله بن راشد القحطاني قرأ صحيح البخاري على الفقيه المحدث محمد بن أحمد النعمان الهجراني، وأخذ عن أبي العين وابن عساكر والمقدسي سنة 588هـ، وتولى حكم تريم إلى غربي العقاد عام 593هـ، وإليه نسب وادي حضرموت، وادي بن راشد، وخلع راشد، وتوفي السلطان الحافظ عبدالله بن راشد رحمه الله عام 616هـ، وهو مدفون في مريمة وهؤلاء وغيرهم من العلماء من فقهاء ومحدثين وأصوليين عرفتهم حضرموت، وعلى أيديهم أخذ أبناء وأحفاد المهاجر السيد أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي المذهب الشافعي السني، ومنهم الفقيه محمد بن علي باعلوي الذي كان شيخه المحدث بامروان كما ذكر ذلك الخطيب وابن عبيد الله السقاف وغيرهم.
وقال سقاف الكاف في كتابه (حضرموت عبر 14 قرنًا، صـ95- 60).
»وفي مطلع القرن السابع دخلت حضرموت الطريقة الصوفية التي أضفت صبغتها على الحضارم، وتجلت هذه الصبغة في أفكارهم وآدابهم وسلوكهم وتربيتهم، وعم حضرموت وأسفل اليمن ومهاجر الحضارم في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا – وماليزيا) وشرق إفريقيا (تنزانيا – وكينيا – وأوغندا – وجزر القمر) هذا المذهب المؤلف من فقه الشافعية وعقيدة الأشعرية والطريقة الصوفية، ومن آثار هذا المذهب تعظيمه للأولياء والصالحين والعلماء وحفظ، مكانتهم في حياتهم وبعد مماتهم، وإعطاء أهل بيت النبي مكانتهم التي حددها لهم مذهب أهل السنة والجماعة، وقررها الإمام الشافعي في مذهبه من وجوب المحبة لهم وتقديمهم في الإمامة، وعدم مكافئتهم في النكاح، فهذا المذهب ساد في حضرموت من مطلع القرن السابع الهجري إلى هذا التاريخ، وليس في حضرموت مذهب آخر لا في العقيدة ولا في الفروع غير مذهب أهل السنة والجماعة، اللهم إلا وجود لبعض أفراد ينتقدون بعض الأشياء كالكفاءة في النكاح، وتعظيم العلماء والصالحين، إلا أن مقال هؤلاء لا يعتد به في الأوساط العلمية«.
ويقلل المستشرق الباحث الكسندر كنيش في كتابه السادة في التاريخ من روايات كتبها العلويون فقال: »منذ أن انتشرت الصوفية وتعمقت في مجتمع حضرموت من منتصف القرن السابع الهجري تقريبًا، والمسألة فيها خلاف كبير؛ إذ اختلف كثيرًا في بدايات دخول التصوف حضرموت، وكذا في رواده الأوائل، كما اختلف أيضًا في بدايات دخول المذهب الشافعي وعلى يد مَنْ من العلماء، وكذا في رواده الأوائل، حيث نازع العلويون في رواياتهم التاريخية التي تدعي الريادة فيما ما كتبوه ودونوه، بعد قرون مضت من انتشار المذهب والتصوف، وفي حقيقة ما كان عليه العلويون الأوائل منذ هجرة أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي، الذي أطلق عليه العلوين بعد قرون طويلة من قدومه حضرموت (بالمهاجر) ويكتنف هذه المسائل الخلافية الكثير من الغموض«، (الكسندر كنيش السادة في التاريخ، 2006م، صـ232- 233).
ويضيف الكسندر كنيش أنَّ كُتَّابًا ومؤلفين من السادة آل باعلوي وبعض المشايخ المتعاطفين معهم حاولوا أن يبرهنوا على نظرية ريادتهم للتصوف ونشر المذهب الشافعي، غير أنهم جوبهوا بنشر روايات تاريخية خارج حضرموت تدحض تلك النظرية فقال: »إن محاولات السادة والمشايخ المتعاطفين معهم للبرهنة على أن السادة هم الرواد الصوفيون والمربون في حضرموت يشوبها الكثير من المتناقضات؛ لهذا اضطر المؤرخون المعاصرون من السادة، مثل علوي بن طاهر الحداد، وصالح الحامد العلوي، أي لي عنق الأحداث لدعم صورة التاريخ الحضرمي التي تصور بعض عائلات السادة بالمبادرين الأوائل في جميع الإصلاحات الدينية والأخلاقية في حضرموت، مما ألحق أكبر الضرر بقضية السادة هو نشر روايات تاريخية لم تكن معروفة من قبل كُتبت إما خارج حضرموت أو من قبل مؤلفين ليس لهم هدف شخصي يتعلق بالنسب (ابن سمرة الجعدي) وللرد عليها، كان على المؤرخين من السادة الذين سبق ذكرهم إراقة الكثير من الحبر لإثبات أن مؤلفي المصادر الخارجية كانوا يجهلون الأوضاع الحقيقية في حضرموت، وأن المؤلفين القريبين من حضرموت كباطحن مثلًا، منحازون ضد السادة لسبب آو لآخر…«. (الكسندر كنيش، السادة في التاريخ، 2006م، صـ232- 233).
ويقول المؤرخ السيد سقاف الكاف (ت 1417هـ): وكانت جميع المحاكم الشرعية والنظم البلدية تأخذ أحكامها من هذا المذهب، ولا يجوز للقاضي ولا غيره الخروج عن المذهب والانتقال إلى غيره مطلقًا، إلا في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي؛ حيث أدخل على نظام التشريع والقضاء مسائلَ مختارة من المذاهب الفقهية الأخرى، رأى أن المصلحة تقتضيها، وذلك سنة 1341هـ، (بتصرف: سقاف بن علي الكاف، حضرموت عبر 14 قرنًا، صـ60)، وأكد ذلك الشيخ عبدالرحمن عبدالله بكير في كتابه (القضاء في حضرموت) قال: »وفى شوال من عام 1360هـ الموافق 1941م جمعت أول مجموعة قضائية كمرجع قضائي يتجاوز حدود المعتمد من المذهب الشافعي من غير معتمد المذهب، أو غيره من المذاهب الأخرى، بل ومن غير المذاهب الثلاثة، كما فى المادة (52، 69، 77)«، (عبدالرحمن عبدالله بكير، القضاء في حضرموت، صـ82).
وعدت هذه المواد من التحسين الحديث، وأنها ذات فائدة قانونية بارزة في السلطنة.