لذة التجريب السرديّ في مجموعة (وآلامٌ أضاعتْ سَحَرَتَها) القصصية لخالد عبدالحليم العبسي
كتابات
د. طه حسين الحضرمي
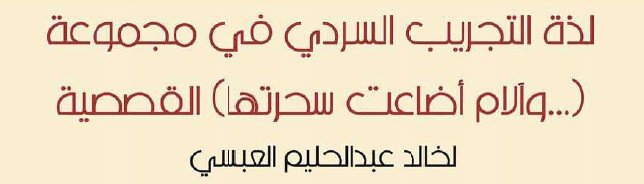
(على الكُتّاب أن يكتبوا واقفين، فإنهم حينها سيتقنون كتابة الجمل القصيرة)

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 11 .. ص 78
رابط العدد 11 : اضغط هنا
حين أسدى المبدع الساحر إرنست همنجواي نصيحته الذهبية الوجيزة السابقة إلى كُتّاب العالم جمعاء كان يضع عينه على أخص خصائص القصة القصيرة جدًّا؛ ألا وهي التكثيف اللغوي.
(1)
خالد عبدالحليم العبسي قاص يكتب القصة القصيرة جدًّا بشغف، ويهيم بصياغتها هيامًا لا حدّ له. فها هو في باكورة إنتاجه (وآلام أضاعت سَحرتها) يتلمس مضايق القصة القصيرة جدًّا في متونها النصّية تشكيلًا وتجريبًا؛ فيغمس قلمه في جمرة الإبداع ليشتعل سردًا ويضيء شعرًا.
وإذا كان أجدادنا الأقدمون يحتفلون بولادة الشاعر حين كان الشعر ديوانهم الأوحد، فحريّ بنا في زمن السرد أن نحتفي بولادة السارد. وإذا كان للشعر فتنته في زمان الوصل والانصهار في بوتقة العشق، فآن للسرد أن تكون له فتنته الخاصة المنبثقة من بوتقة الذات الساردة المتشظية في آفاق التجريب السردي، والمتماهية في فضاءات الكلمة التي تُدرَك بوصفها كلمة حسب حين تتجلّى الشعرية في متونها، والمتساوقة مع الكلمة بوصفها صنوًا لشيء مسمّى على أساس المرجعية التاريخية.
التجريب صنو الإبداع كلاهما يبحر في لجج المغامرة والاكتشاف ثم في اكتناه المجهول واقتناص اللحظة الإبداعية الشبيهة بومضات الأشواق الحرّى المتلألئة في أعماق كل مبدع أصيل؛ أينما كانت وكيفما تجلّت.
(وآلام أضاعت سَحَرتَها) متون سردية تجريبية في إطار (القصة القصيرة جدًّا) بما تحمله في أحشائها من تكثيف لغوي، وبما تخفيه في طياتها من تشكيل سردي تجريبي؛ ابتداءً من عتباتها النصية التي تضمر أكثر ما تظهر، التي تتجلّى في طرائق تشكيل أشتات؛ تمزج المرجعي بالتخيّلي، وتمتح من تواريخ (اللفظة) عبر معجماتها المتعددة (لغةً وثقافةً وأسطورةً).
(2)
تشكّل عتبات هذه المتون تحديًا سافرًا واستفزازيًا للقارىء، فيحتار في اختيار سبيله إلى كشف أسرارها تشكيلًا وبناءً؛ ولا سيما عتبتها الأساسية (العنوان الرئيس) التي يمثّل واجهة صادمة لمتونه المراوغة.
فالتركيب اللغوي للعنوان (… وآلام أضاعت سحرتها) عنوان يراوح بين البوح والسكوت، بين الانفتاح والانغلاق، بين الاكتمال والنقصان.
فـ(الواو) ها هنا استئنافية؛ تضمر في النقاط الثلاثة التي تتقدمها كلامًا لم ينقطع. والكلام المضمر في العنوان يتجلى في متون النصوص السردية اللاحقة له المكتملة طباعةً وبناءً سرديًا، والسابقة عليه تشكيلًا لغويًا مضمرًا في الوعي الكتابي. فالعنوان ها هنا مكتملٌ تركيبًا دون إظهار (الواو)؛ فهو مكوّن من مبتدأ (آلامٌ) وخبر جملة فعلية (أضاعتْ سحرتَها). وغير مكتمل بإظهار (الواو) التي تشي بعدم اكتمال البنية الدلالية القائمة على الاستئناف.
ينفتح العنوان الرئيس على متونه السردية بالتأويل لمكوناته اللغوية المتشكلة من ثلاثة دوال (آلام/ أضاعت/ سحرتها) وينغلق على نفسه بوصفه بنيةً منغلقة على ذاتها باكتمال دلالاتها المتشظية.
تمارس هذه الدوال الثلاثة حضورًا؛ دالًا ومدلولًا ولكن من خلال تشكيل لغوي مغاير بحسب سياقاته المتنوعة. فدال (آلام) يحيل على الأوجاع المصاحبة لكل مبدع حين تشتعل حرائق الأحرف متوهجةً بين أصابعه والصفحات البيضاء، وكل كتابة داءٌ -بحسب تعبير جاك دريدا- يسبب آلامًا لا حدَّ لها لمن يحترفها.
أما دال (السَّحَرة) فيحيل على اللعبة التي يمارسها الكاتب على قرائه؛ فهو يقلقهم أكثر مما يَسْحرهم. بيد أن السحر قد ينقلب على هؤلاء السحرة فيحيل ما تبقى من دموع الأحبار الصدئة آلامًا وأوجاعًا تمتص كل خلايا الأحزان المنبثقة من وهج الحروف؛ محيلةً إياها إلى ذكرى بائسة من الليالي الشحيحة بالحروف المضيئة والكريمة بالخيالات الهزيلة. لهذا كان (للضياع) حضور ملتهب في المتن. أو تُرى لهذا قيل عن الأدباء (أدركته حُرفةُ الأدب)؟!!
(3)
تمارس هذه المتون تمردًا على النمطية المطردة؛ من خلال تشكيلات سردية متعددة، تعتمد التجريب السردي مركبًا إبداعيًا لصياغتها. فالكاتب يستخدم تقنيات سردية تجريبية منبثقة من مقتضيات المتون.
تتجلى هذه المتون في صورتين تشكيليتين:
تتشكّل الصورة الأولى في نصوص موجزة، يميّز بنيتها النصية (الإلغاز). تكتنفها ثلاثُ بِنى؛ الأولى: (عنوانٌ مبهمٌ). الثانية: (متن) يتكئ على (حوار مباشر) قائم على الصورة السردية التي تتشظى بوساطتها وجهات النظر المتعددة، أو (حوار غير مباشر) يتجلى في صورة مناجاة أو في صورة حوار أحادي. الثالث: (عتبة ختامية) بمنزلة فك شفرة اللغز الكامن في المتن وعنوانه المبهم.
فالحوار على الرغم من كونه الصورة المثلى للسرد الدرامي (المسرح)، بيد أنه ها هنا يُبرز بمعية (العتبتين الأولى والختامية) سردًا مكتنزًا بكل المكونات السردية: (الراوي) الذي يظهر في العتبتين بوصفه موجهًا لمسيرة الدلالة للمتن، بينما هو في عداد المضمر في بنية هذه المتون التي تتجلى فيها أصواتُ الشخصيات السردية معبرةً عن وجهات نظرها؛ بمنأى عن سطوة الراوي السردية. ويميز هذه الصورة أن اللغة فيها تنصهر حتى تغدو كتلةً من لهب شعري.
أما الصورة الثانية فيميّزها موقعُ العنوان الذي يأتي في ختام المتن، وكأن الكاتب يستحضر كتابيًا الوضعَ الأصلي للعنوان بوصفه -في الغالب الأعم- آخر ما يكتبه الكاتب، وبهذا لا يكون عتبةً تقع عليها عينُ القارئ.
والكاتب يمارس هذه اللعبة التقنية بوعي تام؛ لأنه ينبه القارئ بطرف خفي إلى ضوابط هذه اللعبة، ففي الفهرس يبرز عنوانات الصورة الأولى بالتسويد في حين يدع عنوانات الصورة الثانية دون تسويد. ويميّز هذه الصورة من المتون (الإبهامُ) الذي يحتاج إلى إنعام نظر وإطالة فكر.
وقد يلجأ الكاتب إلى استخدام تقنيات الحاسوب الكتابية. ففي قصة (قلق لا يُجدي) يستخدم بعض تقنيات (وورد 2010م) بإيراد المتن على شكل أسطر متداخلة أشبه بحركة الحيوانات المنوية وهي تسعى إلى اختراق البويضة.
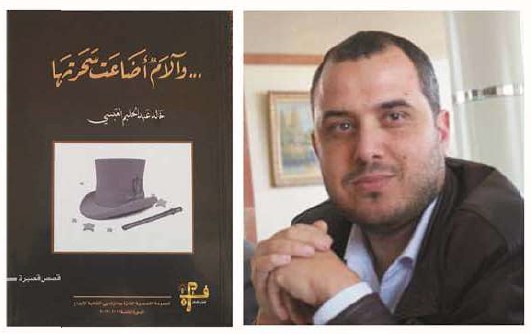
(4)
يسعى الكاتب في هذه المتون إلى ابتكار عوالم تخيليّة غرائبية تتأرجح فيها المرجعية بين المعقول واللامعقول؛ كأن يجري حوارًا بين حفرتين فارغتين في انتظار حيازة لقب (قبر) في قصة (ظل ميت) أو يجري حوارًا بين شاتين (جلحاء وقرناء) في قصة (خوف أشد وخوف) موظفًا أنسنة الأشياء والحيوانات في بنائها.
أو يجري حديثًا انفراديًا أشبه بالمونولوج الداخلي لفزاعة الحقول؛ مبحرًا في أعماقها؛ معتصرًا آلامها ووحدتها مستحضرًا في الأعماق قصائد العقاد في استبطان الأشياء الجامدة وأنسنتها في ديوان (عابر سبيل). وقد يقوم باستنطاق الظلم الذي يشكو من الظلم في قصة (حق). كما يجري حوارًا مثيرًا بين حيوانات منوية تتناقل شائعات عن العالم الخارجي في قصة (قلق لا يجدي).
يبتكر الكاتب عالمًا غير مرئيّ لكائن في عداد المعدوم في قصة (أرنبٌ أضاع ساحره). ويعطي حياة لسلك شائك ضاق ذرعًا بوظيفته الموجعة في انتظار توظيف آخر له في قصة (أي شيء).
وفي قصة (هاوية مغرورة لم تُجرّب الحب) يوغل الكاتب في استنطاق الهوية الإبداعية التي تشكّل مرتكزًا للكتابة بوصفها صورة مرسومة من جهة، وتعبيرًا وجدانيًا من جهة أخرى؛ مستخدمًا فيها وسائل التضافر النصي المتحركة من الخارج (كازنتزاكي/ أدونيس) إلى الداخل (خالد عبدالحليم) عبر فانتازيا حلمية.
يحاول الكاتب من الاقتراب بحذر تجاه قضايا إشكالية؛ مثيرًا حولها زوبعة من غبار التلاعب اللفظي كما نرى ذلك في قصة (خوف أشد وخوف) مستحضرًا النص الغائب المتمثل في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة »لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ«، في إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى كمال العدل والقصاص في الإسلام. في حين أن القصة تبحر في آفاق أخرى يُفهم منها ضمنًا عدم اقتناع (الشاة القرناء) بعدالة القول السابق في صورة استفهام استنكاري. ومثل ذلك في قصة (غفوة على حائط) وقصة (حضارة).
(5)
خالد عبدالحليم العبسي كاتب واع بما يكتب متسلِّح بثقافة متعددة الاتجاهات، متنوعة المشارب، يحتاج القارىء -للولوج إلى مكامن عبقريته- إلى أدوات اكتساح غير عادية. وهو هنا في باكورة متونه السردية التجريبية يضعنا على تخوم فضاءات سردية تسبح فيها آمالٌ وأحلام بغَدٍ مشرقٍ لسرد يمنيّ أمثل.