نقد
أ.د. عبدالله حسين البار
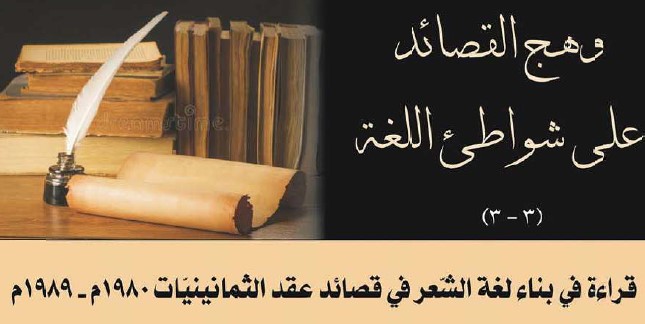
الابتداء والانتهاء في قصائده:
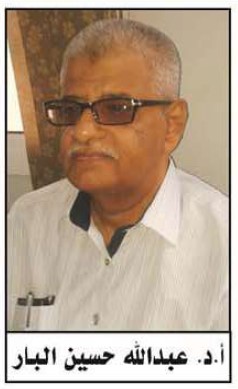
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 11 .. ص 89
رابط العدد 11 : اضغط هنا
»الشعر قفلٌ أوّله مفتاحه«، هكذا قال ابن رشيق في عمدته، وعلّل ذلك بأنّ »حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطيّة النجاح«، ممّا اقتضى منه أن يلزم الشاعر به، فقال: »وينبغي للشاعر أن يجوّد ابتداء شعره فإنّه أوّل ما يقرع السمع، وبه يستدلّ على ما عنده من أوّل وهلةٍ«. وكما اعتنى بالحديث عن المبتدأ لم يخلُ كتابه من عنايةٍ بالمنتهى، فذهب إلى أنّ الانتهاء قفلٌ على الشعر مثلما أوّله مفتاحه. قال: »وإذا كان أوّل الشعر مفتاحًا له وجب أن يكون الآخر قفلًا عليه«.
وهذه صورةٌ من اهتمام علماء البلاغة بهذا المكوّن الشعريّ، وإذا كانوا قد حرصوا على التقعيد للشعراء والإبانة عمّا ينبغي لهم أن يصنعوه حتّى تبلغ قصائدهم ذروة الحسن، فإن صنيعنا هنا استكشاف ما يميّز طرائق الشقّاع في ابتداء شعره وانتهائه عن سواه من الشعراء، فإنّ لكلِ شاعر طرائقه في استفتاح قصائد شعره واختتامها بما يميّزه من سواه.
والحقّ أنّ الشقّاع وإن امتاز من شعراء جيله في طرائق ابتداء القصيدة وانتهائها فإنّ صنيعه فيهما يشي بصلةٍ مّا بما في شعر شاعرين كبيرين من طرائق ابتداءٍ وانتهاءٍ في قصائدهما، وهما نزار قبّاني من جهةٍ، وعبدالله البردّونيّ من جهةٍ أخرى، وهي صلةٌ تركت أثرًا ملحوظًا على طرائقه في طريقة ابتداء القصيدة وانتهائها.
وبعيدًا عن كون هذه الصلة ترسّمًا للخطى أو تناصّ مع التقنية فإنّ ممّا لا يستطاع تجاوزه أنّ لقصائد الشقّاع ابتداءاتٍ وانتهاءاتٍ تعدّ طرائقه في تشكيلها خصيصةً من خصائص أسلوب شعره، تميّزه من شعر سواه.
فهو يستفتح شعره بالتشبيه:
كما تومض الأنجم الساهدة أناديك لكن بلا فائدة
ويستفتحه بالتعليل:
لأنّ خيالها ليلا يوافي أبيت على فراشٍ من قوافي
ويستفتحه بالتحيّة:
صباحَ الخير يا غيري الذي سمّيته نفسي
مساءَ الخير يا شهدي ويا ترنيمةَ الوردِ
ويستفتحه بمتعلّق الفعل الذي لا يظهر في البيت الأوّل، فيتضمّن البيت الثاني؛ لظهور الفعل في أوّله:
لحبيبٍ مثل وجه الصبح أبلج لغرامٍ أحزن القلب وأبهج
أجمع الآن لظى تجربتي كي أصوغ الحبّ أسلوبًا ومنهج
ويستفتحه بحرف العطف (الواو)، ثم يتبعه بفعلٍ مضارعٍ، متلوٍّ باستفهام:
وتسألني من أنا؟ فاطمة أنا…
ويستفتحه بمكوّناتٍ من الإنشاء أمرًا، ونهيًا، واستفهامًا، ونداءً. فمن الأمر:
دعيني لشحذ المعاني دعيني لهذا الغناء الذي يحتويني
ومن النهي الذي يتلوه نداء ثم أمر:
لا تقابلني بقلبٍ منفتح أيّها الوقت أرحني واسترح
ومن الاستفهام الذي يتلوه نداء ثم أمر:
أيّ شيءٍ لديك غير الأماني يا حنان اذهبي دعيني أعاني
ومن النداء الذي يتلوه أمر:
أيّها النائم في حضن الجبل أعط للنائي عناوين الأمل
وهنا تختلط مكوّنات الإنشاء أمرًا ونهيًا واستفهامًا ونداءً كما اجتمعت في أشباه لها، من مثل قوله:
هل أشبّ الغرام كي تفهميني أنتِ يا ربّة الجمال الحزينِ؟
وقوله:
ساعديني على النوى يا أمينة قلق اليوم فوق ما تعهدينه
واجتماعها في بيتٍ من الشعر يمنحه حركةً تشي بقلقٍ داخليّ، ولا تُخليه من نغم مرتفعٍ لا يخفى على أذن واعية.
واللافت على قصيدة الشقّاع أنّها تأبّت في ابتداءاتها على تقعيد علماء البلاغة للابتداء حين عيّنوا (حقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود من هذا الكلام)، وإنّما تحقّق لها ذلك من جهة كون بنيتها الدلالية تتكوّن من خلال العلاقات التي تنشأ بين الدوالّ، وليس من نظم معنًى مقصود، أو فكرة مبتغاة، ومن هنا لم يعد للحديث عن مناسبة النصّ مقام، ولم يعد كافيًا الوقوف على مطلع القصيدة لتدرك مقصودها. فهي إبحار في بواطن الذات، أو تحليق في عوالم اللغة؛ لتشكيل صورة العالم على نحو غير الذي ألف. بل إنّ الوقوف على المطلع أو البيت المبدوءة به القصيدة قد يفضي إلى غير ما قصد إليه النصّ حين يقتصر المتلقّي عليه. وخذ على ذلك مثلًا قول الشقّاع من قصيدةٍ:
لو يقول الليل شيئًا لو يقولْ آه كم أشتاق للفظ البتولْ
هنا تتمنّى الذات المتكلّمة أن يصلها من الليل قولٌ يبهج، أو يبعث الأمل في أعماقها فيُخليها من اليأس، أو يجعلها تحيط علمًا بالمجهول فتعي أبعاده… إلى آخر ما هنالك من ذلك. وهي تكشف عن حنين طاغٍ -يدلّك عليه استخدام اسم الفعل آه وهو للتوجّع، وكم التي للتكثير- للفظ النقيّ من شوائب الزيف، والتدليس، والكذب. لكن هل في هذا ما يشي بما سيتلوه من دلالات تتشكّل من خلال علاقات الدوالّ بعضها ببعض؟
هل فيه ما يبين عن (معنى مقصود)؟ أو أنّ فيه دلالةً تتنامى مع حركة النصّ؟
لقد بُنيت القصيدة في إطار ثلاث دوائر، تتنوّع اتّساعًا وعمقًا. فالدائرة الأولى هي دائرة الذات، وفيها يعرض المتكلّم الذات حائرةً في تناقضاتها، ومنهكة من قلقها، ومستغرقة في أمانيها؛ لتتكشّف أمامها خيبة تقود أحلامها وأشواقها إلى واقعٍ شائهٍ وذميمٍ. فتفرّ منه إلى واقعٍ أوسع، يتمثّل في دائرة الانتماء القوميّ، فإذا بصور التردي، تشمل واقعه، وقد غدا (المعراج -وهو الصعود إلى السماوات العلى- غوصًا في الوحول)، فلم يبق لها إلا ما يمكن أن يكون خلاصًا، وهو دائرة الانتماء إلى الوطن، ففيه الوجود الحر،ّ والخلود الدائم، والهوى غير المنقطع:
لي بلادٌ جرحها من لهبٍ وخلاياها ملايين الفصولْ
تتلقاني بعمرٍ خالدٍ أتلقّاها بعمرٍ لا يطولْ
غير أنّي في هواها سائرٌ وسأفنى بين سيري والوصولْ
فهل كشفت البدايات عن هذه النهايات؟ هل في مطلع القصيدة ما يشي بما تناسل في جنباتها من دلالات متنوّعة؟ وإنّما جاء الأمر على هذه الصورة بسببٍ من انزياح قصيدة الشقّاع عن تقعيد البلاغيّين الأوائل؛ ليصنع نصّه بلاغته كما شاء وشاء له العصر وقوانين الإبداع فيه.
وفي شعر الشقّاع تتخذ الابتداءات صورًا متقابلة، فتارةً يتماهى الابتداء مع العنوان فتكون مداخل القصيدة واضحة المعنى، مدركة الدلالة كما في قصيدته (العائد)، وهو يفتتحها بقوله:
يعود بأقماره الساهدة يهزّ مدينته الراقدة
يرتّل مأساته في الظلام ويطلق أشواقه العائدة
وهنا يأتلف المتلقّي مع منطوق النصّ دون أن يعيا بإدراك مقصده، والوعي بمغزاه.
وتارةً ينفصل الابتداء عن العنوان، ويوغل الابتداء في حالٍ من اللبس، ومن انفتاح الدلالة من حيث صلاحه؛ ليكون تعبيرًا عن أشتاتٍ من الحالات النفسيّة والفكريّة كما في قصيدته (شيءٌ لا يرى)، وهو يفتتحها بقوله:
كان المساء على الرصيف مبعثرا والذكريات كواكبًا أو أبحرا
فهذا مطلعٌ لا يمسّ جوهر التجربة في النصّ، وإنّما هو إطارٌ زمانيّ ومكانيّ، يصلح لأن يشتمل على مواقف متنوّعة من الوطن والأمة، أو استبطان الذات، والكشف عن موجعاتها وتسلياتها.
والشقّاع يوائم بين الصورتين في ابتداءات قصائده، ولعلّ لطبيعة التجربة، وإحاطة المبدع بها، وتمكّنه من تشكيل أبعادها، يدًا في تخيّر هذه الطريقة في الابتداء أو تلك.
ومثل الحديث عن الابتداء في شعر الشقّاع هناك حديثٌ عن الانتهاء فيه.
والانتهاءات في قصائده متنوّعة، فمنها ما يجيء متناميًا عضويًا من ثنايا القصيدة، ومتّحدًا مع ما سلف من أبياتها كما نجد في قصيدته (النّائي). حيث يختتمها بقوله:
وأبثُّ في قلب الجميع محبّةً خضراء للأحباب والأعداءِ
وذلك بعد أن جلّى صورةً إنسانيّةً للذات المتكلّمة التي تشعر بالانتماء للآخرين، حتّى كأنّ كلّ الورى أشلاؤها:
وأحسُّ أنّي في الجسوم ممزّقٌ فكأنّما كلّ الورى أشلائي
ومن هنا كان حنينٌ في الأعماق إلى طاقةٍ تمتلكها هذه الذات؛ لتتمكّن من تحقيق كلّ الرغبات والأمنيات:
أبدًا أحنّ إلى اكتمالٍ نافذٍ ليسير هذا الكون تحت حذائي
فتكون كلّ رغائبي قد حُقّقت ويكون حبّ الناس من إيحائي
ثمّ تختم القصيدة بالبيت المذكور أعلاه، وكأنّه منبثقٌ من ثنايا تلك الأبيات التي سبقته في الموضع في القصيدة.
ومنها ما يجيء في صورة (بيت القصيد)، أو (البيت الذروة)، الذي لا ينفصل عن الجزئيّات المكوّنة لكيان القصيدة، كما نجد في قصيدته (المحبوبة)؛ حيث تتجلّى صورة المحبوبة حسًّا ومعنًى وقدرةً على التغيير، وإبداع الأحلام، وتخطّي تفاهات العصر إلى شوامخ التاريخ، وتجاوز حدود المكان للانسراح في فضاءاته الشاسعة، ثمّ من ثنايا هذا كلّه تنبثق الذات المتكلّمة؛ لتؤكّد وجودها أمام شموخ المحبوبة، وسموّ مقامها، لكن على نحو لا يأذن بالتقليل من شأن صورة المحبوبة، أو وضعها مع الذات في مقام التقابل الضدّيّ، وهنا تسعف الصورة المكثّفة في تحقيق المبتغى، وبها تختتم القصيدة في بيت جامع دال، هو قوله:
“عنتر” يشعل حربًا كي يلاقي وجه “عبلة”
وإن عبلة لتستحقّ، وإنّ عنترة لجديرٌ.
ومنها ما يجيء في (بنية الاقتضاب). وهنا تختتم القصيدة ببيتٍ مقتضبٍ، يتجلّى وحيدًا منفردًا عن بقيّة أبياتها، ولذلك يلجأ الشاعر إلى وضع ثلاث نجماتٍ قبله؛ ليؤكّد عزله عن الأبيات التي سبقته، ويكون جامعًا في دلالته، محكمًا في نسيجه، أدنى ما يكون صلةً ببيت القصيد الذي أشرنا إلي بعض صوره فيما سلف.
ومن القصائد التي خُتِمَتْ ببيتٍ مقتضبٍ قصيدةُ (غير الزمان)، وفيها تصوير لتقلّبات الزمان بين المتضادّات.
قديمٌ فرّ وولّى مهزومًا يعود منتصرًا ويهيمن على الحاضر المعيش.
تافهٌ محتقرٌ مزدرى يغدو الظافر المتحكّم في مجريات الأمور.
والمدينة تتغيّر ألوانها، ويغدو اللهو فلسفة الجدّ، وتستحيل الحياة موتًا لعدم الاستطاعة على فعل شيءٍ.
صورٌ تتوالى، والقصيدة غير قابلةٍ لانتهاءٍ، ولا بدَّ لها من ذلك. فعمد الإبداع إلى وضع ثلاث نجماتٍ لا للانتقال إلى بُعدٍ جديدٍ من أبعاد القصيدة، ولكن ليختمها ببيتٍ جامعٍ دالّ، هو قوله:
بلدٌ جاء من دماء الضّحايا ثمّ أغفى على نهود الغواني
ليظلّ رنينه متواصلا في أذن سامعه الواعية.
وقريبٌ من ذلك صنيعه في قصيدة (اللحن الأخير)؛ حيث تناجي الذات المتكلّمة في النصّ أخرى، وتبين لها عمّا اعتراها من تغيّر في الحال غدت به غير من كانت، وتحوّلت بها علاقاتها بالمكان والإنسان، واستحال كلّ شيءٍ إلى ضدّه ونقيضه.
الصّداقات عداءٌ كامنٌ والهوى يأخذ شكلا مستديرا
والمسرّاتُ خطًى عابرةٌ لحستها بعدنا أمواجُ صيرا
إنّني أصبحتُ شخصًا آخرًا قد تغيّرتُ تغيّرت كثيرا
وهو قولٌ مجملٌ قابلٌ لتفصيلات كثيرةٍ، لكنّ النصّ يُقْتَضَبُ، وتظهر النجمات الثلاث ليجيء بعدها قوله مختتمًا به النصّ في بنية الاقتضاب:
هاتفٌ بالباب يستعجلني فدعيني أعزف اللحن الأخيرا
وهو بيت القصيد. ولعلّ هذا البيت وأمثاله علّة إنشاء القصيدة وسببه، فمنه ينطلق القول، وإليه يساق الحديث.
ومع ذلك فإنّ اختتام القصيدة ببيتٍ مقتضبٍ في شعر الشقّاع يكون جامعًا للدلالة، محكمًا في نسيجه تقنيةٌ اقتنصها من طرائق شاعرين كبيرين في العصر الحديث، هما (نزار قباني) من سورية، و(عبدالله البردّونيّ) من اليمن. وللقارئ أن يتأمّل في قصائد نزار (غرناطة/ إلى تلميذة/ بيروت والحبّ والمطر…)، وقصائد البردّونيّ (زمان بلا نوعيّة/ بين جدارين/ ساعة نقاش مع طالبة العنوان…). وليس في صنيع الشقّاع ما يضير، فلكم يقع الحافر على الحافر لا في المعاني كما كانوا يقولون، ولكنّها كائنةٌ أيضًا في استخدام التقنية وتوظيفها في النصّ.
التحجيل:
وهو ذو صلةٍ باختتام القصيدة من حيث وروده في نهايات أبياتها، والمقصود به تذييل أواخر القصيدة ببيتٍ محلّى بحكمةٍ تبدو تلخيصًا للتجربة كلّها. والحكمة في الشعر بنية فكريّة تسمح بخلق تكامل في القصيدة بين اندفاق البثّ الوجدانيّ والتّأمّل العقليّ فيها، بما يزيد خطابها عمقًا وشفافية وتخييلا متنوّعًا متلوّنًا.
وقد عرفه حازم القرطاجنّيّ، وأشار إليه في (المنهاج)، وأدرك بعض شعراء الحداثة شأنه، فوظّفه في شعره، وحسبك بمحمود درويش مثلًا، وظهر في شعر الشقّاع، فجاء في مختتم قصائد من قصائده، كما في قوله من قصيدة (خطوات مرثيّة):
وحبيبة وعدت ولكنّ الهوى ولّى وإحباطي كعادته مقيمْ
قتل الزمان بقلب خلٍّ خلَّه فحبيبتي ثكلى وشاعرها يتيمْ
ومنه قوله في خاتمة قصيدة (شيءٌ لا يُرى):
قد يكشف المجهول عن أسراره لكن يظلّ هناك شيءٌ لا يرى
وليس ببعيدٍ عنه قوله في قصيدة (وجد):
فإن منعت أو استعصت قليلا فبعض الشّعر يحسن بالزحافِ
وجميعها منبثق من ثنايا التجربة، وملتحم بنسيج النصّ. وليس الوقوف على هذا ونظائره إلا رغبة في توكيد منزع الشقّاع في تجويد لغة شعره، وإحكام بنائه بنيةً ونسيجًا، رؤيةً وأداءً.
وإنّ من الممكن الوقوف هنا، والاكتفاء بما تقدّم لولا أنّ في النفس رغبةً للحديث عن مستويين من مستويات الكلام، أوّلهما:
في إيقاع عَروض النصّ:
أدري أنّ مِنَ الكاتبين مَنْ يخصّ مصطلح الإيقاع بما تعارف عليه دارسو الشعر ونقّاده بـ(الموسيقا الدّاخليّة) بكلّ صورها، لينأوا بالوزن العَروضيّ عن ذلك المصطلح؛ بحجّة أنّه (موسيقا خارجيّة)، وليس هذا بصوابٍ، فليس في القصيدة ما هو (خارجٌ عنها)، وإنّما كلّ شيءٍ داخلٌ فيها حتّى الوزن العروضيّ.
سيقول قائلٌ: ولكن الأوزان وصلتنا جاهزةً، وما على الشّاعر إلا تخيّر ما شاء منها لينظم ما يروم.
وذلك حقٌّ، لكنّه يحتاج إلى قليلٍ من التشذيب والتهذيب، فكون الوزن سابقًا على كون القصيدة فأمرٌ واقعٌ، وقولٌ صحيحٌ. ولكنّ الشّاعر لا يستعمله كما وصل إليه، وإنّما هو يمزجه بتراكيب بنيته اللغويّة، التي يشكّل منها كيان القصيدة، فيعيد تشكيل الوزن، كما يعيد تشكيل البنية البيانيّة، وتراكيب الكلام خبرًا وإنشاءً. فسبق الوزن في الوجود لا يعني أنّه قالبٌ يستخدمه الشّاعر كما هو، وإنّما هو يعيد صياغته على أنحاءٍ تشي بتفاعله مع مكوّناته؛ ليتلاءم مع مقاصده من الكلام. ولهذا قلنا بالتمييز بين (عَروض اللسان)، و(عَروض النصّ).
ولقد حرّرنا فيما سلف هذه المسألة في الفقرة الثانية من هذه البوّابة، فلينظر في مظانّه، فهي ممّا لا يشغلنا هنا، وإن ما يشغلنا هو كيفيّة انتظام الإيقاع العَروضيّ في شعر الشقّاع وما تميّز به من سواه، وتجلّيات بصمته الأسلوبيّة في قصائد هذه المرحلة من تاريخه الإبداعيّ.
نظم الشقّاع القصيدة في بحر واحد وقافية واحدةٍ، فلم يؤثر عنه مسمّطة ولا موشّحة، ولا صاغ القصيدة في نظام (الدو – بيت) في شكله المتطوّر عند جماعة الرومنسيّين، فاقتصر على بناء القصيدة كما عرفتها الأجيال منذ الجاهليّة حتّى يوم الناس هذا. وهو ما يضع المتلقّي في إطار أفق انتظارٍ، يألف المبدَع الآتي فلا ينزلق إلى خيبة توقّع للمنتظر المألوف. فهو حين يقول:
لأنّ خيالها ليلا يوافي أبيتُ على فراشٍ من قوافي
يدرك المتلقّي أنّ القصيدة من بحرٍ، ولها قافيةٌ وحرفُ رويٍّ واحدٍ، فذاك ممّا ألفه في أشباهها من قصائد وصلته عبر أدوار تاريخ الإبداع الشعريّ عند العرب. وقل مثل هذا وسواه في كلّ قصائده. لكنّ المضيّ في قراءة القصيدة -أيًّا كان عصرها- تثير في النفس أسئلةً:
هل نظم الشّاعر الجاهليّ قصيدته على النحو الذي قعّد له العَروضيّون، أبياتٌ متوالية يتكوّن كلّ بيتٍ منها من شطرين صدرٍ وعجز، وللصدر حشوٌ وعَروض، وللعجز حشوٌ وضربٌ؟
أو أنّه ندّ عن ذلك إلى سواه ولم يقف على سرّه أهل العَروض؟
أَوَلَمْ يكن الشّعر إنشادًا قبل أن يكون قراءةَ مكتوبٍ ومدوّنٍ؟
أَوَلَيْسَ لهذا الإنشاد أثرٌ في صياغة البيت؟
أَنَحْسبُ أنْ الشّنفرى حين أنشد قوله:
ولي دونكم أهلون سِيدٌ عملّسٌ وأرقطُ زُهلولٌ وعرفاء جيألُ
هم الأهلُ لا مستودع السرّ ذائعٌ لديهم ولا الجاني بما جرّ يُخذل
أنشده على هذا النحو المكتوب؟
أو أنّه أنشده على نحوٍ من هذا الفضاء الطباعيّ:
ولي دونكم أهلون:
سِيدٌ عملّسٌ
وأرقطُ زُهلولٌ
وعرفاءُ جيألُ
هم الأهلُ
لا مستودع السّرِّ ذائعٌ لديهم
ولا الجاني بما جرَّ يُخذلُ؟
وهذا هو (التشعيب) كما ذكر علماء البديعيّات. وهم يعنون به اتّصال معنى الكلام في البيت الشعريّ دون خضوعٍ لسلطة الوزن، فينتقل جزء من أوّل الشطر الثاني إلى الشطر الأوّل منه، وذلك لتستقيم الدلالة وإن اختلّ وزنه عند إنشاده. وهو يمنح النصّ طلاوة إيقاعيّة، ويشكّله وفق المعنى الذي يقصد إليه الشاعر، فينساق وراء دلالة الجملة ولا غير. وهو تشكيلٌ يقرب ممّا يصنعه شعراء التفعيلة حين يستخدمون (شكل الجملة الشعريّة) عند صياغتهم لقصيدة التفعيلة.
وفي التشعيب يتلاشى من أبيات القصيدة توازيها على المستوى الرأسيّ، وتقابلها على المستوى الأفقيّ، فيتشظّى الوزن محتكمًا إلى المعنى المقصود والدلالة المنشودة.
وقد نهج الشقّاع في شعره ذلك النهج، فتشكّلت أبيات قصائده على هيئات متنوّعة وإن انتظمها بحر واحد. فهو يقول من بحر الرمل:
هذه الأشجار في تجربتي
نشوتي الأولى
وأسراري الحميمة
وعليَّ الآن أن أسألها
ألقًا
يمضي مع الشمس القديمة
ربّما
ذات مساءٍ
جئتُ من طهرها العاتي
إلى الدور الأثيمة
كم تفجّرتُ على أغصانها
بطلا يبدأ مشوار الهزيمة
لفضاءٍ دمويٍّ
أنتمي
جثّتي للمنتهى
أحلى وليمة…
هنا لا تنتظم القصيدة في نظام الشطرين، ولكنّها تتوزّع على الأسطر وفق المعنى الذي يقصده، والذي يتحكّم فيه الإنشاد وإلقاء النصّ. فيعيد الملفوظ شفاهيًّا هندسة المدوّن كتابيًّا وإن انتظم النصّ فيه أوّل مرّة.
وهذا استخدامٌ للبحر يختلف عن استخدامه في قوله من قصيدة (موّال بحريّ):
هل أعيد الفصلَ من أوّله؟
بدأ السأْم ضئيلا وتدرّجْ
أكتب اليوم انحداري
قلقًا
هذه عشرون عامًا
تتدحرجْ
قلقي أجملُ طيرٍ
في دمي
بالقوافي البكر
والرؤيا
تزوّجْ.
وفي هذا ما ينفي مسألتين:
– نمطيّة إيقاع الوزن في قصيدة البحر.
– السيمتريّة التي وُصِمَت بها أبيات تلك القصيدة.
وقريبٌ منه قوله من بحر الخفيف:
إنّه الحزن
حيث أصبح
أمسى
أبحر الحزن في فؤادي
وأرسى
كلّ حلمٍ رسمتُه
صار وهمًا
كلّ سعدٍ رجوتُه
صار نحسا
كلّما أطلع الهوى شمسَ أنثى في سماء الفؤاد
أطفأ شمسا
فالغرام القديم
حلوٌ وقاسٍ
والغرام الجديد
أحلى
وأقسى
وهنا تتحوّل الموازنة التي نجدها في البيت الثاني إلى تشريعٍ نبع من الالتزام بتقفية في ثنايا البيت (رسمته/ رجوته)، وفيها ما يزيد الإيقاع جلاءً في النفس على الرغم من همسه وخفوت نغمته.
ولعلّ هذا التشعيب يتجلّى بصورةٍ واضحةٍ في قوله من البحر الكامل:
وحبيبة وعدت
ولكنّ الهوى ولّى
وإحباطي كعادته قديمْ
قتل الزمان بقلبِ كلٍّ خلَّه
فحبيبتي ثكلى
وشاعرها يتيمْ
وهنا يميل فضاء المكتوب مع ميلان الشاعر في قوله عند الإنشاد:
وإحباطي كعادته قديم.
يتراسل مع هذا الاستخدام تطابق تفعيلات البحر مع مفردات النصّ، وهنا تتراسل الوحدة الوزنيّة مع اللغة، فتستقلّ المفردة بالتفعيلة دون أن تشركها فيها مفردةٌ أخرى. ومن ذلك ما يجيء في موضع القافية؛ حيث جاءت مفردات متراسلة مع تفعيلات بحرها، كما في قوله:
أحسّ أنّي في الجسوم ممزّقٌ فكأنّما كلّ الورى أشلائي
فتكون كلّ رغائبي قد حقّقت ويكون حبّ الناس من إيحائي
يعود الأمس منهمرًا كأشعارٍ نواسيّة
ويزرعني هوى حقّات أو نجوى قلنسيّة
له لفظٌ مسيحيٌّ وأفكارٌ مجوسيّة
أمتصّ غربة عالم متوجّعٍ وأذوق خيبة عالمٍ متوتّرِ
شكّلتني مدينتي ذات حلمٍ شفقً أزرقًا هوًى أرجواني
تارةً أشرب كوبي باسمًا وعلى صدري حمامٌ منشرحْ
ومرارًا من طريقي صائحًا أذبح الصمت بصوتٍ منذبحْ
أقبلت تجربتي عاصفةً تلك أيّامي غبارٌ مكتسحْ
ولن يخطئ المتلقّي ما تنضح به قوافي الأبيات الثلاثة الأولى من قصيدته (عند المحطّة) من تطابق بين الوحدة الوزنيّة والمفردات الموضوعة في موضع القافية. وهي:
صباح تفتّح فيه الشجون فعند المحطّة وجهٌ حنونْ
أحبّ الحبيبات يومي شذًا وخطوي غناءٌ ودربي غصونْ
محطّتها وحدها لم تخن وكلّ المحطّات صارت تخونْ
ولقد يجيء التطابق بين الوحدة الوزنيّة واللغة في حشو الأبيات، ممّا يحدث خرقًا للمألوف من استخدام البحر؛ حيث الأصل أن تتوزّع تفعيلاته، وتتشظّى مكوّناته وفق تركيب الكلام ومفرداته، فتتقاطع المفردات والتفعيلات معًا. قال:
حريقٌ/ إزائي/ حريقٌ/ معي تمرّ الحرائق بيني وبيني
فهذا/ غباري/ وهذا/ دمي وهذا/ بريقي/ وهذا/ رنيني
أيا حضرميّةُ همّي بعيد/ٌ بعيدٌ/ وخطوي/ قصير/ٌ قصيرْ
أأشكو سواي و اشكو الأنا كلانا كسرنا كلانا الكسيرْ
مختالةٌ كمنارة المحضار تشهر أصلها
شناعاتٌ مواظبةٌ على تأليفها الأشنع
يتمطّى كالأفاعي في الضحى وله في الليل صيحات المغولْ
… إلى ما هنالك من ذلك.
ولقد رأيتُ الشقّاع لا يوالي بين حرفي المدّ (الواو والياء) في قوافيه المردوفة بواحدٍ منهما على الرغم من إجازة أهل العَروض ذلك، والتزام أكثر الشعراء به ما خلا أقلّهم كابن الروميّ، وأبي العلاء في الأوّلين، وعبدالله البردّونيّ في الآخرين. ومضى الشقّاع في طريقهم مخالفًا ما أجازه عَروض اللسان للشعراء.
فإذا جاء (الواو) ردفًا في قافية البيت التزم به ولم يوالِ بينه وبين (الياء)، ويفعل مثل ذلك لو جاء (الياء) ردفًا لقافية القصيدة. يستوي في ذلك أن تكون القافية مطلقة أو مقيّدةً.
وهو يكثر من استخدام (الياء) ردفًا بقوافي قصائده –بلغ عدد القصائد المردوفة بالياء اثنتي عشرة، بنسبة 71%، في حين بلغ عدد القصائد المردوفة بالواو خمسًا ولا غير، بنسبة 29%- ولعلّ لملاءمة (الياء) -وهو صوتٌ حادّ- لموقف الحزن والانكسار والأسى التي تجلّت في لغة أشعاره صلةً بذلك الميل إلى استخدام الياء ردفًا دون الواو.
ولقد جاءت قوافيه مطلقة في بعض المظانّ، واستخدم مجرى الضمّة لحرف رويّ قصيدةٍ واحدةٍ لم يتكرّر، وهي قصيدة (هواها)، لكنّه استخدم الفتحة مجرى لرويّ سبع قصائد هي: (إنّه الحزن/ شيءٌ لا يرى/ نهار/ حضرميّة/ المحبوبة/ اللحن الأخير/ المساء)، لكنّه استخدم الكسرة مجرى لرويّ اثنتي عشرة قصيدةً، هي: (النائي/ وجد/ أن تذكري/ غير الزمان/ التفّاحة/ طقوس النار والأحجار/ نوّار وأحجار الصِّبا/ ليس حنيني/ الهروب/ سمرقنديّة/ حصار/ الانهمار الذي سوف يأتي)، وهو استخدامٌ لا يبعد عن استخدامه الياء ردفًا لقوافي قصائده كما سلف، وليس تعليله هنا ببعيدٍ عن تعليله هناك.
على أنّ له في استخدامه القوافي المقيّدة المجرّدة من الردف والتّأسيس طرائق تشكيلٍ يوحّد نغمها لا على مستوى الرويّ وحسب، ولكن على مستوى التوجيه، وهو حركة ما قبل الرويّ المقيّد. فإذا كان شعراء العربيّة يوالون بين حركات الإعراب الثلاث: فتحة، وكسرة، وضمّة في التوجيه، فهو يلتزم إحداها من أوّل بيتٍ في القصيدة حتّى منتهاها، وذاك صنيع ابن الروميّ، وأبي العلاء، والبردّونيّ، وعلى خطاهم مضى. فإذا قال:
أيُّها النائم في حضن الجبَلْ أعطِ للنائي عناوين الأمَلْ
وجاءت الفتحة توجيهًا للقافية، سارت بقية قوافي الأبيات على ذلك النسيج، فلا تخرج عليه.
وإذا قال:
استبدّت هندُ يا قلب اتّئدْ بُدِّل العجز بعجزٍ مستبِّدْ
وجاءت الكسرة توجيهًا للقافية سارت عليه البقيّة الباقية من قوافي القصيدة، ولم تندّ عنه قطّ.
وهو يلتزم ذلك في (الإشباع)، وهو حركة الدخيل في القوافي المؤسّسة، كما في قوله:
أتعدِّدين لي المناقبْ إنّ الذي تعنين غائب
وهنا يلتزم الكسرة (إشباعًا) لحرف الدخيل الواقع بين ألف المدّ وحرف الرويّ المقيّد من أوّل القصيدة حتّى آخرها.
أو تعجبين من انكساري في متاهات الغياهب؟
أو تسألين عن الهوى النَّاري.. عن عشب الغرائب؟
اليوم: تمجيد الحصى.. اليوم: تأليه الطحالب
للموت لون ناصع.. للعصر رائحة الجوارب
لكنّك لا تعدم أن تجده يقع في الحذو في بعض القوافي المطلقة، فتتخالف حركة ما قبل الردف في صوتين متباعدين، كالفتحة والكسرة في قوله:
حريق إزائي.. حريق معي تمرّ الحرائق بيني.. وبيني
وحذو القافية محلّى بالكسرة. ومثله:
يطول الطريق؟.. ولكنه أحبّ المشاوير.. يا نور عيني!
ولا يخلي الشقّاع قوافيه من إعناتٍ، وهو لزوم ما لا يلزم. وقد جاء في قصائده متفرّقًا في بعض المظانّ، وعلى صورتين: صورةٌ تتصل بالصيغة الصرفيّة؛ حيث يلتزم صيغةً صرفيّةً واحدةً في موضع القافية، كما في قوله:
نادى العبير، فسرت خلف ندائه لكن بابكِ والطريق تنكّرا
فتفرَّق الأمل الجميل شراذمًا عبر الشوارع والعذاب تجمهرا
كنتِ البلاد إذا البلاد تأنقت كنتِ الزمان إذا الزمان تعطّرا
عيناكِ حدثتا حديثًا صافيًا لكن شيئًا في القرار تعكّرا
وانظر إلى (تنكّرا/ تعطّرا/ تعكّرا) تلقها على بنيةٍ صرفيّةٍ واحدة.
وقد يوالي بين عدد من الأصوات، التي تسبق حرف الرويّ، كالتزام الهاء والجيم في قوله:
لحبيبٍ مثل وجه الصبح، أبلجْ لغرام أحزن القلب.. وأبهج
أجمع الآن لظى تجربتي كي أصوغ الحب أسلوبًا. ومنهج
والتزام الراء والجيم في قوله:
ناره يمتشق الموج بها صمته أنشودة السِّيف المضرَّج
فاضت الأسرار من نظرته فحكاياه شموس تتبرَّج
وقد تجيء قوافي القصيدة كلّها ملتزمة ما لا يلزم كما في قصيدته (انهمار):
يعود الأمس منهمرًا كأشعارٍ نواسيَّة
يؤرقني.. وقد كانت طيوف الأمس منسيّة
فيطرق كل أبوابي وأحزاني النحاسية
ويزرعني هوى “حقات” أو نجوى “قلنسية”
يعود الأمس.. جنّيًا يداعب نهد إنسية
لقد اضنى مسافاتي لأن خطاه “عنسيّة”
لأنّ جذور أمسي -يا حنيني- غير أمسية
له نطقٌ مسيحيٌ وأفكار مجوسيَّة
فكل خصاله شجنٌ وكل رؤاه حسيَّة
وهو يستخدم القوافي موصولة بالهاء في مظانّ، فيجيء مجرى حرف الرويّ منصوبًا في الأغلب:
وجهها -كان- مظلَّة وسحاباتٍ مطلَّة
لم تلقَ يومًا مثلَها فاحفظ “للبنى” فضلَها
أحمل الورد للذي صرت عيده ودع الحزن للقلوب الوحيدة
لكنّه يستبدل بالهاء وصلًا التاء المربوطة، التي تستحيل هاءً حين تُسكّن، لكنّ الفرق بين استخدام الهاء وصلا والتاء المربوطة وصلًا يكمن في التحرّر من عنت النحو؛ حيث لا مهرب من الالتزام بحركة المجرى وفق الإسناد اللغويّ إذا جاء الهاء وصلًا. أمّا عند استخدام التاء المربوطة وصلًا فحسبه الفتحة التي في أصل الحرف السابق لهذه التاء، ولتأتِ القافية من بعدُ مرفوعةً، أو منصوبةً، أو مجرورةً سيّان، فالعبرة بالسكون التي عليها ولا غير. وانظر مثلًا في قصيدته “العائد” تجد القوافي فيها هي: (الساهدة/ الراقدة/ العائدة/ الخالدة/ الواقدة/ السائدة/ الشاردة/ الباردة/ المائدة/ بائدة/ الجاحدة/ واحدة/ هامدة). وجميع هذه الدوال المستخدمة في موضع القافية صفاتٌ لموصوفاتٍ تقدّمتها. وجميعها اتخذت الحركة الإعرابيّة التي منحها إيّاها الإسناد اللغويّ، فالقوافي (العائدة، الراقدة، الباردة) جاءت منصوبةً؛ لأنّ موصوفها منصوبٌ، والقوافي (الساهدة، الخالدة، الواقدة) جاءت مجرورةً؛ لأنّ موصوفها مجرورٌ، والقافيتان (بائدة، هامدة) جاءتا مرفوعتين؛ لأنّ موصوفيهما مرفوعان. بيد أنّ الحرف الذي يسبق التاء المربوطة، وهو الدال فيها جميعًا قد علته حركة الفتح، فاتخذه الإبداع رويًّا، مكتفيًا به عن استخدام الدال في لفظةٍ أخرى واجبة النصب على المفعوليّة أو سواها؛ ليستقيم له نسق الكلام من جهة الصنعة النحويّة، فاكتفى بتسكين التاء المربوطة، التي استحالت هاءً، وصارت وصلًا للقافية، وجاء الدال وهو حرف الرويّ منصوبًا كما يشتهي. وهذا استخدامٌ لم يصادفه قارئٌ في تاريخ الشّعريّة العربيّة، فعدا عنه علماء العَروض والقافية، ولم يشيروا إليه.
التصريع:
يذكر الطرابلسيّ نقلًا عن جمال الدين بن الشيخ أنّ »من المستحسن إن لم يُقَلْ من المشروط في نظم الشعر عند العرب أن يصرّع الطالع حتّى يدلَّ آخر الصدر على آخر العجز تنبيهًا على القافية التي ستجري وتلتزم«. وقصائد الشقّاع تلتزم التصريع في مطالعها، حتّى وإن كانت القصيدة نتفةً لا تتجاوز أبياتها الثلاثة عددًا. لكنّ أربع قصائد فقط هي التي جاءت غير مصرّعةٍ، وهي: (انهمار/ حصار/ على الرمل/ الأشجار). وليس لخلوّ هذه القصائد الأربع من التصريع صلةٌ بسطحيّة التجربة وبساطتها، فهي لا تخلو من عمقٍ في الرؤية، واتساع في الموقف، كما أنّ تحلية القصائد بالتصريع لا يمنحها مثل ذلك العمق والاتساع ولا يسمها بهما. ولكن من المؤكّد أنّ للتصريع يدًا في تطرية إيقاع القصيدة من جهةٍ، وفيه ما ينبئ عن اتّباعيّةٍ لاستخدامٍ قديمٍ للقصيدة الموزونة بالبحر والقافية، في حين نبا عن ذلك الاستخدام بعض شعراء الحداثة الرومنسيّة، الذين كتبوا القصيدة موزونة ببحر وقافية، وحسبك بأبي القاسم الشّابيّ مثلًا، فقد قلّ حرصه عليه، وتدّنت المبالاة به في شعره، فخلت منه عيون قصائده، وخذ على ذلك شواهدَ من مطالع قصائده:
عذبةٌ أنتِ كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديدِ
إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بدَّ أن يستجيبَ القدرْ
أيّها الشعب ليتني كنتُ حطّابًا فأهوي على الجذوع بفأسي
ألا أيّها الظالمُ المستبدّ حبيب الظلام عدوّ الحياة
… إلى آخر ما هنالك من ذلك.
لكنّك لن تعدم وجود التصريع في شعر نزار والبردّونيّ، وبهما اقتدى. على أنّ نزوعَ الشقّاع إلى استخدام التصريع في مطالع قصائده صورةٌ من صور الأصالة، التي تزاحمها في شعره صورة المعاصرة في اللغة وطرائق التخييل.
***
وعَروضُ القصيدة في شعر الشقّاع صافٍ استخدامه، سليمةٌ من العيوب طرائقُ تشكيله، ممّا يشي بحسٍّ واعٍ بأبعاده، لكنّه لم يخلُ في بعض المظانّ من أثرٍ نزاريٍّ في استخدامه بعض التفعيلات، انزاح بها عن نسيج إيقاعها عن المألوف المرغوب في أمثالها. ومن ذلك استخدام التفعيلة الثانية في بحر السريع مخبونةً (متفعلن)، فيخبو إيقاعها. وقد حرص شعراء العربيّة على استخدامها صحيحةً (مستفعلن)، أو مطويّةً (مستعلن)، ليتمدّد بها إيقاع البيت. وأستطردُ قليلًا لأشير إلى أنّ استخدام هذا البحر في شعر البردّونيّ لم يجر بهذه التفعيلة إلا صحيحةً أو مطويّةً، قال:
للموت أيدٍ من شفار المُدى وقامةٌ قشيّةُ الأعمدة
يا كأسُ لا أسوى جناك ابعدي إنّي كما تحكين وغدٌ عنيدْ
أريد ماذا يا زمانًا بلا نوعيّةٍ لم يدر ماذا يريد؟
يا كلّ آتٍ ما أتى مرّةً خذني وأرضعني جديد الوثوب
واختر طريقًا ما رآه الذي عن كلّ مدعوٍّ وداعٍ ينوب
في القلب شيءٌ ما له سابقٌ وفيه أخفى من نوايا الغيوب
إلى آخره.
أمّا في شعر الشقّاع فتغدو التفعيلة الثانية من بحر السريع في حشو الصدر (متفعلن) كاستخدامها في شعر نزارٍ. قال:
في ضحكها أمومةٌ واشتهاءْ … … …
قلتُ لها وسحرها لم يزل كالمطر الحاني يزيل الجفافْ
يتصل بهذا قصر الممدود في عَروض البيت كما في البيت الأوّل من البيتين أعلاه. ومثله:
ألم تكن في حلقة الأصدقاءْ … … …
لحبيبي أبتدي هذا الغناءْ ثمّ أنهيه لعصرٍ يتهدّجْ
وقريبٌ منه تسكين المتحرّك، كما في قوله:
أهابها وهي اقترابٌ قصيّْ وأشتهيها وهي بعدٌ قريب
سلحف الخوف البراق العربيّْ وغدا المعراج غوصًا في الوحول.
***
وبقولٍ مجملٍ استخدم الشقّاع عددًا من البحور وهي:
| اسم البحر | عدد مرّات تكراره |
| المتقارب | 14 |
| الرمل | 9 |
| الكامل | 9 |
| الخفيف | 8 |
| الوافر | 7 |
| السريع | 4 |
| الرجز التام | 1 |
| البسيط | 1 |
| الإجمالي | 53 |
ونستطيع استخلاص ما يأتي من مطابقة هذا الجدول بمتن النصوص موضوع البحث:
– استخدم الشقّاع من الأوزان ما جرى استخدامه بحرًا وقافيةً عند شعراء الحداثة منذ الرومنسيّين حتّى نزار والبردّونيّ، ونأى عن استخدام البحور التي أكثر من استخدامها شعراء الاجترار كالباروديّ في مصر وابن شهاب الحضرميّ.
– جاء استخدامه لتفعيلات البحور صافيًا وسليمًا ما خلا ما بدا في بعض قصائده المنظومة على بحر السريع.
– التزم الشقّاع في استخدامه للبحور بما تجلّى في متن الشعريّة العربيّة، وما رصدته كتب العَروض، ولكنّه أضاف إلى بنية بعض البحور ما لم يجر لها في تلك الكتب ذكرٌ، مثل استخدامه لبحر الكامل مذيّلًا في قصيدة (خطوات مرثيّة).
– ظهر شغف الشقّاع ببعض البحور دون بعضٍ، فالخفيف جاء تامًّا ومجزوءًا، وجاء الكامل والوافر مثله، وأمّا المتقارب فقد بلغ الذروة في الاستخدام الوزنيّ، يليه الرمل في ذلك الاستخدام.
هذا على مستوى البنية الوزنيّة، أمّا على مستوى تشكيل القافية فإنّ الشقّاع استخدم من القوافي الخمس ثلاثًا، هي: المتدارك، والمتواتر، والمترادف. وتنوّعت حركاتها على حسب ما قد سلف ذكره أعلاه.
ذاك واحدٌ من مستويي الكلام في شعره، والثاني يتصل بـ:
مرئيّات البيان في قصائده:
والمقصود بها بنى الصورة البيانيّة من تشبيهٍ، واستعارةٍ، وكنايةٍ، وما ينشأ بين عناصرها من علاقاتٍ. وإنْ كان هذا لا يعني أن ليس في شعر الشقّاع سواها من أنواع التصوير، فهناك الصورة الحرّة، ولها بناها من لوحةٍ، ولقطةٍ، ومشهدٍ، وهناك الصورة السرديّة، والصورة الحواريّة وما إلى ذلك، لكنّنا اقتصرنا هنا على الصورة البيانيّة؛ لنتبيّن طرائقه في تشكيلها، ومدى ائتلافه واختلافه في ذلك مع شعراء العربيّة في قديم الزمان وحديثه.
يستخدم الشقّاع التشبيه في شعره، ولا يزاحمه على ذلك الاستخدام إلا استعماله الاستعارة في مظانّ منه، ولا غرابة في هذا، فقد قيل: إنّه من قال: إنّ أكثر كلام العرب تشبيه ما خرج عن الصّواب، كما أنبأ المبرّد في (كامله)، وكلاهما، التشبيه والاستعارة، ينتجان علاقة تشابهٍ، كما ذكر جاكوبسون في حديثه عن قانون التماثل في الشعريّة، وإن لم نر رأيه، ولم نقتبس من ناره، لكنّنا سنفيد من كلّ ذلك؛ لتبيان طرائق الشقّاع في تشكيل بنيتي الصورة التشبيهيّة، والصورة الاستعاريّة، وما مسّهما من انزياحٍ عن المألوف والمعتمد في تاريخ الشعريّة العربيّة، ومن ذلك مثلًا انتفاء التّطابق بين (المشبّه) و(المشبّه به)، و(المستعار) و(المستعار منه)، حتّى لتبدو صعبةً على مَنْ ألف طرائق شعراء العرب القدامى ألفةُ مثل هذه الطريقة في استخدامهما. وهو إنّما ينزع منزع الحداثيّين من شعراء العربيّة في عصرها الحديث منذ الرومنسيّين ومن تلاهم من الشعراء.
فأنت كي تدرك عمق التحوّل الذي أجراه الشقّاع في طريقة استخدام هذين المكوّنين الأسلوبيّين قف على قول امرئ القيس مثلًا:
مِكرٍّ مِفرٍّ مقبلٍ مدبرٍ معًا كجلمودِ صخرٍ حطّه السيل من علِ
تجد أنّ الوعي بنقطة التلاقي بين (المشبّه) و(المشبّه به) حاضرٌ في ذهن المبدع في لحظة الإبداع، فوعاها القارئ باستحضارها في لحظة التلقّي، على الرغم من عدم تجلّيها على مستوى المقولة اللغويّة. وهذا على خلاف ما صنعه الشّابّيّ في قوله:
عذبةٌ أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديدِ
حيث اتخذ من (العذوبة)، وهي من باب المذوقات، نقطة التقاءٍ بين (المشبّه) و(المشبّه به)، ولا علاقة بين المشبّه وكلّ تلك المشبّهات به على الرغم من حرص المبدع على تقديم الصفة الجامعة بينها. فالطفولة مرحلةٌ من العمر، والأحلام رؤيا منامٍ، واللحن من المسموعات، والصباح من المنظورات. ولكنّ الاستخدام الحداثيّ للغة شكّل مكوّناتها في النصّ متداخلةً ومتراسلةً حتّى أصبح المسموع مذوقًا، والمُبْصَر يًتذوّق طعمه بالفم. فبهتت علاقة التشابه وإن دلّت عليها مكوّنات البنية. وإنّما صار ذلك كذلك لانتفاء التطابق بين (المشبّه) و(المشبّه به)، ممّا أوغل بالتشبيه في دائرة الاتساع المجازيّ، وهذا على غير ما قال به علماء البلاغة، والعارفون بأسرارها من قبل.
ولم يكن صنيع الشقّاع في استخدامه بنية الصورة التشبيهيّة في شعره ببعيدٍ عن صنيع الشّابّيّ وأضرابه من شعراء الحداثة العربيّة، فهو قريبٌ من قريب. قال:
كما تومض الأنجمُ الساهدة أناديك.. لكن بلا فائدة
هنا تتجلّى انزياحاتٌ على بنية الصورة، منها انزياحٌ في ترتيب عناصرها؛ من حيث إنّ الابتداء بالمشبّه أمرٌ لازمٌ في عرف المتحدّثين عن تلك البنية وسبقه على المشبّه به بلا خلاف، ويستثنون من هذا مجيء المشبّه متّصلًا بالأداة (كأنّ)، ويسبق -في هذا الاستخدام- المشبّه به ولا ريب. لكنّك في البيت أعلاه لا تجد مشبّهًا، وإنّما تجد أداةً (كما)، وجملة فعليّة (تومض الأنجم الساهدة) تقوم مقام المشبّه به، ثمّ تجيء جملة فعليّة أخرى هي (أناديك)، لعلّها تكون في مقام المشبّه. وإنْ هي كانت كذلك فقد انزاحت عن موقعها متأخّرةً. واستخدامُ الجملة الفعليّة في مقام المشبّه والمشبّه به انزياحٌ عن المعهود في أمثاله؛ من حيث كان الاسم هو الأصل في التشبيه، ينبئك عنه حرصهم على نقطة الالتقاء والاشتراك في الصفة. أضف إلى ذلك انتفاء التطابق بين المشبّه (وهو هنا من المسموعات)، والمشبّه به (وهو هنا من المبصرات) ممّا يوغل بالبنية في دائرة المجاز الشّعريّ.
وليس ببعيدٍ منه قوله في أخرى:
سمرقنديّةٌ جاءت بكلّ عذوبةٍ عندي
زحام الشّارع العدنيّ أطلعها بلا وعدِ
كلؤلؤةٍ رماها البحر بين الجزر والمدِّ
هنا يغدو الشارع بحرًا، وزحامه أمواجًا تتلاطم، والمرأة السمرقنديّة لؤلؤةً، يظفر بها المتكلّم في النصّ. ولا علاقة هنا بين المشبّهات والمشبّهات بها، حتّى وإن جاءت جميعها من عالم الجماد ما خلا المرأة السمرقنديّة، فإنّ الصلة بينها لا تخلو من مباعدةٍ ومخالفة.
وانتفاء التطابق في بنية الصورة التشبيهيّة في شعر الشقّاع لا يقف عند حدّ العلاقة بين المشبّه والمشبّه به وإنّما يتجاوزها إلى منطقة إنشاء الصورة، وتأليفها، والجمع بينها وبين مستويات أخرى من التجسيد المرئيّ في القصيدة، كأن ينبثق التشبيه من ثنايا صورة استعاريّة، فتتوالد تلك من هذه. قال:
تثب الأشواقُ في أوردتي كجيادٍ عادياتٍ في السهول
هنا تتجلّى الاستعارة إيحائيّةً تشخيصيّةً وفق التصنيف الدلاليّ؛ من حيث اقتران الفعل (تثب) بالاسم المجرّد (الأشواق). وإنّما ازدوجت صفتها بسبب من ازدواج النظرة إلى طبيعة الفعل، فإذا نسبته إلى الحيوان، وجعلته بعض صفاته فالصورةُ إيحائيّةٌ، أمّا إذا نسبته إلى إنسان فالصورةُ تشخيصيّةٌ، وفي كلتا الحالتين مجلى للاستعارة في إطار علاقة التماهي. تتولّد منها صورةٌ استعاريّةٌ أخرى في إطار علاقة التماثل، وهي التي نجدها في قوله: (في أوردتي)؛ حيث تتماثل الأوردة في نسيج القول مع السّاحات والسّهوب، وفيها من التّشخيص ما لا يخفى على ناظرٍ متأمّلٍ. وتمضي الصورة دون توقّف؛ لتتناسل منها بنية تشبيهيّة تتداخل مع بنية الصورة الحرّة في إطار اللقطة، وأعني قوله: (كجيادٍ عادياتٍ في السهول)؛ حيث تتحوّل الاستعارة في الشطر الأوّل إلى مشبّه، تتلوه أداةٌ هي (الكاف)، وهي تمحض الكلام للمشابهة بين عنصري الصورة، ثم يجيء المشبّه به (جياد عاديات في السهول). وهو تركيب يجلو صورة حرّة في إطار اللقطة؛ حيث يبصر المرءُ حركةَ الجياد، وهي تتراكض في السهول، وتعدو متواثبةً دون أن يسمع صوتًا، وكأنّ اللغة هنا استحالت آلةَ تصويرٍ سينمائيٍّ يجلو الصور، ويجسّد المرائي.
تشكيل الصورة على ذلك النحو ينبئ عن خصوبةٍ في الخيال، وقدرةٍ على التصوير والتشكيل اللغويّ للمرائي المنظورة.
قريبٌ منه ما نجده في قوله:
أهمي كدمع الليلة المتحدّرِ وأجفُّ وحدي كالصباح الأصفرِ
هنا تتجسّد الذات في بنية الاستعارة على هيئة سحابة ممتلئة بالماء، مرّت عليها الرياح، فأمطرت وهمت.
تتولّد منها صورة تشبيهيّة (كدمع الليلة المتحدّر)، ويغدو المطر دمعًا للسحاب المتحدّر في ليلةٍ مّا.
ولاقتضاء التشبيه إلى مشبّهٍ فقد تحوّلت الاستعارة إلى ذلك العنصر، فتناسلت صورةٌ من صورةٍ.
وهنا يهتزّ التطابق بين الدالّ والمدلول؛ من حيث اكتساب دالّ الإنسان هويّة الجماد، واكتساب الجماد هويّة الإنسان بعد أن أصبحت الليلة إنسانًا يبكي ويسيل الدمع. ويتوازى مع هذا جفاف الذات (أجفّ وحدي) وقد غدت ترابًا مبلّلًا بالماء، طلعت عليه الشمس فجفّ. وظهر الصباح مصفرًّا كأنّه جسد مريضٍ ناحلٍ مهزولٍ، تعلوه صفرةُ المرض. وهكذا تتراءى الأشياء والأحياء على غير هيئتها في أصل اللغة وواقع الحال، ممّا يدخلها في دائرة الاتساع المجازيّ، ولا يُخْلي الصورة من مفارقةٍ ظاهرة.
ومن بابه قوله:
أجوب المكلا بهذا الغناء كراعٍ يغازل بنت الأميرْ
حيث تتعالى المكلا معزّزةً ممنّعةً لا تُرام مقاصيرها إلى مقام بنت الأمير، التي لا يُستطاع الوصول إليها، وتبدو الذات في عجزها عن نيل المبتغى والظفر به في مقام الراعي، الذي يشتهي ما لن يكون.
تتناسل من هذا التشكيل التشبيهيّ صورةٌ كنائيّةٌ تمنح علاقة لزوم؛ من حيث دلالة الصورة على معنى الجلال والمنعة التي اتّسمت به تلك المدينة.
ومن مثل هذا التوالد في الصور قوله:
قلق الشيء الذي أرقبه مطرٌ دامٍ صحارى وخيول
يتمطّى كالأفاعي في الضّحى وله في الليل صيحات المغول.
وهنا تتعدّد علاقات بنى مرئيّات البيان لتنوّع عناصرها المكوّنة.
فالقلق وهو مجرّد يقترن بجامدٍ (مطرٌ دامٍ وصحارى)، فينتج علاقة تماثل في إطار بنية الاستعارة، لكنّ ظهورَ علاقةِ اقترانٍ أخرى يشير إليها دالّ (خيول)، يُدْخِلُ الصّورة في دائرة الإيحاء وإن لم ينفصل عن بنية الاستعارة.
تتناسل من هذه المستعارات (مطر دامٍ وصحارى وخيول) صورٌ كنائيّةٌ؛ من حيث النظر إليها على أنّها دوالّ، تنتج مدلولاتٍ لازمة، هي (العقم والجفاف وعطاء كالعدم) على توالي المستعارات. ثمّ يتجسّم المجرّد (القلق) في البيت الثاني فيغدو جَمَلًا يتمطّى في بنية الاستعارة، التي تمنح علاقة تماهٍ بين عنصريها الأساسيّين؛ ليستحيل بالتشبيه إلى أفاعٍ في إطار بنية التشبيه؛ من حيث استطاع (الكاف) أن يمنح الصورة علاقة مشابهة، تنتج مدلولاتٍ، تُدْخِلُ الصورةَ في إطار الكناية، ففي تمطّي الأفاعي بطءُ الحركة ولينُها، وفي صيحات المغول ضجّةٌ واندفاعٌ، فتتولّد من تقابلهما مفارقة ظاهرة.
وفي استخدام الشقّاع لبنية الصورة الاستعاريّة يتجلّى خَرْقٌ للمألوف، وتجاوزٌ للمعهود من نسيج الكلام. قال:
هل أشبُ الغرام كي تفهميني؟ أنت يا ربّة الجمال الحزينِ
الأصل في الشّبوب أن يكون للنار لأن فيه إشعالها، لكنّ اقتران الغرام -وهو مجرّدٌ- بالفعل شبّ -وهو للجماد- أدخل الاستعارة في دائرة التجسيم من جهة، وانزاح بالاستخدام اللغويّ إلى دائرة الاتساع المجازيّ؛ من حيث انتفاء المطابقة بين الدالّ والمدلول. وهو لا يخلو من تناسل صورةٍ كنائيّةٍ؛ حيث في الاستخبار عن الحاجة إلى شبوب الغرام دلالةٌ على برودته وانطفاء لهبه. أمّا وصف الجمال بالحزن فقريبٌ من قريب.
يتماثل هذا مع نزوع الشقّاع في تشبيهاته إلى توظيف بنيتها لإنتاج المعنى وتوليد الدلالة؛ فهو لا يقصد إلى التطابق بين المتشابهات وإنّما إلى ما ينتجه التشبيه من دلالة العبث واللاجدوى في قوله:
لم أكن في الحبّ إلا هاويًا مثلما يرسم طفلٌ في جدار
وإلى ما ينتجه التشبيه من دلالة الحنان والارتواء في قوله:
قلتُ لها وسحرها لم يزل كالمطر الحاني يزيل الجفافْ
وإلى ما ينتجه التشبيه من دلالة الانطلاق والتحرّر من القيود في قوله:
… … … … … … … ذوائبها كالحصان الجموحْ
… إلى آخر ما هنالك من ذلك. وفي جميعها ما يدلّ على أنّ الشقّاع قد اتخذ من تلك المرئيّات أداته لتحويل المعنى الإشاريّ إلى معنى إيحائيّ، يحقّق لقصيدته مستوًى عاليًا من التّخييل، ويضمّخ لغته بعبير الشعرية وأريجها الفواح.
خاتمة:
أخلصُ من هذا إلى أنّ لقصائد الشقّاع في هذه المرحلة من تاريخه الإبداعيّ وهجًا على شواطئ اللغة، يسمها بأسلوبيّةٍ هي أسلوبيّتها الخاصّة المميّزة من سواها رؤيةً وأداءً، موقفًا ونسيجًا.
وهي على تمسّكها بالبنية الوزنيّة في إطار البحر الواحد والقافية الواحدة لم تنحصر لغتها في أسر القديم الموروث، بل انطلقت في فضاء الحديث المبتدع عن وعيٍ بالإبداع مفهومًا وشرطًا، وهو ما سيتجلّى في قصائده في العقد التّاسع من القرن العشرين على أبهى صور التجلّي وأظهرها إشراقًا، وهو موضوع البوّابة الثانية من هذه البوّابات إلى مدائن التخييل.