لغويات
د. محمد علوي بن يحيى
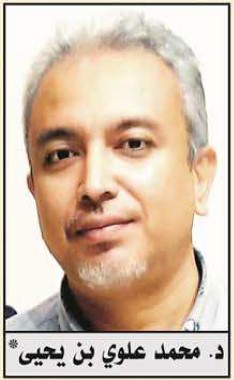
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 12 .. ص 44
رابط العدد 12 : اضغط هنا
تحتل المصطلحات في لغات الشعوب منزلة راقية؛ فهي تقيِّد دلالات الكثير من الألفاظ التي يحتاج إليها الناس، في معاملاتهم اليومية، على اختلاف مستوياتهم الفكرية، والعلمية.
وقد فطن اللغويون المختصُّون بدراسة هذه اللغات إلى أهمية هذه المصطلحات، فوضعوا لها حدودًا، تقيِّد معانيها؛ فلا تلتبس بغيرها، من المصطلحات، أو تشاركها في دلالاتها.
ولم يكن اللغويون العرب بمنأى عن هذا الاهتمام؛ فقد صاحب اهتمامهم بالدلالات الاصطلاحية نزول الوحي الإلهي، على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم ازداد هذا الاهتمام بعد انقطاعه، بمواراة جسده الشريف الثرى، وصارت الحاجة مُلِحَّة لتصنيف علوم، تتخصص في دراسة المصطلحات الشرعية للقرآن الكريم(1)، وما يتعلَّق به، من علوم اللغة، والمنطق، والحساب، والطب، والطبيعة، والفَلَك، وغيرها… كل ذلك ليكون قُربَةً لهم إلى الله سبحانه وتعالى، ووسيلة نافعة لخدمة الناس، في دينهم، ودنياهم.
وبعدما اختلط الأعاجم بالعرب، ودانوا بدين الإسلام، شغفوا بالتعرُّف على تعاليمه السمحة، ورأوا أنَّ تعلُّم لغة العرب هي وسيلتهم المُثلى إلى تعلُّم دين الإسلام، وأحكامه، ولن يتأتَّى لهم ذلك إلَّا بدراسة مصطلحاتهم: اللغوية، والشرعية، والعلمية.
فاقتحموا هذا المضمار، ونافسوا أقرانهم، من العلماء العرب، وأسهموا معهم، في وضع مداميك التراث الإسلامي، والعربي، وإثرائه؛ عن طريق إدخال المصطلحات الأعجمية، الخاصة بألفاظ الحضارة، لديهم، إلى لغة العرب، وترجمتها بما يقابلها من الدلالات اللغوية.
وترسَّموا في ذلك وسائل، في نقل هذه المصطلحات، كـ: الاشتقاق، والمجاز، والتوليد، والتعريب، والنحت، والاقتراض، والارتجال(2).
فنتج عن ذلك نهضة علمية، بلغت شأوًا في الرقي لا تضاهيها غيرها، من حضارات الأمم المُتمدِّنة، إبّان العصر العباسي.
ثم خفتت جذوة تلك النهضة، في العصور التالية، بسبب الحروب السياسية، التي استعرت فيما بين أبناء الأمة الواحدة، من جهة، وبسبب الحروب الصليبية، والمغوليَّة، على العالم الإسلامي، من جهة أخرى، وتمخَّض عن ذلك انحدارات كبيرة، في مختلف المجالات: الدينية، واللغوية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية.
وما كاد أن ينجلي القرن التاسع عشر، ويبزغ فجر القرن العشرين الميلادي، حتى بزغت معه نهضة علمية أخرى، في العالم العربي، رُفِعَت قواعدُها بإخلاص أبنائها، وبغيرتهم على عدم اندثار تراثهم المجيد، وبعزمهم على إعلاء شأنه، كأبهى ما يكون، بين الأمم المتحضِّرة.
»وستظل أسماء: أحمد فارس الشدياق، وخليل اليازجي، ونجيب الحداد، وشاكر شقير، وبشارة زلزل، ويعقوب صرُّوف، وسليمان البستاني، وأمين المعلوف، وإبراهيم اليازجي، وغيرهم، ممن خدم العربية – خالدة ما خَلُدَت الأمة، وعاش أبناؤها يبنون. وستظل المجلات التي حملت عبء النهضة العلمية، كالمُقتَطف، والمَشرِق، والبيان، ثم الضياء، ومجلاَّت المجامع اللغوية، والمؤسسات العلمية – منارًا يهدي الباحثين، ويدفع العمل، والبناء«(3).
ثم شاء الله (سبحانه وتعالى) أن تتحول تلك الآمال، والتطلُّعات، إلى واقع ملموس، تقَرُّ به أعيُن كل مخلِص للغة الضاد… فكانت المجامع اللغوية في (سوريا)، و(مصر)، و(العراق)، ثم (الأردن)، خير كيان، تحفظ مصطلحات هذه اللغة، وترتقي بها؛ عن طريق جعلها لغة أدب، وعلم، معًا، وتسعى، جاهدة، إلى ترجمة، وتعريب، مصطلحات الحضارة، والعلوم الحديثة، الواردة عليها، من الأمم الأعجمية؛ لتلحق بركبهم، في هذه النهضة المتسارعة(4).
وقد اتفق المعنيُّون بوضع المصطلحات على شروط، وضعوها لتكون لهم مرجعًا أساسيًا، يستندون إليه، في وضع المصطلح العلمي… هذه الشروط هي(5):
من خلال النظر في الشرط الأخير، يبدو لي أنه يحتاج إلى وقفة، وتأمل، وتحليل.
إذ يرى المعنيُّون بوضع المصطلحات، أنَّ المصطلح الموضوع يجب ألَّا يزيد عن لفظة واحدة، تفي بالمعنى المقصود، ونقل هذا الرأي (د. أحمد مطلوب)، عن (الأمير الشهابي)، وعن وزارة المعارف العراقية، التي وضعت هذه الأسس، هادفة إلى تأسيس المجمع العلمي العراقي، وعن الخطوط العامة التي وضعها كل من (طه الراوي)، و(معروف الرصافي)، و(الأب إنستانس الكرملي)، عام 1928م، وقد أيدها (ساطع الحصري)، وأصدرها في مجلة التربية والتعليم العراقية(6)، وكذا عن القواعد العامة التي وضعها المجمع العلمي العراقي، في وضع المصطلحات العلمية، عام 1977م(7).
واستعمال اللفظ الواحد، مصطلحًا علميًا، لا خلاف في أنه سبيل محمود، لدى كل شرائح المجتمعات، أو جُلِّها؛ لكونه أسهل تداولًا، وإدراكًا، كإطلاقهم المصطلحات (سيّارة، وطائرة، وقطار)، ونحوها، على وسائل النقل الحديثة، و(خلاَّطة، وغسَّالة، ومِكْوَاة)، ونحوها، على الأجهزة الكهربائية، المنزلية…
بل إنَّ المصطلح ذا اللفظة الواحدة، نجده، أيضًا، يُستعمَل في غير المخترعات الحديثة، كالمصطلحات المستعملة في ضبط مفاهيم الكثير من العلوم القديمة، والمستحدَثَة.
بَيد أنَّه من خلال إنعام النظر فيها نجد الكثير منها لا يفي بالغرض المقصود، إلَّا إذا أُسنِد إلى كلمة أخرى، تزيل معها اللبس، والغموض، في دلالتها، وتنفي بها الاشتراك، في الدلالة، مع غيرها من المصطلحات المشابهة.
فإذا وقف قارئ (مثلًا) على عدد من مصطلحات علم (النحو)، عند العرب، فإنه سيجد أنَّ عددًا منها لا يفي بالغرض، إلَّا إذا أضيف إليه اسم آخر، يتمُّ معه معنى الاسم الأول، أو أُتبِع باسم آخر، يصفه (ينعته)، بصفة تُجلِي الغموض عن موصوفه.
فنجد في مصطلحاتهم: مصدرَ المرة، ومصدرَ الهيئة، ونائبَ الفاعل، وشبهَ الجملة، ونحوها، من المتضايفات، التي تفيد (التعريف)، فيما بينها. وكذا نجد في مصطلحاتهم: الجملةَ الاسمية، والجملةَ الفعلية، والمفعولَ المطلق، والإضافةَ المحضة، والإضافةَ غير المحضة، ونحوها، من النعوت التي تقيِّد معاني منعوتاتها. ولو استُعمِلَت لفظةً واحدةً، من غير تقييد، لاشتركت مع أشباهها من المصطلحات، في الدلالة، ولأدى هذا إلى تعقيد مصطلحات هذا العلم، فوق ما عَلِق به من تعقيد، عند كثير من الدارسين!
ونحو ما ذُكِر من المصطلحات العلمية، عند العرب، نجده، أيضًا، في المصطلحات العلمية عند الغرب، كالمصطلحات: (Nongrammatical sentence)، أي: الجملة غير النحوية، و(Nonkernel sentence)، أي: الجملة غير النواة، أي: الثانوية، وهي من (التراكيب الإضافية).
كما نجد لديهم مصطلحات، نحو: (Grammatical sentence)، أي: الجملة النحوية، و(Kernel sentence)، أي: الجملة النواة، أي: الأساسية، و(Deep structure)، أي: البنية العميقة، و(Surface structure)، أي: البنية السطحية، وهي من (التراكيب النعتية).
مما سبق نجد أن علاقة التلازم واضحة، بين تلك المصطلحات (المركَّبة)، ولا يمكن فصلها، بأي حال من الأحوال، إذ إنَّ دلالة الأسماء الثواني هي من تمام دلالة الأسماء الأوائل(8).
وهذه المصطلحات بلغت من الكثرة التي تجعلنا لا نغض الطرف عنها، ولا نماري في استعمالها على نطاق واسع، ولا سيَّما في هذه المرحلة، الضاربة في الحداثة.
ولعل هذا هو ما حمل (د. أحمد مطلوب) إلى استحسانه استعمال المصطلحات المركَّبة، وهذا ما يبدو في قوله: »لا بأس إذا كانت الترجمة أكثر من كلمة؛ لأنَّه لا يُشترَط كل الاشتراط أن يكون المصطلح كلمة واحدة، ولعل ما في اللغات الأجنبية أوضح دليل على ذلك، ولا سيَّما المصطلحات المنحوتة من عِدَّة كلمات، بموجب قواعد النحت، في اللغات الإلصاقية«(9).
د. محمد علوي بن يحيى .. أستاذ الدراسات اللغوية واللسانية المشارك، بقسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب – جامعة (عدن)
(1) ينظر: بحوث مصطلحية، د. أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، العراق، 1427هـ/ 2006م، ص10- 11.
(2) ينظر: السابق، ص17.
(3) دعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات، د. أحمد مطلوب، دار البحوث العلمية، الكويت، 1395هـ/ 1975م، ص22- 23. وينظر: القرارات النحوية والصرفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، د. خالد بن سعود العصيمي، دار التدمرية، الرياض، السعودية، ط2، 1430هـ/ 2009م، ص19- 26.
(4) ينظر: بحوث مصطلحية، ص31- 37.
(5) بحوث مصطلحية، ص9، وينظر: 99- 100.
(6) ينظر: بحوث مصطلحية، ص9، 27، 36.
(7) ينظر: السابق، ص115- 187.
(8) ينظر: شرح المفصَّل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت 643هـ)، عالم الكتب، بيروت، لبنان، د. ت، 2/ 18.
(9) بحوث مصطلحية، ص189.