ملف
أ. سعيد صبيح الحقيبي
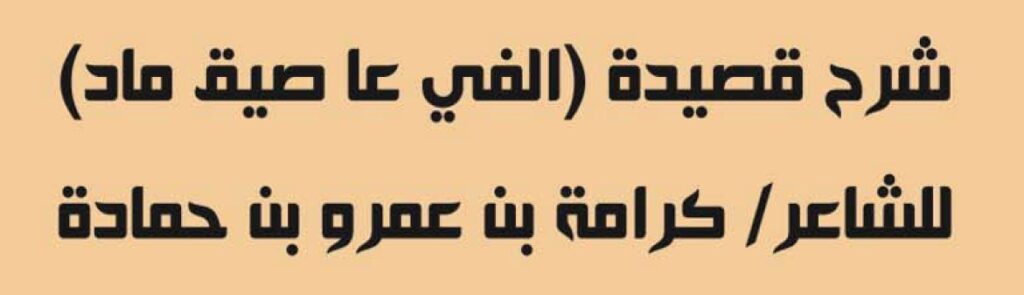
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 13 .. ص 58
رابط العدد 13 : اضغط هنا
المقدمة
النصوص الشعرية المشقاصية -كغيرها- تحمل في طياتها ثقافة المجتمع وفكره الذي ولدت فيه، وتنقل عاداته وتقاليده وتراثه، وتعكس صورًا من حياة الناس، ولذا يعد النص الشعري وثيقة مهمة يعتمد عليها في دراسة أحوال المجتمع المختلفة.
وبين أيدينا هذا النص الشعري الجميل، الذي صور حياة البادية، وطريقة عيشهم وصفاتهم التي يعتزون بها، وهو تصوير صادق نابع من صميم الواقع، إنها قصيدة (الفي عا صيق ماد) للشاعر المعروف الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة الثعيني، أحد أعلام الشعر المشقاصي. ويسرنا -خدمة لتراثنا- أن نقدم للقراء الأعزاء شرحًا موجزًا لهذه القصيدة يقرّب معانيها، ويوضح مضامينها، ويبين ما استغلق من مفرداتها، وهذا النص يعرّف الأجيال الحاضرة والمستقبلة على حياة الآباء في الماضي.
الشاعر في سطور:
* الشاعر الشيخ كرامة بن عمرو بن حمد (حمادة) بن عمرو بن مبرور الثعيني.
* من مواليد ١٣٥٤هـ بداية ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي في وادي بدش (البادية).
* تلقى تعليمه على يد الشيخ سعيد بن عبدالرحمن بن سالم باحميد في ضبق هزاول.
* قضى بداية حياته في البادية متنقلًا تبعًا للمرعى والماء، ويستقر أحيانًا في ضبق هزاول.
* سافر إلى دولة الكويت في مقتبل شبابه سنه ١٩٥٦م للعمل فيها.
* يعد من أبرز شعراء المشقاص، يمتاز شعره بالبلاغة وجودة السبك، وغزارة الإنتاج، له الكثير من الأبيات والحكم السائرة، صدر له ديوان شعر، وله ديوان آخر تحت الإعداد.
* يعد واجهة قبلية واجتماعية في المشقاص، ومقصدًا للدارسين والباحثين في التراث والأعراف القبيلة.
نص القصيدة:
الفي عا صيق ماد
ويا راد اللواطي هبط عا الحيداد
ويا في الجنْسُر خر فوق الرياد
وغطي عا حيد ظبين فيه وقتاد
دحق فيه وعتاد
حلّ فيه وانقل ودّعه ونا شاد
شد عا الحيّاق ونجد مع النجّاد
وعا حل النجود نقل الفرش والزاد
والغراء والمذاليل عا غلاظ الكباد
وتوجه قدا أرض لي فيها مواد
من بين يوهب وهنف اتّاصيق شدّاد
وعا تَوّه مشرّق اتّا خطي المدواد
وساعة قدا الفرش والرهاو ذاك المداد
وساعة عزم جاد
اتّا الخامر وقي حيت الحفوف شاد
الفوهة اتّا الصيقة يخلّوها بلاد
تسمع حنين الحفا وكم من حوار ناد
وهدار كل معواد
ورغا المعزوفات عا زمّ المشاد
وعا صوات الغواد
يتكثّحوا الفاريق متولّدات وولاد
وفصول دون السنة كما بطوخ الزباد
بيض قس كما الفضّة عا قصف النّجاد
والرصص تعملن حوابس تحت كل محياد
والربّ فوق الصفين كما صماغ القتاد
ولحوم المقانيص عاملين غدّاد
تشاتير المتان كما شحف الكناد
ويا كم من وعل غسى الشّوعه وناد
يخلّوه مهدان كما لحوم العياد
بسكن شغل الغيل قطيع فيه وقدّاد
تلاهيم عا قلبي عا يردّوا جداد
وطني وله شوق بنى فوق الفواد
وفيه لي تقاديم من تخاليف الجداد
قسا فيه وعناد
لين فيه وسخا كرم فيه الوفّاد
قلبي قده واد
وفيني عليه ولف وشوق معاد ينزاد
وان فارقيته وكاد
قلبي بقى عنده مع الناس الجواد
طريين ووداد
سخيين وكرام عا ذاك يوجاد
ولا هم حسّاد
إن جاء لحم طري مع خبز موقاد
وان هو قضيم ولبن مفوّرين بنقاد
وفوقه كلام ساد
فوقه هذيف حلو ذكاء فيه وفنّاد
مفصّحين الكلم أن بغوا قدا البدّاد
وان بيوجزوا شداد
معكّيين الكلم صعيبات وعداد
يدوّروا عاجمل لي هي متوجاد
امّا القبيل يوقف والريق فيه يعقاد
والولد يرشدوه من أول ما يوجاد
ولاشبّ وكبر يفحسوه النقّاد
إمّا يظهر معدنه عا كير حدّاد
فسِل وان كان جاد
الفسل يخلّوه يرقد مع الرقّاد
دفه ما يشتل يقع فوقه هناد
وان جاد يمدحوه بثناء عليه ونشّاد
يقعوا عا طرافه حديد تحت حدّاد
يسهروا معه الليل امّا يعدّي قواد
قويين ونجاد
طرشين وذفاف منقوزين ووكاد
رجال محسوبين مع كل مطراد
ولا يبغوا الهوّاد
ولا يقبلوا الذُّل وكلام فيه الندّاد
وعا الصبر جماد
معروفين بالصبر رزينين وركاد
وان سقط فيهم قتيل ما يعملوا حداد
ولا يظهروا الحزن ولا يبغوا العدّاد
ولا يظهروا الشينه مهما الكلام زاد
الكلم لي من لسنهم قروش عند عدّاد
الجار هو والسعيف يقعوا به وكاد
يقعوا عليه حرس وصباع فوق الزّناد
مرفّعين المجاد
يصبروا عا الجار ولا يقوم هدّاد
ولازيّد الشينه يزيدوه وسّاد
تحفُّظ عا السمعة من هيل اللسن الحداد
لي يهووا النقّال كما الشرب والزاد
مدحّقين المجاد
يدوسوا عا المجد أما يخلّوه رقاد
ولا سمعوا عتب يعملوا عليه عياد
يعملوا عليه ركان بناء عليه وشيّاد
يشيدوا عليه قصور بني بلا عماد
شرح القصيدة:
للشعر العامي مميزات كثيرة من أهمها قدرته على التأثير في المتلقي؛ فهو يجمع بين الصنعة والعفوية، وهو أقرب إلى الفطرة، وأكثر صدقًا مع النفس، والشاعر ينقل إلينا تجربته الشعرية بتلقائية وصدق من غير مبالغة أو إسراف في تصنع البديع أو امتثاله، كما أن لهجته العامية تجعله محببًا إلى النفس، ولعل ذلك يرجع إلى قوة التواصل بين الشاعر والمتلقي.
والقصيدة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للشاعر الكبير كرامة بن عمرو بن حمادة، وهو غني عن التعريف، فقصائده الكثيرة والمتنوعة معروفة لدى الجميع، وهو في هذه القصيدة ينقل إلينا تجربة شعرية صادقة، فأنت تلمس فيها تلك الحياة البدوية البسيطة الساذجة، فالأفياء والصيق والجبال والوديان والبيئة الحيوانية تحس فيها ارتباط الشاعر بتلك الحياة، كما أن فيها إحساسًا قويًا بحب الأرض والوطن، ثم تلك الصفات الجميلة التي نكاد نفتقدها في حياتنا الآن، كالكرم والشجاعة والشهامة والصدق والوفاء وحسن الجوار والصحبة، كما استطاع الشاعر أن ينقل إلينا طريقة تربية أبناء الريف وتنشئتهم، إضافة إلى وصف رائع لحق الجار والسعيف، وضرورة الحفاظ على السمعة من أصحاب الألسنة الحداد.
تبدأ القصيدة بذكر مجموعة من الأودية والجبال، والحياة البدوية البسيطة، وهي أسماء ليست معروفة عند كثير منّا اليوم، ولنبدأ من حيث بدأ الشاعر:
الفي عا صيق ماد
ويا راد اللواطي هبط عا الحيداد
ويا في الجنْسُر خر فوق الرياد
وغطي عا حيد ظبين فيه وقتاد
مطلع القصيدة بدوي كما يتضح من ألفاظه، فذكر الفيء والصيق، هبط، الينسر، الحيداد، الظبين، والقتاد، كلها ألفاظ تدل على طبيعة الريف البدوية، وهي بيئة الشاعر التي سيطرت على عواطفه ومشاعره، فالفيء امتد على الصيق – والصّيق جمع صَيْق، وهو غور الوادي بين جبلين، ويسمى كذلك صيقة عند التأنيث، والجمع عند التذكير صياق، واللواطي جبل في القدمة أرض الشاعر، والحيداد هي الأخاديد الطينية، والينسر جبل غرب اللواطي ونجده، والظبين واحدها ظِبة، والقتاد مفردها قتادة وكلاهما من الأشجار الشوكية.
فالشاعر يرسم صورة ولكن بالكلمات لمنظر الفيء بنسائمه العليلة، وهو يمتد على الصيق والرياد، ويغطي على جبل فيه الظبين والقتاد، وعلى من أراد أن يصل إلى جبل اللواطي عليه أن يهبط تلك الأخاديد الطينية. فهي بيئة الشاعر والتي اعتاد العيش فيها لذا يقول:
دحق فيه وعتاد
حلّ فيه وانقل ودّعه ونا شاد
فتلك الأماكن اعتاد الشاعر أن يمر فيها، ويحل وينتقل منها إلى غيرها على طبيعة البدوي في حِلّه وترحاله، ويودِّعها حيث يشد الرحيل؛ فهي حياة بدوية، تتميز بعدم الاستقرار:
شد عا الحيّاق ونجد مع النجّاد
وعا حل النجود نقل الفرش والزّاد
الحياق إلى الجهة البحرية عكس النجد، فالشاعر متجهًا جنوبًا، وينجد أيضًا إن استدعى الأمر ذلك، وإن كان يحل النجود ينقل إليها فرشه وزاده:
والغراء والمذاليل عا غلاظ الكباد
وتوجّه قدا أرض لي فيها مواد
الغرو هو ابن الماعز، والمذاليل الأطفال الصغار، وغلاظ الكباد هي الجمال القوية، فالبدوي ينقل فرشه وزاده وأغنامه وأطفاله، ويتوجه إلى أرض يعرفها له فيها مواد، وهي:
من بين يوهب وهنف اتّاصيق شدّاد
وعا تَوّه مشرّق اتّا خطي المدواد
يوهب وادي يصب في وادي ضبق هزاول، وهنف أيضًا وادي، (اما) بمعنى إلى، (اتا) بمعنى حتى. هذه الأودية التي ذكرها الشاعر هي أماكن يألفها ويتوجه إليها مع الشرق حتى يتجاوز المدواد وهو اسم موضع.
وساعة قدا الفرش والرهاو ذاك المداد
وساعة عزم جاد
اتّا الخامر وقي حيت الحفوف شاد
الفوهة اتّا الصيقة يخلّوها بلاد
الفرش موضع، والخمر وقي واديان، والفوهة هي فتحة الوادي، فالشاعر يتجه إلى هذه الأودية ذات الاتساع والامتداد وجوها حاف جاف (حيث الحفوف شاد) كما يقول، والرهاو هي الأرض التي يسيل فيها الماء بهدوء وتمهل:
تسمع حنين الحفا وكم من حوار ناد
وهدار كل معواد
ورغا المعزوفات عا زمّ المشاد
وعا صوات الغواد
بعد أن ذكر الشاعر الأودية والجبال التي كانت مراتع له أخذ يتحدث عن البيئة الحيوانية، فيذكر النوق؛ فهو يتسمع حنينها حين تفقد (حوارها) الذي (ندّ)، أي: ضاع، أو هرب، فهي تردد أنينها على ابنها المفقود، ويسمع أيضًا هدير الجمال وبخاصة (المعواد)، وهو المعتاد على الهدير في فصل الخريف، ورغا المعزوفات، والمعزوفة هي أول ما يطرح الرحل عليها، يقول الشاعر عبود بن عمرو الغتنيني:
الحمول مسوح وصـب محد يحمّل عامعـزوف لا هو عاده ما نقضـب
أمّا الغواد فجمع كلمة غادة، والغادة هي الفتاة الجميلة الفتية، وهي هنا البنت الراعية التي تصوت على أغنامها، فنجد هنا بيئة حيوانية مصورة حكايات بكلمات الشاعر تصويرًا رائعًا وشيقًا، فالنياق التي تنوح وتبكي وتردد حنينها على ابنها المفقود، وجمال اعتادت على الهدير، والراعية وأغنامها، كل ذلك يخلق صورة ناطقة لحياة بدوية بسيطة وسهلة.
يتكثّحوا الفاريق متولّدات وولاد
وفصول دون السنة كما بطوخ الزّباد
بيض قس كما الفضّة عا قصف النّجاد
والرصص تعملن حوابس تحت كل محياد
والربّ فوق الصفين كما صماغ القتاد
يتكثحوا، أي: ينكبوا، والفاريق المقصود الفرق وهو الجمع الكثير من الأغنام التي قد ولد بعضها والبعض الآخر في طريقه إلى الولادة، ويصفهن بأنهن (كما بطوخ الزباد) كناية عن الامتلاء والسمن، ويصف اللون ويشبهه في البياض بالفضة، كما قصف النجاد والنجاد ما بين الكتف والرقبة باتجاه الظهر وباتجاه الصدر والبطن، ويميل من اليمين إلى اليسار، ويطلق عليه البدو (التنجيد)، ثم يذكر التمر الذي يتم رصه على بعضه، وحين يسيل منه الرُّب فإنه يعمل حوابس، ورص التمر يتم على الصفين تحت سند الجبل، ولذا يذكر المحياد وهي الغرف العالية في الجبل، فالرُّب الذي يسيل يعمل حوابس تحت أسناد الجبل، ويشبّه الرُّب بصمغ القتاد، وهو الصمغ الذي يخرج من شجر القتاد، وكان يشرب كدواء للصدر.
ولحوم المقانيص عاملين غدّاد
تشاتير المتان كما شحف الكناد
المقانيص هو ما يقنص من الصيد، ويتم تقطيعه على شكل أمتان مشترة، يشبه الشاعر لحوم هذه المقانيص بشحف الكناد، والكناد هو أصل الشجرة وجذعها القديم عند شقه بالفأس يطلع شحف مثل لحم المتن.
ويا كم من وعل غسى الشّوعه وناد
يخلّوه مهدان كما لحوم العياد
بسكُنْ شغل الغيل قطيع فيه وقدّاد
يذكر الشاعر الوعول التي يتم اصطيادها، والتي تسقط سقوط الغصن من الشجرة، والشوع هي قرون الوعل، وهي وافرة اللحم، وهو ما عبرت عنه كلمة مهدان، ومن كثرته يشبهه بلحوم الأعياد، وأن هذه اللحوم تقطع بسكن مصنوعة في الغيل وهو غيل بن يمين، ثم تؤكل هذه اللحوم أو تقدَّد، والتقديد تقطيع اللحم بشكل طولي ثم يعلق على الحبال، والتقديد وسيلة معروفة لحفظ اللحوم وأكلها عند الحاجة.
تلاهيم عا قلبي عا يردّوا جداد
تلاهيم، أي ذكريات عادت جديدة عند الشاعر حين بدأ يسترجع ماضيه الذي انقضى كالحلم الجميل، وفي اعتقادي أن كلمة تلاهيم هذه هي مربط الفرس في القصيدة، فما حدث للشاعر جرّ إليه كل تلك الذكريات، فماعاناه من سوء الجوار جعله يتذكر بيئته البدوية القديمة على بساطتها وعيشها الهنيء والنوايا الطيبة التي تكتنف أهلها ومشاعر الحب الصادقة والأخوة والوفاء والتسامح، والشاعر لم يذكر تلك البيئة اعتباطًا وإنما هو يربط موضوع القصيدة بخيط شعوري واحد، جعل هذه الذكريات تنساب على الشاعر، فيتذكرها رغم بعدها الزمني، فهي مهده الأول ومكان نشأته، ولها في نفسه حنين وذكريات لا تقاوم.
وطني وله شوق بنى فوق الفواد
وفيه لي تقاديم من تخاليف الجداد
فالشاعر يتذكر وطنه وموطن ذكرياته، وله في نفسه شوق لا يستطاع وصفه سوى بقوله (بنا فوق الفواد)، وهي كلمة جامعة مانعة لحب الشاعر لوطنه ألم يقل شوقي:
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي
ويقول أبو تمام:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول منزل
وللوطن في نفس الشاعر ذكريات من زمن أجداده، وقد أعطت كلمتا التقاديم والتخاليف معنىً جميلًا لمدى الترابط بين الأجيال، والمقابلة اللغوية أعطت صورة جميلة تحدث في النفس شعورًا عاطفيًا يعمق ارتباط الإنسان بوطنه إلى جانب ذلك الإيقاع الموسيقي الذي أحدثته المطابقة والمجانسة بين الكلمتين، ثم يصف الشاعر العلاقات والصفات في موطن ذكرياته:
قسا فيه وعناد
لين فيه وسخا كرم فيه الوفّاد
قلبي قده واد
وفيني عليه ولف وشوق معاد ينزاد
وان فارقيته وكاد
قلبي بقى عنده مع الناس الجواد
فموطن الشاعر فيه صفات القسوة والعناد واللين والسخاء والمروءة والكرم حين يفد إليه الضيوف، وقلب الشاعر ممدود إلى وطنه وله إليه شوق وولف ليس عليه من مزيد، وإن جرته ظروف لمفارقته فإنه يرحل بجسمه فقط أما القلب فهو في الوطن هناك حيث الناس الأجواد.
طريين ووداد
سخيين وكرام عا ذاك يوجاد
يصف الشاعر أبناء وطنه الأجواد بالمحبة والإخاء والود والسخاء وبذل كل ما يملكون وما يوجد لديهم، فهم ليسوا بخلاء بما تحت أيديهم أليس الجود بالموجود؟
ولا هم حسّاد
إن جاء لحم طري مع خبز موقاد
خبز موقاد، أي: الخبز الذي يدفن في الرماد الحار حتى ينضج، وهي عادة معروفة عند البدو في إنضاج طعامهم.
وان هو قضيم ولبن مفوّرين بنقاد
وفوقه كلام ساد
مفورين بنقاد، أي: ناضجين، ونقاد هي الحجارة التي تكون على المضابي فتتحول إلى جمرة من شدة النار ينضج بها اللبن، والقضيم (حب الذرة)، والشيء المهم أنها توضع في إناء غير معدني عند إنضاجها، يكون لها مذاق خاص ولذيذ، ثم إن الأكل وحده لا يحلو على بساطته إلا إذا كان عليه كلام جميل عذب، ولذا يقول الشاعر: (وفوقه كلام ساد).
فوقه هذيف حلو ذكاء فيه وفنّاد
مفصّحين الكلم أن بغوا قدا البدّاد
فالأكل عليه كلام جميل، فيه تفنيد وذكاء وكلام فصيح إن أرادوا أن يسلكوا سبيل الفصاحة والفطنة والإطالة في الكلام.
وان بيوجزوا شداد
معكّيين الكلم صعيبات وعداد
يدوّروا عاجمل لي هي متوجاد
امّا القبيل يوقف والريق فيه يعقاد
فالشاعر يصف رجال موطنه بالكرم وحسن الضيافة والقدرة على الكلام، فكلامهم أو هذيفهم كما يقول حلو فيه ذكاء وتفنيد وفصاحة، وإن أرادوا الإيجاز فإنهم يأتون بالكلام الصعب العكي الغريب، حتى إن خصمهم يتوقف عن فهمها واستيعابها، ولا يملك لها ردًا ولا جوابًا، وينعقد ريقه في حلقه من شدة الانبهار، فيصيبه العي ولا يستطيع رد جواب كلامهم. ثم يتحدث الشاعر عن أسلوبهم في تربية الأبناء وتنشئتهم فيقول:
والولد يرشدوه من أول ما يوجاد
ولاشبّ وكبر يفحسوه النقّاد
إمّا يظهر معدنه عا كير حدّاد
فسِل وان كان جاد
فهم يعلمون الولد ويرشدونه من أول ما يوجد، حتى إذا كبر وشب جاء دور النقاد فينقدون تصرفاته ويوجهونه إلى الطريق القويم، ولكلمة يفحسوه معنى جيد في الاختبار، فهي تعطي صورة حسية؛ لأن الفحس يتم باليد وإن كان المعنى معنويًا غير حسي، ولذا أعطت صورة الفحس التمييز الجيد، فهم يمتحنون الولد فكأنهم الحدادون الذين يمتحنون الحديد بالنار ليعرفوا جيده من فاسده، والعقلاء والحكماء، وهم الذين أطلق عليهم الشاعر (النقاد) هم من يحدد إذا كان الولد جيدًا أم فسلًا من خلال تصرفاته وأعماله، ثم يتصرفون مع كل واحد حسب نوعيته:
الفسل يخلّوه يرقد مع الرقّاد
دفه ما يشتل يقع فوقه هناد
فالولد الفسل الخائب يتركونه يرقد وينام، حتى إنه لا يستطيع أن يرفع جفنه من على عينه من شدة الكسل والنوم، وقول الشاعر: (يقع فوقه هناد)، أعطت صورة مبتكرة للكسل عند الولد الخائب الذي لا نفع فيه.
وان جاد يمدحوه بثناء عليه ونشّاد
يقعوا عا طرافه حديد تحت حدّاد
يسهروا معه الليل امّا يعدّي قواد
ذكر الشاعر التمحيص الذي يحصل للفتى في حياة البوادي حتى يتميز معدنه، ويعرفون صفة ذلك الفتى فينزلونه موضعه اللائق به، هناك موضعان يصنف إليهما الفتيان في مقتبل شبابهم هما الفسل والجيد؛ والشاعر هنا يعطي صورة دقيقة لحساسية مجتمع البادية القبلي لنوعية الصفات التي سيحملها هذا الشاب أو ذاك، وحبهم لصفات الشهامة والنخوة واعتدادهم بها؛ فلشدة توقهم لمعرفة ما سيكون عليه الفتى يختبر (يفحسوه النقاد) أول ما يشب، وقد قال أحد شعرائنا في ذلك:
والآدمي عند مطلوعه تشوف الدلول
وقد ذكر الشاعر الصنف الأول (الفسل) بإيجاز بليغ (يخلوه)، فهو مهمل غير مرضي عنه في ذلك المجتمع، ولذلك (خلاه) الشاعر وأهمله ولم يعطه أكثر من بيتين، بينما فصل وأطنب في ذكر (الجيد) وكأنه فرح بسرد صفاته فرحًا مستمدًا من فرح أهل البادية واعتزازهم بصفات هذا الفتى الشهم الجيد الذي يعد عضوًا قويًا وسندًا لعشيرته، فذكر أن هذا الجيد يمدح ويثنى عليه ويفتخر به قولًا وترفع منزلته ويؤازرونه فعلًا (يقعوا عا طرافه)، أي يكونون محيطين به مستعدين لتنفيذ أوامره وما تمليه عليه همته العالية وشهامته مهما بلغت صعوبتها كأنهم (حديد تحت حداد)، و(يسهروا معه الليل)، وهذا تعبير عن اهتمامهم به، وتصوير لمجتمع البادية وبنيته القبلية المتماسكة، الذي تتجلى فيه سمات التآلف والإخاء والتلاحم.
ولفظة (قواد) مستعارة من السقي بالماء الجاري المندفع تعبيرًا عن الاستمرار بقوة وإكمال الشيء باقتدار؛ يقول الشاعر عبود بن عمرو الغتنيني:
نا حضرت في زام العناد واليوم تخفيفي معي واما الثقيله عالنجاد
ما بيت قصّر ذيه المواد وأما الزمان السابقي ضاري نسقّي به قواد
وفي اصطلاح البحر يقال: (نمشي قواد)، أي: باتجاه واحد .
ثم استطرد الشاعر، وخرج إلى عد صفات رجال البادية، التي يعتزون بها ويعتدّون بأهلها فيقول:
قويين ونجاد
طرشين وذفاف منقوزين ووكاد
رجال محسوبين مع كل مطراد
فمن أبرز صفاتهم القوة؛ قوة البدن وقوة العزيمة، وهم (نجاد) جمع نجيد، وهو الفتى القوي، وأكثر ما يطلق هذا الوصف على الجمل، ويستعار كثيرًا في أشعارهم للرجل المقتدر الذي يؤدي مهامه بهمة ونشاط، ويتصفون مع ذلك بالسرعة والخفة (طرشين وذفاف)، ويكونون دائمًا على أهبة الاستعداد لكل طارئ، (منقوزين ووكاد) يستجيبون للنداء ويهبون للنجدة.
يجيب بلبيه إذا ما دعوته ويحسب ما يدعى له الدهر أرشدا
وبصفات النجدة والنخوة والقوة التي يمتازون بها والتي تؤهلهم ليكونوا (رجال محسوبين مع كل مطراد) ومحسوبين في اللهجة المشقاصية تساوي معدودين التي يمدح بها العرب رجالهم، وذكر المطراد وهو مطاردة الغزاة وأهل النهب والسلب؛ لأن هذا الوقت خاصة يتنادى فيه الرجال ويعد فيه الشجعان والأبطال ويذكرون.
وخص الشاعر حالة المطراد، ومدح الذين يعدّون في هذه الحالة؛ لأن مجتمع المشقاص بصفة عامة مجتمع آمن مسالم لا يميل إلى الاعتداء، ولكن إذا اعتدي عليه في نفس أو مال فإنه يردع المعتدي ويرده خائبًا، وتتجلى حينئذ شجاعته وشهامته.
ولا يبغوا الهوّاد
ولا يقبلوا الذُّل وكلام فيه الندّاد
ومن صفاتهم أيضًا الأنفة والعزة؛ فهم يأبون الضيم والنقص والعيب، ولا يخفضون رؤوسهم بذل، ويعدون ذلك عارًا تزهق أرواحهم دونه .
و (الهوّاد) هو الإشارة إلى الرجل بالعصا أو اليد ونحوها ورفعها عليه تهديدًا له، وهم لا يرضون بهذا ولا يقبلونه، ويحتمل معنى آخر أنهم لا (يهودوا) ويتوعدوا، وإنما يفعلون ما توعدوا به .
وعا الصبر جماد
معروفين بالصبر رزينين وركاد
وان سقط فيهم قتيل ما يعملوا حداد
ولا يظهروا الحزن ولا يبغوا العدّاد
ذكر الشاعر هنا إحدى الخلال التي يتمتع بها أهل البادية ويتسمون بها وهي الصبر، وبلغ الشاعر بالوصف إلى منتهاه البلاغي حين شبههم بالجماد في الصبر، كأنهم لا يحسون، وهو تشبيه من البلاغة بمكان. فهم معروفون بالصبر في كل أحوالهم، الصبر على تحمل المشاق والصعاب، والصبر حين يصابون بما يؤلمهم لا تهزهم النوازل ولا تزلزهم الحوادث؛ فهم (رزينين وركاد)، أي: يتصفون بالحلم والأناة، فالرزين في اللهجة هو ذو العقل والحلم والوقار، الذي لا يتسرع ولا يتعجل، وقريب منه معنى (الركاد)، يقولون فلان (يتركد)، أي: يتملى في الأمور، ويعيد الفكر، ويطيل النفس، ولا يتعجل، وهو يتناسب مع المعنى الفصيح للركود وهو السكون، يقولون ركد الماء سكن، وكذا الريح والسفينة قال تعالى: [فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ] [الشورى: 33].
ونتيجة هذه الصفة الحميدة أنهم إذا سقط فيهم قتيل يلجأون إلى الصبر والتجلد، فلا يقومون بالحداد وإظهار الحزن والجزع، ويدفعهم إلى ذلك شيء آخر غير الصبر وهو الأنفة والخوف من الشماتة، ومن أمثلة المشقاص (لا قلت أح العدو يفرح)، وقد كان العرب يفعلون ذلك؛ فقد فعلته قريش حين قتل زعماؤهم وأبطالهم في معركة بدر؛ فعندما رجعوا إلى مكة بمصابهم الجلل نهوا عن البكاء على القتلى وندبهم أنفةً وكبرياء؛ لئلا يرى فيهم ضعفًا وذلة، وكان فيهم شيخ كبير يتصبر على بكاء بنيه على مضض، فسمع ذات ليلة امرأة تبكي، فقال: انظروا هل أذن للناس بالبكاء؟ فرجعوا إليه وأخبروه أنها امرأة تبكي على جمل لها ضاع فازداد حسرة، وقال قصيدة منها :
أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهودُ
فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدودُ
(أي الحظوظ).
وكثير من الصفات والعادات التي كانت سائدة عند العرب القدماء نجدها ماثلة في مجتمع المشقاص وفي باديته على وجه الخصوص .
ثم إنهم مع ذلك (لا يظهرون الحزن)، وهذا تعبير غاية في الدقة وحسن التوصيف كما هي عادة شاعرنا الشيخ المقدم كرامة بن عمرو بن حمادة الثعيني، ودقة الوصف هنا تتمثل في أن الحزن على فقد أحدهم مضمر في نفوسهم وساكن في قلوبهم، لكنهم لصبرهم وجلدهم لا تظهر عليهم آثاره، فالحزن موجود لكنه غير ظاهر، ولذا نفى الشاعر إظهاره ولم ينفه .
وفي سياق ذكر صبرهم وعدم إظهار حزنهم يعرج الشاعر على عادة كانت ترافق الحزن وتعبر عنه وهي (العدّاد)، وأخبر أن هؤلاء الموصوفين (لا يبغوا العدّاد)، ولا يبغوا في المشقاص، تعني: الرفض لهذا الشيء، والعدّاد هو ذكر من فقد أو قتل وتعداد صفاته ومحاسنه، وهذه عادة عند عرب الجاهلية ويسمونها (الندب)، وكانت الفتاة في بوادي المشقاص إذا أخبرت أن هذا يوم زواجها، وهو ما يسمى (الربوط)؛ حيث يلقي عليها والدها فوطة، ويخبرها بأنها عروس لفلان، وتبدأ مراسيم الزواج حينئذ، وفي هذه اللحظة تبكي و(تعدد).
ولا يظهروا الشينه مهما الكلام زاد
الكلم لي من لسنهم قروش عند عدّاد
ومن صفاتهم الحسنة التي يمتدحون بها أنهم لا يتلفظون بالكلمة الفاحشة مهما زيد عليهم في الكلام واشتد المراء، فهذا لا يدفعهم إلى النطق بالكلام السيء، الذي لم تعتد عليه ألسنتهم، وهذه القاعدة الأصيلة أكد عليها الشاعر كرامة بن حمادة في قصائد أخرى، بل كثير مما ورد في هذه القصيدة الجامعة الرائعة نجدها في أشعار أخرى للشاعر نفسه، أو لآخرين من شعراء المشقاص، فيقول في عدم صدور الكلام الشين منه:
ما لي في الكلام الشين فيده لا بعد وراح وتوزع في الجهين
وفي قصيدة أخرى يقول :
الكلام الزين حبوب ما لي في الكلام الشين لا طمع ولا مكسوب
ثم يذكر الشاعر أنهم يعدون كلامهم عدًّا ويحسبونه، وكأن ألفاظهم قروش تعدّ وتحسب، فهي كلمات نقية صافية ذات فائدة وقيمة .
الجار هو والسعيف يقعوا به وكاد
يقعوا عليه حرس وصباع فوق الزناد
مرفعين المجاد
يصبروا عالجار ولا يقوم هدّاد
ولا زيّد الشينه يزيدوه وسّاد
تحفظ عالسمعة من هيل اللسن الحداد
لي يهووا النقال كما الشرب والـزاد
الجار والسعيف (المصاحب) لهم حقوق عظيمة في أعراف المشقاصيين كغيرهم، فهم حريصون أشد الحرص على حفظ الجوار والإحسان إلى الجار أينما حلوا وحيثما نزلوا، وكذلك السعيف وهو المصاحب لك في الترحال أو السفر ونحوها، فمن العار أن يضام الجار أو السعيف أو يصاب بأذى دون أن يقوموا بنصرته وحمايته ولو ضحوا بأرواحهم فلذا (يقعوا به وكاد)، أي: مراعين له، جاهزين في أي وقت لنفعه ونصرته وكأنهم حرس حوله في كامل جاهزيتهم (صباع فوق الزناد)، وأصحاب هذه الصفات الجليلة وصفهم الشاعر بأنهم (مرفعين المجاد)، فهم يبنون أمجادًا عالية بصفاتهم ومحاسنهم التي استطرد الشاعر في عدّها والإشادة بها. وتتميمًا لحفظ الجوار وتكميل حقوقه؛ فإنهم يصبرون على ما يبدر من جارهم من إساءة أو زلة؛ فيتجاوزون عنها ويغضون الطرف حتى وإن بالغ جارهم في الأذى، أو زاد فيما يسوؤهم (ولا زيد الشينه يزيدوه وسّاد)، فيعاملونه بلطف وحلم وكرم حتى لا يتحدث الناس عنهم بإساءة الجوار ويعمهم الذم كلهم، ولذا قال: (تحفظ عالسمعه من هيل اللسن الحداد)، وهم المتربصون الطالبون للزلات، كما قال المتنبي مخاطبًا أمثالهم :
كم تطلبون لنا عيبًا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرمُ
وهنا وصف رائع من شاعرنا الشيخ كرامة بن حمادة إذ وصف هؤلاء بأنهم (هيل اللسن الحداد)، فألسنتهم آلات حادة يفرون بها أعراض الناس، ويمزقون بها النسيج الاجتماعي، فهي حادة تقطع وتجرح وتفسد، والتعبير بالألسنة الحداد تعبير قرآني إذ يقول جل شأنه: [سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ] [الأحزاب: 19]، وهؤلاء أصحاب الألسنة الحداد الذين لا يخلو منهم مجتمع وصفهم الشاعر بأنهم هواة للقدح والانتقاص من الناس وعيبهم ونشر معايبهم أو ما يظنونه معايب، بل أصبح ذلك عادة وضرورة لعيشهم مثل الأكل والشرب.
مدحقين المجاد
يدوسوا عالمجد إما يخلوه رقاد
ولا سمعوا عتب يعملوا عليه عياد
يعملوا عليه ركان بناء عليه وشيّاد
يشيدوا عليه قصور بني بلا عماد
أولئك الخارجون عن قيم المجتمع ومبادئه، الهادمون لمبانيه وصفهم الشاعر بأنهم (مدحقين المجاد)، في مقابلة مع أولئك الذين أثنى عليهم وأشاد بصفاتهم الفاضلة (مرفعين المجاد) وهاتان الصفتان تتفرعان عن التقسيم الأول: الفسل والجيد، وأصبحتا ناتجتين عنهما ومآلًا لهما، إما أن يرفع المجد أو يهدم ويداس بالأقدام ولا تبقى له قيمة ولا اهتمام عندهم. وإذا سمعوا بحدوث شيء يلام فاعله وهو (العتب) يفرحون بذلك أشد الفرح وكأنهم في عيد، وينقلونه ويزيدون فيه ويبالغون، يبنون من ذلك الشيء الصغير قصورًا عظيمة، ويبالغون ويسارعون في البناء (بناء عليه وشيّاد)، لكن تلك القصور الكاذبة الواهية سرعان ما تتهاوى وتنهار؛ لأنها لا أساس لها ولا أعمدة، وسرعان ما ينكشف زيف هؤلاء النقالين، وتبين حقيقتهم وضعف نفوسهم .
الخاتمة
إن هذا النص الشعري يعدّ من روائع الشعر المشقاصي، وقائله من أبرز شعراء المشقاص، شاعر مجيد له باع طويل في صناعة الشعر، وهو نص فريد في بابه، تناول بالوصف الدقيق حياة البادية، وصور مشاهد من يوميات البدو في حلهم وترحالهم وانتقالهم مع مواشيهم من وادٍ لآخر، وذكر تفاصيل من طرائق معيشتهم، واستقبالهم لضيوفهم وإكرامهم، وبعض عاداتهم وصفاتهم، وعرج على ملامح من أساليبهم في الكلام والشيم التي يتحلون بها من شجاعة ونجدة وحفظ الجوار. ومبرزًا مظاهر من السمات القبلية الأصيلة التي يتغنى بها، ولا ينسى أن يذم صفات النقص التي لا يخلو منها مجتمع.
ويتوسط القصيدة الشوق إلى الوطن ومحبته الكبيرة التي طبعت في قلب الشاعر، وكأن هذا الشوق هو المحرك الأساس للقصيدة والدافع إلى إنشائها وإنشادها؛ إذ قيلت هذه القصيدة في المهجر في دولة الكويت، مما حدا بالشاعر إلى ذكر وطنه، وتسمية الأماكن التي ألفها من جبال وأودية، واستذكار صفات أهلها.
هذه القصيدة الجميلة بدوية خالصة، فاللون الشعري الذي كتبت عليه هو صوت الكرام (الحداء)، وهو لون من الشعر البدوي المرتبط بالفيء وامتداده على الأودية والوهاد، والشاعر سليل تلك البيئة البدوية، ووفي للانتماء إليها، فهي قصيدة بدوية خرجت من بين الجبال الشاهقة والأودية السحيقة لتتحدث عن البادية.
مقدمة القصيدة جرت على عادة قصائد الكرام في الابتداء بالفيء وذكر المواقع والمواضع التي يحن إليها الشاعر، فهي شبيهة بتقليد الوقوف على الأطلال في الشعر الفصيح، وقد قرأ بعضهم مقدمة القصيدة على الشاعر كما وردت في ديوانه (الفي عالصيق ماد)، فقال: إنها (الفي عاصيق ماد)، أي: على صيق محددة معلومة، وليست مطلقة، وهذه لفتة بديعة تدل على دقة اللهجة المشقاصية وقدراتها التعبيرية والحس المرهف بجماليات هذه اللهجة.
النص غني بالصور البلاغية من تشبيهات واستعارة وكناية، وكلها مأخوذة من بيئة الشاعر، ويكثر التشبيه باستخدام (كما) أشهر أدوات التشبيه في اللهجة، وتظهر في النص ظاهرة أخرى يبدع الشاعر في توظيفها، وهي المقابلة والأضداد، حتى كأننا بين صفحتين متقابلتين بدءًا من الراد وهو تحول الظل من جهة إلى أخرى، مرورًا بالمكوث في مكان والانتقال منه (حل فيه وانقل)، وأيضًا النجد والحيق الشمال والجنوب (شد ع الحيّاق ونجد مع النجّاد)، فالشاعر يأخذ في تصوير شيء ثم ينتقل إلى ضده أو الجهة المقابلة له، ومنها (قسى فيه وعناد ولين فيه وسخاء)، وكذلك المقابلة بين (الجيد والفسل)، و(مرفعين المجاد)، و(مدحقين المجاد)؛ وهي ظاهرة تكاد تكون ملموسة في شعر ابن حمادة .
هذه المقاطع التي أوردناها منفصلة هي في حقيقتها قطعة واحدة متماسكة، ونفس شعري واحد لا يتجزأ، ونفثة إبداعية من إبداعات الشاعر المقدم كرامة بن عمرو بن حمادة الثعيني أجاد سبكها وأتقن نظمها.