ملف
د. عبده عبدالله بن بدر
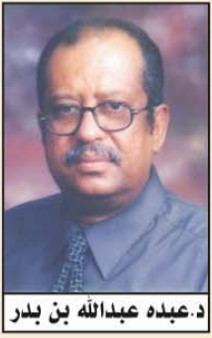
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 13 .. ص 68
رابط العدد 13 : اضغط هنا
لم تقرر المجموعة الصغيرة التي أزمعت الذهاب معها إلى ريدة (عبدالودود) الرحلة بنفسها، بل ذهبت استجابة لدعوة كريمة من شيخ ثعين الشاعر (كرامة عمرو بن حمادة)، ما إن وصلنا إلى الريدة واقتربنا من بيت الشيخ وجدنا أنفسنا محاطين بحفاوة ما بعدها حفاوة من الشيخ نفسه الذي تصدّر الترحيب مع أهله ومقربيه وأصدقائه وممثلين من أهل ثعين، وعبّر الجميع عن هذه الحفاوة ليس بالمصافحة حسب بل بتعابير وجُوههم وكلمات الترحيب الحارة التي انطلقت من حناجرهم مصحوبة بابتسامات تحف بنا وتغمرنا كلما نظرنا إليهم.
إن الحفاوة التي حظينا بها كانت مؤشرًا بالنسبة لي ليس على نقاوة أهل هذه البلدة الطيبة وتقديرهم للضيوف حسب، بل حسهم العالي بمقام الرجال ومكانتهم ولذا رفعوا من سقف التقدير حين علموا أن المجموعة المستضافة نصفهم من كلية الآداب (جامعة حضرموت)، والنصف الآخر من المعنيين بالثقافة ويقدرون المشقاص وأهلها، والبعض على تواصل ومقربة منهم، بل من أهلها مثل (بورح) المطري وباسل باعباد وعبدالرب الحوثري. كان الاستقبال مدنيًا لم تمارس فيه طرائق الاستقبال القبلية المتمثلة في إطلاق الأعيرة النارية المرافقة بالزامل المعتاد في الترحيب بالضيوف. حمدت الله على هذه الطريقة المتحضرة. وقلت لنفسي لقد تغير الناس وتغيرت المرابع ولم تعد كما كانت. بل تغيرت طريقة السكن التقليدية التي اعتاد عليها أهل الوديان واستبدلوها بمساكن من الخرسانة. وتبدلت طريقة الغذاء ونوعيته حتى الملابس لم تعد هي الملابس فلم أر من يلبس المئزر الأسود المصبوغ بالنيل ليتناغم مع لون الصحارى والوديان، كما لم أسمع أصوات الجمال ورغاءها، بل سمعت أصوات (ليلى علوي) وأخواتها وكل شيء يتغير ولم يبق الحال هو الحال ويصبح الماضي كما يقول (دايفيد لوينثال بلدًا أجنبيًا). نعم يصبح الماضي غريبًا بعاداته وتقاليده وقيمه وثقافته في الملبس والغذاء. فبعد وجبة الغداء قدم لنا (الكيك) على الطريقة الإفرنجية وهي عادة في الأكل لم يعرفها أسلاف الريدة وعرفها أخلافها، فضلًا عن أنواع من الغذاء ليس من المناسب ذكرها هنا.
إن الماضي على غرابته في لحظة من الزمن لا يمكن إهماله وتجاوزه بل علينا أن نفهمه ونتبصره، وإن اضطررنا تعلم لغته بأبعادها الثقافية والحضارية هكذا حدثتني نفسي حين مضت بي الذاكرة إلى الزمن الذي ولّى، وتأكد لي أننا لن نستطيع أن نصنع المستقبل إذا لم نفهم الماضي ونرفع كل عقبات الحاضر البائس اللئيم بغض النظر عن المقولة التي عدت الماضي بلدًا أجنبيًا لم نطل الوقوف خارج البيت. بل تتابعت خطوات المجموعة المستضافة إلى الداخل واستقربنا المقام بالجلوس في ديوان عدّ لنا قبل أن نأتي، لفت نظري بساطة المجلس وغياب مظاهر البذخ فيه، بل ليس هناك من علامات تدل عليه لا من قريب أو من بعيد. نظرت في (بن حمادة) فتحققت من سريان البساطة والتواضع ليس في المكان حسب، بل في الإنسان (بن حمادة)، الذي كان يلبس مئزرًا أبيض وقميصًا أشد بياضًا ويلف على رأسه عمامة بيضاء لا تختلف في لونها عن القطع التي تغطي جسده، وشوشت في أذن صديقي وقلت له إن شيخنا ليس مثل شيوخهم يراهم المرء يتمنطقون الجنابي، ويحيط بهم الحراس المدججون بالسلاح الأبيض والسلاح الناري. إن (بن حمادة) لا يريد أن يمُيز نفسه عن الآخرين، ولكنني استدركت وقلت إنه يمتاز عن الآخرين بقوله للشعر وإذا كان أولئك الشيوخ مدججين بالسلاح فهو مدجج بالموهبة الشعرية وهي وحدها تفوق هذه المظاهر البليدة والعابرة. وهتفت في أعماقي يحيا الشعر، حاولت أن أعتدل في جلستي وآخذ حريتي في الحركة فلم أستطع، لقد ضاق بنا الديوان على سعته فانتبه (بن حمادة) ونطق بطريقة عفوية وقال (المتحابين يكفيهم شبر)، إنها عبارة مكثفة لها دلالة إنسانية عميقة فالمكان لا يضيق بأهله إذا كانوا على ود وتراحم ومحبة ويضيق بهم المكان إذا انعدمت هذه الخصال الرائعة. وجدت الفرصة مناسبة لـ أساله عن ديوانه وهل هو راضٍ عنه؟ وما هو رأيه في تبويبه وعنوانات قصائده، ومنحه حق الريادة في الشعر الشعبي المشقاصي، أجابني: بأنهم هم الذي جمعوا وصنفوا وبوبوا، وهم من أطلق عليَّ هذا اللقب ولم أطلقه على نفسي، وأرى أن هناك شعراء كِبار في المشقاص هم من يستحقون لقب الريادة، أما عن عنونة القصائد فقد أكد لي (بورح المطري) أنها من وضع (بن حمادة) نفسه. وحين واجهت (بن حمادة) بهذه الحقيقة لم يعلق، سألته عن شعر الكرّام وهو الشعر الذي ظل محافظًا على تقاليد لغوية وشعرية تمتد في عمق الذاكرة المشقاصية، تحدث لي بشيء من الاعتزاز عن هذا اللون من الشعر وأكد بأنه ينتج بلغه عربية نقية لم تنل منها يد الزمن وظل هذا اللون بتقاليده الفنية نفسها إلى يوم الناس هذا، ثم أضاف أن هذا الكرّام نوع من (الحدا) يمارس من الذين امتهنوا مهنة الجمالة، فضلًا عن كونه كيانًا شعريًا يلون فضاء الصحاري والوديان وارتبط في مستوياته بالتقلبات التي تحصل للفيء أو الظل. فكل مستوى مرتبط بأشعة الشمس ومدى حضوره وغيابه اليومي في المكان، ففي الصباح يتم الغناء بنوع معين من التكريم، وفي الظهيرة بنوع آخر يقال له (الهوجرة)، وحين تكون الشمس في كبد السماء ويتكون ذلك الظل الذي يسبق الزوال ويقال لهُ (الغونة) ويكون له تكريم خاص، أما لحظة غياب الشمس من السماء فيقال لها (غودر)، وهذه اللحظة لها تكريمها، وهكذا تتنوع أنواع شعر الكرّام بالتغيرات التي تحدث لأشعة الشمس في أثناء دورتها اليومية في المكان، ثم استطرد بن حمادة في الحديث عن الشمس وقال عندما تكون محمرة في السماء يقال لها (عولة) هكذا فهمت من حديثه. ثم تدخل أحدهم وسأل عن مفردة في الديوان لا أدري ما هي بالضبط ولكنها مرتبطة بأصوات الجمال والأغنام فاضطر (بن حمادة) للحديث عن هذه الأصوات. وطريقة الشرب عند هذه المواشي. مثل أول شربة يقال لها (نهول)، وإذا تقرب الشرب يقال لهُ (علول). وشعر الكرّام لأنه ارتبط في بدايته بهذه الحياة البدوية استند في معجمه اللغوي إلى هذه المفردات وحولها إلى مفردات شعرية تحلق في فضاء الشعر.

إن هذا الحديث أدخلني في أجواء هذا العالم التلقائي وتذكرت ما قرأته عن شعر الكرّام فاستحضرت السيد جعفر السقاف وما قاله عن هذا الشعر في كتابه الموسوم بـ(لمحات من الأغاني والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت) ومن ضمن ما قاله: إن القارئ لو أتيح له سماع هذه الكلمات منغمة يتردد صداها بين شوامخ سلسلة جبال الوادي، أو حتى على الشريط المسجل لطرب لها أيما طرب. وكأن جعفر هنا يؤكد أن قيمة هذا النوع من الشعر ليس في قراءته بل في سماعه مغنى فقيمته الجمالية ترتفع حين يتحقق شرط الغناء. واللافت أن السقاف لم يذكر أي علاقة بين هذا الشعر والفيء وتمدادته وانحساراته وغيابه، وباختصار كل ما له علاقة بتقلبات أشعة الشمس، وبدلًا عن الحديث عن هذه العلاقة اجتهد وصنف هذا الشعر في أربعة أنواع، وهي:
1- كرّام السوق 2- كرّام فراق الحبيب 3- كرّام العاشق 4- كرّام تخفيف الحزن عن النفس. ولعل الدافع الذي دفع السقاف إلى هذا التصنيف هو تحرر هذا الشعر من الارتباط بمهنة (الجمّالة) وانفصاله من هذه الضرورة المهنية وتجاوزها إلى عوالم فنية الغرض منها ليس حث الجمال على السير، بل التعبير عن الشجن وحرارة العواطف وتدفقها وتحويلها إلى كيان جمالي شعري الغرض من إبداعه التمتع به جماليًا وفنيًا. لقد انفك شعر الكراّم عن لحظته التي ارتبطت بمهنة (الجمّاله) وأصبح يقال ويُغنى ويتمتع به كل أهل المشقاص. ولم يفتني وأنا أتذكر السقاف أن نذكر الباحث (روبرت سارجنت) أيضًا في كتابه (نثر وشعر من حضرموت) إذ تحدث أيضًا عن هذا النوع من الشعر معتمدًا على (بن هاشم) الذي عدّهُ من الأهازيج البدوية، وهي أنغام عربية تتخلل الأغاني التي يغنونها (للجمال) حين يحدونها للسير ويسمونها (غودره) من الفعل يغودر، ويؤدونها في بعض الأحيان بشيء من التطويل (المط). وقد لاحظت أن بن هاشم قد استعصت عليه كلمات هذا الشعر ولم يعلق (سارجنت) على ما قاله بن هاشم، ويرى أن (لاندبرج) قد درس (الحدا) ولا يخفي على القارئ أن صورة (الحدا) واضحة في كتب الأدب العربي، و(سارجنت) يرى أن هذه الظاهرة دُرست وليس هناك من ضرورة لدراستها مرة ثانية.
أن مسألة استعصاء هذا الشعر على الذي يسمعه أول مرة مسألة بديهية؛ لأن معجمه اللغوي له خصوصيته فضلًا عن ارتفاع درجة الاستعصاء، عندما يُنشد أو يُغنى؛ لأن الكلمات تصبح غير مفهومة. أن فهم هذا الشعر يحتاج إلى أذن مدربة على سماع هذا اللون من الشعر وعلى التصاق حميم بلغته وتقاليدها الصوتية والاشتقاقية والنحوية حتى يستطيع أن يرفع هذه الصعوبة، ويمكن أن يلاحظ معي القارئ التصنيف الذي أدرج فيه هذا النوع من الشعر المُغنى وهو (الغودر). وعلى اختزال هذا التصنيف في لحظة زمنية معينة إلا أنه أكد مسألة مهمة وهي ارتباط هذا الشعر (بالفيء أو الظل). ومفردة (الغودر) ليست غريبة على معجم اللهجة الحضرمية فأهل المكلا يقولون (غدرة – وغدر الليل) ويقصدون أن الظلام بدأ يحل في المكان، وإذا كان هذا الشعر قد استغلق على ابن هاشم والسقاف، فإن أهله الحذاق يفهمونه ويستدركون الأخطاء التي يقع فيها المُلقي لهذا الشعر، ويستبعدون ببداهة أي زيادة أو نقصان تفسد هويته ليس هذا حسب، بل أي خلل في الوزن، ومن المؤكد أن بورح وغيره من عشاق هذا الشعر من الذين يعون هذا الشعر وضوابطه، وكأن التدرب على سماعه مكنهم من تكوين حساسية خاصة استطاعوا بوساطتها أن يلاحقوا كل من يخل بهذا الشعر. وبمناسبة الحديث عن هذا الشعر فقد كان لي حوار مع الصديق عبدالقادر باعيسى عن شعر الكرّام، فقد صرح بأن أوزانه بسيطة وليست مركبة ويذكرهُ بالرجز الذي هو أقرب إلى النثر، وطريقة الرجز من الطرائق القديمة التي يلجأ إليها الشعراء الجاهليون وعلى بساطة الشكل الوزني الذي يمتطيه الرجز إلا أن الشكل استطاع أن يتنفس بوساطته الشعراء ويسكبوا أشجانهم فيه ويحققون مستويات من التعامل الجمالي والفني قد لا تحققها الأشكال المعقدة في بعض الأحيان.

إن شعر (الكرّام) قيل من أجل أن يُغنى وبمناسبة الغناء فقد حظينا بسماع صوت المؤدي البارع سالم علي محمد باعباد، وهو صاحب صوت عذب ممتلئ بالشجن فقد كرّم، ثم أدى لونًا آخر يقال له الشحيب وقد انفعلت بأداء هذا الفنان إذ كنت إزاء طريقة في الأداء غاية في التنغيم، ولم تكن الكلمات مستقلة من اللحن بل مندغمة وشكلت معه ماهية واحدة. وعلى الرغم من أن الزمن الذي استغرقه الفنان سالم كان قصيرًا إلا أنني انفعلت به وأحسست بتحولات وجدانية وجمالية لا أستطيع أن أشرحها باللغة بصورتها الكتابية، وخيل لي أن هذا النغم لا يخرج من فم بشري بل من آلة (المدروف) بكل مستوياتها التعبيرية النغمية التي ترفع من درجة الشجن حين يسمعها المرء فيتسلطن وينسى أوجاعه اليومية. آلة المدروف آلة من آلات النفخ الموجودة في حضرموت. إن سالم في لحظة من الزمان استطاع أن يلغي الوظيفة البيولوجية للفم ويحرره منها، ويحوله إلى آلة موسيقية تؤدي وظيفة جمالية تصدح بالغناء وتصنع الجمال وتفجر في السامع أحاسيس لا يشعر بها إلا من سمعها مباشرة وتذوقها. وقلت بيني وبين نفسي إن الفم خُلق عند البشر ليؤدي وظائف جُلها مرتبطة بالحاجات اليومية لكن الفم عند الفنان من أمثال سالم خُلق للغناء. وقد أخبرني باسل باعباد أن هناك مؤدين لهذا اللون من الغناء لا يقلون تفوقًا عن سالم بل ربما يتفوقون عليه ويمتلكون قدرات باهرة في الأداء من هؤلاء محمد بن لحمان باعباد. فقد كان هذا المُغني يحظى بمكانة عالية في (رغدون)، وقد اشتهر بالدان وهو على قرابة أُسرية من سالم، ويعد سالم امتدادًا أصيلًا لهذا الفنان الذي اشتهر في ربوع المشقاص، فضلًا عن المكرم المشهور حسن عوض الشنيني لشهرته التي ذاعت في فضاء المشقاص لقب بـ(القنبلة)، وشهرته أتت ليس من حسن أدائه حسب، بل من قدرته على أداء ألوان من الغناء المشقاصي لا يستطيع أن يؤديها الآخرون. وفي أثناء الحديث عن هؤلاء المغنين استدرك (بن حمادة) قضية مهمة وهي العلاقة التي لا تنفصم بين الشاعر والملحن في بعض الألوان من الغناء مثل الكرّام والشحيب، فالشاعر ينقاد للغناء ولا ينطق إلا بما يتلاءم مع اللحن الذي ينطلق من حنجرته فالمغنى يحدد له كيفية الإطار المناسب لكلماته الشعرية. إن الدندنة ليست فارغة المعنى واعتباطية، بل تمثل قالبًا موسيقيًا يسكب فيه الشاعر شعره بطريقة ارتجالية معتمدًا فيها على سليقته التي تدربت على سماع هذا اللون من الشعر أو ذاك، وتتنفس تقاليده الفنية الأصيلة. وقد كان (بن حمادة) حكيمًا عندما تحدث عن السوارح، وأشاد بدورها في تنظيم حياة الناس في ذلك الزمان ولم شملهم تحت لواء القبيلة ورص صفوف أفرادها من أجل مواجهة المخاطر المحدقة، وقد كانوا في أشد الحاجة لهذه الوحدة، واستطاعوا بهذه السوارح أن يتخطوا مشاكلهم، ومثلت هذه السوارح نُظمًا وأعرافًا وتقاليد توافق عليها أفراد القبيلة، ونجحت في تحقيق تناغم بين الفرد وعشيرته دون أن يخسر طرف الآخر، فالعشيرة يجب أن تأخذ حقها من الفرد، والفرد يجب أن يأخذ حقه من العشيرة، ولولا هذه السوارح ودورها لما استمر هذا المجتمع القبلي ولتفتت من أول لحظة تكون فيها، إن هذه السوارح مثلت في حينها ضرورة اجتماعية حتى تمضي حياة الناس في السلم والحرب، ولم يفت (بن حمادة) وهو يتحدث عن السوارح أن يذكر الأستاذ عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي ويشيد بدوره في دراسة المجتمعات المحلية في المشقاص وبخاصة (ثعين والحموم). وللأستاذ الملاحي كتاب مهم قدم فيه مادة ميدانية عن (ثعين والحموم)، وقد وسم دراسته بـ(الدلالات الاجتماعية واللغوية والثقافية – لمهرجانات ختان صبيان قبائل المشقاص (ثعين والحموم)، ومن ضمن ما ذكره عن السوارح التي تخص المرأة بأنها تلزم أفراد القبيلة بحمايتها واحترامها وحُرم ممارسة أي لون من الاضطهاد والأذى عليها، وفرضت العقوبات الصارمة لكل من يسيء إليها بالشتم أو الضرب، ولكل حالة اعتداء عقوبة خاصة، ومن حق المرأة أن تختار شريك حياتها فلا يلزمها ولي أمرها بالارتباط بمن يختارها حتى ولو كان ابن عمها أو قريب النسب منها. وتعرف هذه السارحة؛ بسارحة الرفقة – أي إيقاف الزواج. وثمة عُرف يعطي للمرأة قطع علاقتها بزوجها عند حدوث سوء في العلاقة فلها حق الطلاق، ويُطلق على هذا الحق بسارحة المشيني. إن الحقوق التي أعطيت للمرأة في هذه السوارح لا نجدها حتى في بعض دساتير البلدان العربية التي تدعي التحضر والتمدن. وبمناسبة الحديث عن السوارح فإن (بن حمادة) من الذين أمدوا الملاحي بالمعلومات عن السوارح وغيرها من التفاصيل التي ارتبطت بوديان المشقاص وقراه، وقد ذكره الملاحي في كتابه -الذي سبق ذكره- وسجل فيه زمن المقابلة ومكانها ريدة عبدالودود (94- 1995م).
إن ابن حمادة على إلحاحي الشديد على توجيه الأسئلة إليه ومحاولة استخراجي ما في دواخله عن حياته وشعره إلا أنه لم يضجر وظل على الدرجة نفسها من الحيوية والترحيب بنا وتركت له حرية الحديث عن حياته الشخصية فتواردت إليه الخواطر وتحدث عن تجربته في المهجر، وذكر أنه سافر من دمخ حساي، وهذه المنطقة عبارة عن لسان بحري لا يبعد كثيرًا عن حساي البلدة، وهي حاضرة من حواضر البحر، وتمثل الحد الأخير الذي يفصل محافظة المهرة عن محافظة حضرموت بحسب التقسيم الإداري. كانت السفن الشراعية (واللنشات) تنطلق من هناك ودفع بن حمادة ثمنًا مقابل سفره إلى الكويت ما يعادل (300 شلن) إفريقي، واستقر في الكويت مدة من الزمن، امتهن فيها تجارة الأقمشة، وممارسته لهذه المهنة عمقت عنده فهم البشر وإجادة التعامل معهم على اختلاف أجناسهم ومشاربهم. وفي المهجر لم تخمد موهبته الشعرية بل ظلت متقدة واستطاع أن يجاري الشعراء هناك وأن يكتب الشعر النبطي مثل ما يكتبون، وحتى وهو يكتب هذا الشعر لم يتكئ على التنوين ليغطي الثغرات التي يقع فيها بعض الشعراء الذين يقولون الشعر النبطي، بل أسعفته موهبته في تجاوز هذا القصور ولم ينسَ وهو يتحدث عن دولة الكويت بكل تقدير واحترام أن يذكر معاملة أهلها الطيبة للحضارمة في ذلك الزمن الجميل إذ خصصت حكومتها المادة (19) من دستورها بفقرة تمنح الحضارمة حق كفالة أنفسهم بأنفسهم. ولكن هذا الحق أصبح اليوم من حديث الذكريات. فقد كان هذا الحق يحمل مضامين إنسانية عميقة ويحفظ للحضرمي كرامته.
*نشر الجزء الأول من هذه المقالة المطولة في مجلة (المكلا)، العدد ()،