قراءة في كتاب
عوض سالم بن حمدين
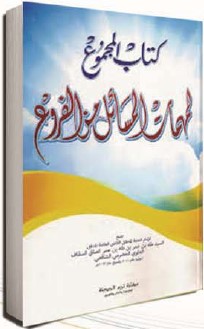
التعريف بالكتاب والكاتب:
اسم الكتاب: كتب على غلاف المجموع هذا العنوان: (كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع، جمع الإمام الحجة المحقق القاضي العلامة المدقق طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي السقاف العلوي الحضرمي الشافعي المولود 1010 والمتوفى عام 1063هـ)[1].
طبعة الكتاب: دار القبلة للثقافة الإسلامية المملكة العربية السعودية، جدة، (ص ب 10932)، الرياض، 1438هـ[2]. قدّم للكتاب: عبدالله بن محمد بن علي الحبشي 1402هـ. عدد صفحات الكتاب (766 صفحة) غير شاملة لصفحات الغلاف.

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 13 .. ص 90
رابط العدد 13 : اضغط هنا
يعد الكتاب -من وجهة نظري- من نوادر الكتب الفقهية في القرن الحادي عشر؛ وذلك لكونه يجمع مجموعة كبيرة من وقائع الأحوال والفتاوى لكثير من علماء حضرموت وغيرهم، ونقل فيه اختلاف العلماء في كثير من مسائل الأحوال والفتاوى في القرن الحادي عشر.
وفي الحقيقة يعد هذا الكتاب وثيقة علمية وتاريخية مهمة من وثائق القرن الحادي عشر، غير أن غالب ما في المجموع مجموع كلام العلامة الفقيه أحمد محمد مؤذن باجمال شيخ القاضي طه بن عمر، وله معه مشاركات في بعض الفتاوى. نعم قد يكون لطه بن عمر جهد مشكور في الاهتمام بجمع كلام شيخه العلامة أحمد بن محمد مؤذن باجمال الأصبحي[3]، وهو من أخص تلاميذه؛ إذ لا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلو من فتاوى وفائدة لأحمد مؤذن، وهذا الجمع عادة حميدة لدى طلاب العلم مع شيوخهم منذ القدم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله، ولو فسح الله له في العمر وعاش إلى طباعة هذ المجموع لأطلق على هذا المجموع (فتاوى مؤذن باجمال)، فليس له في هذا الجامع إلا الحفظ فقط، والحفظ كما هو معلوم عند أهل الحديث حفظ صدر وحفظ كتابة، فكان -رحمه الله- مهتمًا بحفظ كتابة فتاوى شيوخه وبعض فتاواه، وبقي ما كتبه وجمعه محفوظًا في رفوف مكتبته، ثم قام أحفاده من بعده بإكمال المشوار، فجمعوا ما قام به وزادوا الجمع جمعًا، وكانوا خير خلف لخير سلف، وقد كانوا بحق نعم الأحفاد أمناء في النقل. ففي (ص40) قول الجامع: »… من هنا منقول من خط الحبيب طه بن عمر إلى آخر ست ورق«، وفي (ص44) ورد في أول الصفحة وآخرها »من خط سيدنا طه«، وكذلك في (ص45)، أورد الجامع نقل من خط شقيق طه بن عمر بن علي بن عمر بن طه.
وفي المجموع مسائل منقولة عن أحمد مؤذن اشترك في الإجابة عنها هو والحبيب طه، ففي (ص350) في الكلام على مسائل الوقف، قال الجامع: »… وقد وقعت هذه المسألة في وقت سيدنا طه بن عمر وللسيد ولنا فيها نقل يساير اعتبار ذلك العرف«، وفي (ص352) ورد نقل من كلام الفقيه أحمد مؤذن في باب الوقف، قال الجامع ناقلًا عن أحمد مؤذن قال: »… وقد وقعت هذه المسألة وحررناها أنا والسيد طه أتم إيضاح..«.
وأحيانًا تجد في ثنايا المجموع الرد على السيد طه من أحمد مؤذن كما في (ص592) »… وكنت أتعجب مما سمعت من السيد طه من الاقتصار على قوله المختارين لا يقلدون حيث لم يفرق بين المختار المذهبي والمختار غير المذهبي، ومن قواعد الترجيح أن المسألة المذهبية إذا كانت مرجوحة تتأيد بمن قال بها من الأئمة الأربعة، فهذه غوامض يا سيدي من الفتاح قلَّ أن تجدها في أبناء عصري بعد أن كانت عند مشايخنا من الواضحات… «. وفي المجموع أيضًا مسائل منقولة من خط ابن أخيه عمر بن محمد بن طه صاحب كتاب (مختصر تشييد البنيان)، كما في (ص81 و178 و291)، وهناك نقولات أخرى في ثنايا المجموع، وأحيانًا يكون النقل من أحد الأحفاد فيقول: »كما ذكره جدي«، وقد وردت هذه اللفظة من الجامع في (ص71، 493، 530) من هذه النقولات يتضح أن الجامع من أخلاف طه بن عمر البعداء، فقد قال علوي بن عبدالله بن حسين السقاف المتوفى 6/ 5/ 1972م قال في كتابه (التلخيص الشافي)[4]: »قلت: وللجد طه بن عمر مجموعة فتاوى فقهية عظيمة جدًّا وواسعة وأكثرها وقائع أحوال جمعت من بعده، مع فتاوى لبعض إخوانه وبني إخوته من فقهاء زمانه، وقد بقي منها القليل، وقد استنسخها سيدي الوالد عبدالله بن حسين بن محسن السقاف[5] على يد وبقلم الفقيه شيخنا عمر بن عبيد حسان في ثمانمائة صفحة«. قلت: كان جميلًا لو ترجم للناسخ الشيخ الفاضل العلامة عمر بن عبيد حسان المتوفى 1374هـ، شيخ العلامة المؤرخ عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف.
وقد ترجم الشلي في (المشرع) لطه بن عمر (وهو معاصر له)، ولكنه لم يشر إلى مؤلفاته، وإنما وصفه بالقاضي، وذكر شيوخه، وعدَّ منهم أحمد بن عبدالله بن سراج، والفقيه أحمد بن محمد مؤذن باجمال الشهير بـ(الصبحي)، ثم قال: »وتردد إلى مدينة تريم وأخذ بها عن جماعة من علمائها منهم شيخنا القاضي أحمد بن حسين، وشيخنا أحمد بن عمر البيتي، وشيخنا عبدالرحمن السقاف العيدروس..«[6]، ثم ذكر أنه توفي بسيئون 1062هـ، وأسجع وأطنب في وصفه كما هي عادته في (المشرع)، وعلى الطريق نفسه مشى الحبشي، بل نقل نص كلام الشلي في الترجمة وقال: »وكفى بشهادة الشيخ الشلي دلالة على علو قدره ومكانته«[7]. ولا غرابة هنا بل الغرابة في أن لا يذكر لشيخ الجامع -وهو الشيخ العلامة أحمد بن محمد مؤذن باجمال- سوى ثلاثة أسطر، وهو الذي فتاواه تملأ (المجموع)، بل لا تكاد صفحة من صفحات (المجموع) تخلو من ذكره أو ذكر نصوص فتاواه، فهو بطل (المجموع) إن صح التعبير.
إن اللافت للنظر في موضوع التراجم السجع والإطناب في ذكر المشايخ والعلماء والمناصب، إذ كان معمولًا به في القديم ونحسبه من باب حسن الظن بهؤلاء، ألا نتوقف هنا لنتأمل قولًا قاله العلامة الفذ ابن عبيدالله إذ يقول في سياق حديثه عن مثل هذا الأمر في كتابه (إدام القوت) في معرض حديثه عن الإمام أحمد بن عيسى عندما وصفوه وأطنبوا في الوصف والسجع في مناقبه: »… واقتصروا في الإمام أحمد بن عيسى على ذي العقل الكبير، والقلب المستنير، والعلم الغزير، لأجل السجع، ولو كان واسع العلم لبسطوا القول فيه[8]«. واستطرد -رحمه الله إلى أن قال: »… ومن مجموع ما سقناه مع ما سبق من مبالغة… تعرف أن تلك المبالغات -من غير شهادة الآثار- مبني على ممادح العناوين التي لا يراد -من أكثرها- إلا مجرد الثناء، وهو شيء معروف بين الناس«.
العلماء الحضارمة الذين ورد ذكرهم ونقل عنهم في (المجموع):
أبوبكر بن محمد بافقيه باعلوي، أبوبكر بن أحمد السبتي، أحمد محمد مؤذن باجمال الأصبحي، أحمد بن حسين بن عبدالرحمن علوي التريمي قاضي تريم، أحمد محمد بافضل العدني، أحمد بن محمد سراج، أحمد بن الحسين بلفقيه، أحمد بن عبدالرحمن سراج باجمال، أحمد بن عبدالرحيم العمودي، أحمد بن سعد الشحري، أحمد بن أبي بكر باحفص، أحمد بن عمر عيديد حاكم تريم، أحمد بن عبدالله بن عمر باشراحيل الغريب، أحمد بن علي بابحير، إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني، زين بن عبدالرحمن الكندي، عبدالله بن أحمد بازرعة الدوعني، عبدالوهاب بن عمر بن عبدالله بن سمير، عبدالرحمن باحاتم، عبدالله بن عبدالقادر باحاج، عبدالله بن عبدالرحمن سراج باجمال، عبدالله بن عمر باجمال، عبدالقادر بن أحمد الحباني، علي بن عمر باعقبة، عثمان بن محمد العمودي، عبدالرحمن بن شعيب، سالم بن عبدالله باحميد، سالم بن عبدالرحمن باصهي، عمر بن عبدالله الشبامي، محمد بن أحمد باحميش، محمد بن أبي بكر عباد، محمد بن عمر بحرق، عبدالله بن أحمد بامزروع، عبدالرحمن بن أحمد حنبل بارجاء، عبدالله بن أحمد بامخرمة، عبدالله بن عمر بامخرمة، عبدالرحمن بن علي بن حسان، عبدالله بن أبي بكر الخطيب، علي بن علي بايزيد، عبدالله بن عبدالرحمن بلحاج بأفضل، محمد بن سليمان باحويرث، عبدالرحمن بن محمد العيدروس، محمد بن سعد باشكيل، محمد بن عمر قضام، محمد بن علي القلعي، محمد بن عمر معلم، عمر بن محمد جبيزان، عبدالله بن عثمان العمودي، وآخرين ليسوا بشهرة هؤلاء.
الكتب والمصادر الحضرمية التي ورد ذكرها في المجموع ونقل عنها:
(السمط الحاوي) لعبدالله أحمد بامزروع، (حسن النجوى) للعلامة عبدالرحمن بن عمر العمودي، (مختصر شرح الوسيط) للعلامة لأبي بكر بن أحمد السبتي، (قوارع القلوب) للعلامة عمر بن عبدالله الشبامي، (فتاوى باشكيل الصغرى والكبرى) للإمام محمد بن سعد باشكيل، (مختصر فتاوى المزجد) للعلامة أحمد بن عبدالرحمن سراج نقل منها الجامع مسائل ملخصة، (فتاوى باصهي) للعلامة سالم بن عبدالرحمن باصهي، (فتاوى بن عبسين)، (فتاوى بن حسان) للإمام عبدالرحمن بن علي بن حسان، فتاوى علي بايزيد الدوعنية والشحرية، (شرح تراجم البخاري) للإمام محمد بن أحمد بافضل، (الروضة الأنيقة والتحفة الحقيقة) للإمام عبدالوهاب بن عمر بن عبدالله بن سمير، (نشر الرضا في أحاديث المصطفى) عبدالله عمر باجمال، (نظام الدرر حاشية على الإرشاد) للعلامة علي بن علي بايزيد، في 3 مجلدات أو مجلدين كبيرين، قال الجامع: »وعندي الجزء الأول منه«، (تحفة الحدائق والأحداق) للعلامة عبدالله بن عمر بامخرمة، (تاريخ باشراحيل)، (نبذة في الدرج والدقائق) للشيخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب، (شرح الوسيط) للإمام محمد بن سعد باشكيل، (ذيل طبقات الأسنوي) للعلامة عبدالله بن عمر بامخرمة، (مطالع الأنوار في بروج الجمال ببيان الشجرة والمناقب لآل باجمال) لأحمد مؤذن باجمال، (نهاية التحقيق في الخبر المقترن بالتصديق) للعلامة أحمد محمد مؤذن باجمال، (مختصر الأنوار) للإمام محمد بن أحمد بافضل.
إنها لكارثة بحق أن نرى كل هذه الأسماء، وتلك المؤلفات عبارة عن ذكر مجرَّد في كتب، وليس لها أثر في الواقع الملموس.
ضياع المصادر:
نقل الجامع في (المجموع) عن أكابر العلماء من أمثال الإمام القلعي، وابن حسان، وباشكيل، وابن عبسين، والسبتي، وبافضل، وباشراحيل، وبامخرمة، ومؤذن باجمال، وابن سمير، وبامزروع، وباحميش، وبازرعة، وبحرق، وحنبل بارجاء هؤلاء أشهر، وهناك آخرون ليسوا بشهرة هؤلاء، وذكرت لأكثرهم كتب في ثنايا (المجموع)، بل أحال على بعضها، وهناك أعداد كبيرة غير هؤلاء من العلماء على مر العصور، فيصف البشاري ويقول[9]: »بأن أهل حضرموت لهم في العلم رغبة«. ويقول باحنان[10]: »إن حضرموت كانت زاخرة بفطاحل العلماء من الفقهاء والمحدثين والأدباء«. فأهل حضرموت أهل ثقافة وحضارة منذ كان التاريخ، وهذه الصفة جعلت الوافدين إليها يرغبون في المكوث بها رغم ضنك معيشتها، فقد ذكر الشلي حلول العلويين وقال: »إنهم وجدوا بتريم من أرباب العلوم والآداب وأصحاب الفهوم والألباب ما شغلهم عن الأهل والوطن«[11].
ثم يأتي المقدم لـ(لمجموع) عبدالله الحبشي ليقول إن (المجموع) انفرد بذكر فقهاء لا نعرفهم إلا منه، وبكتب نادرة لبعضهم لعل أكثرها فقدت منذ عصر المؤلف، أي في القرن الحادي عشر، وكلامه هذا لا يقبل لدى المهتمين بالبحث والتنقيب؛ لأن المصادر في عصر المؤلف كانت موجودة لدى الجميع ومتداولة، وإلا فما فائدة ذكرها والإحالة إليها إذا لم تكن متداولة، بدليل أن المحبي -وهو شامي من خارج حضرموت المتوفى 1111هــ- ينقل في (خلاصة الأثر) عن كتاب (مطالع الأنوار) لمؤذن باجمال. وقد يعذر الحبشي ذلك أنه أتى في وقت متأخر جدًّا عن عصر الجامع، وكانت هذه الكتب ومؤلفوها قد أخفيت.
والناظر في هذا الأمر أمام خيارين لا ثالث لهما، إمَّا أن يكون هؤلاء العلماء وتلك المصادر والمؤلفات التي ذكرت في (المجموع) غير حقيقية زعمها من كتب (المجموع) فلماذا أتى بها؟ وما الغرض والدافع من ذكرها؟
وإمَّا أن تكون حقيقية ولكن تعمد إخفائها، وهذا هو الرأي الذي نميل إليه، وهو الراجح من وجهة نظرنا، وتؤكده النقولات الكثيرة، منها ما قاله المؤرخ علوي بن طاهر الحداد في كتابه (جني الشماريخ) حيث قال: »وكان شيخنا -رحمه الله- يقول إن سبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطماسها أن الأخلاف لما رأوا في سيرة الأسلاف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها«.
وكأنه يعني كل كلمة قالها، وهذا معناه أن الأخلاف رأوا ما ينكرونه وأخفوا وطمسوا وأفنوا وهنا ما زال السؤال مطروحًا فمن هم الأخلاف الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار علمائها في التاريخ والأنساب والفقه وعلوم العربية وغيرها من المجالات الحضارية والعلمية؟
وهنا نسأل كما سأل د. محمد يسلم عبدالنور في كتابه (الفرق والمذاهب في حضرموت في القرنين السابع والثامن): »أين التراث الخاص بأهل السنة باعتبارهم هم من طمسوا تراث من سبق؛ فإن الأعداد الهائلة التي تذكر كما بينت لم تخلف شيئًا لا فقهيًا ولا فكريًا، أليس من باب النصر والهزيمة أن يحتفظ علماء السنة والشيعة الذي ناظروا الإباضية بتلك المناظرات والاعتناء بها لأنها أخرجت الناس من الخطأ إلى الصواب[12]«.
وقال السيد علوي بن طاهر الحداد في كتابه (عقود الألماس) راميًا باللائمة على الحضارم بأنهم أهل إضاعة وإهمال لآثار ومناقب من سبق[13]، كما يعزو ضياع المصادر إلى حملات الغز والخوارج. وفي موضع آخر يقول إن سبب الضياع هو انتشار الجهل والبداوة بين سكان حضرموت.
وعلى هذا الزعم رد الأستاذ أحمد عوض باوزير -رحمه الله عليه- بقوله: »وربما كان هناك من يريد أن يسأل كيف أمكن نبوغ تلك الفئة من المؤرخين وسط تلك الجهالة المتفشية. ولا إخال أن الحداد كان ينتظر بداهة مثل هذا السؤال…«.
والغريب أن كتب المناقب من أكثر المصادر وجودًا وبقاء في حضرموت، ولم يبق لنا من مصادر تاريخ حضرموت إلا هذه الكتب المناقبية، والتي منها: (المشرع الروي)، و(الجوهر الشفاف)، و(الغرر)، و(العقد النبوي)، و(النور السافر)، و(تذكير الناس)، و(صلة الأهل)، و(البركة والخير في مناقب آل باقشير)، و(كنوز السعادة)، و(تنوير الأغلاس)، و(عقود الألماس)، و(البنان المشير)، ومن أمثالها كثير فلدينا قائمة طويلة وعريضة لسنا بصدد سردها في هذا المقام، وسؤالي عن كتب هؤلاء العلماء الفقهية والتاريخية الضائعة المحال عليها في (المجموع)؟
وسنبقى قليلًا مع السيد علوي بن طاهر الحداد؛ حيث يظهر لنا عبثًا آخر، وهنا في الأنساب حيث ذكر لنا في (الشامل) »وقد سألت شيخنا عن نسب بعض القبائل فأخبرني به، فقلت له إنكم ذكرتم في الرسالة أنهم آل فلان، فقال لي ذلك لقب وضعه لهم سلفنا تفاؤلًا ونسبهم يعود إلى ما ذكرته لك…«[14]، وشيخه الذي عناه هو السيد أحمد بن حسن العطاس صاحب (السفينة المجموعة)، وهي رسالة في الأنساب الحضرمية فتأمل!
ونحن هنا إذ نشكر السيد علوي بن طاهر الحداد على شجاعته الأدبية وأمانته في النقل وسؤاله الواضح لشيخه وجوابه إلا أننا نعتب عليه؛ إذ لم يعلق على هذا العبث في الأنساب. أليس في هذا ظلم للعباد؟
وفي موضع آخر يقول: »… وقد ذكر شيخنا بعض التعليقات مع تناقضها، وتركها كما هي؛ لأن قصده الجمع لا التصحيح والترجيح«[15]!! ونظن أن هذا سكوت على باطل.
ويقول عن أحد علماء دوعن العلامة عبدالرحمن بن أحمد بن عمر باشيخ فقال: »… عنده مجموعة من الكتب القديمة عديمة النظر، فيها عدد من فتاوى فقهاء حضرموت واليمن كفتاوى بامخرمة، وباشراحيل، وبايزيد، والحباني وغيرهم، وقد استعارها بعضهم من ابنه الفاضل الشيخ أحمد ثم أنكره فيها، وكتب إلي وأنا بجاوة يشكو لي عمله، وبلغني بعد ذلك أنه وقعت بينهما دعوى عند والي دوعن ولم أدر هل ردها إليه أم لا؟!
وكان من الصدف الغريبة أن ذلك المستعير أو المغيِّر أخبرني وقد اجتمعْتُ به في جاوة أن لديه ثمانية وعشرين مجلدًا من فتاوى العلماء، فعجبت كيف وصلت إليه، ثم لم يطل الزمن حتى وصل إليَّ كتاب الشيخ أحمد يشكوه، ويطلب مني مراجعته والزمان أبو العجائب«[16].
ورغم أنه لم يفصح عن هذه الشخصية المعاصرة له الموصوفة بأقذع الأوصاف فاتهامه لها (بالمغيِّر) قد لا تثبت حقيقة إنها الشخصية الوحيدة المتسببة في إخفاء المصادر وضياعها، فهذه الحادثة تشير -في نظرنا ونظر السيد علوي بن طاهر- إلى سبب من أسباب ضياع المصادر؛ بدليل وصفه لهذه الشخصية بالمغيِّر ولتلك الكتب بعديمة النظر، وتؤدي إلى احتمال الشك لدى الباحث في أقل الأحوال، وكلمة (المغير) من علوي بن طاهر توحي بأن تلك الشخصية التي استعارت الكتب من الشيخ أحمد بأنه يعرف مقصدها؛ بدليل الوصف، إلى جانب أنه لم يطلب منه إعادتها للرجل، وختم قوله بالزمان أبو العجائب. فتأمل!
ومن باب الموضوعية في هذا الأمر رأينا أن نخرج عن المؤرخين الحضارم إلى غيرهم من الباحثين والمهتمين بالتاريخ الحضرمي لنطَّلع على آراء موضوعية غير حضرمية ليس لأصحابها مصالح خاصة. فوجدنا الباحث الروسي الكسندر كنيش في بحثه (السادة في التاريخ) دراسة نقدية عن التاريخ الحضرمي[17]. عندما تحدث عما رواه باطحن مؤرخ ظفار عن الإمام القلعي قائلًا بأنها: »… تدحض ادعاءات كثير من مؤرخي السادة بأن سلفهم محمد بن علي صاحب مرباط هو الذي نشر التعاليم الشافعية في المناطق الساحلية بحضرموت ولأن الدور العلمي والتعليمي الذي قام به القلعي موثق بعناية وأوضح من أن يتم تجاهله… نرى مؤرخي السادة يزعمون بأن القلعي هو أحد مريدي صاحب مرباط وهم بهذا الزعم يواجهون رواية باطحن التي كررها الجندي، هذه الرواية التي تضيف بأنه قبل وصول القلعي إلى ظفار فإنه لا يوجد أي دليل مشهور عن تواجد المذهب الشافعي بهذه المنطقة، فهل هؤلاء المؤرخون باطحن، وابن سمرة، والجندي، وبامخرمة يجهلون وجود أي عالم هام في ظفار غير القلعي؟ بل إنهم يقررون حقيقة في المرحلة ما قبل وصول القلعي كانت ظفار يسكنها البدو الجهلاء قطاع الطرق يجهلون حتى أسس الإسلام«.
ويستطرد الكسندر كنيش مهاجمًا مؤرخي السادة قائلًا: »بالنسبة لمؤرخي السادة فإن هذه الشخصية شبه الأسطورية -صاحب مرباط- يكتسب أهمية مطلقة لشغل الحلقة الحرجة في سلسلة أنساب السادة ووضعهم ضمن الخارطة التاريخية في فترة غامضة جدًّا، وهي الفترة ما بين وفاة الشخصية شبه الأسطورية الأولى أحمد بن عيسى المهاجر وبين إعادة توطنهم من بيت جبير إلى تريم في العقود الأخيرة من القرن السادس/ الثاني عشر، فاستمرارهم بتأكيد شهرة صاحب مرباط كمفسر وشارح رئيسي للشافعية السنية في عصره ما هو إلا دليل على محاولاتهم اليائسة للخروج من التضارب الخطير في الكرنولوجيا التاريخية (التسلسل الزمني لأحداث التاريخ)، والتي تطعن كالكارثة في سيرته«.
والملاحظ من طرح الباحث الروسي كنيش تشكيكه الواضح والصريح في مؤرخي السادة وتحديدًا المحدثين منهم كعلوي بن طاهر، وصالح بن علي الحامد.
واستئناسًا بما مر معنا من نصوص لعلوي بن طاهر ربما نجد بعض الحق مع الباحث الروسي كنيش فيما ذهب إليه، فقد تساهل علوي بن طاهر في موضوع نسب قبيلة بعينها، وإغارة شخص على كتب ثمينة كما ورد في رواياته.
خروج بعض المصادر إلى خارج حضرموت:
وجدت نقولات عن بعض علماء من خارج حضرموت مما يدل على أن كتب علماء حضرموت وآثارهم قد سارت بها الركبان وبلغ صيتها إلى كل مكان.
فهذا ابن الصلاح المتوفى 643هـ ينقل عن القلعي في كتابه (شرح مشكل الآثار)، والنووي المتوفى 676هـ في كتابه (المجموع)، وابن الرفعة المتوفى 710هـ في كتابه (كفاية النبيه شرح التنبيه)، والسبكي المتوفى 756هـ في فتاواه، وزكريا الأنصاري المتوفى 926هـ في كتابه (أسنى المطالب)، والجندي والمحبي، وبعضهم يشير إلى أن هذه المصادر في حضرموت، كما يؤكد ذلك الجندي المتوفى 732هـ في (السلوك) في ترجمة القلعي قال: »وله مصنفات عدة انتفع الناس بها منها قواعد المهذب، ومنها مستعرب ألفاظه، ومنها إيضاح الغوامض من علم الفرائض، مجلدان جيدان، جمع به بين مذهب الشافعي وغيره، وأورد فيه طرفًا من الجبر والمقابلة والوصايا، وله احتراز المهذب، الذي شهد له أعيان الفقهاء أنه لم يصنف في اعتزاز له نظير، وله لطائف الأنوار في فصل الصحابة الأخيار، وله كنز الحفاظ في غريب الألفاظ، أعني ألفاظ المهذب، وله تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة، وله كتاب أحكام القضاة، مختصر، ويقال إن مصنفاته أكثر مما ذكرت، وهي توجد بظفار وحضرموت ونواحيهما وعنه انتشر الفقه بتلك الجهة«.
والحمد لله فقد أظهر البحث لنا كثيرًا من كنوز الإمام القلعي وغيره في غير حضرموت، وعسى أن تكشف لنا الأيام عن بقية الكنوز.
نماذج من فتاوى وقائع الأحوال في القرن الحادي عشر:
ورد في (المجموع) في (ص194) نقل مسألة في العهدة من خط الفقيه عبدالرحمن بن حنبل بارجاء »قال: وأفتى سالم باصهي تبعًا لابن حسان وعلي بايزيد إن المعهد إذا أسقط الوعد على المشتري من المتعهد أنه يسقط وإن لم يجر بينهما معاقدة. قال سالم وفيه إشكال لكن الفقهاء يعملون به للضرورة تقليدًا لابن حسان«.
إذًا كان قول الإمام والمؤرخ الكبير[18] عبدالرحمن ابن حسان قاضي ريدة المشقاص وعالمها الأوحد المتوفى بكروشم 818هـ محل اهتمام الفقهاء لديهم حتى وصل بهم إلى تقليده والرجوع إلى أقواله، وفيه دلالة على سعة علم هذا الإمام وتضلعه في الفقه، فمن الذين تناقلوا أقوال ابن حسان -رحمه الله- العلامة عبدالله بن محمد باقشير في كتابه (قلائد الخرائد)، والعلامة علي بن قاضي باكثير في كتابه (إيضاح العمدة)، والعلامة عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف في كتابه (صوب الركام)، والعلامة علي بن أبي بكر بافضل في كتابه (مواهب الفضل) وغيرهم، ثم لا نجد كتابًا من كتب هذا الإمام في حضرموت مع الإحالة إلى فتاواه كما في (المجموع) وغيره. بل إلى عصر متأخر ظلت كتب ابن حسان وأشعاره متداولة يحال إليها، يقول المؤرخ علوي بن طاهر: »لابن حسان ثلاثة تواريخ… وقد وقفت على الصغير منها في خزانة سيدي أحمد بن حسن العطاس، (قلت) وقد ناولني شيخنا هذا التاريخ فتصفحته، ولما قدمت بلد حبان زرت بها السيد العالم الفاضل سالم بن أحمد بن عمر المحضار… وقال لي إن عندي تاريخ بن حسان وهو ذاك وأشار إليه في ضمن كتب في رف أمامه، فإذا هو مجلد وسط فلا أدري أي تواريخه كان«[19].
لا شك أن الباحث والمتابع لما نحن بصدده يتحرق شوقًا إلى رؤية تراث ابن حسان سواء كان في الفقه أو التاريخ أو علوم الفلك، ولعله يتساءل معنا أين ما خلفه ابن حسان؟ وهل ابن حسان شخصية خيالية اخترعها الرواة؟ وهل نقل هؤلاء العلماء عن عالم ليس له وجود؟!! ومؤلفات ليس لها أوراق؟!!
وفي (ص107) من (المجموع) إلى (ص112) تكلم أحمد مؤذن باجمال في مسألة من وقائع الأحوال ابتدأها بـ»بسم الله الرحمن الرحيم…«، وبعد الديباجة قال: »وصل إلينا كتاب من سيدنا وبركتنا السيد الفاضل علي بن عمر بن طه باعلوي صحبة جواب سئل سيدنا وشيخنا العارف بالله أحمد بن محمد المدني القشاشي وطلب منا السيد علي أن نتأمله ونكتب عليه ما ترجح لنا في ذلك..« وذكر صيغة السؤال، وفصل في الإجابة تفصيلًا دقيقًا، وعرف بالخبة وشبام والشحر وحوطها، وحكم إقامة الجمعة، وذكر حادثة سيل الإكليل الذي أخذ كثيرًا من البشر في عام 699هـ، المذكور في تاريخ باشراحيل، وذكر خراب قرية الخبة بسيل الإكليل 1049هـ، وختم جوابه بقوله: »وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، قال ذلك الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد مؤذن جمال الأصبحي عفا الله عنه وتولاه بلطفه في الدارين«. وقال: »حررته ضحى يوم السبت تاسع جمادى الأول سنة أربع وستين بعد الألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم«. لم ينتبه أحد من القائمين على هذا المؤلف (مجموع طه) إلى هذا الأمر وفاة صاحب المجموع 1062هـ على قول الشلي و1063هـ على قول صاحب (التلخيص الشافي)، والحبشي، وقول العلامة أحمد مؤذن باجمال في متن المجموع نفسه بأنه حرر الجواب 1064هـ، فقول باجمال إن طه بن عمر في عام 1064هـ ما زال على قيد الحياة… فتأمل.
ومن مسائل الأحوال التي تعرض لها (المجموع) مسألة الكفاءة في النكاح، قال الجامع في (ص433): »… ومما أفادنيه العلامة أحمد مؤذن أن مذهب مالك أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين فقط، وقد عمل به بعض مشايخنا لمصلحة اقتضت ذلك، أو خوف مفسدة. وقال الفقيه المذكور ناقلًا عن السيد العلامة العارف بالله أبوبكر بافقيه، قال حيث وقع عقد قال به إمام ولو مرجوحًا فلا ينقض في حق العوام وإنما حل المنع قبل أن يقع العقد«. وفي (ص449) ذكر مسألة »سأل الفقيه عبدالرحمن بن سراج الدين الشريف العلامة علي بن عبدالرحمن عن مسألة في الكفاءة فأجاب بقوله: ومن أراد الوقوف على أصول المذهب خصوصًا في الأنكحة تعب وأتعب، ومن تتبع الفتاوى في ذلك يجد المخلص إن شاء الله فإن مذهب مالك أن الكفاءة، لا تعتبر إلا في الدين، أي الإسلام فقط، وقد عمل به بعض مشايخنا لمصلحة اقتضت ذلك، أو خوف مفسدة«. وذكر واقعة حال بمنطقة الخريبة بدوعن فقال (ص449): »عقد الفقيه سليمان باحويرث وهو نائب الخريبة بامرأة وليها غائب برجل ظنه الفقيه كفؤًا لها وهو ليس كفؤًا لها، فلما قدم الولي رفع الأمر إلى قاضي الشحر عبدالله باعمر وادعى عدم الكفاءة، وتحققت، فقرر العقد المذكور الفقيه باعمر«. وفي (ص452) »وعقود سيئون معظمها بغير كفؤ؛ لأن فيها اختلاط عبيد وعتقاء وأراذل كثيرة ولا يمكن إلا التقليد… ومن خط عبدالرحمن بن أحمد بن حنبل وزوج عبدالله بن أبي بكر الخطيب نائب تريم بنت بلغريب وهو من بيت العلم يزيدي عام إحدى وسبعين وألف«. وهذا دليل آخر من الأدلة التي تثبت كتابة (المجموع) بعد وفاة طه بن عمر. قلت: وفي موضوع الكفاءة في النكاح كان علماء القرن الحادي عشر عندهم سعة اطلاع وتقبل لآراء المذاهب المعتبرة في العالم الإسلامي بخلاف ما هم عليه المتأخرون، فقد أثارت مسألة الكفاءة صراعًا مشهورًا بين الحضارم في جاوة أدى إلى قيام مدرستين العلويين والإرشاد.
وفي (ص452) »ومن أجوبة العلامة عبدالله بن أبي بكر الخطيب التريمي، قال: وأما مسألة عسكر الزيدية ففي النفس من ذلك شيء كبير من حيث تزويجهم في نساء من غير أهل الصلاح، ويظهر لنا -والله أعلم- أن المراد بالمبتدع في كلام الأئمة هو من يعتقد مذهبًا من مذاهب أهل البدعة فيما هم مخطئون فيه من مسائل الاعتقاد الأصولية ولو في مسألة واحدة ولو في زمن قليل، كالدخل على رؤوس هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، بدليل إلحاقهم في الكفاءة بالفاسق؛ إذ لا يكون فاسقًا إلا حينئذ، وأما مجرد النسبة إلى الجهة فلا عبرة بها، والعامي المحض لا مذهب له معين يلزمه البقاء عليه«. إشارة إلى هذه المسألة نرى تسامح الفقهاء والعلماء في ذلك الوقت في تزويج العوام من الزيود؛ كون العامي لا مذهب له ولا يؤخذ بجريرة قادة الزيدية، فيا له من إنصاف دعت إليه الشريعة السمحاء بالرغم من عدم مداهنتهم لأحد تعرض لسب الصحابة رضي الله عنهم.
وقال الفقيه أحمد بن محمد باجمال الأصبحي في (مطالع الأنوار في بروج الجمال ببيان مناقب آل باجمال)[20]: »اعلم أن آل باجمال -بتشديد الميم- ينتسبون إلى كندة القبيلة المشهورة، وكانوا ملوك حضرموت في الجاهلية، ونقل عن محمد بن عبدالرحمن ابن سراج أنه قال في (مواهب البر الرؤف) إن جد آل باجمال ثور بن مرتع -بضم الميم وفتح الراء وكسر المثناة الفوقية المشددة- ابن معاوية بن ثور بن عفير هو كندة كما في (التهذيب) وكانوا ولاة ثور، فأخذها آل بانجاد فانتقلوا إلى شبام، وجدهم الجامع لجميعهم هو الشيخ أحمد بن إبراهيم فجميعهم منسوبون إليه، وكان معاصرًا للشيخ عبدالله بن محمد باعباد القديم، ثم قال فإذا كانت القبيلة منحصرة في جد معلوم وتشعب أولاده أفخاذًا فإذا مات واحد منهم وجهل أقربهم إليه مع تحقق أن جد هؤلاء الموجودين والميت زيد لكن جهلت الوسائط، فقد اختلف المتأخرون فأفتى أبو قضام بأنه لا بد من ذكر المتوسطين بين الميت والجد المذكور والأحياء والجد هذا التعرف أصولهم المعدودة وأفتى جماعة من الفقهاء تبعًا لأبي قضام وخالف العلامة عبدالله بن عمر بامخرمة، وقال هذا من الإرث المحصور بالاستحقاق، وقال ومحل معرفة الوسائط في القبيلة المنتشرة، وأما مع الانحصار المحقق فلا يحتاج لمعرفة الوسائط، فإن علم أعلى درجة فالإرث له، وإن لم يعلم وادعى ذلك كل واحد من أرباب الميراث المحصورين في ذلك الجد المذكور فيوقف الميراث إلى إقرارهم بالأقرب أو مناقلتهم بالنذر لأحدهم؛ لأن الإرث والحالة هذه محقق محصور فيهم، وجرى على ما قاله أبو مخرمة الفقيه عبدالله بن سراج، وقال في كلام الشهاب ابن حجر ما يشهد لذلك، والذي نعتمده ما قاله أبو مخرمة؛ لأن العلة تقتضيه«.
ورد في (المجموع) في مفطرات الصيام عند ذكره للدخان ناقلًا عن الشمس البرماوي في كتاب (الإيعاب) ذكر التنباك قال (ص148): »وإن قلنا: إن الدخان عين فليس هو المراد بالعين في باب الصيام، قال: ولا أعلم في ذلك من البخور أو دخان الطعام خلافًا انتهى. وفي الإمداد والتحفة ما يوافقه فعلم أن استعمال التنباك على الوجه المعتاد لا يفطر لكن الأولى عدم إظهار مثل ذلك لا سيما للعوام«. اهـ.
هذه الظاهرة الغريبة في القرن الحادي عشر كانت مثار جدل فقهي بين الأدباء والفقهاء عند بدء ظهورها ما بين محلل لها ومحرم لعدم ورود النص، ولا غرابة في ذلك، لكن الغرابة كل الغرابة في الحكم بعدم الفطر للخواص والتحذير بعدم إظهار ذلك للعوام، ونظير هذه فقد جاء في (مختصر تشييد البنيان)[21] لعمر بن محمد بن طه وهو من علماء القرن الحادي عشر، نقل عن الفقيه عبد السلام النزيلي أنه سأل الفقيه محمد بن علي بن محمد بن مطير عن التتن المسمى عندنا بالتنباك هل هو حرام؟ أو مكروه؟ خارم للمروءة؟ ويفطر الصائم أم لا؟ فكان جوابه بحله، وأنه ليس بخارم للمروءة، وليس بمفطر للصائم مع كراهته، قال عمر بن محمد: واعتمده شيخنا يوسف بن عابد وغيره، لكن لا ينبغي إشاعة ذلك عند الجهلة، بل يزجر المتعاطي ذلك نهار رمضان. اهـ.
غير أن شيخنا الشيخ عبدالرحمن بكير -رحمه الله- لم يمرِّر هذه الفتوى في تحقيقه فقال: »لسنا مع هذه الإجابة لا من قريب ولا من بعيد، والقول بها مبطل لحكمة الصيام من أصله.. فكم من هؤلاء المتعاطين من هو مستعد لمواصلة الصوم عن الأكل والشرب، لكنه غير مستعد للصوم عن التنباك بكافة أنواعه ساعة واحدة«.
وقد كان لعلماء حضرموت وأدبائها في القرن الحادي عشر قصب السبق في رفض أي جديد ودخيل على ثقافة المجتمع الحضرمي، فكان أول من حذر من التنباك في حضرموت -فيما أعلم في القرن الحادي عشر- الأديب الكبير الشاعر عبدالصمد بن عبدالله باكثير المتوفى بالشحر 1024هـ، فقال -رحمه الله- كما في الديوان:
ولا تجنح إلى التنباك إني *** نصحتك ان فيه أشياء تضرك
هو العار الذي يدني ويردي *** هو الداء الدفين فلا يغرك
شراب مهلك لا تشتريه ***وضم إليك نقدك في مصرك
وإن ناداك للتنباك داع *** فقل عني إليك كفيت شرك
أيتبع بدعة صارت إلينا *** دسيسة كافر بالله أشرك
شراب من حميم ليس فيه *** سوى مرض القلوب فلا يغرك
فأوله سعال واصفرار *** إلى سل يعود فهات عذرك
لئن قالوا وجدنا فيه نفعًا *** لقد قالوا محالًا ليس يدرك
وفي جانب الإباحة وقف آخرون في جانب الدفاع، قال الأديب الصوفي عبدالغني النابلسي وهو من هواة شرب الدخان خلافًا لما قاله باكثير، وله رسالة في إباحته بعنوان (الصلح بين الإخوان في إباحة الدخان)، قال:
رشفت دخان التبغ لا عن سفاهة *** ولا عبث يزري بقدري ولا يزري
ولكن أداوي نار قلبي بمثلها *** كما يتداوى شارب الخمر بالخمر
وقال أيضًا:
شربنا دخان التبغ لا عن مؤدة *** لها بل هو الممقوت عند ذوي الحجاء
ولكن شيطان الهموم بصدرنا *** عصانا فدخنا عليه ليخرجا
وذكر المحبي في (خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر) في ترجمة الحسن بن أبي بكر بن سالم المتوفى بعينات 1044هـ: أنه »كان شديد الإنكار على من يشرب التبغ واعتنى بإزالته من تلك الديار، وأن الشيخ محمد علي بن علان المكي صنف في حرمته مصنفين أحدهما يسمى (تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك)، والآخر (إعلام الإخوان بتحريم الدخان)، وأنه تبعه بعض الحنفية في تحريمه، وممن أفتى بعدم الحرمة تلميذ ابن حجر الهيتمي وأحد ممن اجتمع بهم الجامع في مكة وأكثر النقل عنه الشيخ عبدالعزيز الزمزمي[22]، والشيخ عبدالله بن سعيد باقشير من شافعية الحجاز إلا لمن حصل له به ضرر، ثم قال المحبي: »قلت: وظهور التنباك المسمى بالتبغ وبالتتن بجهة الغرب والحجاز واليمن وحضرموت كان في سنة اثنتي عشرة وألف كما وجدته بخط بعض المكيين«.
وجاء في (المجموع) رسالة كاملة للعلامة أحمد بن محمد مؤذن باجمال بعنوان (بيان حكم المصادقة بخط الحاكم المجرد وبيان ما يلزم به حكمه على العامة)[23]، كتبها في 1070هـ منكرًا فيها على الفقيه عبدالرحمن باهارون في تساهله في قبوله الأهلة، بل قال في أثنائها: »نعم لا يظن ظان أنا لا نقبل حكم الفقيه باهارون مع شيوع تهوره فإنا نحسن الظن به فإن وصل مع خطه شاهدان عدلان قبلناه وعلى الرأس حتمًا والغالب أنه لا يسري في ذلك الليل إلا عامي أرسله الدولة مجهول الحال يحتاج إلى تزكية عند نائب سيئون لو شهد فإذا كان الأمر كما ذكرنا فليعلم الأمير الناصح لله ورسوله القائم نيابة بنصرة الدين يحب مولاه مولانا السلطان بدر بن عبدالله[24] أن هذه مناظرة في الدين يجب على الأمير تبليغها وعرض كتابي هذا على فقهاء تريم ومتفقهيها واحدًا واحدًا، وليكتب كل واحد بأمانة الله عليه ما يعلمه من حال السيد الفقيه عبدالرحمن فإنهم الخبراء بحاله… إلخ« وقبل نهاية الرسالة قال: »ورأيت إن هذا واجب على علماء تريم وغيرهم، والسيد علي بن عمر بن طه، والأمير يوسف القائم بتريم ليتضح الحق، ويكون رمضان سنة تسع وستين من سنتنا هذه حيث يستهل الأربعاء«.
خاتمة:
هذا البحث تحدث عن كتاب مجموع طه، وهو كتاب من القرن الحادي عشر، مما يجعل لهذا البحث أهمية كبيرة؛ حيث عرض هذا الكتاب وقائع أحوال في ذلك العصر ومدى ما وصل إليه العلم والعلماء الحضارم في ذلك الزمان في مجالات شتى ومنها الفقه.
وقد استوقفتنا في هذا البحث جملة من المسائل منها كثرة العلماء، وإنصافهم وتقبلهم للمذاهب المعتبرة كما في مسألة الكفاءة في الزواج، وكذلك كثرة المؤلفات والكتب التي نقل عنها (المجموع) والتي ذكرت فيه بأسمائها وأسماء مؤلفيها، وعندها توقفنا طويلًا عند قضية ضياع هذه المصادر والمؤلفات الجليلة، وذكرنا بعض النقولات التي تتحدث عن هذا الضياع وأشارت إلى شيء من أسبابه، ذلك بأن ضياع هذه المصادر أوجعنا كثيرًا لما في ضياعها من ضياع ثروة فكرية وعلمية كبيرة، وتعد خسارة فادحة لأبناء حضرموت.
وفي الصميم من هذا كانت لنا وقفة مع بعض وقائع الأحوال في ذلك العصر، كما أشرنا في هذا الصدد إلى بعض الأمور المثارة في الكتاب كمسألة دخول التمباك وموقف علماء حضرموت وأدبائها منه.
[1] ينظر: التلخيص الشافي، ص23.
[2] وطبع طبعة ثانية 1404هـ، بعناية السيد عبدالقادر بن أحمد السقاف. ولم تقع يدي عليها، التلخيص الشافي، ص23.
[3] هو الفقيه العلامة النسابة شهاب الدين الأصبحي نسبة إلى (ذي أصبح) في خلع راشد شمال حوطة أحمد بن زين بحضرموت.
[4] التلخيص الشافي، ص23.
[5] المتوفى بسيئون 1349هـ.
[6] المشرع الروي، الطبعة الأولى، 2/ 125.
[7] المجموع من مقدمة الحبشي، ص8.
[8] إدام القوت، تحقيق: المقحفي، طبعة الإرشاد، ص435- 436.
[9] أحسن التقاسيم، ص87.
[10] جواهر تاريخ الأحقاف، 2/ 33.
[11] المشرع الروي، 1/ 128.
[12] المذاهب والفرق الإسلامية في حضرموت، د. محمد يسلم عبدالنور، ص39.
[13] عقود الألماس، 2/ 49.
[14] الشامل، 2 / 396 طبعة مركز حضرموت للدراسات والتوثيق والنشر، تحقيق: د. محمد يسلم عبدالنور.
[15] الشامل، 2/ 389.
[16] الشامل، 2/ 656- 657.
[17] ترجمة محمد سالم قطن.
[18] جواهر تاريخ الأحقاف، 2/80.
[19] عقود الألماس، ص202.
[20] من خلاصة الأثر للمحبي 1/224 وما بين القوسين النقل في المجموع، ص377.
[21] مختصر تشييد البنيان، ص222.
[22] مفتي الحرمين في القرن الحادي عشر. انظر: مجموع طه، ص535.
[23] فانظرها في المجموع من: ص580- 588.
[24] حفيد بدر أبو طويرق، وهذا الذي حصل بينه وبين الشيخ العمودي حاكم دوعن حرب وتدخل الإمام الزيدي المتوكل في الصلح بينهما 1066 هـ. ينظر: صفحات من التاريخ الحضرمي، لباوزير، ص202.