نقد
د. هادون العطاس
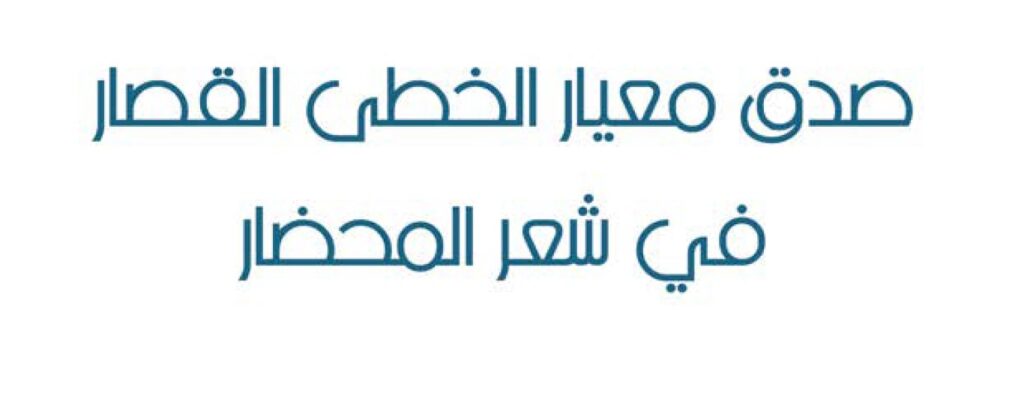

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 16 .. ص 97
رابط العدد 16 : اضغط هنا
توطئة:
سأتناول هنا ما صاغته يدا البروفيسور عبدالعزيز الصيغ –حفظه الله- في موضوعه الذي توسد الصفحات الأولى من الكتاب (المحضار الصوت والصدى)، الذي صدر بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة الشاعر حسين أبوبكر المحضار -رحمه الله- تحت عنوان (الخطى القصار في شعر المحضار)، وقد عرفت البروفيسور شخصية مهتمة ومتذوقة لشعر المحضار. وإن كنت هنا أبرز اختلافنا في قراءة شعر المحضار وفهمه. وقطعًا لا أجزم بصحة فهم أي منا، فالأمر لا ينعدم من تباين الآراء. وقد يكون مرد ذلك تأثير التخصص فهو يقرأ بتأثير من الزاوية اللغوية، بينما أقرأ هنا بتأثير من الزاوية النفسية. ومن هذا المنطلق وددت توضيح ماذا أقصد بصدق المعيار: ففي علم القياس والتقويم في المجال النفسي والتربوي يهتم بأن تتصف أي أداة قياس بخاصيتين حتى نثق بقياسها. وهاتان الخاصيتان هما الصدق والثبات. ولتوضيح هذين المفهومين بِأَوْجَز عبارة ممكنة حتى لا نضيع في متاهات التعريفات، فالثبات يُعرف بدقة القياس، أي إن الأداة دقيقة في قياسها، فمثلًا لو أتيت بجهاز، وقلت لك: هذا الجهاز يقيس الارتفاعات، وأردنا تجريبه فقسنا عمارة ما، فإذا قسنا هذه العمارة مثلًا ثلاث مرات وطلع الرقم نفسه لقلنا حينها إن هذه الأداة تتمتع بخاصية الثبات. أما خاصية الصدق فتعرف بأن الأداة تقيس ما خُصِّصَت لقياسه، أي لما أقول: “هذا جهاز يقيس الأطوال”، فإذا كان فعلًا يقيس الأطوال لقلنا إن هذا الجهاز يتمتع بخاصية الصدق؛ وعليه لما أقول هذا يقيس السكر في الدم، هذا يقيس الضغط، هذا يقيس الذكاء، هذا يقيس طول الموجات وهكذا فإذا قاست هذه الأجهزة ما أعدت لقياسه لقلنا عنها إنها أدوات قياس تتمتع بخاصية الصدق. ومن هذا المنطلق اخترت عنوان موضوعي هذا، وهنا أتساءل هل قاس البروفيسور الصيغ شعرَ المحضار أو قاس قراءتَه وفهمَه لشعر المحضار. ولن أحكم هنا، وسأترك حكمي حتى نهاية هذا الموضوع.
من عنوان الموضوع يبرز لنا تقدير البروفيسور الصيغ لمكانة الشاعر المحضار، بل وقد قال ذلك صراحة في مطلع موضوعه. ووجود خطى قصار في شعر المحضار لا يعيب المحضار ولا ينتقص من شاعريته فهو في الأخير بشر. فسعة خطاه الكثيرة، بفضل الله سبحانه وتعالى، قد أكسبته ما أكسبته من مكانة في قلوب الناس وفي مجالس الأدب والفنون تكفيه وتغنيه. وقد قالت العرب سابقًا: كفى المرء نبلًا أن تُعد معايبه، فالقول بالخطى القصار هذا اعتراف ضمني بوجود خطى واسعة في شعره.
وسأتتبع البروفيسور فيما كتب بترتيبه نفسه قدر الإمكان:

من المقدمة:
ذكر أنه أحصى خمسة نصوص في ديوان (دموع العشاق)، وذكر منها (سل فؤادي)، وهنا غاب عن باله أمران: أولهما: أن هناك طبعات مزوَّرة، وأقصد بمزوَّرة هنا أنها طبعت بغير إذن وترخيص من قبل الشاعر ولم يشرف عليها أحد، وربما كان كنوع من الترويج لهذا النسخ أضيفت نصوص، فمنها ما كان للمحضار ومنها ما كان ليس له. وثانيًا: ذكره أغنية (سل فؤادي) وأنها ليست للمحضار وإنما هي للشاعر سعيد يمين، وهنا يحتمل أنه قصد بهذا العنوان القصيدة التي مطلعها “المحبة بدون إخلاص سبة وتهمة”، فإن قصد هذه القصيدة فقد جافى البروفيسور الحقيقة، فهذه القصيدة هي للمحضار ولا شك في ذلك، وقد ذكرت هذه القصيدة في هذا الديوان في الصفحة رقم (98)، ولكن هناك احتمال آخر قد يبرر للبروفيسور قول ذلك ولكن لا يعفيه من المسؤولية وهي أن هناك طبعة كتبت فيها قصيدة سعيد يمين مرتين، مرة تحت عنوان (سل فؤادي) في الصفحة رقم (142)، وأخرى تحت عنوان (لان القلب القسي) في الصفحة رقم (154) وهي القصيدة نفسها، ولكن كما وضحت طبعت تحت عنوانين مختلفين، وهذا كما قلت لا يعفي البروفيسور من المسؤولية، وهي قد تكون مؤشرًا على قصر خطى التقصي عند البروفيسور؛ حيث لم يكلف نفسه بقراءة النصين ليكتشف ذلك، ولربما اعتمد على أحد يثق فيه فنقل إليه ما نقل.
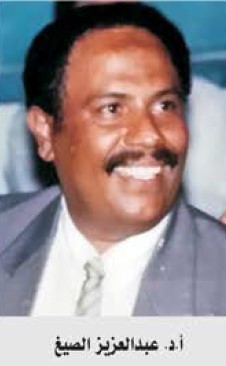
ولا أعرف ما سبب إيراد تلك الفقرة الخاصة بالقصائد المنسوبة للمحضار، ولو حللت الأمر لظهر عندي أن هذه الفقرة توطئة للفقرة التي تليها وبخاصة أنه أراد أن يبرز لنا صورة عن المحضار وغيرته، وبخاصة أنه جعل آخر من ذكرهم ممن نسبت قصيدته للمحضار هو الشاعر عبدالقادر الكاف، الذي أصلًا جعل منه المنافس الأول للمحضار.
أما قوله و»المحضار لم يقف على نشر شعره وإنما تولى نشره آخرون«، فهذا حري أن يثير فيه رغبة التأكد حول ما تم نشره هل نقل ما نقل بصورة صحيحة أم هناك تحوير وأخطاء، لا أن ينبه لذلك ثم يتغافل عما نبه إليه، وبخاصة أنه في بيئة الشاعر وقريب منها، أي يمكنه الاستفسار والسؤال للتأكد، فلو كان في مكان قصي لعذرناه.
من الشعر حلبة تنافس:
لا أحد ينكر أن التنافس وحب الظهور، وهذا أمر دقيق في علم النفس، فهناك حب الظهور، وهناك الحاجة لتحقيق الذات، وهناك الحاجة للاحترام والتقدير، فإذا كان يقصد البروفيسور هنا حب الظهور والاستعراض، فهذا بعيد كل البعد عن شخصية المحضار فكل من عرفه يعرف أنه يُسْحَب بقوة إلى الأضواء، وأنه يتهرب من التجمعات والمقابلات والاحتفالات إلا مع من يرتاح إليهم كأحبته وأهله وأصدقائه، ولا يعني ذلك أن المحضار ليس شخصية اجتماعية (وأقصد به هنا شخصية انبساطية منفتحة)، ولكن ضمن إطار الشخص الواثق من تحقيقه لذاته والحائز على الاحترام والتقدير، ولا أحبذ هنا ذكر أسماء بعض الشخصيات الكبيرة والنافذة، اليمنية وغير اليمنية، التي لو قدر على التخلص من التواصل معهم لفعل، وربما يفسر من قبل هذه الشخصيات أنه نوع من التكبر في شخصية المحضار، بينما في حقيقته هو تهرب من الظهور. ولهذا فكل ما ذكره في فقرتي (الشعر حلبة تنافس، والمحضار واسع الخطى) يظل في خانة الآراء وإن كانت صياغات البروفيسور الصيغ توحي أحيانًا بجزمه في الأمر، وكأنها حقائق ثابتة وبخاصة عندما يتحدث عن تأثر المحضار بمطالع قصائد غيره. وما لم يثبت لنا ذلك فستظل، مهما كانت الصياغات التي استخدمها، في خانة الآراء وستحترم الآراء وإن كنا غير متفقين معها، ولست هنا في وارد الرد على ذلك الآن.
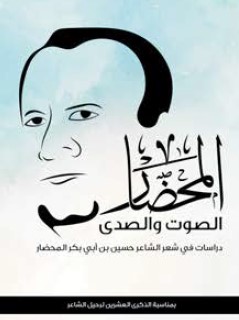
من الخطى القصار في القافية:
كما ذكر البروفيسور وقد أشرت سابقًا أيضًا أن المحضار لم يرع طباعة دواوينه، وتم أيضًا التحريف من خلال النقل، وسأعطي مثالًا إضافيًا على ذلك في قصيدة (يا وارد البحر الذي فيه الدرر توجد)، هناك شطر من هذه القصيدة اشتهر بهذا الشكل “حاشا تكيلوني إلى سعدون أو مسعد ما منهم إنقاذ“، ولربما لو اطلع البروفيسور عليها لضمها ضمن الخطى القصار، ولكن ماذا لو عرف أن هذا ليس ما قاله المحضار، فما قاله المحضار هو “حاشا تكيلوني إلى سعدون أو مسعد ما منهم إسعاد“. ولكن وبشكل عام وفي هذا الشأن أحب أن أسال البروفيسور هل أخل المحضار بالقافية، أو أخل بالإلزام الذي ألزم نفسه وسمي (لزوميات ما لا يلزم)، ففي نظري إذا أخل المحضار بالقافية فهذا فعلًا خطى قصار من المحضار، أما إذا أخل بما ألزم به نفسه فهو عادي الخطى في هذا مقابل أن يكون المعنى والرمز في البيت واسع الخطى. ولكن هنا أحب أن أتناول بشكل خاص البيت الذي تناوله من حيث القافية ومن حيث المعنى على لسان الشاعر القدير ثابت السعدي، وأنا شخصيًا من الناس المعجبين كثيرًا بشعره وبخاصة تعمقه في المعاني وتناوله الموضوع برؤية أعمق، هذا البيت هو:
بغت خاطر مدي مسلم ما يهمه برقها أو رعدها القاصف
هنا أستفسر هل ينطبق عليه ما سبق ذكره؟ وأقصد أن حرف الياء ليس قافية وإنما القافية هي حرفا “في”، أو هذا من لزوميات ما لا يلزم وخرج المحضار عن هذا؟ ثم ماذا لو اكتشفنا أن ما قاله المحضار هو “بغت خاطر صفي”؟
ونعود الآن إلى كلمة “مسلم” وأنها أخلت بالمعنى، وهنا أختلف معه، فالمحضار قال “مسلم” ولم يقل “مستسلم”، والتسليم بالشيء غير الاستسلام له، فالتسليم بالشيء هي الواقعية، هو تقبله كشيء واقع ويجب التعايش معه، ولا يحدد لنا طبيعة هذا التعامل سواء بالمقاومة أو الاستسلام، ولهذا أضاف المحضار ما يهمه برقها أو رعدها القاصف. فنحن نعرف أنه في المصائب الكبرى غالبًا ما تكون ردة الفعل الأولى لنا هي عدم تصديق ما حدث (عدم التسليم بالواقع). ولهذا قال المحضار برقها أو رعدها القاصف ليظهر لنا أن الأمور الحادثات هنا ليست طبيعية.
ورغم أن البروفيسور خصص هذه الفقرة للقافية، وقبلنا بالفكرة العارضة التي تحدثت عن المعنى على لسان الشاعر ثابت السعدي، فإننا نلاحظه مرة ثانية يتطرق للمعنى عندما أشار إلى “قلبي بعدكم كالخيط” (مع أن الأمر هنا لا يمس القافية فلماذا أورده هنا وبخاصة أنه تكلم عن المعنى؟). كلنا نعرف عندما نريد أن نصف القلب وسرعة تأثره نصفه دائمًا بشيء رقيق سهل التأثر، فَوُصِفَ بالشعرة وبالريشة وغيرها من الصفات، إذًا فالمبدأ هنا واحد. فإن لُمْنا المحضار على هذا الابتداع فحينها سنلوم من ابتدع وصف القلب بالريشة ومن وصف القلب بالشعرة وغيرها من هذه الصفات التي دلت على رقة القلب.
من الخطى القصار في المعنى:
| شرطك يا الهوى عندي ونا حامل لواك | وعرف قدر فنك | |
| وبعض الناس ما قامك ولم يحمي حماك | هدم بناء ركنك | |
| ونزل مستواك | ||
| تقبض بالحبال البالية لي هن ركاك | من دون ادراك | |
| ولي ما عز نفسه في الهوى سيبه | وعبر فوقه الشاك | |
كتب البروفيسور: »ففي الشطر: تقبض بالحبال البالية لي هن ركاك، نجد أن المعنى قد اكتمل في الجملة (تقبض بالحبال البالية)، ولكن البيت لم يكتمل فأضاف التكملة الآتية للبيت (لي هن ركاك) ولم تضف إلى المعنى شيئًا«. فهم البروفيسور هنا أن ما قصده الشاعر من ركاك هي البالي نفسه، ولكن ما فهمته أنا لكلمة ركاك هي النحاف، وهي في نظري تبرز ما أحب المحضار أن يوضحه لنا عن صاحبه وأنه لو وجد عذرًا ولو بسيطًا من صاحبه لقبله، فقد تكون هناك حبال غلاظ ولكنهن باليات فيخدعن من يتمسك بهن، أما الحبال النحيفة الدقيقة فيتشكك الإنسان في التمسك بها حتى ولو كانت غير بالية، وصاحب المحضار هنا تمسك بحبال نحيفة بالية فليس له عذر لنقول إنه اغتش بذلك، وهنا نرى أن كلمة ركاك أضافت معنى وأبانت تسامح المحضار، فلو وجد ولو عذرًا بسيطًا لصاحبه لعذره، ولكنه أحب أن يبرز لنا أن صاحبه لم يترك له مجالًا إلا أن يقول له: “ولي ما عز نفسه……”.
| لا حل للولف علمنا السهر في الليل | ليلي يمر فكرة | |
| وعرفت منه زحل والمشتري وسهيل | ومطلع الزهرة | |
| حس في الكبد جمرة | ||
| والعين تصبح من آثار السهر حمرة | فيها علامة | |
| الله كفيلك حيث ما تمشي تصحبك السلامة | ||
كتب البروفيسور: »والشطر (لا حل للولف علمنا السهر في الليل) اكتملت الجملة في قوله: (لا حل للولف علمنا السهر)، ولكن البيت لم يكتمل فأضاف عبارة (في الليل) التي لا شك أضعفت التركيب، فقد تضمنت إمكانية أن يكون السهر في النهار وهو أمر لا يقول به أحد«. وأنا هنا أسأل البروفيسور إن كنت ترى عبارة (في الليل) عائدة للسهر ولهذا أضعفت التركيب، فمتى تم التعلم؟ ولماذا لا يكون هنا (في الليل) عائدة للتعلم؟ وكمثال لو قلت: فلان علمني البيع والشراء في السوق. فعلى قياس البروفيسور أن البيع والشراء أكيد في السوق، ولكن هنا نسأل: أين تم التعلم هل في حجرة الفصل أم تم التعلم مع التدريب المباشر في السوق؟ ولو نظرنا إلى الشطر يقول: (لا حل للولف) إذًا من الذي قام بعملية التعليم؟ الذي أفهمه هنا هو أن المعلم هنا هو الولف. وكيف علمه السهر؟ علمه السهر عن طريق تواجد الوليف؟ وهنا يمكن أن يكون الوليف معه ليلًا أو نهارًا؟ فوجود الوليف معه هنا في الليل وتمت عملية التعلم في الليل؟ طبعًا كان ممكن يعلمه الألفة في النهار ويتركه طول الليل سهران؟ ولهذا قال المحضار: (ليلي يمر فكرة)، فوضح أن تعلم السهر تم في الليل، وأن الليل كله يمر عنده فكرة، أي يتذكر الألفة. فإذا كان المحضار يصف وقت التعلم فعبارة (في الليل) ليس فيها إضعاف بل تبيان للمعنى غير المعنى الذي ذهب إليه البروفيسور، وهي تبرز هنا أن عملية التعلم لم تكن نظرية بل فيها التطبيق والتدريب. وما زلت هنا أكرر (ذا اللي فهمته وما في القلوب يعلمه علام الغيوب). وهذا يذكرني بقصيدة للمحضار غناها الفنان القدير عبدالله الرويشد وغناها الرويشد “ساهر مع الليل وحداني” بينما ما قاله المحضار “ساهر مع الشوق وحداني”.
| بعادك على قلبي يؤثر | ووجدي مناجاتك تثيره | |
| وحبك استعبدني ونا حر | وحيرتي في عشقتك حيره | |
| ونتغاضى ونصبر على الحالي وعالمر | ||
| ونقبل كل شي ونقول في حبك يهون | القنع منك سكون | |
| بس يا ريته يكون | ||
كتب البروفيسور: »وبتأمل (ونتغاضى ونصبر على الحالي وعالمر)، نجد أن الصبر على المر أمر مفهوم، ولكن الصبر على الحالي أمر ليس مستساغًا فما معنى الصبر على الحالي، لقد انساب الشاعر مع قلمه دون أن ينتبه إلى أنه وضع الكلمة (الحالي) دون أن يكون لها داع معنوي«. لو أكملنا قراءة البيت ولم نقف عند هذا الشطر سنلاحظ أن الشاعر كرر “القنع منك سكون بس يا ريته يكون”، إذًا لو تساءلنا لماذا لا يكون هذا “القنع”؟ فهذه هي ديمومة صراع الحب “صراع وجود الحلو مع المر”، هذا التوأم المتلازم وهذا ما يجعلنا نصبر على الحالي والمر، بل يصل بنا الأمر أن نعيش هذا الحالي ونحن نذكر المر. ولأقرب الصورة النفسية بإعطاء هذا المثال: تصوروا شخصًا يعاني من حموضة ولكنه يحب الأكل بالبهارات وبخاصة البسباس، الآن تصوروا كيف تكون نفسيته وهو أمام أكلة شهية ومليئة بالبهارات والبسابيس، ويعرف كيف سيكون استمتاعه بها ويعرف أيضًا ماذا سيعاني بعدها، فمن عاش هذه الحالة أو تصورها لعرف ماذا يعني الصبر على الحلو المزامن للمر. بل لو تتبعنا القصيدة كلها لوجدنا أنه يحكي فترة ليس فيها شيء حالٍ غير حبه “فعالك كلها ضر وأعمالك تحير”، فيصبح هنا الصبر على هذا الحلو شيئًا طبيعيًا.
| نا أول الناس نفرح بقربك | مني وراضي بسلمك وحربك | |
| قابل لعيفك وزينك | ||
| عسى الله يعينك | كلفت نفسك واسهرت عينك | |
كتب البروفيسور: »والكلمتان (سلمك) و(زينك) إنما جاء بهما هنا الحاجة إلى إقامة الوزن فما لهما من داع معنوي«. لو قلنا مثل ما قال البروفيسور وعلى حسب قوله يكتمل المعنى بـ”وراضي بحربك” فهل هذا عَرَّفَنا أن هناك فترات سلم؛ لأن هذا ممكن يوحي لنا أن الحياة هنا كلها حرب وهو راضٍ بها، وهذا ينطبق أيضًا على قول “قابل لعيفك”. إذًا العدل وعدم الجحود والنكران قادت الشاعر أن يذكر السلم والزين حتى يخبرنا أن الحياة معه ليست كلها حربًا وليس كل أفعاله شينة، وأنه أيضًا لا يتنكر لذلك بل هو يرضى بذلك ويقبله.
| نسى جلساتنا بعد السحر عالشواطي | نريح قلوبنا ونقول للعين شطي | |
| وخلي بحر ما بينت شواطيه | غشيم الله يهديه |
كتب البروفيسور: »فكيف يجتمع الوصفان المتضادان في شخص واحد الغشيم والبحر الذي لا يتبين شاطيه إنه التناقض المعنوي«. أرى التوافق والتشابه بين البحر الذي لا يتبين شاطيه، لا تعرف أين مرساه، والغشيم الذي يتصرف بلا منطق ولا عقل فلا تعرف أيضًا مرسى لسلوكه. مع الاعتراض السيكولوجي على قول البروفيسور »كيف يجتمع الوصفان المتضادان في شخص واحد«، فهذا قد يحدث أحيانًا ويسمى في الطب النفسي (التناقض الانفعالي Ambivalence).
| رح ما انته أول من تحدانا وراح | رح ما معي في عشقتك راحة | |
| رح خلني داوي صوابي والجراح | من هو مصوب يعرف جراحه |
“رح ما انته أول من تحدانا وراح” كيف نفهم “راح” هنا، هل بمعنى “رح” في أول هذا الشطر أي بمعنى اذهب وذهب، لو هكذا فهمناها نعم لظهر لنا الشاعر بصورة المهزوم وإن كان لا يستقيم هذا مع خاتمة القصيدة والتي يقول فيها:
| الحب مثل البحر تلعب به الرياح | كل ما له إلا وهاجت رياحه | |
| يا كم وكم من فلك فرفر به لواح | عبرته غابوا وملاحه | |
| ودخلت نا وخرجت صاحي | والموج من كل النواحي | |
| مجراي في مجرى سفينة نوح | ||
فكيف يكون بصورة المهزوم وهو يقول أنا المنتصر والناجي الوحيد في هذا؟
ولكن “راح” هنا بمعنى انتهى وبهذا المعنى نستخدمها كثيرًا في حديثنا اليومي، فمن الذي يتحدى هنا؟ فماذا يعني أن تقول لشخص: “رح ما انته أول من تحدانا وانتهى” ولو تتبعنا معنى القصيدة كلها للاحظنا أنها تصب في هذا المعنى، تبرز ماهية طيبة الشاعر وإخلاصه وتحمله، وهذا يجعل الكثير يتحدونه، ولكن العبرة ليست في كم من تحدى، ولكن في مصير من تحدى.
من الخطى القصار في التذوق اللغوي:
بحسب ما فهمته من قول المؤلف حينما ضحى المحضار بالجانب الجمالي والمعنوي لصالح القافية وتبعاتها من التزامات، وقد تطرق المؤلف للأبيات الآتية:
| هل شي نظر بعد هذا الجور هل شي نظر | هل عاد شي يا حبيبي للمشاكل حلول | |
| طال انتظاري شوية | نحوك العين حوله | |
| من قال ما قال فيه سهل خله يقوله | ||
قال البروفيسور، وهذا فهمه للبيت: »وبيت القصيد في هذا الشطر (نحوك العين حوله) فليس مفهومًا أن يتسبب النظر الطويل في جعل العين حولاء فما بالك إذا كان النظر قليلًا«.
بينما ما فهمته أنا من هذا البيت أن ليس هناك من هو مصاب بالحول، بل أحب الشاعر أن يوصف حالته في لحظة الانتظار، ولأنه لا يريد أن يلاحظ عليه جُلّاسه أنه لا يعيرهم الاهتمام ولا يبين لهم انشغاله بغيرهم بينما في الحقيقة خاطره مشغول بمن ينتظره ولهذا لا يلتفت بكل وجهه للجهة التي سيقبل منها حبيبه بل يحول نظره إلى ذاك الاتجاه؛ ولهذا قال المحضار: (نحوك العين حوله)، فليس في الأمر مرض “الحول” بل هو سلوك مارسه ووصفه لنا.
| ليل والساعة ثنعشر | جيت يا هذا الاغر | |
| ريت حد بالوصل بشر | باهدي له اوتبيس | |
| طاب ليلك يا عريس | ||
وقال البروفيسور: »با هدي له اتوبيس، يستوقفنا المعنى الذي قد يكون مقبولًا بوصف الأغنية تقال في سياق عرسي فرائحي وليس نصًا تعبيريًا عن حالة إنسانية«.
أنا هنا لم أفهم ماذا يقصد المؤلف بقوله: (نص تعبيري عن حالة إنسانية)، هل عندما عبر المحضار عن فرحته بالحدث، ولو أن أحدًا هناك بشره بهذا الوصل لأهداه هدية ليس هذا وصف لحالة إنسانية، بل استخدام المحضار هنا لكلمة أوتبيس هي من نبع الحالة الإنسانية التي عاش بها الحدث، فكلنا نعرف أن ما يمثل موكب الزفاف بطربه وسروره وفرحة المشاركين به تكون في ركاب الباصات (أوتبيس)، فاستخدامه للكلمة هنا هي من تأثير الحدث والحالة الإنسانية التي يعيشها. ولو قدر لأحدهم أن يكون حاضرًا عندما قرأ المحضار قصيدته هذه، فإذا لاحظ ابتسامة عريضة أو ضحكة خفيفة على وجه المحضار فاعرف أنه لما خص هذه الكلمة فهو يعيش لحظة إنسانية انفعالية شديدة عرفها من عرفها وغابت عمن لا يهم المحضار أن يعرفها، فليس قصده هنا حينها لا البلاغة ولا الشعر ولا فنونه بل قصده كيف يوصل ذلك الانفعال الإنساني للشخص الذي أراد أن يوصلها إليه، فالمحضار هنا يعيش لحظة من لحظات قمة إنسانيته.
| مكة بلاد الله | حي مكة بما فيها يلاقيك | |
| هذا الحرم سدك | وهذا البيت أركانه تناجيك | |
| وذا الحجر قبله تقبيل واكحل مقلتيك | ||
كتب البروفيسور: »مكة بلاد الله حي مكة بما فيها يلاقيك، كيف ساغ له أن يطلق على مكة صفة (حي)، والحي إنما هو جزء من البلد، وكان له مجال واسع في الخروج من ضيق هذه اللفظة إلى سعة اللغة ولا يحوجه شيء«.
فقد فهم المؤلف هنا كلمة (حي) بما معناه مساحة جغرافية من مدينة أو قرية (حارة، حافة) بينما أنا فهمتها بأنه يطلب من السامعين إلقاء التحية، ولهذا أحب المحضار أن ينبهك لضرورة إلقاء التحية فقال مكة بلاد الله، أي أن كل مكة وليس فقط الحرم كل مكة مقدسة في نظره وتستوجب إلقاء التحية، وعلينا أن نلقي عليها التحية على أول شيء يقابلنا فيها سواء كان شارعًا أو عمارة أو إنسانًا، ثم تدرج المحضار في إلقاء التحية من العام إلى الخاص فبدأ بكل مكة، ثم الحرم، ثم الكعبة، ثم أركان الكعبة، ثم الحجر الأسود، بل وفي الحجر أيضًا كان هناك التدرج فبدأ بالتقبيل، وشدد هنا على كثرة التقبيل وليس الاكتفاء ببعض القبلات، ثم اكتحال العين بالحجر.
من الخطى القصار في التركيب:
| عالحسود الله أكبر | يحرسك من كل شر | |
| ما يصلك إلا المقدر | يا أنيسي والجليس | |
| طاب ليلك يا عريس | ||
كتب البروفيسور: »يا أنيسي والجليس، لم تضف كلمة الجليس شيئًا، والأنيس تتضمن بالضرورة معنى الجليس«.
في البيت السابق لهذا قال المحضار:
| كن معي يا حلو بسمر | أنت وردة في السمر | |
| أنت مثل الزهر وأزهر | أنت للسامر أنيس | |
| طاب ليلك يا عريس | ||
هل “أنيس” هنا تحمل نفس المعنى في المطرحين؟ ففي “أنت للسامر أنيس” جاءت صفة الأنس هنا من السلوك الذي يسلكه الشخص وهو إذا أنت سهرت وجلست مع السامر أي سامر فأنت له أنيس، وهنا ارتبطت صفة الأنس بسلوك الجلوس. لكن في “يا أنيسي والجليس” فالصفة هنا للشخص، فهذا الشخص أنيس الشاعر في حضوره أو غيابه، وقد يكون الشاعر يأنس بذكراه، ولهذا لم تلتزم صفة الأنس هنا بسلوك الجلوس، ولهذا أضافها الشاعر هنا ليوضح لنا مشهدًا خاصًا وهو الجلوس مع أنيسه. ولو تتبعنا القصيدة سنلاحظ هذا المآل (ليلة الأفراح نلت فيها الحظ الأوفر جيت يا هذا الأغر كن معي).
من الخطى القصار في الوزن:
وهنا كان البروفيسور حريصًا في تعرضه للوزن فأشار إلى أن هذا الخروج عن الوزن قد يكون راجعًا إلى خطأ كتابي أو سبب آخر. وأنا مع البروفيسور في هذا وبخاصة أن المحضار يستخدم كل اللهجات في شعره، فلربما تكتب كلمة ينطقها الشخص بلهجته فيختل الوزن بينما لو نُطِقَت باللهجة التي قالها المحضار لاستقام الوزن. وما يجعلني أنحو نحو هذا الاتجاه حدثان، أولهما كنت شاهده، وقد نقل هذا الحدث الأخ العزيز والمحب الصدوق والتربوي الجليل السيد عيدروس محمد الحبشي في كتابه الشيق والمُتْعَب عليه (شخصيات في حياة الشاعر حسين أبي بكر المحضار)، وذلك عندما زار الأخ الخلوق والإيقاعي المعروف علي سعيد -رحمه الله- المحضار -رحمه الله- وطلب منه أن يلقي عليه لحن أغنية (وين وين وين الوجه لي قابلتني به العام)، فكان رد المحضار أنه قد سلم اللحن فلانًا (وذكر اسم الفنان)، ولكن أصر علي سعيد أن ما سمعه من ذلك الفنان ليس لحن المحضار، وبعد تجاذب صرح علي سعيد مبررًا ما يعتقده بقوله: “بما معناه وليس بالحرف الواحد” أغلب الملحنين إذا لم يكونوا كلهم تكون ألحانهم ناقصة إيقاعيًا ونحن نكمل لهم هذا بالموسيقى إلا ألحانك كلها كاملة إيقاعيًا واللحن الذي سمعته من فلان ليس كاملًا. فألقى عليه حينها المحضار لحنه وبعد سماع اللحن علّق علي سعيد هذا لحنك، وألقى علي سعيد على المحضار اللحن الذي سمعه من الفنان. الحدث الثاني رواه لي الأخ الغالي والمحب الصدوق والأستاذ القدير والغني عن التعريف عبدالله صالح حداد أنه في إحدى جلسات الدان ألقى مغني الدان -(ذكر الأستاذ عبدالله الاسم ولكنني نسيته)، وهو في الوقت نفسه شاعر أيضًا- الصوت الذي سيقصدون عليه، وبعد اللحن ألقى أيضًا شعرًا على الصوت نفسه، فعلّق المحضار بما معناه لن يركب هذا البيت على هذا الصوت، فرد المغني أنا أبو فلان، فكان تعليق المحضار: شل الصوت، وفعلًا بَانَ الخلل وعدّل الشعر بما يتناسب ووزن الصوت. فشخصية تتمتع بهذا الحس الإيقاعي لا أعتقد أنها تفرط بإيقاع قصائدها ووزنها.
وقبل أن أختم بحكمي لا ننسى هنا أن البروفيسور خاض بحرًا هائجًا وهو يعرف ذلك ويكفيه أنه حاز قصب السبق في ذلك، فالنقد والتقويم ليس بالأمر الهين وهو طريق وعر يطلب من الناقد حرصًا شديدًا وتوسعًا حتى لا ينطبق عليه ما ينتقده، ومثل ما بدأت بعلم القياس والتقويم أختم به وأقول وأيضًا في القياس اختلفوا في أيهما أرقى هل الإبداع أو عملية التقويم.
من هذا كله خلصت إلى الآتي: إذا كان ما قاله وقصده المحضار بحسب ما قرأه وفهمه البروفيسور الصيغ فالبروفيسور يكون فعلًا قاس شعر المحضار، وتكون هذه خطى قصار في شعر المحضار، أما إذا كان للمحضار قراءة وقصد مثل ما فهمته أنا أو خلاف لكلينا فيكون حينها قاس البروفيسور قراءته وفهمه لشعر المحضار وليس شعر المحضار. وأترك الحكم بعد ذلك للقراء.