كتابات
د. سعيد الجريري
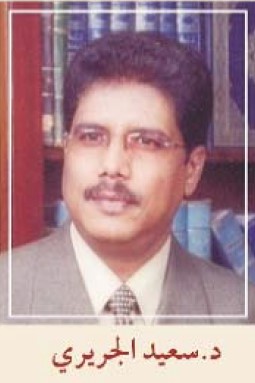
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 17 .. ص 40
رابط العدد 17 : اضغط هنا
لكل إنسان خرائط خوف خاصة في رأسه، تم رسمها منذ طفولته، حتى غدت موازية خرائط العالم الجغرافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي تختلف باختلاف الجغرافيا المكانية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية والنفسية التي ينتمي إليها، لكنه ليس إلا اختلاف في الدرجة فقط.
ولا ترتبط خرائط الخوف بأزمنة الحروب والاستبداد فحسب، ولكنها مرتبطة بأزمنة السلام والاستقرار أيضًا. فخلفيات الخوف ثقافية بالمعنى الشامل للكلمة، ولكل بلد خرائط خوفه، كما لكل إنسان خرائط خوفه التي تخالف أو تشابه خرائط غيره، في المكان نفسه أو في أماكن أخرى يعرفها أو لا يعرفها.
ولقد أثارت خرائط الخوف الأولى تساؤلات الإنسان وهواجسه في مواجهته ما حوله عبر التاريخ، حتى اجتهد واجترح إجابات ذات مناحٍ شتى منها فلسفية أو دينية أو خرافية أو أسطورية، ليخفف من حدة الخوف (وربما الرعب)، ويعزز مفاعيل الأمان. لكنه في مسار تلك التساؤلات والإجابات لم ينج من الاعتساف أحيانًا، حتى استبدل بالأمن الطبيعي خوفًا من صنعه، في ما يشبه مقولة “خيفة كالأمن، أمن كالمخافة” بتعبير البردوني في إحدى قصائده.
قرأت قبل أيام إشارة في مقال للكاتبة الهولندية إيفا ميجر إلى مقال علمي لأستاذة الجغرافيا في جامعة شيفيلد، جِل فالنتين عن “خرائط الخوف لدى النساء” – 1989م، خلاصته عن العلاقة بين خوف النساء من عنف الرجل وتصورهن عنه واستخدامهن للأماكن العامة وكيفية التحكم فيها من قبل مجموعات مختلفة في أوقات مختلفة. وقد توصلت فالنتين إلى أن عوائق استخدام المرأة للفضاءات هو تعبير مكاني عن النظام الأبوي. ولقد أجرت فالنتين مقابلات مع عدد كبير جدًّا من النساء، اكتشفت أنهن جميعًا يحملن خرائط في رؤوسهن بها أماكن مخيفة. وبالرغم من اختلاف أوضاعهن الاجتماعية أو اللون أو الطبقة، إلا أن هناك أوجه تشابه كبيرة، وبخاصة في ما يتعلق، بشكل أساسي، بالأماكن الخالية ذات الإضاءة الخافتة، بالتوازي مع الميادين العامة التي يتسكع فيها مجموعات من الرجال (الضالين).
ومما أكدته إيفا ميجر في مقالها تعليقًا على خلاصة فالنتين أن النساء يتم تعليمهن الخوف منذ سن مبكرة، ويتعلم الرجال أيضًا أين يجب أن تخاف النساء. ولذلك تستوعب النساء هذا الخوف فيضبطن طرق الجري، ويتظاهرن بالتحدث إلى شخص ما بالهاتف عندما توشكن على الوصول إلى المكان الذي يقصدنه، خاصة إن كان مظلمًا شيئًا ما. على أن الخوف قد يتعدى النساء، والناس جميعًا إلى الحيوانات أيضًا، فالعديد من حيوانات المدن تخاف من الناس، مثلما يخاف الناس الآن من الناس مطلقًا، في زمن كورونا الذي جلب معه شبكات جديدة من الخوف، تحدد من يجرؤ منهم على الذهاب إلى مكان ما.
فإذا ما تركنا جل فالنتين وإيفا ميجر جانبًا، فهما تكتبان عن مجتمعين أوروبيين، فإن خرائط الخوف في عالمنا العربي توازي خرائط الاستبداد السياسي والإرهاب الفكري والعنف الاجتماعي والثقافي الذي يطال النساء منه أضعاف ما يطال الرجال، في حالة تستمرؤها جماعات وأنظمة سياسية واجتماعية معززة بخلفيات دينية وعرفية وتقليدية، تهدف من خلالها إلى تقميط المرأة وإخضاعها، حد أن تنبري نسوة لممارسة دور القمع الذكوري بالنيابة، وبقسوة أشد، على اعتبار أن في ذلك تعزيزًا للقيم الدينية والاجتماعية المستهدفة من جهات معادية، وفقًا للخطاب المهيمن الذي توظفه تلك الأنظمة والجماعات لفرض سلطاتها.
أكتب هذا المقال في لحظة تتوالى فيه أخبار عن اختطاف فتيات وأطفال، يتعرض بعضهم للاغتصاب، والقتل أحيانًا لمواراة آثار الجريمة. أي أن الأماكن معظمها صارت مخافات، في مجتمعٍ للأعراض فيه قيمة اعتبارية. ومهما يكن من أسباب خلف تلك الاختطافات ومن يخطط لها وينفذها، في سياق الصراع السياسي والحرب المستمرة بقماءة تاريخية، فإن مما يعزز بقاء المرأة جدارًا قصيرًا لكل من يريد أن يمارس خطاياه، هيمنة ثقافة تقليدية وضعت المرأة في صندوق أفكارها، وأغلقته بقفل سلطاتها، وأوقفت عليه حراسًا عديدين، بمواصفات انكشارية. لكن يبدو أن مقاربة الموضوع في وضع كهذا، أقرب إلى سفسطة البيضة والدجاجة، والعربة والحصان. غير أن من يده في الماء ليس كمن يده في النار، ولذا فإن انتظار المرأة أن يغير الرجل (الأصح هنا الذكر) أفكاره تجاهها، ضرب من المستحيل.
فالأماكن فضاءات عامة، ومتى أحست جماعة أو أفراد بالخوف في الحركة الطبيعية عليها، دل ذلك على انتقاص الحق في استخدامها بلا معيقات، وهو ما تعانيه المرأة، ولا فرق هنا بين من تجلببت حتى لا تكاد ترى منها شيئًا، لا وجه ولا كفين ولا عينين، أو من مالت إلى استخدام حقها في أن تلبس ما تشاء بما لا يتعارض مع الاحتشام العام.
سيقول قائل: إن أدنى حقوقنا الإنسانية في البقاء على (قيد) الحياة لم يعد مؤمّنًا، فلا مجال الآن لحديث عن المرأة وحقها في الاستخدام الآمن للأمكنة. وهذا قول صحيح جدًّا، لكن أسباب ما آلت إليه الأمور ليست منفصلة بشكل أو بآخر عما مورس ضد المرأة من قمع مركب، انعكس على من دأبت على تربيتهن الذين تشربوا قيم اللاحرية من إنسانة مقموعة، ثم تولى ترسيخ فصول الإخضاع آخرون وجهات اجتماعية وسياسية وثقافية، أوصلت الحال إلى هذا المستوى من الهشاشة التي يحاكي فيها الهر صولة الأسد.
العالم قرية، لكنها قرية مخيفة أزقتها ودروبها. غير أن من الطريف أن نقرأ مثلًا عن مبادرة مثل “النساء يصنعن المدينة” التي تتبناها بلدية أمستردام -وعمدتها امرأة يسارية- للسماح للنساء الأكثر مبادرة بأن يكون لهن رأي في تخطيط المدن والأمكنة والفضاءات، لأن ما سبق، وإلى الآن، كان من منظور ذكوري. لكن مع أن مبادرة كهذه قد تجعل من الممكن أن يكون تصميم المدن والأماكن العامة الأخرى أفضل وأكثر أمانًا، إلا أنه ينبغي، في الوقت نفسه، معالجة علاقات القوة والاستقواء الأساسية، لأنه بخلاف ذلك، ستظهر دائمًا خرائط خوف جديدة.
فإن أفرد كل منا خرائط خوفه على طاولة الأمكنة، فماذا عن خرائط الخوف المتعاظلة في دواخلنا، تلك التي تفيض روافدها على خرائط الأمكنة؟ وهل يُعنى الباحثون والباحثات بموضوعات حيوية متصلة بالوجود الآمن للإنسان في مجتمعاتنا، ولا سيما المستضعف المثقل بالمخاوف: المرأة، الضحية التي يرتد عليها ما يجنيه الآخرون، بذريعة أنها تعدت، بشكلٍ ما، حدود تلك الخرائط المتاحة.