عن الدراسات الموضوعية والفنية للأدب – شجون نقدية –
نقد
أ.د. أحمد سعيد عبيدون
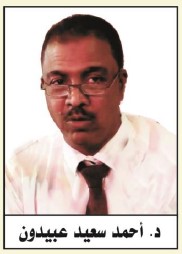
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 17 .. ص 42
رابط العدد 17 : اضغط هنا
(١)
نصادف كثيرًا في طلاب الدراسات العليا في مجال الأدب ونقد الأدب وعيًا يعاين الظاهرة الفنية بمناهج تنتمي إلى رؤى تتعامل مع الأدب من منظور العلم الذي تحسب عليه مما يحوّل هذه النصوص إلى وثائق تخرج عن طبيعتها الأدبية لتفسّر لمصلحة العلم الذي يراها، وليست نصوصًا تنتظر معاينتها بعلم مستنبط من طريقة تشكيلاتها اللغوية، وجماليات أشكالها الفنية وطرائق تأثيرها، هذا الوعي الذي يفصل بين الموضوع والفن، والمضمون والشكل، والمعنى واللفظ كما هو معروف في القديم في التقسيم الرباعي المشهور لابن قتيبة، ونكون في النهاية أمام رسالة نصفها في المجتمع والسياسة والتاريخ ونفسية الشاعر، ونصفها الآخر في أمثلة جديدة للبلاغة العربية المعروفة، في علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، ويبقى شعر الشاعر وأساليبه الجديدة التي تميز لغته وإضافاته الخاصة به لم تمسها يد الدراسة بالكشف ولم تنفض عنها ذرة من غبار.
(٢)
هذه الرسائل تقف عند المصادر والأسباب والبواعث أكثر مما تقف على الطرائق والأشكال والأساليب التي ينبع منها جمال لغة الشعر وتميز صياغاته؛ لذا كثيرًا ما نصادف في التحليل عبارات التعليل والإحالة إلى المجتمع والتاريخ ونفسية الشاعر وظروفه الشخصية في عبارات مثل: وثيق الصلة بنفسه وبالحياة/ أحاسيس صادقة/ زفرات الشاعر التي ينفثها/ تعبر عن مشاعره وأحاسيسه العميقة/ انعكاس لنفسه وظروفه وبيئته وعصره/ عاطفة الشاعر الجياشة وأحاسيسه الملتهبة/ يعكس تجربته الانفعالية ويكشف جانبًا من نفسيته/ فالشعر قالب نفسي يصب الشاعر فيه مشاعره وأحاسيسه/ يعكس شعوره بالندم/ يعكس رأيه في المرأة/ يعكس إبداع الشاعر وشخصيته المميزة/ يعكس نفسية الشاعر وإحساسه الخاص/ …
هذا المسلك في المعاينة يعتمد مناهج تعاين الظاهرة الأدبية وتعللها من خارجها مناهج تعود إلى النقد التاريخي والاجتماعي والنفسي، كما تعود إلى نظرية الانعكاس الميكانيكية التي وجدت عند الماركسيين والتي وقف ضدها الشكلانيون الروس وذاقوا في معارضتها الويل والعذاب، وتلك التي تعود إلى نقاد يرون الأدب ابن البيئة والحياة والمجتمع كما نقرأ عند هيبوليت تين، وسانت بيف، وبروننتيير، وعند من تتلمذ على أفكارهم وتبنى طرائقهم مثل طه حسين وتلاميذ طه حسين، ولعل هذه المسألة في اشتغال علوم أخرى على الأدب مثل علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم التاريخ، هي التي أشار إليها تودوروف في كتابه عن الشعرية في علاقة العلم بموضوعه، فلهذه العلوم الحق في أن تشتغل على الأدب، ولكن ليس لها الحق في أن تسمي العلم الناتج علمًا للأدب، إنه علم جديد جدير أن يقبله العلم الذي تفرّع منه وانبثق عنه، فعلم نفس الأدب فرع من علم النفس، وعلم اجتماع الأدب فرع من علم الاجتماع، وعلم تاريخ الأدب فرع من علم التاريخ، أما علم الأدب فلن يتعدى القوانين التي تسم الأدب وتجعله أدبًا، القوانين الناتجة عن طرائق تشكيله الداخلية، وجماليات صياغاته المميزة، وإمكانات أبنيته المحتملة.
(٣)
ستغدو أفكار الشكلانيين الروس مهمة هنا لتغيير الوعي وتوجيه النظر وتعديل المسار نحو الأدب الذي نراه عندهم لا يتكون من مشاعر ولا أحاسيس ولا موضوعات ولا وقائع … إنما يتكون من كلمات وكلمات فقط، وعليه فلن تكون التجربة تجربة معيشة للشاعر في الواقع والحياة، إنها تجربة في اللغة ومع اللغة، لن يحتاج الشاعر لكي يكتب قصيدة غزلية جميلة أن يذهب لكي يعشق فتاة ويهيم في حبها، بل يحتاج إلى أن يحب قصائد الغزل، ويدمن قراءتها، ويحتاج إلى أن تكون المرأة عنده هي قصيدة الغزل نفسها، إن عمل الشاعر في الكلمات لا يختلف عن عمل الموسيقي في الأنغام، ولا عمل الرسام في الألوان، ولا عمل الراقص في الحركات، وإن الجماليات تكمن في هذه الخصائص المميزة للفن، والتشكيلات المؤثرة للعزف، والتصوير بالكلمات أو بالأنغام أو بالألوان، أو بالحركات، هكذا يبدو الشكل والمضمون في وحدة واحدة صارت مركّبًا جديدًا جديرًا بالمعاينة والدراسة، تمامًا كجزيء الماء الذي يختلف تمامًا في صفاته عن مكونيه الهيدروجين والأكسجين، علينا أن نتبلل بالماء ونشربه ونذهب معه في كل الاتجاهات التي يذهب إليها، وأن ننسى تمامًا المصادر والمكونات؛ لأننا لو فعلنا ذلك فإننا نفكّ هذه العلاقة في الماء بين مكونيه فتكون النتيجة تبخّر هذين الغازين أمام أعيننا، ولن نحصل في النهاية على سوى اللاشيء. هكذا ينتقل النظر في الشكل متجاوزًا الشيء إلى علاقة الشيء بالشيء، ولماذا نذهب بعيدًا وعندنا هذا الوعي النقدي الشكلاني موجود في تراثنا عند عبدالقاهر الجرجاني الذي وضع على نفسه أسئلة تذهب مباشرة إلى الفن وتهمل مصادره وأسبابه ومحفزاته ودوافعه، وظروفه الاجتماعية، وسياقه التاريخي والاجتماعي، في اللحظة التي نعاين فيها الفن والجمال الذي تفوق على الكلام حتى وصل إلى القمة التي يعجز عن الوصول إليها البشر (الإعجاز)، سأل نفسه وهو يعاين الآية: [وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا] هل الآية معجزة؟ أين يكمن إعجازها؟ في لفظها أم في معناها؟ فأجاب: في مكان ثالث هو وحدة هذين المكونين، هذا المكان الثالث هو: النظم، أو الأسلوب؛ أي في الطريق التي تَوحَّد بها اللفظ والمعنى وتَشكَّل في طبيعة فريدة ومميزة، وعندما أراد أن يضع يده على الجمال احتاج إلى الإحالة والإسقاط على شيء، لكنه كان واعيًا، لم يسقطه على المجتمع ولا التاريخ ولا النفسية، أسقطه على لسان العرب كما يقول القرآن نفسه: (بلسان عربي مبين)، كانت العرب في مخاطباتها تقول: (اشتعل شيب الرأس) فيكون المعنى: إن الشيب حل في الرأس في جزء مخصوص منه، فالعلاقة هنا هي (الجزئية والخصوص)، في حين تكون العلاقة في الآية على: (الكلية والعموم)؛ أي لم تبق بقعة في الرأس تدعى رأسًا ألا وقد امتلأت بالشيب حتى نكاد نقول إنه لم تبق في رأسه ولا شعرة واحدة سوداء: [قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا].
علينا أن نكف عن الاعتقاد بأن الأدب انعكاس للواقع، فالأدب لا يعكس الواقع ولا يحاكيه، وإنما يحرفه ويغيره من المعروف والمألوف باتجاه الغرابة والتميز، بحيث يجعلنا نعيد إدراك الواقع بطريقة جديدة نكتشف فيها الواقع كأننا نكتشفه لأول مرة، وبذلك لن تكون المعاينة للكلمات والأشياء بقدر ما ستكون للعلاقات والطرائق ولن تكون الكلمة في الشعر مبنية فنيًا حتى تمد علاقتين أساسيتين إحداهما أفقية مع كل عنصر من عناصر العمل الأدبي، والثانية عمودية مع عناصر العمل الأدبي عامة بوصفها كلًا واحدًا، وهذا هو الشكل! وبذلك يصبح تحليل الشكل بوصفه المضمون نفسه؛ لأن الشكل ليس سوى صياغة المضمون في النهاية.
(٤)
إن الخلل في وعي العلاقة بين الشكل والمضمون كما سبق، واعتناق الفصل بينهما في النظر والتطبيق يؤدي إلى نتائج مؤذية في الوعي والتلقي والكتابة، تجعل الرسائل المكتوبة في ضوئه تتسم بمشكلات كثيرة منها:
أولًا: التكرار للنصوص التي تحتاج إلى المعاينة مرتين مرة في الدراسة المضمونية، ومرة في الدراسة الفنية يؤدي إلى ترهل الرسالة وتشوش بنائها.. ثانيًا: يضطر الباحث إلى استخدام جهاز نقدي ومفاهيمي جاهز ومنجز وهو الجهاز البلاغي المتمثل في علوم البلاغة الثلاثة (المعاني والبيان والبديع)، ولا يستطيع تجاوز ذلك إلى النظر إلى الشعر المدروس بوصفه متنًا واحدًا له خصائصه النظمية والأسلوبية التي تميزه وتحدد طابع الشعرية فيه، ومعروف أن البلاغة تتسم بالثبات والجزئية التي لا تتجاوز الجملة، والتي تسم النصوص جميعًا بهوية واحدة وتصبها في قوالب واحدة لا تعنيها السمات ولا المميزات ولا الخصائص النوعية في الشعر، بعكس الأسلوب الذي يعنى بخلاف ذلك، وفي النهاية نكون أمام أمثلة جديدة لعناوين قديمة في البلاغة نكون معها قد أغنينا البلاغة وأضفنا إليها أمثلة جديدة ولم نكتشف بلاغة الخطاب الشعري المدروس ولا أساليبه المميزة. وثالثًا: الاعتماد على خارج النص أكبر من الاعتماد على الداخل ودراسة النص نفسه المعني بالاهتمام، فتكون الرسالة نصفها في الخارج في التاريخ والسياسة والاجتماع وعلم النفس في الوقت الذي لا يكون فيه الدارس مختصًا في واحد من هذه العلوم، والنصف الآخر في الفن المعني والذي ما يزال يرتبط ويحيل على النصف الأول. ورابعًا: يحار الطالب في الإحالة والإسقاط للشعر، لكنه لا يتردد في إسقاطه على نفسية الشاعر أو مجتمعه أو عصره، ولا يفكر في أسقاطه على الأدب نفسه باعتبار أن الأدب هو الذي ينتج الأدب، ووالد الشعر شعر مثله مثلما والد الشخص شخص مثله، ووعي هذه المسألة مر بمراحل مختلفة من التنظير، لعل أوضح مثال ما ذكره ت س إليوت من أن الشاعر في القصيدة لا ينطبق على أية شخصية ملموسة وواقعية ولا حتى شخصية المؤلف نفسها، وأن الشعر ليس إطلاقًا لسراح الانفعال ولكنه هروب من الانفعال، ليس تعبيرًا عن الشخصية ولكنه هروب من الشخصية، صحيح أن أصحاب النقد الجديد هؤلاء لم يقتلوا المؤلف لكنهم أهملوه وأعرضوا عنه ولم يهتموا به وتركوه جائعًا، حتى إذا ما وصل البنيويون أجهزوا عليه وتركوه جثة هامدة، الأمر الذي نرى وعيه عند رولان بارت الذي يرى في هذا الشأن أن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف، واللغة تعرف الفاعل ولا تعرف الشخص، والفاعل يكفي لكي تنهض اللغة، وهو في النهاية – اسمًا كان أم ضميرًا- ليس سوى كلمة تبنى في النص، كما أشار إلى ذلك -قبلًا- الشكلانيون الروس. إذن الإحالة في الأدب تكون على الأدب حتى نكون أمام شيئين متجانسين يصح التبادل التناصي بينهما، وهنا يطيب الحديث عن التناص وقضاياه إذ يبدو أن وظيفة الشاعر ليست في التعبير عما يحس ويشعر في النفس، أو ما يدور في المجتمع بقدر ما تكون وظيفته الفنية البحث عن الجمال ومحاولة التغلب الفني عليه بجمال أجمل منه، وهذا ما كان يفعله الشعراء أمثال أبي تمام فقد أجاب عندما رأى أحدهم شعر أبي نواس ومسلم بن الوليد عنده أنهما اللَّات والعزى يعبدهما منذ زمن، وهو يقصد بذلك أنه يدمن قراءتهما ليكتب قصائد تتجاوز شعرهما الجميل بعلاقات جديدة تتفوق عليه، فعندما تأمل أبو نواس قول الأعشى:
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها
قال:
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء
لقد تغلّب على تكنيك الأعشى فانتقل بالبناء من التنكير إلى التعريف، من المجهول إلى المعروف، من التلذذ إلى الإدمان، من الندرة والتقطّع (رب كأس) إلى الدوام والاستمرار، من الاختيار إلى الإصرار، من الإخبار للآخر إلى الحوار معه وانتهاج الرفض الذي يظهر في الخطاب في: دع/ عنك.
هكذا لم يكن أبو تمام وأبو نواس يفكران غير في الأدب والنصوص التي تميزت بالجمال وحسن البناء، وفعل مثل ذلك مع بيت أبي نواس:
كالدهر فيه شراسة وليان
فقال:
شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا فأنت لا شك فيك السهل والجبل
(٥)
أتمنى في الأخير أن يبدأ طلابنا حملة من القراءة لكتب في الشكل والبنية والأسلوب والفن، كما أتمنى من الأقسام في الدراسات العليا أن تضع في برامجها مناهج نقد الأدب وبخاصة الداخلية منها: الشكلانية والبنيوية، والتناصية، والأسلوبية والسيميائية … وعلم النص، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تطوير الرؤى النقدية عمومًا، ويجعلها تنتج جديدًا يغير نظرتنا في معاينة الأشياء وتناولها بطريقة مختلفة عما ألفنا واعتدنا من مناهج قديمة تؤدي بنا إلى كثير من الوقوف والانتظار في حين يمر الآخرون بجوارنا مر السهام.