حديث البداية .. التاريخ المنامي
حديث البداية
د. عبدالقادر باعيسى - رئيس التحرير
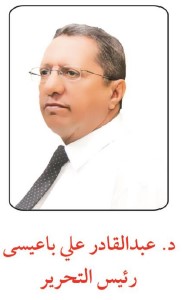
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 18 .. ص 4
رابط العدد 18 : اضغط هنا
بعض معلومات التاريخ الحضرمي مصدرها المنام، ومنه إلى كتب التاريخ تتناقله، وتعتد به، رغم أنه حالة ذاتية منامية، لا علاقة لها بالواقع، ولا بالتاريخ، فكيف يكون ذلك؟
يصير للأسباب الآتية:
1- غياب الروح النقدية المتسائلة والمناقشة.
2- وجود حالة تقديس كبيرة لبعض الأشخاص بوصفهم ينطقون بالحقيقة حتى في أحلامهم.
3- التعامل مع الحلم كما لو كان أصلًا من أصول العلم (الابيستيمولوجيا) في ظاهرة غريبة ونادرة يأخذ فيها الحلم حركة منفصلة خاصة به، تفرض نفسها بشكل مباشر، أو بمرور الزمن وكثرة التداول على الوعي بوصفها حقيقة.
4- عدم متابعة الحكام التقليديين لحضرموت لنشاط العلم وحركته، أو ضعفهم في هذا الجانب، أو لكونهم من المؤمنين بما يقوله الحالمون (من غير أن ينفي هذا إيماننا بالرؤيا الصادقة، لكن توظيفها في اتجاهات معينة هو ما يدعو للتساؤل والمناقشة).
إن الأحلام المفسرة لبعض غوامض التاريخ كتحديد موضع قبر النبي هود مثلاً تضعف أمام الواقعة التاريخية التي يمكن معرفتها عن طريق الوثيقة، أو المقارنة العلمية، أو الاستنتاج المبني على أسس علمية، فإذا ما أراد بعضنا أن يعتد بالأحلام تاريخًا، فهي تاريخ روحاني، أو تاريخ منامي لتلك الأفكار نفسها!.
وفي هذا السياق يمكن كتابة دراسات تُعنى بمتابعة التاريخ المنامي في أسبابه، وتشكلاته، والقضايا التي ركز عليها، والنتيجة التي آل إليها معه التاريخ الحضرمي. وإن عدم مناقشة الفكرة إلى اليوم يشير إلى أن الحلم تعومل معه كما لو كان واقعًا حقيقيًا، أو أمرًا مفروغًا من صحته، أو أن هذا الموضوع لا يقلق أساسًا لدى الكثير، مما تتحول معه المنامات إلى مرجعية موثوقة ترد في بعض الكتابات دون مناقشة، وتشير إلى حالة غير طبيعية تتمثل في أن الوعي بالتاريخ مرتبك لدينا في بعض حالاته، لا سيما أن عبارات الحالم مبتورة عن سياق، وموجزة غالبًا، وتخضع لتصور خاص بها.
وإذا كان الحالم قد رأى، واعتمد رؤيته مؤرخو عصره، أو من يلونهم لظروف فكرية وتوعوية وتاريخية، فكيف تعتمد اليوم من قبل بعض الدارسين، وبعضهم أكاديميون؟! يقودنا هذا إلى سؤال آخر، هو: أليس للمؤرخ الحضرمي المعاصر استراتيجية معرفية، أو في الأقل خلفية معرفية متفلسفة لإنجاز كتاباته؟ أو أن المهم هو سوق النقولات كيفما وردت حيث تظهر تنويعات متعددة داخل الكتابة التاريخية منها الواعي واللاواعي، والذاتي والموضوعي، والتخميني والتوثيقي، تؤدي في المحصلة الأخيرة إلى نتائج مشوشة وتعميمية، فليس كل شيء مما يثير الريبة يمكن أن يحال عليه إلا إذا كان لمناقشته، وإلا نكون في كتاباتنا التاريخية المعاصرة أمام وضع للعلم يقع في منزلة بين المنزلتين يحتاج –بدوره- إلى دراسات أخرى لكشفه وتبيانه.