اللغة العربية بين الشفاهية والكتابية .. (الصوت هو جوهر الثقافة الشفاهية.. والبصر هو محور الثقافة الكتابية)
أضواء
د. قاسم عبد المحبشي
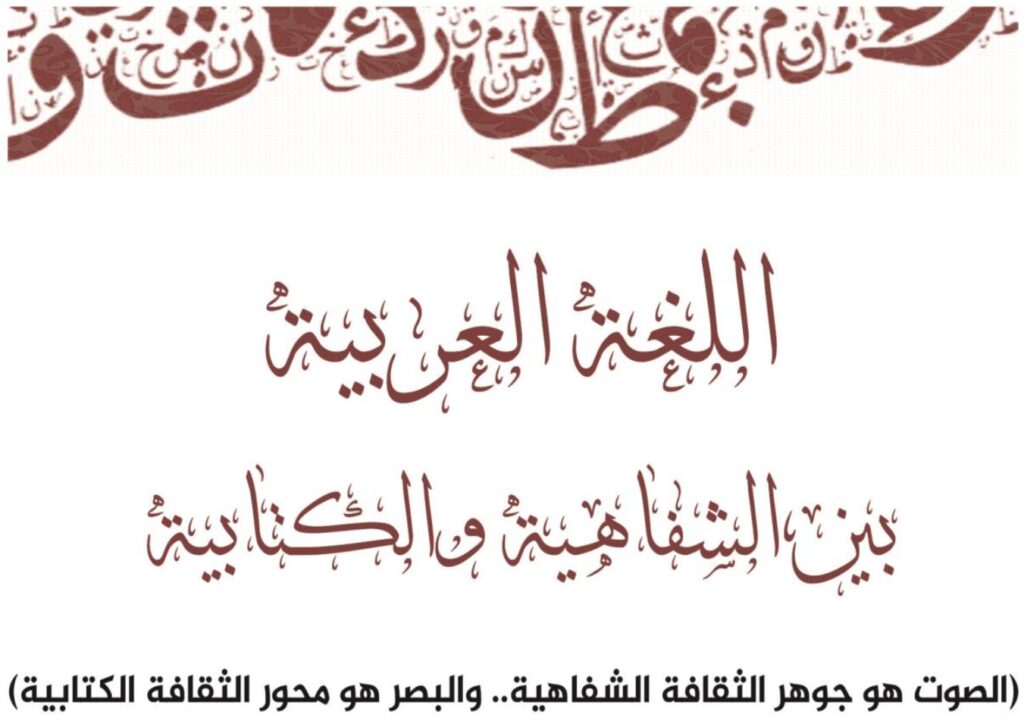

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 18 .. ص 12
رابط العدد 18 : اضغط هنا
لماذا لم تعد لغتنا العربية ديناميكية كما بدأت لغة حياة وفعل وانفعال؛ لتعبر عن الوجود الحقيقي للناس؟ وكما هو معلوم أن اللغة أي لغة حية في عالم الإنسان المتكلم هي لغة الوجود، كما أن السحب هي سحب السماء بحسب هيدجر.
وإذا أدركنا أن اللغة هي الوجود الذي يتكلم ويفكر ويعلن عن وجوده من خلالنا وبنا، فإن التفكير يحمل إلى اللغة في نطقها كلمة الكينونة اللامنطوقة، فهل ما زالت لغتنا المحكية والمكتوبة والمفكر بها تعبر عن حقيقة وجودنا وبيئتنا وسلوكنا وحياتنا الحاضرة المباشرة، أو أن الكلمات انفصلت عن الأشياء منذ وقت طويل، وأصبحت أشبه بالطرابيش المعلقة بالهواء بلا رؤوس، تبادرت إلى ذهني تلك الفكرة وأنا أستمع إلى حديث العالم اللغوي التونسي محمد الجلالي، الذي يتكلم خمس لغات حية فضلًا عن العربية؛ إذ لفت نظري قوله: إن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المعربة، بمعنى إن أواخر الكلمات تتحرك فيها حسب موقع الكلمة في السياق والجملة؛ إذ الكلمة في العربية تبدو راقصة مفعمة بالحياة والتوقد والفعل والفاعلية بعكس كثير من اللغات الأخرى. العربية هي اللغة الوحيدة التي ترفع فاعلها، وهذا هو منطق الحياة النامية والصيرورة التاريخية والحضارية للشعوب الحية. أن يكون الفاعل مرفوعًا فهذا هو منطق الفعل الحضاري الإنساني كقولنا (تصنع الأمةُ دواءَها)، أو (تصنع الأمةُ كساءَها)، بينما الذي ينتظر حتى يقع عليه الفعل هو مفعول به منصوب، والنصب في اللغة العربية هو عدم الحركة أو السكون، وله معنيان النصُب بالضمة كالنصُب التذكارية القديمة أو الأشياء المحنطة والنصَب بالفتح هو التعب بمعنى العجز عن الفعل والبقاء في موضع المفعول به من فاعل آخر، وتلك الخلاصة البالغة الأهمية هي التي أثارت اهتمامي وجعلتني أستمع إليه بانتباه شديد. والسؤال هنا هو إذا كانت اللغة العربية تتميز بهذه الخاصية الوجودية في بنيتها الداخلية فلماذا فقدت بعدها الحضاري وديناميتها الثقافية في مواكبة التاريخ والحياة؟ إن المتأمل في واقع حياتنا الثقافية العربية اليومية سوف يلاحظ -بغير عناء- ذلك الانفصال العقيم بين الدال والمدلول، وبين الكلمات والأشياء، وبين اللغة والوجود، فالكلمة لم تعد تعني المعنى الذي كانت تجسده ذات يوم، حينما بدأت لحمًا ودمًا حيًا كما بدأت العبارات أيضًا (لحمًا حيًا)، الحيوان والأعضاء والجسد والطبيعة والعلاقات انبثقت من الواقع الحي لحياة الإنسان، ولم تكن هذه الرموز إلا تمثيلًا مباشرًا صادقًا وحيًا للأشياء التي تدل عليها؛ إذ إن كثيرًا من الكلمات العربية ارتبطت بالحيوان والبيئة التي عاش فيها العربي في زمن ميلادها، فللكلمات تاريخ كما للبشر تاريخ. إن كلمة “المتن” على سبيل المثال، بدأت بمعنى “ظهر الحيوان” بينما قد تعني الآن “أصول اللغة ومفرداتها” أو متن الكتاب، أي محتواه..، وكلمة “الابتكار” مشتقة من البكر أول مولود الولادة أي حفظًا للنوع، وبالبكارة عزوبة المرأة، والباكر أول النهار، والابتكار الإبداع والاختراع.
وكلمة “الحب” حينما ينطق بها تعني وجود رابطة حميمية بين كائنين، وتعني: الألفة والاتحاد والعيش معًا. و(أنا أحبك) كما يقول هيدجر ليس مجرد تعبير عن ذاتي.. بل هو الوجود يعلن ذاته، ويتجاوزها إلى الآخر، إنها تعني أن الفرد الموجود يتجاوز انغلاقه طلبًا للآخر، ويؤسس الحب في الخارج خارج الذات المنعزلة، وأنا أحبك هي شمولية الوجود الذي لا يعي نفسه إلا شاملًا، إنها الجزئي ظاهريًا والكلي جوهريًا. هذا معناه إن الكلمة ليست تعبيرًا عن ذاتها، بل هي حامل لمحمول، هي صوت الجسد، هي رمز لشيء موجود، ولكنها ليست الشيء ذاته أبدًا، بل كما يقول موريس بلانشو إن الكلمة في اللغات الأصيلة ليست تعبيرًا عن شيء بل هي غياب هذا الشيء.. إن الكلمة تخفي الأشياء وتفرض علينا إحساسًا بغياب شامل بل بغيابها هي ذاتها، وإذا أمعنا النظر في مملكة الرموز هذه -أي اللغة- سنكتشف أشياء مثيرة للدهشة، بل إن فيها من السحر والإثارة ما يأسر اللب، ويلهب الوجدان، فما معنى الكلمات التي نقولها ونعيدها كل لحظة، ما أصل الأسماء وما معناها، من أين جاءت هذه الرموز والإشارات التي نستدل بها على الأشياء؟ وهل ما زالت تعبر عنها بالفعل أم لا؟ أسئلة وقلق كبير ومثير بدأ منذ عقود قليلة يستعر في فضاء الفكر والثقافة الأوربية المعاصرة حول اللغة وأهميتها؛ إذ تنبه عدد كبير من الفلاسفة والمفكرين المعاصرين إلى ما تنطوي عليه هذه البنية الثقافية الشاملة من عناصر وأنساق ودلالات لم تكشف بعد رغم أهميتها الحاسمة وفائدتها العميمة لبناء الإنسان؛ إذ ظهرت في السنوات الأخيرة فلسفات كاملة، وضعت اللغة في صلب اهتمامها منها البنيوية، والأنتروبولوجيا الثقافية، النجوسكية اللغوية، وفي هذا السياق تم بحث الملابسات العميقة للتقابل بين الثقافة الشفاهية والكتابية؛ إذ قام علماء الإنسان وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء اللغة بأبحاث ميدانية من مجتمعات الشفاهية الثقافة، وخرجوا بنتائج مذهلة وعلى درجة كبيرة من الأهمية حول نمط العلاقة بين الثقافة الشفاهية والكتابية وخصائص كل منهما. ولعله من نفل البيان أن اللغة هي ظاهرة شفاهية في الأصل، فحيثما توجد جماعة بشرية تكون لها لغتها، وفي كل الأحوال تكون هذه اللغة أساسًا لغة محكية مسموعة في عالم الصوت. ويرى العالم اللغوي (أدمتسن) “بأن ليس هناك من بين 3 آلاف لغة نتكلم بها اليوم سوى ما يقرب من 78 لغة فقط لها أدب مكتوب”، وتوسع الكتابة من إمكانيات اللغة بصورة تكاد تفوق القياس تقريبًا وتعيد بناء الفكر، والكتابة تعطي اللغة قوة تند عن تلك التي تكون لأي لغة شفاهية خالصة. ويلاحظ المفكر الأمريكي “أولتر أونج” في كتابه المهم (الشفاهية والكتابية) أننا لا نكاد نعثر في عالم اليوم على ثقافة شفاهية لا تكون بشكل ما على وعي بالمركب الثقافي الشاسع الذي لا سبيل إلى بلوغه أدبًا من غير الكتابة، إن هذا الوعي هو بمثابة عذاب نفسي لأولئك الذين تأصلوا في الشفاهية الأولية، أولئك الذين يرغبون في الكتابية بوجدان مضطرب، ولكنهم يعلمون تمامًا أن الانتقال إلى عالم الكتابية المثير يعني كذلك أن يطرحوا وراءهم الكثير مما هو مثير وأثير في علمهم الثقافي الشفاهي السالف، إننا مضطرون إلى أن نموت لنبقى أحياء. فما هي الديناميات النفسية للثقافة الشفاهية يا ترى؟ في غياب الكتابة لا يكون للكلمات في ذاتها حضور بصري، بل مجرد أصوات. نستطيع أن نستعيدها مرارًا ونتذكرها كما هي عليه. هكذا إذن يشكل الصوت المسموع المنطوق جوهر الثقافة الشفاهية ومحورها، لكن الصوت بوصفه حاسة إنسانية يحدث في الزمن مثله مثل كل الإحساسات الأخرى، غير أنه يتميز بعلاقة خاصة بالزمن وتميزه عن غيره من الإحساسات الإنسانية الأخرى، مثل البصر، اللمس، الشم.. إلخ؛ ذلك لأن الصوت لا يوجد إلا عندما يكون في طريقه إلى انعدام الوجود، فليس ثمة طريقة لإيقاف الصوت وتثبيته، فيمكنك إيقاف آلة تصوير متحركة وتثبيت الصورة على الشاشة ولكن إذا أوقفت الصوت فلن يكون لديك شيء سوى الصمت فحسب، فالصوت يقاوم مقاومة كاملة محاولة التثبيت، فالبصر يمكن أن يسجل الحركة ولكنه أيضًا يمكن أن يسجل السكون، بل إنه في الواقع يفصل السكون عن الحركة فلكي نفحص شيئًا عن قرب ببصرنا يستحسن أن نمسك به ساكنًا. لكن الصوت وحده هو الذي لا نستطيع العثور عليه إلا في حالات الحركة، أي لحظة ميلاده المباشر الذي ينعدم ولا يترك أثرًا مميزًا كما هو الحال في الثقافة الكتابية؛ إذ تشكل الكلمات المكتوبة بقايا وآثارًا منقوشة أو مخطوطة في نصوص وعلامات ورموز تقاوم الزمن ونستطيع أن نقرأها أو نراها أو نلمسها في أي وقت ومكان. على هذا النحو تعلي الثقافة الشفاهية من القدرة على التحكم في أنماط التعبير وفي العمليات الفكرية ذاتها، فالمرء الشفاهي لا يمكنه إلا تذكر عبارات وكلمات محدودة ومسموعة ومكررة، ومن ثم فإن أنماط التفكير نفسها تضيق هنا لكي تكون حافزة للتذكر الدائم.
وكلما زاد الفكر المنمط شفاهيًا تعقيدًا زاد اعتماده على العبارات الجاهزة المستخدمة بمهارة، والقانون نفسه في هذه الثقافات مكنون في أقوال معتمدة على الصيغ في أمثال وعبارات لا تكون مجرد زينة شفاهية مضافة إلى التشريع، بل تشكل هي نفسها القانون الفعلي، ولا توجد ثقافة خارج الصيغ والعبارات الجاهزة والمتناقلة؛ لأن الصيغة تساعد الذاكرة وتقويها. ولهذا السبب تزدهر في الثقافات الشفاهية أنماط ثقافية محددة، مثل الشعر، والحكم، والأمثال، والحكايات، والأساطير. ومن سمات الثقافة الشفاهية يذكر أونج:
* عطف الجمل بدلًا من تداخلها؛ إذ تكثر حروف العطف بشكل ملحوظ.
* الأسلوب التجميعي في مقابل التحليل.
* الأسلوب الإطنابي أو الغزير.
* الأسلوب المحافظ والتقليدي.
* القرب من عالم الحياة وردود الأفعال المباشرة، وعدم التمييز بين الكلمات والأشياء.
* لهجة المخاصمة، وغياب الحياد الموضوعي.
ولما كانت النظرة العامة للتقابل بين الشفاهية والكتابية تنطلق من نزعة مركزية أوروبية كتابية تهتم في تقسيم الثقافات والمجتمعات إلى شفاهية وكتابية، الأولى شاعرية حسية حركية لفظية روحية تجميعية بلاغية سحرية في حين أن الأخرى كتابية بصرية تحليلية عقلية علمية نصية تقدمية تجريدية ابتكارية، الأولى صوتية تكرارية تقليدية ذاتية محافظة شخصانية انفعالية صيغية خطابية سكونية ثابتة لا تعرف التجديد والإبداع والابتكار، والأخرى مؤسسية قاموسية موضوعية متطورة باستمرار ونقدية متجددة (إدوارد سعيد، 1981م) لما كانت تلك النظرة الاستشراقية الغربية الكتابية تنظر إلى الشعر والشاعرية نظرة تحقير وازدراء؛ إذ تعد اكتشافات النظرية الشفاهية هذا النمط من فنون القول “بمثابة نتائج مزعجة للثقافة الغربية التي كانت تنظر إلى هوموريس على أنه جزء من ثقافة يونانية قديمة ظل الغربيون ينظرون إليها بتقدير وافتخار. ذلك أن هذه النتائج تدل على أن اليونان الهومرية كانت تحبذ سلوكًا شعريًا وفكريًا اعتقدنا دائمًا أنه عيب” (أونج، 1994م: 79)، ولعل الإحساس بهذا العيب هو الذي دفع أفلاطون -كما يرى هافلوك- “إلى طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة حينما وجد نفسه في عالم جديد ذي ملكةٍ عقليةٍ كتابية أصبحت فيه الصيغ أو الرواسم “الكليشيهات” المفضلة لدى جمهور الشعراء التقليديين، قديمة وضارة”. (أونج، 1994م: 80). وربما لهذا السبب ما تزال ثقافتنا العربية الإسلامية الشفاهية تثير دهشة الدارسين الغربيين واهتمامهم حينما تجعل من موضوع ازدرائهم -أي الشعر والشاعرية- موضوعًا للافتخار والتميز، فما نزال -بعد قرابة ألفين وستمائة سنة من طرد أفلاطون للشعراء، ورفضه لذلك النمط من التعبير الشعري البدائي التراكمي التجميعي اللفظي الشفاهي- نردد مقولة “الشعر ديوان العرب”، وكأنه سرد عقلي لواقع الحياة، واستخدام نفعي للغة. وبعد ألف وثلاثمائة عام من معرفتنا للكتابة ما يزال الشعر والأدب الشفاهي هو كل رأس مالنا الثقافي في عصر التقنية العالية عصر ما بعد الكتابة، فليس هناك أمة من الأمم الحية جعلت من الإعجاز اللغوي والبلاغة الخطابية مصدرًا دائمًا لافتخارها، مثل الأمة العربية التي تمركزت حول البيان العربي واللسان العربي ولم تبارحه قيد أنملة (عبدالعزيز، 2005م: 45)، والشعر هو لغة الوجود الأولى، وهو راسخ الجذور، في البنية الشفاهية لمختلف الثقافات الإنسانية، وعندما وصف فيلسوف التاريخ الإيطالي باتيستافيكو “أقدم مرحلة من التطور الإنساني بأنها عصر الشعر كان قد سبق وصفه هذا ما قاله (جسبرسن) من أنها عصر الغناء، غير أن الصحيح هو عصر اختلط فيه الرقص والغناء والشعر والنثر والأسطورة والاحتفالية والسحر والعبادة”، ( ممفورد، 1980م: 45).
وحينما نقول إن الشعر هو شكل التعبير الجمالي والنفعي الأول في الثقافات الإنسانية الشفاهية، فنحن نعني إنه كان النموذج الإرشادي (البارادايم) الثقافي المهيمن في الفضاء التواصلي العام لكل فنون القول والتفكير والأداء والتعبير في المجتمعات البدائية، كما أن العلم هو البارادايم المهيمن في الثقافة المعاصرة، وقد أضفت اللغة الشعرية روحها الشاعرية على كل أنماط التعبير البدائية المختلفة، الأسطورية واللاهوتية والفنية والفلسفية، فكل النصوص المكتشفة في الحضارات القديمة، مثل (ملحمة جلجامش وأسطورة الخلق والتكوّن والآداب الفرعونية والفيداء الهندية والكونفوشستية الصينية وملحمتا الإلياذة والأوديسة اليونانيتان والتوراة والإنجيل.. إلخ) جميعها صيغت بحسب نموذج الثقافة الشفاهية، وهي التي تعطي للتشكيل الموسيقي للغة الاهتمام الكبير الذي يستغرق سمع المتلقي بما يجعل القول متساميًا عن القول المعتاد (عبد الكريم، 2014م: 33 ). وفي هذا السياق كتب بول زومتور قائلًا: “لا سبيل إلى الشك في أن التاريخ قد عرف يومًا ثقافة بلا شعر شعبي”، ( زومتور، 1999م: 57).
وفي ذات السياق جاءت دارسة الباحث الأمريكي الدكتور فلاج ميلر للتقابل بين الشفاهية والكتابية في الشعر الشعبي اليمني، القصيدة اليافعية أنموذجًا، في إطار الاتجاه العام من الاهتمام المضطرد “لطائفة من المتخصصين (إنثولوجيين، علماء اجتماع، دارسي فولكلور أو من منظور مختلف علماء لسانيات) منذ أكثر من قرن ونصف، تراكمت خلالها حصيلة هائلة من الدراسات والملاحظات، ( زومتور، 1999م: 19).