د.عبدالقادر علي باعيسى
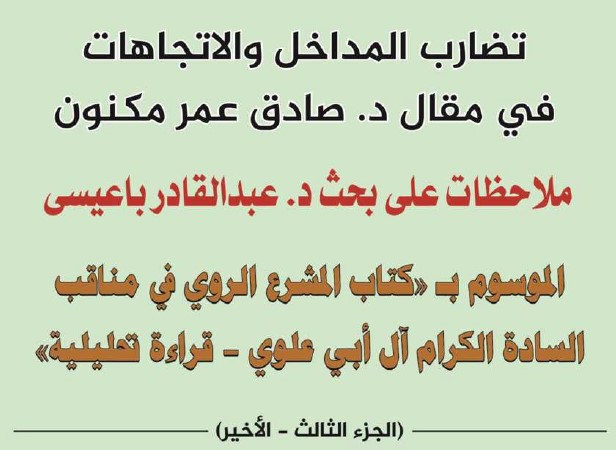

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 21 .. ص 94
رابط العدد 21 : اضغط هنا
وبناء على ما سبق يبدو د. مكنون معتدا بما يراه، ويبدو الاعتداد واضحا حين يسند أقواله بعبارات من مثل “وبالقراءة المعمقة للبحت يتضح لنا أن …”(86) و”والقراءة المتعمقة للبحث تكشف أن…”(87 ) وبإعادة النظر في مقاله لم يتضح لنا ما يدل على (قراءة معمقة) أو (متعمقة) للبحث تعمقا مبنيا على أسس من المعرفة الدقيقة بالاتجاهات العلمية والمنهجية التي خاض فيها، ومن ثَم النتائج التي توصل إليها كما سبق أن أوضحنا، وإلا كنا أفدنا منه، فضلا عن إطلاقه أحكاما قاطعة من مثل أن د. باعيسى يقوم بـ “إصدار نتائج وأحكام نهائية بوصفها حقائق توصل إليها الباحث”(88) وما تم التوصل إليه إنما هو مقاربات قابلة للتعديل والإضافة والمناقشة، وهنا أسأله: كيف وصل إلى ذلك الحكم، وعلى أي شيء بناه، لا شيء سوى أن نعود معه مرة أخرى إلى الحالة الانفعالية التي ظلت تنبث في أجزاء مقاله بصورة خاصة به، فهو الذي يقول بذلك الحكم، ويفرضه على قراءة د. باعيسى التي يتضح أنه ما التفت إلى عنوانها الرئيس البارزة فيه كلمة (قراءة) بصورة رئيسة، فالقراءة مفهوم يتبناه الخطاب الحديث في التحليل لا يعطي نفسه أي سلطة تفرض نفسها على النص.
ومن تلك الأحكام القاطعة التي وصل إليها د.مكنون “أن كل تحليلات د. باعيسى التي بناها على أساس أن هذا النوع من كتب التراجم لآل باعلوي فقط، كتبت بهدف التسيد وفرض السيطرة”(89) إن مثل هذا التعميم الذي يرى أن (كل) تحليلات د. باعيسى لتراجم آل باعلوي جاءت بهدف إبراز تسيدهم وفرض سيطرتهم، تظهر ايديولوجيا استباقية تقرأ ما تريد، بالكيفية التي تريد. وهنا يدخل د. مكنون في تماس شديد بين الاجتماعي والعلمي إلى درجة أن يزاحم الأول الثاني بصورة واضحة في مقاله(90).
ولنضرب مثلا آخر على التعميم، يقول د.مكنون: “و د. باعيسى افترض أن مكانة آل باعلوي هي فقط في حضرموت حيث هي (بيئة قبلية وزراعية بسيطة يمكن أن يتسيد فيها الجانب الوجداني الروحي على الجانب العقلي) والواقع والأدلة التاريخية تدل على أن مكانتهم لم تقتصر على حضرموت، حيث البيئة القابلة للكرامات كما يعتقد د. باعيسى، بل كانت لهم المكانة الاجتماعية في بيئات وحواضر العلم والمعرفة في العالم الإسلامي: في عدن والحجاز والقاهرة وبغداد وإسطنبول والهند وجنوب شرقي آسيا، فضلاً عن شرق إفريقيا حيث كان العمانيون يحكمون هناك”(91) ويورد في الهامش أمثلة على ذلك(92).
وهذا الذي يقوله د. مكنون صحيح، ولا ينكره أحد، ولم يقل د. باعيسى إن مكانتهم في حضرموت وحدها دون غيرها من البلدان بهذا التحديد الحصري(فقط) الذي استخدمه د. مكنون فهذا الافتراض من عنده إذ تكمن واحدة من إشكاليات كتابته في النمذجة التعميمية التي يحاول تقديمها، فتتعالى فكرة (المكانة الاجتماعية) لديه على خصوصيات الأمكنة والأزمنة والظروف، بينما هي ظاهرة متعلقة ببنى اقتصادية وتشريعية، وسياسية، واجتماعية، وحياتية في بلدان مختلفة، وليس بهذا التعميم االذي يركز فيه د. مكنون على المكانة الاجتماعية بصورة مجردة مفصولة عن وقائع التجارب البشرية لجماعات آل باعلوي في هذه المساحة المكانية الواسعة التي ذكرها من عدن إلى جنوب شرقي آسيا والتي هي بحاجة إلى دراسات أوسع وأعمق لمعرفة أسبابها، ذلك لأن فهم أي تجربة يكون بمزيد من قراءتها وتحليلها. وعندما يتم النظر إلى تميز جماعـة في إطـار واسـع من التفاعـلات الاجتماعية والسياسية (مجرد التميز فقط) يبدو هذا نظرا إيديولوجيـا، فتميز آل باعلـوي في تلك المجتمعـات المتعددة ناتج عن مجموع كبير من التفاعلات بما فيها التفاعلات الشخصية الحياتية. ومن المهم معرفة كيفية ولادة ذلك الحضور وكيفية استمراره؟ وفي إطار أي مرحلة أو مراحل تاريخية في هذا البلد أو ذاك؟ وما دور الجانب الديني في ذلك الحضور؟ وما دور الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والشخصية؟ وهل كانت تلك الجوانب بالمستوى نفسه في مختلف تلك الأقطار، أو بمستويات متعددة؟ وبصيغة أخرى، هل حضور آل باعلوي وتأثيرهم في بغداد أو القاهرة كحضورهم وتأثيرهم في جنوب شرقي آسيا، وشرق إفريقيا؟ لا أظن الإجابة بنعم، ولكن د.مكنون نظر في المكانة الاجتماعية بوصفها -من وجهة نظره- شيئًا لازمًا، ولم ينظر في تنويعات تلك الخصوصية ودرجاتها وظروفها مما يدل على التعميم، فأداء الوظائف في تلك المجتمعات بما فيها الوظائف الدينية لن يكون إلا وفق معطيات معينة تفرضها طبيعة تلك المجتمعات وأنظمتها الحياتية، فالآخر هناك عربي، ولكنه ليس حضرميًا، ومسلم ولكنه ليس عربيًا، ونظام التراتب الطبقي في تلك المجتمعات هو غير ما هو معروف في المجتمع الحضرمي، وهذه الفروق بين المجتمعات ستنتج بالضرورة اختلافًا في الدور الذي يمثله آل باعلوي، وغيرهم، فمن المهم الاستقراء الواسع لهذه الظاهرة ودراستها، وتقديرها التقدير العلمي اللائق بها، وليس التعميم بشأنها.
وفي موضع آخر يتحدث د. مكنون مرة أخرى عن (المكانة الاجتماعية) لآل باعلوي، فتحت عنوان إشكالية البحث الاجتماعية يقول: “ربط د. باعيسى المكانة الاجتماعية لآل باعلوي بالكرامات، وجعل من كتاب المشرع الروي دليله على ذلك، والسياق والمضمون العام للبحث يعبر عن هذه الفكرة”(93) وأرجو أن يعيد القارئ قراءة هذا الاستنتاج العام الذي ربط فيه د.مكنون موضوع المكانة الاجتماعية بالكرامات على مدار قراءة د. باعيسى كلها، فنحن هنا أمام موضوع جديد من إنتاجه يمكن أن يعنون له بناء على ما قدمه بـ (ربط المكانة الاجتماعية لآل باعلوي بالكرامات) ويراه منبثًا في كل جزئيات قراءة د. باعيسى، وليس دور الكرامات في تشكيل الوعي في حضرموت في القرن الحادي عشر الهجري كما أشرنا إلى ذلك مرارًا!!.
يستدعي د. مكنون المكانة الاجتماعية في طرحه منطلقًا من وضعه في إطار أنساق وقيم ثقافية معينة، فإذا ما اختلف المقال –أي مقال- مع ما يراه، أو ظنه كذلك، لم يرق له الأمر، لأن الوجود الذاتي (الشخصي) والوجود الاعتباري للقبيلة غير متفارقين بالنسبة إليه، فيأتي الرد انطلاقا من المخزون الايديولوجي لدى الفرد ذاته عن قبيلته، وليس بسبب القراءة وحدها التي يمكن استقبالها من أي طرف محايد بصورة أكثر موضوعية، أو على درجات مختلفة. وعليه فالقيمة العليا عند د. مكنون هي المكانة الاجتماعية التي تستلزم الدفاع عنها، قبل المعرفة، ولذا قال: “إن مشكلة البحث عند الباحث اجتماعية وليست تاريخية أو معرفية”(94) نافيًا القيمة المعرفية لقراءة د. باعيسى، ومؤكدًا الناحية الاجتماعية، وقد كرر ذلك في موضع لاحق بقوله: “وكما بينا سابقًا أن مشكلة البحث عند د. باعيسى اجتماعية”(95) كأن الإشكالية قائمة بين د. باعيسى وآل باعلوي عمومًا، والمسألة ليست كذلك، وإنما هي ببساطة شديدة عدم تطابق في الوعي، بين قراءة د. باعيسى وفهم د. مكنون لها، ولذا بدت القراءة بالنسبة إليه هادفة أساسًا إلى النيل من مكانة آل باعلوي الاجتماعية.
وتظل فكرة (المكانة الاجتماعية) لآل باعلوي مسيطرة على مقال د. مكنون في أكثر من موضع، يقول:”إن إسناد سبب مكانة آل باعلوي الاجتماعية إلى الكرامات، تبسيط مخل في تفسير سنن وقوانين حركة الحياة الاجتماعية وفهمها”(96) وليس من الإنصاف، ولا من المنطق، أن يتم إسناد مكانة آل باعلوي إلى الكرامات فقط، ولكن هذه هي الفكرة الجوهرية المسيطرة على تصور د. مكنون التي يهب للدفاع عنها، وهي فكرة جذرية في طبيعة تفكيره كما تدل عليها افتراضاته. ويضيف: “أن الواقع الاقتصادي والسياسي المتردي في أغلب فترات تاريخ حضرموت، والصراع القبلي المستمر نتيجة لذلك الواقع، لا يمكن أن نفسر المكانة الاجتماعية لفئات المجتمع فيه بجزئية هامشية، أو بالاستناد إلى مجال واحد فقط من مجالات الحياة المختلفة”(97) ولعله يعني بالجزئية الهامشية، والمجال الواحد من مجالات الحياة المختلفة، الكرامات التي يحمّلها أكثر مما حملت في قراءة د. باعيسى ويذهب بها إلى غير ما ذهبت إليه القراءة، ذلك لأنه يستجمع دفاعه عن المكانة الاجتماعية من زوايا مختلفة أكثر مما ينظر في القراءة نفسها، ويبدو ما يقوله هنا أشبه بخطوط عامة غير مترابطة يقفز في أثنائها من فكرة جزئية إلى أخرى، حتى بدت تتابعات الكلام وعلاقاته الدلالية غير واضحة تماما لاسيما في الاستدلال الأخير الوارد توا.
وما نريد أن نقف فيه مع د. مكنون أيضًا هو ما أتى بعد ذلك مباشرة، وهو مهم لاستناده إلى نظرية علمية، فقد نقل عن شحاتة صيام من كتابه (النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى مرحلة ما بعد الحداثة) دون تـنـصيـص مباشر “لهذا فإن أفـضـل نظريـة اجتماعيـة وأنثروبولوجية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، هي النظرية البنائية الوظيفية، التي يمثل مفهوم النسق الأساس الفكري فيها. فهي ترى أن المجتمع عبارة عن نسق عام، يتكون من مجموعة من الأنساق الفرعية التي تؤدي وظائف تساندية. وكلمة نسق تعني بأنه الكل الذي يتألف من مجموع الأجزاء التي تتمايز عن بعضها إلا أنها تتساند في الوقت نفسه. والنظرية الوظيفية ترى أن هناك تدرجا اجتماعيا تحتله شرائح وفئات اجتماعية لها مكانة اجتماعية بحسب الوظائف التي تؤديها، وقيمة المكانة يحددها العرف الاجتماعي في سياقه التاريخي”(98).
لقد أفاد د. مكنون في ما أورده من قول شحاتة: “ومن المهم أن نشير في البداية إلى أن مفهوم النسق يعد الأساس الفكري للوظيفية، ذلك الذي يتألف من مجموعة من العناصر المترابطة مع بعضها البعض، ويسود بينها نوع من التساند الوظيفي. لقد شغل مفهوم النسق مكانة محورية في إطار هذه النظرية، لذا نجده نقطة البدء وارتكاز لكل تحليل وظيفي للبناء الاجتماعي بشكل عام، ولعمليات التفاعل الاجتماعي لمكونات البناء بشكل خاص”(99) كما أفاد من قوله إن “كلمة نسق تعني بأنه الكل الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء التي تتمايز عن بعضها، فإنها في الوقت عينه تكون متساندة، وتمثل مجموع الأجزاء التي يطلق عليها بالأنساق الفرعية”(100) لكن الذي يؤخذ عليه أنه أحال استدلاله الوارد توًا والمشار إليه في الهامش الرابع والثمانين من مقاله، على ما يقرب من ستين صفحة من كتاب شحاتة هي من صفحة (ثلاث وأربعين) إلى صفحة (مائة) وعند الرجوع إلى الطبعة التي اعتمد عليها من الكتاب وجد من بينها سبع صفحات هي من صفحات الهوامش (المراجع كما يسميها د. شحاتة) لا المتن فلا علاقة لها بما يقول، وصفحتان داخلتان في الفصل الثالث المعنون بـ (النظرية الماركسية المادية التاريخية والجدلية)(101) فلا علاقة لها بالفصل الذي يتحدث عنه، أي أنه تزيّد في عدد الصفحات بصورة غير دقيقة، وعليه تكون الصفحات الواقعة بين صفحتي ثلاث وأربعين، وإحدى وتسعين هي الصفحات الأساسية للفصل الثاني الذي اعتمده د. مكنون، المعنون بـ (النظرية البنائية الوظيفية من الرؤية العضوية إلى النسق الاجتماعي) ويضم عدة عنوانات هي بعد المقدمة : مفهوم الوظيفية. مفهوم البناء. التوازن. رؤية المجتمع كنسق. الفعل الاجتماعي وأنساقه. فضلا عن عناوين فرعية داخلية. ولم يشر في اقتباسه إلى أبرز محتويات تلك العناوين وتعدد وجهات نظر العلماء بشأنها بشكل موجز، رغم أنه أحال على كل تلك الصفحات، وكان بإمكانه الإحالة على صفحتي النقل من كتاب د. شحاتة وهما الصفحتان (ثلاث وأربعون) و(ثمانٍ وخمسون) بدل الإحالة إلى كل تلك الصفحات، بل التزيد في عددها.
والأمر الآخر في فقرة د. مكنون موضوع النقاش ما جاء في آخرها، وهو (وقيمة المكانة يحددها العرف الاجتماعي في سياقه التاريخي) وأستغرب لماذا جاء د. مكنون بهذا السبب فقط (العرف الاجتماعي في سياقه التاريخي)، دون غيره من العوامل في تحديد المكانة الاجتماعية والتدرج الاجتماعي، وكأنه العامل الوحيد فقط. لقد أعدت قراءة الفصل المعني من كتاب د. شحاتة (الفصل الثاني) الذي اعتمد عليه فلم يرد فيه مثل هذا القول بوصفه العامل الوحيد فقط(102) وإنما تحدث العلماء عن تدرج اجتماعي يقوم على عدة عوامل، على اختلاف بينهم، فقيمة المكانة يحددها الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، والشخصي، وبناء على ماكس فيبر يقوم التدرج الاجتماعي على الهيبة الاجتماعية أو الاحترام لمثل طبقة النبلاء، والمهن التعليمية، وكبار الموظفين، ويقوم تدرج آخر على المكانة، والحزب أو القوة(103) و”يميز فيبر بين المراتب القديمة والطبقات القائمة في المجتمع، فيرى أن المراتب تتعلق بالمجتمعات المحلية، وأن الطبقات هي المجتمعات بالإضافة إلى غلبة المصالح الاقتصادية عليها. فإذا كانت المراتب تقوم على درجات الكرامة والشرف، فإن الطبقات تقوم على احتكار توزيع الأموال والمصالح الاقتصادية، ويقسم فيبر الطبقات الاجتماعية إلى طبقات عليا وتضم الأفراد المتميزين في الإدارة والإنتاج مثل رجال الصناعة والتجارة والمال والمحاسبة والأطباء والفنانين، ثم طبقة العمال التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث طبقات هم العمال الماهرون وشبه الماهرين، وبين هاتين الطبقتين طبقة وسطى تضم المزارعين والصناع والموظفين”(104) ومن وجهة نظر أخرى فإن “متغيرات المهنة والأوضاع الاقتصادية والقانونية وفقا لآراء سوروكين هي التي تحدد المكانة الاجتماعية للفرد على السلم الطبقي”(105) كما يقسم سوروكين “هذه الطبقات إلى ثلاث شرائح مختلفة كتقسيمه للطبقة العليا إلى عليا عليا، وعليا متوسطة، وعليا دنيا، وهكذا بالنسبة للطبقتين الوسطى والدنيا”(106) وهناك تقسيم كنجزلي دافيز، و وولبرت مور (107) و”جملة ما سبق أن تحديد الطبقة وفقا لآراء البنائية الوظيفية يقوم على أبعاد متعددة مثل: الاقتصاد والمكانة والبعد السيكولوجي والقوة، وأن هناك تركيزًا مكثفًا على المكانة باعتبارها الدعامة الجوهرية في وجود وتصيف الطبقات”(108) بغض النظر عن دوافع هذه المكانة، فليس ثمة تركيز على المكانة الاجتماعية وحدها، أو على الدور التاريخي لوجودها، لاسيما أن مجالات التطبيق التي يستند إليها أولئك العلماء تتعلق بواقع أوروبا وأمريكا الاجتماعي، وهناك آراء لشومبيتر(109) وموسكا(110) ودارندورف(111) وبوخارين(112) وزيمي(113) وبارسونز(114) ولويس كوزر(115) وعلماء اجتماع آخرين(116) وجملة القول كما يقول د.شحاتة صيام: “إن مداخلات تحليل البنية الطبقية ودروب التدرج الاجتماعي لم تشهد إجماعا بين الباحثين. فثمة تباينات جليلة بصدد نظريات الطبقة الاجتماعية والتدرج الاجتماعي، ففي حين ركز علم الاجتماع الكلاسيكي على وصف التدرج الاجتماعي، نجد أن التحليل العلمي للماركسية يركز على بنية الطبقات وكيفية تشكلها داخل نظام الإنتاج“(117).
إن ما وجّه د. مكنون إلى تحديد المكانة الاجتماعية وفق السياق التاريخي فقط، هو الإيديولوجيا، لا المسألة العلمية التي أفاض في شرحها العلماء في موضوع التدرج الاجتماعي. وبناء على تصوره الخاص جعل النظرية البنائية الوظيفية “أفضل نظرية اجتماعية وأنثروبولوجية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال”(118) ولا قيمة لكلمة (أفضل) هذه التي استخدمها في المجال العلمي، والحداثي منه بشكل أخص، إلا انطلاقا من تصور ايديولوجي يحاول تكييف المقولات الحداثية ومن ثم توجيهها لصالح قضايا معينة.
ويقول د. مكنون: “ومع تحفظنا على حالة السيولة في مفهوم الهجنة عند أدوارد سعيد وهومي بابا، فإنه يمكن تطبيق (مفهوم الهجنة بالمعنى الصحيح) للتبادل الثقافي الحر والاختياري على الأثر الحضرمي في المهجر” (119) ويضيف: “كما أنه يمكن دراسة الإنتاج العلمي والأدبي لكثير من العلماء والأدباء الحضارمة في أرض الوطن والمهجر وفقا (لمفهوم الهجنة المنضبط)”(120) ولعل القارئ يلاحظ هذه التعبيرات ذات الطابع التعميمي التقويمي التي وضعناها بين هلالين (مفهوم الهجنة بالمعنى الصحيح) و (مفهوم الهجنة المنضبط) ويقرنها بـقوله السابق (أفضل نظرية اجتماعية وأنثروبولوجية) والدالة في مجموعها على تفضيل إيديولوجي لطرائق معينة يتم منحها صفة الصحة والانضباط والأفضلية لتناسبها مع ما يريد. هذه الإيديولوجية إذا ذهبت إلى العلم جمدت بعض مناحيه، وأسهمت في تغيير بعض اتجاهاته لصالحها، وأرشدت القراء إلى ما تراه مناسبًا لقراءته بعيدا عن مناقشة قضايا تؤرقها، يقول د. مكنون: “يمكن الاستفادة من بعض الأساليب والتقنيات التحليلية لتيار ما بعد الحداثة، وخاصة في مجال تحليل النصوص الأدبية والفن” (121) ونظرت إلى كل النماذج والأمثال الشخصية كما لو كانت مثالاً شخصيًا واحدًا انطلاقًا من تصورها الأساسي المؤطِر للوظيفة الاجتماعية في مناح معينة، هي “بذل العلم، وإصلاح ذات البين، وفعل الخير” (122) وهي وظائف قيّمة، لكن الإشكالية تكمن في التأطير الذي يتغافل عن قيم أخرى أعطت بعض الشخصيات حضورها. وفي هذا الصدد يورد د.مكنون اسم أستاذي السيد العلاّمة عبدالله بن محفوظ الحداد قائلاً: “ولدينا مثال ونموذج يمثل طريقة سلفه آل باعلوي أصدق تمثيل، تتلمذ على يديه د. باعيسى وغيره من أساتذة اللغة العربية في جامعتي (الأحقاف) و(حضرموت) هو العلامة السيد عبدالله بن محفوظ الحداد” (123) لقد كان الرجل -عليه رحمة الله- علما فريدا من الناحية الأخلاقية والعلمية والإنسانية والوطنية، وكان أول في إحساسه بالناس والتجاوب معهم. علمنا كيف نفتح الأسئلة، ونفكر باستقلالية من خلال مقرر النحو الذي كان يقوم بتدريسه، والذي فتح لنا من خلاله مجالاً لتقليب وجهات نظرنا في الكيفيات الإعرابية المقترحة للشاهد النحوي الواحد حتى نصل إلى الصواب، وأفادتنا تلك الطريقة في تقليب وجهات نظرنا في قضايا تواجهنا في حياتنا، وكان يتيح لنا مجالا للتأمل الهادئ في إنتاج أفكارنا بترك مساحة من الوقت أمامنا للتفكير حتى يأتي أحدنا بالإعراب المناسب للبيت الشعري، فتعلمنا من خلال ذلك كيف نبني رؤيتنا للأشياء من خلال عدة احتمالات، ولعل اشتغاله بالقضاء أعانه على تقليب وجهات النظر التي نقلها –بعد ذلك إلى قاعة الدرس. وكنا نراه أقرب إلينا من أنفسنا بلطفه، وذوقه، ومفاكهته لنا، وكان يدفع بنا لتمثيل أنفسنا، لا للتعلق به، أو تمثله. وكان يحاول الاقتراب من سياقنا الشبابي لفهمنا، لا الاقتراب من سياقه لاحتذائه، وبينما كان ينمي فينا الروح العلمية كان يعبر بنا طريق التواضع للوصول إلى العلم، وكانت مفاهيمه -في أثناء الدرس- مفاهيم مخصصة ودقيقة، فهي مفاهيم نحوية وصرفية شكلت مرتكز وجوده المعرفي الرائع فينا، فلم يكن عرضيا في حياتنا أبدا، عليه رحمة الله.
ومما تعلمناه منه في جانب الاحتمال ما أوردناه في قولنا الذي أورده د. مكنون وهو (وقد يكون الدخول في عالم التصوف والكرامات منذ بدء إنشائه (المؤسسي) في حضرموت على يد الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ناتجًا عن إحساس العلويين بالغربة في المجتمع…)(124) وما تم إيراده كان مجرد احتمال قدم له بـ (قد) التي من إفاداتها مع الفعل المضارع -في استخدام الناس لها- التوقع (قد يكون) مما يعني حدوث الشيء أو عدم حدوثه، فتعامل معه د. مكنون على أنه قول قطعي وقدمه للقارئ بعبارة مؤكدة بـ (إنّ) هي “إن القول بأن الفقيه المقدم دخل عالم التصوف والكرامات لإحساس العلويين بالغربة في المجتمع من دون تقديم أي دليل لا نقلي ولا عقلي خطأ منهجي”(125) فكلام د. باعيسى قام على الاحتمالية، لا القطعية التي رآها د. مكنون بناء على (إنّ التوكيدية) التي استخدمها. وسيطول بنا النقاش لو خضنا في مناقشته في ما أورده في هذا الشأن، ونحن نرغب في أن يتلاءم طول هذا الجزء الثالث- الأخير من نقاشنا مع طول كل جزء من الجزئين السابقين، مع أملنا في مناقشة هذا الموضوع وغيره مما أورده د. مكنون في موقف ثقافي آخر لتحريك واقعنا الثقافي الذي نشكر للدكتور مكنون تحريكه بنقاشه، كما نشكر له ما أفادنا به في مجموع ملاحظاته سواء اتفقنا معه أم لم نتفق.
المكلا2021م
______________________
الهوامش:
86) مقال د. مكنون، ص28.
87) نفسه، ص29.
88) نفسه، والصفحة نفسها.
89) نفسه، ص31.
90) يمكن للقارئ أن يطلع على الجوانب المتعددة التي تناولها د. باعيسى في قراءته (ينظر: كتاب المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي، قراءة تحليلية، مرجع سابق، ص55-61.
91) مقال د. مكنون، ص37.
92) ينظر نفسه، ص39 هامش رقم (87).
93) نفسه، ص36.
94) نفسه، ص29.
95) نفسه، ص30.
96) نفسه، ص37.
97) نفسه، والصفحة نفسها.
98) نفسه، والصفحة نفسها.
99) النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، د. شحاتة صيام، الطبعة الأولى، الناشر: مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر2009م، ص43.
100) نفسه، ص58.
101) تم اعتماد الطبعة نفسها التي اعتمدها د. مكنون.
102) ينظر النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، ص77، على سبيل المثال لا الحصر.
103) ينظر نفسه، ص71.
104) نفسه، والصفحة نفسها.
105) نفسه، ص74.
106) نفسه، والصفحة نفسها.
107) ينظر نفسه، ص 78-79.
108) نفسه، ص79.
109) ينظر نفسه، ص80.
110) ينظر نفسه، ص80-81.
111) ينظر نفسه، ص81.
112) ينظر نفسه، ص82.
113) ينظر نفسه، والصفحة نفسها.
114) ينظر نفسه، ص83-84.
115) ينظر نفسه، ص85-86.
116) ينظر نفسه، ص87- 89.
117) النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، ص91.
118) مقال د.مكنون، ص37.
119) نفسه، ص28.
120) نفسه، والصفحة نفسها.
121) نفسه، والصفحة نفسها.
122) نفسه، ص37.
123) نفسه، والصفحة نفسها.
124) نفسه، ص36، ويقارن بـ : كتاب المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي، قراءة تحليلية، ص61.
125) نفسه، ص36.