ملاحظات على كتاب .. (قضايا تاريخية من حضرموت من التاريخ السري للاستعمار البريطاني – التزوير واستلاب الهوية)
ملف العدد
أ.د. عبد الله سعيد بن جسار الجعيدي


المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 24 – 25 .. ص 34
رابط العدد 24 – 25 : اضغط هنا
يعد هذا الكتاب الثاني للباحث والمؤرخ سالم فرج مفلح (يرحمه الله)، وقد قوبل في الأوساط الثقافية الحضرمية بوجهات نظر متنوعة المشارب والتوجهات؛ فبينما انطلق البعض من قناعاته الشخصية لأطروحات المؤرخ مفلح، هناك من وجد في آرائه الجريئة الناقدة للمدرسة الصوفية الحضرمية جبهةً معزِّزة لمواقفهم الضدِّية تجاهها، وفي المقابل ظهرت وجهات نظر مغايرة تراوحت بين الرفض الكامل أو التحفظ.
لهذا ما إن صدر الكتاب حتى اندفع إليه المتحمِّسون؛ للاحتفاء به، بوصفه كشفًا جديدًا أو دراسة فريدة، وذلك بتنظيم ندوة علمية تم اختيار محاورها من فكرة الكتاب نفسه، وعندما عرض عليّ الصديق الدكتور عبدالقادر باعيسى المشاركة في هذه الندوة، تحفظت في البداية من منطلق أن التعاطي العلمي مع الكتب الصادرة يتم عادة بعقد حلقات نقاش مفتوحة الفضاءات، تضع الكتاب في سياقه العلمي؛ بوصفه اجتهادًا بشريًّا قابلًا للنقد الموضوعي، ومما عزَّز من تحفظي في تلك الأثناء ما لاحظته من أن الجهات المنظمة للندوة – وقد أكون مخطئًا – تقدمت عندهم قضية الترويج للكتاب، والاحتفاء به على قضية النقاش العلمي المستقل، لكن بعد قراءتي للكتاب وجدت من المناسب الإدلاء بدلوي والمشاركة سواءً في ندوةٍ، أو حلقة نقاش، أو بنشره في المجلات الثقافية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فذلك يتسق مع اهتماماتي في قراءة المؤلفات التاريخية، التي أجد فيها إثراءً للمشهد الثقافي الحضرمي، ثم قراءتي المتأنية للكتاب تقدم الواجب العلمي النقدي على غيره من الدوافع الأخرى.
وبداية لابد من الإشارة إلى أن قراءتي المنشورة عام 2008م لكتاب المؤرخ مفلح الأول بعنوان: (حضرموت بين القرنين الرابع والحادي عشر للهجرة؛ العاشر والسابع عشر للميلاد بين الأباضية والمعتزلة- مشروع رؤية)، يمكن عدُّها جزءًا أصيلًا من هذه الملاحظات لهذا الكتاب الثاني، الذي يُعدُّ امتدادًا عضويًا لرؤية المؤلف التي تبحث بدرجة أساسية في قضية التحولات المذهبية في العصر الوسيط في حضرموت، على خلاف ما هو سائد أو متعارف عليه؛ بمعنى آخر إن قناعاتي المتحفظة على الكتاب الأول لم تتزحزح، بل أسهم الكتاب الجديد في تثبيتها وتجاوزها؛ لهذا ودرءًا للتكرار وجدت من المفيد الربط بينهما، وذلك ليكون ملحقًا لهذه القراءة في نهاية هذا المقال.
وإذا عملنا مقارنة علمية أولية بين الكتابين فلن تكون لصالح الكتاب الثاني البتة؛ لأن الأستاذ سالم مفلح قد ظهر في الأول بمظهر المؤرخ الحصيف المستميت المسيطر على الفكرة المركزية لموضوع كتابه، بعكس ما ظهر في هذا الكتاب (الثاني)؛ إذ بدا ملحقًا أو مستدركًا لسابقه؛ ففيه نجد شخصيات (مفلحيّة) تجمعت في المكان الخطأ بخطاب متنافر غير متسق، فيه ما فيه من أسلوب المؤرِّخ المدقق، وغضب الثوري، وسطحية النسق الدارج فاختلط الحابل بالنابل، فكان ذلك على حساب هوية النّص؛ لهذا سلب مفلح نفسَه من مكانه الحصين في كتابه الأول، الذي وإن اختلفنا معه لكننا نحترم وجهة نظره وقدرناها.
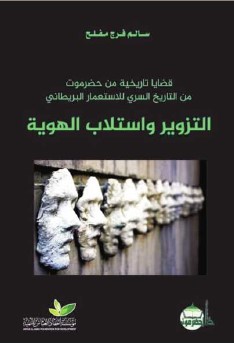
وحتى نبتعد عن الحديث العام ولندلل على ما قلناه، ولأهمية القضايا التي يثيرها الكتاب، ممكن أن نحدد بتركيز شديد ملاحظاتنا في النقاط الآتية:
* إنَّ عنوان الكتاب أقرب للمنحى الدعائي التسويقي، وفيه من الارتباك الذي لا يعكس مضمونه؛ فالمعروف في عنوانات الكتب هو اختزالها لفكرة الكتاب بعنوان عريض، ولا بأس من عنوان صغير توضيحي يحدد مسار الكتاب واتجاهاته. أما في غلاف هذا الكتاب جاء العنوان الأول بخط خفيف (قضايا تاريخية من حضرموت من التاريخ السري للاستعمار البريطاني)، وأسفل منه وبخط أعرض (التزوير واستلاب الهوية)، وهذا يجعل القارئ في حيرة عن أصل العنوان، ومدى علاقته بالمتن، وأيهما يجب أن يقدم، وقد يبدو هذا الترتيب شكليًّا لكن – وهذا الأهم – هو صيغة العنوان: (قضايا تاريخية من التاريخ السري للاستعمار البريطاني)، التي تحيل مباشرة إلى أن (جريمة) التزوير واستلاب الهوية الحضرمية، تم اكتشافها من الأرشيف الاستعماري البريطاني السري، وهو أمر قد يرفع سقف التوقعات في أن المؤلف استعان بكمٍّ هائل وجديد من ملفات ووثائق الأرشيف البريطاني، مكَّنته من كشف النقاب عن خفايا ذلك التاريخ، وأبعاد مؤامرة الاستعمار البريطاني وعملائه على حضرموت. لكن مع الاقتراب من صفحات الكتاب تتلاشى التوقعات، ويصطدم القارئ بهلامية العنوان، الذي لا يستند ولو على وثيقة تاريخية تسعفه ليرتبط مع مسمّاه، ولو من بعيد. ثم إن الإشارات التاريخية المتناثرة عن الدور البريطاني الخبيث في حضرموت سطحية، ومعروفة، ولا تمت للسرية بصلة لا من قريب ولا من بعيد، بل اعترى بعضها أخطاء علمية تاريخية فادحة؛ سنشير إليها في النقطة الآتية.
* من أهم الأخطاء العلمية التي تؤكد أن معلومات المؤلف عن تاريخ الاستعمار البريطاني المباشر في المستعمرة عدن، وغير المباشر في بقية سلطنات ومشيخات الجنوب؛ غير دقيقة وبعضها وليدة سرديات خاصة في خيال المؤلف بعيدة عن حقائق التاريخ المعروفة؛ ما ذكره عن المستشار البريطاني (هارولد إنجرامس) بتحميله مسؤولية جريمة (مذبحة الحموم) عام 1919م، وأنها جرت بعلمه وتعاونه مع السلطنة القعيطية؛ لكسر شوكتهم، وعلى هذه السردية المتخيلة وصف المذبحة بأنها “كتلة ضخمة من الحقد الاستعماري الدفين” (ص177). ومعروف أن أول دخول لإنجرامس لحضرموت كان في عام 1934م، عندما قام بجولة معلوماتية استخباراتية عن حضرموت نشرها عام 1935م؛ في كتاب بعنوان (تقرير عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حضرموت)، وقد تكرر اسم إنجرامس في الصفحات ( 176- 177) خمس مرات بخصوص هذه الجريمة الكبرى؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن إقحام إنجرامس في المذبحة لم يكن على سبيل السهو والخطأ الطباعي المغفور، ومعروف أن المستعمرين البريطانيين لا علاقة مباشرة لهم بهذه المذبحة، وأن تاريخ التدخل الاستعماري المباشر في شؤون حضرموت يعود إلى ثلاثينيات ذلك القرن (العشرين).
* ومما يؤكد عدم دقة المؤلف عن تاريخ الاستعمار البريطاني في حضرموت وضبابيته، وصفُهُ لإنجرامس في ذلك العام (1919م) بلقب (المستشار)، في حين أنَّ هذا اللقب يُعدُّ شكلًا من أشكال التدخل البريطاني في المحميات البريطانية، ظهر بعد تاريخ المذبحة بثمانية عشر عامًا، عندما تقلّد إنجرامس هذا المنصب بعد توقيعه مع السلطان صالح بن غالب القعيطي اتفاقية الاستشارة عام 1937م. كما أن سالم مفلح ذكر تاريخ المذبحة 1918م، وهذا غير صحيح والصواب 1919م، وقصة مذبحة الحموم كما تشير إليها الكثير من المصادر التي عاد إليها المؤلف يتحملها النائب عن السلطان (ناصر أحمد بوبك القعيطي) في الشحر، وأسرة السادة آل العيدروس الذين توسطوا؛ لغرض الصلح، ولا نريد الدخول في التفاصيل، ولكن هذه الضبابية التاريخية – ولن نقول التزوير التاريخي – التي بنى عليها معلوماته وعبارته الخطابية السابقة: “كتلة ضخمة من الحقد الاستعماري الدفين” تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن صوت الغضب الشعبي، والطرح المتهافت تقدم على رصانة المؤرخ وأمانته، وأن عبء عنوان الكتاب جعله يقحم المستعمرين البريطانيين في الزمان الخطأ، والمكان البعيد، وإن كنا لا ننكر سياستهم الخبيثة المدمِّرة أينما يحلون، وحتى بعد أن يرحلوا.
* وفي السياق نفسه حدّد في الكتاب عام اتفاقية عدن في (1917م)، وتكرر هذا الخطأ في مناسبات أخرى باستثناء (صفحة294)، ذكر في فقرة واحدة عام 1917م، وذكر أيضًا عام 1918م، وهو العام الصحيح، وإذا قبل هذه الخطأ العلمي من طالب ماجستير، فإنه لن يقبل من كتاب يدّعي بأنه يبحث قضايا عميقة من التاريخ السري البريطاني، ومعروف أنه في أثناء الحرب العالمية الأولى 1914- 1918م، كان لكل من السلطنتين الحضرميتين: الكثيرية والقعيطية موقفٌ مغايرٌ؛ ففي حين تعاطف القعيطيون مع بريطانيا ومالوا إليها، تعاطف الكثيريون مع العثمانيين، بل وجرت بين السلطنتين في عام 1918م مناوشات سميت بحرب (قسبل)، وبالتالي فإن (معاهدة) أو(اتفاقية)عدن الشهيرة عام 1918م عقدت؛ لترتيب أوضاع ما بعد نهاية الحرب.
* ويستمر الكتاب في تقديم الدليل العلمي على عدم إحاطة مؤلفه بأبجديات تاريخ التغلغل الاستعماري في حضرموت، عن طريق معاهدات الصداقة مرورًا بالحماية إلى معاهدات الاستشارة، ففي صفحة 222 كتب: “في أواخر القرن الثالث عشر الهجري كان الاحتلال البريطاني قد ربط الدولتين القعيطية والكثيرية بمعاهدات الحماية والصداقة معتمداً في ذلك على ما تطلق عليه الدراسات النقدية الكولونيالية (عملاء الصفوة)” (انتهى الاقتباس). من المعروف أن السلطنة الكثيرية دخلت ضمنيًّا في معاهدة الحماية بموجب بنود معاهد عام 1918م الموافق 1336هـ؛ أي في منتصف العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري. فهل يعقل أن المؤلف لم يطلع على بنود هذه المعاهدة؟! وهل هو على غير دراية بأن من ارتبط بمعاهدات مع البريطانيين هم القعيطيون ابتداءً من عام 1882م بمعاهدة الصداقة، ثم معاهدة الحماية عام 1888م، ومعاهدة الصداقة متقدمة على الحماية، بينما قدم في النص المقتبس الحماية على الصداقة، وهذه ليست حقائق سرية، بل هي منشورة في كل الكتب التي تناولت هذه المرحلة، والتي عاد المؤلف إلى معظمها في مصادره.
* وفي (صفحة 93)، يذكر: أن صلح إنجرامس سنة 1934م أي قبل الوظيفة الرسمية لإنجرامس في حضرموت، في حين أن المعروف من إعلان الصلح قد كان في عام 1937م إلى عام 1940م، ثم تم تجديده لعشر سنوات أخرى، وهناك أخطاء أخرى لكننا نكتفي بهذه الإشارات التي تؤكد أن معلومات المؤلف التاريخية عن الاستعمار البريطاني في حضرموت غير دقيقة، وبعضها يصل إلى الخطأ القاتل، الذي ينسف ما تقدم من أطروحاته، والمقدمات الخاطئة تؤدي ـ بلا شك ـ إلى نتائج خاطئة.
لكن لو تم إعادة ضبط العنوان فإننا قد نجد الثمين في الكتاب الذي يستحق المناقشة؛ خاصة قضية الهوية الحضرمية المسلوبة على حد وصف العنوان، وهي تحتل الصدارة في رؤية المؤلف؛ لهذا سيلاحظ القارئ تدفق شحنات مركزة لتأكيد هوية حضرموت الإباضية، ولا مشكلة في ذلك فهي وجهة نظر تاريخية خاصة، من حقه تبنِّيها والدفاع عنها، لكن المشكلة تكمن في استدعاء التاريخ ليتسيّد الحاضر، وغاب عن الكتاب أن الهويات الثقافية في المجتمعات البشرية متحركة، فهناك الكثير من الشعوب غيرت من لغاتها، وديانتها، على سبيل المثال مصر الفرعونية، ومصر القبطية، ومصر الرومانية، ومصر العربية. وهناك التغيرات المذهبية عند معتنقي الدين الواحد. وعلى أية حال فإن معظم التغييرات الثقافية المجتمعية تكون في بداياتها غير اختيارية، ومع مرور الزمن وتجذر حقائق الواقع يحدث ما يمكن وصفه بالقبول الجمعي للسائد الصامد، وخاصة عندما يكون محرك التغيرات من داخل المجتمع نفسه، وليس من خارجه؛ مثال على ذلك التحول العنيف أو القسري في المجتمع الإيراني الفارسي من مذهب أهل السنة إلى المذهب الجعفري الاثني عشري. وقريب من ذلك روما (إيطاليا) في عهد الإمبراطورية الرومانية الوثنية المقدسة، ثم عهد حكم البرابرة، وأخيرًا روما المسيحية.
وما حدث في حضرموت في تاريخها الإسلامي والحديث والمعاصر هو تغيرات مذهبية في إطار الثقافة الإسلامية الجامعة، وأيًّا كانت مسببات هذه التغيرات، وتبعاتها الضارة فإن حضرموت تفاعلت مع الصراعات المذهبية، والتحولات السياسية؛ لهذا فإن التوقف عند ملمح ثقافي تاريخي بالدعوة (الثورية)؛ لإحيائه وقد صار في ذمة التاريخ، ولم يعد له مزاج مجتمعي، أو قبول عام، يعد ضربًا من التمنيات الخاصة – ولم نقل الهذيان -؛ لأنه بهذا المنطق الغريب أولى في حضرموت المطالبة بثقافة مملكتها القديمة؛ التي كانت سائدة لما يقارب ألفَي عامٍ قبل الإسلام. ومن هنا تأتي الأهمية في الدراسات التاريخية الرصينة لفصل خطاب التاريخ – الذي يبحث عن الحقيقة؛ ليستمد منه التجربة والحكمة بوصفه كتلة واحدة بما له وما عليه – والخطاب التثويري؛ لتغيير الواقع بمحاولة نسف مراحل منتقاة من التاريخ، واستدعاء أخرى لجعلها المنقذ لحاضره.
ولتوضيح ما ذهبنا إليه بدايةً نشهد بعمق أطروحات المؤلف النقدية للمصادر الحضرمية، لكنه في تقديرنا لم يستطع الانفصال عن (مفلح) المناضل؛ صاحب القضية الوطنية التي لها مفرداتها الثورية والتنويرية المسموح بها في سياقاتها، ومكانها المستقل في ميادين النضال، وساحات الوغى، وأعمدة الصحف والمجلات، ومن أمثلة هذا الخطاب الثوري قوله في صفحة 9: “ولهذا وجب تفكيك نصوص تلك الرؤية لاكتشاف خباياها، وأسرارها من أجل تجاوزها وإزاحتها من المشهد الوطني إلى غير رجعة؛ كشرط أساسي للنهضة والبناء”، وقوله في صفحة 10 : “…إن معاناة شعبنا منذ وطئت أقدام المستعمرين الإنجليز إلى اليوم، هي نتيجة مباشرة لسياستهم التدميرية التي أخرجت شعبنا من التاريخ الإنساني ليصبح في عداد الشعوب المنقرضة وهي حية”، وقوله في 53: “…لأنه أكمل طمس الهوية الحضرمية السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الحضرمي، وجعلها أثراً بعد عين، وأورث حالة عمى وطني دفع ثمنها الحضارمة غاليًا من المعاناة والدماء والتمزق والتخلف والجهل”.
في هذه النصوص المختارة حمّل المؤلف الاستعمار البريطاني، والمدرسة الحضرمية الصوفية كل الرزايا والمعاناة، ودعا خاصة إلى الثورة ضد (حضرموت الصوفية)؛ لأنها جاءت – كما يرى – على حساب (حضرموت الإباضية)، وهو بهذا يقدم افتراضًا غير مباشر مفاده؛ إنه لو قدر للمذهب الإباضي في حضرموت الامتداد ستكون الأمور أفضل، وهو افتراض لا يستطيع أحد أن يرفضه أو يقبله؛ لأنه لم يحدث، ولكن لا بأس من المقاربة مع الشقيقة (سلطنة عمان)، التي امتد فيها المذهب الإباضي في معظم أرجائها لقرون عدَّة، ومع هذا وإلى عام 1970م – أي قبل وصول السلطان قابوس باني نهضة عمان الحديثة إلى سدة الحكم – كانت الأوضاع العامة فيها أكثر سوءًا مما هو عليه في حضرموت (الخرافية)، وسر الحكاية يكمن في أنَّ عُمَان تقدمت بإدارة وطنية سليمة ومخلصة، في حين أنَّ حضرموت تعثرت؛ لأسباب عدَّة ليس لها علاقة قريبة بالمذاهب الدينية وحركتها، ((إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)).
وفي الكتاب الكثير من مفردات الخطاب الثوري سنشير لبعضها عند الحديث عمّا وصفناه (بغضب النصوص)، لكن الجدير بالإشارة في هذا السياق إلى أن الكتاب الذي مدّ خطابه المعادي للصوفية حتى عصرنا الراهن، ودعا لإزاحتها كطريق وحيد نحو المستقبل المنشود، تغافل بشكل غريب عن واقع حضرموت الراهن، وانقسامها بين الصوفية (المحتلة لحضرموت)، وبين السلفية بكل أنواعها (الوافدة على حضرموت)، والتي صار لها مؤخرًا ثقلها الموازي. صحيح إن المؤلف المؤرخ سالم مفلح ينتمي ثقافيًّا للوسط السني الشافعي المعتدل غير المحسوب على الصوفية ولا على السلفية، لكن عدم إشارته إلى هذا التزاحم الذي يشترك أصحابه في القطيعة مع (هويتهم الإباضية الوطنية القديمة)، يثير الكثير من علامات الاستفهام.
إنَّ ضبابية معلومات المؤلف عن تاريخ الاستعمار البريطاني في حضرموت – كما سبقت الإشارة – جعلته يفترض وقائع لا مكان لها في التاريخ، ثم يشعلها بأسلوب ثوري يمكن وصفه إيَّاها بـ(غضب النص)، فهو يصب جام غضبه على المكتبة السلطانية، ويصفها بالشيطانية؛ لأنها احتضنت ـ بزعمه ـ كتابين متآمرين على حضرموت، وترك كل ما فيها من مؤلفات تعد بالآلاف، ثم ترك الاستعمار وما ينهبه من ثروات حضرموت، وصوّر مصير الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بأنه قائم على مؤامرتهم لتأصيل الصوفية؛ كي تعيش في أمان، كل هذا بلا دليل علمي أو سراج منير، وفي هذا الصدد دمغ الكتاب بنصوص اتسمت بالطرح السطحي الملتحم بالغضب الشخصي من ذلك قوله: “غير إن إنشاء المكتبة في ظل الاستعمار البريطاني، لابد أن يكون وراءه هدف تدميري قاتل للهوية الوطنية”، وهنا لا تعليق لنا!.
وتأكيدًا على نصوص الغضب التي ظهر فيها المؤلف شاهرًا سيفه لا قلمه نلاحظه يستخدم ألفاظًا لا تليق بأهل القلم، وأصحاب المشاريع الثقافية الكبرى؛ لهذا ظهر الغضب في النصوص عند إصراره على قذف المتآمرين على هوية حضرموت ـ بحسب رأيه ـ بمفردات الشتيمة، مثل (دناءة، وخسة وخسيسة ونذالة وتبخيس قذارة وحقارة…وغيرها)، وهي تنتشر في الكتاب انتشار الغضب في الورق، وإذا قيل إن المؤلف حُرٌّ في أسلوبه، ومفرداته لتوصيل فكرته، وبلوغ غاياته، فإن أسلوب الغضب الجامح كثيرًا ما يهز رؤية المؤرخ حتى لو عزّز آراءه واجتهاداته بالوثائق الدامغة.
وفي رأيي أن العنصر القوي في الكتاب يكمن في نقده التاريخي لبعض المؤلفات الحضرمية المشهورة في القرن العاشر الهجري وما بعده، لكن غلب على كثير من الاجتهادات أسلوب التأكيد من زاوية نظره الخاصة لقضايا تاريخية يصعب القطع فيها، وهذا جعله كمن يقرأ النص بعين واحدة، ومعروف إنه في غياب الأدلة الدامغة يستخدم المؤرخون عادة المنهجين الاستقرائي والاستنباطي؛ وهما من المناهج التي تقرب الصورة ولا تؤكدها؛ لهذا تجدهم كثيرًا ما يستخدمون مفردات مرنة، مثل: ويبدو لنا، وفي اعتقادنا، ولعله …إلخ، التي تحترم القارئ وترفع من قيمة المؤلف الذي هو غير ملزم بتأكيد ما غاب عنه الدليل القطعي؛ من أمثلة ذلك قوله: في صفحة 21 :”إن ما تم حذفه من نص الخبر هو (بن) في (يسر بن نجم)…”، وهو بهذا يختلق نصًّا جديدًا ظنيًّا، ولا يذكر مصادره، وفي صفحة 29 يورد أيضًا نصًّا من كتاب شنبل: “وقيل في السنة التي قبلها وصل السلطان جعفر”، ويعلق المؤرخ مفلح على النص بقوله: “وهل يعقل أن يكون غير متيقن من سنة حدوثه”، في حين أنَّ لفظة ( قيل) تدل على المرونة، وليس الجزم وتتسق مع نصوص المصادر التي تعتمد على الحوليات، ومن الأمثلة التي تجعل استنتاجات المؤلف واهمة قوله: في صفحة 45: “من المؤكد أن يكون هذا الخبر منقولًا من مصدر تاريخي إباضي حضرمي، ولا بد أن صاحبه قد أورد كل تلك الأبعاد في صياغته الأصلية”؛ فهو هنا يؤكد ويقطع بدون ما يثبت استنتاجاته بمصادر تسنده، في حين أنَّ المؤلف لو استعان بمفردات مرنة – كما سبقت الإشارة – كأن يقول: ويبدو لنا…. إلخ، لكان أقوم، وأقوى لحُجَّتِه.
وفي تضاعيف صفحات الكتاب تستمر السرديات المتخيّلة التي تتعسف على النصوص بإسقاطات حديثة، لا تستوعبها المراحل السابقة فهو يستخدم مصطلح الشعب الحضرمي، والوطن الحضرمي، ويصوِّره كأنه لحمة سياسية متأصلة في التاريخ، ثم يقلّل من هذا الشعب من غير قصدٍ منه عندما يقول: إن أصحاب الرؤية السائدة شلوا حركته، وأنهم زرعوا فيه نفسية الإنسان المدجن بثقافة الهزيمة، والانكسار، وفي الآن ذاته تفترض إحدى السرديات شخصية الحضرمي المثالية النقية المقاومة، لاسيما عندما تحدث عن الهجوم الكثيري على بلدة قيدون قال: “إن هذه الأفعال القبيحة يستحيل أن يقوم بها جنود حضارم في جيش بدر في حق أهلهم” (صفحة 83)، وهذا التنزيه العاطفي للحضارمة المبالغ في رفعهم عن طبيعة المجتمعات الإنسانية، التي لا تخلو من وجود نماذج الخائن، والخانع، والمجرم، والبطل والشجاع والمخلص، وهذا الطرح الذي يسهل الرد عليه بمواقف تاريخية ومعاصرة نستنتج منه بأن هناك حضرموت مثالية متخيّلة تمنَّاها المؤلف، لكن الكتابة التاريخية الرصينة هي التي تعيد تصور الأحداث، وتقريبها كما كانت، وليس كما نحب ونتمنى.
والخلاصة إن الكتاب مزيج من التاريخ، والخطاب الوطني الثوري، والسرديات المتخيّلة، ولهذا سيُقرأ من زوايا نظر متنوعة، لكن هذا الثلاثية شبه المتنافرة في رأينا نحن طلبة علم التاريخ قلّلت من القيمة التاريخية للكتاب – مع ما سبق ذكره من نماذج لأخطاء تاريخية وصفناها بالقاتلة – ومعروف أن هوية المؤرخ المنهجية تضيع عندما يتحول إلى جبهة تضطره إلى التمترس في خندق ضيق لمواجهة عدو افتراضي يتصيّد هفواته، ومثالبه، وهو بهذا يحرم نفسه من الفضاء المفتوح حيث حرية التحليق، واتساع الرؤية، وسلاسة الهبوط.

ملحق.. وهو مقالنا عن كتاب مفلح الأول:
صدر مؤخَّرًا عن دار حضرموت للدراسات والنشر كتابٌ مهمٌّ بعنوان: (حضرموت بين القرنين الرابع والحادي عشر للهجرة؛ العاشر والسابع عشر للميلاد بين الإباضية والمعتزلة، مشروع رؤية) تأليف الأستاذ سالم فرج مفلح. وضّح فيه المؤلف رؤيته العامة للكتاب بأنه يحاول تقديم مشروع رؤية، تعالج بعضًا من العيوب الكثيرة، التي يعانيها المكتوب عن تاريخ حضرموت الوسيط، وخلاصة ما أراد أن يقوله المؤلف: هو إن الأوضاع المذهبية والعقائدية والسياسية في حضرموت في العصر الوسيط لم تكن سنيِّة، بل كانت بين الإباضية والاعتزال، وظلت كذلك حتى العصر الحديث عندما ظهر على مسرح الأحداث السلطان بدر بن عبدالله الكثيري (بو طويرق).
ولأن المؤلف قدّم رؤية مغايرة عما هو معروف ومكتوب ومتداول عن تاريخ حضرموت السياسي والمذهبي، فقد أثرى هذا الطرح الكثير من الجدل والنقاش في الأوساط الثقافية المهتمة بتاريخ حضرموت، وتعدّدت الآراء والمواقف حوله، بين التعاطي المرن، والإعجاب المفرط، والرفض المطلق.
وما سأسجله هنا يدخل في باب التعاطي المرن مع هذا الكتاب المثير؛ عن طريق ملاحظات عامة وعابرة، دوَّنْتُها في أثناء القراءة، حاولتُ أن تكون بعيدة عن لغة الذم، والمدح، أو اقتناص الأخطاء.
لقد انطلق المؤلف من منهجية واضحة وهي الشك تارة، والرفض والتحييد تارة أخرى لغالب ما وصلنا من الموروث الثقافي لفترة الدراسة المتناولة، والتي تتعارض في أطروحتها مع الفرضيات المسبقة للمؤلف، ولكنه يعود إلى نصوص محددة لصالح مشروع بحثه، وقد وجد ضالته في نصوص أدبية يرى أنها أفلتت من يد الاغتيال، وواقع الحال أن المؤلف معذورٌ بعض الشيء عندما لجأ إلى بعض النصوص الأدبية، واجتهد في قراءتها وحاول استنطاقها؛ لاستجلاء جانب من الحقيقة التاريخية الغائبة والمغيبة. وفي اعتقادي أن الاستخلاصات التي خرج بها المؤلف لا تتحمل البناء المعرفي الكبير، والجديد الذي حاول أن يبرزه في مشروع الرؤية.
إن القراءة المجدية لأحداث التاريخ لابد أن تكون متجددة ومتأنية؛ لأن حقيقة الماضي لا تنكشف دفعة واحدة، بل عبر درجات ومراحل متتابعة وبوجوه جديدة، ولكن يشترط عند القراءة المتجددة للتاريخ ومصادره الابتعاد قدر الإمكان عن هيمنة الفرضيات المسبقة، ومنطق اقتناص السقطات.
والكتاب جمع بين محاولة تأكيد رؤية خاصة عند المؤلف ومشروع الرؤية، وكنتُ أظن قبل قراءتي للكتاب بأنني سوف أغرق في بحر من التساؤلات، أو سأمتد مع خطوط عامة عبر قرون عديدة من تاريخ حضرموت الوسيط والحديث، وإذا بنا نوجَّهُ من البداية وعن دراية إلى ما أراد أن يؤكده المؤلف، واضعًا أمامنا مقدماته ودافعاً لنا بلطف إلى نتائجه، وفي اعتقادي أن المؤلف وعن وعي منه ترك للباحثين والمهتمين فضاءً واسعًا لاختيار تساؤلاتهم، ورمى حجارته في المياه الراكدة؛ حتى تتسع دوائر المعرفة وتحتوي التساؤلات.
ولا شك في أن المؤلف كباحث موضوعي يتمنّى ظهور الحقيقة التاريخية، أو ما يقرب إليها وإن بدت على عكس ما يرى، وان كنت مع من تشكّك في أكثر أطروحات المؤلف، فإن هذا الشك أو الرفض يستجوب طرح الدليل العلمي المغاير، وهذا كما يبدو هدف معلن للمؤلف لاستدراج (الناس) نحو إعادة قراءة التاريخ، وإن أمكن إعادة كتابته.
ومن الأمور التي لفتت النظر في الكتاب؛ ذلك البعد المذهبي الطاغي للأحداث السياسية التي شهدتها حضرموت في فترة الدراسة، وقد صرح المؤلف في أكثر من موضع أن صراع القوى المتنافسة في حضرموت، هو صراع مذهبي بغطاء سياسي وليس العكس، وهذا الطرح الصارم يجرد الأحداث التاريخية من كونها حركة بشرية، تتأرجح فيها أولويات الصراع البشري وفقًا لمتغيرات المصالح، وتنوع المؤثرات، وتغير موازين القوى.
ومما يلفت النظر أيضًا في هذا الكتاب أن المؤلف رفض الرواية السائدة على وجود التصوف في حضرموت، قبل القرن العاشر الهجري، وميّز بين الزهد الذي كان سائدًا في حضرموت والتصوف، وإذا كان تاريخ حضرموت إلى القرن الثامن الهجري يكتنفه الكثير من الغموض حسب اتفاق معظم المؤرخين، فإن الفترة اللاحقة تمثل حالة انفراج نسبي؛ إذ يستطيع الباحث الصبور انتزاع مادته التاريخية من مصادر الموروث الديني والاجتماعي الحضرمي، هذا فضلًا عن المصادر اليمنية الأخرى التي تناولت أحداث اليمن بشكل عام، وهذا من شأنه تصحيح بعض الآراء التي وردت في مشروع الرؤية. وعلى سبيل المثال يظهر ذلك واضحًا عند الانقسام الداخلي المذهبي المسيَّس بين أمراء السلطنة الكثيرية في بداية القرن الحادي عشر الهجري، وتدخل الدولة القاسمية الزيدية فيه. فبالعودة إلى المصادر القاسمية، مثل (تحفة الأسماع والأبصار) للجرموزي، و(طبق الحلوى) لابن الوزير، و(تاريخ اليمن) لحسام الدين الملقب أبو طالب لا نجد النفَس المذهبي عند تناولهم للعلاقات القاسمية الكثيرية، ونستنتج من هذه المصادر أن الصراع كان سياسيًا بأهداف متنوعة.
إن الهزة الفكرية التي تعمَّدها الأستاذ سالم فرج مفلح جديرة بالتأمل وإمعان الفكر، وهي رؤية قد نختلف أو نتفق معها، لكنها في جوهرها دعوة صادقة، تبحث عن حقائق التاريخ، وتستفز الهمم، والكتاب (المشروع) – ككل المشاريع – يحتاج إلى العمل المؤسسي، والجهود المشتركة التكاملية المخلصة التي ترجع دائمًا إلى التراث فتسبر غوره، وتمتص رحيقه ليعاد إنشاؤه نورًا يضيء الطريق.