نقد
أ.د. عبدالله حسين البار
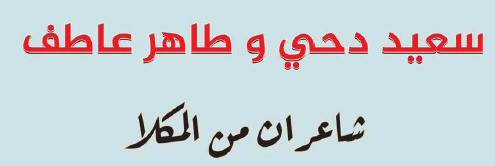

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 24 – 25 .. ص 115
رابط العدد 24 – 25 : اضغط هنا
الحداثة الشعريّة نمطان.
نمطٌ صعبٌ ومخيفٌ، وهو الذي يمثّلُه شعراءُ في العربية الحديثة والمعاصرة أدونيس واحدٌ منهم، ومنهم الشعراءُ خليل حاوي وصلاح عبد الصبور وأحمد حجازي والسياب وأنسي الحاج ودرويش والبردّونّي وآخرون من أمثالهم تنسرب لغتهم الشعرية في دوائر المتعة النصّيّة، كما علّم بارت.
ونمطٌ سهلٌ أليفٌ، وهو الذي يمثّله شعراءُ في العربية الحديثة والمعاصرة نزار قباني واحدٌ منهم، ومنهم نازك الملائكة ولطفي أمان وفاروق جويدة وعمر أبو ريشة وخالد عبد العزيز وآخرون من أمثالهم تعلّقت لغتهم الشعريّة بمربعات اللذّة النصيّة ومثلّثاتها، كما دلّ على معناها بارت أيضًا.
وما بين ذينك النمطين نمطٌ يجمع بين صفتيهما لعلّ الشعراء العرب الكبار بُلند الحيدريّ ومحمد الفيتوري وأمل دنقل خير من يمثّله.
ولقد مشى الشاعر المكلاوي الأستاذ سعيد محمد دحي على خطى المنتمين إلى النمط الأول بامتيازٍ.
وسار الشاعر المكلاوي طاهر عاطف الكلدي مترسّمًا طريق المتمثّلين خصائص أصحاب النمط الثاني ومميزات بناء لغتهم الشعرية باقتدار.
وهذان الشاعران متجايلان، جمعتهما حقبةٌ من الزمن واحدةٌ، وأحاط بهما إطارٌ مكانيٌّ واحدٌ، فقد ولدا في مدينةٍ واحدةٍ هي المكلا، وترعرعا في البيئة نفسها، وتقلّبا في أزقتها وشواطئها وسفوح جبالها بل وفي قمم تلك الجبال. وعرف كلّ منهما من تلك المدينة وجهًا غير الذي عرفه الآخر. واستهوى كلّا منهما ما رأى فانشده به وأُخِذَ به وسار إليه مشتاقًا. سيّان قبحه وجماله، دنسه وطهره، ذنبه وغفرانه. فلكلٍّ فيها ما يهوى. وذلك شأنُ المدن من أمثالها، وإن بدت ملامح تلك الصور محدودةَ الأثر فيها لا ترقى إلى ما نجده في المدن الكبرى، لكنه موجودٌ، وتجلّت أصباغٌ منه على أشعار هذين الشاعرين، كلّ على حسب شخصيته وتجاربه وثقافته في العموم والخصوص.
لكن، على الرغم من ذلك التوافق بينهما بدت صورة الشعر عند كليهما مختلفةً في بناء لغة الشعر، وهندسة القصيدة وتكنيكها. فالمطّلع على شذراتٍ من شعر الشاعر طاهر عاطف يلحظ ما شاب لغتها من شائباتٍ تتعلّق بالمفردة والتركيب وسبك البيت وحبك المعنى، في حين خلت منها لغة الشاعر سعيد دحي فصفت مظهرًا وشفّت مخبرًا. وهذا إجمالٌ في القول قد نجد له فسحةً في هذا المقام فنفصّله، وقد يعزّ علينا تفصيله فنكتفي بالمجمل منه، لأنا نودّ النظر في بواعث هذا الاختلاف في مستويات لغة الشعر عند هذين الشاعرين.
وهي بواعثُ شتّى لا يستطيع الناقد، أو قل قارئ النص، أن يغفلها، أو يغضّ الطرف عنها. منها: قلّة المحصول التعليميّ عند “طاهر” موازنةً بكثرته عند “سعيد”. فقد درس هذا المرحلةَ الثانويّةَ في السودان، وأكمل الجامعةَ بدراسة اللغة الإنجليزيّة وآدابها في كلية التربية بجامعة عدن، وعمل معلّمًا لها في كليّة التربية بالمكلا، ناهيك باتساع آفاق المعرفة أمامه حين هاجر واغترب عن بلاده. وهذا حالٌ لم تسنح فرصته للشاعر طاهر عاطف. فكان اعتماده في التحصيل على ما وقع بين يديه، وما أملته عليه قريحته ولا غير. حتّى معرفته باللغة الإنجليزية لم ترق إلى المستوى الأكاديميّ الذي ارتقت إليه معرفة الشاعر سعيد دحي به، فاختفى أثرها في شعر طاهرٍ.
ومنها: ما يتصل بجامع النصّ الذي تمثّله كلا الشاعرين. فسعيد انفتح على تجارب شعراء الحداثة في العربيّة الحديثة وسواهم من أمثالهم في اللغة الإنجليزيّة، مستفيدًا مما قرأه عنهم في العربيّة، ومما دلّته عليه الدراسة والثقافة العامة. وهو ما صفرت منه يدا طاهرٍ، فانحصر في النموذج (النزاريّ)، وفي منزع بعض شعراء المكلا خاصّةً، كالشاعر يسلم باحكم، والشاعر عبد الرحمن باعمر ومن في حكمهما من الشعراء الذين عرفتهم المكلا، فتقاصرت لغته الشعريّة في حين جلّى “سعيد” لغةً وعلا.
ومنها: الرؤية لمفهوم الشعر وغايات القصيدة والموقف من القصيدة. فأما “طاهرٌ” فقد عنّ له أن الشعر صدى تجارب شخصية محضة، ثم بدا له أن يجعل منه فضاءً يعالج به بعض مشكلاتٍ في مجتمعه. وهو في أغلب ما خلّف من نصوصِ شعره المبعثرة في أماكن شتّى، والمدوّنة بأقلام محبين لا يتعمّقون في قراءة الشعر ولا درسه ولكنّهم حفظوا له نصوصًا عديدة هي كل ما بقي له من نتاجٍ شعريٍّ وكان سببًا في بقاء اسمه يتردّد على أفواه رواة الشعر، وقليلٍ من دارسيه. أقول: إنه في أغلب ذلك أقرب إلى شعراء الفطرة والطبع منه إلى شعراء الصنعة والمحكِّكين الذين يعيدون النظر في قصائدهم ويراجعونها حتى تبدو تامة النسج مكتملة الصياغة. فهو ممن يجيدون سبك الشعر لكنه لا ينشغل بتنقيحه ولا يعتني بهندسته ولا يدقق في تكنيكه، ناهيك بأنه لم يقع على قارئ ناقد يهذب له ما شاب شعره من شوائب، ويصلح له ما بدا مختلًّا منه، أو يدلّه عليها ليصلحها هو على أقلّ تقدير.

أما “سعيد” فقد كانت القصيدةُ كتابَ ذاتِه، وهدهدَه الذي يأتينا من سبئه بنبأٍ يقين. ولذلك عمقت قصيدته رؤيةً وتنوّعت موقفًا وازيّنت هندسةً وتكنيكًا. والإبداعُ في أصله تكنيكٌ.
ولعلّ العامل الحاسم والفاعل في التمييز بين هذين الشاعرين (المكلاويين) يكمن في طبيعة الانتماء السياسيّ، ومدى الالتزام به، وبشروط نواميسه قبولًا ورفضًا. “فسعيدٌ” ينطلق من رؤًى سياسيّةٍ تجعله يقبل موقفًا ويرفض آخر، ويبشّر بصورٍ من المعاني وينذر بأخرى آخرين لينفروا منها، وإن بدا في واقعه المعيش متحفّظا في الجهر بها والإعلان عنها لأمرٍ كذلك الأمر الذي بسببه جدع قصيرٌ أنفه، لكنها موجودةٌ في شعره ولها فيه دلائل لا تخفى.

أمّا “طاهرٌ” فقد كان أقرب في شعره إلى المستغرقين في الذات ومشكلاتها، فقد حُمِّلَ وزرًا من زينة تلك الذات ومن مباذلها، ومن انسحابها من المجتمع وقضاياه بعد أن اتخذ المجتمع وراعوه منه موقفًا هو إلى المقاطعة أقرب من سواه. فبدا في صورٍ من شعره أدخل في من وصفوا (بالبوهيميّين) واللامبالين بقضية أو موقف.
ومن هذه البواعث والدواعي انبثق التمايز والاختلاف بين الشاعرين. ووقوفنا اليوم معهما على تلك البواعث سبيلٌ للوقوف على مميزاتٍ بينهما في الأداء وخصائص الأسلوب. ولعلنا – إن أمكن الوقت وأسعفت الصحة – حين نعرض لقصائدهما بشيءٍ من التحليل نتعرّف على النصوص التي كان من المتوجّب ذكرها في مظانّ من هذه المقالة لكن اتساعها وتناميها حال دون الاستشهاد بما تيسّر من تلك القصائد فعذرًا عذرًا حبيبي القارئ، فللضرورة أحكامها كما يقولون.
طاهر عاطف وشعراء عصره
موازنةٌ نقديّةٌ بين قصائدَ ثلاثٍ
قبل البدء في عملية التحليل نبدأ أولَ ما نبدأ بنشر القصائد الثلاث، لغاياتٍ ثلاثٍ.
الأولى: لتوثيق نصّها، وأعني بذلك قصيدة الشاعر يسلم أحمد باحكم، ومطلعها:
ماس تيهًا وثنى العِطفَ غراما فحنا القلب عليه وترامى
وقد شوّهها التداولُ إلى حدَّ الابتذال، فغدت مسخًا في الرواية، وعجز المتبصّرون بالشعر عن تذوّقها وتبيّن شعريتها لما امتلأت به من أخطاءٍ لم يصوبها قلمٌ، ولم يسدّد قوافيها عارف بالشعر يحسن ضبطه. وإنّي أشكر هنا كلّ الذين أسعفوا وساعدوا على العثور على النصّ الكامل وشبه المنضبط لهذه القصيدة، وقد عزَّ الوصول أليها لولا همّةٌ قعساءُ اتسم بها بعض الأحبة شِيبًا وشبانًا.
والثانية: التعريف بنموذجٍ من شعر طاهر عاطف ليتعرّف القراء على شيءٍ من تجاربه الإبداعيّة وطرائقه في نسج الشعر وسبكه. وقد اخترنا له قصيدةً مطلعها:
من رصيف الحزن أهديكم سلاما شاحبَ اللونِ كأحزان اليتامى
وقوامُها واحدٌ وثلاثون بيتًا. يبث فيها طاهرٌ بعضَ وجدِه وشجنِه ويتحسّر فبها على ما فاته من زمنِه، ويأسى على ما تبقّى منه لقادم الأيّام. ومن أسفٍ أننا لم نجدها مذيّلةً بتاريخٍ كما صنع في قصائد أخرى له أودعها كرّاسةً مخطوطةً في أمانة أحد الأحبّة الذي تكرّم وأعارنيها لنفيد منها ما نفيد ثمّ نعيدها إليه مشكورًا، وقد تمّ.
وقد استدعت تتمّةُ القول في هاتين القصيدتين استحضار الثالثةِ الأخرى، وأعني بها قصيدة الشاعر عبدالرحمن عمر باعمر، ومطلعها:
مرَّ كالبان اعتدالًا وقواما بخطًى تبعث في القلب السلاما.
وهي ذائعةٌ منتشرةٌ، لا يكاد يجهلها أحدٌ، ولها في أفئدة المتلقّين ومحبّي شعر الغناء الفصيح في حضرموت وسواها من البلدان مقامٌ معلومٌ. وقد خُيِّلَ لي ذات زمنٍ أنها من قديم ما لُحِّن وغُنِّيَ حتّى أخبرني الأستاذ عزيز الثعالبي بغيضٍ من حكايتها وحكاية قصيدة الشاعر يسلم باحكم، فعلمتُ أن لا تزال بلادي مبدعةً ولّادةً، وأنّ نهر الإبداع فيها سائرٌ لا ينضب ماؤه.
وبهذا اكتمل أمامي متنٌ شعريٌّ، قوامُه ثلاثُ قصائدَ اتفقت في شيءٍ واختلفت في أشياء ممّا استوجب هامشًا نقديّا يكشف فيه كاتبه غامضًا، ويضيء معتمًا، ويضع القصائد الثلاث في ميزان الوعي بالشعر وإدراك خصائصه الأسلوبيّة.
وهاكم القصائد الثلاث قصيدةً قصيدةً.
ماس تيهًا وثنى العِطف غراما فحنا القلبُ عليه وترامى
ذو محيّا تخجل الشمسُ له إذ بدا كالصّبح، أو زاح اللثاما
بحياتي أغيدٌ قلبي به هام مذ حيّا، وأحياني ابتساما
مُتْ رقيبي. إنّ عيشي قد صفا من لقاهُ، ولديّ الأنسُ داما
رقص القلبُ سرورًا إذ وفي لِيَ وعدًا. إنّه وعدُ الكراما
لا بلغت القصدَ إن رمتُ به بَدَلًا، أو سَمِعَتْ أُذْني مَلاما
هاتِ أطربنا بذكراه وكرّرْ فيه وصفًا. وأدر فينا الـمُداما
نحتسيها بنتَ دنٍّ، عَرْفُها زاد لمّا فاح نَدًّا وخزامى
آهِ ما أنعمَ أوقاتي بها! تمّ لي بدرُ التداني. يا سلاما
مُتُّ لولا أنّه أدركني من لمى رشفته تحيي العظاما
أنتَ عينُ الأنسِ حقًّا، ولكم أصبح القلبً مقرًّا ومقاما.
*** *** ***
مَرَّ كالبانِ اعتدالًا وقَواما بخطًى تبعثُ في القلبِ السَّلاما
رَقَصَتْ من تِيهِهِ أعطافُه وأريجُ السِّحرِ قد أزرى الحزاما (أو الخزامى)
أَسْكَرَ الروضَ شذًا من طِيبِهِ وشدا الشّحرورُ يزجيه الغراما
ياحبيبًا خفقَ القلبُ لَهُ تَرْجمت دقّاتُه منه الكلاما
قُلْ لمن قد لامني في حُبِّه لا تُطِلْ عَذْلَكَ فينا والملاما
ليس يدري الوجدَ إلّا مُدْنَفٌ يجرعُ اللوعةَ أو يُسقى الحِماما
قد صفا لي من زماني واحدٌ كان لي من كلِّ دنياي الـمَراما
فصنعنا من هوانا جَنّةً سَبَحَتْ أرواحُنا فيها هُياما
وانتَشَت سكرى بِأقْداحِ الهوى فَنَسِينا حَولَنا هذا الأناما
يا لدنيانا نعيمًا عامِرًا نحتسي القُبلةَ خمرًا ومُداما
ياحبيبي تِهْ دَلالًا في الورى واسكنِ الأحشاءَ دارًا ومُقاما
ومُرِ القلبَ فَمَا أسعدَهُ أن يطيعَ الأمرَ ياروحي دواما
ما مقامُ العمرِ أن فارقتني وجعلتَ النورَ في عيني ظلاما
*** *** ***
| من رصيف الحزن أهديكم سلاما | شاحبَ اللونِ كأوجاع اليتامى |
| مــفرقــي شابَ ولكن لم يزل | رغم أهوال الهوى قلبي غلاما |
| يسألُ الركبانَ عن أخباركم | وينادي: أين أحبابي القدامى |
| أنتمُ أضرمتمُ النَّارَ بقلبي | مَنْ سواكم يا ترى يطفي الضَّراما؟ |
| نضبت بئرُ الهوى من بعدكم | كيف يحلو لى الهوى فيها مقاما؟ |
| صار قلبي زاهدًا من بعدكم | نذر العمرَ صلاةً وصياما |
| رضع القلبُ الهوى من ثَدْيِكم | فتعالوا علّموا قلبي الفطاما |
| ناسكٌ يقتاتُ من ذكراكم | كلُّ شيءٍ غيرَكم أضحى رُغاما |
| هذه الأيّامُ مِن دوراتِها | لم يَدُمْ حُلْوٌ ولا مُرٌّ أقاما |
| يحتسي الأحبابُ من كاساتِها | عَلْقَمًا حينًا .. وأحيانًا مُداما |
| وتُريهم كلَّ يوم عجبًا | تارةً حربًا .. وأطوارًا سلاما |
| قُلَّبٌ ساعاتُها .. غدّارةٌ | لا تُراعي الوُدَّ أو تَرْعى الذِّماما |
| هل نسيتم كيف عشنا زمنًا | نملأُ التاريخَ عشقًا وهُياما؟ |
| إنْ مشينا فخُطانا قَبلَنا | تزرعُ الدَّربَ غُصونًا وحَماما |
| أو سمرنا فالدُّجى في نشوةٍ | وضياءُ البدرِ سُكْرًا يترامى |
| أو جلسنا والضُّحى منتصفٌ | لفَّنا الفُلُّ وغطّانا الخزامى |
| قبلَنا ما كان قبلٌ .. بعدَنا | لن تلاقي عابدَ الحُسنِ إِماما |
| كلُّ شيءٍ صار لا معنى له | فكؤوسُ الخمرِ وهمٌ والنَّدامى |
| وحديثُ العشقِ أضحى تافهًا | والجميلاتُ مللن الابتساما |
| والليالي فقدت روعتَها | وضياءُ الكونِ قد صارَ ظلاما |
| والروابي الخضرُ لا لونَ لها | والعصافير مضت تنعي الغراما |
| والروابي فقدت فتنتَها | وخيولُ الشعر مزقن اللِّجاما |
| وبناتُ الحَضْرِ ما عُدن هنا | وبناتُ البَدْوِ غادرن الخياما |
| وزُقاقات (المكلا) أَقْفَرَتْ | والزِّحامُ الحُلوُ ما عاد زحاما |
| والغواني فوق (جولِ الديس) لا | تُلْهِمُ الشّعرَ الذي يحيي العظاما |
| وخُصُورُ القومِ لا تُرقصُها | “مَرَّ كالبانِ اعتدالًا وقواما” |
| كلَّما ماست أمامي حُلْوةٌ | صحت يا قلبُ: فأصغى ثُمَّ ناما |
| كُلُّ ما حولي قبيحٌ .. ذابلٌ | فكأنَّ الحُسنَ قد أرخى اللَّثاما |
| وخيالي لم يَعُدْ يسعفني | ولساني كاد أن ينسى الكلاما |
تنهض العلاقة بين القصائد الثلاث على أساسٍ من ثنائيّة الائتلاف والاختلاف بينها، وتجلّت في عددٍ من المستويات، أوّلها:
المستوى الإيقاعيّ: اتفقت القصائد الثلاث في إيقاعها الوزنيّ بحرًا وقافيةً وحرفَ رويٍّ، فجاءت جميعها من بحر الرَّمَل التام، عروضه محذوفةٌ وضربه تام، وجاءت قافيتها مردوفةً، ورويّها الميم، والألف بعده وصلٌ.
كما اتفقت في (التصريع). وهو – كما عرّفه ابن رشيقٍ في (عمدته) – “ما كانت عَرَوُضُ البيت فيه تابعةً لضربه تنقص بنقصه وتزيد بزيادته”. وهو هنا بزيادةٍ.
لكنّ القصائد الثلاث اختلفت في أشياء أخرى، فمنحها الاختلافُ هويّةً إبداعيّةً انمازت بها قصيدةٌ من قصيدةٍ على عددٍ من المستويات، أهمُّها مستوى العنوان. فقد تميّزت قصيدة طاهر بعنوانٍ يتدلّى من أعلاها كالثريّا المتلألئة، بينما عُرِفت قصيدتا باحكم وباعمر بالجملة الفعلية الأولى التي اُستفتِحت بهما القصيدتان، فصارتا عنوانًا لكلّ واحدةٍ منهما، فيقال (ماس تيهًا) و(مرّ كالبان).
وإذا كانت قصيدة باعمر قد حملت في الديوان المطبوع عنوانًا هو (غصن البان)، فهو غير شائعٍ، وليس فيه ما يدلُّ على تلك القصيدة لا جوهرًا ولا عَرَضًا. فإذا أجبتَ سائلًا يسألك عمّا تقرؤه، وقلتَ: قصيدة (غصن البان). ما فهم منك قصدًا. حتّى إذا قلتَ له: (مرّ كالبان). وعى قولك وأدرك مقصودك.
ولعلّ الحال ينطبق على قصيدة الشاعر يسلم باحكم لو أنّه طبع ديوانه ووضع لقصائده عنواناتٍ لم تعرف بها من قبل فيتغيّر المقصود منها بتغيّر العنوان.
أمّا قصيدة طاهر فقد وُسِمَت بالعنوان من بدئها. والعنوانُ علامةٌ سيميائيّةٌ كما يقولون، ومن هنا أهميّته عند تخليل النصّ. إنّه بوّابةُ العبور إلى النصّ. هذا في العموم، أمّا ونحن منحصرون في نصِّ طاهرٍ فإن القول سيتخذ تحليلا تفريعيًّا.
عنوان القصيدة – كما وسمها به الشاعر نفسه – هو (رسالةٌ من رصيف الحزن)، ووضع هذا الدّال (رسالة) عنوانًا لقصيدةٍ ثيمةٌ عرفتها الشعرية العربية في عصرها الحديث منذ الشاعر بدر شاكر السيّاب حتّى الشاعر نزار قباني. وما من شاعرٍ من شعراء الحداثة العربيّة إلا بعث قصيدةً موسومةً بعنوانٍ هو (رسالة إلى، أو مِنْ)، واختلفت سمتها، فقد تكون ثوريّةً اجتماعيّةً كما في (رسالة إلى سيف بن ذي يزن) للمقالح، أو عاطفيّةً وجدانيّةً كما في (رسالة من تحت الماء)لنزار قباني. وقد تأتي (رسالة) نكرة لا تُدرَك هويّتُها إلا بقراءةِ متنِها الشعريّ كاملًا كما في قصائد كتبها السيّاب ودرويش وعددٌ آخر من شعراء الحداثة العربيّة، وتكرّر استخدامهم لهذا الدّال عنوانًا في أكثر من قصيدةٍ. بل وظهر عنوانًا لمجموعٍ نصّيّ كاملٍ هو (مئةُ رسالةِ حبٍّ) وهو للشاعر نزار قباني.
جاءت قصيدة طاهر لتنتظم في هذا النسق الشعريّ، وليست الوحيدةَ فيه، فلها نظائر، لكن هذه القصيدة استحوذت على الاهتمام كونها عمدت إلى تبيان موقفه من التحوّلات الاجتماعيّة التي رآها تحدث في مجتمعه (الصغير) المكلا، وكان معنيًّا بتحوّلاته لأثرها في نفسه وأحواله المتبدِّلة. فكأنّ تلك “الرسالة” هي كتابُ ذاته الذي ينفث فيه أساه ويشكو بثّه وحزنه إلى الآخرين حيث هم يوجدون، وفي هذا ما يخصب تجربة قصيدة طاهرٍ عمّا في قصيدتي باحكم وباعمر اللذين هيمن عليهما حسّ الغناء والطرب فتخيّلا مواقفَ وصاغا فيها مقاطعَ من شعرٍ تنسجم مع طبيعة اللحن المصوغ من أجلها ليتذوق المتلقي طربًا، ويبتهج من أداء الغناء. ومن هنا عزّت قراءة القصيدتين بعيدًا عن دائرة التلحين، وعزّ تلقيهما نصّين شعريّين معزولينِ عن تلكم الدائرة، في حين تألّقت قصيدةُ طاهرٍ في وجدان المتلقي وإن لم يضمَّها نسقٌ لحنيٌّ. وهذا اختلافٌ جوهريٌّ بين القصائد الثلاث وإن انتظمت في نظامٍ إيقاعيٍّ واحدٍ.
ينتصب الدّال (رسالة) – وهو نكرةٌ – خبرًا لمبتدأ محذوف إن أردت ذلك. ولقد يغدو مبتدأً خبره شبه الجملة من الجار والمجرور وما بعدهما، وهذا ،كذلك، جائز. لكن قف عند حرف الجر (مِنْ)، فستراه يفيد معنى ابتداء الغاية، وهو معنى غير ما جاء في استخدام (إلى) عند المقالح الذي أفاد معنى بلوغَ الغاية وانتهاءها. وهكذا هم الشعراء يوظّفون أقسام الكلام اسمًا وفعلًا وحرفًا لمقاصد الشعر ودلالاته المتنوعة.
يتلو حرف الجر تركيبٌ إضافيّ (رصيف الحزن)، وكلّنا يعرف الرصيف، وكلّنا يعرف الحزن من حيث هما دالان لهما وجودهما في المواضعة اللغوية، إِنْ شيئًا حسيًّا أو حالًا معنويًّا، لكن الشاعر انزاح بهما فأدخلهما دائرة الاتساع.
وللرصيف حضور في أدب الحداثيّين عامة، وفي أدب (الوجوديّين) منهم خاصة، فهم يرون فيه نقيضًا للتجدّد والتنوّع من حيث هو وجودٌ إسمنتيّ حجريّ لا يتغيّر ولا يتجدّد، تمرّ فوقه الجموع ذهابًا وإيابًا وهو حيث هو فغدا رمزا للصبر والاحتمال.
ويا رصيفا يحفر الصبر في لوحيه تاريخ الأسى والشحوب
ويستنكرون جموده وعدم تململه من ذلك الحال ولو بنأمةٍ خافتةٍ أو حركةٍ ضعيفةٍ.
يأتي لفيفٌ ويليه لفيف وأنت ثاوٍ ههنا يا رصيف
تستعرض الأطوار مستنكرًا ومبديًا صبر الحياد الحصيف.
ويعجبون من اتحاده بالجموع التي تعبر فوقه وتثقل عليه الأعباء المتجدّدة دون تمرّدٍ على الموجود.
ثُمَّ ماذا؟ ورصيفٌ مُثْقَلٌ برصيفٍ يحسب الصمت حصافة.
… إلى آخر ذلك.
ولقد كان رصيفُ طاهرٍ باعثًا على الحزن كونه مكانًا ترصد منه الذات المتكلّمة تحوّلات المجتمع وتبدلاته الاجتماعية. ومن هنا جاءت الرسالة المبعوثة منه بعد اكتمال الرؤية واشتمالها على صنوف التحول والتغيير.
وفي هذا تتجاوز قصيدة طاهر قصيدتي باحكم وباعمر معًا لانغمارها في جحيم الواقع ونأيها عن عاطفة الرومنسيّين، وبساطة الوعي في أشعارهم، فصعد بقصيدته إلى مستوى تجارب الشعراء في عصره، وإلى أضرابه من شعراء جيله.
2) الاختلاف على مستوى الاستفتاح في مطالع القصائد:
وهناك اختلاف بين القصائد الثلاث على مستوى الاستفتاح بالضمير. فقد عمدت قصيدتا باحكم وباعمر إلى الاستفتاح بضمير الغائب (هو) تحديدًا. فقال الباحكم: (ماس تيهًا) دون أن يعيّن لنا ذلك الذي ماس فجهلنا هُويّته ولم نحدّد معالمه ولم يبق لنا منه إلا ذلك الضمير الدال على الغائب, وشايعه في ذلك الباعمر حيث قال: (مَرَّ كالبان), فلم نعلم من ذلك الذي مَرَّ, وما صلتُه بالذات الشاعرة في كلتا القصيدتين.
ويتمدّد هذا الغياب في القصيدتين, فإذا هو عند باحكم يتحوّل إلى نعت للمجهول بالجمال دون أن نعرف من يكون ذلك المائس تيهًا، أهو صديقٌ أم حبيبٌ, أَذَكَرًا كان أم أنثى أم أَيَّ شيءٍ هو في عالم الأحياء والأشياء والنعوت. فقال:
ذو محيا تخجل الشمس له إن بدا كالصبح أو زاح اللثاما
وهنا تشير الكناية في قوله: (أزاح اللثاما) إلى أن المقصود بالمائس تيها حبيبةٌ نجهلها فلم يزل الشاعر يوغل بها في الخفاء ولا يكاد يظهرها للعيان, ومثله صنع الباعمر حيث يقول:
رقصت من تيهه أعطافه وأريج السحر قد أزرى الحزاما
ولقد تكون (الخزاما).
ووصف المحبوب بالتيه عند باعمر إنما هو ترسُّمٌ لقول الباحكم ذلك في مطلع قصيدته, فهو تابعٌ له، ولم يكن قوله في نعته محبوبه بذلك أصيلًا كما هو الحال في مطلع قصيدة الباحكم.
لكنّ طاهرًا ينزاح عنهما في الاستفتاح بضمير المتكلم، والإشارة إلى حال الذات (شاحب اللون), وهو بهذا يَلِجُ بالذات المتكلمة إلى دائرة الانفعالية أو التعبيرية كما قال جاكبسون في حين ثوى بطلا قصيدتي الباحكم والباعمر في دائرة الملحمية والسرد. قال طاهر:
من رصيف الحزن أهديكم سلاما شاحبَ اللون كأوجاع اليتامى
وهنا تتجلى الذات المتكلمة لضمير (الأنا) لتؤكِّد حضورها على مرارة مأساته, وتعلن عن وظيفة تعبيرية للكلام يبث من خلالها المتكلم شجنه وحزنه.
وحتى إذا اخذنا بالرواية الأخرى في هذا المطلع, وقد وردت عند بعض رواة شعره, وهي:
من رصيف الحزن يهديكم سلاما شاحبُ اللون كأوجاع اليتامى
يظلُّ ضمير الغائب هنا في مقام التجريد الذي يتعادل فيه ضمير الغائب مع ضمير المتكلم في الدلالة على الذات المتكلمة. وكأنّ الشاعر جَرّدَ من ذاته آخر يتحدّث عنه وهو يقصد نفسه.
وهو ما يؤكّده الشاعر في البيت الثاني من القصيدة بقوله:
مفرقي شاب ولكن لم يزل رغم أهوال الهوى قلبي غلاما
وفي هذا تأكيدٌ على أنّ الغياب في البيت الأول – على هذه الرواية – هو حضورٌ ظاهرٌ في البيت الثاني, وفي ما تلا من أبياتٍ لاحقةٍ. ومن هنا يُسوّغ الافتتاح لضمير المتكلّم لاتساق الدّوال وتناغم التركيب. وهذا كثيرٌ في أشعار الشعراء العرب. قال الأعشى:
وَدِّعْ هريرةَ إنّ الرَّكبَ مُرتَحِلُ وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أيُّها الرّجُلُ
فالمخاطب هنا هو الشاعر نفسه, وإنما جاء بآخر منه ليقيم بينهما حوارًا ويجلو دراميّة نفسيّة ملحوظة. ومثله قول أبي الطيب:
لا خيلَ عندَكَ تُهديها ولا مالُ فَلْيُسعِدِ النّطقُ إنْ لم يُسْعِدِ الحالُ
والقول فيه ما قيل في سالفه. وهكذا صنع طاهرٌ, جَرّدَ من ذاته آخرَ وأخبر عنه ليفيد منه معنى السرد والملحمية. أما قوله: (شاحب اللون) فهو في الرواية الأولى منصوبٌ على الحاليّة, وهو في الرواية الثانية مرفوعٌ على الفاعليّة. وهذا من سمات الكلام السامي الذي يحتمل الصفة ونقيضها, ومن هنا وسم الشعراء بأنهم أمراء الكلام.
3) الترادف: وفي قصيدتي الباحكم والباعمر اتفاقٌ على استخدام الترادف على مستويي الإفراد والتركيب. فأنت حين تقف على مطلع قصيدة باحكم تجده يفتتحها بالجملة (ماس تيهًا) التي تعادل في الدلالة قولك: تكبر واستعلى. ثم يشفعها بجملة ثانية هي: (وثنى العطف), وهي دالة على التكبر والاستعلاء. أما (غراما) فهي نابيةٌ في موضعها, لأنّ حال المتكبر المستعلي أن ينأى عن الهوى والغرام. ولذلك يروون عن (نرسيس) في الميثولوجيا اليونانية نأيه عن الغواني الحسان ترفعًا وتأبيًّا وتكبّرًا على الرغم من تهافتهنّ عليه. ولكنّ باحكم رأى في محبوبه ذلك الحال, فله ذلك. لكنّ جملتي (ماس تيها) و (ثنى العطف) مترادفتان تمنحان الدلالة عينها.
أما في قصيدة الباعمر فإن الترادف بين المفردات لا يخفى من مطلع القصيدة: مَرَّ كالبان اعتدالًا وقواما. وهل الاعتدالُ إلا القوامُ والقوامُ إلا الاعتدالُ؟ وهو مولعٌ بذلك حتى تكرّر في ابيات أخرى من القصيدة:
يا لدنياي نعيمًا عامرًا نحتسي القبلة خمرًا ومداما
وهل الخمر غير المدام؟ وقال:
يا حبيبي تِهْ دلالًا في الورى واسكنِ الاحشاءَ دارًا ومقاما
وهل يكون المقام إلا في الدار حتى غدت الدار مقاما؟
لكن باعمر أحكم الوصف بالطمأنينة في السير حين قال: (بخطًى تبعث في القلب السلاما).
على أن قصيدة باحكم مليئةٌ بالخروج عن الصحة النحوية كما في قوله:(إنّه وعدُ الكراما) حيث نصب ماحقُّه الجرُّ بالإضافة, ونصب ما حقُّه الرفعُ كما في قوله: (ياسلاما). وكلُّ ذلك بتأثير العامية ومزاحمتها للفصحى في شعر الرجل وتلك خصيصةٌ معروفةٌ في شعره, ولعدم وجود التنقيح الذي يساعد على الخلاص من منكرات الخطأ وملبسات الجنوح عن الصواب.
ولا يخفى على عين اللبيب المتفحّص ما في قصيدة باعمر من ترسّم لخطى باحكم في كثير من معانيه, وكأنه يعيد تجربته نسخةً ثانيةً دون أن يتجاوزها كما صنع طاهرٌ في نظمه قصيدته التي تجاوزت القصيدتين معا وإن شايعتهما وزنًا وقافيةً ورويًّا.
ولعلّ قارئًا كريمًا يسأل: ما الرابطُ الجامعُ بين الشاعر يسلم أحمد باحكم والشاعر طاهر عاطف الكلدي, ولكلٌّ منهما مشربُه الشعريُّ واتجاهُهُ الإبداعيُّ؟
والإجابةُ عن هذا السُّؤال, وهو صائبٌ, ستتجاوز التعاقب اكتفاءً بالتزامن إجراءً نقديًّا يبين عن الغامض ويكشف عن المقصود.
فالناظرُ في لغةِ قصائدِ باحكم التي شدا بها الفنّانان محمد جمعة خان وعبد الربّ إدريس يَلْفِتُه ما يشوب فصحاها من استخدامٍ عاميٍّ، وتجاوزٍ عن الالتزام بنحو العربية وسننها. وما تتسم به تلك العامية من نفحاتِ عبيرِ فصاحةٍ عربيةٍ على نحو يتسق مع قدرات الشاعر وحرصه على تيسير النظم على ذلك المنوال دون الالتزام بما التزم به سواه من شعراء عاصرهم وعاصروه, وأقاموا معه في مدينةٍ واحدةٍ هي المكلا, وغنّى لهم الفنانان جمعة وإدريس قصائدَ فصيحةً ذات عربيةٍ سليمةٍ. ولقد انتجت تلك اللغة الهجين صورًا من الخصائص الاسلوبية في شعر باحكم المغنَّى وتميزت بها.
وكنتُ وقفتُ من ذلك على بعض ظواهر تستحقّ ذكرًا في هذا المقام, وهي إن قلّت عددًا فعلى قدر النزر اليسير المتوفّر من شعره. من ذلك:
هذه اللغة المشوبة لا نملك أن ننعتها بالعربية الفصيحة ولا بالعامية المحكية محليًّا ولكنّها مزيجٌ من هذه وتلك. وهي ميسرة لدى شاعرٍ أتقن ضبط وزن الشعر بحرًا وقافيةً ورويًّا, ووجد في اللحن منجاةً لإخفاء عيوب لغته ونبوِّها عن قواعد العربية وسننها. فشاعت قصائده بين المتلقين بوساطة جمعة وإدريس ومن تابعهما من مغنيين, فلهج بها المتعلم والجاهل, وتذوقها المقرزم بالشعر والعالم بأسراره, وجذبت الألحان الموضوعة على تلك الأشعار أفئدة تهوى الغناء وتطرب له.
ومن الغريب أن لغةً كتلك اللغة لم تجد من يقوّمُها ويكشف عن ملامحها ليتبيّن شُداةُ الشعر مواضع الاستقباح والاستحسان فيها على الرغم من وجود عارفين بأصول العربية ومتمكنين منها في المدينة أو خارجها فتركت وشأنها تفعل أفاعيلها في أفئدة المتلقيين دون تبصّرٍ.
هذا الصنيع من شاعر ٍكباحكم كان ذا أثرٍ سلبيٍّ على شاعرٍ مثل طاهرٍ فظهرت في شعره أصباغٌ من تلك اللغة الهجين دون أن تلقى مُعِيْنًا يُهَذْبُها ويُنَقِّحُها ويُخَلِّصُ شعر طاهر منها. وهو لم ير في استخدامها حرجًا، ألم يجدها في شعر شاعرٍ ذاع صيته؟ يغني له كبار المغنين ويتباهى بترديد أشعاره كل أهل مدينته. فَلْتَبْقَ في الشعر إذًا ما بقيت القصائد, وَلْيَتَكَفَّلِ الزّمن ببث الرأي فيها. وليس هذا الصنيعُ نتاجَ نظرةٍ فلسفيّةٍ للغة كما فعل دانتي في اللغة الايطالية ولكنه صدى انفعال واستسهال للإبداع دون مشقّةٍ وإعناتٍ. وهاك نماذج مختارة عشوائية من شعر طاهر. قال:
كنتُ أصلبْ كلَّ يومٍ ألف مرة
كنتُ أبلعْ كلَ يومٍ ألف جمرة
لم أذق ثانيةً واحدةً معنى المسرّة
كل أيام فراقي لم تكن إلا عذاباتٍ وآلامًا وحسرة
هنا عمد الشاعر إلى جزم الفعل المضارع دون مسوّغ للجزم ليستقيم له الوزن، وأمضى السطر الشعريّ على وزنه مفترضًا فيه صحة الأداء، مع أنه كان في ميسور الشاعر وقد أعسره الوزن على الوقوع على الصيغة الملائمة لاستقامته أن يجعل جملتي (كنت أصلب / كنت أبلع) في سطرين متناظرين يتلو كل فعل منهما الظرف اللاحق به. وسيحقق التوازي بين التراكيب للشعر نغمًا لا يخفى. وخذ مثلًا آخرَ:
1 كلُ ما فيك تغيّر.
2 صرت أحلى: صرت أكثر.
3 لا زلت عالي الرأس مرفوع الجبين.
4 لوحةً عظيمةً تسر الناظرين… إلخ.
وبمسٍّ قليلٍ من قلمٍ حصيفٍ يمكن للسطر الثالث أن يصبح:
لم تزل
عاليَ الرأسِ ومرفوعَ الجبين
ويستقيم له الوزن ويصحّ له المعنى. كما يمكن استبدال كلمة (عظمى) بكلمة (عظيمة), فَيَسْتَدُّ المعوجّ.
أما أطرف ما استخدمه طاهرٌ في قصائده من العامية الحضرمية وكان مُوَفّقًا في استخدامه فهو قوله:
لا أنتَ هارونُ الرشيد أبثُّه غُرَرَ القصيدِ, ولا أنا بِنْ هاني
ففصيحها (ابن هاني). ولكنّ الوزن سينكسر فحذف همزة الوصل وجاء بها حضرميةً ذات رنين موقّعٍ وموفٍ بالقصد.
وجميع هذه الهنات في شعره ما كان لها أن تأتيه من جهة شعراء العربية قديمهم وحديثهم, وإنما مصدرها ما لمسه في لغة شعر باحكم من استخدامٍ للعامية فيها دون تنقيح فاستساغها ثم احتذاها, وما كان له أن يصنع ذلك لولا اختفاء صوت الناقد وقلمه الذي يصحح الخطأ ويحرص على السلامة اللغوية في العربية.
لكنّ طاهرًا يظلُّ على الرغم من كلّ ذلك شاعرًا غطت عليه الأيام برداءٍ ثقيلٍ فجهل قومه مقامه وقد آن لهم أن يعرفوا قدره فينتصروا لإبداعه.
ٍٍالمكلا 22/10/2019