دراسات
د. عبده عبدالله بن بدر
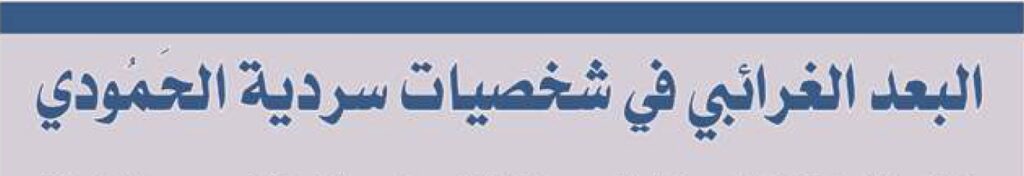

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 1 .. ص 76
رابط العدد 1 : اضغط هنا
كلية الآداب – جامعة حضرموت
نشرت مجلة الرافد كتابها الشهري المعتاد في ديسمبر ( 2013) العدد 060 من تأليف الدكتور عمر عبد العزيز والكتاب بحسب التصنيف الأدبي يعدّ من جنس السرديات ، والسردية المعنية بالدرس اختارت لنفسها عنوانا ً هو (الحَمُودي) وهو أسم لأحد الشخصيات الرئيسة في النص، و(الحَمُودي) العنوان مكتوب برسمٍ إملائيٍ عريض يتلقفهُ القارئ ببصره مباشرة من أول نظرة في واجهة العتبة الأولى المحمولة على الغلاف.
إن العنوان الرئيس لون نفسه باللون الرمادي ربما لتهيئة القارئ نفسيا ً لاستقبال الشخصيات المحاطة بظلال الغرائبية والعجائبية فضلا ً عن طبيعة اللون الرمادي نفسه الذي يحيل إلى الغموض والسردية، ولم تنس السردية نفسها ان تُدرج تحت هذا العنوان الرئيس عبارة شارحة تُجليهِ أتت على النحو الآتي ((قصة مهاجر على درب الحنين والأنين)) وهي عبارة اكتست باللون الأسود لتتناغم مع هارمونية اللون الرمادي لتعزيز عالم الغرائبية والأسرار والمكابدة والمعاناة ، لرفع درجة التعايش مع هذا العالم الذي لا يخلو على غرائبيته من الدهشة والألق، والقبض على معانٍ خاصة تنعدم في الواقع الحسي المباشر وتظهر على مستوى الرؤية والمعنى وتبدى ذلك في تفاعل الراوي مع الشخصيات. إن القارئ يجد نفسه بوساطة الإحالة إلى العنوان الشارح إزاء سردية تحكي عن الهجرة والترحال وما يرتبط بها من مشقة ومعاناة ولعل الدوال (الحنين والأنين) تزخ بهذه المعاني، وتعزيزا ً لمعنى الهجرة والرحلة زيَّن الغلاف نفسه بمكون ٍ بصري من أجل سد فراغات المعنى في الغلاف والمكون البصري عبارة عن صورة لطائر النورس ، وهو طائر لا يخلو من الغرائبية في هيئته الهيكلية ومفرط في الرشاقة فمنقاره مفرط في الطول ويتقارب في طوله مع رجليهِ ، ورقبته طويلة أيضا ً ، وكأن هذه الهيكلية التي هو عليها قد تحققت من جراء المكابدة والمعاناة في الهجرة والترحال ، والنورس في الواقع يداوم على الهجرة والترحال وعلى الرغم أنه يحيا في البر إلا أن مصيره مرتبط بالبحر، فهو لا يبتعد عن البحر إلا ليقترب منه ولا خيار له في هذه العملية إلا أنه مجبور عليها، إذ يعتمد في قوته على البحر وهو يحمل دلالة البشارة لكل من يركب البحر.
إن مثل هذه الكيانات البصرية يلجأ إليها السارد بوعي من أجل خدمة النص ورفع درجة رمزيته الفنية وتساعد هذه الكيانات البصرية في الإشباع الجمالي عند القارئ. ولعل الدرس السيميائي قادر على قراءة هذه اللغة البصرية بطريقة حاذقه – ولا يقتصر الأمر على السارد في اللجوء إلى مثل هذه اللغة البصرية ، بل أن دور النشر تستعين بها لتغوي القارئ وتروج لإنتاجها في عالم عرض الكتاب وتدفع القارئ من أجل الأقبال عليه ، وليس من المبالغة إذا ما استحسن القارئ الاختيارالموفق للمكون البصري في السردية المعنية فهو اختيار واع ٍ له علاقة وثيقة بالنص ولعله يوازي في معناه العنوان الرئيس (الحَمُودي) ويعبر عنه بطريقة خاصة يستهويها الحـس البصري و(الحَمُودي) عبر البحـر كانت لـه حياةٍ لا تخلو من الشقاء، لكن البهجة والرضا لم ينعدم منها إنه نورس بشري.
إن القارئ وهو يتأمل في هجرة الشخصيات وترحالها لا يمكن أن يضع الجميع في مستوى موحد لمعنى الهجرة أو الرحلة (فالحَمُودي) حين هاجر كان مجبورا ً على هذه الهجرة ولا إرادة له فيها ، لكن شخصية الطيّار لم تكن مرغمة على الهجرة أو الترحال على طريقة (الحَمُودي) بل مشكلتها وجودية تتطلع إلى تجاوز الظاهر من الوجود لتنفذ إلى الباطن حيث الأسرار والحقائق الكبرى ، ولذا كانت الرحلة هي رحلة المعنى للحياة واكتشاف الذات والشعور بنور الحقيقة الكبرى التي تؤول إليها حركة الأشياء والأحياء ، ومعنى الرحلة بالمفهوم غير المباشر يمكن أن تدرج فيه جُل الشخصيات إذ ليس بالضرورة أن تكون الرحلة التنقل في المكان، بل يمكن أن يكون على مستوى الذات كما هو الحال في (دَمّدَمْ) أو السيدة الصموت أو جدة الراوي نفسها – وحتى شخصية (البحار الكشار) مارست مفهوم الرحلة لكن على مستوى المعرفة البشرية الملتصقة بالبحر ،في أثناء الترحال كانت تتنامى هذه المعرفة وتتقوى ، وكل من هذه الشخصيات تقدم معنى للوجود على طريقتها الخاصة وعلى تباين هذا المعنى بين البساطة والعمق إلا أنه لا يخلو من الدهشة والألق والإحساس بالإشباع الوجداني .
إن الخصوصيات التي انفردت بها الشخصيات في هذه السردية أنتجت صوراً من الغرائبية والعجائبية لازمت هذه الشخصيات وعززت وجودها ، ولم تكن هذه الغرائبية على صورة واحدة بل تعددت في طبيعتها ومرجعيتها ، فمره تمتح هذه الغرائبية من عالم الأسطورة والخرافة التي تتغذى على الوعي الشعبي كما هو الحال في شخصية (دَمْدَمْ) الحريص على العادة السنوية التي يظهر فيها يحمل بيرقا ً ينفث دخانا ً يُزعمّ أنه يقضي به على الثعابين والآفات في حارة العرب (بمقديشو)،و(دَمْدَمْ) معنى قرآني يعني الهلاك والعذاب، ولكنه هنااتخذ دلالة إيجابية فهو هلاك للأمراض والآفات التي تصيب القرية وأهلها وليس هلاكاً وعذاب لأهل القرية كما هو الشأن في قصة النبي صالح حين عقروا أهلها الناقة ، ومرة أخرى تمتح هذه الغرائبية من حقل التصوف وتبدت هذه الغرائبية فيما فعله الطيّار الذي اتخذ من عمامته وسيلة نقل بحرية يشق بها أمواج البحر ويتحدى بها صاحب الباخرة الذي أبى أن يحمله على باخرته ولم يتردد الراوي في وصف ما فعله الطيار بالفعل نفسه الذي فعله الغزالي وليس الأمر مقصورا ً على هذا الفعل الخارق العجيب بل أن الطيار ومن بعده الطيارون من أهل المعروف والتقوى ، كانوا يتناوبون على قراءة القرآن ويختمونه في ليلة واحدة ، وهم أنفسهم من تحمل عبء نشر الإسلام في ربوع أفريقيا ، ومرة ثالثة تجلت هذه الغرائبية في سلوك (سيدة الصمت) هذه الشخصية على الرغم من أن القارئ يمكن أن يحيل مرجعيتها إلى الأسطورة وهي المرجعية نفسها التي يمكن أن يسند إليها (دَمْدَمْ) إلا أن هذه الشخصية كانت محاطة بالغموض أكثر من (دَمْدَمْ) ولا يتجرأ أحد على النيل منها أو السخرية منها فضلا ً عن تأكيد الراوي على أناقتها .إن هذه السيدة كانت تصمت فصلا ً كاملا ً لا تكلم فيه إنسيا ، ثم تنطق بعد ذلك ويزعم أنها على صلة بعالم الجن وهي السيدة الوحيدة التي تفهم (دَمْدَمْ) وتُحسن التعامل معه ، ومن المتابعة لشخصية (بلّو على قووود) . وهي جدة الراوي نلمح هذه الغرائبية أيضا ً فهي على أميتها القرائية والكتابية إلا أنها تجيد التسبيح والأوراد والأذكار بطريقة لافتة وبدون أخطاء وبحسب وصف الراوي أنها تؤدي هذه الأوراد ببيان شفاهي تكاد تراه بالبصر كما لو أنها من علماء (اللسانيات الكبار 28) وكانت شعلة من النشاط إلى أن تجاوزت المئة من العمر وفوق هذا وذاك فهي تخاطب الأموات وتعتني بكل أفراد العشيرة ، فضلا ً عن قدرتها الاستشرافية فقد توقعت بالخطر الأمريكي القادم على الصومال قبل وقوعه بسنوات إذ أشارت إلى البحر وقالت ((من هنا سيأتيكم عدو مبين يفتح موت دائم وأنين)) 30 . ويمكن إحالة مرجعية هذه الغرائبية إلى حقل التصوف وهو حقل الطيار نفسه إلا أن (بلّو على (قووود) لا ترحل من مكانها مثل الطيار فهي تستطيع وهي لم تغادر القرية أن تكتسب كل هذه القدرات والعطايا وهي عطايا وهبات إلهية ولا تتحقق إلا بتمكين إلهي بحسب منطوق الراوي. أما شخصية (البحار كشار) على معرفته بعلم الهيئة وعلم الفلك إلا أنه في علمه لا يخلو من غرائبية ومعرفة بأسرار البحر فكان يحدد سير الباخرة بوساطة طعم المياه التي يتذوقها ، ويعرف بعد كم من المسافة يتغير لون البحر ودكنته وكيفية فرح الأسماك وغضبها وغيرها من الأسرار – أما شخصية (الحَمُودي) على صفاتها البشرية التي أجلاها الراوي ورصد بعض ملامح حياتها اليومية إلا أن هذه الحياة لم يحررها الراوي من الغرائبية وأن لم تكن هذه الغرائبية حاضرة بقوة كما هو الحال في الشخصيات التي سبق ذكرها .
إن غرائبية (الحَمُودي) نابعة من القدرات الذاتية القارة في هذه الشخصية وتتمتن هذه القدرات في أثناء هروبه من سطوة جند الإمام وقطعه للمسافة من تعز إلى عدن مشيا ً على الأقدام (وفجأة في ليلة الرعب تلك كان يرى كالبوم ، ويسمع كالغزال ، ويجول بعينيه الدائريتين كاليعسوب النهري ، ويستدعي قواه الكامنة كالحصان في مضمار السباق ، وينتصر على جراح رجليه بطاقة التجفيف الذاتي للدماء النازفة) 48 . إن الراوي هنا استبدل صفات (الحَمُودي) البشرية بصفات حيوانية وهي صفات مطلوبة من أجل تجاوز الأوقات العصيبة التي يمر بها (الحَمُودي) إنها لحظات تقرر وجوده ، أما الصفات الغرائبية الأخرى هي قدرته على المنام ومخاطبته لجده أثناء النوم على الرغم من أن جده (الطيار) رحل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ، وتواصله مع جده لا يحظى به كل البشر بل من كان له مقام (الحَمُودي) . وبفضل جده القريب من الحضرة الإلهية . وعلى كل هذا القدرات الذاتية عند (الحَمُودي) إلا أنه لا يخترق سنن الطبيعة كما يفعل الطيار ، تبقى الشخصية الأخيرة وهي شخصية (زياد بري) رصدت من قبل الراوي وربما فرضها عليه المكان فهي شخصية سياسية تمتعت بقدرات ذاتية استطاعت أن تقرأ طالع الأيام للصومال وزعمت أن الاقتتال والصراع في الصومال لن يكف وسيستمر ، وقد أسهم (بري) في إشعال فتيل هذه الحرب في ربوع (الصومال)، حين فتح مخازن الأسلحة للقبائل ، وعلى الرغم من تخليه عن السلطة بعد الإطاحة به إلا أنه لم يتخل عن ثلاثة أشياء وهي طائرة الرئاسة وختم الرئاسة وكرسي الرئاسة ، وهذه غرائبية لا يمكن أن تصدر إلا من إنسان مريض بالسلطة ومهووس بها ومُدمن لقراءة كتاب أبن سيرين في تفسير الأحلام .
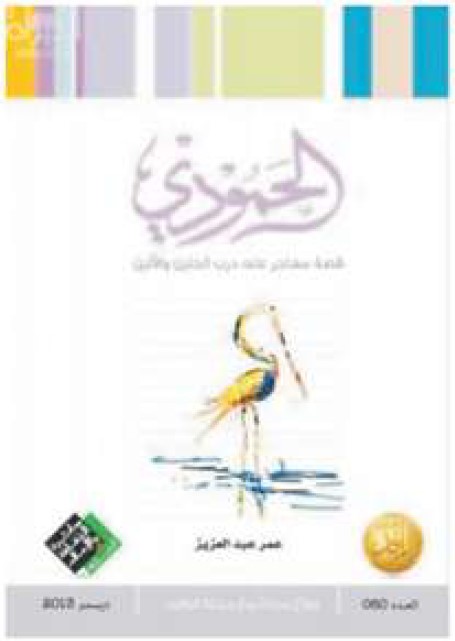
إن الغرائبية في سردية (الحَمُودي) حاضرة بقوة في جُلّ الشخصيات وإن تباينت في مستواها وحقلها التي تمتح منه ، لكنها ظلت ملازمة للسردية إلى آخر صفحة فيها ، والراوي اعتمد في بناء شخصياته على الإلحاح على هذا البعد الغرائبي حتى أصبحت بعض الشخصيات عبارة عن كيانات غرائبية شبه خالصة تقدمت فيها الصفات والأفعال الغرائبية على الصفات والأفعال الأخرى كما هو الحال في شخصية (دَمْدَمْ) و(سيدة الصمت) والطيّار. وتعزز هذا البعد الغرائبي بفضل الراوي الذي لا يكتفي بالرواية عن الآخرين عن نفسه ويبدي تعاطفا ً مع شخوص السردية إلى درجة التماهي معها ، ويسقط المسافة بينه وبينها ، ويعدد مناقبها وفضائلها ، و يلجأ إلى لغة تُعلّي من قدراتها وترفع من شأنها ومقامها فضلا ً عن الشعور الذي يتنامى عند القارئ إزاء الراوي بشأن الماضي الذي ولى وغاب على مستوى الوجود الحسي الظاهري ، لكن مازال حاضرا ً بقوة يتلألأ في وجدان الراوي ويشع بالبهجة والحنين إليه ، ولذا تجد الراوي الذي يصف هذا الزمن الذي ولى (بزمن الصفا الأول) وأن الوجود فيه مشحون بالرومانسية وأن الدهشة لا تفارق الإنسان وأن العالم كله له مذاق خاص .
إن الراوي يمتدح هذا الزمن ويُشيد بالحياة فيه ويعلن عن فضيلتها وكيف أنها ساعدته على أن يتعايش مع الجميع ويرافقهم بسلام ومودة بغض النظر عن مللهم ونحلهم ، منتصرا ً بذلك للنزعة الإنسانية القارة في كل إنسان سليم الطبع والعقل . واللافت أن الراوي لم يعارض هذه الغرائبية سوى مرة واحدة هي تلك المرة التي اعتقد فيها الناس في حارة العرب بمقديشو أن القنافذ منّة من السماء تتنزل للقضاء على الثعابين وأتت هذه المعارضة بلغة هادئة ومتفهمة لهذا الوعي الشعبي على لسان الراوي إذ يقول (( بعد سنين عرفت سر العشق لتلك القنافذ التي كانت قادرة على إخراج الثعابين من أوكارها والقضاء عليها، ذلك أن الثعبان يتعاطى مع القنفذ كفريسة سهلة ، وحالما يلتف عليه لخنقه تنغرز أشواك القنافذ في جسده حتى إنه لا يستطيع الفكاك فينزف حتى الموت ، ومن هنا جاء الاعتقاد الشعبي بأن القنافذ منة سماوية ، لأنها تقوم بقتل الثعابين المنتشرة في أروقة الحارة )) 12