ملف العدد
أ.د. عبدالله حسين البار
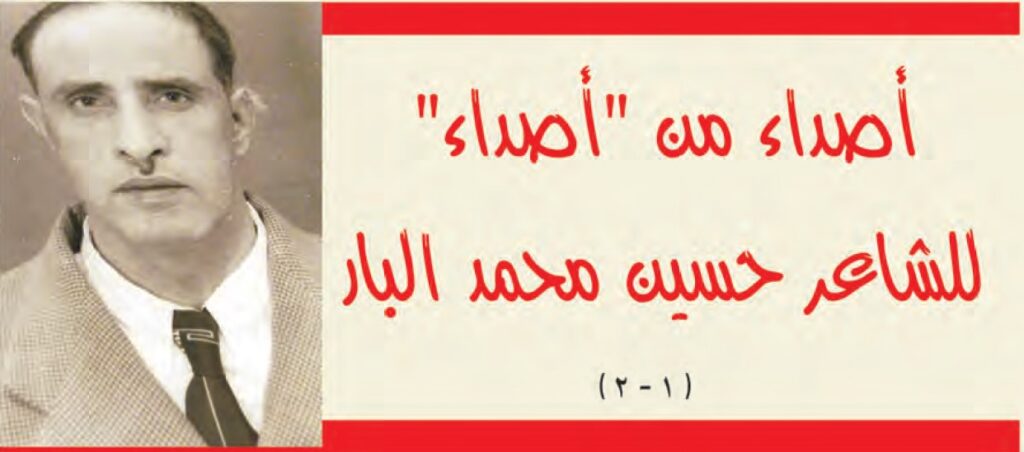

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 4 .. ص 65
رابط العدد 4 : اضغط هنا
حكاية الديوان:
(أصداء) هو الديوان الثاني للشاعر حسين بن محمد البار (1918م – 1965م) بعد ديوانه الأول الموسوم بـ(من أغاني الوادي), الذي طبع في مصر ما بين عامي (1955م – 1956م) في حياة الشاعر الذي اعتنى بانتقاء قصائده وترتيبها في أربعة أبواب هي الوجدانيات, والطبيعيات, والعبرات, والمتنوعات. وصدّره برسم فوتوغرافي له في بدء مرحلة الشباب مذيّلاً ببضعة أبيات عنوانها (رسمي), ثم كلمة قصيرة معنونة بـ(كلمة الشاعر) ثم بإهداء. وتلك أبهاء لم يحظ بها ديوانه الثاني (أصداء) بسبب من وفاة الشاعر قبل إنجازه نصّا معدًّا للنشر, فظلّ في أضابيره قصائد تتراكم مع الأيام منها المنشور في صحيفةٍ, ومنها ما أنشده الشاعر إبان حياته في محفلٍ من المحافل الثقافية التي كانت عامرة بنشاط أدبي مميز يوم ذاك. لكنه هو الذي وضع له هذه الثريا التي تتدلى في فضاء صفحته الأولى وإن لم يحظ بغلاف مستقل كونه لم يطبع مفردا كما طبع أخ له من قبل, وحظي بمكونات الكتاب. أما (أصداء) فبقي نصوصا تفتش عن وجودها الكتابي زمنا ليس بالقصير يمتد من العام 1973م حتى ضمّته صفحات الأعمال الشعرية الكاملة التي صدرت في العام 2004م عن دورِ نشرٍ ثلاثٍ(1). ولقد كاد يطبع الديوان في بيروت في منتصف سبعينيات القرن العشرين بعد أن أبدى الشيخ سالم بالعمش حماسة لطباعته, لكنّ انفجار بركان الحرب الأهلية هناك حال دون تحقيق الأماني ففنيت, وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن, بل وكادت النسخة (الأم) المخطوطة بقلم الشاعر تضيع إذ لم تكن لها نسخ محفوظة لا عند قريب ولا عند غريب. لكن الله حفظها, وفي أواخر ذلك العقد تمكن السيد عبدالقار بن حامد البار رحمه الله من أن يستلّ النسخة الأم من براثن الضياع, وأن يعيدها سالمةً ليد من تكفّل بنشرها ديوانا وهو ابن الشاعر الأكبر الأستاذ عمر حسين البار رحمه الله. ولقد حرص السيد عبدالقادر بن حامد البار على أن يستنسخ صورا من الديوان المخطوط ووزعها على ذوي الاعتناء بالشاعر وشعره فحفظ المتن, لكن المخطوطة الأم لم تكن معلومة المثوى والمأوى والمآل. وعلى الرغم من ذلك فقد خطر لكاتب هذه الصفحات أن يعد الديوان للنشر فيقدمه إلى دار الهمداني بعدن التي أخذت يومذاك في طباعة كتب متنوعة بين دوواين شعر ومجموعات قصصية ومؤلفات بحثية. وشجعه على الإقدام على تلك المغامرة عددٌ من الأحبة والصحب, فتخيّر من المخطوطة قصائد وسلمها للمعنيين بالدار يداً بيدٍ, وقد أجيزت نصوصها جميعا, وطُلِبَ منه – اعتمادا على إشارة من الشاعر العراقي سعدي يوسف – إعداد مقدمة للديوان فتكفل بكتابتها بكل نشاطٍ وحبورٍ الأستاذ الكبير السيد علي عقيل بن يحيى(2), ولم يمض شهر إلا والمقدمة مع نسخة الديوان مسلمتين للإخوة المعنيين بالنشر في دار الهمداني, واستبشر الجميع بقرب خروج الديوان إلى فضاء القراءة والتفاعل النقدي بعد أن ظل سنينَ عددًا حبيس الأدراج لا يرى قارئا ولا يعرفه من عرفوا للشاعر ديوانه الأول (من أغاني الوادي). وكان زمن تلك الوقائع في أواخر العام 1984م. وفجأة, ولا بد من هذه (الفجأة), جرت الرياح بما لا تشتهي السفن, وانفجر بركانُ حربٍ أهليةٍ ثانيةٍ في 13/يناير/1986م في مدينة عدن. وكانت دار الهمداني من الأماكن التي طالتها نيران الحرب, فاشتعل القلق في أفئدة عديدة, وظل السؤال حائرًا يبحث عن جواب يتحدد به مصير الديوان ومكانه ومثواه. ولم تنجل الغمة عن ذلك المصير إلا في منتصف العام 1987م حين تم الاتصال بالأخ العزيز الدكتور محمد أحمد جرهوم وقد اعتلى منصب وزير الثقافة في تلك الأعوام, وشُرِحَ له حال الديوان البائس التائه بين المطابع ونيران الحروب الأهلية. فتكرّم مشكورا بالبحث عن نسخة الديوان حتى وجده وأعثر ذوي الشاعر البار على مخبأه فاستعادوه مخطوطا دون أن يطبع. ثم كانت محاولة ثالثة في أحد أعوام التسعينيات ولكنها لم تنجح, فكان الانصراف عن التفكير في طباعته أمرا ذا جدوى. وحملت الرياح كاتب هذه الصفحات في آفاق مترامية فانشغل عن الديوان وإن لم ينشغل عن صاحبه وشعره المنشور والمطبوع في ديوانه (من أغاني الوادي) حتى كان يوم لقي فيه الأخ العزيز الدكتور عبدالرحمن محمد بامطرف فأنبأه بوجود مخطوطة ديوان (أصداء) بين أضابير والده الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف رحمه الله, ورجاه أن يبلغ ذوي الشأن من إخوته بالمحافظة على المخطوطة كونها بخط الشاعر نفسه, وهو يخشى عليها من التلف والضياع. وحين أبدى له كاتب هذه الصفحات الرغبة في استلام المخطوطة بموجب وثيقة مكتوبة بخطّة يقر فيها باستلامها منه, أبى وآثر أن يتم تسليمها لأخيه الأكبر الذي سلّمها ذات يوم – أو لعله أرسلها – للأستاذ بامطرف ليخط لها مقدمة ولكنه لم يفعل. وجرى الاتصال بالأستاذ عمر البار وإخباره بما استجد فأوكل أمر استلام المخطوطة إلى يد كاتب هذه الصفحات فآبت إلى منزل الشاعر بعد أن طوّفت ما طوّفت راضية من الغنيمة بالإياب. وسكنت حركتها فلم تزعزعها يد عن رفها الذي ثوت فيه آمنة مطمئنة حتى كان عام 2004م حين نهض الشاعران الكريمان محمد هيثم رحمه الله وسالم بن سلمان حفظه الله فألحّا على كاتب هذه الصفحات في طباعة شعر والده كاملا في مجلد واحد شمل دواوينه الثلاثة (من أغاني الوادي) و(أصداء) و(ديوان الأغاني). وهكذا قُدِّر لديوان (أصداء) بعد لأيٍ أن يرى النور, وتصافحه عيون الدارسين وشداة الأدب, فجاء على هويّة إبداعية غير التي رسمها له الشاعر في حياته وعند إنجاز قصائده, وغير ما يمكن أن تكون عليه لو طال العمر بالشاعر وتولى أمر إخراجه بنفسه. وهما هويتان مغايرتان لهوية إبداعية ثالثة نسجها ذوق الشاعر عمر البار حين هيأ الديوان للنشر في سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك, وبالرغم منه, فإن للديوان هوية إبداعية جوهرية يمثلها أجمل ما اشتمل عليه من قصائد اتفق عليها كل من نظروا فيه مخطوطا وركاما بين الأوراق. إنما الاختلاف موجود حول بعض القصائد رآها هذا جديرةً بالنشر فيه لغاية مقصودة, ورآها ذلك غير ملائمةٍ للقارئ في زمن نشرها الأخير. فانتظم الديوان في أربع وثلاثين قصيدة متنوعة التجارب والمواقف والرؤى, ومتجددة في طرائق النسج وأشكال التعبير ونظم التشكيل. وهو ما سيدور عنه حديثنا في هذا المقام بدءا بعنوانه أولا من حيث العنوان في الأثر الأدبي مجلى للثقافي والجمالي فيه في آن.
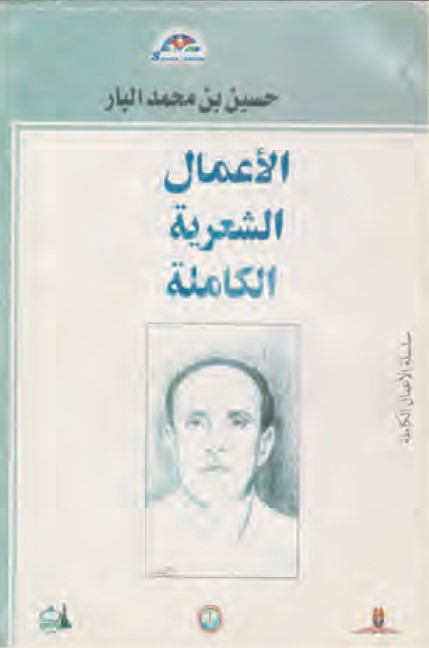
عنوان الديوان:
عنوان الكتاب – كائنا ما كان, ديوانا شعريا أو رواية أو مسرحية أو دراسة علمية – هو مجموع العلامات اللغوية التي يتنقّاها المؤلف مفردات أو جملا ويؤلف بينها ليعين بها وجوده فتدل عليه. فهو على هذا كالاسم العلم للكائن البشري بل أوثق منه صلة بالخصوصية. ففي الاسم العلم يشترك أفراد عديدون وإن اختلفت هوياتهم وتفرقت بهم السبل, أما عنوان الكتاب فندر أن يشترك فيه كتابان قدم العهد بهما أو حدث. فأنت حين تقول : (العقد الفريد) لا تحتاج إلى مزيد بيان لتعيينه, لكنك بحاجة إلى مزيد من العلامات الإيضاحية حين تتحدث في الناس عن شخص اسمه (عبدالله) مثلا. ومن هنا خطورة عنوان الكتاب وأهميته عند علمائه. فهو ما يعطي الكتاب كيانه الوجوديّ المستقلّ والمنفرد, بل ويحدد محتواه الكلي الذي يميزه عن سواه من أعمال (المؤلف) الأخرى. وهو ما يدل عليه ما يعرف (بالأعمال الكاملة) لهذا المؤلف أو ذاك, فتراها تندرج في كل شامل جامع, ولكن بعضها يستقلُّ عن بعضٍ من صفحة (العنوان) حتى آخر سطر فيه.
العنوان إذا بنيةٌ نصيةٌ متعددةٌ مشكلاتُها, بيّنةٌ آثارُها في عملية تأليف الكتاب, وفي عملية قراءته ومقاربته نقديا. وهذا في عموم القول, أما في خصوصه فإننا ننظر في بنية العنوان من خلال النظر في الديوان الثاني للشاعر البار الموسوم بـ(أصداء). وهي مفردة جاءت جمعًا, ومفردها (صدى). و(الصدى) في معاجم اللغة : شدة العطش, وقيل: هو العطش ما كان. واسم الفاعل منه (صدٍ وصادٍ وصديان).
قال القطامي:
فهن ينبذن من قولٍ يصبن به :: مواقع الماء من ذي الغُلّة الصادي
وقال شوقي :
تذكّري هل تلاقينا على ظمأ :: وكيف بلَّ الصدى ذو الغُلّة الصادي
والجمع (صداء).
و(الصدى) : الدماغ نفسه, وحشو الرأس.
و(الصدى) عند العرب طائر يصيح في هامة المقتول إذا لم يُثْأَر له. وقيل: هو طائر يخرج من رأسه إذا بلي, ويدعى (الهامة). وإنما كان يَزْعَمُ ذلك أهل الجاهلية, وقد جرت به أشعارهم, وتعددت دلالته فيها. فهو في بيتي (مغلس الفقعسي):
وإن أخاكم – قد علمت مكانه :: بسفح قبا – تسفي عليه الأعاصرُ
له هامة تزقوا إذا الليلُ جنَّها :: بني عامرٍ هل للهلاليّ ثائرُ
تعييرٌ. وهو في بيتي شاعر يوصي ابنه:
ولا تَزْقَوَنْ لي هامةٌ فوق مرحبٍ :: فإنَّ زُقاءَ الهامِ للمرءِ عائبُ
تنادي: ألا اسقوني وكلُّ صدًى به :: وتلك التي تبيضّ منها الذوائبُ
تحذيرٌ. وهو في بيت ذي الأصبع العدواني:
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي :: أضربك حتى تقول الهامة اسقوني
فخرٌ واعتدادٌ.
والصدى | إلى ذلك | : الصوت. وهو : ما يجيبك من صوت الجبل ونحوه بمثل صوتك. وجمعه (أصداء).
وهو عند أصحاب المعاجم الحديثة: رجع الصوت يرده حاجزٌ كالجبل ونحوه لاصطدام الموجات الصوتية.
ولقد جرى (الدال / الصدى / أصداء) مفردا وجمعا في أبيات من شعر البار في ديوانه الأول (من أغاني الوادي) بمعان ودلالات. فهو رجع الصوت في قوله:
مازال فيك صدى لأنغامي هنا :: وصدى يرف لآهتي وأنيني(3)
وهو يقيمها في نسق التقابل الضدي, حيث يدل صدى الأنغام على البهجة والفرح, ويدل صدى الآهة والأنين على الأسى والحزن, وإن لم يبعدا عن السياق الوجداني الذي شمل استخدامه لهذا اللفظ مفردا أوجمعا. لكنه في مظان ينزاح عن هذه الدلالة ليمنح الدال دلالة حديثة هي (الأثر والانعكاس).
أنت في هذة الحياة ملاكي :: ليس هذا الغناء إلا صداكِ
كل هذي الأكوان عندي رؤاكِ :: وحياتي لولاك تصبح مرة(4)
هنا تشكل اللفظ (صدى) في نسق الاستعارة. فيتراءى (شعر الشاعر) غناء, ويغدو (الغناء) صدى المحبوبة, وأثرها الجميل المحبوب في وجدان الشاعر. وهو ما يقرب دلالة من قوله في موضع آخر:
ورعت صدى القبلات روح الليل كالنغم الضئيل(5)
حيث يتشابه أثر القبلات في الوجدان بأثر النغم الجميل الهادئ في ظلمات الليل وسكونه.
إلحاح فكرة (الصدى) على وجدان الشاعر في مظان من قصائد شعره المكتوب في مرحلة الأربعينيات من عقود القرن العشرين وقد ضمّها ديوانهُ الأول (من أغاني الوادي), وما أبانت عنه مخطوطة الديوان الثاني التي قسمها الشاعر إلى أقسام, وجعل عنوان القسم الثاني (أصداء) ضامًّا إليه قصائد الديوان كما أنجزها واحتواها من بَعْدُ كتابه الموسوم بالأعمال الشعرية الكاملة ينبئ أن (عنوان) الديوان قد سبق في الوجود عددا كثيرا من قصائد الديوان المطبوع. فقصائد مثل : دموع الغريب, الأسير الشاكر, رجل العهد الأسود, مع التونسي, في سبيل البدلية كتبت في مرحلة الخمسينيات, وغيرها ثمة مثلها. وقصائد مثل: حيرة, فقيد العلم, في ذكرى رائد الفن كتبت في بداية عقد الستينيات, قبل وفاة الشاعر بقليل. ومع ذلك أدرجها كلها في القسم الثاني من دفتر أشعاره الموسوم بـ(أصداء). وهنا تتجلى مفارقة. فعنوان أي كتاب لا يوضع على صفحة عمل إلا حين يتهيأ صاحبه لطباعته ونشره. فهو يظل نصوصا متفرقة – وإن قرئت في مجلة أو صحيفة, أو سمعت ينشدها الشاعر في محفل ما – ولا تتهيأ لتصير كتابا إلا حين يتخير منها عددا ويضع لها عنوانا جامعًا ويدفع بها للمطبعة. فتعيين عنوان الكتاب لا يكون إلا بعد ولادة العمل واكتمال عناصره المؤلفة. ولعله لهذا قالت العامة في أمثالها : (لا خلق سميناه) يعنون الوليد الذي لم يولد بعد. لكن هذا الديوان سمي قبل اكتمال خلقه وبلوغ نصوصه الحد الذي يجعل منها ديوانا.
هل ينبئ هذا أن الشاعر كان على وعي بفكرة (الأصداء) التي هيمنت على فكره من وحي اضطراب واقعه الاجتماعي الموّار بالتحول والتطلّع إلى غدٍ مختلفٍ عن حاضرٍ يرفضه لسوء معالمه الظاهرة؟ إن فكرة الأثر المنعكس على وجدان الشاعر في شتى صوره عاطفية أو اجتماعية أو سياسية, ذاتية أو وطنية أو قومية لا تخفى على قارئ شعره, سيان ذلك في قصائده في ديوانه الأول أو قصائده في ديوانه الثاني فدلّت على رومانسية تتجاوز هموم الذات وانشغال الشخص الفرد إلى هموم الوطن وإنسانه والقومية ومشكلاتها مما يشي برؤية اجتماعية متدثرة بلغة شفافة تتلقح من لغة أشعار علي محمود طه وإيليا أبو ماضي وأبو القاسم الشابي والأخطل الصغير وإبراهيم ناجي وصالح بن عليّ الحامد, لتخرج من هذا المزيج المتجدد في تاريخ الشعرية العربية خصبةً مؤتلقةً ذات خصوصيةٍ مميزة. وذاك ما ينبئ عنه فرادة عنوانها.
ومفارقة أخرى تجيء العنوان من جهة نقض معادلته المألوفة. (فقلما نجد عنوانا متصدرا وحده, فهو دائما خاضع لهذه المعادلة:
عنوان + عنوان فرعي
عنوان + عنوان جنسي) (6)
فللكتاب عنوان رئيسي واحد, وتتبعه عنوانات فرعية حين تتعدد أجزاؤه, كما في (ثلاثية محمد ديب) حيث نجد (الدار الكبيرة/ الحريق/ النول) وقد وضع لها إضافة لهذا أرقاما تميز كل جزء منها هي (1/2/3). في حين اكتفى نجيب محفوظ في (ثلاثيته) بأسماء فرعية سمت في كل عمل حتى غدت عنوانات رئيسية هي (بين القصرين) و(قصر الشوق) و(السكرية). ومن المؤلفين من يكتفي بوضع عنوان رئيسي ثم يشفعه بذكر أجزائه كما في كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني في الأقدمين, و(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) للدكتور جواد علي في المتأخرين.
وحين يكتفي المؤلّف بعنوان رئيسي لعمله يلغي فكرة استخدام عنوان فرعي لانعدام الحاجة إليه فيكتفي به علما مفردا, لكنه يشفعه بعنوان يحدد جنسه الكتابي شعرا كان أم قصصا قصيرة أم رواية أم مسرحية أم دراسة كائنا ما كان منحاها الفكريّ. وهذا المؤشر التجنيسي ذو أهمية في التمييز بين الأعمال التأليفية حين تتشابه عنواناتها الرئيسية. فإذا قلنا: (المكلا) شفعناه من حيث هو عنوانٌ بقولنا: (رواية) ثم نشير إلى إسم المؤلف. أو شفعناه بقولنا: (شعر) ثم اسم المؤلف فلا ينبهم المقصود على المتلقي حينذاك. وفي العموم لابد للكاتب من عنوان رئيسي ثم يشفعه عنوان تجنيسي يحدد هويته. وهو أمر أدركه المؤلفون العرب في تراثنا القديم فعمدوا إلى المزج بينهما في صيغ مسجوعة, فقالوا: (البرهان في علوم القران) ومثله (الإتقان). فالعنوان الرئيسي هو (البرهان, والإتقان) وشبه الجملة تقوم مقام المؤشر التجنيسي للكتاب. ومثله (التبيان في أقسام القران) أو (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) و (كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر) أو (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)… إلى آخر ما هنالك, فالباب متسع, والحديث فيه لا يكاد يحدّ. وأما في كتب المحدثين فالأمر ظاهر لا يعسر متلقّيا ولا يحوج الكاتب إلى مزيد بيان. فما من كتاب يحمل عنوانا رئيسيا إلا ويشفع بمؤشر تجنيسي لاحق به لحوقَ لزومٍ. أما في الديوان الثاني للشاعر حسين محمد البار فلا نجد غير عنوان رئيسي يحتل الجزء الأسفل من الصفحة (197) ولا غير, وِتْرٌ دون شَفْعٍ, هكذا (أصداء) ولا غير. سيقول قائل: لقد اكتفى الناشر بعنوان رئيسي في صدر غلاف الكتاب وهو (الأعمال الشعرية الكاملة) وحسبك بهذا مؤشرا تجنيسيّا. وهذا حقّ. ولكن هذا الديوان ينقصه مالم ينقص من أمثاله من دواوين الشعر التي طبعت أولاً مفردةً مستقلةً مزدانةً بعتباتها النصية كما نجد في الدواوين الثلاثة للشاعر صالح بن عليّ الحامد قبل أن يضمّها مجلد الأعمال الكاملة في طبعتيه. أضف إلى ذلك ما فعلته بعض دور النشر من ضم الأعمال الكاملة في مجلدات ومنحها عنوانا رئيسيّا ثم يشفعون ذلك بعنوانات فرعيّة هي عنوانات الدواوين التي ضمّها هذا المجلد أو ذاك, وهو ما لم يحظ به هذا الديوان, فجاء منزاحا عن سواه على أية صورة ذكرت.
والعنوان بصيغته اللغوية التي جاء عليها مفردةٌ معزولةٌ عن سواها من الدوال التي تؤلف بتصاقب بعضها ببعض جملةً دالةً, فجاء مبهمًا يثير أسئلةً , ويُظْهُر حاجةً إلى صفةٍ أو مضافٍ إليه لينجلي الإبهام عنه. فهذه الـ(الأصداء) أصداء من؟ أو أصداء ماذا؟ وهل هي أصداءُ تجاربَ فكريةٍ أو اجتماعيةٍ سياسيةٍ أو نفسيةٍ؟ وهل هي أصداءُ ذاتٍ مفردةٍ أو هي أصداء ذواتٍ كثرٍ تعددت صورها, وتنوعت آفاقها؟ والواقع أنك حين تتأمل في هواجس القصائد ونواتجها الدلالية نقترب من يقين جوهره أن هذا العنوان هو خلاصة ما دلّت عليه قصائد الديوان من تجارب حياة وتشكيل لغة. فهو على هذا بؤرة إشعاعٍ تضيء عتمة الطريق إلى جوهر القصائد واحدةً واحدةً, ومتصل بها تجربةً وتشكيلا.
الليث والخراف المهضومة أو فيما هو (التناصّ)
من ذهب بالقول عن الشعر إلى أنه غامض محيّر وصعب وطويل سلّمه قال فيه قولا لعله الصواب المحض, فما تزال نظريات الأدب واتجاهات النقد تلهث وراءه لتقع على جوهره فلم تلق إلى ذلك سبيلا. فتعددت المداخل إليه لتنوّع مضايقه. أترى سبب ذلك طول عمره في تاريخ البشرية؟ لعل ذلك يجوز. فالرواية والقصة القصيرة فنان حديثان مقارنة بعمر الشعر في الوجود, ومن هنا تبدو دراسة الرواية أو القصة القصيرة أيسر حالا من دراسة الشعر, ومن ينظر في جهود البنيويين والسيميولجيين في دراسة صور السرد تلك يتبين ذلك مقارنة بدراستهم للشعر. على أن أولئك الدارسين وآخرين من أمثالهم كالأسلوبيين وأصحاب “الشعريات” ودعاة علم النص لم يدعوا الحنين إلى دراسة الشعر قط, فأسهم كل فريق من هؤلاء ومن أولئك بنصيب في درسه والاعتناء به, فكثرت مقولاتهم فيه, ومن تلك المقولات ما أجملوه في (أمثولة) الليث والخراف المهضومة أو فيما هو التناص. وعرفوه بتداخل النصوص أو انبثاق نص لاحق من ثنايا نص سابق, أو التعالق بين النصوص, ولم يحصروه في مستوى من مستويات (النص / القصيدة) فقط فشمل كل مستوياتها الايقاعية والتخيلية والدلالية. وبالغ بعضهم في الاعتناء بهذه المقولة فجعلها المدخل إلى قراءة (النص). وفي هذا موضعٌ لنظرٍ. فالتناص مدخل من مداخل نقدية أخرى إلى عالم (النص / القصيدة) وليس هو (المدخل) إلى قراءتها الذي لا تناصره مداخل أخرى عند قراءة (النص / القصيدة). والعِلّة في هذا الاحتراس أن التناص لا يكون في (النص / القصيدة) كليّا, ولكنه جزء من كل وإن أوهم توظيفه فيها بغير ذلك. فتظل جوانب أخرى يستقل الإبداع فيها بذاته غير متكئ على سواه إن على مستوى البناء وإن على مستوى التشكيل الصياغي للغة النص. ولهذا بدا – ويبدو- اعتماد (التناص) المدخل إلى قراءة النص شبيها بصنيع علماء البلاغة حين اتخذوا من مكوّناتها مداخل لقراءة (النص / القصيدة) فتحدثوا عن (الاستعارة) في نص ما, وعمدوا إلى جلائها فيه بنية ووظيفة ونمطا وينبوعا, غير مكترثين بما ضمته القصيدة من مكونات أخرى. فاتسم صنيعهم النقدي ذلك بالذريّة كونه نظر في أمر وأهمل أمورا لا تقل أهمية في بناء النص. وكذلك هو الحال عند من وقفوا على التناص بوصفه المدخل إلى قراءة (النص / القصيدة). ولأضرب لك مثلا. هذا الشاعر الكبير عبدالله البردّوني كتب في أواخر عام 1971م قصيدته (أبو تمام وعروبة اليوم) فتعالق فيها مع أشعار لأبي تمام منذ مطلعها الذي قال فيه:
ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب :: وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب(7)
حيث يتناص مع قول أبي تمام:
السيف أصدق إِنباء من الكتب :: في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعب
على مستوى البنية السطحية الظاهرة. وفيها يمثل (صدق السيف) نصّا من بيت أبي تمام ليقرّ في بيت البردّوني, لكنه يتشكل على المستوى نفسه في بنية التخالف من جهة أن بيت البردّونيّ يشي بحالة من التردد والتشكك والظن, ومن هنا جاءت صيغة (التعجب) (ما أصدق السيف) متبوعة بأسلوب الشرط (إن لم ينضه الكذب), ومثلها ما جاء في الشطر الثاني من البيت. في حين جاء بيت أبي تمام منبثقا من أغوار اليقين وقرار المؤكد الذي لا شك فيه. وجاءت الجملة في البيت اسمية مثبتة ( السيف أصدق إِنباء من الكتب), ودلّ تقديم الجار والمجرور (في حدّه) – وهو في مقام الخبر – على اختصاص المبتدأ (الحدّ) به, وانحصاره فيه للتمييز بين أشتات الحالات, ومتناقضات المواقف.
مثول النص السابق – بيت أبي تمام – في البنية السطحية للنص اللاحق – بيت البردّونيّ – لا ينفي الغياب الكامن في المستوى العميق للنصّ اللاحق. حيث يثوي المسكوت عنه, ولعلّه المقصود من وراء استخدام بنية التناص في هذا المقام, أعني بذلك البحث عن (القوة) في مقام (الضعف), و(التحدي) في ثنايا (الانكسار), و (المغامرة) في أنساغ (النكوص). ومن هنا يتراءى بيت أبي تمام ماثلا في بيت البردّونيّ وغائبا في آن.
وثمّة مسألة تتصل بما سلف وتتعلق بمقدرة الذات المبدعة على تصريف القول وفق ما تبتغي وتروم, وعلى ولوج مضايقه لجلاء مقاصدها من الكلام حين تتملك اللغة تملّك عزيز مقتدر, فتصوغ الصور والرؤى في لغة تشفّ عن حضورها الإبداعي دون اتكاء على نص غائب أو حاضر. وهذه مسألة ذات أهمية كونها تجعل عملية (التناص) جزءا من التعبير اللغوي وليست كلّه. قال البردّونيّ:
سبعة أبيات يتعالق بعضها مع أبياتٍ لأبي تمام فتستدعيها, ويستقل بعضها بلغته ورؤاه فيصعد في سلم الشعرية درجات عُلًى. فإذا كان البيت رقم (32) يستدعي قول أبي تمام:
خليفةُ الخضرِ.. مَنْ يَرْبعْ على وطنٍ :: في بلدةٍ.. فظهور العيس أوطاني(9)
وقوله في البيت رقم(34) يستدعي قول أبي تمام:
بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها :: تنال إلا على جسر من التعب(10)
أما قول البردّوني في البيت رقم (33):
أرعيت كل جديب لحم راحلة :: كانت رعته وماء الروض ينسكب
فيستدعي قول أبي تمام في وصف البعير:
رعته الفيافي بعدما كان حقبة :: رعاها.. وما الروض ينهل ساكبه(11)
إذا كان ذلك كله قد تجلى حاضره من غائبه, فإن في الأبيات أبياتا تستقل بشعريتها عن هذا التداخل, وتنفرد بطرائق تعبير لا تمتّ إلى أية علقة بنص غائب سابق. كمثل قوله: (شبابة في شفاه الريح تنتحب), (راحل في غير ما سفر), (رحلي دمي), (طريقي الجمر والحطب), (أمتطي ناري وأغترب), وقف على البيت رقم (37) وسرّح الفكر في أبعاده الدلاليّة ستجد فيه ذاتا لم يعرفها أبو تمام ولا عصره. وسينتهي بك الفكر إلى أن (التناص) مدخل من مداخل قراءة (النص / القصيدة) ولا يصلح لأن يكون المدخل الوحيد لقراءتها. أقول قولي هذا لألج منه إلى صور من التعالق النصي في ديوان البار هذا, تعددت مصادرها, وتنوعت نواتجها الدلاليّة, فجاءت على عدد من المستويات. منها مستوى العنوان في قصائد الديوان, فحين تفتح أولى صفحاته تلقاك أول قصائده وعنوانها (الملاح التائه), وهو عنوان يستدعي عنوان الديوان الأول للشاعر المصري علي محمود طه, وحين تتصفح ديوان الشاعر المهندس تجد القصيدة الرابعة فيه يتدلى من فضائها عنوان (الملاح التائه) (12), وهذا لأن الشاعر علي محمود طه وسم الديوان كله بعنوان القصيدة. لكن اللافت هنا هو التخالف الدلالي بين العنوانين, وهو ناتج عن تغاير التجربة الشعرية في القصيدتين. فقصيدة البار تتحدث عن تجربة (الحضرمي) الذي كتبت عليه الغربة عن مسقط رأسه ومثوى صباه الأول فتشرّد في الآفاق يطلب مبتغاه, ولقد يجده, ولقد لا يجده. أما ذلك الحضرمي الذي يرسم البار صورته المعنوية في القصيدة فهو المتحدث عنه فيها, فلقد يكون الشاعرَ ذاته وقد تجلى في القصيدة من باب (التجريد). ولقد يكون حضرميا آخر تلقّط الشاعر أجزاء صورته من نماذج متعددة حتى اكتملت أبعادها فجاءت على النحو الموصوف في القصيدة. وأيّا كان بطل القصيدة فهي تحمل شجنا اجتماعيا وهمَّا غيريّا يتجاوز دائرة الذات ومشاغلها النفسية وانفعالاتها الخاصة(13). أما الملاح التائه في قصيدة علي محمود طه فصورته لا تتجاوز شهوات الذات ورغباتها, وإن شكت الدهر في عموم, وهجر المحبوب الذي تمنّت وصاله ورجت لقياه. وبين الحالين فرق من جهة الغاية والمقصد. على أن من القصائد ما يستدعي قصائد أخرى من جهة البناء وطرائق التشكيل. فقصيدة (كيف أشقى) (14) تستدعي في بنائها الشعري قصيدة إيليا أبو ماضي (لست أدري) (15) من جهة عروض النص – جاءت القصيدتان من بحر الرمل المجزوء, وتعددت في كل مقطع القوافي فصار لكل مقطع قافيته وحرف رويه – ومن جهة تكرار اللازمة, (لست أدري) عند أبو ماضي, و(كيف أشقى) عند البار. لكن البار خالف الشاعر المهجري الكبير في موضعين. أولهما أنه حرص على أن يأتي السطر الرابع من كل مقطع مكتملا وزنه (أربع تفعيلات كاملة), وجعل اللازمة تفعيلة مستقلة في سطر مستقل (فاعلاتن). وثانيها أنه اتخذ للسطر الرابع قافية ورويا يتناغم مع الصوت المتكرر في اللازمة كما في قوله من القصيدة مثلا شرودا ليس إلا:
كيف أشقى وزهور الروض في الروض تنوح
وطيور الأرض بالألحان تغدو وتروح
تنشق العطر شذيّا في الروابي والسفوح
فإذا حاكيتها فعلا وإحساسا وذوقا
كيف أشقى
وهو ما لم يفعله الشاعر المهجري الكبير, فاكتفى في السطر الرابع للمقطوعة بثلاث تفعيلات, وعدّ اللازمة (لست أدري) تكملة لتفعيلات السطر فصارت أربعا, دون أن يلتزم بحرف روي يتناغم معها كما في قوله من القصيدة مثلا شرودا ليس إلا:
كم فتاة مثل ليلى وفتى كابن الملوّح
أنفقا الساعات في الشاطئ تشكو وهو يشرح
كلّما حدّث أصغت وإذا قالت ترنّح
أحفيف الموج سر ضيعاه؟
لست أدري
مما يشي بأن الشاعر البار وإن عمد إلى الاستدعاء, استدعاء النصوص السابقة إلى نصه اللاحق, لا يقف عند حدود ذلك النص السابق بل يخالفه لتوكيد خصوصية الذات الإبداعية. لكنه في قصيدته التي عنوانها (مع التونسي) (16) يتجاوز حد الاستدعاء إلى حد المعارضة, حيث بدت قصيدة الشاعر بيرم التونسي في السخرية من (المجلس البلدي) في مصر صوتا قابله الشاعر البار بصدى تمثل في قصيدة يسخر فيها من (المجلس البلدي) الذي أنشئ في (حضرموت), وكان الناس يتأملون منه خيرا لكن آمالهم خابت فاستحق سخرية الشاعر وتنديده فقد (طغى على حضرموت المجلس البلدي). والبار في قصيدته هذه يحتذي حذو التونسي في قصيدته من جهة الوزن فكلتاهما من البحر البسيط, وفي توحيد القافية وحرف الروي حيث التزما (المجلس البلدي) في موضع القافية فكرراها من أول القصيدة حتى آخرها. وكانت السخرية سبيلهما للنيل من ذلك المجلس في عصريهما. قال البار:
في كل يوم أرى سيارة ملئت :: قمامةً .. ورئيسَ المجلس البلدي
وإذا كانت المعارضة هنا – وهي صورة من صور التناص – بادية للعين لا يخفى مصدرها, فإن قصيدته التي رثى بها العلامة الحبيب عبدالرحمن بن عبيد اللاه السقاف, ومطلعها:
عبرت حياتك عزّةً وإباءَ :: واليوم تسمع للمَنون نداءَ(17)
تستدعي إلى الذاكرة قصيدة أحمد شوقي في رثاء عمر المختار, ومطلعها:
ركزوا رفاتك في الرمالِ لواءَ :: تستنهض الوادي صباحَ مساءَ(18)
فكلتاهما على وزن واحد وهو (الكامل التام), وقافيتهما وحرف روييهما واحد كما ترى.
والبار في قصيدته (مع التونسي) يستدعي صورة من الأدب الأجنبي يمثلها قوله:
فمن بكى لي من الحرمان قلت له :: اسكب دموعك عند المجلس البلدي
وإن شكى لي روميو من صبابته :: قلت اتصل برئيس المجلس البلدي(19)
وهنا يستدعي البار العلم (روميو) من أدب شكسبير ليجعله علامة على العاشق المحروم الذي يرجو وصال من يحب ولكنه لا يقوى على الوصول إليه. وليس في هذا الاستدعاء من طريفٍ, لكن النظر في دلالته وصلته بما تلاه ينبئ عن طريف. فروميو غدا مؤشرا على جملة العشاق الذين يرومون وصالا (بغواني المجلس البلدي) (الكانسات قلوب المغرمين) واللاتي (تروي مكانسهن ألحان الغرام إذا ترنمت بأغاني المجلس البلدي), فغدا مفردا في صيغة الجمع. فإذا نظرت إلى فعل الأمر في الشطر الثاني من البيت, وهو مقول القول, تراءى لك رئيس المجلس البلدي في صورة مزدراة نُجِلّ مقامه الكريم عن التردي إليها وهو ذو منزلة عالية ومكانة سامية. لكنه نزق الشعر وبدوات الشعراء. وحسبك هذا إيضاحا. وفي كل صور الاستدعاء التي سلفت تجد المظانّ الأدبيّة هي مقصد الشاعر يتنقّى منها ما يشاء ليوظفه في قصيدته كيف يشاء, ومن مثله صور أخرى يستدعي فيها أبيات شعراء سبقوه فيتناص معها, ولكنني أتجاوزها لأقف عند استدعاء الشاعر للموروث الديني كالذي نجده في قوله معترفا بأخطائه وخطاياه في كنف المصطفى عليه الصلاة والسلام:
أضعت زهرة عمري في هوىً نهم :: بين المزاهر أو بين المزامير
ورحت أركض في لهوي وفي عبثي :: وما ترفقت يوما بالقوارير(20)
فالاستعارة التصريحية في آخر الشطر الثاني من البيت الثاني من هذين البيتين (القوارير) تستدعي إلى الذهن الحديث النبوي الذي رواه أنسٌ كما في سنن أبي داوود حيث قال: (كان أنجشه يحدو بالنساء, وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال, وكان أنجشه حسن الصوت, وكان إذا حدا أعنقت الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك يا أنجشه! رويدَك سوقَك بالقوارير) (21). فتلك هناك من هذه هنا. ومثله قوله في هذه القصيدة:
دعوتني فأجاب القلب داعيه :: كما دعا الله يوما صاحب الطور(22)
وهو يعني بصاحب الطور نبي الله موسى عليه السلام, والطور في الأصل (الجبل), وليس علما على مكان. والشاعر يستدعي قوله من سورة مريم: {وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا} آية رقم “52”. ومثيلاتها من آيات القران الكريم التي عرض فيها جوانب من قصة موسى عليه السلام. وإذا وجدنا في البيت مأخذاً فإنا نجد الشاعر يدفعه عن نفسه بقوله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون} “الآيات 224-226 من سورة الشعراء”. وتلك حجتهم من قديم الزمان وما تزال وستظل. وما لا يفعلون تنفسح في الدلالة حتى تشمل ما يتخيلون ويصورون ويشبهون. وفي جلالة تنزيلها ما يحمي الشعراء من شطط أخيلتهم وحذلقات ألسنتهم, وحسبك من القلادة ما أحاط العنق.
والبار قد تملك لغة شعره واستطاع بها الصعود درجات عليا في الشعرية, وتمكن من جلاء هواجسه وتجسيد رؤاه كما رام وقصد, وإن لم ينأ بتلك اللغة من صور الاستدعاء ما وجد سبيلا إليه ميسّرا. قال (في رثاء ولده الصغير علي بن الحسين الذي غودر في طفولته في أثناء إقامة الشاعر بالحجاز) كما كتب في صدر القصيدة:
فالأبيات من رقم (9) إلى رقم (15) تتسلسل لغتها في تعبير استعاري يشف عن شجن عميق لفقد الطفل الصغير, عن عاطفة محتدمة للأم الثكلى, وعن ألم ممض في وجدان الأب الغريب النائي عن أحبته, حتى إذا ما وصلنا إلى البيتين (16 و 17) تراءى التناص منبثقا من صورة الليل فيي معلقة امرئ القيس:
وليل كموج البحر أرخى سدوله :: علي بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه :: وأردف أعجازا وناء بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل :: بصبح, وما الإصباح منك بأمثل(24)
فقرب ليل الأم في قصيدة البار من ليل امرئ القيس وإن تخالفا. فليل امرئ القيس أشد شمولا للوجود فهو (كموج البحر) وليل البار أعمق ظلمة فهو (أليل). وامرؤ القيس يرجو انجلاء الليل ليقينه بإقبال الصبح, وليل البار لا صبح له فالحيرة فيه غير منقطعة (فما تدري متى هو ينجلي؟). وهكذا يبين لك أن البار ذو بصمة أسلوبية في شعره وإن احتذى سابقا من الشعراء وترسم بعض خطاه.
هواجس (الموضوع) في الديوان
تنبئ قراءة متن الديوان عن انغمار (الإبداع) في مشكلات المجتمع, وقضايا الأمة,ومستجدات الواقع المعيش. وعن انكفاء (الإبداع) على التعبير عن ذلك كلّه, وجلاء صوره رغبة في إصلاح المختلّ وتقويم المعوجّ, والتنديد بالقبح والظلم والطغيان والشر في كل صوره. ومع ذلك, وعلى الرغم منه, فقد اتسع (الإبداع) لهموم الذات المتكلمة في النص فحضرت في متنه, وتعالى صوتها صافيا, وانتثرت في قصائد الديوان ممثلة بضميرها النحويّ على مختلف صوره فاعلا ومفعولا, متصلا ومنفصلا, ظاهرا ومستترا. فما خلت منه قصيدة أو كادت, وإن اختلف مدى حضورها كثافة وانتشارا بين قصائد الديوان. فبينما تراه مهيمنا في قصائد مثل (حيرة وكيف أشقى وبالله يا جنبات الواد وحنين إلى الماضي وما أشبهها) حتى ليسم لغتها بالوظيفة التعبيرية تجد قصائد أخرى يزاحم فيها ضمير المتكلم سواه من ضمائر الغيبة والخطاب. بل ويتجاوز الحال شبكة الضمائر في الديوان إلى جوهر الناتج الدلالي في القصائد. فبينما تراه يصف لك معاناة وطنه من حاكم ظالم طاغ. إذا هو يمزج بين معاناة الذات وبين معاناة الوطن في مماثلة تدنو من اتحاد الذاتين في كيان:
أنا أبكي من حكمه, وبلادي منـه تبكي بمدمع هتّـان
قد دهاها في عهده ما دهاها ودهاني من حكمه ما دهاني(25)
فالجرحان من ألم, والدمعان من وادٍ.
ولقد بدا ميسّرا لنا الحديث عن (أنا) الشاعر البار في هذا الديوان كما جلته قصائده, لكننّا أعرضنا عن ذلك ليتسع الحديث فيشمل محاور أخرى كشفت عنها القصائد فدلّت على سعة في التجربة, واستغراق في وصف أبعادها. فصحّ لنا من ذلك خمسة محاور هي:
وسنتناولها محورا محورا بادئين بـ:
محور الذات المتكلمة في النص:
تتراءى الذات المتكلمة في النص على صور متنوعة, تحتويها سياقات مختلفة وأنساق شتّى. فهي تارة ظاهرة في مقام الاعتراف بالخطيئة:
| إني هنا يا أبا الزهراء في كنف قدمت أحمل آلامي ولي أمل يا طالما خفقت روحي مصفقة أبغي الفرار على شوقي فيقعد بي أضعت زهرة عمري في هوى نهم ورحت أركض في لهوي وفي عبثي | يحمي النزيل ويرضي كل مقهور وأنت تعرف ما يعنيه تعبيري إذا تمثلت لي تصفيق مسحور إني بماء الخطايا جدّ مغمور بين المزاهر أو بين المزامير وما ترفقت يوما بالقوارير(26) |
هنا تتسلسل (الذات) من دائرة (الكليّة) المطلقة (يحمي النزيل ويرضي كل مقهور) إلى دائرة (الخصوصية) المنحصرة في شجن الذات وانشطار وعيها بالحياة بين ملاذّ تتعدد ألوانها (بين المزاهر أو بين المزامير) وبين الشوق لبلوغ متعة تتجاوز الآنيّ إلى سرمديّ سامٍ (يا طالما خفقت روحي مصفقة إذا تمثلت لي تصفيق مسحور). ولقد تردد ضمير (التكلم) تسع عشرة مرة في ستة أبيات مما يشي برغبة الذات في التخفف من عبء الإثم الذي يبهظها, فكان اعترافها بالخطايا التي ارتكبتها وسيلتها في التخفف منها (قدمت أحمل آلامي ولي أمل…, أبغي الفرار على شوقي فيقعد بي…) فهل خلعت (الذات) عنها عبء آثامها؟ وهل اتحد شطراها بعد هذا الاعتراف؟ هذا ما سنراه في سياق غير هذا السياق.
والذات تظهر تارة أخرى في مقام الحسرة على فائت عزيز على النفس فقدانه كائنا ما كان, طفلا من أبنائه, أو مصلحا بلغ في حماسته للإصلاح حد الزعامة, أو فنانا رائدا عزّ نظيره في الواقع الحضرمي كما نجد في قوله راثيا الفنان الكبير محمد جمعة خان:
ثرى توسّد فيه متعب لغب ::: من رحلة في سماء الفن يطويها
أعلى الشراع وولى بعدما عثرت ::: به أمانيّ كثر ظل يعليها
وبلبل ما قضى من دهره وطرا ::: عبر الليالي التي قد عاش شاديها
غنت على شدوه الأحقاف راقصة ::: حينا من الدهر قاصيها ودانيها(27)
وتلقاها ثالثة في مقام الحنين إلى أشواق في النفس لا تتناهى, كما في هذه النجوى التي يبث فيها شكواه إلى ربّه:
منك الإعانة والرعاية ::: وبك الإغاثة والحمايه
مالي سواك مؤمّل ::: أرجو نداه لكل غايه
أنت الملاذ وأنت إن ::: أضنتني الدنيا نهايه
إني بلطفك عائذ ::: فزع ألجلج في الشكايه
وهي ذات لم تنتف عنها الحيرة وإن أمضت في الحياة سنين عددا, وقاربت سن الكهولة نضجا, فتاهت بين رفاق جاءوا وقالوا كلاما:
وقال الرفاق إلا ما إلا ما
إلا ما التغني
بحلو التثني
وسود الليالي وساع التهنّي
وبين رفاق آخرين قالوا كلاما مناقضا, يحثون به الذات على التغنّي:
وقالوا رفاق : تغنّ تغنّ
فإنا نصيخ, وإنّا وإنّا
فصف ما تراه
وصوّر رؤاه
وأترع وجودك من كل دنِّ
ولم ينهه فريق ثالث عن الغناء, ولكنهم نظروا في محتوى القول فأوصوه بموضوعه خيرا:
وصف للحياة صنوف الحياه
وهول الظلام وجور الطغاه
وأرسل غناء
يروّي الظماء
ويرسم أطياف بؤس وحزن
وصور حياة بدوت مثقله
من الوهم والبؤس والزلزله
فشعبك عبد
قد التف قيد
برجليه, والقيد غير مرن(29)
فحملت الذات من كل هؤلاء وأولئك كلاما كثيرا يفح لظى, وقولا قليلا يفوح عبيرا:
فأترعت كأسي
وقلت لنفسي
هم الناس .. فاستعجلي أو تأني
وتلك حيرة قد تفضي إلى حال من اللامبالاة, ويصير مآل الذات إلى صفات من الشقاء والتعاسة. فكان لا بد من انتفاضة داخلية تعمر المتهدم, وتفتح للأمل أبوابا ونوافذ لتتجدد صور الأمل رغم اليأس:
لي من النجم إذا رفَّ جليس لا يمل
لي من الأنسام أنغام وأرواح وظل
وحديث ساحر الإيقاع للأحزان يجلو
فإذا ما همست في أذني واحدة منهن صدقا
كيف أشقى؟(30)
وهذه (الذات) لا تتجلى في المتن الشعري معزولة عن (الآخر) ولكنها تتجلى فيه ومعه وبه. وتتباين علاقتها به, فهو تارة (جحيم) لا يطاق, وفي أخرى (نعيم) تأنس به (الذات). وتتقلب بها أحوالا بها تتقلب أحوال (الذات) وتتغير أجواؤها النفسية. ففي خطابها (الآخر) تنطلق (الذات) هاتفة به في مقام الالتماس والاستعطاف:
| رَوِّ الفـؤاد بـخـمـرة الآبـاد ردّد بـيـانـك يا هـزار فإنني ردّده لي فـلـقـد سئمت ملاحناً عد بي إلى الماضي لأشهد لحظة عد بي إليـه عسـاك تبعث نشوة | وأشع رؤاها في وجود الصادي ظمئ إلى هذا البيـان النـادي أسنـت ولابست الحيـاة عوادي مـرح الحيـاة .. وزينة الأعياد في بـاهـت متـلفع بـسـواد(31) |
تنطلق (الذات) مع (الآخر) من دائرة الأنس به, والركون إليه ليخفف بعض آلامها, وينجيها من براثن حاضر بائس ترفضه, علّها تقع في أكفّ ماض يهدهد أحلامها وينعش أعماقها. وتلك نغمة عزفها شعراء (الوجدان) في تاريخ الشعرية العربية في عصرها الحديث, تجدها عند (الهمشري) كما تجدها عند (الشابي) ولم يخل منها (علي محمود طه) ولا (إبراهيم ناجي) في كثير من أشعارهم. وهنا تتراءى صورة (الآخر) في ملامح نعيم منتظر. لكنّ (الحياة) من حيث هي (غائيّة في حالة فعل. غائيّة تعمل جاهدة في سبيل فردية), و(الدنيا) بما هي وجود متعين متحقق يستحيلان جحيما لا ينقطع:
| ذقت الحياة بها مرارة علقم ::: بين النـواح تمرّ والعواد وشربتها صابا بأنّة مخلص ::: ممزوجة أو غمزة من عاد |
ولذلك تتصاعد شكوى الذات من (الحياة) و(الدنيا) كونها لم تحظ منهما بأنس ولا سلوى تلوذ بهما من شقاء ألمّ بها غير منبتٍّ:
| ماذا لقيت من الحياة سوى الأسى ::: والنائبات يقفن بالمرصاد يا ويـح لي ما كنـت أعلم أنني ::: ومصائب الدنيا على ميعاد أواه يـا دنيـا رأيتـك قحـمة ::: حدباء لا تحنو على الأولاد تلديننا لمـصـائـر مجهـولة ::: ومسالك مبثوثة الأرصـاد |
وتلك شنشنة عرفتها الشعرية العربية عند أبي الطيب الذي قال:
| كيف الرجاء من الخطوب تخلصا ::: من بعد ما أنشبن في مخالبـا أوحـدنني ووجـدن حزنا واحدا ::: متناهيا فجعلنه لي صـاحبـا ونصبنني غرض الرماة تصيبني ::: محنٌ أحدُّ من السيوف مضاربا أظمتـني الدنيـا فلما جئتـهـا ::: مستسقيا مطرت عليَّ مصائبـا(32) |
ومن بعده ضجّ أبو العلاء بالشكوى في صور متنوعة:
| عللاني فإنّ بيض الأماني ::: فنيت والظلام ليس بفانِ كم أردنا ذاك الزمان بمدح ::: فشغلنا بذم ذاك الزمانِ (33) تأملنا الزمان فما وجدنـا ::: إلى طيب الحياة به سبيلا ذر الدنيا إذا لم تحظ منها ::: وكن فيها كثيرا أو قليلا (34) |
ولم يقف عند ذلك بل جأر بتأففه من خساسة ما حوله, فقال:
| يسوسون البلاد بغير عقل ::: فينفذ حكمهم .. ويقال ساسة فأفِّ من الحياة وأفّ منّي ::: ومن زمن رئاسته خسـاسة (35) |
وقد قاده ذلك التذمر من الحياة إلى حال من استواء الأضداد في نفسه, فقال:
| غير مجدٍ في ملّتي واعتقادي ::: نوح باك ولا ترنم شادي وشبيه صوت النعيِّ إذا قيس ::: بصوت البشير في كل ناد أبكت تلكم الحمـامة أم غنّت ::: على فـرع غصنها الميـاد (36) |
وتلك هي النتيجة التي اعترفت بها الذات في قصيدة (البار) فهتفت:
| سيّان عندي صرخة نائح ::: دامي الفؤاد .. ونغمة من حاد |
والذات لا تخفي ضعفها في مواجهة الحاضر, ورغبتها في الفرار منه اعترافا بالعجز عن تغييره وإن تمردت عليه, وحملت عليه في مظانّ أخرى من المتن الشعري. لكنها تتجاوز ذلك الضعف بشيء من الأمل الذي يدفع الألم, بقليل من الأنس بالآخر الذي يحيل الشقاء رمادا بَعْدَ أن كان نارا محرقة:
| ودعت فيك صباباتي وأحـلامي ::: ونبع شعري ووحي الخافق الدامي ودعت فيك عهودا لست أذكرها ::: إلا وتصـرخ أنـاتـي وآلامـي ودعت فيك غوافي العمر حالمة ::: ملأى الجـوانب من شـدو وأنغامِ مرت ليـاليـك والأيام راكضة ::: نشوى فيـا ويـح ليـلاتي وأيامي إني أقـدّسهـا ذكرى وألثمهـا ::: روحـا فلا برحت روحي وأنسامي (37) |
هنا (الآخر) مكان تأنس إليه الذات إذ تمحي من أعماقها فيه كل بلابلها وأساها فتلوذ فيه بما ينسيها شقاء يرهقها ويزيدها ألما على ألم, فتراها تحيل المكان – وهو وادي دوعن – من مذكر لغة إلى مؤنث لغة, لأن الأنثى أنس القلب التائه والذات الحائرة, ناهيك بأن (المكان إذا لم يؤنث لا يعول عليه) كما قال محيي الدين ابن عربيّ, ومن ثم كان الابتهاج رغم الشقاء:
| أنا الشـقـي ولكنّي سعدت بها ::: في نفحة مـن عبير الناضر النـامي في همسة الليل والأكوان صامتة ::: يذيبـها بيـن إيـضـاح وإبـهـام يذيبها قـطـرات منه خـالـدة ::: ملء المشاعر من نبع الهوى السامي (38) |
وللذات في هذا المتن الشعري صور أخرى سنلقاها في غير هذا المحور من محاور دلالية. وهذا إنما كان هكذا بسبب من أن الشعر عند شعراء الوجدان تعبير فلا تخلو القصيدة من هواجس الذات وتصوير ذبذباتها الداخلية في كل موقف ومقام. ومن هنا وسم الواسمون لغة ذلك الشعر بالوظيفية التعبيرية لانكفائها على ذات المرسل في هجس شعري.
الهوامش :