لقاء العدد
د. ماهر بن دهري
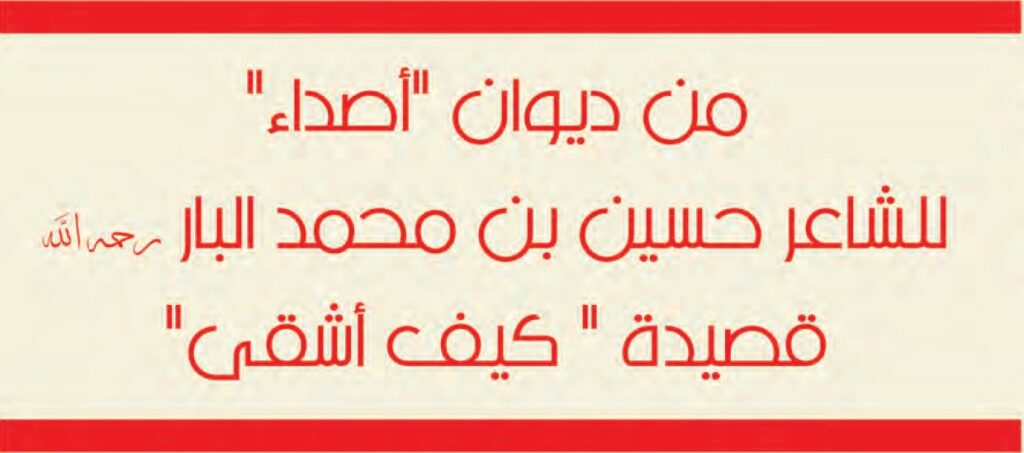

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 4 .. ص 74
رابط العدد 4 : اضغط هنا
كيف أشقى ؟ لِمَ أبكِ؟ والدُّنا تضحك حولي
وغــداً تمحــو يـــدُ الأيــامِ جُثماني وظــلّي
وغــــداً تُخــرسُ ألحانــيَ من جــــدٍّ وهزلِ
وسيــنسانــيَ مَــن لــم آلَهُ ذكـــراً وشوقا
كيف أشقى!!!
كيفَ أشقى ومصيري في تلافيف الظلام
لسـت أدري ما ورائي؟ أرحيـلٌ أم مُقـام؟
لـست أدري ما ورائي؟ أحيــاة أم حِمام
كــل هذا غامض ليس إليه الفهمُ يرقى
كيف أشقى !!!
الغد المجهول يشقيني وكأس في يديّا
وبوسعي رشفُها اليومَ فلا أرقبُ شيّا
وإذا حطّمتُها خــوفَ غــدٍ من شفتيّا
ووهبتُ اليوم للّحان وقلت الكأسُ دقّا
كيف أشقى!!!
كيف أشقى! وزهور الرّوض في الروض تفوحْ
وطيــورُ الأرض بالألحــان تغـــدو وتـــــــروح
تنشُـــقُ العطــرَ شـذيّاً فـــي الروابي والسفوح
فــــإذا حــاكـيتهـا فــِعلا وإحــساســاً وذوقـــــا
كيف أشقى!!!
أيُّهــا البحــــرُ ألا أسْطيعُ أن أفهمَ ســــرَّكْ؟
آهِ لَـــوْ حـدثْـتـنـي عنــكَ فماذا كـانَ ضرَّك؟
سوف أحيى مثلما تحيى فمَن يُدركُ غوْرك؟
وإذا مــا النّـفسُ ضـاهتــك رحابـــات وعُمقا
كيف أشقى!!!
لـــي مـــن النجم إذا رفَّ جــليسٌ لا يُـــمَلُّ
لــــي مـــن الأنســام أنغــامٌ وأرواحٌ وظلُّ
وحـــديثٌ ساحـــرُ الإيقـــاع للأحزان يجلو
فإذا ما همستْ في أذني واحدةٌ منهنَّ صدقا
كيف أشقى!!!
وإذا الليل احتواني فهو محراب صلاتي
طـالما أصغى إلــــى أنّاتِ قلبي وشُكاتي
طــالما فجّـــرَ في النفس معينَ الذكريات
وإذا هــدهــدَ آلامــي وقــــد راقــ ورقّا
كيف أشقى!!!
(1)
قصيدة” كيف أشقى” إحدى قصائد ديوان ” أصداء” للشاعر حسين محمد البار، وقد نسجها على منوال قصيدة الطلاسم لإيليا أبي ماضي، حيث ترسّم الشاعرُ البار خطى إيليا أبي ماضي، ولكنه لم يطابقه تمام المطابقة، بل اختلف النص الذي بين أيدينا عن نص الطلاسم في أمور وشابهه في أمور، فتشابه النصّان في ما هو آتٍ :
وأبرز أوجه الخلاف من حيث عدد المقاطع حيث بلغت في ” الطلاسم” واحداً وسبعين مقطعاً، بينما في ” كيف أشقى” بلغت سبعة مقاطع. كما ألزم الشاعر البار نفسه في البيت الرابع من كل مقطع بما لا يلزمه، حيث التزم بروي يناسب روي البيت الخامس، وهو مالم يلتزم به إيليا أبو ماضي.
وعودة إلى قصيدة ” كيف أشقى” لنبدأ الحديث عن هذا العنوان الذي جاء جملة اسمية تبدأ باسم الاستفهام” كيف” الذي عكس حالة من القلق كما أنه يثير فضول القارئ حول هذا الشقاء ما سببه وما طبيعته؟ ولِمَ يشقى الشاعر؟ أهو شقاءٌ خاص أم شقاء عام؟ وهل تغلّب الشاعر عليه أم لا؟ وهذه أسئلة يثيرها العنوان دون أن يعطي أي إجابة عنها.
إن العنوان الذي يُعد عتبة تضيء النص يفجأ القارئ بهذه الصيغة، وهو وإن كان يمنح النص عتمة لكنها العتمة التي لا تفتأ تنبلج شيئاً فشيئا لتضع القارئ أمام النص في حوار يستكشف خبيئه ويفضّ بكارته ليصل إلى لحظة الكشف والتجلي بعد الاحتجاب الذي لفّ النص للوهلة الأولى. وقد اعتمد النص في التأجيل الدلالي على الأسلوب الإنشائي، حيث اختار أسلوب الاستفهام كعنوان للنص، لأن الأسلوب الإنشائي يتسلط على القارئ تسلطا ثنائياً، فيقرّبه من النص بهذا السؤال، لكنه في الوقت نفسه ينئيه ويبعده حين يغلق عليه سُبل الإجابة ليظل في حالة ترقب وانتظار ناتجين عن عدم حسم سبب الشقاء.
يثير النص الذي بين أيدينا عدداً من الأسئلة الفلسفية التي تؤرق الذات المبدعة الحاضرة في هذا النص حضوراً طاغياً، وهي أسئلة محيرة لا تجد الذات المبدعة لها جواباً؛ لهذا تظلّ تلح عليه من خلال إعادة اللازمة “كيف أشقى” التي ينهي بها كل مقطع.

ويتكون النص من سبعة مقاطع كل مقطع مكون من خمسة أسطر تنتهي بجملة:” كيف أشقى”؟
وقد اتكأ النص على بنيتين رئيستين هما: ( الموت والحياة) أو التدمير والتكوين، والسعادة والشقاء، وسيتم الحديث عنهما عندما نخلص إلى الكلام عن الموضوع.
والملاحظ في هذا النص الذي نقف معه أن الذات كان لها حضور طاغٍ، يمكن الادعاء معه أنها تسربت في كل جزئياته، ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال عدِّ أبيات النص ومقارنتها بتكرار الذات فيها، حيث إن النص مكونٌ من خمسة وثلاثين سطراً، ومع هذا فقد تكررت الذات فيها أربعاً وسبعين مرة أي بمعدل تكرارين في كل سطر، حيث تكرر ضمير المتكلم خمساً وأربعين مرة، وتكرر ضمير الغائب اثنتين وعشرين مرة كما تكرر ضمير المخاطب سبع مرات.
إن حضور الذات المتكلمة ضِعف الغائبة يؤكد حرصها على أن تبقى صياغياً ليتوازى هذا الحرص مع حرصها على البقاء الفعلي. ويلاحظ كثافة حضور الذات ( أنا) في مناطق بعينها، هي مناطق توحي بالشعور بالحزن والضعف والعجز(أشقى- أبكِ – لست أدري – لا أرقب – لا أسطيع أن أفهم – أحيى) أما الضمير (ي) الذي يعود للمتكلم فإنه تكرر في المواطن التي ورد فيها معلناً شعوراً بالوحدة، وإحساساً بالآلام، والخوف من المجهول (الدنا تضحك حولي، تمحو يدُ الأيام جثماني وظلي، تُخرس ألحاني، سينساني، مصيري في تلافيف الظلام، لست أدري ما ورائي، الغد المجهول يشقيني، بوسعي رشفها، آه لو حدثتني، لي من النجم إذا رفّ جليس، لي من الأنسام أنغام، الليل احتواني فهو محراب صلاتي، أنّات قلبي وشكاتي، هدهدَ آلامي).
أما ضمير الغياب فإنه يعمل في اتجاهين متضادين، فتارة يتلاءم مع حالة السعادة المفقودة التي تنشدها الذات المبدعة لكنها كانت حاضرة فيما حولها: ( الدنا تضحك، في الروض تفوح، تنشقُ العطرَ، حديثٌ ساحرُ الإيقاع للأحزان يجلو، فجّرَ في النفس معين الذكريات، هدهدَ آلامي، راقَ ورقّا) وتارة أخرى يعمل في الذات المتكلمة ويشترك في إكسابها حالة الفقد والوجع ( تُخرس ألحاني، الغد المجهول يشقيني، أصغى إلى أنّات قلبي).
(2)
وإذا ما انتقلنا من الحديث عن الذات لنخوض في الموضوع الذي دار حوله النص نجده حديثاً عن ثنائية السعادة والشقاء، وقد تناولها في مجموعة من المحاور، يلتقي بعضها بالبعض الآخر وقد يتصادم معه، لكنه في الأخير يخدم رؤية الذات المبدعة ويتلاءم معها بطريقة أو بأخرى.
المحور الأول: هو محور الموت والمصير المجهول الذي ينتظر الذات المبدعة التي بدت في صورة المستسلم لما سيجري والقلقة على غياب مآثرها واندراس سيرتها، وخوفها من القادم نتيجة عدم معرفتها بما سيؤول إليه الحال؛ لذلك دار معجمه حول هذا الأمر في النص حيث يقول:
وغــداً تمحــو يـــدُ الأيــامِ جُثماني وظــلّي
وغــــداً تُخــرسُ ألحانــيَ من جــــدٍّ وهزلِ
وسيــنسانــيَ مَــن لــم آلَهُ ذكـــراً وشوقا
كيف أشقى!!!
كيفَ أشقى ومصيري في تلافيف الظلام
لسـت أدري ما ورائي؟ أرحيـلٌ أم مُقـام؟
لـست أدري ما ورائي؟ أحيــاة أم حِمام
كــل هذا غامض ليس إليه الفهمُ يرقى
فقد ترددت مفردات الموت والخوف من المصير المجهول والقلق على ضياع سيرتها من خلال(تمحـو يـدُ الأيـامِ جُثماني، وغـداً تُخـرسُ ألحانيَ، وسيـنسانـيَ مَن لم آلَهُ ذكراً، كيفَ أشقى ومصيري في تلافيف الظلام، لست أدري ما ورائي؟ أرحيـلٌ أم مُقام؟، لست أدري ما ورائي؟ أحياة أم حِمام).
فهذه الذات تقف محملة بهموم المُضي نحو المجهول كنتيجةٍ مباشرة للرحيل الذي هو قدرُ كل المخلوقات، ومبعثُ الخوف ليس الرحيل، ولكن من المصير الذي ستؤول إليه الذات بعد هذا الرحيل.
والمحور الثاني هو محور الزمان: الذي ضمَّ ستاً وخمسين مفردة، جاءت ثمان منها محددة بظرف الزمان (غداً، الأيام، غدا، الغد، اليوم، غدٍ، اليوم، الليل) وقد تعلّقت بالموت والخوف، ووردت ثمان وأربعون مفردة استوعبت الزمن الماضي والحاضر والآتي، وحظُّ الزمن الماضي منها عشرون فعلا تعلق زمن الماضي بالضياع أو الفقدان أو القلق أو بعث للخوف ( لستُ أدري، ليس إليه الفهم يرقى، وإذا حطمتها، ووهبت اليوم للحان وقلت الكأس دقّا، حاكيتها، حدثتني، ماذا كان ضرك، ضاهتك، رفَّ، همست في أذني، احتواني، أصغى، فجّرَ، هدهدَ، راق ورقّا) أما الزمن الحاضر فقد بلغ ثمانية وعشرين فعلا حمَلَ حديثا عن شعورٍ بالسعادة أو الحزن وما يرافقهما من شيوع الروائح الطيبة أو الغناء، أو اندراس سيرة ونسيان وغيره مما يدور في مجالَيْ السعادة والفرح أو الحزن والشقاء.
المحور الثالث: محور المكان: وقد حضر المكان في ثنايا النص حضوراً ظاهراً إذ تدور كل الأحداث في زمان ومكان، والمكان الذي ورد في النص مكان يبعث على الفرح والسعادة أو هو مكانٌ من يعيش فيه يشعر بالسعادة، حيث بلغت مفردات المكان عشر مفردات( الدّنا تضحك حولي، لست أدري ما ورائي، ووهبتُ اليوم للحان، زهور الروض في الروض تفوح، طيور الأرض بالألحان، تنشق العطر شذيا في الروابي والسفوح، البحر) فالأماكن يلاحظ عليها أن بعضها قد أخذ بعداً مطلقا خالصا للمكانية (حولي – ورائي) وبعضها بعدا بين المحدودية والاتساع( الأرض – الروابي – السفوح) وبعضها بعدا موسعا (الدّنا – البحر).
ثم تكتمل ثلاثية الزمن بالآتي الذي جسّد حالة القلق والحيرة التي تعيشها الذات، وقد بدا هذا واضحاً في مخاطبته البحر وحديثه عن عدم فهم أسراره، وتمنيه لو يخبره، ومع هذا فإنه يختار أن يحيا مثله، ( سوف أحيى مثلما تحيى).
(3)
ويأتي الاستدعاء باعتباره سمة رئيسة تساهم في إكمال المعنى الذي نشدته الذات المبدعة، فمن خلاله يعمل على استحضار أصوات متعددة تتوازى في رؤيتها مع رؤية الذات المبدعة، سواء في معاناتها أو حيرتها، أو تفاؤلها وحزنها وسرورها.
وقد اختارت الذات المبدعة استحضار نص ” الطلاسم” بكل ما فيه من أسئلة فلسفية تحمل قلقا حول أسباب السعادة والشقاء التي تنتابها في مراحل أو أوقات محددة، وهي أسئلة لها من الوجاهة الشيء الكثير، كما أنها أسئلة أرّقت الفلاسفة والشعراء وهاهي تؤرق الذات المبدعة التي لا تستطيع لها جواباً إلا في إعادة السؤال المتمثل في اللازمة ” كيف أشقى؟” التي ينهي بها تساؤلاته المقلقلة والمحيرة.
وأول ما بدا هذا الاستدعاء واضحاً في النص بقوله:
لسـت أدري ما ورائي؟ أرحيـلٌ أم مُقـام؟
لـست أدري ما ورائي؟ أحيــاة أم حِمام
هذه العبارة التي آثر إيليا أبو ماضي تكرارها نهاية كل مقطع واختتامه بها التي تعني على الصعيد الفلسفي تعليق الجواب أو اللا أدرية الفلسفية عنده. فلئن غاب عن إيليا أبو ماضي كيف جاء إلى الحياة وإلى أين يسير وهو أمر يعكس حيرة وقلقاً واضطرابا فإن الأمر ذاته تشعر به الذات المبدعة لكنه منصبٌّ ومسلّط فقط على أسباب الشقاء.
ولما كان من الاستدعاء ما هو امتصاص لنصوص أخرى، باعتبار أن أيَّ نص ليس خلقاً من العدم ووجوداً من لا شيء، وإنما قد سبقته نصوص مشابهة له، هذه النصوص تجعله فرعاً من أصل أو جزءاً من منظومة متكاملة، ولبنة في بناء عام، وحلقة تكتسب دلالتها من التصاقها بسواها من النصوص. أو هو على حدِّ تعبير جوليا ” كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات، وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى([1])، لمّا كان ذلك كذلك فقد متحت الذات المبدعة من نص” الطلاسم” معنى يعكس انتشار الروائح الطيبة التي جادت بها زهور الروض حين قال:
كيف أشقى! وزهور الرّوض في الروض تفوحْ
هذا المعنى الذي تماهى مع قول إيليا:
وزهورُ الأرض تُفشي مُجبرات عطرَها
ولئن كان إيليا متشائما في طلاسمه يجعل الزهور تمنح عطرها مكرهة فإن الذات المبدعة هنا أرادت عكس الأمر تماماً؛ رغبة منها في رسم الابتسامة وبعث السرور فجعلت الزهور تمنح هذا العطر، وكلُّ ما يحيط بهذا الجو كان باعثاً للسعادة وناشراً منهج التفاؤل:
كيف أشقى! وزهور الرّوض في الروض تفوحْ
وطيــورُ الأرض بالألحــان تغـــدو وتـــــــروح
تنشُـــقُ العطــرَ شـذيّاً فـــي الروابي والسفوح
وحين يخاطب إيليا البحر فإنه يستخدم لغة فيها نبرة من التعالي والاستكبار قائلاً:
فيك مثلي أيّها الجبّار أصداف ورمل
إنّما أنت بلا ظلّ ولي في الأرض ظلّ
إنّما أنت بلا عقل ولي ،يا بحر، عقل
بينما تخاطبه الذات المبدعة بنبرة هادئة لا استكبار فيها حين تقول:
لــــي مـــن الأنســام أنغــامٌ وأرواحٌ وظلُّ
وحـديث ساحــرُ الإيقاع للأحـــزان يجلـو
هكذا تظهر الذات المبدعة في نوع من التآلف والتقارب مع مكونات الطبيعة.
وانطلاقا من الروح التفاؤلية التي تسيطر على الذات المبدعة، فإنها تنظر إلى الأمور من جانب ترى فيه الجمال، فهي تعتبر الليل فرصة للاختلاء بالنفس ومناجاة المحبوب، بل تعدَّى هذا الأمر لتجعل الليل متعاطفا معها، فهو يصغي إلى أناتها وشكواها، يقول النص:
وإذا الليل احتواني فهو محراب صلاتي
طـالما أصغى إلــــى أنّاتِ قلبي وشُكاتي
طــالما فجّـــرَ في النفس معينَ الذكريات
بخلاف إيليا الذي يجعل الليل سجانا يكابده قائلا:
لم أجد في القصر شيئا ليس في الكوخ المهين
أنـــا فـــي هـــــذا وهــــذا عبــــــد شــكٍّ ويقين
وسجـــينُ الخالـــدين اللّيــــل والصّبح المبيـن
هكذا اكتفت الذات باستدعاء التجربة اللا أدرية من حيث الأسئلة الفلسفية التي أثارتها لكنها استطاعت أن تكوّن تجربة أخرى من خلال المخالفة في طبيعة الأسئلة حيث ناقشت الذات المبدعة أسباب الشقاء التي تجعل الناس يضيعون أنفس ما ملكوا وهو الوقت في أمور تافهة.
(4)
ولما كان النص الذي بين أيدينا نصا لغويا في المقام الأول والأخير، فكان لزاما الوقوف على الصياغة باعتبارها الإطار الذي يستوعب النص، أو الوعاء الذي يشكل النص؛ ذلك أن الخطاب الأدبي يفرض تقاليده علينا في تعاملنا مع هذا النص أو ذاك.
وأول ما يواجهنا في التعامل اللغوي هو اعتماد النص على الجملة الفعلية رغم أن أول شيء نقابله هو الجملة الاسمية التي عُنوِن بها النص، إذ تبلغ الجمل الفعلية اثنتين وثلاثين جملة، بينما بلغ عدد الجمل الاسمية خمساً وعشرين جملة، وهو ما يعني ميل الدلالة نحو التجدد، وأن الذات تميل إلى تجدد الأمل وتوسيع دائرة التفاؤل، مع محاولة لتحجيم دائرة الشقاء المتمثل في الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت. وتبلغ الأفعال المضارعة واحداً وثلاثين فعلا بينما تبلغ الأفعال الماضية فيها عشرين فعلا وهو مؤشر على الرغبة الداخلية في نشر التفاؤل والسعادة للخلاص من الشقاء الذي تعانيه الذات المبدعة.
وعند قراءتنا للنص الذي بين أيدينا نلاحظ أن الدوال انزاحت عن مرجعيتها المعجمية أو العرفية، ولم تتمسك بها، بل لقد حاولت التخلص من هذه المرجعية بدخولها في دائرة المجاز وما يتصل به؛ لتحلق في دائرة الشعرية، ولتتمكن من ممارسة فاعليتها الإنتاجية بعيداً عن مراجعها التقليدية التي تقيدها بإطار معلوم لا يُحدِث تأثيراً في المتلقي.
فقد وظّف النصُّ بنية الاستعارة المكنية اثتي عشرة مرة تمثلت في: ( والدّنا تضحك، تمحو يدُ الأيّام، تُخرسُ ألحانيَ، الغدُ المجهولُ يشقيني، وهبتُ اليومَ للحان، همست في أذني واحدةٌ منهنّ، الليلُ احتواني، أصغى إلى أنَّات قلبي، فجّرَ في النفس، هدهدَ آلامي، وقد راقَ، ورقَّا)
ففي الاستعارات السالفة نلحظ تخلص الجمادات من دلالتها المعجمية لتحمل دلالة أخرى، قادرة على الفعل وبث المشاعر فيما حولها والتأثير على الحالة النفسية لمن يعيش حولها، وإن كان الغالب فيها بعث الشقاء، إلا أننا نلمح شيئاً من السعادة يلوح في قوله: (والدّنا تضحك حولي)، صحيح أن هذا الضحك ق يثير شيئاً من الحزن في نفس الذات المبدعة، لكنه في الوقت ذاته يسبغ الحياة بلون وطعم السعادة وإن بدَوَا خارج الذات.
هذا الكم الكبير من الشقاء والتعاسة التي رسمتها الذات المبدعة في تصويرها لما حولها لم يكن بمقدوره الانتصار على إرادة الذات المبدعة في نشر السعادة، فقد استطاعت الذات المبدعة التغلب عليها، وقد رسمت لنا الأيامَ وهي تسعى لمحو آثارها ( تمحو يدُ الأيام جثماني وظلي) وإسكات ألحانها (تخرس ألحانيَ) ومحاولة الغد تنغيص حياتها (الغدُ المجهولُ يشقيني ) إلا أن الذات استطاعت أن تحصل على تعاطف جزء آخر مكون من النجوم والأنسام والأنغام ما جعلها تشاركه وتهمس متعاطفة معه(همست في أذني واحدةٌ منهنّ) وليس هذا فحسب، بل لقد شاركه الليل كل معاناته واستطاع تحويل وقت الوحدة إلى خلوة يختلي مع محبوبه الأسمى ليبعث في نفسه الطمأنينة والراحة والسعادة (وإذا الليلُ احتواني فهو محراب صلاتي)، ولم يكتف بهذا بل لقد شخّص الليل فجعله كثير التفاعل معه من خلال: ( طالما أصغى إلى أنَّات قلبي وشكاتي)، بل وجعله أضا سببا لبث السعادة من خلال: ( طالما فجّرَ في النفس معينَ الذكريات)، ويزيد من تعاطف الليل معه فإذا هو يخفف الآلام ويبعث الشعور بالرقة التي تملأ نفسه بالسعادة الغامرة ( وإذا هدهدَ آلامي، وقد راقَ، ورقَّا كيف أشقى؟)
أشرنا سلفا إلى أن النص يقوم على ثنائية: ( الموت والحياة) أو التدمير والتكوين، والسعادة والشقاء؛ لذا اتكأ النص على المفارقة التي تجمع بين الشيء وضده، وهو أمر يزيد من عتمة النص باعتباره فاقدا للفروق الحاسمة داخل الأضداد المذكورة، وقد استخدم النص بنية التقابل خمس مرات، جاءت بصيغة الفعل مرتين وبالصيغة الاسمية ثلاث مرات، وردت أولى الاستخدامات في قوله: ( لِمَ أبكِ؟ والدنا تضحك)، فالتضاد بين البكاء والضحك يقود إلى وجود فاصل بين الطرفين خصوصاً إذا نظرنا أن الفاعل في صيغتي المقابلة اثنان يتفقان في أن كليهما ضميرا مستترا، ويختلفان في أن أحدهما للمتكلم الحاضر المذكر، والآخر للغائب المؤنث، ففي الأول الفاعل( أنا) وفي الثاني الفاعل ( هي).
ويستخدم النص بنية المقابلة ويخرجها عن دائرة التعامل مع المألوف التي يقدمها المعجم إلى دائرة التداخل التي تزيل حدة المفارقة وتكاد تلغي الثنائية، فتشكل بنى طارئة تجمع بين التضاد والتوافق على صعيد واحد ( جدٍّ وهزل) و( أرحيلٌ أم مقام) و ( أحياةٌ أم حِمام)، و( تغدو وتروح).
واستخدم النص بنية الجناس التي تعمل على مستوى الإدراك السمعي والإدراك البصري، فقد وظفها النص وغالبا ما كان يختار القافية لتزيد من حدتها الإيقاعية مثل:
كيف أشقى! وزهور الرّوض في الروض تفوحْ
وطيــورُ الأرض بالألحــان تغـــدو وتـــــــروحْ
وكذلك في قوله:
أيُّهــا البحــــرُ ألا أسْطيعُ أن أفهمَ ســــرَّكْ؟
آهِ لَـــوْ حـدثْـتـنـي عنــكَ فماذا كـانَ ضرَّكْ؟
كما استخدم النص بنية التكرار، وهي بنية لها طبيعتها الإيقاعية العالية، فالتكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يُعنى بها، ويسلط الضوء على نقطة حساسة فيها، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها أكثر من عنايته بسواها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة، فبالإضافة إلى تكرار النص عبارة ” كيف أشقى” في كل مقطع فقد جاء التكرار في قوله:
لسـت أدري ما ورائي؟ أرحيـلٌ أم مُقـام؟
لـست أدري ما ورائي؟ أحيــاة أم حِمام
ولأن التكرار ليس مجرد ترديد كلمة معينة، أو عبارة محددة، بل هو وسيلة لغوية يحمِّلها الشاعر نبضه وعاطفته، باعتباره مرتبطا بالحالة الشعورية التي تلح عليه ولا تغيب عنه فقد ورَدَ التكرار في النص أثناء حديثه عن مسامراته قوله:
لـــي مـــن النجم إذا رفَّ جــليسٌ لا يُـــمَلُّ
لــــي مـــن الأنســام أنغــامٌ وأرواحٌ وظلُّ
وحين تحدث عن تعاطف الليل معه قال:
طـالما أصغى إلــــى أنّاتِ قلبي وشُكاتي
طــالما فجّـــرَ في النفس معينَ الذكريات
د. ماهر سعيد بن دهري
أستاذ الأدب الحديث والمعاصر المشارك
كلية الآداب جامعة حضرموت
([1]) أحمد الزعبي: التناص نظرياً وتطبيقياً، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن، ط2، 2000م ، ص 12.