نقد
أ.د. عبدالله حسين البار
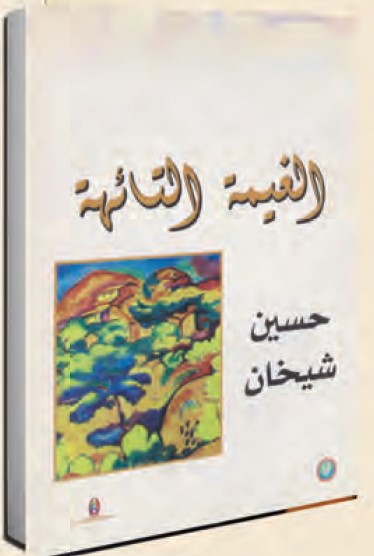
إشارةٌ
إلى صديقي وأخي الدكتور ماهر سعيد بن دهري الذي أعادني إلى أجواء عوالم شيخان كرّةً أخرى بعد انقطاعٍ.
وعبارة
من لي بإنسـانٍ إذا غاضـبتُـهُ وجهلتُ كان الحِلمُ ردَّ جوابِهِ
وإذا ظمئئتُ إلى الشرابِ شربتُ من أخلاقه.. وسكرتُ من آدابِهِ
وتـراه يصغي للحديـثِ بقلبِـهِ وبإذنـِهِ.. ولعلّه أدرى بِهِ
أبوتمام.

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 91
رابط العدد 6 : اضغط هنا
مدخل:
أما (الغيمة التائهة) فعنوان المجموع الشعريّ الذي ضمّ عددًا من القصائد والمقطّعات التي نظمها في حياته الشاعر حسين عمر شيخان رحمه الله. والحقّ أنّ الشاعر حسين عمر شيخان (1929م – 1997م) هو (الغيمة التائهة). و(الغيمة التائهة) هو الشاعر حسين شيخان.
الشاعر والديوان كلاهما كيانٌ واحدٌ بمصيرٍ واحد.
أتعدّ هذه قراءة عجلى لعنوان ذلك المجموع الشعريّ؟
لقد تكون كذلك.
فكلا الكائنين, مُبْدِعًا ومُبْدَعًا, واقعًا ونصًّا, تاها في دروب الحياة إلا من شيءٍ يسيرٍ يمور في الأفئدة, وتجري به الألسنة في أحايين متفرّقة.
لم يبق من الشاعر وسيرته إلا ذكرياتُ لقاءاتٍ قديمةٍ, وأصداءُ أحاديثَ أضحت تتساقط من الذاكرة, وقد هرم أصحابها.
ولم يبق من الشعر إلا قصائدُ لا تتلاءم عددًا مع عمره الإبداعيّ الذي بدا في عدد الس نين مقاربًا إلى الخمسين عاما.
فما قصّة هذا الشاعر؟
وما حكاية إبداعه؟
وكيف تجلّت شعريته؟
وَبِمَ تتميّز خصائص الأسلوب في شعره؟
أسئلةٌ, وسواها أخرى من أمثالها, ولعلَّها أكثر تعقيدا منها, سنحاول الإجابة عنها في السطور التالية.
أسئلة لا نملك إجابةً عنها, أو إنّ جوابها ظنٌّ:
إنّ ما نجهله عن الشاعر حسين عمر شيخان وشعره يفوق ما نعلمه عنهما. ومن هنا تنبعث الأسئلة, ويكثر الاستفهام من مثل متى بدأ الشاعر حسين عمر شيخان ينظم الشعر ويصوغ القصائد؟ هل عُرِفَ حسين شيخان في المكلا بصفته شاعرًا في العقود الخامس والسادس ومنتصف السابع من القرن العشرين كما عُرِفَ الشاعر حسين بن محمد البار الذي قدم من وادي دوعن إلى المكلا واستقرّ بها منذ العقود الخامس والسادس ومنتصف السابع, وكان بها واحدًا من شعرائها المعدودين؟
أو لم يكن بين أتراب حسين شيخان من عُرِفَ عنه هذه الموهبة؟ وللشعر عبيرٌ فوّاحٌ لا تخفى له رائحةٌ كخمرة أبي نواس.
هل نشر شيئا من شعره في صحيفة (الأمل) التي أصدرها جده لأمه, وساعد هو في تحريرها, ونشر بها مقالاتٍ, وربّما بعض النصوص الإبداعية كالقصة التي أجاد في كتابتها؟
ولماذا لم ينشر قصائدَ فيها مثلما نشر المقالة والقصة؟
هل لعدم نشره القصائد فيها صلةٌ بموضوع القصيدة ولغتها؟
إن للشاعر حسين عمر شيخان قصيدةً عنوانها (الحطابة) صيغت قصةً قصيرةً كما كان يذكر ذلك الشاعر نفسه عن نفسه. وكأنّ زمن نظمها شعرًا وكتابتها قصةً كان في غضون آخر العقد الخامس وأول العقد السادس. وإن من قرأ القصيدة منشورةً في ديوانه, أو سمعها من قبل من فم الشاعر ينشدها, يذهله ما فيها من سبك وحبك متماسكين متناسقين. وإن كان الشاعر قد نظمها في آخر الأربعينيات أو ما حولها. وشعرٌ صافٍ كهذا الذي ظهر في القصيدة يتجاوز قصائده الإخوانية التي وُسِمَ بها كثير من شعره. فلماذا لم يعرف مثل هذا الشعر شعراءُ ونقادٌ كانوا قريبين منه وكان قريبا منهم لدرجة المخاللة الصافية؟ وهل عرفوا فيه الفنّان الشاعر أو الشاعر الفنّان, أو هو كان يخفي عنهم مثل تلك الصفة في نفسه؟ لكنني أذكر – وقد عرفتُ الشاعر عن قربٍ منذ ثمانينيّات القرن الماضي – أنه حدثني عن نصيحة الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف له بعدم الزواج كونه فنانًا لا ينبغي له أن يتقيد بأسرة أو ما أشبه. وحين واجهه الشاعر بإشارة إلى تجربته هو – أعني الأستاذ بامطرف – في الزواج رد عليه بقوله: أنا لست من الفنانين. وذلك صحيح. وإني على يقين من أن (شيخان) كان يعرض قصصه على الأستاذ بامطرف لأمرٍ ما. سمعته من الشاعر مرةً ومن الذين لحقوا بركب الإبداع وكانوا من جلساء الأستاذ بامطرف مرةً أخرى.
وإذا وقفنا على قصيدة (المستقية)([1])– وهي السقّاءة التي كانت تجلب الماء إلى المنازل من سقاية الحي – خمّنّا أنها نظمت في آخر الخمسينيات أو أول الستينيات, ولربما سبق نظمها في الزمان واحدًا من ذينك الزمنين, لكنها حتما سبقت العام 1968م الذي ألغي فيه نظام السقاية في مدينة المكلا كما كان سائدا في أربعينيات القرن العشرين. فإذا صح هذا الحدس فهي من قديم شعره, وهي لا تخلو من تماسك نصيٍّ يدلّ على شاعرية مقتدرة. فهل لها نظائر وإن في موضوعات أخرى, وتجارب أخر صيغت على هذا السمت من السمو في الأداء اللغوي؟
إن في الديوان بائية من أربعة أبيات, مطلعها:
مرّغتُ خدّيَّ في نهديكِ فاضطربا * ………………………..
ثم يتلوه ثلاثة أبيات, هي:
وأيّنا نبش الأغوار فاندلعت
شرارة قد تحولنا لها حطبا
هنا بصدرك إلهامي, أيمكنني
أن أطعم النار ما استلهمته الأدبا؟
وكيف أحرق أقمارا فرشت لها
صدري, وأغمس في أنوارها اللهبا؟([2])
هنا منظورٌ للشعر ذو نَفَسٍ رومانسيٍّ, ولغة تعبيرية انفعالية يهيمن عليها ضمير المتكلم – تكرر في البيتين الأخيرين (8 مرات) – بما يشي بتغليب الوظيفة التعبيرية عليهما كما علّم جاكوبسون. وفي نسيج الأبيات ما ينبئ عن شاعرٍ يصعد في سماء الفن واثقَ الخطوة غيرَ مضطرب, ويسعى لتجاوز حدِّ القرمزة إلى فضاء الإبداع.
لكن يظل هذا مجرد افتراضٍ لا يؤيده برهان, ولا تؤكده وثائق. ومع ذلك فمن الممكن – اتكاءً على هذا الافتراض – القول إن الشاعر حسين عمر شيخان انطلق في مدائن التخييل الشعري منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين, واستمرّ يمخر عباب الشعر مذ ذاك حتى وفاته في 9/مارس/1997م. ولهذا التأطير التاريخي دلالته.

نصوص تبحث عن ديوانها:
خلّف الشاعر حسين شيخان نصوصًا تائهةً في أضابيره, ولم يخلّف لنا ديوانًا مصنوعًا كغيره من الشعراء, وإن ظلت دواوينهم مخطوطةً غير مطبوعة. ومن عجبٍ أنه لم ينشر خلال سبعة عشر عامًا من 1980م إلى 1997م – وهي السنوات التي عرفته فيها عن كثب – سوى ثلاثِ قصائدَ, وظل مكتفيًا بإنشاد شعره على الأصفياء من أصدقائه, وعلى بعض من اتصلوا به وعرّفوه بما يعرفون عنه من نظمٍ للشعر واقتدارٍ على صوغه.
وعلى الرغم من إلحاح المعجبين بشعره عليه بتقييد قصائده بالكتابة, أو بالتسجيل الصوتي على أقلّ تقديرٍ فإنّ الشاعر كان نافرًا من الفكرة, وأن أشار إلى قصائد بعينها أنها مكتوبةٌ بكاملها. أما الأغلب منها فمفرّقٌ في قصاصاتٍ الله والشاعر يعلم عددها, وصلة بعضها ببعض. فلقد تتداخل الاوزان وحروف الروي, وقد تتكرر الصور, وقد يسترجع بيتًا فيعيد صياغته على نحو آخر دون أن يمحو ما سبق أن قيّده في قصاصةٍ إلى آخر ما هنالك من ذلك. وكل هذا ينبئ أن الشاعر لم تتح له الفرصة لتنقيح شعره وتقويمه ليخرج للناس مستدًّا إلا في قصائد قليلة منها القصائد الثلاث التي نشرها في بعض المظان, وهي (حتى أنت يا جالاتيا, وما وراء البريق, وهو), ومنها القصائد التي نظمها ليحل بها مشكلة منزله وبعث بها إلى ذوي الشأن في ذلك الزمان. وظل حال الشعر على ما هو عليه, نصوصًا تتراكم في قصاصاتٍ. ووافى الأجل المحتوم الشاعر ونصوص شعره على تلك الهيئة, وذلك الوصف حتى نهض أخونا وصديقنا الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الصيغ فتولّى أمر جمع القصائد وترتيبها وتنسيقها وضم الأشباه إلى نظائرها من القصاصات, وأعاد الشوارد الضالة منها إلى نسقها حتى اكتمل بين يديه ديوان قوامه كما ذكر في المقدمة (خمس وستون قصيدةً), وصواب التمييز هنا (نصًّا)؛ لأن عدد القصائد المكتملة بنيتها هو أربعون قصيدةً, وأما ما تبقى – وعدده خمسة وعشرون نصًّا – فأبياتٌ لم تكتمل بنية القصيدة فيها, فهي إما مطالع بدأها الشاعر ولم يتمّها, أو مقطّعات لم تتصاعد في نفسه لتغدو قصائدَ كاملةً. وإن بعض تلك المقطّعات ما لم يشأ لها الشاعر أن يطول نصُّها ليكون وقعها في النفس أشدَّ تأثيرًا, فهي أقرب إلى الخاطرة الموجزة التي يكون لها صدى في الوجدان لا يكف جرسه عن الرنين.
ولقد حرص الدكتور الصيغ على أن يصنع من ذلك الركام من الأوراق ديوانًا, فاختار له عنوانًا هو (الغيمة التائهة), ووضع له مقدمةً جاءت في خمس صفحات من القطع الصغير وذيلها باسمه, وعيّن هنا تاريخَ كتابتها التي جاءت بعد وفاة الشاعر بثلاث سنين عددًا.
خيبة التوقع:
هذا مصطلح جرى على أقلام علماء الاسلوب وبعض دعاة نظرية التلقي. وهي تدل على مرتبة في الإبداع لا يرقاها إلا المبدعون الكبار؛ لأنهم يفاجئون قراءهم ومتلقي إبداعهم بما لا يألفون فيدهشون ويعجبون. ولكنها في مقام حديثنا عن ديوان (الغيمة التائهة) للشاعر حسين عمر شيخان بعد صدوره في عام 2003م لم تكن تعني شيئا من ذلك, بل عنت في نفوس من اطلعوا على الديوان من محبّي شعر الرجل والعارفين به أملا مكسورا, ورجاءً مهدورا, خاب فيه منتظر, وتراجع اندفاع محموم. ولهذا الحال الموصوف أسبابٌ موضوعية, ولكلّ سببٍ صلةٌ بواقعٍ مشهود. وهاك حصرا ببعض ذلك, غايته تنقية الديوان مما علق به لتجنُّب الوقوع فيه في طبعات قادمة واجبة القدوم.
1 – ترتيب قصائد الديوان على ترتيب الحروف الأبجدية, فبدأ بروي الهمزة ثم تلاه روي الباء فالتاء فالثاء فالحاء وهكذا حتى الياء. وما لم يحتوه رويٌّ في قافيةٍ من حروف المعجم تجاوز عنه إلى ما تلاه.
وهذه طريقةٌ معمولٌ بها في صناعة دواوين الشعر العربي القديم منذ شعراء الجاهلية حتى عصر الاجترار الذي يمثله ابن شهاب وشوقي وحافظ ابراهيم وآخرون من أمثالهم. على أن شعراء الرومنسية – وقد حملوا راية التجديد والابتداع – تجاوزوا ذلك وعدلوا عنه, فتنوعت قصائدهم تجربة وتشكيلا, وكانت لهم غاياتٌ من صناعة الديوان أعلى شأنًا وأعمق غورًا من مجرد حفظ القصائد وإخراجها للناس. ثم تلاهم شعراء الحداثة فباعدوا بالأمر وجاءوا بأفانين من التشكيل. والشاعر حسين عمر شيخان واحدٌ من هؤلاء المجددين المبتدعين, أفتعامل قصائده عند جمعها وتنسيقها في ديوان معاملةَ التقليد والاجترار؟ أحسب أن ذلك لم يكن لائقًا به وبشعره.
سقوط خمس قصائد بحالها كاملة من الديوان المطبوع على الرغم من وجودها مطبوعة بالقرص المدمج الذي قدمه الدكتور الصيغ للناشر وللطابع معًا. وعندي دليل ذلك. والقصائد الخمس هي (أنظل نلهث/ سد بمأرب/ الوجه الآخر/ مكاشفة/ شهران في الظلام). وجاءت قصيدة (سمراء) منهوكة الأبيات حيث ثبت منها بيتان هما:
سمرتك الخمرية الآسرة
تزهو بها الدنيا على الآخرة
تعصر فيك الشمس ألوانها
والحور لا تلفحها الهاجرة([3])
وسقطت ستة أبيات كاملة لسبب مجهول.
وتلك القصائد هي ممّا تجب عودتها من تيهها فيجتمع شملها في نسق الديوان مع القصائد الأخر.
ج- أخطاءٌ في ابياتٍ وردت في قصائد الديوان لم يصوبها نظرٌ, ولم يصحّحها قلم. فجاءت على مستوياتٍ من الخطأ منها العَروضي, ومنها النحوي, ومنها الصياغي. ولقد كان في الإمكان تصويبها ولكنه لم يتم, وبقي الخطأ ولمّا يَزَلْ.
جاء في الديوان صفحة 15:
| وتلملم الطين المبعثر وارتمى خلف الرداء يصول حيث يشاء |
وصوابه: الغيم؛ لأن الحديث عن الغيم الذي عرّى السقاءة.
وفيه صفحة 16:
| وعوت شراهات الجماد, وسابقت خطوي الدروبَ كأنها أحياء |
وصوابه: الدروبُ. فالدروب تسعى للوصول إليها قبله. وهذا من بعض طرائق الشاعر في تشكيل الصورة الاستعارية, وسنراه.
وفي صفحة 26يقول الشاعر:
| فكيف نبقى كما كنا بموطننا قبل التحرر في الاوطان أغرابُ |
وصوابه: أغرابا؛ لأنها منصوبة على الحالية بالفعل (نبقى), وواجبة النصب لأنها خبر (كنا).
وفي ص 28-29 جاء قوله:
| لا تحاولْ أن تستقيم لتنجو كيف تنجو والظرف جدّ عصيبُ من فناء البذور يا ضيّق الأف قِ يجيء النماء جدّ خصيبُ |
هذا لأن روي القصيدة هو (الباء المضمومة). لكن الصواب كسر الحرفين (الباء) في البيتين كونهما في موضع الإضافة.
وجاء في ص31:
| عامان! هل أقوى! أراني عاجزٌ عن حملهن, تمزقت أعصابي |
وصوابه: أراني عاجزاً عن حملهما. ولكنه آثر اليسير على العسير, ولم يحرص على تنقيح النص.
وفي ص36:
| ارقصي وارسلي قوامك زلزالا يهز الوجود من رقصاتِهْ |
وصوابه: وأرسلي؛ لأن ماضيه رباعي (أرسل), وهمزته همزة قطع لا تسقط في درج الكلام. ولكن بقاءها في الكلام يكسر الوزن, فأجراها مجرى الفعل الثلاثي الذي همزته في الأمر همزة وصل تسقط في درج الكلام.
وفي ص 46:
| لستَ الغبيَّ. وليس فيك تغابيًا أهو الحياد؟ فكيف عنه تحيد؟ |
وصوابه: تغابٍ؛ لأنها في موضع اسم (ليس) المرفوع. ومعلوم أن الاسم المنقوص يحذف ياؤه عند الرفع أو الخفض.
وجاء في ص 48:
| أحبك لا أدري ماذا أحس | ولا أدري من أين هذا الشذا؟ |
البيت من بحر (المتقارب), وله ثماني تفعيلات كلها على وزن (فعولن) وما يمسها من زحاف وعلة. لكن ليس في تفعيلاته (مفاعيلن) التي وردت في حشو الشطرين. فهذا كسر عروضي لا يخفى على القارئٍ. ومع ورود البيت في مخطوطة الشاعر على ذلك النحو, فإن إصلاحه متيسر. وذلك باستبدال (لم) بـ (لا). فتغدو رواية البيت على النحو التالي:
| أحبك لم أدر ماذا أحس | ولم أدر من أين هذا الشذا؟ |
وبهذا يستقيم وزن البيت. أما استخدام (الذال) في موضع (الدال) في كلمة (الشذا) لتتسق مع الروي في أبيات القصيدة فتأويله عندي أن الشاعر أجرى نطقه بها مجرى العامة من أهل (المكلا) الذين يقلبون (الذال)(دالا) فيقولون في (هُوَذا):(هُوْدا) مع الإمالة في اسم الإشارة, فغدت (الشذا) (الشدا).
وجاءت في ص55 مقطّعة أو قل نتفة من أربعة أبيات, وزنها بحر السريع, ورويّها (الدال المقيدة), وعنوانها (مندوبها). ومطلعها:
| مندوبُها السامي قد جاءني | قدّم أوراقكِ للاعتمادْ |
ورواية البيت على النحو المثبت في الديوان ذبحٌ لرقبة (الخليل) بمدية مثلومة.. ولم يسلم من ذلك المصير (سيبويه) على جلالة قدريهما. فهناك كسرٌ عروضي في الشطر الأول تمثل في قوله: (السامي قد), فليس له صلة بتفعيلة (مستفعلن أو مستعلن) التي تجيء في حشو بحر السريع. وصوابه:(السامي الذي) فيستقيم الوزن. وهنالك خللٌ في التركيب تمثل في توزّع الضمائر, ففي المفتتح جاء ضمير الغائبة, وفي حشو الشطر الثاني جاء ضمير المخاطبة, فانتفى الاتساق في شطري البيت.
والصواب: إجراء (مندوب) مضافا إلى ضمير المخاطبة ليستقيم النسق بين أول البيت وآخره. وبهذا تصح رواية البيت على النحو الآتي:
| مندوبُك السامي الذي جاءني | قدّم أوراقكِ للاعتماد |
علما أن الأبيات جميعها ليست بذات شأن في تجربة الديوان.
وجاء في ص 82:
| عيناي كالمرصد تطوي المدى | تمرق عبر الموصد المغلقِ |
وهنا يختل التركيب من حيث التطابق بين الفعل والفاعل. فالعينان اسم مثنّى, والفعل (تطوي) يدل على اسم مؤنث مفرد. والصواب أن يكون التركيب عيناي تطويان. لكن الوزن ينكسر, فآثر ما صنع. مع أن من اليسير توحيد الفاعل والفعل من حيث العدد فتغدو (عيناي) (عَيْنِيَ) بتحريك ياء المتكلم ليستقيم الوزن وتصحّ بنية الكلام. مع أن للتركيب تأويلا آخر تصح به بنيته كما جاءت في النص يسعفنا به (تشومسكي) وعناصره التي بها تتحول الجملة في النص. ولكنّ لهذا مقامًا آخر غير هذا المقام.
أما همزة الوصل التي استحالت في مظانَّ كثيرة من الديوان همزة قطع فحدِّث عنها ولا حرج. ولكثرة ذلك اكتفي بالإشارة عن تفصيل العبارة.
وحسبي ما ذكرت من كل تلك الشوائب, وأشباهها أخرى لم أذكرها اختصارا للقول فيها, لأنّ بي توقًا للحديث عن خصائص لغة شعر الديوان, ومميزاته الأسلوبية. وسأبدأ بأولها:
هواجس شفّ عنها القصيد:
لا بد للذات الشاعرة من محمول موضوعي تصدر عنها أشعارها حتى ولو لم يكن للشعر من وظيفة – في منظورها – سوى أن يكون شعرًا صافيًا محضًا ولا غير. فإذا كانت اللغة علامات, ولكل علامة دال ومدلول, وأساس الشعر علامات لغوية, فلا مهرب من ان تكون له دلالاته المتعددة.
والشاعر الذي كانه السيد حسين عمر شيخان دنا في شعره من منظور الشعر الصافي فتعددت صور المرائي في قصيده وتنوعت, واكتفى منها بأن يتلمس ملامح الحسن والجمال ومواضعه فيها فَشُغِلَ بها دون اكتراث بقبحٍ, أو وضع اعتبار لأعراف, أو حرص على تلمّس أبعاد فكرية غير البعد الجمالي الذي يتخلق في نفسه وتشف عنه القصيدة التي ينظمها في هذا الهاجس أو ذاك. فلا غاية له من شعره إلا الجمال الذي رآه, وتعبيره عنه في صفاء لغة وبهاء تشكيل. إنه كعمر بن أبي ربيعة الذي وصف نفسه بأنّه (موكّل بالجمال يتبعه حيث هو). فقد كان حسين شيخان موكلا بالجمال يتبعه إن وجده, وينقب عنه ما توارى عنه فيبرزه ليعبر عنه ويجلو صورته كائنا ما كان ينبوعها, امرأة ارستقراطية من علية القوم, أو (مستقية) من سفلتهم. إن ما يشغله هو ما يمور في وجدانه, ويرتعش به فؤاده من حب للجمال, فلم يشغل بمصدره, ولم تكن به حاجة إلى الانصراف عن التعبير عنه إلى غايات وظيفية ينشغل بها المجتمع سياسية كانت أم اجتماعية, ولم تهمه مشكلات فكرية في الحياة والإنسان يتأملها فقد كان في غنى عن ذلك كله, وكفاه انشغاله بالجمال الذي يراه ويعبر عنه في شغف واحتدام واحتشاد.
| نغمٌ من مسارب “الصيق” ينساب شجيًّا إلى معابد نفسي |
| يغمر الروح بالصفاء وبالوجد وسحر الرؤى يهدهد حسي |
| والقوافي تطلّ من بين جنبيَّ ومن خلفها ملامح يأسي |
| أوقدي لي الشموع, واستمعي شعري, وهاتي إليَّ خمري وكأسي |
| واسنديني إلى ذراعك, فالأوزان سكرى, تموج داخل رأسي |
| وامسحي جبهتي لكي يستعيد العقل ما ضاع من شعوري وحسي |
| فنفوس الأصيل يد فنها الليل, وفيها آثار يومي وأمسي([4]) |
والسبب في ميل الشاعر إلى هذا الاتجاه الإبداعي هو انسرابه إلى إطار ثقافيٍّ راقَ له منذ بدء اكتشافه هذه القدرة على كتابة الشعر ونظمه في نفسه, وأعني وقوعه مأسورًا في أدب أوسكار وايلد وشعر نزار قباني, وشعراء الغزل في عصر بني أمية – خاصة – من أمثال عمر وجميل والقيسين وعروة بن أذينة والأحوص وغيرهم من شعراء ذلك العهد.
سيقول قائل: إنّه إذًا الإيغال في مفهوم (الفنّ للفنّ). وأقول: إن ذلك ليس ببعيدٍ عنه مادام خيرُ من تأثّر بهم, وترسّم خطاهم يصدرون في إبداعهم عن مثل ذلك المنظور, ويشفّون عنه في ما ينتجون من أعمال أدبية. ومن قرأ المقدمة النثرية التي دبّجها الشاعر نزار قباني لديوانه الثاني (طفولة نهد) يدرك ذلك. ولهذا الديوان أثره الظاهر على كثيرٍ من قصائد حسين شيخان إنْ بالمعارضة الصريحة, وإن “بالتناص الأطراسي”.
ولقد كان في مقدور الشاعر حسين شيخان أن يصوغ منظوره للشعر في بيان مقروء ولكن انشغاله بإبداع الشعر والتفنن في أداء قصيدته صرفه عن بلورة منظوره للإبداع يحدد به مفهومًا, ويجلو به رؤيةً فاكتفى من ذلك بمضمون مقولة الفرزدق المشهورة: (علينا أن نقول وعليكم أن تتأوّلوا).
ولقد قال حسينٌ مُحْكَمًا وبديعًا من القول, وآن لنا أن نتأوله تحيةً لشعريته وتقديرًا لها.
أفضت بي قراءة قصائده التي احتواها ديوانه الموسوم بـ (الغيمة التائهة) إلى الوقوف على الهواجس التي تدل عليها المسميات التالية:
وسأبدأ بالحديث عن أولها, وهو:
الموقف من المرأة:
لم تكن المرأة موضوعًا اجتماعيًّا أو ثقافيًّا ينشغل به الشاعر حسين شيخان فيدافع عن مشكلاتها وقضاياها, فما كان من الشعراء المعنيين بمجتمعاتهم, ولا بالتأمل في الحياة وإنسانها, ولكنه كان شاعر ذات تهيم بالجمال بعيدًا عن الأعراف والأخلاق الموروثة متحرّرًا من قيودها. فلم يشغله من المرأة إلا ما كان يراه ملمحَ حسنٍ وموضعَ جمالٍ. فإذا هام الشعراء بوجوه الحسناوات اللاتي زهاها الحسن أن تتقنع كما قال ابن أبي ربيعة شغف حسين شيخان بعجيزة المرأة ونهدها, فانْشَدَهَ بهما عن كل شيء سواهما:
| عبر المضيق وفيه لامس ما اشتهت أرض, وما اجترأت عليه سماءُ ولوى بغلمته النهود ولفّها وعلى العجيزة قلّ منه حياءُ وتفتح الجسد الشهيّ, تدافعت منه الربى, وتواثب الإغراءُ وعلى ارتجاجٍ عاصفٍ وموقّعٍ رقصت أراجيح الصبا العذراءُ([5]) |
| ماذا أتى بك؟ قلت خلفك ها هنا بذخٌ مطلُّ |
| هذا الشقيُّ الداعر الرعاش خلفك مستغلُّ |
| يدعو فينزلق النهار ويرتمي غيمٌ وطلٌّ |
| أرجوحة سكرى لها لحني عوى واحتد طبلُ |
| عجز يموح هنا وراءك ماله في الناس شكلُ([6]) |
| يا نهدها على فمي | يعصر كرم الموسم |
| أمتصّ من حلمته | أشهى نبيذ العالمِ |
| ألـفّـه أديـره | كأنني لم أفطم([7]) |
| مهزهزة العجز لا توقفيه | فقد هز ذقنا وأسقط عمة |
| وخليه أرجوحة, فالقفيه | تدلّه فيه اشتهاءً وغلمة |
| وثوري مع اللحن ردفا وخصرا | وهزي له الصدر سفحا وقمة([8]) |
| … … … … … .. | وعجز عوى عند الزفين له حجل([9]) |
إلى آخر ما هنالك من ذلك.
وإذا كان (النهد) عند نزار (معجمًا) خاصًّا به لا تكاد تخلو منه قصيدة فإنّ (العجز) عند حسينٍ معجمه الخاص الذي تشف عنه لغة شعره. على أن هذا جزيئ من بنية كلية يتراءى فيها موقف الشاعر من المرأة كما جلته قصائده فيها.
وحسين شيخان شاعرًا صانعُ صورٍ يتلقط جزئياتها ويلونها فتغدو لوحات مبهرة, لكل لوحة ألوانها وأضواؤها وظلالها وخطوطها المرسومة. فتنوعت لذلك صورة المرأة في شعره, ولم تجيء على حال واحدة ولا على هيئة مكرورة.
فهو تارة يسمو بها إلى مرتبة التقديس فيرى في صوتها (رنين أجراس السماء), وهو (صوت سماوي= صوت ملائكي) في همسه ورقة جرسه, لكنه لا يخفي تردده في نسبة ذلك الصوت إلى السماء فأعاده إلى الأرض دون أن يخليه من ذلك الجلال فجعله (ميراث جد لك في الأنبياء), ويعلل هذه النسبة بقوله:
| لا بد للتبليغ من نبرة | مقنعة جاءتك بالانتماء([10]) |
ثم يعود فيزيد صوتها ارتباطا بالأرض فيجعل للشعر حظا موفورا من التقدير إن هي صدحت به, فهو (يرقى ولو كان رقيق البناء), ويغالب الفناء ما دام يمتص منها رحيق البقاء, ولقد قادته هذه (الأرضية) إلى تلمس وقع صوتها في نفسه فإذا هو:
| أحس إذ ينساب في داخلي | بأنّني في ذروة الانتشاء([11]) |
هنا تتحوّل المرأة إلى صوت يسحر بنبراته وتميّز نطقه لمخارج الحرف, وتستحيل الذات الشاعرة أذنا تترجم كل معاني البهاء والجلال في ذلك الصوت, وتغدو حالة اللقاء بالمرأة انتشاءً روحيًّا لا صلة له باشتهاء ولا رغبة محتدمة في اتصال جنسي, ومن هنا سمت في وجدانه إلى مرتبة التقديس. وإذا كانت القصيدة منظومة في شخص بعينه فقد غدت في عين الإبداع مفردًا بصيغة الجمع, وأضحى العلم اسم جنس لنظائر من أشباهه. وإذا كانت (السامعة) هي وسيلته في استبيان سموّ صوت المرأة وجلاله في القصيدة السابقة فإن (الباصرة) هي وسيلته في قصيدته (سمراء) حين رأى فيها حسنا أرضيا يتعالى على الحسن السماوي, فتقدس الأرضي بتميزه بعنصر خاص لا وجود له في الجنة, وهو (الشمس) فالله قد نزّه الجنة منها فقال مخاطبا آدم عليه السلام: “فقلنا يا آدم إنّ هذا عدوٌّ لك ولزوجك فلا يخرجنّكما من الجنة فتشقى. إنّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنّك لا تظمأ فيها ولا تضحى.” طه: ١١٧ – ١١9. ومن هنا غدا ما هو مصدر شقاء للإنسان منبع جمال يهب الحسناء فرادتها بسمرتها, وتغدو سمرتها حافزًا على الزهو, فيتعالى الأرضي على كل شيء يناقضه:
| سمرتك الخمرية الآسرة | تزهو بها الدنيا على الآخرة |
| تعصر فيك الشمس ألوانها | والحور لا تلفحها العاصرة([12]) |
ولقد غدت (سمراء) شيخان (جالاتيا) أخرى انبهر بها خالقها, وهو عندي هنا الشاعر نفسه الذي اكتشف ذلك الجمال الساحر الكامن في سمرة المرأة التي رأى فجلاه في أبيات قصيدته مثلما انبهر (بجماليون) بجمال تمثاله (جالاتيا) فتضرع للآلهة أن تحيله أنثى حية لينعم بأطايبها. وهنا بدا الأرضي مقدّسًا لأنه صنع الخالق البارئ المصور الذي تتكامل مخلوقاته لتصنع للوجود جمالا لا تدركه إلا باصرة وعت بهاء الجمال وروعة الجلال فيه.
| يا سمرةً يغسل أطرافَه المغربُ في صبغتها النادرة |
| بهرتِ بالسمرة حتى اليدَ المبدعة الخالقة الماهرة([13]) |
واتحاد الطبيعة بكل صورها, ينابيع تتفجر من الأرض فتنساب على سطحها, أو ضفاف تترقرق بين صخورها أمواج بحر هادئ ساج ينشر عليه الفجر أنواره الخافتة وتفوح الأزهار فيه بشذاها والندى يتقطر عليها باردا فتتفتح النفس عند خرير الماء ليملأها سحر وجمال وجلال. هذه الطبيعة حين تتحد بحسن المرأة وبهاء جمالها تفجر في الذات عشقا تتحدى به عاديات الزمان. وتغدو الحياة شبابا خالدا لا تنال منه كهولة ولا تبيده شيخوخة:
| تعالي نعش عند نبع الحياة | على السفح أو في أعالي القمم |
| فنمتص منها رحيق الخلود | ونقوى على عاديات الهرم |
| ونمضي إلى ما وراء الحياة | وننفذ خلف البلى والظلم([14]) |
وهنا تستحيل الطبيعة موضعا للقداسة, ويصير (الهوى) سموا على الغرائز والشهوات بل وتغدو (المحبوبة) مصدر طهر للذات وللمكان في هذا الوجود:
| تعالي إلى معبدي في الضفاف | ليحيا بأنفاسك المعبد([15]) |
وتلك حال من العشق لا يضيرها تناءي الديار وتباعد العاشقين ما دامت (المحبوبة) نائية بجسدها ولكن روحها في فكر الذات الشاعرة العاشقة وشعرها:
| أنت تحيين في ربى (الديس) بالجسم, وبالروح أنت في أشعاري |
| أتملى سناك في كل بيت من قصيدي فتنثني أفكاري |
| وتطلّين من خلال رؤى ذهني معاني تفيض بالأسرار([16]) |
لكن هذه (الرومانسية) التي تمنح (المرأة) قدرة على منح الوجود الذاتي صورا مملؤة بالسحر والفن والهوى والدلال لم تمنع الذات العاشقة من تمني لحظات من الوصال الذي يطامن من جيشان الهوى واحتدامه في النفس, فكانت أمنية لا تقوى على تحقيقها قدرة أرضية كائنة ما كانت قوتها:
حداد يا ليت لي كالضوء مقدرة
أنسل عبر ضفاف الأفق في الوادي
أنساب في الديس في محراب ملهمة
أرتل الحب من شعري وإنشادي
وأحتسي القبلة العذراء في وله
تهفو على شفتيها للفم الصادي
وأرتمي في ذراعيها على حلم
أضمه بحنان الشاعر الشادي([17])
ولأن الحب يمنح العشاق طاقة على اجتراح ما لا يقوى على اجتراحه سواهم فقد هتف الشاعر في لحظة انفعال محتدمة قائلا:
| ستظل عيناها تلاحقني | حتى ولو قد لفني كفني |
| سأفر من نعشي أودعها | وأعود, لو جاءت تشيعني([18]) |
وتلك حال من الشجن يفضي إلى أحلام لا يستطيع لها تحقيقا. وهو قول لا يخفي هوى عارما وإن اشتط في تخيله فجاء على هيئة لا يقوى على قول مثلها جميل أو المجنون.
في تلك القصائد الثلاث, ومن أمثالها (شباك/ ويدك/ واحتراق), تسمو المرأة إلى مرتبة سامقة لا تطالها شهوات عربيدٍ ولا بذاءة ماجنٍ لكن الذات الشاعرة المتوثبة في أعماق حسينٍ ما كان لها أن تقر على حال فكان لابد لها من حال يحول إلى النقيض فتعوي داخله الشراهة للجنس اشتهاءً وتتدفق في شرايينه رعونةً لا يستطاع كبتها أو الحد من عرامها.
| أسعى وراءك لا أَكِلُّ وشموخُ نفسي مستذلُّ رحالة هيمان بعدك لا يحد هواي عقلُ رشد الكهولة قد قبرت وها أنا ذا اليوم طفلُ ولكم تعثر بي الطريق وزلَّ بي قدم ورجلُ وتشققت قدماي أدماها من الأشواك غلُّ([19]) |
تلك المعاناة لا باعث لها سوى (الداعر الرعّاش خلفها يستغل هواه فيذل شموخه).
| هذا المزرزر قَد ثوبك, متُّ إن في الصرم غزلُ |
| أنا خلف هذا الثقب مهما قال عني الناس نذلُ |
| سأظل خلفك لاهث الأنفاس, ما للناس دخلُ([20]) |
وإنما المرأة هنا (حطّابة) تحمل فأسها إلى الوادي لتحتطب منه ما يمكنها جمعه وبيعه لتقتات بثمنه وصغارها, ولكن عينا في الوجود رأت فيها الجمال الذي لم يره سواها فكانت صورة للحطّابة صيغت شعرا يؤكد أن لا قيمة للموضوع في ذاته وإنما العبرة بالقدرة على الصياغة وحسن الأداء. ومن بابها (المستقية)([21]), وهي أوغل في التخييل الشعري, فالشاعر قد رأى في قربة الماء المحمول على ظهر المرأة غيومًا تتجمع فينسكب منها الماء فيبتل ثوبها فيشف عن خفايا من جسدها لم تعد مستورة فيشب اللهيب في أعماقه اشتهاءً واغتلامًا.
عرّاك غيم شف منه رداء ::: شهقت له سحب فساح فضاء
وتلملم الغيم المبعثر وارتمى ::: خلف الرداء يصول حيث يشاء
عبر المضيق وفيه لامس ما اشتهت ::: أرض, وما اجترأت عليه سماء
ولوى بغلمته النهود ولفّها ::: وعلى العجيزة قلّ منه حياء[22]
والمرأة في كلتا القصيدتين موضوع اشتهاء لم يتحقق بفعلٍ فاستحال إلى قولٍ يجسد أمنية ويبرز حلما:
ودنوت للغيم الرضيع وفي فمي:: شبق, وتلهث داخلي الصحراء
ووقفت أستسقي السماء تصابيا :: كيلا يجف على الرداء الماء[23]
ومن المفارقات في شعر حسينٍ أن المرأة التي سما بها إلى مرتبة التقديس في (أسماء) و(سمراء) و(شباك) هوى بها إلى مرتبة الإزدراء في والاتضاع في قصيدة (المساواة). وإذا كانت المرأة في تلك القصائد مخصوصة بذات واحدة هي المعنية بالقول, فإن المرأة في هذه القصيدة مطلقة التعيين, يدلّك على ذلك المنادى (يا امرأة) في هيئة (النكرة غير المقصودة) ليفيد منه معنى العموم, فشمل خطاب القصيدة المرأة مخصوصة وغير مخصوصة بالذكر.
وهنا يقيم الشاعر تقابلا ضديا بين (أنثى) يمثلها ضمير المخاطبة (أنت,) وبين (ذكر) يمثله ضمير المتكلم (أنا). أي بين امرأة ورجل, بين فرع وأصل, في جدل يقوم على حال من الترفع والعنجهية ورفض مقولة (المساواة) بين الجنسين.
أتراه في هذا يعكس موقفًا اجتماعيًّا لم يزل سائدا في حضرموت وفي بعض البلاد العربية فينظر للمرأة على أنها (مرذولة) لا قيمة لها سوى كونها موضوعا للشهوة وممارسة الجنس وما أشبه هذا من فعل حقير ممتهن وإن صعدت في المجد إلى مراقٍ سامقة عزّ على رجال صعودها؟
هذا ما يمكن استنتاجه من حججه التي رام من خلالها توكيد تفرده وألمعيته, وتجاوز مبدأ المساواة بين الجنسين. فالرجل حامل رسالات السماء أما المرأة فَمَبِيْضٌ ووعاء يحمل لقاحاته, ويضخ فيه سكان قاراته:
مازلت ألمع ذهن فوق قارتنا :: وأنتِ لم تبلغي أدنى التماعاتي
حملت كل رسالات السماء أنا :: وأنتِ لم تحملي إلا لقاحاتي
ما أنت إلا مبيض لي وأوعية :: أضخ فيها أنا سكان قاراتي
لذائذي وحدها قد أخرجت أمما :: بقاؤها الأن مرهون بلذاتي[24]
لقد ملك بصفته ذكرا الكون كله فتضخم وجوده فيه, وأخلاها من كل حق في امتلاك العالم حولها فانتفى وجودها إلا ما شاء أن يعطيها فغدت بعض أملاكه التي لا يحقّ لها حقٌّ ولا يوجد لها وجود مادام ههو أصل الوجود, لذلك فالمساواة مستبعدةٌ في خلده, وأنى لها أن تكون؟!
كيف المساواة والعادات تفصلنا
فعادة الشهر ليست ضمن عاداتي
وفي الحضانة ما يلهي موظفة
من أن تنافس في الإنتاج حالاتي[25]
والقصيدة تحمل شجنًا نفسيًّا وفكريًّا في آن. فلقد جاءت دعوى المساواة بين الجنسين من أبواق سلطةٍ حاكمةٍ للشاعر موقفٌ رافضٌ منها وإن لم يجهر به يومذاك. فاتخذ من تلك الدعوى موقفًا معاديًا وانبرى ضدّها صوتًا حرًّا ينقضّ على جوهرها ليفتته أجزاء فيتلاشى فلا تقوم له قائمة. إنه موقف من السلطة في دعوتها للمساواة بين الجنسين, وليس هو موقفًا من المرأة في ذاتها. فضاع الجزئي (البريء) في الكلي (المتهم). ألم أقل لك إنها من مفارقات شاعر شغله انفعاله بالفكرة أشد انشغال؟ إنه ليس عدوًّا للمرأة كالذي قيل في وصف (العقاد) أو (الحكيم). والدليل على ذلك نصوصه التي يعترف فيها بأن المرأة ملهمته, وينبوع إبداعه, وهي التي يسمو بها في قصائده إلى منازلَ ساميةٍ تنبئ عن توقير وتقدير. لكنه الرفض القار في أعماقه للسياسيّ في بلده في ذلك الزمن, وقد عجز عن منا فحته مواجهةً فاكتفى بمداراته حبًّا في البقاء, وحرصًا على السلامة من الأذى.
سيقول قائلٌ: ولكنك لن تعدم في بعض قصائده غضبًا محتدمًا ينفثه في وجه امرأة مثل (البرنسيسة), فعلا عليها بصوت ذكوريٍّ نسي فيها أنوثتها فخلا من رقة وحنان.
والحق أن قصيدته الموسومة بذلك الاسم تنبئ مرجعيتها السياقية إلى عشق كامن في طوايا النفس, خبرته الذات زمنًا وأمّلت منه ثمارًا حلوةً مشتهاةً. لكنّ أملها خاب, وزفت المرأة لآخر لا يلائمها, فرام منها وصالا ينتهك به أعرافًا ويستبيح قيمًا اجتماعية ودينية انصياعا لنزوات الهوى وانطلاقات الغرام في فضاء الإباحة, فتأبت عليه معتصمة (بزوجها) الذي لا تقيم له الذات الشاعرة شأنا إذ تراه لا شأن له غير انه تاجر من التجار. فجن جنونه وانبرى يهجو ذلك الزوج ويزدريه انتصارًا لذاته المجروحة وعشقه المسفوح. وأنت تلحظ ذلك من النواتج الدلالية لدوال النص, فهو (جبان) [ أول من يفر/ يرتعب من رؤية ظل الشاعر ناهيك بشخصه] وهو(مصاص دماء) [ شبلوك/ جشع/ يقتات من جهد المقل/ يكدس الأرباح ] وهو (مزدرى) [ رقعت بجلده ثقوب نعلي/ بصقت عليه وندمت لإهانة تفلي]. وهو (غبي لا عقل له يعي به فوارق المعاني) [ لم يدر فرقا بين أنملة ونملي/ لا يفرق بين مغلول ومغلي]. وهو من الضعف أنه (يكفيه لسع قملي) ليفنى. وتلك نظائر دلالية تمنح نظيرة دلالية واحدة هي أن هذه المرأة أعلى شأنًا وأسمى مقامًا من ذلك الزوج. لذلك يتحول الاستفهام إلى حال من الاستنكار والتعجب ويبعث على الدهشة والاستغراب:
تتوعدين بزند أول من يفر ومن يولّي؟
وتهددين بمن سيجبن لو رأى في الدرب ظلّي؟
أبزنده تتوعدين ؟ فحاذري كيلا تضلّي
أتهددين بمن رقعتُ بجلده أثقاب نعلي؟[26]
والجملة في البيتين الأولين محولة عن (الخبرية) بعنصر من عناصر التحويل وهو (التنغيم) كما علم تشومسكي.
هو إذا غضبٌ عارمٌ محتدمٌ على الرجل الذي حال بين عاشق ومعشوقة. وتلك تجربة في الشعر تذكر (بالأحوص) الذي كان يهوى اخت زوجته ويكتم هواها في نفسه حتّى آن لأهلها أن يزوجوها فزفت لمن لم يكن كفيًّا لها, فغضب الشاعر الأحوص (حين بلغه الأمر) فأنشأ يقول:
أإن نادى هديلا ذات فلج :: مع الإشراق في فنن حمامُ
ظللتَ كأنّ دمعك درُّ سلكٍ :: هوى نسقًا وأسلمه النظامُ
تموت تشوّقًا طربًا , وتحيا :: وأنت جَوٍ بدائك مستهامُ
كأنك من تذكّر أمّ حفصٍ :: وحبلُ وصالِها خلقٌ رمامُ
سلامَ الله يا مطرًا عليها :: وليس عليك يا مطرَ السلامُ
كأنّ المالكين نكاحَ سلمى :: غداةَ يرومُها مطرٌ نيامُ
فإن يكن النكاح أباح شيئا :: فإن نكاحها مطرًا حرامُ
فطلقها فلست لها بأهل :: وإلا عضَّ مفرقَك الحسامُ[27]
ولا مراء في اختلاف شكل التعبير في القصيدتين عن التجربة, لكنك لا تعدم شيئا من التشابه في الاحساس بغبن المرأة حين تزف لمن لا يليق بها كفاءة, ومن هنا اشتعل غضب الشاعرين, وكشف غضبهما عن هوى مستكن في الأعماق.
على أن فلتة لسان انزلقت إلى قصيدة حسين في آخر بيت في القصيدة, وهو قوله:
ما كان أول من أتاك :: وهل أتاك الآن قبلي[28]
وهذه نفحة من قصيدة (نزار قباني) وعنوانها (امرأة من زجاج), وفيها يقول:
هذا الذي يسعى إليك الآن لا أرضاه عبدي
يكفيه ذلًّا أنه قد جاء ماء البئر بعدي[29]
وبين القصيدتين تشابه في مظان, وتمايز في مظان به تستقل لكل قصيدة بصمتها الاسلوبية رغم تشابه المنظور.
وفي الديوان قصائد اخرى تبرز فيها مواقف للذات من المرأة, منها ما هو إنسانيّ كما في (استغاثة), ومنها ما هو بلاغ للناس عن خلق الذات الشاعرة وسموّ قيمها كما في (حتى أنت يا جالاتيا), ومنها ماهو غير هذا وذاك. وفي كل تلك القصائد أولاها وأخراها لا تبدو المرأة في شعره قضية اجتماعية ولا مشكلة ثقافية, فلا حديث له عن حجاب وسفور كما نجد عند بعض شعراء العربية في عصرها الحديث, وقصيدة شوقي الموسومة بعنوانها (صداح) واحدة من قصائد أخرى كتبها شعراء آخرون في مثل هذا الموضوع. ولا حديث يحث فيه على تعليم المرأة والسعي إلى خلاصها من آثار الجهل وتبعاته كما نجد في شعر شاعر كحسين البار. ولا هو يقف بشعره منافحًا عنها ليحميها من عنف مجتمعها ضدها, ويحث الآخرين من الذكور الفحول ذوي النزعة النيتشوية في معاملة المرأة على الرفق بها من حيث هي من القوارير اللاتي وجب الرفق بهنّ. كلا لم يكن شيء من ذلك يشغله ويستميل إليه وعيه ويصدر عنه إبداعه. وإنما ظل شاغله جمالها وحسن خَلْقِها. فتمايُل بُرقعِها يستثير شاعريته, وخلف ثوبها اللصيق بجسدها المرمريّ يشرد عقله, وفي ضحكة ثغرها يسمع اجراس جنة (ترن, فينهار الوقار ويختل). وذلك أقصى ما تفاعلت معه شاعريته وانفعلت به. ولذلك تعددت المرائي والرأي واحد وموضوع الصورة واحد وجوهره.
15/4/2017م
[1]) جاء عنوانها في الديوان (تحت الأمطار) وليس بذاك.
[2]) الغيمة التائهة, حسين شيخان, ط1, 2003م, منشورات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين, ص33. ولم أروِ عجز البيت الأول؛ لأنه مضطرب التركيب, مختل المعنى.
[3]) الغيمة التائهة, ص67.
[4]) الغيمة التائهة, ص148-149. ولاحظ إجراء همزة القطع على أنها همزة وصل (أسنديني). وانظر (الإبطاء) في قافيتي البيتين الثاني والسادس.
[5]) الغيمة التائهة, ص 15.
[6]) نفسه: ص105.
[7]) نفسه: ص113.
[8]) نفسه: ص97.
[9]) نفسه: ص13.
[10]) الغيمة التائهة, ص13.
[11]) نفسه, ص14.
[12]) الغيمة التائهة, ص67.
[13]) هما من الابيات التي سقطت من الديوان المطبوع على الرغم من وجودها في القرص المدمج.
[14]) الغيمة التائهة, ص146.
[15]) نفسه: ص147.
[16]) نفسه: ص149.
[17]) نفسه: ص 54.
[18]) نفسه: ص 134.
[19]) نفسه: ص 102.
[20]) نفسه: ص 106.
[21]) ورد عنوانها في الديوان (تحت الأمطار), وليس بذاك. وإنما الغيم ومطره معادل موضوعي لقربة الماء التي تحملها المرأة يومذاك لتسقي البيوت ماءها. وعنوانها كما ذكر الشاعر هو (المستقية) تماثلا مع (الحطابة).
[22] نفسه صـ 15
[23] نفسه صـ 16
[24] نفسه صـ39
[25] نفسه صـ40
[26] نفسه صــ99-100
[27] طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام الجمحي , السفر الثاني صـ666-668
[28] الغيمة التائهة : صـ101
[29] الرسم بالكلمات : نزار قباني صـ156