نقد
د. طه حسين الحضرمي
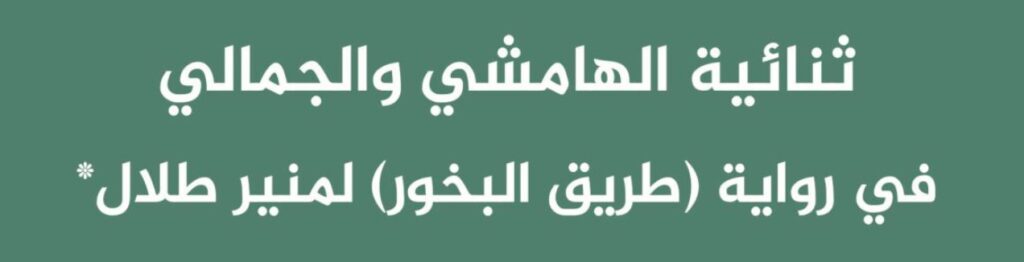

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 18 .. ص 87
رابط العدد 18 : اضغط هنا
مدخل:
ميّزت الشكلية الروسية بين بنيتين في العمل السردي هما: (المتن الحكائي) الفابيولا fibula ([1]). والبنية الأخرى هي ( المبنى الحكائي) السوزيت sjuzhet ([2]).
بهذه الثنائية انفتح باب واسع ولج من خلاله نقاد السرد إلى الدهاليز اللامتناهية للسرد. فشكّلوا من هذه الثنائية دروساً مهمة أعانت على استكشاف هذا العالم الساحر. كما انبثق منها تنويعات ذات مؤشر دلالي في استكناه العمق المعرفي للعملية الإبداعية. وفي استغوار عملية إنتاج الدلالة. لهذا اتسع مجال البحث حولهما بوصفهما وجهي المروي المتلازمين.
فقد ميّز اميل بينفنيست Emile Benveniste (1902 ـ 1976م) بين ثنائية (الحوار) و(السرد) التي كان لها تأثير بيّن على النظرية الأدبية ([3]). ثم جاء سيمور تشاتمان Seymour Chatman (1928 ـ 2015م) ليميّز بين (القصة) و(الخطاب) في إطار حديثه عن مشكلات وجهة النظر في الرواية. فالقصة عنده هي سلسلة الأحداث وما ينطوي عليها من أفعال ووقائع وشخصيات محكومة بزمان ومكان معينين. أما الخطاب فهو التعبير عن تلك الأحداث. فخلص بذلك إلى أن القصة هي محتوى التعبير السردي. والخطاب هو شكل ذلك التعبير ([4]). ثم تعددت المصطلحات التي استخدمها نقاد السرد للدلالة على هذين المفهومين.
فالقصة تثير في الذهن واقعاً أو أحداثاً قد وقعت وشخصيات روائية تختلط من هذه الوجهة بشخصيات الحياة الفعلية. أما الخطاب فيهتم بالأحداث من خلال الكيفية التي يلجأ إليها السارد. وعلى هذا الأساس ليست الأحداث التي يتم نقلها هي التي تهم. وقريب من ذلك فعل جيرار جينيت ([5]) حين ميّز بين مستويين في العمل السردي هما (الحكاية) أي محتوى الرواية. و(الخطاب) أي كيفية تشكّل هذا المحتوى في العملية السردية.
المادة الحكائية هي أقل مكونات الرواية شأناً؛ لأنها نابعة من خارج النص الروائي. فهي تتقبل أنواعاً من التشكيل شتى تتعدد بتعدد كتّاب الرواية ومبدعيها. ومن هنا عُدّت (هامشاً) يتنامى في تضاعيفه (الجمالي) ([6]).
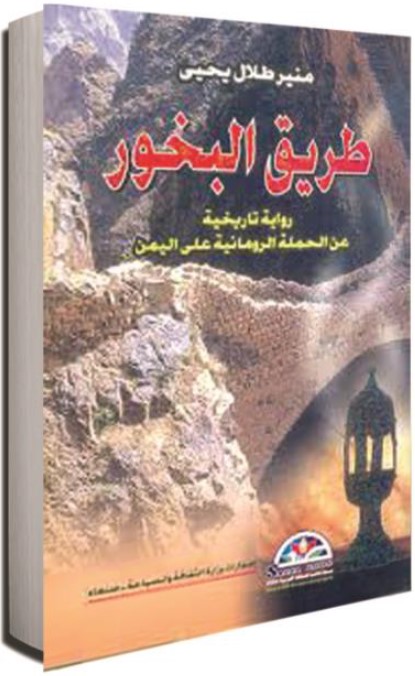
أما الخطاب فهو المعوّل عليه في الدراسات السردية الحديثة؛ لأنه الكيفية التي بها يشكّل المبدع حكايته. فهي التي تميّز مبدعاً عن آخر. وفيها تتجلّى عبقرية الروائي.
عندما ندرس رواية ذات مادة حكائية مستقاة من التاريخ ينبغي أن نكون على علم بقوانين الهامشي في الفن. مع العلم أن الهامشي وضع غير جمالي مرتبط بالفن ارتباطاٌ غير سببي- على حد تعبير فيكتور شكلوفسكي([7])- بيد أن الفن لن يتخلق دون مادة خام منبثقة من ذلك الهامشي. فالرواية التاريخية يتنازعها هاجسان: ([8]) أحدهما الأمانة التاريخية التي تحتم على الروائي عدم مجافاة ما تواضعت المصادر التاريخية عليه من الثوابت من مثل قيام الدول وسقوطها. واشتعال الحروب والوقائع المأثورة. والآخر مراعاة قواعد الفن الروائي مما يحقق للرواية التاريخية «شرط الانسجام الداخلي الذي يتم من خلال المنطق الظاهر أو الخفي الذي ينتظم مقومات النص المختلقة ويجعل من وحدة بين عناصرها تضامن وتكامل»([9]).
تدور أحداث رواية (طريق البخور) حول مرحلة حرجة من تاريخ اليمن القديم. وهي الحملة الرومانية على اليمن. وتتلخص المادة الحكائية (الهامشي) في الآتي: ([10])
عندما اعتلى أغسطس عرش الإمبراطورية الرومانية من عام 31ق.م وحتى عام 14م. أوعز إلى الوالي الروماني في مصر(ايليوس غاليوس) بتجهيز حملة عسكرية كبيرة بهدف الاستيلاء على بلاد العرب الجنوبية وخاصة مملكة سبأ اليمنية. فقام ايليوس غاليوس بتجهيز مائة وثلاثين سفينة حربية على متنها عشرة آلاف جندي من الرومان والمصريين. فأبحرت تلك السفن من ميناء يقع على الساحل المصري للبحر الأحمر. لتتجه بهم إلى ميناء (لويكة كومة) حيث زودهم ملك الأنباط(عبادة الثاني) بألف جندي من الأنباط العرب وخمسمائة مقاتل من الغوغاء للسيطرة على بلاد العرب الجنوبية. كما عيّن وزيره (سايلوس) أي (صالح)؛ ليكون دليلا ومرشدا للحملة. وبذلك قدّم الملك العربي كل المساعدات المطلوبة ووضع الأراضي النبطية العربية تحت تصرف الرومان الغزاة. فقطعت الحملة مسافة 1400كم من الشمال إلى الجنوب. وسارت في الصحراء مدة ستة أشهر حتى وصلت مشارف بلاد اليمن. وخلاصة الأمر أن الحملة فشلت في تحقيق مآربها فعاد الرومان إلى مصر يجرون وراءهم أذيال الخيبة والهزيمة. وقد عزا (استرابون) سبب هزيمة الحملة إلى الوزير(صالح) الذي غش – حسب زعمه- القائد فأوهمه بتعذر الوصول إلى البر. لعدم وجود العدد الكافي من الجمال ولعدم وجود الطرق البرية الصالحة لمرور الجيش الروماني. وكان هدفه بذلك إضعاف الرومان وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف والمتصرف وحده في الأمور.فلما وصل (ايليوس) بجيشه إلى ميناء(لويكة كومة) – ينبع حاليا- كان المرض قد فتك بالجنود لفساد الماء والأطعمة وسوء التغذية. مما اضطره إلى قضاء الصيف والشتاء فيه. حتى تعافى جنوده فأستأنف مسيره جهة اليمن. فدخل أولا أرضا لم يسمها (استرابون) وإنما ذكر أنها كانت تحت ملك يدعى(الحارث) وكان من ذوي قرابة ملك النبط. فاستقبلهم بحفاوة. ثم استمر الجيش في مسيره حتى وصل إلى منطقة مأهولة بالأعراب يقال لها (عرارين). وهكذا بدأ الجيش في التوغل نجاه الجنوب وفي أثناء ذلك لم يخض معارك مذكورة. فبدأ (ايليوس) في التخريب والتدمير. وبدأت المدن في التسليم دون قتال. قلم تلق الحملة مقاومة تذكر. والحقيقة أن هذه الحملة يكتنفها الكثير من الغموض في تفاصيلها لشحة المراجع التي تذكرها إلا ما كان من أمر(استرابون) الذي يؤكد الدكتور جواد علي أن معارفه عن جزيرة العرب كانت محدودة ([11]). كما يعتقد أن أقدامه لم تطأ أرضا في جزيرة العرب. فليس هناك شاهد يثبت اشتراكه في هذه الحملة. و لعله استقى ما قصه عن الحملة من صديقه (ايليوس).
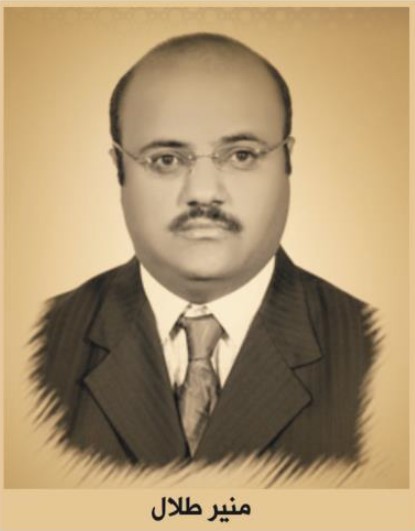
انطلاقا من موجز المادة الحكائية السابقة. نستطيع القول أنها مادة خصبة لإنتاج رواية تاريخية متميزة. والروائي منير طلال كان موفقاً في اختياره هذه المرحلة التاريخية الموغلة في أعماق التاريخ اليمني. بيد أن هناك عدة تساؤلات أبرزها هذان التساؤلان:
– ما الدافع إلى اختيار التاريخ مركباً حكائيا لرواية ما ؟
– وهل لهذا الاختيار ما يسوغه في عصرنا هذا ؟
مما لاشك فيه أن اختيار الروائي لموضوع ما يزيد من توهج شعرية طرائق تشكيل هذه المادة روائياٌ. كما أن تمثل العصور الماضية فنياٌ يشكل إرهاصا لنهضة قومية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك. على الرغم من ذلك فهي تشكل مشكلة تعبيرية يلجأ إليها كثير من الروائيين في عصرنا الراهن الذي يتميز في مجمله بممارسة الإرهاب الفكري ضد أصحاب الأقلام. فيلجأ الكُتّاب إلى التاريخ فيوغلون في خباياه ودهاليزه فيشعلون شمعات باهتة تهتدي بها أعين القراء الحساسة. وتعجز أعين الرقباء عن مشاهدتها فضلا عن الوصول إليها.كما أن الرواية التاريخية قد تحمل في أحشائها تبشيراً أيديولوجياً بفكرة ما تجول في ذهن هذا المبدع أو ذلك. وهذا ما نجده متحققا في بعض روايات نجيب محفوظ وعلي باكثير وجمال الغيطاني ممن امتطوا صهوة التاريخ فيها.
والرواية التاريخية تتسم بازدواجية المرجعية. فالمرجع الأول فيها تاريخي واقعي ناجز. لا يمكن التلاعب بوقائعه تبعا للرغبة. لأنه متصل بحدث تزكيه الوثائق التاريخية المبثوثة في مظانها. أما المرجع الثاني فله صلة وثيقة بالحدث التاريخي وكيفية تجليه في المنجز الإبداعي. وهذا الأمر يجعلنا في قلب تشكل العلاقة بين التاريخي والتخييلي. الذي ينبغي أن يتشكل على وفق معايير النوعية الأدبية. وهاهنا يكتسب الهامشي قانونه الخاص في إطار الجمالي.
فهل استطاع منير طلال أن يُكسب الهامشيَّ قانونَه الخاصَ أو قل قوانينه في الفن الروائي ؟ للإجابة عن هذا التساؤل لابد من جلاء تشكل الفن الروائي من خلال الهامشي الكائن في التاريخ في رواية (طريق البخور). مبحرين معها من خلال أبرز مكونات الجمالي فيها وأعني بذلك: العتبات والراوي والشخصية الروائية والزمن الروائي .
أولا: العتبات :
تشكل العتبات بوابة يلج من خلالها القارئ إلى دهاليز النص. لهذه الرواية عتبة رئيسة هي (طريق البخور) وعنوان فرعي تكميلي (تجنيسي/مضموني) هو(رواية تاريخية عن الحملة الرومانية على اليمن).
للعنوان وظائف معينة نجملها في الآتي: ([12])
– الوظيفة التعيينية/التسموية: يقوم العنوان بتعيين الموضوع وتحديد مضمونه العام وتسميته.
– الوظيفة الإغرائية/التحريضية: يثير في المتلقي كما هائلا من التحفز الاستطلاعي.
– الوظيفة الأيديولوجية: كما يثير في المتلقي عدة أسئلة على المستوى التعبيري والأيديولوجي.
وعنوان (طريق البخور) غامض من جهة ومن جهة أخرى منفتح على المضمون. كما أنه في بنيته اللغوية ثنائي الصياغة يقوم على دالين تجمع بينهما علاقة الإضافة. وبما أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد. فالبنية تتحول من الثنائية إلى الإفراد. وهاهنا غياب صياغي لبعض مكونات العنوان. بيد أننا قد نحتار في تقدير الأصل المفترض لأن العنوان في حد ذاته لا يعين على تحديد نوعية النص. لكن الروائي يمهد لنا السبيل في إحالتنا على العنوان التكميلي المذكور آنفا يعضد دلالة العنوان الرئيس، ويُزيل غموضه، فيتفتح على المضمون مباشرة؛ لأن العنوان التكميلي يصرح بالمرجع النوعي للرواية بشكل عام. وهذا يفقد الرواية وهجها التخييلي. لهذا سنتعامل مع العنوان الرئيس بوصفه علماٌ على العربية السعيدة. وهو يحيل على مضمون الرواية وما يحمله من تأويلات متصلة بالغزو وأطماع الغزاة والمقاومة الفتيّة من اليمنيين التي تنتهي بالنصر ودحر الغزاة. فطريق البخور هو الطريق الذي فتح شهية الغزاة لمحاولة إخضاع بلاد العرب الجنوبية. وهو ما صرح به أحد التجار اليونانيين لإغراء الإمبراطور الروماني قائلا: «إن جنوب الجزيرة أو ما يطلق عليها العربية السعيدة لوفرة خيراتها ولسيطرتها على طرق التجارة البرية والبحرية. هي المنطقة المطلوب السيطرة عليها لأنها المتحكمة بتجارة العالم وثرواته…إذا تحقق ذلك فسوف تصبح الإمبراطورية الرومانية المقدسة في أوج مجدها الاقتصادي والمالي لأنها ستمتلك بلاد اللبان والبخور والبهار » ص6. لهذا كان للعنوان وظيفته التعينية المميزة لإعطاء مؤشر تجاه الأحداث المروية.
أولا: الراوي:
الراوي هو ››أسلوب صياغة أو بنية من بنيات القص. شأنه في ذلك شأن الشخصية. والزمان والمكان. وهو أسلوب تقديم المادة القصصية‹‹([13]). والذي لاشك فيه أن هناك مسافة تفصل بين الروائي(الكاتب) والراوي. فلا يتساويان في الموقع؛ لأن الروائي يتستر بالراوي؛ لتقديم عمله. وقد مرت هذه التقنية بعدة مراحل متغيرة. كان لها تأثير على طبيعة الراوي. تبعا لتطور تقنيات السرد. فبعد أن كان للراوي حضور طاغٍ في القص التقليدي – بتدخلاته السافرة في أثناء القص. وذلك بإلقاء المواعظ والحِِكَم . بل بإصدار الأحكام ذات الصبغة الأيديولوجية- طرأ على بنية التوصيل القصصي. بعض التطورات التي كان من نتائجها اختفاء هيمنة الراوي تدريجيا وقد حدث ذلك نتيجة موقف جمالي ينادي بنفي شخصية الراوي وعدم إظهاره في السرد([14]). وقد تنبه بيرسي لوبوك إلى مدى التطور الذي طرأ على هذه التقنية. وذلك على يد الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير ولاسيما في روايته (مدام بوفاري)..
تنبه نقاد السرد فيما بعد إلى أهمية هذه التقنية. فقاموا بوضع تصنيفات للراوي. لا تخرج في جوهرها عما حصره لوبوك في مدى حضور الراوي أو غيابه. وهو ما أطلق عليه تودوروف بـ (مظاهر السرد) ([15]) مستوحيا ذلك من تصنيف جون بويون الشهير للراوي مع تعديل طفيف غير جوهري؛ مشيرا إلى علاقة الراوي بالشخصية. ومدى تطابق علم أحدهما بعلم الآخر أو عدمه . مصنفا ذلك على النحو الآتي:
1- السارد (الراوي) < الشخصية الروائية. أي. أن الروائي يعلم أكثر من الشخصية. وهو ما اصطلح عليه بـ(الرؤية من الخلف) وهي الصيغة التي يلجأ إليها القص الكلاسيكي في أغلب الأحيان.
2- السارد (الراوي) = الشخصية الروائية. أي أن الراوي يعلم بقدر ما تعلم الشخصية. وهو ما اصطلح عليه بـ(الرؤية مع). وقد شاعت هذه الصيغة في القص الحديث.
3- السارد (الراوي) > الشخصية الروائية. أي أن معرفة الراوي أقل من معرفة الشخصية الروائية. فالراوي لا يصف إلا ما يراه ويسمعه فقط .فلا سبيل إلى معرفة ما في الضمائر. وهو ما اصطلح عليه بـ(الرؤية من الخارج). ويرى تودوروف([16]) أن مثل هذه المعرفة الحسية الخالصة لا تعدو أن تكون مواضعة. ذلك لأن سردا ينحصر في مستوى مثل هذا الوصف الحسي الخارجي غير معقول. ولكنه موجود بوصفه نموذجا لطريقة من طرائق الكتابة. ولم تخرج هذه الصيغة عن حدود التجريب. وقد عُرف همنجواي بهذه الصيغة في عدد من قصصه القصيرة مثل (القتلة).
الراوي في (طريق البخور) كلي المعرفة أو (الراوي العليم) بحسب أدبيات السرد. وبهذا تتميز رؤيته بأنها من الخلف. فلا يترك للشخصيات مساحة للتعبير عن مشاعرها وأحاسيسها إلا في نطاق ضيق. فمن هنا كان ضمير الشخص الثالث (ضمير الغائب هو) مركبا سرديا لرواية أحداث هذه الرواية. بيد أن المنظور الموضوعي يسود في عموم الرواية مزاحما من خلاله الراوي المراوح بين الحضور والغياب. فالسارد يستهل روايته بهذه الكلمات التي توحي بأننا أمام كتاب في السرد التاريخي:
الزمان: 22 ق.م ·
المكان: روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية·
الإمبراطور الروماني أغسطس أوكتافيوس الذي اتسعت في عهده الإمبراطورية الرومانية لتصبح أكبر دولة في العالم. جلس على عرشه ومجموعة من التجار اليونانيين والإغريق تطلب إليه السيطرة على بلاد العرب الجنوبية المكان الهام والاستراتيجي» ص5.
بهذه الموضوعية الحادة يعلن الراوي عن المسافة الكائنة بينه وبين المروي. وهي مسافة لاشك في اتساعها. بيد أنها تضيق فجأة وربما تتلاشى بعد هذا الاستهلال ليسود السرد المشهدي بوساطة الحوار بين الشخصيات. فلا يخرج الراوي في هذه الحالة عن التعليق على الحوار وتوجيهه توجيها أقرب ما يكون إلى ما يصنعه المسرحي. وهاك أنموذجا متصلا اتصالا مباشراً بالمقطع الاستهلالي السابق:
« فبادره رئيس طائفة التجار اليونانيين في محاولة لإغرائه:
– إن طريق الذهب خارج عن نطاق سيطرتنا. أقصد البهار.إنه الطريق المعروف بطريق البخور.
وقف أحد التجار وانحنى للإمبراطور وقال:
– الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي عصفت بنا كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار البهارات والعطور والبخور والمر بشكل جنوني فاق كل التصورات.
تنهد التاجر بألم وعاود الكرم:
– مع أن الفائدة الحقيقية من هذه التجارة ليست للتجار العرب الذين يربحون أضعافا مضاعفة لما نربحه» ص5.
وهكذا يستمر الحال حتى يعود الراوي إلى الظهور على النمط السابق:
«المكان ميناء الإسكندرية. حيث تزدحم السفن الشراعية. وحركة البيع والشراء في أوجها بين التجار المصريين والإغريق. بينما منارة الإسكندرية التي بناها الفراعنة تنتصب كشاهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة. ومن أحد السفن الرومانية ينزل عدد من القادة الرومان حيث يكون في استقبالهم عدد من الجنود الرومان. وهنا ينزل رسول الإمبراطور محييا الضابط الكبير الذي جاء يستقبله» ص8.
وبهذا يظل الراوي محصوراً بين هذين النمطين من القص. فتقل في تقنيته الانزياحات. لهذا ساد في هذه الرواية الصوت الواحد. فصادر الراوي أصوات الشخصيات فجعلها تتكلم على نسق واحد. كما صارت صدى لصوته. فمن هنا برزت خصائص (الصوت الواحد/المونوفونية) في هذه الرواية من خلال تدخلات الراوي السافرة. ومعلوم أن من وظائف الراوي تحديد رؤية المروي له للمروي. وذلك بتوجيه أفكاره ومشاعره تجاه حدث ما. أو بالإجابة عن تساؤلاته أو بإضاءة جانب من جوانب السرد. ويتجلى هذا التدخل حينما يتبنى الراوي تقنية الرؤية من الخلف التي تمكنه من التدخل في سياق السرد وقتما يشاء. بيد أن هذه التدخلات قد تؤدي إلى ترهل العمل السردي ولاسيما حينما تكون فجة. فتفضح أسرار اللعبة التي تدور بين الراوي والمروي له. بل ربما أفقدت العمل السردي جمالياته فأطفأت توهج شعريته. هذا ما نجده في رواية( طريق البخور) مما يجعل المروي له لا يدري أيقرأ رواية أم أنه يقرأ تاريخا محسّن الصياغة. تتجلى هذه التدخلات في الأشكال الآتية:
1- الشرح والتفسير: كقول الراوي معلقا على هلع بعض جند الرومان حينما قامت قبيلة خثعم مع حلفائها بمهاجمتهم. فأخذوا يصيحون فزعين: ساتير. ساتير« وهم يظنون بأن الشياطين هاجمتهم. حيث يعتبرون ساتير هم شياطين الطبيعة ورفقاء الإله باخس إله الخمر. وهؤلاء الشياطين ذوو أجسام نصفها الأعلى بشري والأسفل على شكل حيوان حصان أو تيس» ص71. فهذا التعليق يصلح أن يكون في كتاب عن الميثولوجيا أو أساطير الشعوب. بيد أنه لا يصلح أن يكون بهذا الشكل في رواية إلا إذا وُظف سرديا. ومثل ذلك قوله «وانعقد لسانه فاستدعى مجلسه الاستشاري المسمى مسود والذي يتكون من كبار رجال الدولة» ص101. وربما ساق هذا الشرح أو التفسير على لسان شخصية ما دون أن يوظف ذلك تعبيريا كقوله على لسان وزير ملك نجران : «في هذه القاعة يجتمع المجلس الاستشاري الذي يقرر سياسة الدولة» ص101.
2- التقويم الذي يحمل توجيها أيديولوجيا للنص: ويتجلى هذا التقويم في عدة أشكال تعضد سمات (الصوت الواحد/المونوفونية) مثل:
أ- النعوت والألقاب التي لا تعتمد على سياقها الخاص وهي تنسجم بشكل أساسي مع موقف الراوي من الموضوع الذي يصفه. كقول الراوي عن مملكة سبأ «وأما في عاصمة مملكة سبأ العظيمة مأرب فقد كانت الحياة تجري على النحو المعتاد» ص30. وكقوله عن صالح «ارتاحت نفس الملك عبادة فوزيره الوفي صالح سوف يتدبر الأمر ويتحمل التبعات إذا كشف بينما المطلوب منه أن يمثل دور الحليف الوفي لروما. وهو الدور الذي يجيد إتقانه ببراعة» ص53. وها هنا تقويمان متقابلان بنعت واحد(الوفي) فهو في حق صالح يحمل تقويما إيجابيا. وفي حق الملك يحمل تقويما سلبيا. فالصفة الأولى تعضد صفة الانتماء للأمة العربية (الوزير العربي) حليف قومه العرب. أما الصفة الثانية فتعضد اللاانتماء والانسلاخ من الأمة(الحاكم الخائن) حليف الأعداء. كما قد يأتي النعت مباشرا كقوله عن الحملة الرومانية «تصل رسائل التحذير باقتراب جحافل القوات الرومانية الغازية للبلاد العربية إلى كل بلاد وإمارة عربية» ص23.
ب- قد يأتي هذا التقويم على شكل تقويم أيديولوجي مباشر. يتبنى من خلاله الراوي منظومة ما ينطلق منها ليجعلها ميزانا عاما لشخصيات الرواية. فالرواية تدور في إطار منظومتين أيديولوجيتين هما: منظومة الغزاة (الحملة الرومانية) ومنظومة المقاومة ( جزيرة العرب) وبشكل خاص (جنوب الجزيرة العربية). فالراوي يلزم منظومة المقاومة العربية. لذلك ينطلق في تقويمه من وجهة نظر هذه المنظومة. فهو يتعاطف مع المصريين الذين يعملون في خدمة الإمبراطورية الرومانية سخرةً وإرهاباً فيقول «الحركة دائبة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر فالآلاف من العمال المصريين يعملون بالسخرة لتجهيز السفن الرومانية حيث تلسع العصي ظهور العمال إن أبطأوا بالعمل أو اشتاقوا للراحة» ص15.
ج- يوظف الراوي الأحداث في تقويمه للشخصيات مثل تصويره حالة جاليوس حينما فاجأه المقاومون في خيمته في صورة كاريكاتورية «تفاجأ اليوس جاليوس وهو بخيمته بالهجوم الذي نال خيمته هي الأخرى. وأمام قوة الهجوم المفاجئ حاول الاختباء أسفل سرير نومه إلا أن ضربة سيف خاطفة أصابته في ساقه» ص137. وإمعاناً في امتهان هذه الشخصية يقول الراوي واصفا حالته بعد هذه الحادثة «يفتح اليوس جاليوس فمه ببلاهة وكأنه غير مصدق لما يحصل» ص137.
وهكذا نجد هذه السمات جلية في عموم الرواية مما يؤيد ما ذهبنا إليه من تصنيف هذه الرواية في إطار الرواية ذات الصوت الواحد([17]).
3- التأريخ المباشر: يمثل هذا التدخل شرخا في تسلسل الأحداث السردية فيتحول الراوي إلى مؤرخ كقوله «المكان ميناء الإسكندرية. حيث تزدحم السفن الشراعية وحركة البيع والشراء في أوجهها بين التجار المصريين والإغريق. بينما منارة الإسكندرية التي بناها الفراعنة تنتصب كشاهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة…يركب الرسول العربة التي تأخذه من خلال الطرقات الممتلئة بالتماثيل المعبرة عن الحضارتين المصرية والرومانية ويصل الموكب إلى قلعة ضخمة على منحدر جبلي حاد» ص8. ويقول في موضع آخر «يقف الملك ويتحرك نحو تمثال كبير للآلهة المقه. وقف على حجر ضخم تزينه عشرات الوعول المنقوشة بدقة وبجواره مذبح كبير كانت الدماء ما زالت فيه طرية من القرابين والنذور التي قدمت صباح ذلك اليوم كما تقتضي التعاليم وانحنى الملك للآلهة باحترام وخشوع كبيرين» ص27.
4- إظهار المسافة الزمنية: وتتجلى هذه السمة في عدة أشكال أبرزها:
أ- الإشارة الصريحة إلى زمن الكتابة: كقول الراوي «يبحر الأسطول الروماني لغزو بلاد العرب الجنوبية من موانئ مصر على البحر الأحمر صوب ميناء لوكي كومي- ينبع حاليا-وسط إقليم الحجاز» ص18.
ب- استخدام ألفاظ وكلمات لا تنتمي إلى العصر المروي عنه: كقول إحدى الشخصيات «حرب العصابات القائمة على قاعدة اضرب واهرب هي الوسيلة الوحيدة أمام القبائل وعلى الدول العربية في الجنوب توحيد صفوفها لخوض حروب نظامية ضد الرومان» ص21. وغيرهما من مثل (الوطن) و (الشعب) و(الثورة) و(جيش العروبة) و(الخارجون على القانون) و(الأحداث الدولية) و(من أشقائنا العرب) و(المعادلة الحربية) ([18]).
ج- الإشارة إلى أحداث وكلمات عصرية تحمل توجيها أيديويولوجيا: من مثل الإشارة إلى مضايقة المحتلين للنساء([19]). والاستعانة بالأجانب على غزو بلاد العرب([20]). الهجمات الانتحارية([21]). نقل الحضارة والثقافة الرومانية من خلال الغزو والاحتلال([22]). من ليس معنا فهو ضدنا([23]).
د- استخدام شعارات عصرية مباشرة: من مثل قول إحدى الشخصيات «العربي لا يقبل الذل والهوان. ولن يقبل عربي عنده كرامة بالخضوع للرومان» ص103. وكقول آخر «لن نرثى العروبة والعرب. ولن نبكي على الأطلال لأننا أمة كالعنقاء تولد من رمادها. إننا أمة لا تعرف اليأس والاستسلام. أمة قررت أن تستمر في أداء رسالتها لكل الأمم والشعوب. أمة لا مكان فيها للخونة والخانعين والمستسلمين» ص85. وكقول آخر «لا يوجد قائد عربي في أيامنا يجسد حلم الشعب العربي. يقيم للعرب مجدهم في العالم وينقذهم من حياة الذل والهوان» ص78. وغيرها من الجمل التي توحي بالزخم القومي الذي كان شائعا في شعارات ستينيات القرن العشرين([24]). كما نلمح بعض الكلمات والجمل التي لا تسمعها إلا في التحليلات السياسية المعاصرة ولاسيما في النقاش الذي دار بين صالح واسترابون – حول الحضارة العربية وحول مجدهم- الذي استمر عدة صفحات([25]).
ثانيا: الشخصية الروائية
تزاوج الرواية التاريخية عادة بين الشخصيات التاريخية والشخصيات المتخيلة. وربما لجأ المبدع إلى إسناد أعمال تاريخية إلى الشخصيات المتخيلة ليزيد من توهج بنائها في إطار الحدث السردي. كما أنه قد يسند أعمالا لا تاريخية إلى الشخصيات التاريخية وفي هذا نظر؛ لأن الشخصية في الرواية التاريخية محلّ يتقاطع فيه التاريخي والروائي. والعام والخاص والمرجعي والجمالي ([26]).
بالنظر إلى شخصيات رواية (طريق البخور) نجد افتقادها إلى الشخصية المتخيلة الفاعلة في الحدث السردي مما يفقد الشخصية البعد الدرامي. ومرد ذلك ذوبان الجمالي في دهاليز الهامشي. فالشخصيات الرئيسة المؤثرة في سير الحدث السردي هي على التوالي: ايليوس جاليوس(قائد الحملة الرومانية) والوزير صالح (مرشد الحملة العربي) واسترابون (مؤرخ الحملة) وتبع هؤلاء شخصيات ثانوية تدور في إطارها حسب التصنيف الأيديولوجي للمنظومتين السائدتين في النص: الاحتلال # المقاومة .
يغلب على هذه الشخصيات الثبات والنمطية. وهو ما عبّر عنه فورستر([27]) بمصطلح (الشخصية المسطحة) التي تدور في أدق أشكالها حول فكرة أو صفة وهي حقيقة يمكن التعبير عنها بجملة واحدة. وهذا الأمر أفقد الشخصيات شعريتها فلم يتعد الصراع -فيما بينها ما ذكرته الكتب التاريخية وهو صراع خارجي في عمومه- إلى صراع داخلي يدور في أعماق الشخصيات؛ لهذا قل حديث النفس (المونولوج) في هذه الرواية إلا في نطاق ضيق. فغلب على حوارها الخطاب المباشر الذي يتكئ عليه السرد المشهدي. لهذا صادر الراوي كل حقوق الشخصيات- إذا صح التعبير- الأيديولوجية والتعبيرية. فهو يحوّل الشخصية في إطار الصراع السردي إلى مؤرخ معبرا عن أيديولوجية الراوي/المؤلف مثلما صنع مع شخصية (استرابون) عند حديثه عن مملكة معين في حواره مع قائد الحملة «كان استرابون يسجّل العديد من الملاحظات فسأله اليوس جاليوس – أراك قد دونت معلومات كثيرة عن المعينيين فلماذا تهتم بهم بهذه الدرجة ؟
يبتسم استرابون وهو يرتب أوراقه قائلا:
– لا يوجد أحد لا يعرف دولة معين العظيمة التي طاف تجارها مدن وموانئ العالم يبيعون بضائعهم النادرة.
كانت عينا استرابون تبرق بالإعجاب خلال حديثه مع اليوس جاليوس فتجمع كبار القادة والضباط للاستماع إليه فيما واصل حديثه:
– اشتهر المعينيون بأنهم تجار مهرة ولاسيما للبضائع النادرة كالبخور واللبان والطيب والمر التي تعتبر من المواد المقدسة والغالية الثمن لاستخدامها في معابد العالم لممارسة الطقوس الدينية
ابتلع استرابون لعابه وواصل كلامه والقوم من حوله كأن على رأسهم الطير:
– تأتي مختلف البضائع من أرخبيل سوقطرى وظفار والمهرة وميناء مواز وجبلان عبر طرق القوافل المختلفة التي تمتد من قنا وشبوة مرورا بدولة سبأ حتى الأراضي المعينية لتصل عبر الصحاري والقفار بالحجاز وتمر بأراضي عرب الأنباط الفينيقيين واليبوسيين حتى ميناء غزة على البحر المتوسط »ص105-106.
لو حذفنا من المقطع السابق الوصلات الرابطة للحوار لما ميزنا بينه وبين أي كتاب تاريخ تعليمي. ولما وصفناه بحوار سردي. ناهيك أن يكون كاشفا عما في وعي الشخصية مما يجعل الشخصية مجرد وسيلة إيصال معلومة يريد الراوي إيصالها إلى القارئ. لهذا أنطقه ليعبر عن أيديولوجيته تعبيريا كالوصف التي أطلقه استرابون على دولة معين(العظيمة). أو كقول صالح وهو يحاور استرابون:
« – إنك فعلا أمام سور مدينة معين ذي الخمسة والسبعين برجا ولهذا المدينة بوابتان إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
يدون استرابون المعلومات التي زوده بها صالح ويسأله:
– هل قمت سابقا بزيارة هذه المدينة ؟!
يضحك صالح في مرح:
– نعم زرتها وأتذكر أنني زرت معبد نكرح وهو للإله عشتر وهو معبد ضخم جدا كما يوجد معبد آخر في وسط المدينة.
يدون استرابون هذه المعلومات فرحا بها وهو يطلب من صالح إمداده بالمزيد من المعلومات:
– إنك رجل مثقف وعلى إطلاع هل لديك المزيد من المعلومات حول هذه المدينة ؟!
يجيبه صالح وابتسامة عذبة زينت ثغره:
– يطلق أيضا على هذه المدينة اسم براقش والمدينة هي موطن التاجر المعيني الشهير زيد ريل.
استرابون بطرب وفرح:
– زيد ريل التاجر المعيني الذي كان يتاجر مع اليونانيين وكان يزود جزيرة(ديلوس)اليونانية بالبخور واللبان والمر لمعابدها(يتوقف متفكرا) كانت هناك أنباء بأنه أصيب بخسارة فادحة في تجارته أليس كذلك ؟
يضحك صالح مجددا ويقول:
– نعم. إلا أن زيد ريل كان رجلا ذا علاقات حسنة بفراعنة مصر فأنقذوه لأنه كان المرد الرئيسي لكل المواد التي تحتاجها المعابد الفرعونية في طقوسها الدينية من تحنيط وخلافه. »149-150. فالحوار ها هنا لا يعبر عن وجهة نظر ما تساعد على جلاء الحدث أو تزيد في توتره فهو أشبه بسقط المتاع. وهذه من تلك.
كما أن الشخصية قد تتحول إلى ساردة للأحداث نيابة عن الراوي الذي ربما تكاسل عن أداء مهمته. مثلما فعل مع جاليوس واسترابون في حوارهما الذي يجلو بعض الأحداث التي أجملها الراوي ليدع مهمة تفصيلها إليهما. فها هو جاليوس بقوله مخاطبا استرابون عقب معركة نشبت بينهم وبين بعض القبائل العربية:
«- إن الطريق الطويل والمضني قد نال من الجنود ومن معنوياتهم بعد أن كانوا يمنون أنفسهم بنزهة قصيرة لاحتلال أرض العرب(ثم أضاف في توتر وقلق) كما أن مهاجمة القبائل العربية لنا طوال الطريق قد أنهك الجيش وأضعف من عزيمته(اتسعت عينا اليوس جاليوس وهو يزفر بعمق) أضف إلى ذلك نقص الماء وتعرضنا للأوبئة والأمراض وسط الصحراء مع هجمات القبائل علينا طوال فترة سيرنا. إنها عوامل كفيلة بهزيمة أعتى الجيوش(سكت قليلا ثم أكمل) لكن جيشنا استعاد قوته وعزيمته بعد مراسلة ملك نشق لنا وعبر حديثك [أي استرابون] عن ثروات العرب(بتر عبارته والتفت ناحية مدينة نجران وقال) لقد أرسلت بترونيوس بحملة لاستلام مدينة نشق وقد استلمها دون مشاكل ومملكة نجران التي أمامنا أصبحت لا تملك الخيار بالمقاومة نظرا لأن مملكة نشق التي في جنوبها قد أصبحت في أيدينا.
كان استرابون كعادته يسجل الكلام الذي يسمعه حتى لا يفوته شيء فقال وكأنما أدرك شيئا:
– إذن فمملكة نجران أصبحت بين المطرقة والسندان للجيش الروماني »ص108.
فما مر مثل شرود لكيفية بناء الشخصية في رواية(طريق البخور).
ثالثا: الزمن الروائي
يتميز الزمن الروائي بعدم التزامه التسلسل الزمني التزاما مطردا وفقا لترتيب وقوعها. لهذا تجد الروائي يعمد إلى تقطيع الزمن ومطه إلى الأمام تارة وإلى الخلف تارة أخرى مما يؤدي إلى تقنيتي الاسترجاع والاستباق. وقد يتماهى الراوي مع الشخصية لتتولد تقنية التزامن. وفي أثناء ذلك كله تتجلى تقنيات أخرى مثل:
1) الوقفة: وهي تقنية تشير إلى توقف زمني كامل في حين يسير النص دون حركة زمنية. وهذا لا يحدث إلا في المقاطع الوصفية.
2) المشهد: وهي تقنية تتمثل في فترة زمنية قصيرة على مقطع نصي طويل. وهي تقنية تعتمد الحوار لذلك سميت بالمشهد.
3) التلخيص: وهي تقنية زمنية تعني سرد الحوادث ووقائع يفترض أنها جرت في سنوات أو شهور أو ساعات في صفحة أو فقرة أو أسطر دون تفاصيل.
4) الحذف: وهي تقنية زمنية تعني القفز على مساحات طويلة أو قصيرة من الزمن الروائي دون الإشارة إلى ما وقع فيها من أحداث.
بالنظر إلى بناء الزمن في رواية (طريق البخور) نجده خاليا من الاسترجاع والاستباق والوقفة والتلخيص. وذلك بسبب التزام الرواية الخط الزمني المستقيم وبسبب غلبة الهامشي على الجمالي. مما أفقد الزمن الروائي خصوصيته السردية.
واللافت للنظر في هذه الرواية استخدام الراوي للفعل المضارع بشكل ملحوظ. بيد أنه استخدام غير موظف سرديا. أي أنه لم يستخدم لغرض إظهار تزامن الراوي مع الشخصية. فمعلوم أن الراوي حينما يلجأ إلى استخدام (الفعل المضارع) إنما يؤكد على تزامنه مع الشخصية. أي أنه يتطابق مع الموقع الزماني لهذه الشخصية. لهذا فهو يشعرنا بأنه يحتل الموقع الزماني الذي تحتله الشخصية والتي يتبنى وجهة نظرها الزمانية في توجيه الأحداث السردية. ولا سبيل له إلى ذلك إلا في الدخول إلى وعي الشخصية ونقل الأحداث من خلاله. وفي هذه الحالة يتلاشى صوت الراوي. وهي حالة لا تتحقق من خلال السرد المألوف في الرواية التقليدية. وإنما تتحقق من خلال مظاهر الرواية الحديثة التعبيرية من مثل : تيار الوعي والمونولوج المروي والخطاب الحر غير المباشر والسرد الذاتي. وذلك حين يتعالق كلام الراوي مع كلام الشخصية. فلا نرى هذا الأمر متحققا في رواية (طريق البخور) حينما لجأ الروائي إلى الإكثار من استخدام (الفعل المضارع) لدواع غير تأليفية. فالفعل المضارع في هذه الرواية لا يقوم بأية وظيفة تعين على تشكّل الأنماط السابقة من الخطاب وإنما يتجلى بشكل آلي. بحيث لو استبدل الفعل الماضي به لما حدث أي تغيير في تنامي الحدث السردي أو في وجهة نظر الشخصية. ولا أراني مستطيعا حصر أمثلة استخدام الفعل المضارع على هذه الشاكلة؛ لأنه يشكل لازمة من لوازم الراوي التأليفية. بيد أني سأختار من الرواية أمثلةً شُرُدا. يقول الراوي « يجيبه رومانوس الذي يرتدي الملابس العسكرية وقد ضم يده إلى صدره» ص6. ففي المقطع السابق يشكل الفعل المضارع(يجيبه) اضطرابا زمنيا لعدم اتساقه مع النظام العام للجملة. لأن قوله فيما بعد «وقد ضم يده إلى صدره» أبطل مفعول الفعل المضارع قبله للدلالة على التزامن. في حين لو بدأ الجملة السابقة بقوله (فأجابه) لكان هناك انسجام عام في الكلام. ومما يقلق الجملة السابقة أيضا، الاسم الموصول (النعت) وصلته (الذي يرتدي الملابس العسكرية) الذي زاد من ترهل الجملة بشكل عام. لأنه لا يؤدي أية وظيفة سردية. وشبيه ذلك كثير في هذه الرواية مما يجعل أكثر المقاطع السردية أقرب إلى تقنية (السيناريو) منه إلى السرد الروائي وذلك لوجازة الجملة وغلبة الجمود عليها حتى وإن احتوت على الأفعال لهذا تأتي الأفعال نابية عن سياقها في النص. ليصبح صنيع الروائي أشبه بصنيع الكاتب المسرحي أو كاتب السيناريو([28]). وهاك مثالا شرودا على ذلك «مارس الذي يشرب كأسا من الخمر وينهش قطعة من اللحم بيده الأخرى» ص9.
وبهذا تفقد بنية الزمن في هذه الرواية شعرية الزمن المنبثقة من الانحراف عن بنية زمن الخبر التاريخي -الذي يعتمد على الاستقامة وعدم الالتواء- إلى بنية الخطاب التخييلي القائم على التشظي والتقطعات والالتواءات. مما يجعل الجمالي يتوارى في إطار الهامشي إن لم يلغه بشكل من الأشكال.
الهوامش
· من إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م.
([1]) الفابيولا (المتن الحكائي) مفهوم يحيل على المادة الخام التي تشكّل جوهر الأحداث في سياقها التاريخي. ولهذا يمكن عرضه بطريقة عملية حسب النظام الطبيعي. بمعنى النظام الوقتي والسببي للأحداث. وباستقلال عن الطريقة التي نظمت بها تلك الأحداث أو أدخلت في العمل. ينظر: نظرية الأغراض، توماشفسكي، ضمن كتاب: نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط1، 1982م، ص180.
([2]) السوزيت (المبنى الحكائي) مفهوم يحيل على النظام الذي يتخذه ظهور الأحداث في سياق البنية السردية. فهو يقدم المروي على شكل متوالية من الأحداث المروية بما يتضمن من استرجاعات واستباقات وحذف وتقديم وتأخير. فالمبنى الحكائي يتشكّل من الأحداث نفسها بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل. كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعيّنها لنا. ينظر: المرجع السابق.
([3]) ينظر: نظرية الرواية(دراسة مناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة)، السيد إبراهيم، دار قباء، القاهرة، 1998م، ص101.
([4]) ينظر: النظرية النقدية في عصر ما بعد الحداثة، عبدالله هوار، دار غيداء للنشر والتوزيع, عمان، 2017م ص18.
([5]) ينظر: خطاب الحكاية، بحث في المنهج ، جيرار جينيت، ترجمة محمد معتصم وعبدالجليل الأزدي وعمر حلي، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ط2، 1997م، ص39.
([6]) ينظر: بعيدا عن الشعر، قريبا من النثر، عبد الله حسين البار، دار حضرموت للدراسات والنشر، المكلا، ط1، 2012م، ص164.
([7]) ينظر: رواية الرواية التأريخية: تسلية الماضي، ليندا هتشيون، ترجمة شكري مجاهد، مجلة فصول، القاهرة، م 12، ع 2، صيف 1993، ص 96.
([8]) ينظر: الرواية والتاريخ طريقتان في كتابة التاريخ روائيا، محمد القاضي، فصول، المجلد(16) العدد(4)، ربيع 1998م، ص43.
([10]) ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (الجزء الثاني)، جواد علي، دار العلم للملايين، بيروت، مكتبة النهضة، بغداد، ط2، 1977م، 44 وما بعدها.
وكذا: حملة ايليوس جالوس على بلاد العرب، دروس وعبر، عاطف خويره.
http://www.najah.edu/ARABIC/newsletter/issue72/titles/13.htm
([11]) ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص49.
([12]) ينظر: عتبات (جيرار جينيت من النص إلى المناص)، عبدالحق بلعابد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008م، ص74.
([13]) بناء الرواية، سيزا قاسم، دار التنوير، بيروت، ط1، 1985م، ص180.
([15]) ينظر: مقولات السرد الأدبي، ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب: طرائق تحليل السرد الأدبي، رولان بارت وآخرون، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، ط1، 1992م، ص58-59.
([16]) ينظر المرجع السابق، ص59.
([17]) ينظر على سبيل المثال : طريق البخور، 47، 48، 53، 62، 70، 86، 97، 114.
([18]) ينظر المصدر السابق، على سبيل المثال: 21، 28، 100، 103، 104، 112، 123، 129،130.
([19]) ينظر المصدر السابق: 96، 97.
([20]) ينظر المصدر السابق: 100.
([21]) ينظر المصدر السابق: 140.
([22]) ينظر المصدر السابق: 123.
([23]) ينظر: المصدر السابق 120، 121.
([24]) ينظر المصدر نفسه: 63،121.
([25]) ينظر المصدر نفسه: 72-79.
([26]) الرواية والتاريخ. طريقان في كتابة التاريخ، ص46.
([27]) ينظر: أركان القصة، ترجمة كمال عياد جاد، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001م، 94.
([28]) ينظر : طريق البخور، على سبيل المثال: 10، 11، 13، 16، 44، 68، 135، 152، 198، 203، 215.