دراسات
صالح مبارك عصبان

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 20 .. ص 28
رابط العدد 20 : اضغط هنا
مقدمة:
تعد المادة التاريخية للقرن الثالث عشر الهجري من أغزر المراجع والمصادر وأوفرها مقارنة بغيرها من الحقب التاريخية، ويعود ذلك لما شهدته حضرموت من أحداث في الشأن السياسي وتأثيره على الحياة، وقد سجل كثير من شهود تلك المرحلة مدوناتهم وحولياتهم التاريخية، ولن يجد الباحث مشقة في الحصول على معلومات جمة عن موضوع بحثه؛ إذ يستطيع جمع أطرافه والغوص في مظانه ومقارنة مصادره، للخروج بنتائج تساعد على فهم مجريات تلك الأحداث، التي استمرت عقودًا من الزمن، أفضت إلى تغييرات جذرية في الساحة الحضرمية، وأعادت الحياة الطبيعية إلى شرايين البلاد بعد أن عصفت بها رياح الحروب والفتن.
وبالنظر إلى تلك المدة يرى المرء غلبة قضية الصراع على الحكم والتسلط على القضايا الأخرى، بل هو علامة بارزة في بحر تلك الأمواج المتلاطمة، وكان محركها الأساس، فعلى أساس مده وجزره تغيرت الأحوال، وتبدلت المواقف، وأزهقت الأرواح، وأتلفت الأموال، وتعطلت المصالح، وعبر هذا المخاض العسير وقسوته، لاحت في الأفق إشارات مهدت لمرحلة جديدة، تنفس فيها السكان الصعداء، وتفاءلوا بيوم جديد.
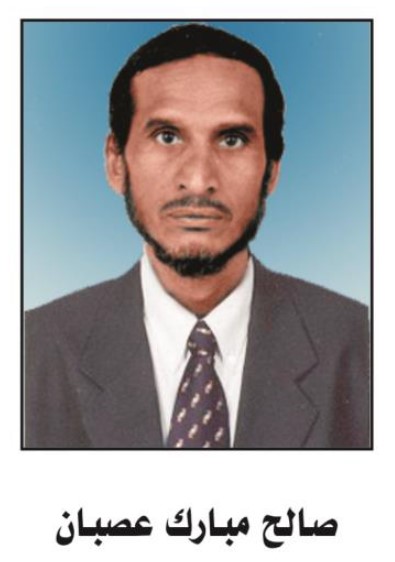
وفي هذا البحث نحاول معرفة دوافع هذا الصراع، نتأمل ونربط بين الأسباب، لا نحاكم شخوصه، ولا نثرب على أجنحته، ولسنا في مقام التصويب أو التخطئة، بقدر ما نعرض تاريخًا أصبح رموزه في ذمة الله، ويهمنا فيه تصرفات النفس البشرية، التي تجنح بها الطموحات، وتقذف بها الأهواء، وتقوى وتضعف، ونخضع كل ذلك للنقاش الموضوعي، الذي يؤدي إلى أخذ العبرة ومعرفة سنن الله في الكون بتعاقب الدول وتغير الأحوال، وكل ذلك يحتاج إلى قراءة ودراسة لما كتب، تنفض عنه غبار الإهمال وتخرجه من زوايا النسيان.
وينتظم هذا البحث في تمهيد ومبحثين، يتحدث الأول عن طبيعة الصراع، وعوامل تفاعلاته، ومواقف القوى المختلفة منه، ويستعرض المبحث الآخر الآثار المختلفة على الحياة العامة بحضرموت وخاصة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وما أفرزه الصراع من معطيات وتغير في موازين القوى، وينتهي البحث بخاتمة.
تمهيد:
لو عدنا قليلًا إلى الوراء، فإن السمة التي ميزت القرن العاشر الهجري من الناحية السياسية في حضرموت، سطوع نجم السلطان بدر بو طويرق (ت 977هـ)، الذي دانت له غالب المناطق، وفي عصره أدخل الأتراك آلة حربية كان لها دوي عظيم، وضربت باسمه النقود، وكثر تردد الطامعين من الداخل والخارج في منازعته الحكم، فغزا البرتغاليون الشحر، وبوفاته تناوشت السلطنة الخطوب والأزمات السياسية، وصراع الإخوة، ويتدخل أئمة صنعاء في القرن الحادي عشر، ويدخل السلاطين في عهد ولاء لهم، وفي نهاية هذه الحلقة ينقسم بيت الحكم على قسمين: يحالف الأول الأئمة، ويتحرك الآخر في مسار الاستنجاد بعنصر ثالث، حيث قدمت جنود يافع ليرجحوا كفة أحد الطرفين، فتضطرب الأمور، وتبرز تحالفات جديدة، ويأفل نجم الدولة الكثيرية في عهد السلطان جعفر بن عمر بن جعفر الكثيري، »ويتوسط القرن الثاني عشر وقد فرغ الناس من دفن الدولة الكثيرية الأولى، وأخذوا ينظرون إلى ما قد سد الأفق من غيوم الفوضى والاستبداد والظلم والجور واندفاع القوى المسيطرة وراء أغراضها اندفاعًا لا يردعه رادع ولا يزعه وازع«([1]).
وورثت الطوائف اليافعية وبعض القبائل الحضرمية تلك التركة المقطعة الأوصال، فتاهت في المجهول بلا هدف ولا نظام، تقودها شهوة التسلط والسباق إلى إشباع رغباتها في التحكم في الرعية، والحصول على الأموال ووسائل المعيشة، مع تساهلها في أية التزامات تحفظ أرواح الناس وأموالهم، وتكونت كيانات هشة في مدن حضرموت وقراه، ودور سياسي واجتماعي (للحوط)، مما دعا المؤرخ محمد بن هاشم إلى وصف تلك المرحلة بمرحلة (سلطات الطوائف)، فهي في نظره لا تحتاج إلى وصفها (بدولة)، وتخضبت أعوام القرن الثالث عشر بالدماء نتيجة للصراع المحتدم بين تلك الطوائف، وحلت الفوضى السياسية والتلاعب بأرواح المواطنين، ويمتد هذا الدور الذي يصفه البعض (بالدور القبلي) إلى نهاية القرن الثالث عشر؛ إذ استرسلت القبائل المسلحة في الحروب والفوضى، وحُشدت العشائر والقبائل لأقطاب أساسية، تتركز في ثلاث شخصيات، هي: عمر بن عوض القعيطي، وغالب بن محسن الكثيري، وعبدالله بن علي العولقي، وتحولت الصراعات من أجل الثأر والغارات إلى صراع هدفه السلطة والملك([2])، وتبرز شخصيات أخرى لا تقل أهمية عن تلك الرموز، هي شخصيات: الكسادي وآل بريك، والعمودي وغيرهم، وتؤدي مكونات قبلية أخرى أدوارًا (مساعدة) -إن جاز لنا التعبير- في أتون المعارك والفتن، مع الحصول على مكاسب وخسائر متعددة.
ومن جانب آخر ففي بداية القرن الثالث عشر الهجري مرت الأوضاع السياسية بمرحلة اضطراب وعدم استقرار، وتمزقت أسر الحكم في ساحل حضرموت وواديه، وقسمت المدن بينها، وتلونت خارطة النفوذ تبعًا للقوة بعد ضعف القوة الكثيرية وانفراط عقدها، وسرى التمزق إلى الحلقات الأدنى (القبيلة، الفخيذة)، ولم يعد يجمعها جامع في ظل البحث عن حليف يساعد على صد هجمات الغزاة والمغيرين، وانعدام الشوكة المركزية، وتقلص التعايش السلمي وسلطة الأب الأكبر الذي يعود إليه الأمر، ويكون لحكمه نفوذ ولكلمته صدى، لهذا »تجد كل قبيلة منقسمة على نفسها إلى فخائذ وأسر متطاحنة، وتتصارع داخل مثاويها ومبانيها، وتظلم العزل من المواطنين -الذي يقيمون بينهم ويسمونهم (الرعايا)- ظلمًا، يبلغ بالبعض منهم إلى درجة ترويع النساء والأطفال، وبيع الأحرار واختطافهم، ونهب الأموال، وقطع الطرق، وإتلاف النخيل وقتل الأبرياء«([3]). ولا شك في أن كثيرًا من تلك الممارسات اضطر الناس إليها اضطرارًا بعد غياب حاكم يحمي أعراض الناس، وسرعان ما انتشرت ظواهر القتل بين المتحاربين، وعمليات النهب، وساعد تجار الحروب على إذكاء تلك الفتن، ورفعت طموحات الساسة من منسوبها، وهي مرحلة لا تختلف كثيرًا عن بعض الفترات التي سفكت فيها الدماء »وإنه لمن المثير للاهتمام أن يشهد الإقليم الحضرمي على ما فيه من جفاف وفقر وقلة سكان ذلك الاختصام الذي تميز بالحروب الطاحنة التي دارت في كافة أدوار التاريخ…«، ويتساءل المؤرخ بامطرف قائلًا: »هل يُقتل البشر على وجه البسيطة لمجرد نزوة الاقتتال؟ وهل الاستيلاء على السلطة مجرد السلطة الغير مفضية إلى الحصول على طائل من ثروة أو رفعة من جاه، يدفع إلى المغامرات الدموية«([4]).
وعلى أية حال فقد آلت الأمور إلى ظهور بؤر الصراع التي تركزت في المدن، وهي التي شهدت المعارك، وعمليات الكر والفر، وبيعها وشرائها، وتعرض سكانها لأنواع من البؤس والحصار، بل إلى التهجير أحيانًا، وعانت المناطق المحيطة بها من ويلات الحروب، ولم تسلم هي الأخرى من بناء التحصينات ووضع نقاط الحراسة، وشهدت مزارعها عمليات نهب وإتلاف.
ونتيجة لهذه الصورة التي رسمناها للحالة السائدة، تأثرت الحياة العامة بحضرموت بدءًا من غياب الدولة والحاكم الذي يقيم العدل وينظم الحياة، ومرورًا بالوضع الاقتصادي الذي عانى الكساد والجمود من جهة، وخاصة ركنه الأساس (الزراعة)، التي يتم تعطيل وسائل إنتاجها أو تخريب أدواتها، ويتعرض النخيل والزرع للقطع، أما التجارة فتسوء حالتها أحيانًا لعدم وجود الطرق الآمنة، وفي الجانب الاجتماعي تشتت الكيانات السكنية بفعل الهجرة والتهجير، فضلًا عما يصيب الناس من هلع وخوف، وفرضت الضرائب والإتاوات من قبل صاحب السلطة هنا أو هناك، وأفرزت الحرب هيمنة القوة التي علا صوتها ولم يسمع لصوت العقل ونصح الناصحين إلا فيما ندر، ومع هذا لم يغب دور الناصحين ومساعي أهل الخير ممن أرادوا أن يعم السلام ويعيش الناس في أمان.
المبحث الأول: الصراع على الحكم طبيعة القوى المتصارعة وعوامل التأثير:
أولًا: خارطة الصراع ومراكز القوة:
بالنظر لما اكتسبته بعض المدن الحضرمية من إرث تاريخي وموقع مهم، اتخذها الحكام على مر الأزمان مراكز لتحركاتهم، وشيدوا فيها مباني الحكم وحصون الدفاع وقلاعها، وبنيت فيها دور العلم، ولهذا كانت مناطق سباق لطلاب الحكم والسيطرة، ولا بأس أن نورد هنا مثالًا يشهد على تمدد حركة الصراعات على طول حضرموت وعرضها في أزمنة مختلفة، ففي ولاية عبدالله بن راشد (ت 616هـ)، الذي حاول أن يضرب على أيدي العابثين بالأمن، فاحتل شبام، وقصد ساحل حضرموت سنة 559هـ وحاصر الشحر، »وانتفضت نهد وبنو حارثة وحضرموت وتجيب، وحصلت حوادث قتل وتخريب في سيئون وجفل وشبام وغيرها من مدن الوادي وقراه، وحوصرت تريم، وشق راشد بن أحمد وفهر بن عبدالله عصا الطاعة وعاثا فسادًا في أراضي صوح بالقرب من تريم«([5])، وكأن التاريخ يعيد نفسه في القرن الثالث عشر الهجري؛ إذ أصبحت مدن حضرموت وقراها مسرحًا لعمليات من امتلك السلاح.
وكانت مدن الشحر والمكلا من أهم المدن الساحلية في عملية الصراع، وتليها غيل باوزير، ثم تدخل بروم وقرى وبلدات أخرى، أما في الوادي فإن الخارطة تتسع لتشمل بالإضافة الى المدن الرئيسة (شبام، وتريم، وسيئون، ودوعن)، مناطق وقرى أدَّت دورًا كبيرًا في خطَّي الهجوم والدفاع وبناء التحصينات (من الأكوات والقلاع والحصون)، كما كانت القبائل المحيطة بها مصدرًا بشريًا للحرب.
ولعل أهم الأسباب التي هيأت تلك المدن لهذا الدور، وجود القرى الرئيسة، ممن جمعتهم العصبية لبناء كيانات تمارس الأمر والنهي، وتتحكم في شئون مناطق نفوذها، مع عدم تجاهل المفتاح الرئيس لهذا كله ألا وهو الصراع الكثيري اليافعي، الذي يلخص عشرات الأعوام من التناحر، لم يحسم إلا بعامل خارجي تم الارتماء في حضنه، »وبما أن الفريقين درجوا تحت سماء حضرموت وتنفسوا هواءها وأصابوا من خيراتها ما أصابوا وتحملوا من مشاقها ما تحملوا، فإن السنين القليلة أو الكثيرة التي باعدت بين القدوم الشنفري والقدوم اليافعي إلى حضرموت ليست مما يرجح كفة التاريخ لصالح تلك الفئة أو تلك«([6]).
والمتتبع لسير (الفتن) يرى انتقالها من مكان لآخر، فتتوسع في منطقة، ثم تنحسر لتشتعل في أخرى فينجذب لها المتحالفون، وبقدومهم تجري الاستعدادات ومتطلبات الالتحام وعناصر الصد وأدواته ويتهيأ المجتمع لضبط حياته وفقًا ومستجدات الأحداث.
وهكذا نرى أن الطوائف اليافعية توزعت في المدن فاستقلوا بالأمر في تريم وسيئون وشبام وملحقاتها، وفي الشحر والمكلا، وتقاسمت المدينة الواحدة بينها، ففي تريم مثلًا ثلاث سلطات (آل غرامة، وآل عبدالقادر، وآل همام)، وفي سيئون آل الضبي، وفي تريس بنو النقيب، وبنو بكر بمريمة، وفي شبام الموسطة، وآل بريك في الشحر، وآل كساد في المكلا، واستقلت بعض القبائل الحضرمية بمناطق متعددة، مثل ابن يماني التميمي في منطقة قسم، وقبائل أخرى من تميم في قرى مختلفة، وفي دوعن العمودي، وغير ذلك من النفوذ القبلي.
وقد حاول جعفر بن علي الكثيري إحياء الدولة الكثيرية سنة 1218هـ/ 1803م فاستولى على شبام ولم يفلح في الاستيلاء على سيئون أو تريم، وبوفاته سنة (1323هـ) تعثرت المحاولة، ثم قام حكم أسرة عيسى بن بدر الكثيري سنة 1239هـ، ودخلت الأحلام الكثيرية مرحلة عصيبة.
وظهرت التحالفات كضرورة اقتضاها تفاوت القوة، وتضارب المصالح واللهث وراء المغانم، ومحاولة إصلاح الأوضاع، كما هو في حلف عمر بن جعفر الكثيري، وآل علي جابر اليافعيين، وآل عبدالعزيز الذين استطاعوا إلى حد ما إعادة الطمأنينة للناس([7]).
وحين ننظر إلى ملف التحالفات طيلة تلك المرحلة نراها تخضع لتبدل المواقف، وتتم أحيانًا بين قبائل خارج إطار القطبين الرئيسين، وتكون شاملة في ظروف أخرى، لتكون جبهة عريضة لتحقيق هدف كبير، كما حصل في الهجوم على سيئون من قبل آل كثير وقبائل العوامر وآل باجري وآل جابر والحموم سنة 1264هـ، وتحالف القعيطي والكسادي لاستعادة الشحر سنة 1283هـ، وهناك تحالفات وقتية ذات أهداف قصيرة المدى، منها تحالف السلطان الكثيري منصور بن عمر بن جعفر الكثيري مع الجمعدار عوض بن عمر القعيطي سنة 1273هـ، وتحالف يافع مع آل تميم والمناهيل بالاستيلاء على أجزاء من تريم سنة 1275هـ، وغيرها([8]).
ويتم التصالح وكتابة العهود والمواثيق وإقامة هدنة بين الأطراف إما لمساع يقوم بها العلماء والوجهاء، وإما لالتقاط الأنفاس، أو للتخفيف من مشقة الحرب، ومن ذلك الصلح بين الدولة الكثيرية وقبائلها في ربيع الأول سنة 1287هـ، وبين آل تميم والعوامر سنة 1274هـ، ومكاتبات المقدم ابن يماني لآل بريك والكسادي وأهل القطن بالصلح الذي حصل بينه وبين السلطان غالب بن محسن الكثيري في ربيع الآخر سنة 1274هـ ليدخلوا ضمن (صلح المسندة) الشهير في جمادى الأولى 1294هـ/ 1877م، وبين القعيطي وحلفائه وآل تميم والمناهيل من جهة وآل كثير ومن في صفهم من جهة أخرى، الذي أنهى سبع سنين من الحرب في مدينة تريم([9]).
وبهدف إيجاد مراكز انطلاق وتوسع عمدوا إلى شراء المدن والقرى، وكانت تتم إما بالترغيب بالأموال، وإما تحت الضغوط والقوة، وتارة اقتسام المدينة مناصفة، وهذا كله يدل على الوضع الذي وصلت إليه الجغرافيا الحضرمية من تقطيع لأوصالها أدت لتأخرها وحصارها وسوء أحوال سكانها، ولعل أشهر الأمثلة في ذلك شراء منطقة الغرف سنة 1261هـ من قبل السلطان غالب بن محسن الكثيري من القرامصة التميميين، وقام ببناء دور بها، تمهيدًا لمناوشة يافع، وبوصول عبود بن سالم من الهند اشترى حصن ابن مطهر، وفي سنة 1262هـ اشترى آل كثير نصف بلدة تريم من عبدالقوي غرامة، وكانت فاتحة زواله من تريم، ومن ذلك أيضًا شراء نصف منطقة الخليف بتريم لآل عبدالله من آل همام سنة 1261هـ، وشراء منطقة الحزم بغيل باوزير من قبل الأمير عبدالله بن علي العولقي سنة 1261هـ ردًا على شراء الغرف من قبل آل كثير، وفي سنة 1272هـ باع آل عمر بن جعفر من عائلة آل عيسى بن بدر الكثيري بلدة حورة وحصونها ومراكزها للقعيطي، في حمى التنافس مع الكثيري على شراء المناطق، كما تم الاتفاق بين منصور بن عمر الكثير والقعيطي على صلح تقسيم شبام بينهما نصفين وذلك سنة 1275هـ، وفي سنة 1294هـ تنازل النقيب صلاح بن أحمد الكسادي عن نصف المكلا وجميع بروم والحرشيات للقعيطي مقابل مال([10]).
وعمومًا فقد اشترى ممثلون لآل عبدالله الكثيري والقعيطي بضعة قرى محيطة بشبام وتريم وسيئون، »وحاولت كلتا الأسرتين السيطرة على المواقع الاستراتيجية والاقتصادية الهامة في المنطقة، وقد نشأ صراع طويل ومرير من أجل السلطة تم في غضونه تقسيم البلاد برمتها بين تلك الأسرتين«([11]).
وتنشأ الحروب بين القبيلة الواحدة أو فرع منها مع قبيلة أخرى؛ إذ (تثور الفتنة) -كما يعبر عنها- لأتفه الأسباب، وحروب أخرى أكثر حجمًا، ومنها حروب غرامة وآل كثير سنة 1263هـ، وحرب النخيل بين فخائذ من آل كثير ويافع سنة 1269هـ، ووقعة المجف بين آل غرامة والدولة (آل كثير) سنة 1263هـ، وحرب المسندة بين آل تميم وآل كثير سنة 1272هـ، وحرب بين العمودي والكسادي سنة 1286هـ بعد خلاف بين العموديين أنفسهم، ومعركة البقرين بين آل كثير والكسادي سنة 1283هـ، ومعركة المشراف في ساحل حضرموت سنة 1293هـ بين الحلف الثلاثي (الكسادي والكثيري والعولقي) من جهة والقعيطي ومعه آل بريك من جهة أخرى([12]).
ويحدث في نهاية هذه المواجهات تغيير في خارطة مناطق السباق، ففي رمضان 1255هـ أجلى منصور بن عمر الكثيري قبائل الموسطة اليافعية من شبام، وفي شرق الوادي بدأ السلطان غالب بن محسن يتوسع، وبالمقابل أجلى عمر بن عوض القعيطي آل كثير من قرى بالقرب من القطن، وخطط آل كثير لاحقًا لغزو ساحل حضرموت، وفي سنة 1272هـ استطاع مهاجمو يافع تهديد شبام([13])، وهكذا عبر المؤرخ ابن حميد الكندي عن هذه الدوامة قائلًا: »والحاصل أن حضرموت لا تزال مربوشة أعلاها وأسفلها كلما خمدت فتنة من جانب ووهدت، ثارت في الجانب الآخر«([14])، وكأي حرب فإن المساوئ والتصرفات الهمجية تفرض نفسها مع ازدياد الخصومات، وكثرة الدماء والانتقامات والثأر، فيتم التنكيل بالمهزوم، وقطع الرؤوس، والرمي العشوائي على البيوت مما يسبب ضحايا ممن لا ناقة لهم ولا جمل في تلك الحروب، ويحدث أن يلجأ الجند إلى بيوت الأهالي يتخذونها متاريس فيعود الضرب عليهم وتنهدم تلك البيوت([15]).
ومن القضايا التي انتشرت في أثناء الحروب نظام (الرهائن)؛ إذ يضع الفريقان رجالًا أو التعديل بالأبناء ووضعهم في السجن لضمان تنفيذ العهد والاتفاق([16]).
أما النهايات التي أفضت إليها الصراعات فكانت بزوال دويلات وطوائف، وضعف قبائل أخرى وإزهاق الأرواح، وإنفاق الأموال، وتعطل المصالح العامة، وهي أحداث تدعو للاعتبار من نزوات التسلط والاحتكام للسلاح والقوة، لإشباع رغبات وتحقيق أمنيات كان يمكن أن تحقق بوسائل أخرى.
ثانيًا: عوامل التأثير:
دارت رحى الحرب على التراب الحضرمي واكتوى بنيرانها الجميع وانخرط حملة السلاح يساندون هذا ويخذلون ذاك، ولعبت بعض العوامل دورًا في بدء الحرب واستمراريتها نعرضها كما يأتي:
1- المال والتمويل:
وهو المحرك الأساس للحرب، ووجد زعماء الحروب ضالتهم في الهند حيث أموالهم التي كونوها، »والعنصر المثير للاهتمام في هذا الصراع كان اعتماد كافة الأطراف على التحويلات والسلاح والعتاد والمرتزقة والغذاء إلى حضرموت بسبب شحة المصادر في البلاد نفسها فقد ساهم في ذلك المهاجرون في سنغافورا وجاوا وحيدر أباد وشرق إفريقيا والحجاز«([17])، وجزء من الأموال التي تدفقت حاولوا بها إحلال الأمن والسلام وإقامة دولة بحضرموت مقرونة بطموحات سياسية للقضاء على الكيانات الهزيلة، وفي ساحل حضرموت كانت الموانئ مصدرًا من مصادر التمويل، ومن المصادر الداخلية فرض الضرائب والاستيلاء على أموال الوقف، وقد استخدمت تلك الأموال بصورة رئيسة في تموين المعارك، ودفع أجور الجنود، وجلب المحاربين من خارج حضرموت، وبناء الحصون والدفاعات، والنفقة على السلاطين والأمراء والحاشية، وشراء العبيد.
2- العنصر الخارجي:
ونعني بهم القادمين من خارج حضرموت، وهم قسمان: القسم الأول، ويعمل غالبًا كخبراء في إصلاح الأسلحة، ويجلبون من الهند وتركيا والحديدة وغيرها، أما القسم الآخر، وهو الذي يستأجر كمحاربين، نظير مبلغ من المال، وتصل أعدادهم إلى المئات، وتتركز مناطق استقدامهم في ما يطلق عليه ابن حميد (قبائل القبلة)، وخاصة وذو حسين ودهم والعوالق، بالإضافة لمناطق يافع([18])، والعجيب أنهم يتحولون من جهة إلى أخرى حسب ما يعطى لهم من الدراهم والغذاء، ولم تسلم المزارع والنخيل من غاراتهم وهجماتهم حينما ينفد ما لديهم من زاد.
3- تجارة الرقيق:
أوجدت تجارة الرقيق وقودًا رخيصًا للحروب، ونشطت عمليات الشراء في الحجاز وتركيا وإفريقيا، و»وفرت علاقات تجارة الرقيق مع شرق إفريقيا للحضارم إحدى وسائل تجارة البحر الأحمر في عشرينيات القرن التاسع عشر، فأبحرت السفن من المكلا وموانئ حضرمية أخرى إلى زنجبار لغرض جلب شحنات العبيد بيع بعضهم في حضرموت…. وفي الفترة ما بين (1850- 1880م) عمل ميناء المكلا والشحر كمحطات توزيع -احتلت قدرًا من الأهمية- للعبيد لمختلف الموانئ العربية، وكذلك عساكر عبيد للحروب المستمرة بين القعيطي والكثيري«([19])، وتطلق عليهم تسميات حسب مصدر قدومهم، فيقال (عبيد سواحلية)، (عبيد نوبة)، (عبيد مماليك)، ومع طول سنوات الحرب أصبح للقبائل والأفراد عبيد يتم توزيعهم على جبهات القتال، وأدى بعض الأفراد دورًا في العمل كوسطاء للشراء أو السفر بهم، يقول المؤرخ ابن حميد في (تاريخه): »والسلطان غالب ذكر لأخيه عبدالله أنه قد صدر مع السيد علي بن عمر محضار العيدروس دراهم لأخذ عبيد من جهة اليمن والشام«، وفي موضع آخر يقول: »وذكر أيضًا أنه بايصدر دراهم إلى بندر الحديدة لأجل أخذ عبيد نوبة مع أناس من أصحابه على نظر السيد سعيد بن سلطان صاحب مسكت«([20])، ويتكرر اسم علي بن عمر محضار العيدروس، وابن جراب، وصاحب مسقط مرات عدة في عمليات شراء العبيد، يقول ابن حميد: »وبلغنا أن السيد علي بن عمر بن محضار العيدروس وعبدالرحيم بن جراب نفذا إلى أرض السواحل من بندر منبي لأخذ عبيد للسلطان غالب«([21])، وحتى في رحلة العودة من الحج يصطحب البعض معه عبيدًا، ويتم الإهداء للوجهاء والزعامات القبلية، وما أسهل ما يقتل العبيد وتؤخذ أسلحتهم!
وأصبح امتلاك العبيد لازمًا من لوازم التسلط والظهور، »ففي شهر ذي الحجة 1269هـ نفذ السلطان علي بن أحمد من بلد سيئون مراده الهند وحيدر أباد ويقول إن نيته الفتح على السلطان المعان غالب بن محسن بثلاث خصال أحدها تحريضه على أخذ الأرقاء دائما لحتى يكونوا عددًا كثيرًا«([22]).
وسيكون لهذا العدد الوافر آثاره في السنوات التالية؛ إذ أصبح رافدًا قويًا للقوة العسكرية للسلطنتين الناشئتين (الكثيرية والقعيطية)، وتحول العبيد إلى خدمًا لبعض الأسر والعوائل، وبتدخل الاستعمار البريطاني وعوامل أخرى منع الاتجار بالرق.
ثالثًا: مواقف تجاه الأحداث:
أدخلت الأحداث الناس جميعًا في حيرة من أمرهم، ولم تمنع الضبابية والغموض وشدة الصراع من تحديد المواقف، والاصطفاف مع أحد الفريقين أو ضده تبعًا للمصلحة العامة، أو البحث عن سبل لإنهاء الصراعات وإقامة الشرع والعدل، أو لتحقيق مصالح خاصة، ويمكن رصد ثلاثة مواقف فرضت نفسها، وهي على النحو الآتي:
1- المناصب والحوط:
للمناصب والحوط حضور في جزء من تاريخ حضرموت، وكانت عبارة عن سلطات الأمر الواقع في ظروف معينة، والحوط: »هو الموضع الذي يختطه المنصب أو أحد المعتقدين ويحوطه ويعلن بأنه أصبح حرمًا آمنًا على الدوام لا يمكن فيه قتل ولا قتال ولا نهب ولا ظلم بين القبائل ولا السلاطين؛ فيستجيبون ويتعهدون بذلك، ومن دخله صار آمنًا؛ لأنه في حمى مؤسسه مختطه«، أما المناصب »جمع منصب وهو المرجع في الأمور العامة والمشاكل الاجتماعية«([23])، وتنتقل (المنصبة) بالوراثة، وتعطى للحوط صفات القدسية لأداء دورها الديني والاجتماعي بوصفها مقرًا لرفاة الولي، وتزداد قيمتها كلما كانت كرامات الولي وخوارقه مذاعة ومنتشرة بين عامة الناس، وللمناصب سطوة وضبط للأمور، واستضافة الضيوف، والتدخل لوقف الفتن القبلية([24])، وهي أحد مظاهر (الجاه) والظهور، فقد كان لبعضهم مراسم تبرز كيانهم وتعلي من شأنهم، فتضرب لهم (الطيالات) تحت ظلال الأعلام والبيارق في الأعياد والمناسبات، مصحوبة بالألعاب الشعبية (كالرزيح، والخابة، ونعيش البقارة) من قبل رعاياهم، ويحق لهم فرض العقوبات على من خالف أوامرهم، سواء بالنفي خارج الحوطة أو منعه من العمل مدة محددة، أو الضرب، ويبرر الأستاذ محمد بن أحمد الشاطري لنشأة ووجود هذه المسميات فيقول: »وطبيعة حضرموت وظروفها من شأنها أن توجد فيها هذه المؤسسات العظيمة النفع، ولهذا توجد روابط وثيقة بين هؤلاء المناصب الذين يتمتعون بالوجاهة وحسن العقيدة فيهم، -وهو ما يسميه البعض بالنفوذ القبلي الروحي- والقبائل المتسلحة، ولهم نفوذ عليهم في حدود معينة، كما أن لبعض المناصب نفوذ وسلطة على مواطنيهم فترى النفوذ القبلي والنفوذ الديني أو الروحي -كما يسميه البعض- يمشيان جنبًا إلى جنب في تلكم الأزمان«([25])، ولا ينجو من جرائم القتل والنهب إلا من اعتصم بإحدى الحوط، وهذه هي بعينها أدوات الحكم حيث الجمع بين الغطاء الروحي (الفكر) والقوة.
وترتبط الحوط بأسر معينة، يأتي في مقدمتها العلويون وتلحق بهم أسر أخرى، أما باقي أفراد المجتمع فلا (حوط) لهم، لعدم امتلاكهم الشوكة والعلم والجاه، وقد أدت دورًا في الصراع كوسيط، وكانت ملاذًا آمنًا للنازحين وكهفًا للاجئين، (كما تصورها منظومة الهيمنة الفكرية)، والمناصب هم أيضًا حسب رأي المؤرخ محمد بن هاشم إحدى ركائز الإصلاح بين المتحاربين وكبح جماح أهوائهم، ويتم ترضيتهم والذهاب إلى أماكنهم، ويتوجهون وقت الأزمات وحصول الضرر على القرى، إلى حملة السلاح فيما يسمى (النكف) يطالبونهم بدعم (الدولة) ضد خصومها، ففي شوال ١٢٦٨هــ وصل مناصب ثبي وتاربة وبور إلى سيئون (للنكف) على آل كثير الشنافر بتركهم معاونة الدولة([26]).
وتؤدي المنصبة والحوطة دور (الحاكم) في وسط محدود، خصوماته بسيطة وبين أسره روابط عائلية، وأفراد يمكن السيطرة عليهم، و»مفهوم ابن خلدون عن العصبية يمكن أن يكون ذا فائدة عند محاولة إيجاد فهم أفضل لدور الحوطة في القيام بدور الوساطة إذا ما نشبت صراعات بين القبائل المختلفة، وكذلك الحفاظ على السلام، إن فاعلية الحوطة نشأ جزئيًا عن نسب السادة الذين يسيرون أمور الحوطة«([27])، وتحظى قدسيتها فيما يعده ابن حميد (منقبة) لتخفيف الشدائد، فيقول وهو يصف حالة بيت انهدم على أناس مات نصفهم، ولم يمت النصف الآخر: »لأنها حوطة محل سلف«([28]) حسب تعبيره.
ونشط العلويون عبر هذين المسميين (المناصب والحوط)، ولكي نفهم أحد الأسباب الرئيسة لمواقف العلويين؛ بوصفهم أصحاب النفوذ الروحي -حسب وصف المؤرخ الشاطري كما تقدم- نثبت هنا كلامًا للمؤرخ محمد بن هاشم، يبين جزءًا من حقيقة مواقفهم؛ إذ يقول: »وإنما أخرج السادة العلويين من عزلتهم إلى المعترك السياسي، وحملهم على نبذ تقاليدهم القائلة بوجوب ابتعادهم عن التدخل في شئون السلطات وتنازعها، هو ضجيج الوطن وعجيجه من عظيم ما يقاسي من الاضطرابات والفتن، وما يكابده قاطنوه من الضيم والقهر، ومن انعدام القوة الحاكمة التي تخضع لها البلاد سواء اتصفت بالعدل أو الجور«([29])، وهي مبادرة ترجمت عبر سعيهم في الإصلاح سواء بين القبائل المسلحة أو بين سلاطين الدولتين، والمناداة بإقامة الشرع وأحكامه، كما حصل من قبل الفقيه الحسن بن صالح البحر بوضع مشروع لهذا الأمر، وعدد من المبادرات الأخرى التي غرضها حقن الدماء، وحفظ الأعراض، والرأفة بالرعية، ورد المظالم، وتأمين طرق الحجاج، ومعاتبة الظلمة وأهل الجور([30]).
وكانوا محط استشارة الأمراء والسلاطين الذين كانوا -غالبًا- لا يصدرون أمرًا أو يوردونه إلا بالرجوع إليهم، »ففي جمادى الآخر 1270هـ وصل كتاب من السلطان غالب بن محسن الكثيري لبعض وجهاء العلويين في سيئون يستشيرهم في أن يبقى في الهند أو يسافر إلى الشام (الحجاز)، أو الذهاب إلى العثمانيين، أو الخروج إلى حضرموت؛ فأشاروا عليه بالخروج إلى حضرموت«، وكان هذا السلطان يعتقد فيهم ويتعلق بهم أيما تعلق، حتى قال في معرض التأكيد على كلامه: ».. إني أيقنت بالهلاك، ولكن إذا دهمني أمر حملت معي خطوط الحبايب العلويين الذي تأتيني منهم من الجهة الحضرمية، وهي ما تزيد على مائة وعشرين خطًا، وأقول في نفسي: حاشا الله أن تلطخ كتب الحبايب بالدماء، فصرت أنى توجهت إلى أمر وهي معي، قضي بإذن الله تعالى وبركة أهل البيت النبوي«([31])، بل يدعونهم إلى اللجوء إليهم، ففي كتاب أيضًا من الفقيه البحر، قال فيه بعد مناصحة وبيان وتخويفه بالله على ما تُرتكب تحت نظره من مظالم: »… وقد جعل الله معكم وعندكم من حاز الكرامتين، شرف النسب وشرف العلم فعظموهم وأجلوهم، وأما النسب فقد قال الله تعالى لرسوله: [إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ]وقال صلى الله عليه وسلم: »إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما« أخرجه الترمذي«([32]).
ولهم اتصالات خارجية بمحمد علي باشا في مصر، وإمام اليمن، وأهم اتصال كان استعانتهم بالدولة التركية في سنة 1266هـ لتجهيز حملة للاستيلاء على الشحر؛ لتأمين إمداد آل كثير من الساحل، والتي تعرف بحملة إسحاق بن يحيى العلوي، وشكل العلويون لجنة منهم لمقابلته حين وصوله، ومن مواقفهم الهجرة من المدن التي أنهكتها المعارك والضرائب إلى قرى وحوط معلنين احتجاجهم([33]).
ولا يمكن التسليم لما أورده البعض من أن العلويين لم يكن في نيتهم إقامة دولة (علوية)، أو أن تحركاتهم بعيدة عن الأغراض السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تهدف ضمن أمور أخرى إلى الإصلاح الاجتماعي؛ إذ »بدأت حركة السادة المرموقين من مدن سيئون وتريم وشبام إلى القرى المجاورة، أتت هذه الحركة احتجاجًا على الظروف الاجتماعية السياسية في تلك المدن، كما أنها وجدت دافعًا من التهديدات الموجهة ضد سلامة السادة من قبل الحكام المحليين، أخيرًا بلغت هجرة السادة ذروتها بقيام عدة انتفاضات غير ناضجة ضد الأسر اليافعية الحاكمة بدعم من قيادات قبلية قوية«([34])، وهو يؤكد اتصال أصحاب الطموح السياسي منهم بالقوى القبلية والقوى الأجنبية مع وجود الآمال بتجديد الحكم الكثيري وتطبيق القانون »بعد إعطاء الصفة الشرعية لحكم آل عبدالله الكثيري على المنطقة برمتها، وذلك عن طريق جمع التقاليد التاريخية والدينية والأنساب في بوتقة واحدة«([35])، وهكذا قُدّم زعيم آل عبدالله، غالب بن محسن الكثيري في شكل مثالي واحتفل به كمنقذ سحري، وما محاولات محمد بن عقيل بن يحيى سنة 1217هـ، وطاهر بن الحسين سنة 1220هـ، وترشيح أحمد بن علي الجنيد 1253هـ إلا تصب في هذا السياق([36]).
وقد يحصل الخلاف بينهم وبين السلاطين، بل يحصل إلى حد الصدام، كالحرب التي وقعت بين السلطان جعفر بن علي الكثيري ومنصب عينات أحمد بن سالم بن الشيخ أبي بكر([37]).
2- العلماء:
قام بعض علماء ذلك العصر بما يملي عليهم مقامهم بتوضيح مواقفهم مما يدور، فبدأوا ببيان وجوب نصب إمام يسوس الناس ويقيم الشرع، قال ابن حميد في تاريخه: »وكان جل دعوة سيدنا الإمام الحبيب الحبر القمقام أحمد بن عمر بن سميط علوي ببلد شبام في شأن إقامة الوالي في الجهة الحضرمية خصوصًا لما يشاهده فيها من المنكرات والجور والظلم من غير نكير ولا وازع شرعي ولا طبعي«، وكان يقول (أي ابن سميط): »… فبعدم وجود السلطان في هذه الأوطان وأخريات الزمان تهدمت للدين أركان، وخربت ربوعه الحسان، وظهرت شوكة أهل البغي والعدوان«([38])، أما الفقيه علوي بن سقاف الجفري ففي درس في شهر ربيع الأول 1266هـ طالب الناس بالتوبة إلى الله، وطالب العلماء بأن يقتربوا من السلطان، وأن يجعلوا منهم وزيرًا، وكاتبًا، وحاسبًا، ومحتسبًا تحت نظرهم؛ لتستقيم أمور الدنيا والدين، مع تعليمه ما يجب عليه كوال لإقامة الشريعة، وظهور العدل، وأن هذا أفضل لهم من نوافل العبادات، وفي موضع آخر أمر أن ينادى في الأسواق بأن من له مظلمة عند السلطان نفسه فليتوجه له، وإن منع من ذلك، فهي الطامة وقال: (فلا يستقيم الظل والعود أعوج)، و(صلاح الرعية بصلاح الراعي)([39]).
ولهم في باب النصح سهم، فالفقيه علوي المشهور له قدم راسخ في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب الحسن بن صالح البحر كتابًا للدولة حين رآهم أعرضوا عن إقامة الشريعة، ومما جاء فيه »… ونرجو من الله أن تستجيبوا الداعي وتمتثلوا أمره وتخافوا بطشه وقهره، وتحفظوا أنفسكم من وقوع سخطه وزجره وتحكموا على أنفسكم ما شرعه في دينه من أمره ونهيه«([40]).
المصادر والمراجع:
الهوامش:
[1]– محمد بن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية، ص141.
[2]– انظر: ابن هاشم، المصدر السابق، ص141، بامطرف، في سبيل الحكم، ص13، محمد الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، (2/ 337، 403).
[3]– أبحاث لعدد من المستشرقين والأكاديميين، الشتات الحضرمي، ص63، وانظر: الشاطري، الأدوار، (2/ 339).
[4]– بامطرف، في سبيل الحكم، ص15.
[5]– سعيد باوزير، صفحات من التاريخ الحضرمي، ص78.
[6]– بامطرف، مصدر سابق، ص18.
[7]– انظر: صلاح البكري، تاريخ حضرموت السياسي، ص116، ابن هاشم، مصدر سابق، ص141، 153، 154، بامطرف، مصدر سابق، ص14.
[8]– باوزير، مصدر سابق، ص184، بامطرف، مصدر سابق، ص16، 42، ابن هاشم، مصدر سابق، ص213.
[9]– سالم الكندي (ابن حميد)، تاريخ حضرموت، (2/ 163، 305)، بامطرف، مصدر سابق، ص100.
[10]– ابن حميد، المصدر السابق، (1/ 334، 340، 343)، البكري، مصدر سابق، (1/ 123)، بامطرف، مصدر سابق، ص14.
[11]– الشتات الحضرمي، مصدر سابق، ص62، 63.
[12]– باوزير، مصدر سابق، ص15، 166، 184، 208، وانظر: عبدالرحمن السقاف (ابن عبيدالله)، إدام القوت، ص545.
[13]– باوزير، مصدر سابق، ص205، 207.
[14]– ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 300).
[15]– ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 41، 42، 140).
[16]– ابن حميد، المصدر السابق، (2/ 314، 339، 368).
[17]– الشتات الحضرمي، ص67.
[18]– ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 6، 35، 41، 53، 58).
[19]– الشتات الحضرمي، ص347، 348.
[20]– ابن حميد، (2/ 18، 62).
[21]– انظر: المصدر السابق، (2/ 74، 86، 113، 121).
[22]– المصدر السابق، (2/ 116).
[23]– الشاطري، مصدر سابق، (2/ 291، 287).
[24]– انظر: (المقصد في زيارة المشهد)، عبدالعزيز جعفر بن عقيل، مجلة (آفاق)، ص28، 29، 35، مارس 1987م، اتحاد الأدباء، المكلا.
[25]– الشاطري، مصدر سابق، ص290.
[26]– ابن هاشم، مصدر سابق، ص142، ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 39، 96).
[27]– الشتات الحضرمي، ص47.
[28]– ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 84).
[29]– ابن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية، ص143.
[30]– انظر: ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 96، 158، 160، 188، 372).
[31]– ابن حميد، (2/ 136، 154).
[32]– المصدر السابق، (2/ 127).
[33]– انظر: باوزير، مصدر سابق، ص177، ابن هاشم، مصدر سابق، ص181، ابن حميد، (2/ 208).
[34]– ابن هاشم، مصدر سابق، ص181، الشتات الحضرمي، ص59، 61.
[35]– الشتات الحضرمي، ص62، 69.
[36]– بامؤمن، الفكر والمجتمع، ص200.
[37]- ابن هاشم، مصدر سابق ص115.
[38]– ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 66، 67).
[39]– المصدر السابق، (65، 69).
[40]– المصدر السابق، (2/ 127).