تأملات
أ.د. أحمد سعيد عبيدون
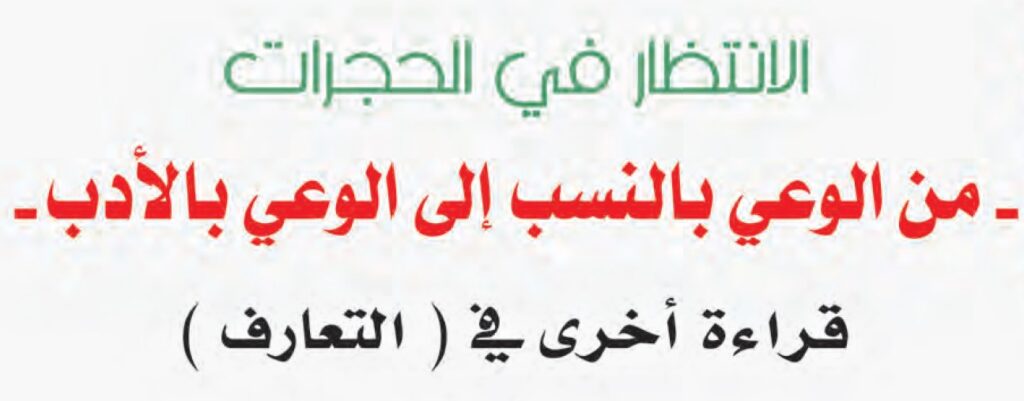

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 2 .. ص 108
رابط العدد 2 : اضغط هنا
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات : ١٣) .
في الآية وحدات بشرية أربع : ( الناس ) ، و ( الشعوب ) ، و ( القبائل ) ، و أصغر وحدة فيها ( الذكر والأنثى ) ، وفيها تحديد لوظيفة الخلق وعلته في ( التعارف ) . ورغم أن التعارف في معناه العام هو المعرفة والعرفان ؛ وهمـا وجـهـان يجمعان الحسي والقلبي معاً ، فإن النظر إليه في هذه الخلية البشرية الصغرى ( الذكر والأنثى ) من جسد البناء البشري يعطي للتعارف معناه السياقي الدقيق، وهو الأمر الذي يتجلى خلال علاقتين أساسيتين :
– علاقة عمودية تقوم على التقابل والاختلاف والتضاد ، وهي التي تمثل التقاء الذكر بالأنثى التقاء يثمر عنه تواصل واتحاد بينهما .
– علاقة أفقية تقوم على الانتشار والتكاثر والتوالد الذي يجعل الاثنين أربعة والأربعة ثمانية في متوالية هندسية مستمرة . وقد عبرت الآية عن العلاقة الأولى بـ ( الخلق ) ، وعن الثانية بـ ( الجعل ) ، يبدو فيها الأول غيابياً يجيء من العدم، كما حدث لــ ( آدم وحواء ) ، والثاني حضوري يتناسل عن زوجه الموجود في العلن عبر عنه بــ ( البث ) كما تؤكده الآية الأخرى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) (النساء: ١) .
لقد اختار من صور البناء البشري صورتين تعبران عن هاتين العلاقتين وهما ( القبائل ) و ( الشعوب ) ، تمثل (القبائل ) الصورة العمودية في علاقة الاتصال والاختلاف والتقابل ، وهي جمع (قبيل) مثل قبائل الرأس، وقبائل الشجرة، وهي أيضاً في المآل الأخير : الجماعة من الناس من قوم شتى كالزنج والروم والعرب كما جاء في مادة ( قبل) في لسان العرب . وأما ( الشعوب ) فتمثل الصورة الأفقية في علاقة التوالد والانتشار والبث والتكاثر، وهو أمر واضح في جذرها الدلالي (شعب ) وقد سميت شعوباً لأن القبائل تشعبت منها كما يقول الزمخشري الكشاف مج 4، 374 – 375.
هذا هو ( التعارف ) البشري الذي يقف فيه الناس جميعهم على حد المساواة ، يشتركون في حق الوجود ، والإيجاد واستمرار الحياة وتدفقها في تواصل حسي يحدده ( النسب ) ، بنيته الصغرى (الذكر والأنثى)، وبنيته الكبرى هم (الناس).
(2)
هناك ( تعارف ) آخر في الآية يتجاوز هذا المفهوم الحسي إلى آخر عقلي لا يقوم على ( التساوي ) ولكنه يقوم على ( التفاضل ) : ( أكرمكم ، أتقاكم) ، هذا المستوى يتحدد بمقدار القرب والبعد عن الله ، ويعطي لمعنى ( المعرفة والعرفان ) بعدها العقلي والعملي بحيث تنتقل من المعرفة البشرية في (النسب ) إلى المعرفة العقلية في ( التقوى ) . كيف يمكن أن نحدد الأكرم والأتقى في الوقت الذي نظل فيه في سياق الخلق والتوالد والبث ، في مثال
عملي وواقعي يكون مناسباً لهذه الحالة ؟ هناك مثال نموذجي هو مثال ابني آدم اللذين يمثلان مطلع التعارف والبث البشري قبل أن يصبح الناس شعوبا وقبائل ، لقد حدث معهما قطع لهذا (التعارف ) فيما يمكن أن نسميه بـ (التجاهل ) .
في اختبار عملي للتقوى في مثال العطاء، قدم هابيل أفضل ما عنده قرباناً لله ، وقدم قابيل أسوأ ما عنده ، فتقبل الله الأحسن ولم يتقبل الأسوأ، ورغم أن الخطأ واضح والخلل موجود
في ( التقوى ) ، (علاقة الفرد بالله ) وبدلاً من مراجعة هذه العلاقة ومعرفة السبب الحقيقي – وهذا هو ( العدل ) – توجه قابيل مباشرة إلى قطع التعارف البشري بحرمان أخيه حق الحياة وتجاهله بـ ( القتل ) ! كما قطع التعارف العقلي بـ ( الظلم ) ؛ لأنه لم يرد نتيجة فعله إلى سببها الحقيقي وهو ضعف التقوى ونسيان الله وتفضيل الذات على محبة الله ، هذه التقوى التي لم تخل منها الآيات السابقة كلها :
– إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
– يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
– إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
هكذا فكر قابيل فتوصل إلى القرار العقلي الظالم والمغلظ : ( لأقتلنك ) ، مطيحا بالتعارف على مستوى التفكير والنظر ، شافعاً إياه بالفعل والعمل : (فقتله ) ، مطيحاً بالتعارف على
المستوى البشري ، قاطعاً حبل النسب لهابيل إلى الأبد، الأمر الذي استدعى تشريعاً لإدانة القتل وتجريمه في البشرية على مدى الحياة ” أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ” وهذان الجانبان النظري والعملي هما الجانبان اللذان حددتهما الآية منذ البداية : جانب العلم والخبرة معاً : “إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” .
(3)
إن التعارف العقلي يقوم على المعنوية : الفكر والقلب والفؤاد، أما قطعه فأمر يقوم على الحسية معتمدا الجوارح : اللسان واليد ، وهو ما بدا ظاهراً في : ( قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ) و ( فَقَتَلَهُ) لذا نجد سورة الحجرات التي تنتمي إليها هذه الآية تعبر عن هذا الوعي وهو يتجه من الحسية إلى المعنوية ، إنها مجموعة من الآداب والقيم التي تنتج من التفاعل والتعامل مع الناس ومعرفة الآخرين بطريقة تكشف مستوى الوعي وهو ينتقل من الحواس الخارجية السطحية إلى الحواس الداخلية العميقة في الإنسان ، مثل : النهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي ، و ،، والجهر له بالقول ، والحث على غض الأصوات ، وعدم النداء من وراء الحجرات ، وهي كلها أفعال تتعلق بالفم واللسان والحنجرة ؛ لذا وصفهم بافتقاد العقل ( لَا يَعْقِلُونَ) ووجههم إلى فعل قلبي وهو الصبر ( وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) ، ومثل التبين في الأنباء التي ينقلها الفاسق ، حتى لا يؤدي بهم هذا الفعل للوقوع في الجهالة والندم ، ومثل تحبيب الإيمان في القلوب وتزيينه في النفوس، وتكريه الكفر والفسوق والعصيان والإصلاح الذي يعتمد العقل والحكمة بين طائفتين مقتتلتين من المؤمنين ، والإصلاح بينهما بالعدل ، والأخوة بين المؤمنين ، وعدم السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب الذي ينافي الإيمان ويؤدي للظلم ، ومثل اجتناب الكثير من الظن وعدم التجسس والغيبة التي تشبه فعلاً يقوم به الفم : أكل لحم الأخ ميتاً ، ومثل التفريق بين الإسلام الذي يقوم على فعل اللسان والجوارح ، والإيمان الذي يكون محله القلب في نموذج بسيط وغير واع من البشر هم (الأعراب) ، وهي كلها أفعال وقيم وآداب تنتقل من الحسية المعتمدة على اللسان والجوارح ، في اتجاه نحو العقل والقلب والصبر والتأني والتفكير والعدل ، إنه التعارف في عمقه المؤدي إلى التفاعل والتزاوج وإيلاد الأفكار وتداولها ، وارتفاع الإنسان من مستوى العاطفة والتفكير البسيط والساذج ، إلى مستوى العقل المنتج في أعلى درجاته في الإنسان .