أضواء
صالح مبارك عصبان

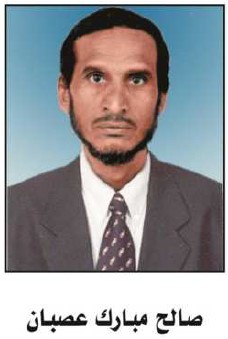
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 28
رابط العدد 3 : اضغط هنا
يمثل الأستاذ علي عقيل بن يحيى (١٣٤٢ – ١٤٠٨ هـ ) / (۱۹۲۳) – ۱۹۸۷ م ) أنموذجاً متميزاً في تاريخ الحركة الوطنية في جنوب اليمن لما اتصف به من صفات، أهمها أنه جمع بين النضال الوطني من خلال العمل السياسي والمثقف الواعي، وقد بدأ تاريخه الوطني مبكراً ، بل في السنوات الأولى من شبابه، إذ شاء القدر أن يتعرف على شخصيات وطنية تحمل أفكاراً معادية للاستعمار، فظهرت مواقفه المعبرة عن تبلور وعيه الوطني عبر اشتراكه في عدد من الجمعيات الوطنية، لينتقل بعدها إلى مرحلة متقدمة بعد ابتعاثه إلى سوريا للدراسة عام ١٩٤٧م والتحاقه بحزب البعث العربي الاشتراكي، ثم عاد إلى حضرموت قادماً من الكويت التي عمل بها في دائرة المعارف، وبدأ في بث الوعي والتحذير من خطر الاستعمار، وشارك في عدد من المؤتمرات والمظاهرات المنددة باتفاقيات الحماية والاستشارة ليعود مرة أخرى إلى سوريا عام ١٩٦٦م بعد انتخابه عضواً في القيادة القومية لحزب البعث، وبعد الاستقلال – عام ١٩٦٧ م – عاد إلى حضرموت ، ومع ظهور موجات الانقسام والانتقام في صفوف الحركة الوطنية آثر التوجه إلى العمل الثقافي فعين في المركز اليمني للأبحاث الثقافية والمتاحف بعدن، وأسهم إلى حد كبير في حفظ الموروث الفكري والثقافي في الجنوب ، وتفرغ من خلال عمله للبحث (۱) .
ترك الأستاذ علي عقيل أبحاثاً متعددة الأغراض ، في التاريخ والأدب والشعر الشعبي والثقافة، وفي موضوعنا هذا نحاول تتبع القضايا التاريخية التي اهتم بها وملامح الكتابة فيها، وهو كغيره من الكتاب والباحثين يؤخذ من كلامه ويرد، وبالضرورة لابد أن تؤثر على أبحاثه عوامل مختلفة من حيث المحيط الفكري والسياسي وأثر الزمان والواقع، وبناء عليه فقد يتفق القارئ معه في آراء ويختلف في أخرى، بل ربما نراه يبعد النجعة أحياناً ، لكن تظل أبحاثه غنية بالفوائد. وتتسم بالعمق والوضوح وحشد كثير من الشواهد والأدلة .
ومن العناوين التي كتبها في مجال التاريخ نورد أمثلة على سبيل المثال لا الحصر، منها : لمحة تاريخية عن شبام. في سبيل فهم جديد لتراثنا، المقاومة الشعبية لبدايات النفوذ البريطاني في سواحل حضرموت … وغيرها من الأبحاث التي نستعرض بعضاً منها في السطور الآتية :
تاریخ حضرموت :
ينظر الأستاذ علي عقيل إلى التاريخ بوصفه تراثاً يحمل وقائع وأحداثاً وعلاقات الناس فيما بينهم، ويؤكد على ضرورة تدوينه لمعرفة تطور المجتمعات وفي التاريخ الحضرمي أصدر كتاباً عام ١٩٤٩م بدمشق بعنوان (حضرموت) ، وجاء تأليفه – كما بينه في مقدمة الكتاب بهدف ( أن يعطي الشباب القومي في بلاد الشمال العربي فكرة عن حضرموت)، منطلقاً من فكرة قومية للتعريف بهذا البلد ، وليكون أيضاً نافذة للشباب الحضرمي المعرفة بلاده.
والكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه أحاط بأوضاع حضرموت من الناحية الجغرافية والسكانية والمدن واهتمام المستشرقين بالمنطقة، وتاريخ حضرموت القديم والعصر الإسلامي والتاريخ السياسي الحديث، والتعليم والأدب والعادات والتقاليد، ويختلف إلى حد ما عن غيره من المؤرخين الحضارم في أنه أعطى مساحة كبيرة للتاريخ المعاصر باعتباره أحد المعاصرين للأحداث والتحولات ، خاصة في المجالين السياسي والتعليمي، ووضع عنواناً خاصاً ( للحركة السياسية ) ، التي اعتبر أول نشوء لها عبر تشكيل الجمعيات والجهد الشعبي والمؤتمرات، لتتجه لاحقاً إلى شكل تنظيمي بتكوين ( هيئة وحدة حضرموت ) و ( الحزب الوطني ) غير أنه يؤكد أن تلك الفعاليات السياسية لم تتحرر من العصبية القبلية والمناطقية (٢) .
ويناقش عبر النظر القومية ، قضية (وحدة حضرموت ) وارتباط حضرموت بالجنوب العربي فيقول : (وبنفس إيماننا بالقومية العربية بما تزخر به من قوة وحقيقة وخلود، وهذا هو نفس إيمان الجنوب العربي بالجامعة في كل ما يعلق عليها من آمال و ينتظره من عطف وعون) (۳).
وفي الكتابة التاريخية عن حضرموت يحاول جاهداً التنقيب عن كل ما يتعلق بالآثار الدالة على حضارة المنطقة، ففي بحث بعنوان (تعيين مواقع بعض البلدان التي طمست في وادي حضرموت) يؤكد أن كثيراً من المدن والقرى والمواقع الحضرمية طمست بفعل الحروب والصراعات. ونتيجة لهذا استبدلت الأسماء، وضرب أمثلة ، كقارة الأشياء التي صارت تدعى ( حصن الرباكي)، ومسجد مسعود بن يماني في تريم الذي أصبح اسمه ( فضل بامقاصير) ، ومسجد الإباضية في شبام صار ( مسجد الخوقة ) وينطبق هذا الطمس – من وجهة نظره – على القبائل أيضا حيث تنتقل من طور الشهرة إلى طور الانغماس، ومن القوة إلى الضعف فيطمس الاسم ويتلاشى بفعل قوة الغالب وتسلطه ( ومن ذلك قبيلة ) تجيب) من بني الأشرس من كندة الذين كان لهم دور كبير في التاريخ الحضرمي، وفيهم مدن وزعامة …) (٤) . وبحلول القرن السابع الهجري لم يعد لهم ذكر، وسرد أمثلة أخرى على المواقع التي اندثرت، كقارة قشيب، وسروم، وبذل جهداً في الاستعانة ببعض المصادر والمراجع لبیان تاريخها ومكائها، ويبدو أن هذا الجهد مقدمة لبحث طويل ( لم أقف على نسخة منه ) .
وكذلك الحال في مقال مقتضب بعنوان ( كندة في العربية الجنوبية وهجرتها إلى القمر ) .. ذكر فيه أسباب هجرة القبائل اليمنية إلى العراق والشام ووسط الجزيرة العربية وارتباط ذلك بأحداث كبرى، والمقال مقدمة لبحث لم يكتمل . أما البحث الذي بعنوان ( ملامح من تاريخ مدينة شبام ) (5)، فيعد من أطول وأعمق البحوث التاريخية التي كتبها ولم يقتصر فيه على مدينة شبام فحسب بل توسع في التاريخ الحضرمي، وتناول موقع المدينة وأوديتها ومساجدها وعلماءها وطريقة العمران وأسباب ذلك النمط ، من حيث حدة الصراعات القبلية والمذهبية ، وتطرق إلى العهود السياسية فيها، وخاصة في العهد الإسلامي بقدوم عامل النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد الانصاري رضي الله عنه وتردده عليها، والعصور اللاحقة وبقائها كمقر للإباضية، ومروراً بالدويلات الأخرى ووصولاً إلى آل دغار ونهد وآل إقبال وآل يماني وآل كثير ودويلات يافع وانتهاء بالسلطنة القعيطية ، والأوضاع العلمية والاقتصادية والاجتماعية ومما يميز هذا البحث ما ورد فيه من إشارات لبعض القضايا المختلف فيها في التاريخ الحضرمي مثل ، تاريخ الإباضية بحضرموت، وصمت المؤرخين الذين كتبوا عن حضرموت عن ما يسمى بــ (مجاهل التاريخ الحضرمي ) ، ويرى (أن إهمال الأمويين والعباس يين لليمن وحضرموت أوقعها في وهدة عميقة من التخلف والجهل والعزلة ) (٦) ، ويرى أن شخصية الأمير الشاعر الإباضي إبراهيم ابن قيس الهمداني يحتاج إلى مزيد من التحقق ، على الرغم من أنه اعتبره أول عالم برز من علماء شبام في القرن الرابع الهجري (٧) ، ومن القضايا التي أثارها وذكر رأيه فيها ، مقارعة الإباضية وخفوت صوتها كسلطة وبقاؤها كعقيدة ) والغريب منه ما ذكره من عدم وجود تأليف في حضرموت إلا في وقت متأخر جداً ، ولا وجود لأربطة ولا مدارس في شبام في العهود الإسلامية الوسيطة والأخيرة (٩) .
تاريخ الفكر العربي والإسلامي:
يزخر التراث العربي والإسلامي بثروة فكرية سبقت ما يسمى بعصور النهضة الأوروبية، فقد كان السبق للأطروحات الفكرية لعلماء المسلمين، ويلتقط الأستاذ علي عقيل النماذج الأكثر حضوراً في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، ومن أشهرها تراث العلامة عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، الذي قال عنه بروكلمان : ( أن ابن خلدون صور وصاغ فلسفة هي بلا شك أعظم نتاج أبدعه أي ذهن في أي عصر وفي أي بلد ) (١٠) ، ونطالع المبحث الأول الذي كتبه الاستاذ علي عقيل بعنوان ( استطلاع آراء ابن خلدون في مسألة القبيلة ) الذي يفند فيه آراء ابن خلدون في تكون الدول وتلاشيها ، ويرجع ذلك إلى كثرة القبائل والعصائب، وأثر ذلك في نشوء ما أسماه (علاقات الإنتاج) وتغيرها أو تطورها ، ويقرر ) أن الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة) (۱۱) ويناقش الدور السلبي لسيادة العلاقات القديمة ( العصبية ) في تخلف المجتمع واختلال الدولة، وظهور تصرفات سيئة في المجتمع تفرضها المصالح الضيقة غير المشروعة التي ألن تنال إلا بالتنازع القبلي العشائري )، وأن القبيلة في أصلها طبيعية لكنها طور سابق للتحضر ومعيق له ) (۱۲)، وأنه كلما خلت البلدان من العصبيات سهل وجود الدولة وسيادة سلطانها، ثم يسقط الأستاذ علي عقيل رأي ابن خلدون على الواقع العربي اليوم ليقرر أن اضطراب النظام الاقتصادي بسبب أسلوب المعاش المتدني هو العائق نحو قفزة حضارية، أما في مقال بعنوان ( واقعية ابن خلدون في دراسته للتعامل مع البشر والتاريخ، فيستعرض المقولة الشائعة لابن خلدون (المغلوب مولع ابتداء بالاقتداء بالغالب )، ويعتبره غوصاً (سيكولوجيا ) في النفس البشرية، وطبيعتها وأخلاق وسلوكيات الناس وتعلقهم بالأحساب على حساب العلم والفضل، ويرى أن الغلبة تكون أيضاً بالمذاهب والمال والسلطة والجاه والعوائد، وحتى في وال المجتمعات، يحصل من المغلوب – وصولاً للتقليد – كثيراً من التصرفات كالخضوع والتملق (۱۳) .
قضايا في التاريخ الإسلامي:
نهل ابن يحيى من معين التراث الإسلامي قارئاً ومستمعاً، واستوقفته بعض القضايا التي عرض فيها وجهة نظره متأثراً فيها بمدارس فكرية قديمة ومعاصرة، ففي بحث بعنوان (صحة الموقف من البدء ) يفترض أنه كلما كان الموقف من الأمور صحيحاً منذ البداية، كان ذلك عاملاً من عوامل عدم الانحراف وتصحيح الأخطاء، وبعكس ذلك إذا سارت المواقف مع المخطئين ، إما طمعاً في منصب أو مال ، أدى ذلك إلى ظهور أوضاع سيئة – حسب وجهة نظره – ويضرب مثالاً بالموقف من (الحاكم ) ونشوء ما أطلق عليه بالمصطلح المعاصر ( الطبقة البيروقراطية ) المستفيدة من السلطة والسائرة في ركابها ، ويرى أن ما حصل بعد استشهاد الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وما حصل من مواقف تؤكد ما ذهب إليه من أثر المواقف، واعتبر الشيعة والخوارج من أصحاب المواقف المبدئية في رفض العهد الجديد ( ) (١٤) ، – والحديث عن الشيعة والخوارج يستلزم استصحاب الحديث عن أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة، وانحرافهم عن المنهج الصحيح – ، كما ذكر أن بعض العلماء آثروا الاعتزال، وأخرين ناصروا الحاكم . ووفقا لهذا الاستقطاب ظهر – حسب
تصوره – التعصب والتقليد .
أما في بحثه الموسوم بـ [ آل رسول والاضطراب في انتسابهم إلى غسان ومؤلفاتهم ] فقد تتبع اضطراب المؤرخين في هذه المسألة واستشهد بأقوال ابن سمرة والجندي وابن الأثير وابن واصل، ويعيد هذا الاضطراب إلى أن آل رسول دخلوا اليمن ضمن قوة عسكرية من الأيوبيين ، وينطبق الكلام نفسه على المؤلفات التي نسبت لسلاطينهم (١٥) . وتتجلى القيمة
العلمية لهذا البحث في قوة الملكة العلمية للأستاذ علي عقيل والرجوع في المسألة الواحدة إلى عدد كبير من المصادر والمراجع واستخراج الإشكالات والتمحيص والمقارنة، وقد يجانب
الحقيقة – أحياناً – وهذا من طبيعة أي عمل بشري، ويبدو أن الذي دعاه إلى تتبع هذه القضية ما لاحظه من خلط في الأسماء والأماكن والتأليف من قبل بعض المؤرخين، وضرب لذلك أمثلة ، منها أن السخاوي نسب كتاب [ العقود اللؤلؤية ] للملك الأشرف بن إسماعيل ابن عباس ابن رسول والحقيقة أنه للخزرجي . وفي مقال ( مصادرنا فيما يكتبه الآخرون عنا ) ، يتحدث عن كتابات الرحالة والسائحين في البلاد العربية وما يكتبونه من أساطير وحكايات لا تصح، ويستثني بعض المستشرقين الذين قال عنهم إنهم خدموا التراث، ويرى أن تفسير أولئك الرحالة للواقع والمجتمع العربي يخضع لتصوراتهم وأهوائهم ، ويطالب بأن يعرض كل ما كتبوه على ميزان النقد والتحري والتمحيص، بعيداً عن الانبهار به واعتباره من المسلمات أو من المراجع التي لا تقبل النقد (۱۷) .
التراث والتأليف :
وهذا باب يلحقه بمؤلفاته التاريخية من حيث ارتباطه بالتدوين، ولأنه عاش في بيئة علمية وعمل في لجان للاهتمام بالمخطوطات فقد أخذ حيزا كبيراً من اهتمامه، ويناقش في مواضيع متفرقة ماهية التراث، فيقول : ( التراث تلك الحصيلة المدونة من الحوادث والأعمال والقضايا والسلوك ] (١٨) ويطالب المثقف الواعي باستيعاب التراث وربطه بحاضره، ويطالع كتب التراث الإسلامي وأمات العلوم ويستخرج منها الشواهد مثل كتب ابن القيم والماوردي وغيرهما، وخاصة في قضايا الحكم والسلطة ويقارن بين أنموذجين حول صلاح الحكم وفساده، مبيناً تاريخ الخليفتين أبي جعفر المنصور وعمر بن عبد العزيز، من خلال النظر إلى تصرفات كل منهما وحاشيته، ومفردات العدل والجور والتواضع والتعالي، ويستدعي – تبعاً لتأثره الفكري – مصطلحات الفكر السياسي الأوربي من مثل ( تأثير البنية التحتية والفوقية ووسائل الإنتاج ). ويسمي هذا الاستنتاج ( تفسيراً علمياً ) (۱۹)، لكنه مع استصحاب هذه المصطلحات تميز عن الآخرين في أنه لا يذوب في دهاليز هذه المصطلحات أو يبتعد عن انتمائه العربي ، بل يحذر من ( الاغتراب الثقافي ) والتبعية للآخرين فيقول : ( إن المعاصرة معيارها الحقيقي الاستفادة من ثقافة العصر على مستوى العالم كله لكن دون ذوبان للذات )، ويؤكد على عدم القطيعة مع أصول المسلمين وخاصة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب العلوم الشريعة والتراث العربي الإسلامي (٢٠). وحول المخطوطات كتب بحثاً بعنوان [التأليف والمخطوطات في الشطر الجنوبي من اليمن ] واشتمل على معلومات قيمة عن حركة التأليف في اليمن عامة وحضرموت خاصة، وتطرق إلى ما فقد من مخطوطات حضرموت، ونشوء المكتبات ، ويسطر بحثاً عن المخطوطات مرة ثانية بعنوان [ الموقف العلمي من التراث والمخطوطات خاصة] ويحذر مرة أخرى من التعامل الفج مع التراث بحجة أنه نتاج فكر طبقي ساد فترة من الزمن ، ويرى (أن الموقف العلمي هو الحفاظ على الكتب والمخطوطات) والاستفادة منها، لأنها أصبحت وسيلة المعرفة المراحل التاريخية، وأن إهمالها والقضاء عليها هو التخلف ذاته (٢١).
وختاماً فإن الحديث يطول عن الكتابة التاريخية عند الأستاذ علي عقيل، وحسبنا أننا أوردنا نماذج مع بعض ملامح هذه الكتابة.
هوامش :
(1) المزيد من الاطلاع على سيرته انظر، علي بن عقيل انشودة الوطن والثورة اتحاد الأدباء والكتاب بحضرموت، و علي عقيل بن يحيى من مسيلة آل شيخ إلى دمشق)، جمع وترتيب
هود سالمين عبيد .
(۲) انظر علي بن عقيل، حضرموت، مطبعة سوريا بدمشق ١٩٤٩ م ص ٦٩ وما بعدها . (۳) المصدر السابق ص ٨٤
(٤) انظر علي عقيل بن يحيى من مسيلة آل شيخ إلى دمشق ص ٧٦،٧٥
(٥) المصدر السابق ص ۱۹۸.
(٦) المصدر السابق ص ۲۲۰،۲۱۸،۲۱۷
(۷) انظر المصدر السابق ص ۲۲۰ ، ۲۷۰ .
(۸) المصدر نفسه ص ٢٢٤ .
(۹) المصدر نفسه ص ٢٦٩ .
(١٠) المصدر نفسه ص ٣٤٠ .
(۱۱) المصدر نفسه ص ٣٤٤ .
(۱۲) المصدر نفسه ص 346.
(۱۳) المصدر نفسه ص 352 – 359.
(١٤) انظر المصدر نفسه ص ۱۸۷،۱۸٦.
(۱٥) انظر المصدر نفسه ص 273 – 297
(١٦) المصدر نفسه . ص ۲۹۹ .
(۱۷) المصدر نفسه ص ٧٥ .
(۱۸) المصدر نفسه ص ۳۲۲
(۱۹) المصدر نفسه انظر ص ۳۳۷
(٢٠) المصدر نفسه انظر ص ۳۳۹
(۲۱) انظر المصدر نفسه ص ١٣٤، ١٣٥.