دراسات
أ.د. عبدالعزيز سعيد الصيغ
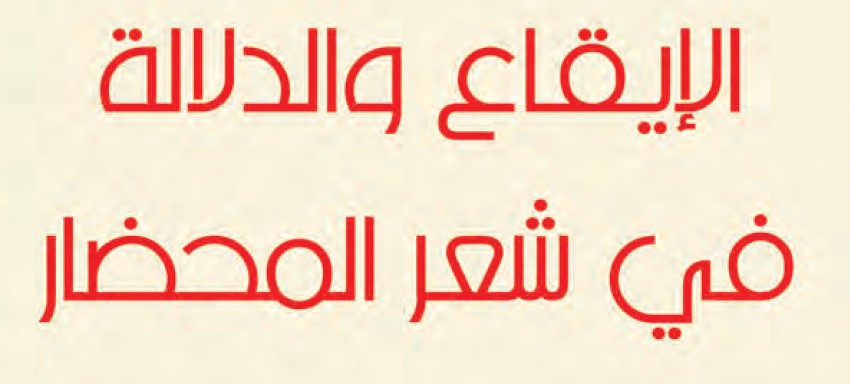

تحاول هذه الأوراق أن تجلي جانبين من جوانب التجربة الإبداعية في شعر الأغنية عنده، جانب الإيقاع، وجانب الدلالة، وهما جانبان يحيطان بأغاني المحضار إحاطة تامة .
الإيقاع يتناول جانب النغم في اللغة وفي الموسيقى، والدلالة تتناول جانب المعنى في اللغة، والمحضار له فيهما منازل عليا، فقد نبغ نبوغا في جانب الإيقاع الموسيقي لم يسبق إليه، كما نبغ في جانب المعنى والدلالة في الشعر الشعبي نبوغا ارتفع باللهجة الحضرمية التي كتب بها إلى مرتفعات عليا .
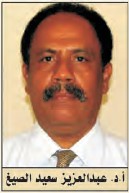
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 55
رابط العدد 3 : اضغط هنا
لم يكن المحضار منذ بداياته الأولى شاعرا عاديا، ولم يقف كمتذوق محب للموسيقى التي كانت تنساب في حلبات الرقص الشعبي كمتذوق وإنما حمل على أكتافه منذ البداية مشروعا فنيا هجست به نفسه، ثم أفضى به إلى من كان قريبا منه ، ثم أخرجه إلى عالم الواقع ، هذا المشروع هو تطويع ألحان الرقص أو الشرح كما يسمى للأغنية التي كانت تشكو من فقر الألحان وكانت تعتمد على ألحان تركية وهندية وصنعانية، يقول بامطرف : ” أتى على الأغنية حين من الدهر أصبحت فيه مسخا مشوها فهي أما صدى أصم للحن هندي أو سرقة من لحن عربي قديم ذي مسحة تركية أو أنها كانت أغنية بدائية ذات نغم متكرر ممل كالضربة على الطبل أو كالنقر على وتر واحد ” (1)
ويقول سعيد عبد المعين : ” من المقهى في سطوح نادي الكوكب بالشحر كانت البداية.. لقد ضمتني جلسة ذات مرة بالمحضار وعازف الرق سعيد الجاوي في مقهى النادي كالعادة ، ولكن المحضار .. أتانا مثقلا بالأفكار الحديثة والرؤى الجديدة .. وكان مضمون تلك الأفكار يدور حول إمكانية تطويع الألحان والرقصات والألعاب الشعبية الحضرمية .. للغناء.. سألته عن اللون الغنائي الذي سنحاول تطويعه للطرب فأجاب : الشرح أي الهبيش ، أخذ زميلي الجاوي معشرة الشاي وأخذت ملعقة السكر وأمامي كأس فارغ وأنشد المحضار حينها بيته الأول:
یا رسولي توجه بالسلامة
زر صحابي وبلغهم سلامي
قل لهم عاد شي في الوصل حيلة
ليه لا أوعدوا خلفوا المواعيد (۲)
هذه البداية المبكرة له في هذا الشعر الناضج القوي، كشفت عن موهبة استثنائية ليس في الشعر وإنما في التأليف اللحني، واجتماع الخاصيتين فيه برهنت عن حالة إبداعية تمثل ظاهرة في الشعر وفي الغناء حــ افظ عليها، وعلى تطورها واستمراريتها حتى لامس فيها أفاقاً عليا قل أن يصل إليها الموهوبون .
وهو رجل إيقاعي بمعنى الكلمة، فقد كان يتخير ألفاظ كلماته تخيرا، بل أصوات كلماته، كما كان يتخير ألحانه ، وهذا التخير دليل على أنه كان يأخذ من صندوق لغوي مليء بالمفردات وكان على وعي لغوي كبير بها، كما كان يأخذ من صندوق لحني مليء بالألحان ، وكان على وعي لحني كبير بها، وقد أصاب الاستاذ بامطرف حين وصفه بالدائرة الموسيقية.
إيقاع الأوزان والقوافي :
كان للمحضار مهمتان يضطلع بهما وهو يتصدى لتأليف أغانيه المهمة الأولى تتمثل في البناء اللغوي للأغنية، والمهمة الثانية في البناء اللحني لها، وليست الثانية بأقل أهمية من الأولى، وربما زادت عليها . والبناء اللغوي للأغنية له مقتضيات من اختيار المفردات ووضعها في أماكنها المناسبة، وصياغتها في تراكيب تحافظ على موسيقية اللغة، فالبناء اللغوي له موسيقيته، مثل اللحم ن تماما هذه الموسيقية أو الإيقاع يأتي من جوانب لغوية متعددة، منها ما يطلق عليه الوزن العروضي، ومنها ما يسمى موسيقى اللغة والوزن العروضي ينقسم على أوزان البحور، وقوافيها .
إيقاع الوزن :
يكثر الحديث حول أوزان اغاني المحضار هل هي أوزان مستقلة يمكن النظر لها في إطار أوزان الشعر الشعبي، أو أنها أوزان خاصة اعتمد المحضار فيها إيقاعات الرقصات الشعبية؟ وإذا كانت كذلك فهل يمكن إفرادها والحـديث عنها، أو أنها ممتزجة بإيقاعات الرقصات الشعبية و الحانها امتزاجا يتعذر الفكاك منه ؟ .
النظر إلى أغاني المحضار بوصفها أبنية شعرية لغوية يجعل قضية الوزن فيها قضية يسيرة ، فهي تندرج في إطار أوزان الشعر الشعبي، ويمكن فهم حديث المحضار الذي أدلى به صوتيا فهما خاصا، فقد صرح في مقابلة مع الصحفية التونسية كوثر البشراوي في قناة (ام بي سي) بقوله : ” الأغاني تتقيد باللحن ، وميزانها اللحن (۳) ، وهو حديث يمكن الوقوف عنده مليا، ولكنه لا يمنع من القول أن أغاني المحضار نصوص شعرية كتبت بلغة عامية، وانتظمت في إطار شعري شعبي له أحكامه الفنية التي لم يخرج عليها المحضار من الأوزان والقوافي . وفي حديث الإيقاع اللحني الذي سنتناوله سيكون تفصيل مسألة الأوزان والألحان في أغاني المحضار، أما هنا فنحن بصدد الحديث عن أوزان وقوافي شعر المحضار بوصفها نصوصا لغوية شعرية عامية اللغة تندرج في إطار عام لا تخرج منه. والواقع أن عبارة المحضار لا تنفي وجود الأوزان، بل إن الأوزان والألحان بينهما اشتراك ، فالموسيقى أصوات واللغة أصوات ، ولكل منهما إيقاعات والإيقاع هو تناسب في الأصوات يحدث لذة في الأذن ويقوم في الموسيقى على النقرات ، وفي الشعر على التفعيلات .
بنى المحضار أغانيه بوصفها نصوصا شعرية على أوزان الشعر الشعبي التي لها مقاييسها، وهي أوزان تتفق مع أوزان الفصيح في أحوال كثير وتفترق معه في أحوال أخرى، ويردد الناس أبيات أغاني المحضار وجمله الشعرية، دون أن يستحضروا في كثير من الأحيان ألحان هذه الكلمات، ذلك أن الوزن والبناء الشعري في هذه الجمل والأبيات يوفر لهم المتعة اللحنية إذا جاز التعبير.
الوزن عند المحضار يتصل بالألحان اتصالا قويا، ولذلك تخرج كثير من الأغاني عن دائرة الأوزان خروجا لافتا إلا أنه يتقيد بالمقاطع التي يبدأ بها تقيدا صارما في جانب الوزن، ويمكن الحديث عن الوزن من جانبين ، جانب اللغة وهو ما يمكن إطلاق مصطلح العروض عليه، والثاني جانب الموسيقى أو اللحن، فأوزانه إذن يتجاذبها هذان الجانبان .
فقد بنى المحضار أغانيه على ايقاعات الرقصات الشعبية، وهو خبير في ذلك يقول بامطرف في مقدمة الدموع : ” نجد الديوان عامرا بالأغاني الراقصة المتراوحة بين (الصخب) و ( الانسيابية) وكلها تفسر جانبا واحدا وهو المرح الاجتماعي على ما عرف بين الحضارم في أفراحهم، وإنك لواجد .. رقصة (الخابة) في أغنية ( من حسانك تفضل جود لي باللقاء وستجد رقصة (الغية) معبرا عنها أحسن تعبير في أغنية (نوب جردان يلقي عسل ) ، وسيجد عشاق رقصة الساحلي) بغيتهم في أغنية أنا وخلي تراضينا وقسمنا الهوية بخيرة ) أما رقصة (الدرجة) فمجالها أغنية ( صابر وفي القلب ما فيه ) (٤) ولا شك أن بامطرف هنا يذكر أمثلة من أغاني المحضار، ولعله ير إلى أن أغانيه كانت خارجة في معظمها من معطف ألحان الرقص الشعبي. هذا التداخل الكبــ ير في أوزان أغاني المحضار بين اللحن الراقص ( المأخوذ من الرقص ) والوزن الشعري العروضي منح أغانيه موسيقية عالية، وأكسبها
خصوصية حتى ليمكن القول إن أوزان أغانيه يتجاذبها عنصران عنصر لحني وعنصر عروضي، وهذا الذي دفع بامطرف إلى التساؤل قائلا: ” إذا ما طلب أحد منا أن تحدد موهبة المحضار الأولى وهل هو شاعرا أولا أم أنه ملحن أولا وشاعر ثانيا ترددنا في الحكم عليه، ولربما قلنا على سبيل الحكم غير المبرم أن المحضار ملحن في المقام الأول وشاعر في المقام الثاني لأن لألحانه الفضل في ذيوع أشعاره بين الناس ولولا تلكم الألحان لما عرف الناس من أشعاره إلا النزر اليسير وفي نطاق محدود ، لكن المحضار بحكم المهارة في صنعته الشعرية المتقنة يجعل لحنه
وشعره في حالة تنافس مستمر من حيث التأثير على النفوس فلا تدري أكان اللحن هو المفضل أم أن الشـ عر كان الأجدر بالأفضلية “(٥) .
وإذا كان الأستاذ الكبير قد تساءل عن المحضار الملحن والمحضار الشاعر وأيهما مقدم على غيره ، ومال إلى تقديمه ملحنا ، فإن تساؤلا آخر ينتصب أمامنا هو ، هل أغاني المحضار تقوم على أوزان الشعر الشعبي، أو على أوزان الرقصات الشعبية؟ وما هي الصلة بين الوزنين؟
وقد تقدم قول بامطرف إن المحضار أقام أغانيه على أنغام الرقصات، وأهم من ذلك أن المحضار نفسه قد صرح في مقابلة مع الصحفية التونسية كوثر البشراوي في قناة (ام بي سي) بقوله : ” الأغاني تتقيد باللحن ، وميزانها اللحن ” (٦)
وقد قطع المحضار القول بأن أغانيه تقوم على اللحن لا على الوزن ، إلا أننا حين نتأمل كثيرا من أغاني المحضار نجد استقامة أوزانه على مقاييس اللغة، فأشطار أغانيه منضبطة الوزن، ويمكن وضع تفعيلات لها من تفعيلات العروضيين .
والواقع أن الألحان مادتها الأصوات واللغة مادتها الأصوات، ولذلك فإن اللحن هو تناسب في الأصوات، كما أن الوزن والتفعيلات هي تناسب في أصوات اللغة وإذا كان اللحن يقاس بالنقرة فإن الوزن الشعري يقاس أيضا بما يشبه النقرة وهو السبب ( حرف متحرك + حرف ساكن ) ولذلك فإن التداخل بين الوزن واللحن كبير، وربما يلتقيان ويتحدان معا في صورة
من الصور.
يذكر المؤرخون أن الخليل بن احمد حين اخترع العروض كان باعثه عنده التناسب الذي كان يسمعه من سوق الحدادين الذي كان يمر به في طريقه، بل إن كثيرا من الباحثين وحد بين تفعيلات العروضيين وإيقاعات الألحان .
الأوزان :
تقلب المحضار في تخير أوزان أغانيه بين الخفيفة المرحة التي تتناسب معها الجمل القصيرة والمفردات البسيطة السهلة . وبين الأوزان الثقيلة الطويلة التي تذكر ببحور الشعر في الفصحى كالطويل والبسيط والكامل، وقد رأى الباحثون في الشعر العربي أن هذه البحور لاءمت موضوعات وأحوال خاصة فهي أقرب إلى شعر المدح والرثاء والحكمة، كما لاءمت البحور الخفيفة والمجزوءة حالات أخرى . وعلى الرغم من أن الحديث هنا عن شعر الأغاني الذي يتلاءم مع الأوزان الخفيفة والمجزوءة إلا أننا نجد أن المحــضار استخدم بحورا طويلة ثقيلة وبحورا خفيفة ، ولا داعي للتدليل على أوزان البحـور الخفيفة فهي الأصل في الغناء ، ومن الطويلة نجد الأغنية الآتية:
يا اهل الطويلة علينا يدكم طايلة
ورماحكم فاتكة وسهامكم قاتلة
حتى الغليا عندكم تمشي وهي جافة
والريم ما ينقنص ويكابرين الوعول
نا جيت بازوركم يا أهل الطويلة
عسى شي عندكم لي قبول (۷)
والطريف أن وزن هذه الأغنية هو وزن البحر البسيط في الفصحى الذي يعد من البحور الطويلة، وقاموس هذه الأغنية ومفرداتها تحيلك إلى الشعر الفصيح ، حتى أنها تكاد أن تجرد من الألفاظ العامية.
ومن الأغاني التي تستوقف الباحث ببطء أوزانها ، وقربها من الأوزان الطويلة وبموضوعها الذي يتناسب مع البحور الطويلة أغنية ( الصبر أولى ) يقول فيها :
الهوى حاكم مسلط عا نفس غصب وقلوب
لا حكم ما في حكامه شي انقلابه
كم وكم خرج صحابه من رواشين وغلوب
بعد ريح النصر حسوا بالغلابه (۸)
والطريف أن وزن هذه الأغنية من بحر الرمل الذي يكتسب خفة بتفعيلاته الثلاث ويكفي أن نتأمل أغنية الأطلال لأم كلثوم وهي من الرمل لنعرف خفة الوزن :
يا فؤادي لا تسل أين الهوى
كان صرحا من خيال فهوى
اسقني واشرب على أطلاله
وارو عني طالما الدمع روى
كيف ذاك الحب أمسى خبرا
وحديثا من أحاديث النجوى
ولا شك أن هذه الإطالة في الوزن بزيادة تفعيلة رابعة هي التي أثقلت ميزانه وأكسبته بطئا، ولكنها منحته جلالا يتناسب مع جلال المعاني التي ساقها المحضار في هذه الأغنية .

واستكمالا لحديث أوزان الأغاني أقول لقد تتبعت أغاني المحضار في ديوانيه الأول
والثاني، فوجدتهما يغلب عليهما أوزان لا تنتسب إلى الشعر الفصيح ولا إلى الشعر الشعبي لا سيما أوزان شعر الشبواني المربوع والمخموس ، والمسدوس والمثمون .
ففي ديوان دموع المشاق وجدت إحدى عشرة أغنية من بين اثنتين وخمسين لها أوزان معروفة في الشعبي والفصيح منها تسع أوزانها أوزان الفصيح وهي السريع والهزج، والرجز والوافر والرمل ، وأغنيتان من بحر شعبي هو المربوع على النحو الآتي:
ويستنتج من ذلك أن هذه الأغاني تمضي على أوزان الشعر الفصيح والعامي، ولكنها
لا تلتزم قواعده التزاما صارما، بل هذه الأغنيات المذكورة في الجدول تنتمي إلى هذه البحور في أبياتها أو أشطرها الأولى فقط . ومن خلال أبحر الفصيح الخمس المذكورة ( رجز ، رمل ، وافر ، سریع هزج) نجد أنها من البحور ذات التفعيلة الواحدة، ويلتزم الشاعر فيها تفعيلات ثلاث في كل شطر، أو أقل، ولا يزيد، في حين أن اللحن في الأغنية التي تأتي على هذا الأبحر، قد يتطلب زيادة تفعيلة أو أكثر، ولمعرفة ذلك نتأمل الأغنية :
أعود له من بعد ما خانني
استغفر الله
فإن الشطر الثاني به تفعيلة مرفلة كما يقول العروضيون فوزنه ( مستفعلاتن) أي أن اللحن اقتضى إطالة الكلام قليلا ونكتفي بهذا في ما يخص الوزن .
القوافي:
القافية هي المصدر الثاني الذي يعتمد عليه الإيقاع الشعري، فالقوافي واختيارها وتنوعها تظهر جانب البراعة عند الشاعر وهي محطات الكلام فالبيت يقف عندها والشاعر يوقع عليها قصيدته وفي الفصيح تنسب القصيدة إلى القافية فيقال بانية أو سينية أو لامية نسبة حرف القافية الأخير والمحضار عني بالقافية عناية فائقة بل إن القافية تفنن بها تفننا كبيرا، وإذا كان اللحن هو الموسيقى التي اعتمد عليها المحضار في أغانيه، فإن القوافي هي بمثابة الموسيقى التي اعتمدها المحضار في بناء أغانيه وأشعاره فيها.
وقد التزم في القوافي التزامات كثيرة وكان بارعا، لا تشعر وأنت تسمع أو تقرأ نصوصه الغنائية أنه مقيد بهذه الالتزامات ، ولتأخذ النص الأول الذي كتبه بحسب كلام سعيد عبد المعين السالف ذكره:
يا رسولي توجه بالسلامة
زر صحابي ويلفهم سلامي
قل لهم عاد شي في الوصل حيلة
ليه لا اوعدوا خلفوا المواعيد
عدهم ما هني طرفي منامه
بات ليلي تزعل في منامي
واذكر الا ليالينا الجميلة
لي مضت في سفوح الخرد الغيد (۹)
واللافت في هذه الأغنية التي مثلت البداية أن الشاعر إلى جانب براعته في تأليف الكلام فيها، فقد التزم التجنيس ، فكان في كل مقطع يجنس (سلامه / سلامي ) ( منامه / منامي ) وهو عبء على الشعراء لا سيما المبتدئين منهم، وقد صار هذا سمتا له رافقه في جميع أعماله الغنائية وغيرها .
الإيقاع في اللغة:
يتمثل الإيقاع اللغوي في النغمات اللغوية التي تنتجها الآليات اللغوية ، فموسيقى اللغة تكمن في التناسب الصوتي الذي يحقق العذوبة والجمالية ، وتتمثل في مستويات اللغة الثلاثة: الصوتي والصرفي والتركيبي ، ففي الصوتي تتمثل في الحروف ، وفي الصرفي تتمثل في الكلمات . وفي التركيبي تتمثل في الجمل.
الإيقاع في الحروف :
اللغة أصوات ، أو حروف تشكل المكونات الأولى للغة، وهذه الحروف توضع بطريقة خاصة لتتولد منها الكلمات ثم لتتشكل من الكلمات اللغة، ولذلك فالمادة الأساسية للغة هي الحروف أو الأصوات، والإنسان يتخير من هذه الأصوات مفردات لغته ، ولذلك يبدو كلاما ما منسقا جماليا عذبا، ويبدو آخر خاليا من أي عذوبة، بسبب هذا الاختيار.
والإيقاع أو التناسب في الأصوات يعد أساسا من أسس هذه الجمالية الصوتية أو العذوبة، والشعراء أكثر منشئي الكلام حفاظا على التناسب أو الإيقاع في كلامهم وهم متفاوتون في الوصول إلى درجات الحسن والابداع في الكلام ، وقد تحدث العرب كثيرا عن جماليات الكلام ، وذكروا بيت الشاعر أسماء بن خارجة الذي يقول فيه :
وحديث الذه هو مما
ينعت الناعتون يوزن وزنا
منطق رائع، وتلحن أحيانا
وخير الحديث ما كان لحنا
وإيقاع الكلام سواء أكان نثرا أم شعرا يبدأ بوقع أصواته ، ويتمثل إيقاع الأصوات في اختيار الأصوات ذات النغمة الموسيقية الأعلى، كالميم والنون واللام، والكلمات التي يكون تأليف الأصوات فيها غير متنافر فالكلمات التي تكون الحروف فيها متقاربة المخارج تكون ثقيلة في النطق والتي تكون بعيدة المخارج تكون خفيفة في النطق .
وايقاع الحروف يكون في تناسبها مع روف أخرى، وفي تكرارها، فالتكرار الصوتي يحدث جمالية وإيقاعا عذبا، إذا روعي في الاختيار عدم الإملال، يقول أحد الباحثين: ” كان الشاعر الجاهلي يسعى إلى تحقيق التكرار الصوتي من طريقين أحدهما نمطي يتصل بنظام القصيدة القديمة كما كانت قد استقرت عليه عبر تاريخها الطويل وهو الالتزام بقافية واحدة وبحر واحد يحدث بهما الشاعر إيقاعا صوتيا واحدا في القصيدة جميعا، والثاني إبداعي يكشف فيه الشاعر عن قدراته الخاصة في إحداث أصوات بعينها تتكرر في كل بيت على حدة فتخلق في داخله جناسا صوتيا، وتختلف من بيت إلى آخر فتخلق بين هذا البيت وغيره من أبيات القصيدة الأخرى وقوافيها الثابته ما يصح أن نسميه طباقا صوتيا (١٠) .
يتمثل التكرار عند المحضار في الاستفادة القصوى من إمكانيات اللغة فهو يستعمل هذه الظاهرة أحسن استعمال فنجده يستفيد من التكرار الحرفي، فتتكرر الحروف عنده بشكل لافت فتحدث موسيقى خاصة تضفي على العبارة تأثيرا في نفس المستمع أو القارئ يكون أدعى إلى امتلاء العبارة بالمعنى .
ومن التكرار الحرفي يمكن الوقوف عند اغنيته التالية:
من الغيرة على حبك نسيت اني احبك
وأني كنت أترجاه قربك
واتمنى لقاك
أنا داري بقلبي يا حبيبي ..
وأنت وش دراك
لا سيما بيته التالي:
وان شفتك استبشريك ..
ولا أسخا شوف شر بك
وحك حتى على أكلك ..
وشربك وما داخل كساك
انا داري بقلبي يا حبيبي ..
وانت وش دراك
فالعناية بتكرار الحرف واضحة هنا وضوحا تاما، واستعملها الشاعر بإتقان تام ، حتى إنك لا تشعر بتكلفه فيها رغم الصعوبة التي ولدتها، مما جعل بعض الفنانين يلقون عنتا في غناء هذه الأغنية، بتراكيبها الفريدة.
والبيت مليء بالصنعة الشعرية التي لا يتقنها إلا القلة، فهو من المهارة بحيث يستعمل عدة معارف لغوية في هذا البيت فالسجع واضح ، والجناس حاضر حضورا كبيرا، والمعنى والدلالة وقوتهما حاضرة أيضاً.
وتتمثل ظاهرة الإيقاع الصوتي للحروف في السجع، الذي يحدث موسيقى خاصة وقد حفل بها شعر المحضار ، وكذلك في الجناس الذي أكثر منه المحضار، وبرع فيه براعة كبيرة .
السجع :
السجع من مكونات الإيقاع اللغوي يقول ابن سنان في سر الفصاحة : ” أما القوافي في الشعر فهي تجري مجرى السجع ” (١١) .. والسجع يكسب الكلام حسنا، ولذلك عد من المحسنات البديعية، ويحرص كثير من الشعراء على تحلية أشعارهم به، ليزيد الشعر موسيقية أعلى، يقول المتنبي:
فنحن في جذل والروم في وجل
والبر في شغل والبحر في خجل (١٢)
وتعريف السجع : ” أنه توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد .. والأصل في السجع إنما هو اعتدال في مقاطع الكلام ، (۱۳) والمحضار أدرك قيمة السجع الجمالية ، فأكثر منه وجعله أداة بارزة من أدواته الفنية التعبيرية ، ويغلب غلبة لافتة على أغانيه الأولى في ديوان الدموع (١٤):
رمز عينه بريد المحبة
بين قلبي وقلبه
باقي الناس ما با يفهمونه
كل تأشير له ألف معنى
في فؤاد المعنى
يفتهم من حواجبه وجفونه
قال لي أيش غير طباعك
قلت ليلة وداعك
عندما سرت والنفس محنونة
الجناس :
يعد الجناس من أكبر ادوات مؤلفي الأغاني، فهو ذو طاقة موسيقية عالية يكسب جملهم وتراكيبهم اللغوية جمالية مؤثرة ولا شك أنه من جماليات اللغة الفصحى التي استخدمها كثير من الشعراء ولكن من أبدع في استخدامها قليلون ومن أبرزهم الشاعر العظيم أبوتمام الذي كان أحد أساطين الجناس في الشعر العربي وقل أن تجد قصيدة لا يستعمل الجناس فيها، بل إنه هو الذي جعل له قيمة كبيرة كما أرى .
وقد كان المحضار من الشعراء القلائل في العامية الذين استعملوا هذه الآلية اللغوية، وهي تحدث موسيقية لغوية واضحة، وهو قد جعلها في شعرة سمة له، وأدخل معها لوازم أخرى جعلها أكثر صعوبة ، ليبين مقدراته النظمية العالية . فمنذ ديوانه الأول (دموع العشاق) نجده يقيد شعره تقييدا بهذه الظاهرة، ويربطها بقيد القافية فتصبح كالسلسة التي يربط الإنسان بها قدميه، ولكنه يتحرك في هذا القيد حركة طليقة، وكأنها انطلاق وانفكاك وليست حبساً وتقييداً . وتبدأ ظاهرة التجنيس بشكل أولي في ديوانه الأول في مجموعة من الأغاني ، بدأ بالالتزام فيها بشطرين ، ثم زادت إلى أكثر من ذلك، ويمكن أن نمثل للبداية أغنيته
يا رسولي) التي يقول فيها:
يا رسولي توجه بالسلامة
زر صحابي ويلفهم سلامي
قل لهم عاد شي في الوصل حيله
ليه لا أوعدوا خلفوا المواعيد
بعدهم ماهني طرفي منامه
بات ليلي تزعل في منامي
واذكر إلا ليالينا الجميله
لي مضت في سفوح الخرد الفيد(١٥)
ونجد الشطرين الأولين في كل مقطع يلتزم الشاعر التجنيس فيهما ( سلامة / سلامي ) ( منامه / منامي) ثم نجد التجنيس في أغاني أخرى في ثلاثة أشطر كالحال في أغنيته ( عذاب) وهي مشهورة بجملتها الأولى ( على ضو ذا الكوكب الساري) يقول فيها:
على ضوذا الكوكب الساري
با قضي الليل خبة وسيرة
ولا حد بما أقصده داري
غير الذي يعلم الأن
وقد التزم في هذه الأغنية التي تتألف من ستة مقاطع بالتجنيس في شطرين أيضا إلا أنه في المطلع جنس في ثلاثة أشطار (ساري / سيرة / أسرار ) ، وفي أحد المقاطع خالف فلم يجنس بين شطرين ( صباري / جار ) ويبدو أن الشاعر في أغانيه الأولى كان يميل إلى الطبع أكثر من ميله إلى الصنعة ولذلك يترك التجنيس إذا لم يأت له عفو الخاطر، ولكنه كان يغلب التجنيس حتى لا تشعر بخروجه عليه في أغانيه لعذوبة التراكيب وجماليتها .
الإيقاع في الألفاظ:
كما يتولد الإيقاع من الأصوات المفردة يأتي من الكلمات ، والاستفادة الصوتية منها ومن مجاورتها لغيرها من الألفاظ وتتمثل ظاهرة الإيقاع اللفظي في التكرار ؟
التكرار:
ويكون في تكرار الأحرف ويتمثل في السجع والجناس كما تقدم، وفي تكرار الكلمات، وفي تكرار الجمل، ويظهر جليا في شعر المحضار، فهو يستجلب النغمات من اللغة كما يستجلبها من الألحان التي تنتجها النغمات الراقصة .
وليس التكرار قصورا من الشاعر في تأدية مشاعره ومعانيه وإنما هو ظاهرة لغوية احتفى بها النقاد قديما وحديثا، يقول الجاحظ : ” ليس التكرار عيا، ما دام الحكمة كتقرير المعنى، او خطاب الغبي أو الساهي ، كما أن ترداد الألفاظ ليس بعي ما لم يجاوز مقدار الحاجة ويخرج إلى العبث (١٦).
ويأتي لدواعي أهمها أن المعاني أوسع مدى من الأصوات ولذلك قد تقصر عن تأديتها فيلجأ الكاتب أو الشاعر إلى التكرار ليضفي معاني جديدة، كما أنه يرتبط بالجانب الوجداني النفسي الذي قد لا تؤديه الألفاظ منفردة، فيقوم التكرار إلى تأدية قسط من هذه المعاني .
والتكرار الكلمي، بمعنى تكرار الكلمات نجده في أكثر أغانيه، بل إن التكرار من أهم وسائل التعبير والتأثير عنده وهو مله من المعانى ما يرفعه عن دائرة الملل التي قد يتصف بها، كون إعادة اللفظ مما يثقل التعبير، وهو لا شك يستحضر نصوص الشعر العربي التي يكرر فيها الشعراء الكبار الألفاظ دون أن يجد القراء مللا في تكرارها كقول مالك بن الريب من قصيدته التي رثى فيها نفسه :
لقد كان في أهل الغضا لودنا الغضا
مزار ولكن الغضا ليس دانيا (۱۷)
فكرر كلمة ( الغضا) ثلاث مرات في بيت واحد يحتوي على إحدى عشرة كلمة ، ولولا قدرة الشاعر في بناء اللغة في هذا البيت لأثقله هذا التكرار، وشكل عبئا عليه، ولكن القارئ يشعر بجمالية صادرة من هذا التكرار وموسيقية جميلة .
يقول المحضار في إحدى أغانيه:
الهوى يخرب مصانع
مصانع عالية والجبر يبنيها
يا محب قلبي تراجع
تراجع
من زمن حاسبك نافع
نافع
الإيقاع في التراكيب الجمل) :
والإيقاع في التراكيب يكون في تكرار الجمل، وفي تناسبها، فالجمل القصيرة المتتابعة تحدث إيقاعا جميلا .
أما تكرار الجملة موجودها في شعره كثير كثير، بل هناك أغان قام عمودها على التكرار، ولا نقصد بذلك الشلة فهذا أمر آخر لا نقصده ، ومن ذلك أغنيته ( ما افتهم لي ) التي بناها على هذه الجملة، يقول فيها :
ما افتهم لي ليش تقصد تعدي في الملاوي
وهي قدامك الجاده
ما افتهم لي ذي سياسة حكيمة منك وألا
شقاوة عقل ومعانده
ويش يفيد التمادي في عنادك…..
في الملاوي اذا خلصت زادك
الملاوي تشل كل ما كسبته لها وتقول هل من مزيد
وتتكرر هذه الجملة في بداية كل مقطع من الأغنية بشكل لافت، والجملة تكشف عن الحيرة التي أقام الشاعر الأغنية عليها، ففيها يصف حالة الحيرة والقلق التي تملكته، وقد قام التكرار هنا برسم الجانب النفسي ، الذي أضفى على معاني الأغنية قوة أكبر.
تناسب الجمل :
لا يعنى الشـاعر في عمله الشعري بالحفاظ على سلامة التركيب واختيار المفردة وإصابة المعنى وصحة الوزن فحسب، إنما هو يسعى إلى تحقيق التأثير في المستمع والقارئ، وربما توافر هذه الأشياء لا يحقق له هذا التأثير الذي يسعى إليه، لا سيما إذا كان ممن يطمح في تحقيق أقصى درجات الفن وتتوافر عنده أدواته .
ولذلك يستدعي هذا التأثير من جوانب أخرى، ومن يسعى إلى كتابة نص أغنية يحرص على أن تكون لها مكانة بين السامعين فهو أحرص على خفة العبارة هولة اللفظة واللجوء إلى الجمل القصيرة، وهي ما التفت إليها المحضار في بناء أغانيه، فقد كان حريصا على تناسب الجمل وخفتها ، يسعى في ذلك سعيا حثيثا.
هذا التناسب في الجمل وعدم إطالتها والخفة في العبارة ، يكسبها إيقاعا مميزا يوازي إيقاع الوزن والقافية، ولعل هذا شي مما قصده الأستاذ با مطرف بقوله : ” أشعار المحضار الغنائية لها مذاقها الخاص بعيدة عن اللحن (۱۸) وهو يقصد بعيدة عن الوزن .
وقد أشار بامطرف إلى حرصه على جمالية التركيب اللفظي في مواضع أخرى كقوله: “
حينما قلنا إننا نتردد أن نصنفه ملحنا أولا أو شاعرا أولا كنا وما زلنا نراعي التنغيم الأخاذ في ألحانه ، ونراعي القول المسبوك الرصين في أشعاره (۱۹).
الدلالة في شعر المحضار :
المحضار من الشعراء الذين احتفوا بالمعنى احتفاء لافتا ، فهو شاعر يحيط شعره بالإتقان في جوانبه المختلفة، جانب اللغة وهي المادة الأولى ، وجانب المعنى ، وجانب الموسيقى و المعنى هو الخلاصة من الكلام .
والدلالة لها مظاهر متعددة في اللغة العربية الفصحى، وكثير منها متحقق في شعر المحضار لأنه يكتب أشعاره بلغة تصدر من قوس واحد مع الفصحى وهي العامية والمعروف أن العامية تتســـع إمكانياتها اللغوية إلى مديات كبيرة إذا وجدت همم وقدرات إبداعية كبيرة، وهو ما نجد شواهده عند كثير من المبدعين في لهجات عربية كثيرة .
تتمثل الدلالة عنده في : الترادف والاشتراك اللفظي والتضاد، والمعجم، والاقتراض، والازدواج اللغوي، والإشارة وتعدد المعنى .
كيف تعامل المحضار مع هذه الظواهر اللغوية، هل كان واعيا بهذه الظواهر في شعره؟ وهل استعملها مدركا لإشكالياتها اللغوية؟ أو أنها كانت تأتيه عفو الخاطر، لا يتكلفها ، ولا يسعى إليها، ولا يتأمل في أبعادها في شعره .
لم يعرف عن المحضار أنه كان حريصا على تفسير شعره كما ذكر الأستاذ بامطرف ، ولم يعرف عنه في لقاءاته الكثيرة أنه كان ميالا إلى توضيح مغاليقه وقد رد بامطرف ذلك إلى أنه كان يرغب أن يترك الناس في حيرة من شعره مما يجعل شعره منفتحاً على معان متعددة، وهذا التفسير إنما هو طريقة لطيفة من الأستاذ لإضفاء ميزة أخرى إلى الميزات الكثيرة
التي يتحلى بها المحضار، حتى لو كان خاليا منها .
كان المحــضار غنياً في اللغة غنيا في المعاني ، وهذا الغنى يدل على نتيجة بديهية أنه كان على وعي بمفردات هذه اللغة وتراكيبها، وعلى وعي بدقائق الكلمات ، يضع المفردة في مكانها الخاص بها، لا تلجؤه الضرورة في أكثر الأحيان إلى وضع مفردة في غير مكانها، سواء أكان ذلك في الحفاظ على متانة المعنى، أو جمالية التركيب أو دقة الحفاظ على الوزن والقافية وقد وجدت حالات كثيرة كان مضطرا إلى وضع كلمات ليست في مكانها المطلوب وكان ذلك في حالات القافية غالباً .
الترادف :
والترادف في الألفاظ “ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة وهو ضد المشترك ، أخذ من الترادف الذي هو ركوب ا اح د خلف آخر كأن المعنى مركوب واللفظان راکبان عليه (٢٠) أو هو ” الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد (۲۱) . والترادف من الظواهر التي عني بها اللغويون كثيرا، وهي تتصل بإشكالية اللفظ والمعنى، والمحضار عني بالمعاني عناية بارزة ، فلم تكن أغانيه مجرد دغدغة عواطف، ولا إثارة مشاعر، وإنما كانت كشفا عن مكنونات الأنفس، والتقاطا وتبيينا للمشاعر المتضاربة التي تجيش في النفس الإنسانية، وهذا الذي ارتفع بالعبارة عنده، وسمى باللغة سموا .
إن المتأمل في شعر المحضار الغنائي يجد هذا التدفق المعنوي ،اللافت والتتبـع للمشاعر المختلفة وصياغتها في تراكيب تستحضر أساليب العربية الرفيعة في نصوصها البارزة، وقد وجدنا في شعر المحضار ظاهرة الترادف ترد كثيرا ، وهي ظاهرة واردة في اللغة بشـكل كثير يستعملها الناس في تعابيرهم، وتبدو أكثر في كلام العارفين باللغة وبمفرداتها الكثيرة ، فهي تنبئ عن وفرة مفردات الكاتب، كما تنبئ عن وفرة المعاني . ومنذ ديوانه الأول الدموع ، تجد هذا الثراء اللغوي والتصرف في المفردة، تصرف المثري، يقول:
فارقتهم والدمع من عيوني سبل
والتذكار في خاطري لم يزل
يا ريت لي عندهم كن والا محل
يكفل الراس لو حتى تنعشر فوت (۲۲)
وتستوقفنا الكلمتان المترادفتان ( كن ) و(محل) ونتساءل: أجاءت الكلمتان مترادفتين بمعنى واحد ، أم أن كل واحدة منها حملت معنى مستقلا ؟ وهل الشاعر يعيد المعنى ذاته في عباراته أو أنه يحمل كل لفظا معنى آخر يثري ما قبله؟
ونعود إلى معجم العربية الكبير ( لسان العرب ) فنجده يفرق بين معنيي اللفظين تفريقا واضحا يقول : ” الكن : البيت …. ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن (۲۳)
في حين أن الكلمة الأخرى لها معنى آخر يقول: ” المحل: نقيض المرتحل …. الموضع الذي يُحل فيه (٢٤) وعلى ضوء هذا التوضيح نجد أن المعنى في بيت المحضار أن الشاعر يتمنى أن يكون له إقامة ثابتة ( كن ) وإن لم فليكن له فيه (محل) أي زيارة بينهم يقضي فيها وقتا.
وبذلك يتبين أن المحضار في استعماله للترادف لا يفرط في استعمال الألفاظ ، وإنما يقيد المعنى تقييدا ، فلا يأتي اللفظ زائدا لا شأن له إلا تكملة وزن ، أو ضبط قافية . وهذا مثال من أمثلة عديدة تبدو للوهلة الأولى أن الشاعر قصرت به العبارة فأقامها كلمة ليس لها من فائدة في المعنى وإنما سبيلها الحفاظ على هيئة البيت وسلامة الوزن، ثم بتأمل التركيب والمعنى تجد أن الكلمات جميعها قــد اتخذت وظائفها الدلالية، وأن لا حشو في تكرار لفظ وترادفه (٢٥) .
ويمكن أن نضيف مثالا آخر من أغنية الحجيرة ) التي يقول فيها:
كنا قطيرة نخرج الظهر في هجر الهجيرة
تطلع النوف ونمر حيث الحضف والضيق
للحب غيرة في محلات مصيونة ستيرة
خابوا الناس لي يكشفونه في المطاريق (٢٦)
وحين نلجأ إلى المعاجم العربية لنبحث عن هذه المفردة ( الحضف) نجد أن معجم اللسان وهو من أوعى المعاجم قد خلا منها، ولكن تاج العروس ذكرها قائلا : قال الصاغاني : ” الحضف بالكسر .. : الحية ..
وأنشد لرويشد
وهدت جبال الصبح هذا ولم يدع
مدقهم أفعى تدب ولا حضفا (۲۷)
ومن هذا المعنى يمكن أن نستنتج ان الحضف وهي عامية حضرمية تقال بتحريك الضاد لا بتس كينها، وتدل على المكان الضيق، ويبدو أن معناها مكان الحية، وهو ضيق ويتسم بالخطورة، فالكلمتان إذن بمعنيين مختلفين فهم يمرون حيث الأماكن الشديدة الخطورة، و الضيقة .
الاشتراك اللفظي :
ومن القضايا التي ترتبط بدلالة الألفاظ قضية الاشتراك اللفظي ، وهو أن تشترك عدة معان في لفظ واحد، أو أن يدل لفظ على عدد من المعاني، وهي ظاهرة عني بها الدلاليون ، واستعملها المحضار بشكل لافت، وهي تحتاج إلى إدراك دقيق لمعاني الألفاظ كما أنها تتصل إلى جانب تعميق المعنى بتحسين العبارة، لتتأمل قوله في أغنيته :
وهم عالعسل واللين من سمح ضروني
وبعده سقوني من القاطع وضروني
ورجعوا يجافوني على الفلس والدائك
إذا عزني الله هم مقصودهم هوني
بغونا نخب جم ونا نمشي على هوني
ومن حب جم في عظامه جا له الصانك (۲۸)
والمحضار يستثمر الجانب الموسيقي في هذه الألفاظ، كما يستثمر الجانب الدلالي فيها، فهو يس تعمل اللفظ (ضروني) بدلالتين مختلفين، فاللفظة الأولى تحتمل دلالة واحدة ( عودوني) ، في حين تحتمل الثانية دلالتين ، ( عودوني ، أو أذوني ) ، أما اللفظة الثانية ( هوني ) فلما دلالتان (الهوان ، و التريث)، ويستعمل البلاغيون العرب هذا النوع في المحسنات البلاغية التي تجلب إلى العبارة واللفظ جرسا موسيقيا يحدث لها جمالية عالية . ويبلغ المحضار في التصرف بالألفاظ درجات عالية من البراعة حتى يحدث تأثيرات نفسية في متلقيه نجد ذلك في
أغنيته التي يقول فيها:
مشينا بها في الرمل مشي المجانين
علشان ما في القلب من شوق وحنين
لأحبابنا لي في سعاد الزبينة
ولا حد يلومه لي يفارق ضنينه
مية يمشي السواق ومية وعشرين
لا با يهون قلت من غير تهوين
نريد المعزة ما نريد الهوينة
ولا حد يلومه لي يفارق ضنينه
فقد جعل كلمة ( الهوينة ) تنصرف إلى معنى آخر ) عكس المعزة) وهو غير المعنى الذي بدأه في جملة: ( لا با يهون قلت من غير تهوين ) الذي هو ( إبطاء السرعة ) ، فكلمة ( الهوينة) حملت معنيين وهي من المشترك، وقد استطاع الشاعر أن يستثمر تعدد المعنى في اللفظ ليحدث في نفس المستمع أثرا نفسيا جميلا .
التضاد :
والتضاد من قضايا المعنى البارزة وهي وجود لفظ يحمل معنيين متناقضين، ولا شك أن استعمال هذا اللفظ يحدث إشكالا معنويا لتناق ض الدلالة فيه ، وهذا التناقض يمكن أن يكون عائقا من عوائق إيصال المعنى، وضعف الرسالة، ويمكن أن يكون مثيرا لفظيا يؤدي الى إكساب العبارة شعرية عالية، وقد استعمله المحضار احسن استعمال .
ويمكن الاستشهاد على ذلك بالنموذج السابق :
وهم عالعسل واللبن من سمح ضروني
وبعده سقوني من القاطع وضروني
حيث تحتمل كما تقدم لفظة (ضروني ) المعنى ونقيضه، ففي الأولى كان النفع بشرب العسل، والثانية كان الضرر بشرب المر.
الدلالة في الايقاع :
ربما يبدو العنوان غريبا، فالإيقاع إنما هو تناسب في أصوات اللغة، فهل يمكن أن ينتج هذا التناسب معنى ما الواقع أن اللغة بتراكيبها ودلالاتها إنما تسعى الى إحداث تأثير في المتلقي قارنا كان أو سامعا، فالنتيجة النهائية للغة هو هذا التأثير، وهو مقصد الرسالة اللغوية .
والأصوات قد تحدث تأثيرا من غير أن تكون في كلام لغوي ، أو تحدثه في كلام لغوي، فيتولد التأثير من جانبين : جانب لغوي يقوم على دلالة الألفاظ منفردة والتراكيب، وجانب أصواتي يقوم على جمالية تناسب الحروف وتراكيب الكلمات فلاشك أننا نشعر في قراءة قطعة ما
بجمالية اللغة الذي تحدث أثرا نفسيا، وهو أثر نفسي يأتي ليس من جهة المعنى وإنما من جهة أصوات اللغة، كما أن الأثر الذي يحدثه الكلام يأتي من التركيب ، وكلا الأثرين يولدان المعنى العام للنص أو الأثر الأكبر للرسالة اللغوية .
هذه أشياء مما سمح بها الوقت من إبداعات المحضار حاولنا أن نقف عليها وسوف نستكمل الوقوف على غيرها إذا سمح الوقت والجهد.
المراجع :
– البيان والتبيين للجاحظ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
– التكرار الإيقاعي في اللغة العربية ، د. سيد خضر دار الهدى للكتاب، مصر، كفر الشيخ ط 1 ۱۹۹۸م.
– التعريفات للقاضي العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان بيروت ١٩٨٥م. تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مطبعة
حكومة الكويت .
– ديوان مالك بن الريب تحقيق : نوري حمودي القيسي، مستل من مجلة معهد المخطوطات
العربية مجلد ١٥ جزء ١ .
– سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ت ٥٤٦٦ ط ۱۹۸۲۱م دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
– شرح البرقوقي لديوان المتنبي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ٥١٤٠٧ ١٩٨٦م. – في البلاغة العربية علم البديع ، الدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت
لبنان.
– لسان العرب لابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد احمد حسب الله هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف ، القاهرة جمهورية مصر العربية.
– اللغة عند المحضار للباحث نفسه ، نشر جزء منه في كتاب المحضار بأقلام عشاقه .
– المزهر في علوم العربية وانواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي تحقيق محمد احمد جاد المولى و محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي مكتبة دار التراث. القاهرة ، بدون تاريخ .
– مجلة سعاد الشحر حضرموت ، الجمهورية اليمنية العدد العاشر.
– مقابلة مع الصحفية كوثر البشراوي بثتها قناة ( ام بي سي ) .
– دموع العشاق – ابتسامات العشاق .
الهوامش :
1 – دموع العشاق ص / 6
2 – مجلة سعاد الشحر العدد العاشر مقابلة أجراها الأستاذ رياض باشراحيل مع عبد المعين
ص / ١٢.
3 – مقابلة مع الصحفية كوثر البشراوي بثتها قناة ( ام بي سي ) .
4 – دموع العشاق ص/ 10 – 11 .
5 – ابتسامات العشاق ص / ٧ في هذا هذا المقطع من كلام بامطرف ملاحظات نحوية لم نشأ أن نشير لها تحديدا سيدركها من له دراية بالنحو .
6 – مقابلة مع الصحفية كوثر البشراوي بنتها قناة (ام بي سي).
7 – ابتسامات العشاق ص / ٥٩
8 – ابتسامات العشاق ص / ۹۳
9 – دموع العشاق ص / ۲۲
١٠ – التكرار الايقاعي في اللغة العربية ، د. سيد خضر دار الهدى للكتاب، مصر، كفر الشيخ ط 1. ۱۹۹۸ م ص ۸.
۱۱ – سر الفصاحة ص/ ۷۹ .
١٢ – شرح البرقوقي لديوان المتنبي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ١٩٨٦، ۳/۲۰٤ ١٣ – في البلاغة العربية علم البديع ، الدكتور عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان ص / ٢١٤٥ .
١٤ – ينظر دموع العشاق ص / ٢٥ و ص ٧٩ .
١٥ – دموع العشاق ص ۲۲
١٦ – البيان والتبيين للجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ۱/۷۹
۱۷ – دیوان مالك بن الريب تحقيق : نوري حمودي القيسي ص/۸۸
۱۸ – ابتسامات العشاق ص ٧
۱۹ – ابتسامات العشاق ص /١٦ ١٧
٢٠ – التعريفات للقاضي العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان بيروت ١٩٨٥ ص / ٢١٠.
٢١ – المزهر في علوم العربية وانواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي تحقيق: محمد احمد جاد المولى و محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي مكتبة دار التراث، القاهرة ١/٤٠٢ .
۲۲ – دموع العشاق ص/ ۸۳ .
٢٣ – اللسان من / ٣٩٤٢
٢٤ – اللسان ص ۹۷۲
٢٥ – ينظر: ينظر دموع العشاق: ص / ١٠٢ / 111 / 113 / 116 / 119 / 123 .
٢٦ – ابتسامات العشاق ص ٤٧
27 – تاج العروس ٢٣/١٤٦
۲۸ – ابتسامات العشاق ص ٩٠ .